بدائع الفوائد/المجلد الأول
< بدائع الفوائد
→ الغلاف بدائع الفوائد
المجلد الأول
محتويات
1 فائدة: حقوق المالك والملك
2 فائدة: تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع
3 فائدة: تقديم الحكم على سببه
4 فائدة: الفرق بين الشهادة والرواية
5 فائدة: قول الواحد في هلال رمضان
6 فائدة: الهدية والاستئذان
7 فائدة: الخبر
8 فائدة: تقسيم الخبر
9 فائدة: معاني لفظ شهد
10 فائدة: حد الخبر
11 فائدة: الإنشاءات التي صيغها أخبار
12 فائدة: المجاز والتأويل
13 فائدة: إضافة الموصوف للصفة
14 فائدة: الاسم والمسمى
15 فائدة: اسم الله والاشتقاق
16 فائدة: هل الرحمن في البسملة نعت
17 فائدة: حذف العامل في بسم الله
18 فائدة: عطف الصلاة على البسملة
19 فائدة: بطلان أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة
20 فائدة: اشتقاق الفعل من المصدر
21 فائدة: المصدر عند الكوفيين
22 فائدة: عمل الحروف
23 فائدة: اختصاص الإعراب بالأواخر
24 فائدة: وصف الحرف بالحركة
25 فائدة: تقول نونت الكلمة وسينتها وكوفتها وزويتها
26 فائدة: التنوين في الكلمة
27 فائدة: الحكمة في علامة التصغير
28 فائدة: تنوع الأفعال
29 فائدة: إضافة ظروف الزمان للأحداث
30 (فائدة: قياس الأسماء الخمسة أن تكون مقصورة)
31 فوائد تتعلق بالحروف الروابط بين الجملتين وأحكام الشرط
32 فائدة: الروابط بين جملتين
33 فائدة عظيمة المنفعة: تقديم بعض الألفاظ الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب
34 (مسائل في المثنى والجمع)
35 (الواو والألف في يفعلون وتفعلان)
36 فائدة: أسماء الأيام
37 فائدة: الأمس واليوم والغد
38 فائدة: حذف لام يد ودم وغد
39 فائدة: دخول الزوائد على الحروف
40 فائدة: فعل الحال
41 فائدة: حروف المضارعة
42 فائدة: السين تشبه حروف المضارعة
43 فائدة بديعة: دخول أن على الفعل
44 فائدة: إذا الظرفية الشرطية
45 فائدة بديعة: لام كي ولام الجحود
46 فائدة: نفي الماضي ونفي المستقبل
47 فائدة بديعة: لام الأمر ولا الناهية
48 فائدة بديعة: المفرد والجمع وأسباب اختلاف علامات الجمع
49 فائدة: علامة التثنية والجمع
50 فائدة بديعة: تقدم علامة التثنية والجمع للفعل
51 فائدة بديعة: قولهم ضرب القوم بعضهم بعضا
52 فائدة: إنما للنفي والإثبات
53 فائدة بديعة: الوصلات الخمسة
54 فائدة بديعة: ما الموصولة
55 (سورة الكافرون)
56 فصل: الرد على المعتزلة
57 فائدة: ضمير من يكرمني
58 فائدة: حذف الألف من ما الاستفهامية
59 فائدة بديعة: قوله ثم لننزعن من كل شيعة
60 فائدة: تحقيق معنى أي
61 فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب
62 (في أسماء الله وصفاته)
63 (أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى)
64 فائدة: المعنى المفرد لا يكون نعتا
65 فصل: إقامة النعت مقام المنعوت
66 فائدة بديعة: النعت السببي
67 فائدة: اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه
68 فائدة: تفسير الكلام
69 فائدة بديعة: اسم الإشارة
70 فائدة: العامل في النعت
71 فائدة بديعة: حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة
72 فائدة: النعت
73 فائدة بديعة: الشيء لا يعطف على نفسه
74 تتمة
75 فائدة جليلة: تقدير العامل في المعطوف
76 فصل: حتى
77 تنبيه
78 فائدة: أو للدلالة على أحد الشيئين
79 فصل: لكن
80 (فصل في لا العاطفة)
81 فائدة بديعة: أم على ضربين
82 فصل: أم المنقطعة للإضراب
83 فائدة بديعة: لا يجوز إضمار حرف العطف
84 فائدة بديعة: كل لفظ دال على الإحاطة بالشيء وكأنه من لفظ الإكليل
85 فصل: كل ذلك لم يكن ولم يكن كل ذلك
86 فصل: إضافة كل للمخاطبين
87 فائدة: كلا وكلتا بين الكوفيين والبصريين
88 فائدة: تأكيد المفرد بأجمع
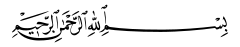
قال الشيخ الإمام العلامة الأوحد البارع أوحد الفضلاء وقدوة العلماء وارث الأنبياء شيخ الإسلام مفتي الأنام المجتهد المفسر ترجمان القرآن ذو الفوائد الحسان أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته.
الحمد لله ولا قوة إلا بالله، هذه فوائد مختلفة الأنواع.
فائدة: حقوق المالك والملك
حقوق المالك شيء وحقوق الملك شيء آخر، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق وحقوق الملك تتبع الملك ولا يراعى بها المالك، وعلى هذا حق الشفعة للذمي على المسلم من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين.
والنظر الثاني أظهر وأصح، لأن الشارع لم يجعل للذمي حقًا في الطريق المشترك عند المزاحمة. فقال: إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فكيف يجعل له حقًا في انتزاع الملك المختص به عند التزاحم وهذه حجة الإمام أحمد نفسه. وأما حديث لا شفعة لنصراني فاحتج به بعض أصحابه وهو أعلم من أن يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين.
فائدة: تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع
تمليك المنفعة شيء وتمليك الانتفاع شيء آخر، فالأول يملك به والمعاوضة، والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة وعليها إجارة ما استأجره، لأنه ملك المنفعة بخلاف المعارضة على البضع، فإنه لم يملكه، وإنما ملك أن ينتفع به. وكذلك أجاره ما ملك أن ينتفع به من الحقوق، كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس والربط ونحو ذلك لا يملكها، لأنه لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع وعلى هذا الخلاف تخرج إجارة المستعار فمن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما، قال: لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع ومن جوزها كمالك ومن تبعه. قال: هو قد ملك المنفعة، ولهذا يلزم عنده بالتوقيت، ولو أطلقها لزمت في مدة ينتفع بمثلها عرفًا، فليس له الرجوع قبلها.
فائدة: تقديم الحكم على سببه
قولهم: إذا كان للحكم سببان جاز تقديمه على أحدهما. ليس بجيد وفي العبارة تسامح والحكم لا يتقدم سببه، بل الأولى أن يقال: إذا كان للحكم سبب وشرط جاز تقديمه على شرطه دون سببه. وأما تقديمه عليهما أو على سببه فممتنع، ولعل النزاع لفظي فإن شرط الحكم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته، فلو قدمت الظهر مثلًا على الزوال والجلد على الشرب والزنا لم يجز اتفاقًا. وأما إذا كان له سبب وشرط فله ثلاثة أحوال. أحدها: أن يتقدم عليهما فلغو، والثاني: أن يتأخر عنهما فمعتبر صحيح، الثالث: أن يتوسط بينهما فهو مثار الخلاف. وله صور:
إحداها: كفارة اليمين سببها الحلف وشرطها الحنث، فمن جوز توسطها راعى التأخر عن السبب، ومن منعه رأى أن الشرط جزء من السبب.
الثانية: وجوب الزكاة سببه النصاب وشرطه الحول ومأخذ الجواز وعدمه ما ذكرناه.
الثالثة: لو كفر قبل الجرح كان لغوًا وبعد القتل معتبر وبينهما مختلف فيه.
الرابعة: لو عفى عن القصاص قبل الجرح فلغو وبعد الموت عفو الوارث معتبر وبينهما ينفذ أيضا.
الخامسة: إذا أخرج زكاة الحب قبل خروجه لا يجزي، وبعد يبسه يعتبر وبين نضجه ويبسه كذلك.
السادسة: إذا أذن الورثة في التصرف فيما زاد على الثلث قبل المرض فلغو وإجازتهم بعد الموت معتبرة وأذنهم بعد المرض مختلف فيه، فأحمد لا يعتبره لأنه أجازة من غير مالك. ومالك يعتبره وقوله أظهر.
السابعة: إذا أسقطا الخيار قبل التبايع ففيه خلاف فمن منعه نظر إلى تقدمه على السبب، ومن أجازه وهو الصحيح قال: الفرق بينهما أنهما قد عقدا العقد على هذا الوجه فلم يتقدم هنا الحكم على سببه أصلًا. فإنه لم يثبت وسقط بعد ثبوته وقبل سببه، بل تبايعا على عدم ثبوته وكأنه حق لهما رضيا بإسقاطه وعدم انعقاده وتجرد السبب عن اقتضائه. فمن جعل هذه المسألة من هذه القاعدة، فقد فاته الصواب.
ونظيرها سواءً اسقاط الشفعة قبل البيع فمن لم ير سقوطها، قال: هو تقديم للحكم على سببه، وليس بصحيح بل هو إسقاط لحق كان بعرض الثبوت، فلو أن الشفعة ثبتت ثم سقطت قبل البيع لزم ما ذكرتم ولكن صاحبها رضي بإسقاطها وأن لا يكون البيع سببًا لأخذه بها، فالحق له وقد أسقطه. وقد دل النص على سقوط الخيار والشفعة قبل البيع وصار هذا كما لو أذن له في إتلاف ماله وأسقط الضمان عنه قبل الاتلاف، فإنه لا يضمن اتفاقًا فهذا موجب النص والقياس. وأما إذا أسقطت المرأة حقها من النفقة والقسم، فلها الرجوع فيه ولا يسقط، لأن الطباع لا تصبر على ذلك ولا تستمر عليه لتجدد اقتضائها له كل وقت، بخلاف اسقاط الحقوق الثابتة دفعة كالشفعة والخيار ونحوهما، فإنها قد توطن النفس على إسقاطها وأشباهها لا تتجدد فافهمه.
فائدة: الفرق بين الشهادة والرواية
الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الأزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة. فإلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة واللهمة الموجبة للرد، فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبًا على الظن. صدق المخبر وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط. ولما كان النساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها، لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها، وأما اشتراط الحرية ففي غاية البعد ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك أنه قال: ما علمت أحدًا رد شهادة العبد والله تعالى يقبل شهادته على الأمم يوم القيامة. فكيف لا يقبل شهادته على نظيره على المكلفين ويقبل شهادته على الرسول ﷺ في الرواية فكيف لا يقبل على رجل في درهم ولا ينتقض هذا بالمرأة؟ لأنها تقبل شهادتها مع مثلها لما ذكرناه، والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد.
وعلى هذه القاعدة مسائل:
أحدها الاخبار عن رؤية هلال رمضان من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه للمكلفين، فهو كالأذان. ومن اشترط فيه العدد ألحقه بالشهادة لأنه لا يعم الأعصار ولا الأمصار، بل يخص تلك السنة وذلك المصر في أحد القولين وهذا ينتقض بالأذان نقضًا لا محيص عنه. وثانيها الاخبار بالنسب بالقافة فمن حيث أنه خبر جزئي عن شخص جزئي يخص ولا يعم جرى مجرى الشهادة، ومن جعله كالرواية غلط فلا مدخل لها هنا، بل الصواب، أن يقال من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عامًا يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات جرى مجرى الحاكم. فقوله: حكم لا رواية.
ومن هذا الجرح للمحدث والشاهد هل يكتفى فيه بواحد إجراء له مجرى الحكم أو لا بد من اثنين؟ إجراء له مجرى الشهادة على الخلاف، وأما أن يجري مجرى الرواية فغير صحيح وأما للرواية والجرح. وإنما هو يجرحه باجتهاده لا بما يرويه عن غيره.
ومنها الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها. هل يشترط فيها التعدد؟ مبني على هذا ولكن بناؤه على الرواية والشهادة صحيح، ولا مدخل للحكم هنا.
ومنها التقويم للسلع من اشترط العدد رآه شهادة ومن لم يشترطه أجراه مجرى الحكم لا الرواية.
ومنها القاسم هل يشترط تعدده على هذه القاعدة؟ والصحيح الاكتفاء بالواحد لقصة عبد الله بن رواحة.
ومنها تسبيح المصلي بالإمام هل يشترط أن يكون المسبح اثنين؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة.
ومنها المخبر عن نجاسة الماء هل يشترط تعدده؟ فيه قولان.
ومنها الخارص والصحيح في هذا كله الاكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة، وأما تسبيح المأموم بإمامه ففيه نظر، وفيها المفتي يقبل واحدًا اتفاقًا.
ومنها الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع. والصحيح الاكتفاء فيه بالواحد كالتقويم والقائف. وقالت المالكية: لا بد من اثنين ثم تناقضوا. فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة.
فائدة: قول الواحد في هلال رمضان
إذا كان المؤذن يقبل قوله وحده، مع أن لكل قوم فجرًا وزوالًا وغروبًا يخصهم، فلأن بقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى وأحرى.
فائدة: الهدية والاستئذان
يقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان. وعليه عمل الأمة قديمًا وحديثًا، وذلك لما احتف بأخبارهم من القرائن التي تكاد تصل إلى حد القطع؟ في كثير من الصور مع عموم البلوى بذلك، وعموم الحاجة إليه. فلو أن الرجل لا يدخل بيت الرجل ولا يقبل هديته إلا بشاهدين عدلين يشهدان بذلك. حرجت الأمة. وهذا تقرير صحيح، لكن ينبغي طرده وإلا وقع التناقض. كما إذا اختلفا في متاع البيت، فإن القرائن التي تكاد تبلغ القطع تشهد بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنه. والمرأة لما يليق بها ولهذا قبله الأكثرون وعليه تخرج حكومة سليمان بين المرأتين في الولد وهي محض الفقه. وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس، وهو كما ذكر، وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال من اجتماع الأهل والقرابات وندرة التدليس، والغلط في ذلك مع شهرته وعدم المسامحة فيه ودعوى ضرورات الناس إلى ذلك ما أوجب قبول قولها.
فائدة: الخبر
قبول قول القصاب في الذكاة ليس من هذا الباب بشيء، بل هو من قاعدة أخرى. وهي أن الإنسان مؤتمن على ما بيده وعلى ما يخبر به عنه، فإذا قال الكافر: هذه ابنتي جاز للمسلم أن يتزوجها، وكذا إذا قال: هذا مالي جاز شراؤه وأكله فإذا قال هذا ذكيته جاز أكله، فكل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده فلا يشترط هنا عدالة ولا عدد.
فائدة: تقسيم الخبر
الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة، فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية، وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى. وإن كان خبرًا جزئيًا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة، أو العلم فهو الشهادة وإن كان خبرًا عن حق يتعلق بالمخبر عنه، والمخبر به هو مستمعه أو نائبه فهو الدعوى. وإن كان خبرًا عن تصديق هذا الخبر، فهو الإقرار وإن كان خبرًا عن كذبه، فهو الإنكار وإن كان خبرًا نشأ عن دليل فهو النتيجة، وتسمى قبل أن يحصل عليها الدليل مطلوبًا، وإن كان خبرًا عن شيء يقصد منه نتيجته فهو دليل وجزؤه مقدمة.
فائدة: معاني لفظ شهد
شهد في لسانهم لها معان. أحدها الحضور ومنه قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [1] وفيه قولان: أحدهما من شهد المصر في الشهر. والثاني من شهد الشهر في المصر. وهما متلازمان. والثاني الخبر ومنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. والثالث الاطلاع على الشيء ومنه: { والله على كل شيء شهيد }، [2] وإذا كان كل خبر شهادة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، وعن أحمد فيها ثلاث روايات. إحداهن اشتراط لفظ الشهادة. والثانية الاكتفاء بمجرد الإخبار اختارها شيخنا. والثالثة الفرق بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة وعلى الأفعال، فالشهادة على الأقوال لا يشترط فيها لفظ الشهادة وعلى الأفعال يشترط، لأنه إذا قال: سمعته يقول فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله ﷺ فيما يخبر عنه.
فائدة: حد الخبر
اختلف أبو المعالي وابن الباقلاني في قولهم في حد الخبر إنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب. فقال أبو المعالي: يتعين أن يقال يحتمل الصدق أو الكذب، لأنهما ضدان فلا يقبل إلا أحدهما. وقال القاضي: بل يقال يحتمل الصدق والكذب، وقوله أرجح إذ التنافي إنما هو بين المقبولين لا بين القبولين ولا يلزم من تنافي المقبولات تنافي القبولات، ولهذا يقال: الممكن يقبل الوجود والعدم، وهما متناقضان. والقبولان يجب اجتماعهما له لذاته، لأنه لو وجد أحد القبولين دون الآخر لم يكن ممكنًا، فإنه لو لم يقبل الوجود كان مستحيلًا ولو لم يقبل العدم كان واجبًا فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين. وإن تنافى المقبولان، وكذلك نقول: الجسم يقبل الأضداد فقبولاتها مجتمعة والمقبولات متنافية.
فائدة: الإنشاءات التي صيغها أخبار
اختلف في الإنشاءات التي صيغها أخبار كبعت وأعتقت. فقالت الحنفية: هي أخبار، وقالت الحنابلة والشافعية: هي إنشاءات لا أخبار لوجوه، أحدها: لو كانت خبرًا لكانت كذبًا، لأنه لم يتقدم منه مخبره من البيع والعتق، وليست خبرًا عن مستقبل. وفي هذا الدليل شيء، لأن لهم أن يقولوا: إنها إخبارات عن الحال، فخبرها مقارن للتكلم بها. الثاني: لو كانت خبرًا فإما صدقًا وإما كذبًا. وكلاهما ممتنع. أما الثاني فظاهر. وأما الأول فلأن صدقها متوقف على تقدم أحكامها، فأحكامها: إما أن تتوقف عليها فلزم الدور أو لا يتوقف، وذلك محال لأنه لا توجد أحكامها بدونها، ولقائل أن يقول: هو دور معية لا تقدم، فليس بممتنع، وثالثها: أنها لو كانت أخبارات فأما عن الماضي أو الحال، ويمتنع مع ذلك تعليقها بالشرط، لأنه لا يعمل إلا في مستقبل. وإما عن مستقبل وهي محال لأنه يلزم تجردها عن أحكامها في الحال، كما لو صرح بذلك. وقال ستصيرين طالقًا، ولقائل أن يقول: ما المانع أن يكون خبرًا عن الحال. قولكم يمتنع تعليقها بالشرط. قلنا: إذا علقت بالشرط لم تبق أخبارًا عن الحال، بل أخبارًا عن المستقبل. فالخبر عن الحال الإنشاء المطلق، وأما المعلق فلا. ورابعها: أنه لو قال لمطلقة رجعية: أنت طالق. لزمه طلقة أخرى مع أن خبره صدق، فلما لزمه أخرى دل على أنهما إنشاء ولقائل أن يقول: لما قلنا هي خبر عن الحال، بطل هذا الإلزام. وخامسها أن إمتثال قوله تعالى: { فطلقوهن لعدتهن } [3] أن يقول: أنت طالق. وليس هذا تحريمًا، فإن التحريم والتحليل ليس إلى المكلف، وإنما إليه أسبابهما. وليس المراد بالأمر أخبروا عن طلاقهن، وإنما المراد إنشاء أمر يترتب عليه تحريمهن ولا نعني بالإنشاء إلا ذلك. ولقائل أن يقول: المأمور به هو السبب الذي يترتب عليه الطلاق فهنا ثلاثة أمور، الأمر بالتطليق، وفعل المأمور به وهو التطليق. والطلاق وهو التحريم الناشىء عن السبب. فإذا أتى بالخبر عما في نفسه من التطليق فقد وفى الأمر حقه وطلقت. وسادسها أن الإنشاء هو المتبادر إلى الفهم عرفًا وهو دليل الحقيقة. ولهذا لا يحسن أن يقال فيه صدق أو كذب ولو كان خبرًا لحسن فيه أحدهما: وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة أخر. فأجيب عن الأول بأن الشرع قدر تقدم مدلولات هذه الأخبار قبل التكلم بها بالزمن الفرد ضرورة الصدق، والتقدير أولى من النقل. وعن الثاني: أن الدور غير لازم فإن هنا ثلاثة أمور مترتبة فالنطق باللفظ لا يتوقف على شيء. وبعده تقدير تقدم المدلول على اللفظ وهو غير متوقف عليه في التقدير وأن توقف عليه في الوجود وبعده لزوم الحكم ولا يتوقف اللفظ عليه وأن توقف هو على اللفظ. وعن الثالث أما يلزم أنها إخبارات عن الماضي ولا يتعذر التعليق، فإن الماضي نوعان: ماض تقدم مدلوله عليه قبل النطق به من غير تقدير فهذا يتعذر تعليقه. والثاني ماض بالتقدير لا التحقيق. فهذا يصح تعليقه. وبيانه أنه إذا قال: أنت طالق. إن دخلت الدار فقد أخبر عن طلاق امرأته بدخول الدار. فقدرنا هذا الارتباط قبل تطلقها بالزمن الفرد ضرورة الصدق، وإذا قدر الارتباط قبل النطق صار الخبر عن الارتباط ماضيًا، إذ حقيقة الماضي هو الذي تقدم مخبره خبره، إما تحقيقًا وإما تقديرًا. وعلى هذا فقد اجتمع الماضي والتعليق ولم يتنافيا. وعن الرابع أن المطلقة الرجعية أن أراد بقوله لها. أنت طالق. الخبر عن طلقة ماضية لم يلزمه ثانية، وإن أراد الخبر عن طلقة ثانية فهو كذب لعدم وقوع الخبر، فيحتاج إلى التقدير ضرورة التصديق فيقدر تقدم طلقة قبل طلاقه بالزمن الفرد. يصح معها الكلام فيلزمه. وعن الخامس أن الأمر متعلق بإيجاد خبر يقدر الشارع قبله الطلاق فيلزم به لا أنه متعلق بإنشاء الطلاق حتى يكون اللفظ سببًا كما ذكرتموه، بل هو علامة ودليل على الوقوع، وإنما ينتفي الطلاق عند انتفائه كانتفاء المدلول لانتفاء دليله وعلاماته. ولا يقال: لا يلزم من نفي الدليل نفي المدلول، فإن هذا لازم في الشرعيات لأنها إنما تثبت بأدلتها. فأدلتها أسباب ثبوتها. وأما السادس فهو أقواها وقد قيل إنه لا يمكن الجواب عنه إلا بالمكابرة فإنا نعلم بالضرورة أن من قال لأمرأته: أنت طالق. لا يحسن أن يقال له: صدقت ولا كذبت. فهذه نهاية أقدام الطائفتين في هذا المقام.
وفصل الخطاب في ذلك أن لهذه الصيغ نستبين نسبة إلى متعلقاتها الخارجية فهي من هذه الجهات إنشاءات محضة. كما قالت الحنابلة والشافعية ونسبة إلى قصد المتكلم وإرادته: وهي من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاءه كما قالت الحنفية: فهي إخبارات بالنظر إلى معانيها الذهنية إنشاءات بالنظر إلى متلقاتها الخارجية. وعلى هذا فإنما لم يحسن أن يقال بالتصديق والتكذيب وإن كانت أخبارًا، لأن متعلق التصديق والتكذيب النفي والإثبات. ومعناهما مطابقة الخبر لمخبره أو عدم مطابقته وهنا المخبر حصل بالخبر حصول المسبب بسببه فلا يتصور فيه تصديق ولا تكذيب، وإنما يتصور التصديق والتكذيب في خبر لم يحصل مخبره ولم يقع به. كقولك: قام زيد فتأمله.
فإن قيل: فما تقولون في قول المظاهر أنت علي كظهر أمي هل هو إنشاء أو إخبار، فإن قلتم إنشاء كان باطلًا من وجوه. أحدها: إن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب والله سبحانه قد كذبهم هنا في ثلاثة مواضع. أحدها في قوله: { ما هن أمهاتهم } [4] فنفى ما أثبتوه وهذا حقيقة التكذيب. ومن طلق امرأته لا يحسن أن يقال: ما هي مطلقة. الثاني قوله تعالى: { وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا } [5] والإنشاء لا يكون منكرًا، وإنما يكون المنكر هو الخبر، والثالث أنه سماه زورًا والزور هو الكذب. وإذا كذبهم الله دل على أن الظهار إخبار لا إنشاء، الثاني: أن الظهار محرم وليس جهة تحريمه إلا كونه كذبًا والدليل على تحريمه خمسة أشياء. أحدها: ما وصفه بالمنكر. والثاني: وصفه بالزور. والثالث: أنه شرع فيه الكفارة ولو كان مباحًا لم يكن فيه كفارة. والرابع: أن الله قال: { ذلكم توعظون به } [6] والوعظ إنما يكون في غير المباحات. والخامس قوله: { وإن الله لعفو غفور } [7] والعفو والمغفرة إنما يكونان عن الذنب.
وإن قلتم: هو إخبار فهو باطل من وجوه. أحدها: أن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فجعله الله في الإسلام تحريمًا تزيله الكفارة وهذا متفق عليه بين أهل العلم. ولو كان خبرًا لم يوجب التحريم فإنه إن كان صدقًا فظاهر. إن كان كذبًا فأبعد له من أن يترتب عليه التحريم. والثاني: أنه لفظ يوجب حكمه الشرعي بنفسه وهو التحريم، وهذا حقيقه الإنشاء بخلاف الخبر فإنه لا يوجب حكمه بنفسه، فسلب كونه إنشاء مع ثبوت حقيقة الإنشاء فيه جمع بين النقيضين. وثالثها: إن أفادة قوله أنت علي كظهر أمي للتحريم كإفادة قوله: أنت حرة. وأنت طالق. وبعتك ووهبتك وتزوجتك ونحوها لأحكامها. فكيف يقولون هذه إنشاءات دون الظهار وما الفرق؟ قيل: أما الفقهاء فيقولون الظهار إنشاء ونازعهم بعض المتأخرين في ذلك وقال: الصواب أنه إخبار. وأجاب عما احتجوا به من كونه إنشاء.
قال: أما قولهم كان طلاقًا في الجاهلية، فهذا لا يقتضي أنهم كانوا يثبتون به الطلاق، بل يقتضي أنهم كانوا يزيلون العصمة عند النطق به. فجاز أن يكون زوالها لكونه إنشاء كما زعمتم، أو لكونه كذبًا وجرت عادتهم أن من أخبر بهذا الكذب زالت عصمة نكاحه، وهذا كما التزموا تحريم الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد ونحو ذلك. قال: وأما قولكم إنه يوجب التحريم المؤقت وهذا حقيقة الإنشاء لا الإخبار فلا نسلم أن ثم تحريمًا البتة، والذي دل عليه القرآن وجوب تقديم الكفارة على الوطء كتقديم الطهارة على الصلاة، فإذا قال الشارع: لا تصل حتى تتطهر لا يدل ذلك على تحريم الصلاة عليه، بل ذلك نوع ترتيب سلمنا أن الظهار ترتب عليه تحريم، لكن التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له ودلالته عليه. وهذا هو الإنشاء، وقد يكون عقوبة محضة كترتيب حرمان الإرث على القتل، وليس القتل إنشاء للتحريم وكترتيب التعزير على الكذب وإسقاط العدالة به، فهذا ترتيب بالوضع الشرعي لا بد لآلة اللفظ. وحقيقة الإنشاء أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك الحكم ويدل عليه كصيغ العقود. فسببية القول أعم من كونه سببًا بالإنشاء أو بغيره. فكل إنشاء سبب وليس كل سبب إنشاء. فالسببية أعم فلا يستدل بمطلقها على الإنشاء، فإن الأعم لا يستلزم الأخص، فظهر الفرق بين ترتب التحريم على الطلاق وترتبه على الظهار. قال: وأما قولكم إنه كالتكلم بالطلاق والعتاق والبيع ونحوها، فقياس في الأسباب فلا نقبله، ولو سلمناه فنص القرآن يدفعه.
وهذه الاعتراضات عليهم باطلة.
أما قوله: إن كونه طلاقًا في الجاهلية لا يقتضي أنهم كانوا يثبتون به الطلاق إلى آخره. فكلام باطل قطعًا فإنهم لم يكونوا يقصدون الأخبار الكذب ليترتب عليه التحريم، بل كانوا إذا أرادوا الطلاق أتوا بلفظ الظهار إرادة للطلاق ولم يكونوا عند أنفسهم كاذبين ولا مخبرين، وإنما كانوا منشئين للطلاق به. ولهذا كان هذا ثابتًا في أول الإسلام حتى نسخه الله بالكفارة في قصة خولة بنت ثعلبة. كانت تحت عبادة بن الصامت، فقال لها: أنت علي ظهر أمي. فأتت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: «حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر الطلاق، وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي، فقال: «حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، فقال رسول الله ﷺ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أؤمر في شأنك بشيء»، فجعلت تراجع رسول الله ﷺ. وإذا قال لها: حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك وكان هذا أول ظهار في الإسلام. فنزل الوحي على رسول الله ﷺ فلما قضى الوحي قال: «ادعي زوجك» فتلا عليه رسول الله ﷺ: { قد سمع الله }. [8] الآيات فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحريم الحاصل بالطلاق في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بالكفارة، وبهذا يبطل ما نظر به من تحريم الناقة عند ولادها عشرة أبطن ونحوه، فإنه ليس هنا لفظ إنشاء يقتضي التحريم، بل هو شرع منهم لهذا التحريم عند هذا السبب.
وأما قوله إنا لا نسلم أنه يوجب تحريمًا فكلام باطل فإنه لا نزاع بين الفقهاء أن الظهار يقتضي تحريمًا تزيله الكفارة فلو وطئها قبل التكفير أثم بالإجماع المعروف من الدين والتحريم المؤقت هنا، كالتحريم بالإحرام وبالصيام والحيض. وأما تنظيره بالصلاة مع الطهر ففاسد فإن الله أوجب عليه صلاة بطهر، فإذا لم يأت بالطهر ترك ما أوجب الله عليه فاستحق الإثم، وأما المظاهر فإنه حرم على نفسه امرأته وشبهها بمن تحرم عليه، فمنعه الله من قربانها حتى يكفر. فهنا تحريم مستند إلى طهارة وفي الصلاة لا تجزئ منه بغير طهر، لأنها غير مشروعة أصلًا. وقوله التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له وقد يكون عقوبة إلى آخره جوابه أنهما غير متنافيين في الظهار فإنه حرام، وتحرم به تحريمًا مؤقتًا حتى يكفر. وهذا لا يمنع كون اللفظ إنشاء كجمع الثلاث عند من يوقعها، والطلاق في الحيض فإنه يحرم ويتعقبه التحريم، وقد قلتم: إن طلاق السكران يصح عقوبة له. مع أنه لو لم يأت بإنشاء السبب لم تطلق امرأته اتفاقًا فكون التحريم عقوبة لا ينفي أن يستند إلى أسبابها التي تكون إنشاءات لها. قوله السببية أعم من الإنشاء إلى آخره جوابه أن السبب نوعان: فعل وقول فمتى كان قولًا لم يكن إنشاء. فإن أردتم بالعموم أن سببية القول أعم من كونها إنشاء وإخبارًا فممنوع. وإن أردتم أن مطلق السببية أعم من كونها سببية بالفعل والقول فمسلم. ولا يفيدكم شيئًا.
وفصل الخطاب أن قوله: "أنت علي كظهر أمي" يتضمن إنشاء وإخبارًا، فهو إنشاء من حيث قصد التحريم بهذا اللفظ، وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه. ولهذا جعله الله منكرًا وزورًا. فهو منكر باعتبار الإنشاء، وزور باعتبار الإخبار.
وأما قوله: إن المنكر هو الخبر الكاذب، فالخبر الكاذب من المنكر. والمنكر أعم منه، فالإنكار في الإنشاء والإخبار فإنه ضد المعروف، فما لم يؤذن فيه من الإنشاء فهو منكر، وما لم يكن صدقًا من الإخبار فهو زور.
فائدة: المجاز والتأويل
المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له. وهنا نكتة ينبغي التفطن لها وهي أن كون اللفظ نصًا يعرف بشيئين. أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعًا، كالعشرة. والثاني ما أطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلًا ولا مجازًا. وإن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده وصار هذا بمنزلة خبر المتواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده، وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير من التأويلات السمعيات التي أطرد استعمالها في ظاهرها وتأويلها. والحالة هذه غلط، فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذًا مخالفًا لغيره، ومن السمعيات فيحتاج إلى تأويله لتوافقها. فإما إذا أطردت كلها على وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى، فتأويلها ممتنع. فتأمل هذا.
فائدة: إضافة الموصوف للصفة
أضافوا الموصوف إلى الصفة وإن اتحدا، لأن الصفة تضمنت معنى ليس في الموصوف فصحت الإضافة للمغايرة. وهنا نكتة لطيفة وهي أن العرب، إنما تفعل ذلك في الوصف المعرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب للأعلام، كما لو قالوا، زيد بطة أي صاحب هذا اللقب. وأما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه. فلا يضاف الموصوف إليه لعدم الفائدة المخصصة التي لأجلها أضيف الاسم إلى اللقب فإنه لما تخصص به كأنك قلت: صاحب هذا اللقب. وهكذا في مسجد الجامع وصلاة الأولى فإنه لما تخصص الجامع بالمسجد ولزمه كأنك قلت: صاحب هذا الوصف، فلو قلت: زيد الضاحك وعمرو القائم لم يجز. وكذا إن كان لازمًا غير معرفة. تقول: مسجد جامع وصلاة أولى.
فائدة: الاسم والمسمى
اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلًا له حقيقة متميزة متحصلة فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه، لأنه شيء موجود في اللسان مسموع بالآذان.
فاللفظ المؤلف من همزة الوصل والسين والميم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلًا. واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان، وهو المسمى والمعنى. واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياء والدال هو الاسم، وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم عبارة عنه. فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى. ولهذا تقول: سميت هذا الشخص بهذا الاسم، كما تقول: حليته بهذه الحلية. والحلية غير المحلى. فكذلك الاسم غير المسمى. وقد صرح بذلك سيبويه، وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهبه اتحادهما. والذي غر من ادعى ذلك قوله الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وهذا لا يعارض نصه قبل هذا. فإنه نص على أن الاسم غير المسمى. فقال الكلم: اسم وفعل وحرف، فقد صرح بأن الاسم كلمة. فكيف تكون الكلمة هي المسمى، والمسمى شخص.
ثم قال بعد هذا: تقول سميت زيد بهذا الاسم، كما تقول علمته بهذه العلامة. وفي كتابه قريب من ألف موضع أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى. ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير وإعراب وبناء، فذلك كله من عوارض الاسم لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلًا وما قال نحوي قط ولا عربي أن الاسم هو المسمى، ويقولون: أجل مسمى يقولون أجل اسم، ويقولون: مسمى هذا الاسم كذا. ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذا ويقولون هذا الرجل مسمى بزيد ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيد ويقولون بسم الله ولا يقولون بمسمى الله. وقال رسول الله ﷺ: «لي خمسة أسماء» ولا يصح أن يقال لي خمس مسميات و «تسموا باسمي»، ولا يصح أن يقال تسموا بمسمياتي ولله تسعة وتسعون اسمًا ولا يصح أن يقال تسعة وتسعون مسمى.
وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي ها هنا التسمية وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى. والتسمية عبارة عن فعل المسمى، ووضعه الاسم للمسمى. كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلى ووضعه الحلية على المحلى. فهنا ثلاث حقائق اسم ومسمى وتسمية، كحلية ومحلى وتحلية وعلامة ومعلم وتعليم ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقها، وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد.
فإن قيل: فحلوا لنا شبه من قال باتحادهما ليتم الدليل، فإنكم أقمتم الدليل فعليكم الجواب عن المعارض.
فمنها أن الله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق. فلو كانت أسماؤه غيره، لكانت مخلوقة وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا صفة لأن أسماءه صفات وهذا هو السؤال الأعظم الذى قاد متكلمي الإثبات إلى أن يقولوا: الاسم هو المسمى، فما عندكم في دفعه؟
الجواب أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وباطل. فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها، ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها فلم يزل بأسمائه وصفاته وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه، وإن كان لا يطلق على الصفة إنها إله يخلق ويرزق، فليست وصفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله.
وبلاء القوم من لفظة الغير فإنها يراد بها معنيين: أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقًا. ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها، فإذا قيل علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام. كان المعنى صحيحًا، ولكن الإطلاق باطل، وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلًا لفظًا ومعنى.
وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن وقالوا: كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه. فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال، ومن تلك الصفات صفة الكلام، كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة. وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى، فإذا كان القرآن غير مخلوق ولا يقال: إنه غير الله، فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهي غيره، فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم الاشكال. وإن أسماءه الحسنى التي في القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق ولا يقال: هو غيره ولا هو هو وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون: أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة ولمذهب من رد عليهم ممن يقول: اسمه نفس ذاته لا غيره، وبالتفصيل تزول الشهبه ويتبين الصواب والحمد لله.
حجة ثانية لهم، قالوا: قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك. وإذكر اسم ربك. سبح اسم ربك.
وهذه الحجة عليهم في الحقيقة، لأن النبي ﷺ امتثل هذا الأمر وقال: «سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم»، ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربي العظيم، ثم أن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول: عبدت اسم ربي ولا سجدت لاسم ربي ولا ركعت لاسم ربي ولا باسم ربي ارحمني. وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا بالاسم. وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم فقد قيل فيه: إن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد نعظم ما هو من سببه ومتعلق به كما يقال سلام على الحضرة العالية والباب السامي والمجلس الكريم ونحوه. وهذا جواب غير مرضي لوجهين:
أحدهما: أن رسول الله ﷺ لم يفهم هذا المعنى وإنما قال: «سبحان ربي»، فلم يعرج على ما ذكرتموه.
الثاني: أنه يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق على المسمى، فيقال: الحمد لاسم الله ولا إله إلا اسم الله ونحوه؛ وهذا مما لم يقله أحد.
بل الجواب الصحيح أن الذكر الحقيقي محله القلب لأنه ضد النسيان، والتسبيح نوع من الذكر فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان. والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعًا ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما واجتماعهما فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقليل ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك. فاقحم الاسم تنبيهًا على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر، والتسبيح من اللفظ باللسان لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه، والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله، لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى.
وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال: المعنى سبح ناطقًا باسم ربك متكلمًا به وكذا: سبح اسم ربك المعنى سبح ربك ذاكرًا اسمه. وهذه الفائدة تساوي رحلة، لكن لمن يعرف قدرها. فالحمد الله المنان بفضله ونسأله تمام نعمته.
حجة ثالثة لهم قالوا: قال تعالى: { ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها } [9] وإنما عبدوا مسمياتها.
والجواب أنه كما قلتم: إنما عبدوا المسميات، ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلة كاللات والعزى وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقة فإنهم سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لها، وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها. وهذا كمن سمى قشور البصل لحمًا وأكلها فيقال: ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه، وكمن سمى التراب خبزًا وأكله يقال: ما أكلت من إلا اسم الخبر. بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه، وما الحكمة ثم إلا مجرد الاسم. فتأمل هذه الفائدة الشريفة في كلامه تعالى.
فإن قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: { فسبح باسم ربك العظيم } [10] ولم تدخل في قوله: { سبح اسم ربك الأعلى }؟ [11]
قيل: التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى آخر، ويراد به ذلك مع الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل، ولهذا تسمى الصلاة تسبيحًا. فإذا أريد التسبيح المجرد فلا معنى للباء، لأنه لا يتعدى بحرف جر، لا تقول: سبحت بالله، وإذا أردت المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيهًا على ذلك المراد كأنك قلت: سبح مفتتحًا باسم ربك أو ناطقًا باسم ربك، كما تقول صل مفتتحًا أو ناطقًا باسمه. ولهذا السر والله أعلم دخلت اللام في قوله تعالى: { سبح لله ما في السماوات والأرض } [12] والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة ولم يقل في موضع سبح الله ما في السموات والأرض كما قال: { ولله يسجد من في السموات والأرض }، [13] وتأمل قوله تعالى: { إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون }، [14] فكيف قال: ويسبحونه لما ذكر السجود باسمه الخاص فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه.
شبهة رابعة: قالوا قد قال الشاعر:
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ** ومن يبك حولًا فقد اعتذر
وكذلك قول الأعشى: * داع يناديه باسم الماء مبغوم *
وهذه حجة عليهم لا لهم. أما قوله: ثم اسم السلام عليكما، فالسلام هو الله تعالى والسلام أيضا التحية، فإن أراد الأول فلا إشكال، فكأنه قال: ثم اسم السلام عليكما أي بركة اسمه وإن أراد التحية فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول وباسمه لفظه الدال عليه، والمعنى ثم اسم هذا المسمى عليكما، فيراد بالأول اللفظ، وبالثاني المعنى كما تقول زيد بطة ونحوه مما يراد بأحدهما اللفظ وبالآخر المدلول فيه. وفيه نكتة حسنة كأنه أراد ثم هذا اللفظ باق عليكما جار لا ينقطع مني بل أنا مراعيه دائمًا.
وقد أجاب السهيلي عن البيت بجواب آخر وهذا حكاية لفظه فقال: لبيد لم يرد إيقاع التسليم عليهم لحينه، وإنما أراد بعد الحول ولو قال: السلام عليكما كان مسلمًا لوقته الذي نطق فيه بالبيت، فكذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ أي إنما اللفظ بالتسليم بعد الحول وذلك أن السلام دعاء، فلا يتقيد بالزمان المستقبل، وإنما هو لحينه ألا نرى أنه لا يقال بعد الجمعة اللهم ارحم زيدًا ولا بعد الموت اللهم اغفر لي. إنما يقال: اللهم اغفر لي بعد الموت فيكون بعد ظرفًا للمغفرة والدعاء واقع لحينه، فإن أردت أن تجعل الوقت ظرفًا للدعاء صرحت بلفظ الفعل. فقلت بعد الجمعة: ادعو بكذا أو أسلم أو ألفظ بكذا، لأن الظروف إنما يريد بها الأحداث الواقعة فيها خبرًا أوامرًا أو نهيًا، وأما غيرها من المعاني كالطلاق واليمين والدعاء والتمني والاستفهام وغيرها من المعاني، فإنما هي واقعة لحين النطق بها، وكذلك يقع الطلاق ممن قال بعد يوم الجمعة: أنت طالق وهو مطلق لحينه. ولو قال بعد الحول: والله لأخرجن انعقدت اليمين في الحال ولا ينفعه أن يقول أردت أن لا أوقع اليمين إلا بعد الحول فإنه لو أراد ذلك لقال بعد الحول أحلف أو بعد الجمعة أطلقك. فأما الأمر والنهي والخبر فإنما تقيدت بالظروف، لأن الظروف في الحقيقة إنما يقع فيها الفعل المأمور به والمخبر به دون الأمر والخبر فإنهما واقعان لحين النطق بهما، فإذا قلت: اضرب زيدًا يوم الجمعة، فالضرب هو المقيد بيوم الجمعة، وأما الأمر فأنت في الحال آمر به، وكذلك إذا قلت: سافر زيد يوم الجمعة فالمتقيد باليوم المخبر به لا الخبر، كما أن قوله اضربه يوم الجمعة المقيد بالظرف المأمور به لا أمرك أنت فلا تعلق للظروف إلا بالأحداث، فقد رجع الباب كله بابًا واحدًا فلو أن لبيدًا قال: إلى الحول ثم السلام عليكما، لكان مسلمًا لحينه، ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول، وكذلك ذكر الاسم الذي هو بمعنى اللفظ بالتسليم ليكون ما بعد الحول ظرفًا له.
وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه رحمه الله.
وأما قوله باسم الماء، والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة، ولهذا عرفه تعريف الحقيقة الذهينة والبيت لذي الرمة وصدره: * لا ينعش الطرف إلا ما تحونه * ثم قال داع يناديه باسم الماء، فظن الغالط إنه أراد حكاية صوت الظبية وإنها دعت ولدها بهذا الصوت وهو ماما، وليس هذا مراده، وإنما الشاعر ألغز لما وقع الاشتراك بين لفظ الماء المشروب وصوتها به، فصار صوتها كأنه هو اللفظ المعبر عن الماء المشروب فكأنها تصوت باسم هذا الماء المشروب، وهذا لأن صوتها ماما وهذا في غاية الوضوح.
فائدة: اسم الله والاشتقاق
زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وإنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء؟ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله.
ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلًا وفرعًا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وقول سيبويه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء هو بهذا الاعتبار لا أن العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال، فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهما. فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي، وإنما هو اشتقاق تلازم سمى المتضمن بالكسر مشتقًا، والمتضمن بالفتح مشتقًا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى.
فائدة: هل الرحمن في البسملة نعت
استبعد قوم أن يكون الرحمن نعتًا لله، من قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الرحمن علم، والأعلام لا ينعت بها. ثم قالوا: هو بدل من اسم الله قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص بالله لا يشاركه فيه غيره، فليس هي كالصفات التي هي العليم والقدير والسميع والبصير، ولهذا تجري على غيره تعالى. قالوا: ويدل عليه أيضا وروده في القرآن غير تابع لما قبله كقوله: { الرحمن على العرش استوى }، [15] { الرحمن * علم القرآن }، [16] { أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن }، [17] وهذا شأن الأسماء المحضة، لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. قال السهيلي: والبدل عندي فيه ممتنع، وكذلك عطف البيان لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين، فإنه أعرف المعارف كلها وأبينها. ولهذا قالوا: وما الرحمن ولم يقولوا: وما الله ولكنه، وإن جرى مجرى الإعلام فهو وصف يراد به الثناء، وكذلك الرحيم إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه، وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية. فإن التثنية في الحقيقة تضعيف. وكذلك هذه الصفة فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكر فكان اللفظ مضارعًا للفظ التثنية لأن التثنية ضعفان في الحقيقة، ألا ترى أنهم أيضا قد شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت لشيئين متلازمين. فقالوا: الحكمان والعلمان وأعربوا النون كأنه اسم لشيء واحد. فقالوا: اشترك باب فعلان وباب التثنية. ومنه قول فاطمة: يا حسنان يا حسينان برفع النون لابنيها ولمضارعة التثنية امتنع جمعه فلا يقال غضابين، وامنع تأنيثه فلا يقال غضبانة، وامتنع تنوينه كما لا ينون نون المثنى فجرت عليه كثير من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظًا ومعنى. وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. تم كلامه.
قلت: أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميته وصفيته فمن حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم. ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعالى حسن مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية ولم يجيء قط تابعًا لغيره، بل متبوعًا. وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة.
فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر. وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا.
وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف، والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: { وكان بالمؤمنين رحيمًا }، [18] { إنه بهم رؤوف رحيم }. [19] ولم يجىء قط رحمن بهم فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجل لك صورتها.
فائدة: حذف العامل في بسم الله
لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة.
منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضًا للمقصود. فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدؤ به اسم الله كما نقول في الصلاة: الله أكبر، ومعناه من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر ليكون اللفظ مطابقًا لمقصود الجنان وهو أن لا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه.
ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه.
ومنها أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل فكأنه لا حاجة إلى النطق به لأن المشاهدة والحال دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى. والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق كما قيل:
ومن عجب قول العواذل من به ** وهل غير من أهوى يحب ويعشق
فائدة: عطف الصلاة على البسملة
اسثشكل طائفة قول المصنفين: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله"، وقالوا: الفعل بعد الواو دعاء بالصلاة والتسمية قبله خبر، والدعاء لا يحسن عطفه على الخبر. لو قلت: مررت بزيد وغفر الله لك لكان غثًا من الكلام والتسمية في معنى الخبر، لأن المعنى افعل كذا باسم الله.
وحجة من أثبتها الاقتداء بالسلف. والجواب عما قاله هوان الواو لم تعطف دعاء على خبر، وإنما عطفت الجملة على كلام محكي، كأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد أو أقول هذا وهذا، أو اكتب هذا وهذا.
فائدة: بطلان أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة
قولهم: الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الله تعالى غاير ينهما في قوله: { عليهم صلوات من ربهم ورحمة }. [20]
الثاني: أن سؤال الرحمة تشرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبي ﷺ وهي حق له ولآله. ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره، ولم يمنع أحد من الترحم على معين.
الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء وصلاته خاصة بخواص عباده.
وقولهم الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه:
أحدها: أن الدعاء يكون بالخير والشر والصلاة لا تكون إلا في الخير.
الثاني: أن "دعوت" تعدّى باللام وصليت لا تُعدّى إلا بعلى، ودعاء المعدى بعلى ليس بمعنى صلى، وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء.
الثالث: أن فعل الدعاء يقتضي مدعوًا أو مدعوًا له، تقول: دعوت الله لك بخير، وفعل الصلاة لا تقتضي ذلك، لا نقول: صليت الله عليك، ولا لك. فدل على أنه ليس بمعناه، فأي تباين أظهر من هذا، ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق فإياك والإخلاد إلى أرضه.
ورأيت لأبي القاسم السهيلي كلامًا حسنًا في اشتقاق الصلاة وهذا لفظه قال: معنى الصلاة اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف، إلا أن الحنو والعطف يكون محسوسًا ومعقولًا فيضاف إلى الله منه ما يليق بجلاله وينفي عنه ما يتقدس عنه، كما أن العلو محسوس ومعقول. فالمحسوس منه صفات الأجسام. والمعقول منه صفة ذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى كثير موجود في الصفات، والكثير يكون صفة للمحسوسات، وصفة للمعقولات وهو من أسماء الرب تعالى، وقد تقدس عن مشابهة الأجسام ومضاهاة الأنام. فالمضاف إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة، ثم إذا ثبت هذا فالصلاة كما تسمى عطفًا وحنوًا. تقول: اللهم اعطف علينا أي ارحمنا، قال الشاعر:
وما زلت في ليني له وتعطفي ** عليه كما تحنو على الولد الأم
ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانثنى عليه. ورحمة الله للعباد جود وفضل، فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم. وهذه الأفعال إذا كانت من الله أو من العبد فهي متعدية بعلى مخصوصة بالخير لا تخرج عنه إلى غيره، فقد رجعت كلها إلى معنى واحد إلا أنها في معنى الدعاء. والرحمة صلاة معقولة أي انحناء معقول غير محسوس ثمرته من العبد الدعاء لأنه لا يقدر على أكثر منه، وثمرته من الله الإحسان والإنعام فلم تختلف الصلاة في معناها، إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها. والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس فلم يختلف المعنى فيها إلا من جهة المعقول والمحسوس وليس ذلك باختلاف في الحقيقة، ولذلك تعدت كلها بعلى واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاة ولم يجز صليت على العدو أي دعوت عليه فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة وإن كان راجعًا إليه، إذ ليس كل راحم ينحني على المرحوم ولا ينعطف عليه.
فائدة: اشتقاق الفعل من المصدر
رأيت للسهيلي فصلًا حسنًا في اشتقاق الفعل من المصدر هذا لفظه. قال: فائدة اشتقاق الفعل من المصدر. إن المصدر اسم كسائر الأسماء يخبر عنه، كما يخبر عنها. كقولك: أعجبني خروج زيد، فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو الفاعل له مجرورًا بالإضافة، والمضاف إليه تابع للمضاف، فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدر لم يكن الإخبار عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره، وحق المخبر عنه أن يكون مرفوعًا مبدوءًا به فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفًا يدل على أنه مخبر عنه، كما تدل الحروف على معاني في الأسماء. وهذا لو فعلوه لكان الحرف حاجزًا بينه وبين الحدث في اللفظ. والحدث يستحيل انفصاله عن فاعله كما يستحيل انفصال الحركة عن محلها. فوجب أن يكون اللفظ غير منفصل، لأنه تابع للمعنى فلم يبق إلا أن يشتق من لفظ الحدث لفظ يكون كالحرف في النيابة عنه دالًا على معنى في غيره، ويكون متصلًا اتصال المضاف بالمضاف إليه وهو الفعل المشتق من لفظ الحدث، فإنه يدل على الحدث بالتضمن ويدل على الاسم مخبرًا عنه لا مضافًا إليه، إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى الاسم كاستحالة إضافة الحرف، لأن المضاف هو الشيء بعينه. والفعل ليس هو الشيء بعينه ولا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في الفاعل وهو كونه مخبرًا عنه فإن قلت: كيف لا يدل على معنى في نفسه وهو يدل على الحدث. قلنا: إنما يدل على الحدث بالتضمن. والدال عليه بالمطابقة هو الضرب والقتل لا ضرب وقتل، ومن ثم وجب أن لا يضاف ولا يعرف بشيء من آلات التعريف، إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه لا بلفظ يدل على معنى في غيره، ومن ثم وجب أن لا يثنى ولا يجمع كالحرف، ومن ثم وجب أن يبنى كالحرف، ومن ثم وجب أن يكون عاملًا في الاسم كالحرف كما أن الحرف لما دل على معنى في غيره وجب أن يكون له أثر في لفظ ذلك الغير. كما له أثر في معناه، وإنما أعرب المستقبل ذو الزوائد لأنه تضمن معنى الاسم إذ الهمزة تدل على المتكلم والتاء على المخاطب والياء على الغالب. فلما تضمن بها معنى الاسم ضارعه فاعرب. كما أن الاسم إذا تضمن معنى الحرف بني. وأما الماضي والأمر فإنهما وإن تضمنا معنى الحدث وهو اسم فما شار كافيه الحرف من الدلالة على معنى في غيره وهي حقيقة الحرف أوجب بناءهما حتى إذا ضارع الفعل الاسم من وجه آخر غير التضمن للحدث خرج عن مضارعة الحرف وكان أقرب شبهًا بالأسماء كما تقدم. ولما قدمناه من دلالة الفعل على معنى في الاسم وهو كون الاسم مخبرًا عنه وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم مضمرًا أو مظهرًا بخلاف الحدث، فإنك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرًا ولا مظهرًا نحو قوله تعالى: { أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة }، [21] وقوله: { وأقام الصلاة }، [22] والفعل لا بد من ذكر الفاعل بعده كما لا بد بعد الحرف من الاسم. فإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدر وهو كونه دالًا على معنى في الاسم، فلا يحتاج من الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة واحدة. وتلك الصيغة هي لفظ الماضى لأنه أخف وأشبه بلفظ الحدث إلا أن تقوم الدلالة على اختلاف أحوال المحدث فتختلف صيغة الفعل. ألا ترى كيف تختلف صيغته بعد ما الظرفية من قولهم: لا أفعله ما لاح برق وما طار طائر لأنهم يريدون الحدث مخبرًا. عنه على الإطلاق من غير تعرض لزمن ولا حال من أحوال الحدث، فاقتصروا على صيغة واحدة وهي أخف أبنية الفعل. وكذلك فعلوا بعد التسوية نحو قوله: { سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم }، [23] وقوله: { أدعوتموهم أم أنتم صامتون }، [24] لأنه أراد التسوية بين الدعاء والصمت على الإطلاق من غير تقييد بوقت ولا حال، فلذلك لم يحتج إلا إلى صيغة واحدة وهي صيغة الماضي كما سبق.
فالحدث إذًا على ثلاثة أضرب. ضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله وإلى اختلاف أحوال الحدث، فيشتق منه الفعل دلالة على كون الفاعل مخبرًا عنه، وتختلف أبنية دلالته على اختلاف أحوال الحدث. وضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله على الإطلاق من غير تقييد بوقت ولا حال فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنية نحو ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية وبعد ما الظرفية. وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله بل يحتاج إلى ذكره خاصة على الإطلاق مضافًا إلى ما بعده نحو سبحان الله. وسبحان اسم ينبىء عن العظمة والتنزيه فوقع القصد إلى ذكره مجردًا من التقييدات بالزمان أو بالأحوال ولذلك وجب نصبه. كما يجب نصب كل مقصود إليه بالذكر نحو إياك وويله وويحه وهما مصدران لم يشتق منهما فعل حيث لم يحتج إلى الإخبار عن فاعلهما ولا احتيج إلى تخصيصهما بزمن، فحكمها حكم سبحان ونصبهما كنصبه، لأنه مقصود إليه ومما انتصب لأنه مقصود إليه بالذكر زيدًا ضربته في قول شيخنا أبي الحسن وغيره من النحويين، وكذلك زيدًا ضربت بلا ضمير لا نجعله مفعولًا مقدمًا لأن المعمول لا يتقدم على عامله وهو مذهب قوي، ولكن لا يبعد عندي قول النحويين أنه مفعول مقدم وإن كان المعمول لا يتقدم على العامل والفعل كالحرف، لأنه عامل في الاسم ودال على معنى فيه فلا ينبغي للاسم أن يتقدم على الفعل كما لا يتقدم على الحرف، ولكن الفعل في قولك زيدًا ضربت قد أخذ معموله وهو الفاعل فمعتمده عليه ومن أجله صيغ. وأما المفعول فلم يبالوا به إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل، ألا ترى أنه يحذف والفاعل لا يحذف فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد من حذفه. وأما زيدًا ضربته فينتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ.
و هذا الفصل من أعجب كلامه. ولم أعرف أحدًا من النحويين سبقه إليه.
فائدة: المصدر عند الكوفيين
قولهم للضرب ونحوه مصدر؛ إن أريد بحروف مصدر مصدر صدر يصدر مصدرًا فهو يقوي قول الكوفيين إن المصدر صادر عن الفعل مشتق منه والفعل أصله، وأصله على هذا صادر، ولكن توسعوا فيه كصوم وزوز وعلل في صائم وبابه.
قال السهيلي: هو على جهة المكان استعارة كأنه الموضع الذي صدرت عنه الأفعال والأصل الذي نشأت منه.
قلت: وكأنه يعني مصدورًا عنه لا صادر عن غيره.
قال: ولا بد من المجاز على القولين: فالكوفي يحتاج أن يقول الأصل صادر، فإذا قيل: مصدر قدر فيه حذف أي ذو مصدر، كما يقدر في صوم وبابه. ونحن نسميه مصدر استعارة من المصدر الذي هو المكان.
فائدة: عمل الحروف
أصل الحروف أن تكون عاملة، لأنها ليس لها معان في أنفسها، وإنما معانيها في غيرها، وأما الذي معناه في غيره وهو الاسم، فأصله أن لا يعمل في غيره، وإنما وجب أن يعمل الحرف في كل ما دل على معنى فيه، لأن اقتضاءه معنى فتقتضيه عملًا لأن الألفاظ تابعة للمعاني، فكما تشبث الحرف عما دخل عليه معنى وجب أن يتشبث به لفظًا، وذلك هو العمل.
فأصل الحرف أن يكون عاملًا فنسأل عن غير العامل، فنذكر الحروف التي لم تعمل وسبب سلبها العمل.
فمنها هل، فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض وسبق إليها عمل الابتداء أو الفاعلية فدخلت لمعنى في الجملة، لا لمعنى في اسم مفرد، فاكتفي بالعمل السابق قبل هذا الحرف وهو الابتداء ونحوه.
وكذلك الهمزة نحو أعمرو خارج فإن الحرف دخل لمعنى في الجملة ولا يمكن الوقوف عليه ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه، لأنه حرف مفرد لا يوقف عليه ولو توهم ذلك فيه لعمل في الجمله ليؤكدوا بظهور أثره فيها تعلقه بها ودخوله عليها واقتضاؤه لها، كما فعلوا في إن وأخواتها حيث كانت كلمات من ثلاثة أحرف فصاعدًا يجوز الوقف عليها كأنه وليته ولعله فأعملوها في الجملة إظهارًا لارتباطها وشدة تعلقها بالحديث الواقع بعدها، وربما أرادوا توكيد تعلق الحرف بالجملة إذ كان مؤلفًا من حرفين. نحو هل فربما توهم الوقف عليه أو خيف ذهول السامع عنه، فأدخل في الجملة حرف زائد ينبه السامع عليه وقام ذلك الحرف مقام العمل نحو هل زيد بذاهب وما زيد بقائم. فإذا سمع المخاطب الباء وهي لا تدخل في الثبوت تأكد عنده ذكر النفي والاستفهام وأن الجملة غير منفصلة عنده، ولذلك أعمل أهل الحجاز ما النافية لشبهها بالجملة. ومن العرب من اكتفى في ذلك التعلق وتأكيده بإدخال الباء في الخبر ورآها ثابتة في التأثير عن العمل الذي هو النصب. وإنما اختلفوا في ما ولم يختلفوا في هل لمشاركة ما لليس في النفي. فحين أرادوا أن يكون لها أثر في الجملة يؤكد تشبهها بها جعلوا ذلك الأثر كأثر ليس وهو النصب والعمل في باب ليس أقوى، لأنها كلمة كليت ولعل وكأن. والوهم إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى توهم انفصال الجملة عن ما وهل فلم يكن بد من إعمال ليس وإبطال معنى الابتداء السابق، ولذلك إذا قلت: ما زيد إلا قائم لم يعملها أحد منهم، لأنه لا يتوهم انقطاع زيد عن ما، لأن إلا لا تكون إيجابًا إلا بعد نفي فلم يتوهم انفصال الجملة عن ما. ولذلك لم يعملوها عند تقديم الخبر نحو ما قائم زيد إذ ليس من رتبة النكرة أن يكون مبدوءًا بها مخبرًا عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلها، فلم يتوهم المخاطب انقطاع الجملة عما قبلها، لهذا السبب فلم يحتج إلى إعمالها وإظهارها كما كان قبل دخولها مستغنيًا عن تأثيرها فيه.
وأما حرف لا فإن كان عاطفًا فحكمه حكم حروف العطف ولاشيء فها عامل. وإن لم تكن عاطفة نحو لا زيد قائم ولا عمرو، فلا حاجة إلى إعمالها في الجملة، لأنه لا يتوهم انفصال الجملة بقوله: ولا عمرو، لأن الواو مع لا الثانية تشعر بالأولى لا محالة وتربط الكلام بها فلم يحتج إلى إعمالها وبقيت الجملة عاملًا فيها الابتداء كما كانت قبل دخول لا. فإن قلت: فلو لم يعطف وقلت: لا زيد قائم، قلت: هذا لا يجوز لأن لا ينفي بها في أكثر الكلام ما قبلها تقول هل قام زيد؟ فيقال: لا، وقال سبحانه: { لا أقسم بيوم القيامة } [25] وليست نفيًا لما بعدها هنا بخلاف ما لو قيل: ما أقسم فإن ما لا تكون أبدًا إلا نفيًا لما بعدها، فلذلك قالوا: ما زيد قائم، ولم يخشوا توهم انقطاع الجملة عنها. ولو قالوا: لا زيد قائم لخيف أن يتوهم أن الجملة موجبة وأن لا كهي في النكرات نحو: { لا لغو فيها ولا تأثيم }، [26] إلا أنهم في النكرات قد أدخلوها على المبتدأ والخبر تشبيهًا لها بليس، لأن النكرة أبعد في الابتداء من المعرفة، والمعرفة أشد استبدادًا بأول الكلام.
وأما التي للتنزيه فللنحويين فيها اختلاف أهي عاملة أم لا. فإن كانت عاملة فكما اعملوا أن حرصًا على اظهار تشبثها بالحديث. وإن كانت غير عاملة كما ذهب إليه سيبويه والاسم بعدها مركب معها مبني على الفتح فليس الكلام فيه.
وأما حرف النداء فعامل في المنادى عند بعضهم قال: والذي يظهر لي الآن أن النداء تصويت بالمنادى نحوها. وأن المنادى منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره، كما تقدم من قولنا في كل مقصود إلى ذكره مجردًا عن الإخبار عنه أنه منصوب، ويدلك على أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمل في الاسم دونه نحو صاحب زيد أقبل ويوسف أعرض عن هذا، وإن كان مبنيًا عندهم فإنه بناء كالعمل. ألا تراه ينعت على اللفظ كما ينعت المعرب ولو كان حرف النداء عاملًا لما جاز حذفه وإبقاء عمله.
فإن قلت: فلم عملت النواصب والجوازم في المضارع والفعل بعدها جملة قد عمل بعضه في بعض. ثم إن المضارع قبل دخول العامل عليه كان مرفوعًا، ورفعه بعامل وهو وقوعه موقع الاسم. فهلا منع هذا العامل هذه الحروف من العمل كما منع الابتداء الحروفَ الداخلة على الجملة من العمل، إلا أن يُخشى انقطاع الجملة كما خيف في إن وأخواتها.
فالجواب من وجهين:
أحدهما أن العامل في المبتدإ وإن كان معنويا كما أن الرافع للفعل المضارع معنوي، ولكنه أقوى منه، لأن حق كل مخبر عنه أن يكون مرفوعًا لفظًا وحسًا، كما أنه مرفوع معنى وعقلًا، ولذلك استحق الفاعل الرفع دون المفعول لأنه المحدث عنه بالفعل فهو أرفع رتبة في المعنى فوجب أن يكون اللفظ، كذلك لأنه تابع للمعنى. وأما رفع الفعل المضارع فلوقوعه موقع الاسم المخبر عنه والاسم التابع له، فلم يقو قوته في استحقاق الرفع. فلم يمنع شيئًا من الحروف اللفظية عن العمل، إذ اللفظي أقوى من المعنوي وامتنع ذلك في بعض الأسماء المبتدأة لضعف الحروف وقلة العامل السابق للمبتدإ.
الجواب الثاني أن هذه الحروف لم تدخل لمعنى في الجملة إنما دخلت لمعنى في الفعل المتضمن للحدث من نفي أو إنكار أو نهي أو جزاء أو غيره، وذلك كله يتعلق بالفعل خاصة لا بالجملة فوجب عملها فيها كما وجب عمل حروف الجر في الأسماء من حيث دلت على معنى فيها ولم تكن داخلة على جملة، وقد سبق إليها عامل معنوي ولا لفظي.
ومما ينبغي أن يعلم أن النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم لحصوله في موضع الأسماء، فلا سبيل لنواصب الأفعال وجوازمها أن تدخل على الأسماء ولا ما هو واقع موقعها فهي إذا دخلت على الفعل خلصته للاستقبال ونفت عنه معنى الحال. وهذا معنى يختص بالفعل لا بالجملة.
وأما إلا في الاستثناء فقد زعم بعضهم أنها عاملة ونقض ذلك بقولهم: ما قام أحد إلا زيد وما جاءني إلا عمرو. والصحيح أنها موصلة الفعل إلى العمل في الاسم بعدها كتوصيل واو المفعول معه الفعل إلى العمل فيما بعدها، وليس هذا يكسر الأصل الذي قدمناه، وهو استحقاق جميع الحروف العمل فيما دخلت عليه من الأسماء المفردة والأفعال، لأنها إذا كانت موصلة للفعل. والفعل عامل فكأنها هي العاملة، فإذا قلت: ما قام إلا زيد، فقد اعملت الفعل على معنى الإيجاب. كما لو قلت قام زيد لا عمرو. وقامت لا مقام نفي الفعل عن عمرو، فلذلك قامت إلا مقام إيجاب الفعل لزيد. إذا قلت: ما جاءني إلا زيد، فكأنها هي العاملة فاستغنوا عن أعمالها عملًا آخر.
وكذلك حروف العطف وإن لم تكن عوامل، فإنما جاءت الواو الجامعة منها لتجمع بين الاسمين في الإخبار عنهما بالفعل فقد أوصلت الفعل إلى العمل في الثاني وسائر حروف العطف يتقدر بعدها العامل، فيكون في حكم الحروف الداخلة على الجمل. وإذا قلت: قام زيد وعمرو. فكأنك قلت: قام زيد وقام عمرو فصارت هذه الحروف كالداخلة على الجمل. فقد تقدم في الحروف الداخلة على الجمل أنها لا تستحق من العمل فيها ما تستحق الحروف الداخلة على الأسماء المفردة والأفعال.
ونقيس على ما تقدم لام التوكيد وتركهم أعمالها في الجملة مع أنها لا تدخل لمعنى في الجملة فقط، بل لتربط ما قبلها من القسم بما بعدها. وهذا هو الأصل فيها حتى أنهم ليذكرونها دون القسم فيشعر عند المخاطب بالنهي كقوله:
إني لأمنحك الصدود وإنني ** قسمًا إليك مع الصدود لأميل
لأنه حين قال: لأمنحك علم أنه قد أقسم، فلذلك قال: قسمًا وهذا الأصل محيط بجميع أصول أعمال الحروف وغيرها من العوامل وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في الأسماء، ومنبهة على سر امتناع الأسماء أن تكون عاملة في غيرها، هذا لفظ السهيلي والله أعلم.
فائدة: اختصاص الإعراب بالأواخر
اختص الإعراب بالأواخر، لأنه دليل على المعاني اللاحقة للمعرب، وتلك المعاني لا تلحقه إلا بعد تحصيله وحصول العلم بحقيقته، فوجب أن يترتب الإعراب بعده كما ترتب مدلوله الذي هو الوصف في المعرب.
فائدة: وصف الحرف بالحركة
قولهم حرف متحرك وتحركت الواو ونحو ذلك تساهل منهم، فإن الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حيز إلى حيز، والحرف جزء من المصوت ومحال أن تقوم الحركة بالحرف، لأنه عرض والحركة لا تقوم بالعرض، وإنما المتحرك في الحقيقة هو العضو من الشفتين أو اللسان أو الحنك الذي يخرج منه الحرف.
فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضم عند النطق فيحدث مع ذلك صويت خفي مقارن للحرف إن امتد كان واوًا، وإن قصر كان ضمة، وكذلك الفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف وحدوث الصوت الخفي الذي يسمى فتحة أو نصبة وإن مدت كانت ألفًا وإن قصرت فهي فتحة، وكذلك القول في الكسرة، والسكون عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق بالحرف فلا يحدث بعد الحرف صوت فينجزم عند ذلك أي ينقطع، فلذلك سمي جزمًا اعتبارًا بانجزام المصوت وهو انقطاعه وسكونًا اعتبارًا بالعضو الساكن.
فقولهم: فتح وضم وكسر هو من صفة العضو. وإذا سميت ذلك رفعًا ونصبًا وجزمًا وجرًا في من صفة الصوت، لأنه يرتفع عند ضم الشفتين، وينتصب عند فتحهما، وينخفض عند كسرهما، وينجزم عند سكونهما، ولهذا عبروا عنه بالرفع والنصب والجر عن حركات الإعراب، إذ الإعراب لا يكون إلا بعامل وسبب. كما أن هذه الصفات التي تضاف إلى الصوت من رفع ونصب وخفض، إنما تكون بسبب وهو حركة العضو. واقتضت الحكمة اللفظية أن يعبر بما يكون عن سبب عما يكون عن سبب وهو الإعراب. وأن يعبر بالفتح والضم والكسر والسكون عن أحوال البناء، فإن البناء لا يكون بسبب، وأعني بالسبب العامل فاقتضت الحكمة أن يعبر عن تلك الأحوال بما يكون وجوده تغيرًا له إذ الحركات الموجودة في العضو لا تكون إلا بآلة كما تكون الصفات المضافة إلى الموصوف.
وعندي أن هذا ليس باستدراك على النحاة فإن الحرف وإن كان عرضًا فقد يوصف بالحركة تبعًا لحركة محله. فإن الأعراض وإن لم تتحرك بأنفسها فهي تتحرك بحركة محالها وعلى هذا، فقد اندفع الإشكال جملة.
وأما المناسبة إلى ذكرها في اختصاص الألقاب فحسنة. غير أن كثيرًا من النحاة يطلقون كلًا منها على الآخر. ولهذا يقولون: في قام زيد مرفوع علامة رفعه ضمة آخره ولا يقولون رفعه آخره فدل على إطلاق كل منهما على الآخر.
فائدة: تقول نونت الكلمة وسينتها وكوفتها وزويتها
تقول: نونت الكلمة ألحقت بها نونًا، وسينتها ألحقت بها سينًا، وكوفتها ألحقت بها كافًا. فإن ألحقت بها زايًا. قلت: زويتها لأن ألف الزاي منقلبة عن واو لأن باب طويت أكثر من باب حوة وقوة. وقال بعضهم زييتها وليس بشيء.
فائدة: التنوين في الكلمة
التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلها فلا تدخل في الاسم إلا علامة على انفصاله عما بعده، ولهذا كثر في النكرات لفرط احتياجها إلى التخصيص بالإضافة، فإذا لم تضف احتاجت إلى التنوين تنبيهًا على أنها غير مضافة، ولا تكاد المعارف تحتاج إلى ذلك إلا فيما قل من الكلام لاستغنائها في الأكثر عن زيادة تخصيصها وما لا يتصور فيه الإضافة بحال، كالمضمر والمبهم لا ينون بحال، وكذلك المعرف باللام وهذه علة عدم التنوين وقفًا إذ الموقوف عليه لا يضاف. واختصت النون الساكنة بالدلالة على هذا المعنى لأن الأصل في الدلالة على المعاني الطارئة على الأسماء أن تكون بحروف المد واللين وأبعاضها وهي الحركات الثلاث فمتى قدر عليها فهي الأصل. فإن تعذرت فأقرب شبهًا بها وآخر الأسماء المعربة قد لحقها حركات الإعراب فلم يبق لدخول حركة أخرى عليها سبيل ولا لحروف المد واللين، لأنها مشبعة من تلك الحركات ولأنها عرضة الإعلال والتغير. فأشبه شيء بها النون الساكنة لخفائها وسكونها وإنها من حروف الزيادة وإنها من علامات الإعراب، ولهذه العلة لا ينون الفعل لاتصاله بفاعله واحتياجه إلى ما بعده.
فائدة: الحكمة في علامة التصغير
جعلت علامة التصغير ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالثة.
وحكمة ذلك والله أعلم ما أشار إليه السهيلي فقال: التصغير تقليل أجزاء المصغر والجمع مقابله، وقد زيد في الجمع ألف ثالثة كفعالل فزيد في مقابلته ياء ثالثة ولم يكن آخرًا كعلامة التأنيث، لأن الزيادة في اللفظ على حسب الزيادة في المعنى. والصفة التي هي صغر الجسم لا تختص بجزء منه دون جزء بخلاف صفة التأنيث فإنها مختصة في جميع الحيوانات بطرف يقع به الفرق بين الذكر والأنثى. وكانت العلامة في اللفظ المنبئة عن معنى المناسبة طرفًا في اللفظ بخلاف الياء في التصغير، فإنها منبئة عن صفة واقعة على جملة المصغر. وكانت ياء لا ألفًا لأن الألف قد اختصت بجمع التذكير وكانت به أولى، كما كانت الفتحة التي هي أخفها بذلك أولى، لأن الفتح ينبىء عن الكثرة، ويشار به إلى السعة كما تجد الأخرس والأعجم بطبعه. إذا أخبر عن شيء كثير فتح شفتيه وباعد ما بين يديه، وإذا كان الفتح ينبىء عن السعة والضم الذي هو ضده ينبىء عن القلة والحقارة، كما تجد لم المقلل للشيء يشير إليه بضم يد أو فم. كما فعل رسول الله ﷺ حين ذكر ساعة الجمعة وأشار بيده يقللها فإنه جمع أصابعه وضمها ولم يفتحها.
وأما الواو فلا معنى لها في التصغير لوجهين. أحدهما: دخولها في ضرب من الجموع نحو المفعول فلم يكونوا يجعلونها علامة في التصغير فيلتبس التقليل بالتكثير. والثاني: أنه لا بد من كسر ما بعد علامة التصغير إذا لم يكن حرف إعراب كما كسر ما بعد علامة التكسير في مفاعل ليتقابل اللفظان، وإن تضادا كما قابلوا علم بجهل وروى بعطش، ووضع فهو وضيع بشرف فهو شريف. فلم يمكن إدخال الواو لئلا يخرجوا منها إلى كسرة واستبقيت الألف لأجل أصل الجمع لها بقيت الياء وفتح ما قبلها لأجل ضم أول الكلمة لئلا يخرج من ضم إلى كسر.
فائدة: تنوع الأفعال
الأفعال واجب وممكن ومنتف أو في حكمه. فالرفع للواجب والنصب للممكن، والجزم الذي هو عدم الحركة للمنفي، أو ما في حكمه هذا هو الأصل، وقد يخالف وإن شئت قلت: الأفعال ثلاثة أقسام: واقع موقع الاسم فله الرفع نحو هل تضرب واقع موقع ضارب. وفعل في تأويل الاسم فله النصب نحو أريد أن تقوم أي قيامك. وفعل لا واقع موقع اسم ولا في تأويله فله الجزم نحو لم يقم.
فائدة: إضافة ظروف الزمان للأحداث
إنما أضيفت ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها نحو، يوم يقوم زيد، لأنها أوقات لها وواقعة فيها فهي لاختصاصها بها أضيف إليها وهذا بخلاف ظروف المكان لأنها لا تختص بتلك الأحداث. فإن اختصت غالبًا حسنت الإضافة نحو هذا مكان يجلس القاضي ويكون بمنزلة يوم يجلس القاضي سواء، وربما أضيفت أسماء الزمان إلى أحداث لا تقع فيها لاتصالها بها كقوله تعالى: { ليلة الصيام }. [27] فالليلة من ظروف الزمان وقد أضيفت إلى الصيام، وليس بواقع فيها. فلما جاز في بعض الكلام أن يضاف الظرف إلى الاسم الذي هو الحدث وإن لم يكن واقعًا فيه أضافوه إلى الفعل لفظًا وهو مضاف إلى الحدث معنى. واقحم لفظ الفعل إقرارًا للمعنى وتخصيصًا للغرض ورفعًا لشوائب الاحتمال، حتى إذا سمع المخاطب قولك يوم قام زيد علم أنك تريد اليوم الذي قام فيه زيد، ولو قلت مكان قولك ليلة الصيام ليلة صيام زيد ما كان له معنى إلا وقوع الصيام في الليل، فهو الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل عند إرادتهم. إضافة الظروف إلى الأحداث وقس على ذلك المبتدأ والخبر. وأما ريث فبمنزلة الظرف وقد صارت في معناه، وكذلك حيث وذي تسلم أن المعنى في قول بعضهم اذهب لوقت ذي تسلم، أي سلامتك. فلما حذفت المنعوت وأقمت النعت مقامه أضفته إلى ما كنت تضيف إليه المنعوت وهو الوقت. قال السهيلي: وهو عندي على الحكاية حكوا قول الداعي تسلم كما تعيش وتبقي فقولهم، اذهب بذي تسلم. أي اذهب بهذا القول مني. ولم يقولوا اذهب بتسلم لئلا يكون اقتصارًا على دعوة واحدة، ولكن قالوا: بذي تسلم أي بقول يقال فيه تسلم يريدرن هذا المعنى وحذفوا القول المنعوت بذي اكتفاء بدلالة الحال عليه. وأما قوله * بآية ما يحبون الطعام * فالآية هي العلامة وهي ههنا بمعنى الوقت، لأن الوقت علامة للوقت والذي يجوز إضافته من ظروف الزمان إلى الفعل، ما كان منها مفردًا متمكنًا جاز إضافته إليها، وما كان مثنى كيومين ونحوه لم يضف إليها، لأن الحدث إنما يقع مضافًا لظرفه الذي هو وقت له فلا معنى لذكر وقت آخر. وأيضا فالجملة المضاف إليها نعت للظرف في المعنى. فقولك: يوم قام زيد، كقولك يوم قام زيد فيه في المعنى، والفعل لا يدخله التثنية فلا يصح أن يضاف إليه الاثنان، كما لا يصح أن ينعت الاثنان بالواحد.
وجه ثالث وهو أن قولك: قام زيد يوما قام عمر. ولم يصح إلا أن يكون جوابًا لمتى. واليومان جواب لكم وما هو جواب لكم لا يكون جوابًا لمتى أصلًا فإن أضفت اليومين إلى الفعل صرت مناقضًا لجمعك بين الكمية وبين ما لا يكون إلا لمتى. وأما الأيام فربما جاء إضافتها مجموعة إلى الفعل لأنها قد يراد بها معنى الفرد، كالشهر والأسبوع والحول وغيره، وكذلك غير المتمكن كقبل وبعد لا يضاف إلى الفعل، لأنك لو أضفتها إليه لاقتضت إضافتها إليه ما يقتضيه قولك يوم قام زيد أي اليوم الذي قام فيه، وذلك محال في قبل وبعد لأنه يؤول إلى إبطال معنى القبلية والبعدية. وأما سحر يوم بعينه فيمتنع من إضافته إلى الفعل لما فيه من معنى اللام فقس على هذا.
(فائدة: قياس الأسماء الخمسة أن تكون مقصورة)
وقال السهيلي قياس الأسماء الخمسة أن تكون مقصورة لأن أصلها أبو أخو والواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ألفًا تكون مقصورة كما هو إحدى لغاتها، ولكن هذه الأسماء حذفت أواخرها في حال الإفراد والإنفصال عن الإضافة. وقال لي بعض أشياخنا في بعلبك: إن التنوين لما أوجب حذف الألف المنقلبة لالتقاء الساكنين حذفوها رأسًا كما قيل:
رأى الأمر يفضي إلى آخر ** فصير آخره أولًا
فإذا أضيفت وزالت عند التنوين رجعت الحروف المحذوفة وكان الإعراب فيها مقدرًا كما هو مقدر في الأسماء المقصورة، وقال بهذا بعض النحاة. قال: والأمر فيها عندي أنها علامات إعراب، وليست حروف إعراب والمحذوف منها لا يعود إليها في الإضافة كما لا يعود المحذوف من يد ودم. وبرهان ذلك أنك تقول أخي وأبي إذا أضفت إلى نفسك كما تقول: يدي ودمي، لأن حركات الإعراب لا تجتمع مع ياء المتكلم كما تجتمع معها واو الجمع، فلو كانت الواو في أخوك حرف إعراب لقلت في الإضافة إلى نفسك هذا أخي كما تقول هؤلاء مسلمي فتدغم الواو في الياء لأنها حرف إعراب عند سيبويه. وهي عند غيره علامات إعراب، فإذا كانت واو الجمع تثبت مع ياء المتكلم وهي غير زائدة وهي عند غيره علامة إعراب. فكيف يحذف لام الفعل وهو أحق بالثبات منها؟ فقد وضح لك أنها ليست الحروف المحذوفة هي الأصلية.
فإن قيل: فلم أعربت بالحروف ولم أعلت بالحذف دون القلب خلافًا لنظائرها، مما علته كعلتها. وهي الأسماء المقصورة. قلنا في ذلك جواب لطيف وهو: أن اللفظ جسد والمعنى روح فهو تبع له في صحته واعتلاله، والزيادة فيه والنقصان منه كما أن الجسد مع الروح، كذلك فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة أو حذف، فإنما يكون بحسب ما يكون في المعنى اللهم إلا أن يكثر استعمال كلمة فتحذف منها تخفيفًا على اللسان لكثرة دورها فيه، ولعلم المخاطب بمعناها كقولهم: إيش في أي شيء ولم أبل.
وهذه الأسماء الخمسة مضافة إلى المعنى، فإذا قطعت عن الإضافة وأفردت نقص المعنى فينقص اللفظ تبعًا له، مع أن أواخرها حروف علة فلا بد من تغييرها. إما بقلب وإما بحذف، وكان الحذف فيها أولى كما قدمنا وكان ينبغي على هذا أن يتم لفظها في حال الإضافة كما تم معناها. إلا أنهم كرهوا أن يخلوا الخاء من أخ والباء من أب من الإعراب الحاصل فيها، إذ ليس في الكلام ما يكون حرف إعراب في حال الإفراد دون الإضافة. فجمعوا بين الغرضين ولم يبطلوا أحد القياسين فمكنوا الحركات التي هي علامات الإعراب في الأفراد. فصارت حروف مد ولين في الإضافة، وقد تقدم أن الحركة بعض الحرف، فالضمة التي في قولك أخ هي بعينها علامة الرفع في أخوك إلا أن المصوت بها يمد ليتمموا اللفظ كما تمموا المعنى بالإضافة إلى ما بعد الاسم ولم يحتاجوا مع تطويل حركات الإعراب إلى إعادة ما حذف من الكلمة رأسًا، كما لا يعاد محذوف يد ودم.
وأما التثنية فإنهم صححوا اللفظ فيها بإعادة المحذوف تنبيهًا على الأصل وهو الانقلاب إلى ألف فقالوا: أخوان وأبوان. كما قالوا: عضوان ونضوان، لأن قياسه في الأصل كقياسه بخلاف يد ودم فإن أصلهما يدي ودمي فلم يكن بابها كباب عصى ورحا. فاستمر الحذف فيهما في التثنية والإفراد.
فإن قيل: فلم لا يعود في ابن في تثنية ولا إضافة. قيل: لأنهم عوضوا من المحذوف ألف الوصل في ابن واسم فلم يجمعوا بين العوض والمعوض بخلاف أخ وأب، ومنعهم أن يعوضوا من المحذوف في أخ وأب الهمزة التي في أولها فرارًا من اجتماع همزتين. وأما حم فأصله حمأ بالهمزة فلم يكونوا ليعوضوا من الهمزة همزة أخرى فجعلوه كأخ وأب.
فإن قيل: فلم قالوا في جمعه بنون دون ابنون. قيل: الجمع قد يلحقه التغيير بالكسر وغيره، بخلاف التثنية فإنها لا يتغير فيها لفظ الواحد بحال، مع أنهم رأوا أن جمع السلامة لا بد فيه من واو في الرفع، وياء مكسور ما قبلها في النصب والخفض فأثسبهت حاله حال ما لم يحذف منه شيء. وليست هذه العلة في التثنية، ولم يقولوا: أبنات، كما قالوا: ابنتان. فإنهم حملوا جمع المؤنث على جمع المذكر لئلا يختلف.
وأما أخت وبنت فتاء أخت مبدلة من واو كتاء تراث وتخمة، وإنما حملهم على ذلك ههنا، إنهم رأوا المذكر قد حذفت لامه في الإفراد. فقالوا: أخ وكان القياس أن يقولوا: في المؤنث أخت كسنة، ولو فعلوا ذلك، لكانت تلك التاء حرف إعراب في الإضافة والإفراد ولم يمكنهم أن يعيدوا المحذوف في الإضافة إلى اللفظ، فيخالف لفظه لفظ المذكر، ولا أمكنهم من تطويل الصوت بالحركات ما أمكنهم في التذكير، لأن ما قبل تاء التأنيث ليس بحرف إعراب، ولا أمكنهم نقصان اللفظ في الموطن الذي تم فيه المعنى، فجمعوا بين الأغراض بإبدالها تاء لتكون في حال الإفراد علمًا للتأنيث وفي حال الإضافة من تمام الاسم كالحرف الأصلي إذ هو موطن تتميم كما تقدم، وسكنوا ما قبلها لتكون بمنزلة الحرف الأصلي، وضموا أول الكلمة إشعارًا بالواو وكسروها في بنت إشعارًا بالياء، لأنها من بنيت.
وقالوا في تأنيث ابن: ابنة وبنت ولم يقولوا في تأنيث أخ إلا أخت. والعلة في ذلك مستقراة كما تقدم.
وأما قولهم فوك وفاك وفيك فحروف المد فيها حروف إعراب لانفرادها فلم يلزم فيها ما لزم في الخاء والباء ألا تراهم يقولون: هذا في وجعلته في في كما يقولون: مسلمي فيثبتونها مع ياء المتكلم. وهذا يدلك على أنها حرف إعراب بخلاف أخواتها، ألا تراهم في حال الإفراد كيف أبدلوا من الواو ميمًا لتتعاقب عليها حركات الإعراب ويدخلها التنوين. إذ لو لم يبدلوها ميمًا لأذهبها التنوين في الإفراد، وبقيت الكلمة على حرف واحد. فإذا أضيفت زالت العلة حيث أثبتوا التنوين فلم يحتاجوا إلى قلبها ميمًا.
فإن قلت: أين علامات الإعراب في حال الأصالة؟ قلت: مقدر فيها. وإن شئت قلت: تغير صيغها في الأحوال الثلاثة هو الإعراب والمتغير هو حرف الإعراب فإن قلت: فلم لم تثبت الألف في حال النصب إذا أضيفت إلى ضمير المتكلم. فتقول: فأي كعصاي. قلت: الفرق أن ألف عصا ثابتة في جميع الأحوال، وهذه لا تكون إلا في حال النصب وقد قلبت تلك ياء في لغة طي، فهذه أحرى بالقلب.
وأما ذو مال فكان الأظهر فيه أن يكون حرف العلة حرف إعراب، وأن لا يكون الاسم على حرفين كما هو في بعض الأسماء المبهمة، كذلك يدلك على ذلك قولهم في الجمع: ذوو مال وذوات مال إلا أنه قد جاء في القرآن ذواتا أفنان وذواتي أكل، وهذا ينبىء أن الاسم ثلاثي ولامه ياء انقلبت ألفا في تثنية المؤنث خاصة.
وقولهم في التثنية: ذواتي وفي الجمع ذوات، والجمع كان أحق بالرد في التثنية، لأن التثنية أقرب إلى لفظ واحد ولأنها أقرب إلى معناه، ألا تراهم يقولون: أخت وأختان وأخوات وابنة وابنتان، لا تقول في الجمع: ابنتات، [28] فلذلك كان القياس حين قالوا: ذوات فلم يردوا لام الكلمة. (ألا يردوا في التثنية).
والعلة فيه أن ألف ذو وإن كانت منقلبة عن واو فإن انقلابها ليس بلازم، وإنما هو عارض بدخول التأنيث ولولا التأنيث لكانت واوًا وفي حال الرفع غير منقلبة، وياء في حال الخفض، والتثنية أقرب إلى الواحد لفظًا ومعنى فلذلك حين ثبوتها جعلوها واوًا. كما هي في الواحد إذ كان مرفوعًا ومثنى ومجموعًا وكان حكم الواو أغلب عليها من حكم الياء والألف، ثم ردوا لام الفعل لأنهم لو لم يردوها لقالوا ذواتا مال في حال الرفع، فيلتبس بالفعل نحو رمتا وقضتا إذا أخبرت عن امرأتين وذواتا من الذوي فكان في رد اللام رفع لهذا اللبس.
وفرق بين ما يصح عينه في المذكر نحو ذات وذو وبين ما لا يصح عينه في مذكر ولا جمع نحو شاة فإنك تقول في تثنيته: شاتان كقياس ذات وليس في جمع ذات ما يوجب رد لامها كما في تثنيتها كما تقدم.
وأما سنتان وشفتان فلا يلزم فيهما من الالتباس بالفعل ما لزم في ذواتا لو قيل لأن نون الاثنين لا تحذف منهما حذفًا لازمًا لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام بخلاف ذواتا، فإن النون لا توجد فيها البتة للزومها الإضافة.
فوائد تتعلق بالحروف الروابط بين الجملتين وأحكام الشرط
وفيها مباحث وقواعد عزيزة نافعة تحررت بعد فكر طويل بحمد الله.
فائدة: الروابط بين جملتين
الروابط بين جملتين هي الأدوات التي تجعل بينهما تلازمًا لم يفهم قبل دخولها وهي أربعة أقسام:
أحدها: ما يوجب تلازمًا مطلقًا بين الجملتين. أما بين ثبوت وثبوت، أو بين نفي ونفي، أو بين نفي وثبوت. وعكسه في المستقبل خاصة وهو حرف الشرط البسيط كان فإنها تلازم بين هذه الصور كلها. تقول: إن اتقيت الله أفلحت وإن لم تتق الله لم تفلح. وإن أطعت الله لم تخب، وإن لم تطع الله خسرت. ولهذا كانت أم الباب واعم أدواته تصرفًا.
القسم الثاني: أداة تلازم بين هذه الأقسام الأربعة تكون في الماضي خاصة. وهي لما تقول: لما قام أكرمته. وكثير من النحاة يجعلها ظرف زمان. وتقول: إذا دخلت على الفعل الماضي فهي اسم، وإن دخلت على المستقبل فهي حرف. ونص سيبويه على خلاف ذلك وجعلها من أقسام الحروف التي تربط بين الجملتين ومثال الأقسام الأربعة. لما قام أكرمته ولما لم يقم لم أكرمه ولما لم يقم أكرمته، ولما قام لم أكرمه.
القسم الثالث: أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره، وهي لو نحو لو أسلم الكافر نجا من عذاب الله.
القسم الرابع: أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره وهي لولا نحو: لولا أن هدانا الله لضللنا.
وتفصيل هذا الباب برسم عشرة مسائل.
المسألة الأولى: المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا بالمستقبل، فإن كان ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى. كقولك: إن مت على الإسلام دخلت الجنة، ثم للنحاة فيه تقدير إن أحدهما: إن الفعل ذو تغير في اللفظ وكان الأصل إن تمت مسلمًا تدخل الجنة، فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلًا له منزلة المحقق. والثاني أنه ذو تغير في المعنى وإن حرف الشرط لما دخل عليه قلب معناه إلى الاستقبال. وبقي لفظه على حاله. والتقدير الأول أفقه في العربية لموافقته تصرف العرب في إقامتها الماضي مقام المستقبل وتنزيلها المنتظر منزلة الواقع المتيقن نحو: { أتى أمر الله }، [29] { ونفخ في الصور }، [30] ونظائره، فإذا تقرر ذلك في الفعل المجرد فليفهم مثله المقارن لأداة الشرط. وأيضا فإن تغيير الألفاظ أسهل عليهم من تغيير المعاني، لأنهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على المعنى. وأيضا فإنهم إذا أعربوا الشرط أتوا بأداته ثم اتبعوها فعله يتلوه الجزاء، فإذا أتوا بالأداة جاؤوا بعدها بالفعل وكان حقه أن يكون مستقبلًا لفظًا ومعنى، فعدلوا عن لفظ المستقبل إلى الماضي لما ذكرنا فعدلوا عن صيغة إلى صيغة. وعلى التقدير الثاني كأنهم وضعوا فعل الشرط والجزاء أولا ماضيين، ثم أدخلوا عليهما الأداة فانقلبا مستقبلين والترتيب والقصد يأبى ذلك فتأمله.
المسألة الثانية: قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: { إن كنت قلته فقد علمته }، [31] فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ، وهو ماضي المعنى قطعًا، لأن المسيح إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة. وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه. والتقدير إن أكن أقول: هذا فإنك تعلمه. وهذا تحريف للآية، لأن هذا الجواب إنما صدر منه بعد سؤال الله له عن ذلك، والله لم يسأله وهو بين أظهر قومه ولا اتخذوه وأمه إلهين إلا بعد رفعه بمئين من السنين فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارًا لقاعدة نحوية هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية. وقال ابن السراج في أصوله: يجب تأويلهما بفعلين مستقبلين تقديرهما إن ثبت في المستقبل. أني قلته في الماضي يثبت أنك علمته. وكل شيء تقرر في الماضي كان ثبوته في المستقبل فيحسن التعليق عليه.
وهذا الجواب أيضا ضعيف جدًا ولا ينبىء عنه اللفظ. وليت شعري ما يصنعون بقول النبي ﷺ: «إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه»، هل يقول عاقل إن الشرط هنا مستقبل. أما التأويل الأول فمنتف هنا قطعًا. وأما الثاني فلا يخفي وجه التعسف فيه، وإنه لم يقصد أنه يثبت في المستقبل إنك أذنبت في الماضي فتوبي ولا قصد هذا المعنى، وإنما المقصود المراد ما دل عليه الكلام إن كان صدر منك ذنب فيما مضى فاستقبليه بالتوبة. لم يرد إلا هذا الكلام.
وإذا ظهر فساد الجوابين فالصواب أن يقال جملة الشرط والجزاء تارة تكون تعليقًا محضًا غير متضمن جوابًا لسائل. هل كان كذا ولا؟ يتضمن لنفي قول من قال: قد كان كذا فهذا يقتضي الاستقبال، وتارة يكون مقصوده ومضمنه جواب سائل، هل وقع كذا؟ أو رد قوله قد وقع كذا، فإذا علق الجواب هنا على شرط لم يلزم أن يكون مستقبلًا لا لفظًا ولا معنى، بل لا يصح فيه الاستقبال بحال كمن يقول لرجل: هل أعتقت عبدك؟ فيقول: إن كنت قد أعتقته فقد أعتقه الله، فما للاستقبال هنا معنى قط، وكذلك إذا قلته: لمن قال صحبت فلانًا. فيقول: إن كنت صحبته فقد أصبت بصحبته خيرًا. وكذلك إذا قلت له: هل أذنبت؟ فيقول: إن كنت قد أذنبت فإني قد تبت إلى الله واستغفرته. وكذلك إذا قال: هل قلت لفلان كذا وهو يعلم أنه علم بقوله له؟ فيقول إن كنت قلته فقد علمته. فقد عرفت أن هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظًا ومعنى ليطابق السؤال الجواب ويصح التعليق الخبري لا الوعدي. فالتعليق الوعدي يستلزم الاستقبال. وأما التعليق الخبري فلا يستلزمه. ومن هذا الباب قوله تعالى: { إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين }، [32] وتقول: إن كانت البينة شهدت بكذا وكذا فقد صدقت، وهذه دقيقة خلت عنها كتب النحاة والفضلاء وهي كما ترى وضوحًا وبرهانًا ولله الحمد.
المسألة الثالثة: المشهور عند النحاة والأصوليين والفقهاء أن أداة إن لا يعلق عليها إلا محتمل الوجود والعدم. كقولك: إن تأتني أكرمك، ولا يعلق عليها محقق الوجود فلا نقول: إن طلعت الشمس أتيتك، بل تقول: إذا طلعت الشمس أتيتك وإذا يعلق عليها النوعان.
واستشكل هذا بعض الأصوليين فقال: وقد وردت إن في القران في معلوم الوقوع قطعًا كقوله: { وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا }، [33] وهو سبحانه يعلم أن الكفار في ريب منه. وقوله: { فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار }، [34] ومعلوم قطعًا انتفاء فعلهم.
وأجاب عن هذا بأن قال: إن الخصائص الإلهية لا تدخل في الأوضاع العربية، بل الأوضاع العربية مبنية على خصائص الخلق. والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب وعلى منوالهم فكل ما كان في عادة العرب حسنًا أنزل القرآن على ذلك الوجه أو قبحًا لم ينزل في القرآن. فكل ما كان شأنه أن يكون في العادة مشكوكًا فيه بين الناس حسن تعليقه بأن من قبل الله ومن قبل غيره سواء كان معلومًا للمتكلم أو للسامع أم لا. ولذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: إن كان زيد في الدار فأكرمه، مع علمه بأنه في الدار لأن حصول زيد في الدار شأنه أن يكون في العادة مشكوكًا فيه، فهذا هو الضابط لما تعلق على إن فاندفع الإشكال.
قلت: هذا السؤال لا يرد، فإن الذي قاله القوم: إن الواقع ولا بد لا يُعلق بأن. وأما ما يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع، فهو الذي يعلق بها وإن كان بعد وقوعه متعين الوقوع. وإذا عرفت هذا فتدبر قوله تعالى: { وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور }، [35] كيف أتى في تعليق الرحمة المحققة أصابتها من الله تعالى بإذا وأتى في إصابة السيئة بأن فإن ما يعفو الله عنه أكثر، وأتى في الرحمة بالفعل الماضي الدال على تحقيق الوقوع. وفي حصول السيئة بالمستقبل الدال على أنه غير محقق ولا بد، وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباشرة الرحمة لهم وإنها مذوقة لهم. والذوق هو أخص أنواع الملابسة وأشدها وكيف أتى في الرحمة بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه؟ فقال: { منا رحمة } وأتى في السيئة بباء السببية مضافة إلى كسب أيديهم. وكيف أكد الجملة الأولى التي تضمنت إذاقة الرحمة بحرف؟ إن دون الجملة الثانية وأسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر.
وتأمل قوله تعالى: { وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه }، [36] كيف أتى بإذا ههنا؟ لما كان مس الضر لهم في البحر محققًا بخلاف قوله: { لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط }، [37] فإنه لم يقيد مس الشر هنا بل أطلقه ولما قيده بالبحر الذي هو متحقق فيه ذلك أتى بأداة إذا.
وتأمل قوله تعالى: { وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا }، [38] كيف أتى هنا بإذا المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأس؟ فإن اليأس، إنما حصل عند تحقق مس الشر له. فكان الإتيان بإذا ههنا أدل على المعنى المقصود من إن بخلاف قوله: { وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض }، [39] فإنه بقلة صبره وضعف احتماله مني توقع الشر أعرض وأطال في الدعاء، فإذا تحقق وقوعه كان يؤوسًا. ومثل هذه الأسرار في القرآن لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله وفهم يؤتيه عبدًا في كتابه.
فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } [40] والهلاك محقق.
قلت: التعليق ليس على مطلق الهلاك، بل على هلاك مخصوص، وهو هلاك لا عن ولد.
فإن قلت: فما تصنع بقوله: { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون }، [41] وقوله: { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين }، [42] وتقول العرب: إن كنت ابني فأطعني. وفي الحديث في السلام على الموتى: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»، واللحاق محقق. وفي قول الموصي: إن مت فثلث مالي صدقة.
قلت: أما قوله: { إن كنتم إياه تعبدون }، الذي حسن مجيء إن ههنا الاحتجاج والإلزام. فإن المعنى إن عبادتكم لله تستلزم شكركم له، بل هي الشكر نفسه، فإن كنتم ملتزمين لعبادته داخلين في جملتها فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه وهذا كثيرًا ما يورد في الحجاج. كما تقول للرجل: إن كان الله ربك وخالقك فلا تعصه. وإن كان لقاء الله حقًا فتأهب له. وإن كانت الجنة حقًا فتزود إليها، وهذا أحسن من جواب من أجاب بأن إن هنا قامت مقام إذا وكذا قوله: { إن كنتم بآياته مؤمنين }، [43] وكذا قولهم: إن كنت ابني فأطعني ونظائر ذلك.
وأما قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فالتعليق هنا ليس لمطلق الموت، وإنما هو للحاقهم بالمؤمنين ومصيرهم إلى حيث صاروا.
وأما قول الموصي: إن مت فثلمث مالي صدقة فلأن الموت وإن كان محققًا، لكن لما لم يعرف تعين وقته وطال الأمد وانفردت مسافة أمنية الحياة نزل منزلة المشكوك كما هو الواقع الذي يدل عليه أحوال العباد فإن عاقلًا لا يتيقن الموت ويرضى بإقامته على حال لا يحب الموت عليها أبدًا. كما قال بعض السلف ما رأيت يقينًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، وعلى هذا حمل بعض أهل المعاني: { ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون } [44] فأكد الموت باللام وأتى فيه باسم الفاعل الدال على الثبوت وأتى في البعث بالفعل ولم يؤكده.
المسألة الرابعة: قد تعلق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود فيلزمه محال آخر وتصدق الشرطية دون مفرديها. أما صدقها فلاستلزام المحال المحال، وأما كذب مفرديها فلاستحالتهما وعليه: { قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين } [45] ومنه قوله: { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا }، [46] ومنه: { قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا }، [47] ونظائره كثيرة.
وفائدة الربط بالشرط في مثل هذا أمران. أحدهما: بيان استلزام إحدى القضيتين للأخرى. والثاني: أن اللازم منتف. فالملزوم كذلك فقد تبين من هذا. أن الشرط تعلق به المحقق الثبوت والممتنع الثبوت والممكن الثبوت.
المسألة الخامسة: اختلف سيبويه ويونس في الاستفهام الداخل على الشرط فقال سيبويه: يعتمد على الشرط وجوابه فيتقدم عليهما ويكون بمنزلة القسم نحو قوله: { أفإن مت فهم الخالدون }، [48] وقوله: { أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم }، [49] وقال يونس: يعتمد على الجزاء فتقول: إن مت أفأنت خالد والقرآن مع سيبويه. والقياس أيضا كما يتقدم القسم ليكون جملة الشرط والجزاء مقسمًا عليها ومستفهمًا عنها، ولو كان كما قال يونس لقال: { أفإن مت فهم الخالدون }
المسألة السادسة: اختلف الكوفيون والبصريون فيما إذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء، ثم ذكر فعل الشرط ولم يذكر له جزاء نحو أقوم إن قمت فقال ابن السراج: الذي عندي أن الجواب محذوف يغني عنه الفعل المتقدم قال: وإنما يستعمل هذا على وجهين. إما أن يضطر إليه شاعر. وإما أن يكون المتهكلم به محققًا بغير شرط ولا نية فقال: أجيئك ثم يبدو له أن لا يجيئه إلا بسبب فيقول: إن جئتني فيشبه الإستثناء ويغني عن الجواب ما تقدم وهذا قول البصريين وخالفهم أهل الكوفة وقالوا: المتقدم هو الجزاء، والكلام مرتبط به وقولهم في ذلك هو الصواب، وهو اختيار الجرجاني قال: الدليل على أنك إذا قلت؟ آتيك إن اتيتني كان الشرط متصلًا بآتيك وإن الذي يجري في كلامهم لا بد من إضمار الجزاء ليس على ظاهره. وأما إن عملنا على ظاهره وتوقفنا أن الشرط متقدم في النفس على الجزاء، صار من ذلك شيئان ابتداء كلام ثان، ثم اعتقاد ذلك يؤدي إلى ابطال ما اتفق عليه العقلاء في الإيمان من افتراق الحكم بين أن يصل الشرط في نطقه وبين أن يقف ثم يأتي بالشرط وإنه إذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فوصل لم يعتق ولو وقف. ثم قال: إن شاء الله فإنه يعتق. فإذا سمعت ما قلنا عرفت خلاف المسألة. فالمشهور من مذهب البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط هذا كلامه.
قلت: ولم يكن به حاجة في تقرير الدليل إلى الوقف بين الجملة الأولى وجملة الشرط، فالدلالة قائمة. ولو وصل فانه إذا قال: أنت حر فهذه جملة خبرية ترتب عليها حكمها عند تمامها.
وقوله: إن شاء الله ليس تعليقًا لها عندكم. فإن التعليق، إنما يعمل في الجزاء وهذه ليست بجزاء، وإنما هي خبر محض، والجزاء عندكم محذوف فلما قالوا: إنه لا يعتق، دل على أن المتقدم نفسه جزاء معلق هذا تقرير الدلالة ولكن، ليس هذا باتفاق فقد ذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أن الشرط، إنما يعمل في تعليق الحكم إذا تقدم على الطلاق فتقول: إن شاء الله فأنت طالق. فأما إن تقدم الطلاق ثم عقبه بالتعليق فقال، أنت طالق إن شاء الله طلقت ولا ينفع التعليق، وعلى هذا فلا يبقى فيما ذكر حجة، ولكن هذا المذهب شاذ والأكثرون على خلافه وهو الصواب لأنه إما جزاء لفظًا ومعنى قد اقتضاه التعليق على قول الكوفيين، وأما أن يكون جزاء في المعنى وهو نائب الجزاء المحذوف ودال عليه، فالحكم تعلق به على التقديرين والمتكلم إنما بنى كلامه عليه.
وأما قول ابن السراج إنه قصد الخبر جزمًا، ثم عقبه بالجزاء فليس كذلك، بل بنى كلامه على الشرط كما لو قال له: علي عشرة إلا درهمًا فإنه لم يقر بالعشرة ثم أنكر درهمًا، ولو كان كذلك لم ينفعه الاستثناء، ومن هنا قال بعض الفقهاء: إن الاستثناء لا ينفع في الطلاق، لأنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة فقد أوقع الثلاثة ثم رفع منها واحدة وهذا مذهب باطل. فإن الكلام مبني على آخره مرتبط أجزاوه بعضها ببعض، كارتباط التوابع من الصفات وغيرها بمتبوعاتها والاستثناء لا يستقل بنفسه فلا يقبل إلا بارتباطه بما قبله فجرى مجرى الصفة والعطف. ويلزم أصحاب هذا المذهب أن لا ينفع الاستثناء في الإقرار، لأن المقربة لا يرفع ثبوته وفي إجماعهم على صحته، دليل على إبطال هذا المذهب، وإنما احتاج الجرجاني إلى ذكر الفرق بين أن يقف أو يصل، لأنه إذا وقف عتق العبد ولم ينفعه الاستثناء، وإذا وصل لم يعتق فدل على أن الفرق بين وقوع العتق وعدمه هو السكوت. والوصل هو المؤثر في الحكم لا تقدم الجزاء وتأخره فانه لا تأثير له بحال كما ذكره ابن السراج أنه إنما يأتي في الضرورة، ليس كما قال فقد جاء في أفصح الكلام وهو كثير جدًا. كقوله تعالى: { واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون }، [50] وقوله: { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين }، [51] وقوله: { قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون }، [52] وهو كثير.
فالصواب المذهب الكوفي، والتقدير إنما يصار إليه عند الضرورة بحيث لا يتم الكلام إلا به، فإذا كان الكلام تامًا بدونه فأي حاجة بنا إلى التقدير، وأيضا فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم الخبر والمفعول والحال ونظائرها.
فإن قيل: الشرط له التصدير وصفًا فتقديم الجزاء عليه يخل بتصديره.
قلنا: هذه هي الشبهة التي منعت القائلين بعدم تقديمه وجوابها: أنكم إن عنيتم بالتصدير أنه لا يتقدم معموله عليه، والجزاء معمول له فيمتنع تقديمه فهو نفس المتنازع فيه. فلا يجوز إثبات الشيء بنفسه وإن عنيتم به أمرًا آخر لم يلزم منه امتناع التقديم، ثم نقول: الشرط والجزاء جملتان قد صارتا بأداة الشرط جملة واحدة وصارت الجملتان بالأداة كأنهما مفردان. فأشبها الفردين في باب الابتداء والخبر فكما لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ، فكذلك تقديم الجزاء، وأيضا فالجزاء هو المقصود والشرط قيد فيه وتابع له فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعًا. ولهذا كثيرًا ما يجيء الشرط متأخرًا عن المشروط، لأن المشروط هو المقصود وهو الغاية والشرط وسيلة فتقديم المشروط هو تقديم الغايات على وسائلها ورتبتها التقديم ذهنًا، وإن تقدمت الوسيلة وجودًا فكل منهما له التقدم بوجه وتقدم الغاية أقوى، فإذا وقعت في مرتبتها فأي حاجة إلى أن نقدرها متأخرة وإذا انكشف الصواب فالصواب أن تدور معه حيثما دار.
المسألة السابعة: لو يؤتى بها للربط لتعلق ماض بماض. كقولك: لو زرتني لأكرمتك. ولهذا لم تجزم إذا دخلت على مضارع لأن الوضع للماضي لفظًا ومعنى كقولك لو يزورني زيد لأكرمته. فهي في الشرط نظير إن في الربط بين الجملتين لا في العمل ولا في الاستقبال. وكان بعض فضلاء المتأخرين وهو تاج الدين الكندي ينكر أن تكون لو حرف شرط، وغلط الزمخشري في عدها في أدوات الشرط قال الأندلسي: في شرح المفصل فحكيت ذلك لشيخنا أبي البقاء. فقال: غلط تاج الدين في هذا التغليط، فإن لو تربط شيئًا بشيء كما تفعل إن قلت: ولعل النزاع لفظي فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي. فالصواب ما قاله أبو البقاء والزمخشري وإن أريد بالشرط ما يعمل في الجزأين فليست من أدوات الشرط.
المسألة الثامنة: المشهور أن لو إذا دخلت على ثبوتين نفتهما أو نفيين أثبتتهما أو نفي وثبوت أثبتت المنفي ونفت المثبت، وذلك لأنها تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، لم إذا امتنع النفي صار اثباتًا فجاءت الأقسام الأربعة وأورد على هذا أمور.
أحدها قوله تعالى: { ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله }، [53] ومقتضى ما ذكرتم. أن تكون كلمات الله تعالى قد نفدت وهو محال، لأن الأول ثبوت وهو كون أشجار الأرض أقلامًا، والبحار مدادًا لكلماته وهذا منتف. والثاني: وهو قوله ما نفدت كلمات الله فيلزم أن يكون ثبوتًا.
الثاني: قول عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فعلى ما ذكرتم يكون الخوف ثابتًا، لأنه منفي والمعصية كذلك، لأنها منفية أيضا. وقد اختلف أجوبة الناس عن ذلك.
فقال أبو الحسن بن عصفور: لو في الحديث بمعنى إن لمطلق الربط فلا يكون نفيها إثباتًا ولا إثباتها نفيًا. فاندفع الإشكال. وفي هذا الجواب ضعف بين فإنه لم يقصد في الحديث مطلق الربط كما قال، وإنما قصد ارتباط متضمن لنفي الجزاء ولو سيق الكلام إلا لهذا ففي الجواب إبطال خاصية لو التي فارقت بها سائر أدوات الشرط.
وقال غيره: لو في اللغة لمطلق الربط، وإنما اشتهرت في العرف في انقلاب ثبوتها نفيًا وبالعكس. والحديث إنما ورد بمعنى اللفظ في اللغة. حكى هذا الجواب القرافي عن الخسروشاهي، وهو أفسد من الذي قبله بكثير، فإن اقتضاء لو لنفي الثابت بعدها وإثبات المنفي متلقى من أصل وضعها لا من العرف الحادث، كما أن معاني سائر الحروف من نفي أو تأكيد أو تخصيص أو بيان أو ابتداء أو انتهار، إنما هو متلقى من الوضع لا من العرف فما قاله ظاهر البطلان.
الجواب الثالث: جواب الشيخ أبي محمد بن عبد السلام وغيره وهو أن الشيء الواحد قد يكون له سبب واحد فينتفي عند انتفائه وقد يكون له سببان فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه، لأن السبب الثاني يخلف السبب الأول كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجًا لورث أي بالتعصيب فإنهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر، وكذلك الناس ههنا في الغالب، إنما لم يعصوا لأجل الخوف فإذا ذهب الخوف عنهم عصوا لاتحاد السبب في حقهم فأخبر عمر أن صهيبًا اجتمع له سببان يمنعانه المعصية الخوف والإجلال فلو انتفى الخوف في حقه لانتفى العصيان للسبب الآخر وهو الإجلال. وهذا مدح عظيم له.
قلت وبهذا الجواب بعينه يجاب عن قوله ﷺ في ابنة حمزة: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة»، أي فيها سببان يقتضيان التحريم فلو قدر انتفاء أحدهما لم ينتف التحريم للسبب الثاني. وهذا جواب حسن جيد.
الجواب الرابع: ذكره بعضهم بأن قال: جواب لو محذوف وتقديره لو لم يخف الله لعصمه فلم يعصه بإجلاله ومحبته إياه، فإن الله يعصم عبده بالخوف تارة، والمحبة والإجلال تارة. وعصمة الإجلال والمحبة أعظم من عصمة الخوف، لأن الخوف يتعلق بعقابه، والمحبة والإجلال يتعلقان بذاته وما يستحقه تبارك وتعالى، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان دين الحب أثبت وأرسخ من دين الخوف وأمكن وأعظم تأثيرًا. وشاهد ما نراه من طاعة المحب لمحبوبه وطاعة الخائف لمن يخافه. كما قال بعض الصحابة: أنه ليستخرج حبه مني من الطاعة ما لا يستخرجه الخوف، وليس هذا موضع بسط هذا الشأن العظيم القدر، وقد بسطته في كتاب الفتوحات القدسية. [54]
الجواب الخامس: أن لو أصلها أن تستعمل للربط بين شيئين كما تقدم، ثم أنها قد تستعمل لقطع الربط فتكون جوابًا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط. كما لو قال القائل: إن لم يكن زيد زوجًا لم يرث، ققول أنت: لو لم يكن زوجًا لورث زيد. إن ما ذكره من الربط بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس بحق، فمقصودك قطع ربط كلامه لا ربطه. وتقول: لو لم يكن زيد عالمًا لأكرم أي لشجاعته جوابًا لسؤال سائل يتوهم أنه لو لم يكن عالمًا لما أكرم. فتربط بين عدم العلم والإكرام فتقطع أنت ذلك الربط، وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والإكرام، لأن ذلك ليس بمناسب ولا من أغراض العقلاء ولا يتجه كلامك إلا على عدم الربط.
كذلك الحديث، لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوفهم، وأن ذلك في الأوهام، قطع عمر هذا الربط وقال: لو لم يخف الله لم يعصه.
وكذلك لما كان الغالب على الأوهام أن الشجر كلها إذا صارت أقلامًا والبحار المذكورة كلها تكتب به الكلمات الإلهية، فلعل الوهم يقول: ما يكتب بهذا شيء إلا نفد كائنًا ما كان، فقطع الله تعالى هذا الربط ونفى هذا الوهم وقال: { ما نفدت.
قلت: ونظير هذا في الحدي. أن زوجته لما توهمت أن ابنة عمه حمزة تحل له لكونها بنت عمه، فقطع هذا الربط بقوله: إنها لا تحل وذكر للتحريم سببين الرضاعة وكونها ربيبة له، وهذا جواب القرافي، قال: وهو أصلح من الأجوبة المتقدمة من وجهين أحدهما: شموله للحديث والآية وبعض الأجوبة لا تنطبق على الآية، والثاني: أن ورود لو بمعنى إن خلاف الظاهر وما ذكره لا يتضمن خلاف الظاهر.
قلت: وهذا الجواب فيه ما فيه فإنه إن ادعى أن لو وضعت أو جيء بها لقطع الربط فغلط فإنها حرف من حروف الشرط التي مضمونها ربط السبب بمسببه والملزوم بلازمه. ولم يؤت بها لقطع هذا الارتباط ولا وضعت له أصلًا فلا يفسر الحرف بضد موضوعه. ونظير هذا قول من يقول: إن إلا قد تكون بمعنى الواو، وهذا فاسد، فإن الواو للتشريك والجمع وإلا للإخراج وقطع التشريك ونظائر ذلك. وإن أراد أن قطع الربط المتوهم مقصود للمتكلم من أدلة. فهذا حق، ولكن لم ينشأ هذا من حرف لو، وإنما جاء من خصوصية ما صحبها من الكلام المتضمن لنفي ما توهمه القائل أو ادعاه ولم يأت من قبل لو.
فهذا كلام هؤلاء الفضلاء في هذه المسألة، وإنما جاء الإشكال سؤالًا وجوابًا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته. وأنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون الله.
فاعلم أن لو حرف وضع للملازمة بين أمرين، يدل على أن الحرف الأول منهما ملزوم والثاني لازم، هذا وضع هذا الحرف وطبيعته، وموارده في هذه الملازمة فإنه إما أن يلازم بين نفيين أو ثبوتين أو بين ملزوم مثبت ولازم منفي أو عكسه. ونعني بالثبوت والنفي هنا الصوري اللفظي لا المعنوي.
فمثال الأول: { قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذًا لأمسكتم خشية الإنفاق }، [55] { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما }، [56] { ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد تثبيتًا }، [57] ونظائره.
ومثال الثاني لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي ولو لم يخف الله لم يعصه.
ومثال الثالث: { ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله }. [58]
ومثال الرابع: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهذه صورة وردوها على النفي والإثبات.
وأما حكم ذلك فأمران:
أحدهما: نفي الأول لنفي الثاني، لأن الأول ملزوم والثاني لازم، والملزوم عدم عند عدم لازمه.
والثاني تحقق الثاني لتحقق الأول، لأن تحقق الملزوم يستلزم تحقق لازمه.
فإذا عرفت هذا، فليس في طبيعة لو ولا وضعها ما يؤذن بنفي واحد من الجزأين ولا إثباته، وإنما طبعها وحقيقتها الدلالة على التلازم المذكور، لكن إنما يؤتى به للتلازم المتضمن نفي اللازم أو الملزوم أو تحققها. ومن هنا نشأت الشبهة فلم يؤت بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزأين أو نفيهما، فإذا دخلت على جزأين متلازمين قد انتفى اللازم منهما. استفيد نفي الملزوم من قضية اللزوم لا من نفس الحرف. وبيان ذلك أن قوله تعالى: { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا }، [59] لم يستفد نفي الفساد من حرف لو، بل الحرف دخل على أمرين قد علم انتفاء أحدهما حسًا فلازمت بينه وبين من يريد نفيه من تعدد الآلهة، وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، فإذا كان اللازم منتف قطعًا وحسًا انتفى ملزومه لانتفائه لا من حيث الحرف.
فهنا أمران؛ أحدهما: الملازمة التي فهمت من الحرف. والثاني انتفاء اللازم المعلوم بالحس. فعلى هذا الوجه ينبغي أن يفهم انتفاء اللازم والملزوم بلو. فمن هنا قالوا: إن دخلت على مثبتين صارا منتفيين بمعنى أن الثاني منهما قد علم انتفاؤه من خارج فينتفي الأول لانتفائه. وإذا دخلت على منفيين أثبتتهما لذلك، أيضا لأنها تدخل على ملزوم محقق الثبوت من خارج فيتحقق ثبوت ملزومه كما في قوله: لو لم تذنبوا فهذا الملزوم وهو صدور الذنب متحقق في الخارج من البشر فتحقق لازمه وهو بقاء النوع الإنساني وعدم الذهاب به، لأن الملازمة وقعت بين عدم الذنب وعدم البقاء، لكن عدم الذنب منتف قطعًا، فانتفى لازمه وهو عدم الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء، وكذلك نفيه الأقسام الأربعة يفهم على هذا الوجه.
وإذا عرف هذا؛ فاللازم الواحد قد يلزم ملزرمات متعددة، كالحيوانية اللازمة للإنسان والفرس وغيرهما، فيقصد المتكلم إثبات الملازمة بين بعض تلك الملزومات، واللازم على تقدير انتفاء البعض الآخر فيكون مقصوده أن الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك الملزوم الآخر، فلا يتوهم المتوهم انتفاء اللازم عند نفي ملزوم معين. فإن الملازمة حاصلة بدونه وعلى هذا يخرجه لو لم يخف الله لم يعصه. ولو لم تكن ربيبتي لما حلت لي فإن عدم المعصية له ملزومات فهي الخشية والمحبة والإجلال، فلو انتفى بعضها وهو الخوف مثلًا لم يبطل اللازم، لأن له ملزومات أخر غيره، وكذلك لو انتفى كون البنت ربيبة لما انتفى التحريم لحصوا الملازمة بينه وبين وصف آخر وهو الرضاع، وذلك الوصف ثابت وهذا القسم، إنما يأتي في لازم له ملزومات متعددة فيقصد المتكلم تحقق الملازمة على تقدير نفي ما نفاه منها.
وأما قوله تعالى: { ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام } [60] فإن الآية سيقت لبيان أن أشجار الأرض. لو كانت أقلامًا والبحار مدادًا فكتبت بها كلمات الله لنفدت البحار والأقلام، ولم تنفد كلمات الله. فالآية سيقت لبيان الملازمة بين عدم نفاد كلماته، وبين كون الأشجار أقلامًا والبحار مدادًا يكتب بها، فإذا كانت الملازمة ثابتة على هذا التقدير الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المكتوب، فثبوتها على غيره من التقادير أولى.
ونوضح هذا بضرب مثل يرتقى منه إلى فهم مقصود الآية. إذا قلت لرجل: لا يعطي أحدًا شيئًا لو أن لك الدنيا بأسرها ما أعطيت أحدًا منها شيئًا. فإنك إذا قصدت أن عدم إعطانه ثابت على أعظم التقادير التي تقتضي الإعطاء، فلازمت بين عدم إعطائه وبين أعظم أسباب الإعطاء، وهو كثرة ما يملكه. فدل هذا على أن عدم إعطائه ثابت على ما هو دون هذا التقدير، وإن عدم الإعطاء لازم لكل تقدير فافهم نظير هذا المعنى في الآية، وهو عدم نفاد كلمات الله تعالى على تقدير أن الأشجار أقلام والبحار مداد يكتب بها. فإذا لم تنفد على هذا التقدير كان عدم نفادها لازمًا له. فكيف بما دونه من التقديرات!
فافهم هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقت ولا تكاد تجدها في الكتب، وإنما هي من فتح الله وفضاله فله الحمد والمنة، ونسأله المزيد من فضله. فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية، وجاءت النصوص بمقتضاهما معًا من غير خروج عن موجب عقل ولا لغة ولا تحريف لنص، ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذه الفائدة لساوت رحلة. فكيف وقد تضمن من غرر الفوائد ما لا ينفق إلا على تُجاره. وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة، والزجاجة المستديرة المثقوبة جوهرة ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق بينهما والله المعين.
المسألة التاسعة: في دخول الشرط على الشرط. ونذكر فيه ضابطًا مزيلًا للأشكال إن شاء الله، فنقول: الشرط الثاني تارة يكون معطوفًا على الأول، وتارة لا يكون، والمعطوف تارة يكون معطوفًا على فعل الشرط وحده، وتارة يعطف على الفعل مع الأداة، فمثال غير المعطوف. إن قمت إن قعدت فأنت طالق. ومثال المعطوف على فعل الشرط وحده إن قمت وقعدت. ومثال المعطوف على الفعل مع الأداة إن قمت وإن قعدت. فهذه الأقسام الثلاثة أصول الباب وهي عشر صور:
أحدها: إن خرجت ولبست فلا يقع المشروط إلا بهما كيفما اجتمعا.
الثانية: إن لبست فخرجت لم يقع المشروط إلا بالخروج بعد اللبس فلو خرجت ثم لبست لم يحنث.
الثالثة: إن لبست ثم خرجت، فهذا مثل الأول وإن كان ثم للتراخي فإنه لا يعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده.
الرابعة: إن خرجت لا إن لبست فيحتمل هذا التعليق أمرين: أحدهما: جعل الخروج شرطًا ونفي اللبس أن يكون شرطًا. الثاني: أن يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن اللبس، والمعنى إن خرجت لا لابسة أي غير لابسة أي غير لابسة، ويكون المعنى إن كان منك خروج لا مع اللبس، فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحدة. وعلى الثاني لا يحنث إلا بخروج لا لبس معه.
الخامسة: إن خرجت، بل إن لبست ويحتمل هذا التعليق أمرين أحدهما: أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به لأجل الإضراب. والثاني: أن يكون كل منهما شرطًا فيحنث بأيهما وجد ويكون الإضراب عن الاقتصار، فيكون اضراب اقتصار لا اضراب إلغاء. كما تقول: أعطه درهمًا بل درهمًا آخر.
السادسة: إن خرجت أو إن لبست فالشرط أحدهما أيهما كان.
السابعة: إن لبست، لكن إن خرجت، فالشرط الثاني وقع لغا الأول لأجل الإستدراك بلكن.
الثامنة: أن يدخل الشرط على الشرط ويكون الثاني معطوفًا بالواو. نحو إن لبست وإن خرجت فهذا يحنث بأحدهما فإن قيل: فكيف لم تحنثوه في صورة العطف على الفعل وحده إلا بهما وحنثتموه ههنا بأيهما كان؟ قيل: لأن هناك جعل الشرط مجموعهما. وهنا جعل كل واحد منهما شرطًا برأسه. وجعل لهما جوابًا واحدًا وفيه رأيان. أحدهما: أن الجواب لهما جميعًا وهو الصحيح. والثاني: أن جواب أحدهما حذف لدلالة المذكور عليه وهي أخت مسألة الخبر عن المبتدإ بجزأين.
التاسعة: أن يعطف الشرط الثاني بالفاء نحو قوله تعالى: { فإما يأتينكم مني هدى }، [61] فالجواب المذكور جواب الشرط الثاني، وهو وجوابه جواب الأول. فإذا قال: إن خرجت فإن كلمت أحدًا فأنت طالق. لم تطلق حتى تخرج وتكلم أحدًا.
العاشرة: وهي أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط على الشرط بلا عطف. نحو إن خرجت، إن لبست واختلف أقوالهم فيها فمن قائل إن المؤخر في اللفظ مقدم في المعنى وإنه لا يحنث حتى يتقدم اللبس على الخروج ومن قائل بل المقدم لفظًا هو المقدم معنى. وذكر كل منهم حججًا لقوله.
وممن نص على المسألة الموفق الأندلسي في شرحه، فقال: إذا دخل الشرط على الشرط وعيد حرف الشرط توقف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول. كقولك: إن أكلت، إن شربت فأنت طالق، فلا تطلق حتى يوجد الشرب منها قبل الأكل، لأنه تعلق على أكل معلق على شرب. وهذا الذي ذكره أبو إسحق في المهذب وحكى ابن شاس في الجواهر عن أصحاب مالك عكسه والوجهان لأصحاب الشافعي.
ولا بد في المسألة من تفصيل وهو أن الشرط الثاني إن كان متأخرًا في الوجود عن الأول كان مقدرًا بالفاء. وتكون الفاء جواب الأول والجواب المذكور جواب الثاني مثاله: إن دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجر تقديره، فإن صليت فيه وحذفت الفاء لدلالة الكلام عليها. وإن كان الثاني متقدمًا في الوجود على الأول فهو في نية التقدم وما قبله جوابه والفاء مقدرة فيه ومثله قوله عز وجل: { ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم }، [62] أي فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. وتقول: إن دخلت المسجد إن توضأت فصل ركعتين. تقديره إن توضأت فإن دخلت المسجد فصل ركعتين. فالشرط الثاني هنا متقدم وإن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود على الآخر، بل كان محتملًا للتقدم والتأخر لم يحكم على أحدهما بتقدم ولا تأخر، بل يكون الحكم راجعًا إلى تقدير المتكلم ونيته فأيهما قدره شرطًا كان الآخر جوابًا له وكان مقدرًا بالفاء. تقدم في اللفظ أو تأخر وإن لم يظهر نيته ولا تقديره احتمل الأمرين فمما ظهر فيه تقديم المتأخر قول الشاعر:
إن تستغيثوا بنا أن تذعروا تجدوا ** منا معاقل عز زانها الكرم
لأن الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر، ومنه قول ابن دريد:
فإن عثرت بعدها إن وألت ** نفسي من هاتا فقولا لا لعا
ومعلوم أن العثور مرة ثانية إنما يكون بعد الذعر. ومن المحتمل قوله تعالى: { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين }، [63] يحتمل أن تكون الهبة شرطًا، ويكون فعل الإرادة جوابًا له ويكون التقدير إن وهبت نفسها للنبي. فإن أراد النبي أن يستنكحها فخالصة له ويحتمل أن تكون الإرادة شرطًا والهبة جوابًا له، والتقدير إن أراد النبي أن يستنكحها فإن وهبت نفسها فهي خالصة له يحتمل الأمرين. فهذا ما ظهر لي من التفصيل في هذه المسألة وتحقيقها. والله أعلم.
فائدة عظيمة المنفعة: تقديم بعض الألفاظ الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب
قال سيبويه: الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب تقول: صمت رمضان وشعبان وإن شئت شعبان ورمضان بخلاف الفاء، وثم إلا أنهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم، وهم ببيانه أعني وإن كانا جميعًا يهمانهم ويغنيانهم هذا لفظه.
قال السهيلي: وهو كلام مجمل يحتاج إلى بسط وتبيين فيقال: متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقدم ويكون المتكلم ببيانه أعنى.
قال: والجواب أن هذا الأصل يجب الاعتناء به لعظم منفعته في كتاب الله وحديث رسوله، إذ لا بد من الوقوف على الحكمة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر نحو السميع والبصير والظلمات والنور والليل والنهار والجن والإنس في الأكثر، وفي بعضها الإنس والجن وتقديم السماء على الأرض في الذكر، وتقديم الأرض عليها في بعض الآي ونحو سميع عليم ولم يجيء علهيم سميع، وكذلك عزيز حكيم وغفور رحيم. وفي موضع واحد الرحيم الغفور إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر، وليس شيء من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة، لأنه كلام الحكيم الخبير وسنقدم بين يدي الخوض في هذا الغرض أصلًا يقف بك على الطريق الأوضح.
فنقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدم المعاني في الجنان، والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان، وإما بالطبع، وإما بالرتبة، وإما بالسبب، وإما بالفضل والكمال، فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخفة والثقل بأحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرها. سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق وكان ترتب الألفاظ بحسب ذلك نعم، وربما كان ترتب الألفاظ بحسب الخفة والثقل، لا بحسب المعنى كقولهم: ربيعة ومضر وكان تقديم مضر أولى من جهة الفضل، ولكن آثروا الخفة لأنك لو قدمت مضر في اللفظ كثرت الحركات وتوالت، فلما أخرت وقف عليها بالسكون.
قلت: ومن هذا النحو الجن والإنس، فإن لفظ الإنس أخف لمكان النون الخفيفة والسين المهموسة. فكان الأثقل أولى بأول الكلام من الأخف لنشاط المتكلم وجمامه. وأما في القرآن فلحكمة أخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الأكثر والأغلب وسنشير إليها في آخر الفصل إن شاء الله.
أما ما تقدم بتقدم الزمان فكعاد وثمود والظلمات والنور، فإن الظلمة سابقة للنور في المحسوس والمعقول وتقدمها في المحسوس معلوم بالخبر المنقول، وتقدم الظلمة المعقولة معلوم بضرورة العقل قال سبحانه: { والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة }، [64] فالجهل ظلمة معقولة وهي متقدمة بالزمان على نور العلم ولذلك قال تعالى: { في ظلمات ثلاث }. [65] فهذه ثلاث محسوسات ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة. وثلاث معقولات وهي عدم الادراكات الثلاثة المذكورة في الآية المتقدمة إذ لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع، وفي الحديث: «إن الله خلق عباده في ظلمة، ئم ألقى عليهم من نوره». [66]
ومن المتقدم بالطبع نحو مثنى وثلاث ورباع ونحو: { ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم }، [67] الآية.
وما يتقدم من الأعداد بعضها على بعض إنما يتقدم بالطبع كتقدم الحيوان على الإنسان والجسم على الحيوان. ومن هذا الباب تقدم العزيز على الحكيم، لأنه عز فلما عز حكم. وربما كان هذا من تقدم السبب على المسبب ومثله كثير في القرآن نحو: { يحب التوابين ويحب المتطهرين }، [68] لأن التوبة سبب الطهارة. وكذلك: { كل أفاك أثيم }، [69] لأن الإفك سبب الإثم، وكذلك: { كل معتد أثيم }. [70]
وأما تقدم هماز على مشاء بنميم، فبالرتبة لأن المشي مرتب على القعود في المكان. والهماز هو العياب، وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه بخلاف النميمة.
وأما تقدم مناع للخير على معتد، فبالرتبة أيضا، لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه قبل غيره.
ومن المقدم بالرتبة: { يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر } [71] لأن الذي يأتي راجلًا يأتي من المكان القريب، والذي يأتي على الضامر يأتي من المكان البعيد. على أنه قد روى عن ابن عباس أنه قال: وددت أني حججت راجلًا لأن الله قدم الرجالة على الركبان، في القرآن فجعله ابن عباس من باب تقدم الفاضل على المفضول، والمعنيان موجودان، وربما قدم الشيء لثلاثة معان وأربعة وخمسة، وربما قدم لمعنى واحد من الخمسة.
ومما قدم للفضل والشرف: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم }، [72] وقوله: النبيين والصديقين ومنه تقديم السميع على البصير وسميع على بصير، ومنه تقديم الجن على الإنس في أكثر المواضع، لأن الجن تشتمل على الملائكة وغيرهم، مما اجتن عن الإبصار قال تعالى: { وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا } [73] وقال الأعشى:
وسخر من جن الملائك سبعة ** قيامًا لديه يعملون بلا أجر
وأما قوله تعالى: { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان }، [74] وقوله: { لا يُسئل عن ذنبه إنس ولا جان }، [75] وقوله: { ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبًا }، [76] فإن لفظ الجن ههنا لا يتناول الملائكة بحال لنزاهتهم عن العيوب، وأنهم لا يتوهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب، فلما لم يتناولهم عموم لفظ لهذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم.
وأما تقديم السماء على الأرض فبالرتبة أيضا، وبالفضل والشرف.
وأما تقديم الأرض في قوله: { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء }، [77] فبالرتبة أيضا، لأنها منتظمة بذكر ما هي أقرب إليه وهم المخاطبون بقوله: { ولا تعملون من عمل } [78] فاقتضى حسن النظم تقديمها مرتبة في الذكر مع المخاطبين الذين هم أهلها بخلاف الآية التي في سبأ، فإنها منتظمة بقوله عالم الغيب.
وأما تقديمه المال على الولد في كثير من الآي فلأن الولد بعد وجود المال نعمة ومسرة، وعند الفقر وسوء الحال هم ومضرة، فهذا من باب تقديم السبب على المسبب، لأن المال سبب تمام النعمة بالولد.
وأما قوله: حب الشهوات من النساء والبنين. فتقديم النساء على البنين بالسبب، وتقدم الأموال على البنين بالرتبة.
ومما تقدم بالرتبة ذكر السمع والعلم حيث وقع، فإنه خبر يتضمن التخويف والتهديد، فبدأ بالسمع لتعلقه بما قرب كالأصوات وهمس الحركات، فإن من سمع حِسَّك وخَفيَّ صوتِك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك إنه يعلم، وإن كان علمه تعالى متعلقًا بما ظهر وبطن وواقعًا على ما قرُب وشَطَن، ولكن ذكر السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم، فهو أولى بالتقديم.
وأما تقديم الغفور على الرحيم فهو أولى بالطبع، لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة تطلب قبل الغنيمة. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص: «ابعثك وجهًا يسلمك الله فيه ويغنمك وارغب لك رغبة من المال»، فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسلامة قبل الغنيمة وبالغنيمة قبل الكسب.
وأما قوله: وهو الرحيم الغفور في سبأ فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة، فإما بالفضل والكمال، وإما بالطبع، لأنها منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان. فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصهم والعموم بالطبع قبل الخصوص كقوله: { فاكهة ونخل ورمان }، [79] وكقوله: { وملائكته ورسله وجبريل وميكال }. [80]
ومما قدم بالفضل قوله: { واسجدي واركعي مع الراكعين }، [81] لأن السجود أفضل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة، لأنه انتقال من علو إلى انخفاض، والعلو بالطبع قبل الانخفاض، فهلا قدم الركوع؟ فالجواب أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: { اركعي مع الراكعين }، ولم يقل اسجدي مع الساجدين، فإنما عبر بالسجود عن الصلاة وأراد صلاتها في بيتها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها. ثم قال لها: اركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين في بيت المقدس، ولم يرد أيضا الركوع وحده دون أجزاء الصلاة، ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة، كما تقول: ركعت ركعتين وأربع ركعات، يريد الصلاة لا الركوع بمجرده؛ فصارت الآية متضمنة لصلاتين: صلاتها وحدها، عبر عنها بالسجود لأن السجود أفضل حالات العبد، وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع، لأنه في الفضل دون السجود، وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابها. وهذا نظم بديع وفقه دقيق وهذه نبذ تشير لك إلى ما وراء أو تنبذك وأنت صحيح بالعراء.
قالوا: ومما يليق ذكره بهذا الباب قوله: { وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود }. [82] بدأ بالطائفين للرتبة والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافين، وجمعهم جمع السلامة، لأن جمع السلامة أدل على لفظ الفعل الذي هو علة تعلق بها حكم التطهير، ولو كان مكان الطائفين الطواف لم يكن في هذا اللفظ من بيان قصد الفعل ما في قوله للطائفين ألا ترى أنك تقول: تطوفون، كما تقول: طائفون، فاللفظان متشابهان.
فإن قيل: فهلا أتى بلفظ الفعل بعينه فيكون أبين، فيقول: وطهر بيتي للذين يطوفون.
قيل: إن الحكم يعلل بالفعل لا بذوات الأشخاص، ولفظ الذين ينبىء عن الشخص والذات، ولفظ الطواف يخفي معنى الفعل ولا يبينه فكان لفظ الطائفين أولى بهذا الموطن.
ثم يليه في الترتيب والقائمين، لأنه في معنى العاكفين وهو في معنى قوله: { إلا ما دمت عليه قائمًا } [83] أي مثابرًا ملازمًا، وهو كالطائفين في تعلق حكم التطهر به. ثم يليه بالرتبة لفظ الراكع، لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يختصمون بما قرب منه كالطائفين والعاكفين، ولذلك لم يتعلق حكم التطهير بهذا الفعل الذي هو الركوع وإنه لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده، فلذلك لم يجىء بلفظ جمع السلامة لأنه لا يحتاج فيه إلى بيان لفظ الفعل، كما احتيج فيما قبله.
ثم وصف الركع بالسجود ولم يعطف بالواو كما عطف ما قبله لأن الركع هم السجود. والشيء لا يعطف بالواو على نفسه ولفائدة أخرى وهو أن السجود أغلب ما يجيء عبارة عن المصدر، والمراد به ههنا الجمع، فلو عطف بالواو لتوهم أنه يريد السجود الذي هو المصدر دون الاسم الذي هو النعت. وفائدة ثالثة أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حكم الشريعة، فلو عطفت ههنا بالواو لتوهم أن الركوع حكم يجري على حياله.
فإن قيل: فلم قال السجود على وزن فعول ولم يقل السجد كالركع، وفي آية أخرى ركعًا سجدًا ولم جمع ساجد على السجود ولم يجمع راكع على ركوع.
فالجواب أن السجود في الأصل مصدر كالخشوع والخضوع، وهو يتناول السجود الظاهر والباطن. ولو قال: السجد في جمع ساجد لم يتناول إلا المعنى الظاهر، وكذلك الركع ألا تراه يقول: تراهم ركعًا سجدًا وهذه رؤية العين وهي لا تتعلق إلا بالظاهر. والمقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله مما يراد به قصد البيت والبيت لا يتوجه إليه إلا بالعمل الظاهر. وأما الخشوع والخضوع الذي يتناوله لفظ الركوع دون لفظ الركع، فليس مشروطًا بالتوجه إلى البيت، وأما السجود فمن حيث أنبأ عن المعنى الباطن جعل وصفًا للركع ومتممًا لمعناه، إذ لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود الباطن ومن حيث تناول لفظه. أيضا السجود الظاهر الذي يشترط فيه التوجه إلى البيت حسن انتظامه أيضا مع ما قبله مما هو معطوف على الطائفين الذين ذكرهم بذكر البيت، فمن لحظ هذه المعاني بقلبه وتدبر هذا النظم البديع بلبه ارتفع في معرفة الإعجاز عن التقليد، وأبصر بعين اليقين أنه تنزيل من حكيم حميد تم كلامه.
قلت: وقد تولج رحمة الله مضائق تضايق عنها أن تولجها الإبر وأتى بأشياء حسنة وبأشياء غيرها أحسن منها.
فأما تعليله تقديم ربيعة على مضر ففي غاية الحسن وهذان الاسمان لتلازمهما في الغالب صارا كاسم واحد فحسن فيهما ما ذكره.
وأما ما ذكره في تقديم الجن على الإنس من شرف الجن فمستدرك عليه، فإن الإنس أشرف من الجن من وجوه عديدة قد ذكرناها في غير هذا الموضع.
وأما قوله: إن الملائكة منهم أو هم أشرف، فالمقدمتان ممنوعتان. أما الأول فلأن أصل الملائكة ومادتهم التي خلقوا منها هي النور، كما ثبت ذلك مرفوعًا عن النبي ﷺ في صحيح مسلم. وأما الجان فمادتهم النار بنص القرآن ولا يصح التفريق بين الجن والجان لغة ولا شرعًا ولا عقلًا. وأما المقدمة الثانية وهي كون الملائكة خيرًا وأشرف من الإنس فهي المسألة المشهورة وهي تفضيل الملائكة أو البشر والجمهور على تفضيل البشر. والذين فضلوا الملائكة هم المعتزلة والفلاسفة وطائفة ممن عداهم، بل الذي ينبغي أن يقال في التقديم هنا إنه تقديم بالزمان لقوله تعالى: { ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون * والجان خلقناه من قبل من نار السموم }. [84]
وأما تقديم الإنس على الجن في قوله: { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان }، [85] فلحكمة أخرى سوى ما ذكره، وهو أن النفي تابع لما تعقله القلوب من الاثبات فيرد النفي عليه، وعلم النفوس بطمث الإنس ونفرتها ممن طمثها الرجال هو المعروف. فجاء النفي على مقتضى ذلك. وكان تقديم الإنس في هذا النفي أهم.
وأما قوله: { وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا فهذا يعرف سره من السياق، فإن هذا حكاية كلام مؤمني الجن حين سماع القرآن كما قال تعالى: { قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا } [86] الآيات. وكان القرآن أول ما خوطب به الإنس ونزل على نبيهم وهم أول من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل الجن فجاء قول مؤمني الجن: { وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا } [87] بتقديم الإنس لتقدمهم في الخطاب بالقرآن، وتقديمهم في التصديق والتكذيب.
وفائدة ثالثة وهي أن هذا حكاية كلام مؤمني الجن لقولهم بعد أن رجعوا إليهم بأنهم لم يكونوا يظنون أن الإنس والجن يقولون على الله كذبًا، فذكرهم الإنس هنا في التقديم أحسن في الدعوة وأبلغ في عدم التهمة، فإنهم خالفوا ما كانوا يسمعونه من الإنس والجن لما تبين لهم كذبهم فبدأتهم بذكر الإنس أبلغ في نفي الغرض والتهمة وأن لا يظن بهم قومهم أنهم ظاهروا الإنس عليهم، فإنهم أول ما أقروا بتقولهم الكذب على الله، وهذا من ألطف المعاني وأدقها، ومن تأمل مواقعه في الخطاب عرف صحته.
وأما تقديم عاد على ثمود حيث وقع في القرآن فما ذكره من تقدمهم بالزمان فصحيح. وكذلك الظلمات والنور. وكذلك مثنى وبابه.
وأما تقديم العزيز على الحكيم فإن كان من الحكم وهو الفصل والأمر، فما ذكره من المعنى صحيح، وإن كان من الحكمة وهي كمال العلم والإرادة المتضمنين اتساق صنعه وجريانه على أحسن الوجوه وأكملها. ووضعه الأشياء مواضعها وهو الظاهر من هذا الاسم، فيكون وجه التقديم أن العزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كمال بأكملها وأعظمها وغايتها، فتقدم وصف القدرة لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة الخلق وهو مفعولاته تعالى وآياته. وأما الحكمة فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار غالبًا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. ووجه ثان أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به، فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه من الحكم والمعاني. ووجه ثالث أن الحكمة غاية الفعل، فهي متأخرة عنه تأخر الغايات عن وسائلها، فالقدرة تتعلق بإيجاده. والحكمة تتعلق بغايته فقدم الوسيلة على الغاية، لأنها أسبق في الترتيب الخارجي.
وأما قوله تعالى: { يحب التوابين ويحب المتطهرين }، [88] ففيه معنى آخر سوى ما ذكره. وهو أن الطهر طهران طهر بالماء من الأحداث والنجاسات وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي، وهذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا ينفع بدونه، بل هو مكمل له معد مهيىء بحصوله فكان أولى بالتقديم، لأن العبد أول ما يدخل في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك ثم يتطهر بالماء من الحدث.
وأما قوله: { كل أفاك أثيم }، [89] فالإفك هو الكذب وهو في القول والإثم هو الفجور وهو في الفعل. والكذب يدعو إلى الفجور كما في الحديث الصحيح أن الكذب يدعو إلى الفجور، وأن الفجور يدعو إلى النار، فالذي قاله صحيح.
وأما كل معتد أثيم ففيه معنى ثاني غير ما ذكره وهو أن العدوان مجاوزة الحد الذي حد للعبد فهو ظلم في القدر والوصف. وأما الإثم فهو محرم الجنس ومن تعاطى تعدى الحدود تخطى إلى الجنس الآخر وهو الإثم. ومعنى ثالث وهو أن المعتدي الظالم لعباد الله عدوانًا عليهم، والأثيم الظالم لنفسه بالفجور فكان تقديمه هنا على الأثيم أولى، لأنه في سياق ذمه والنهي عن طاعته. فمن كان معتديًا على العباد ظالمًا لهم فهو أحرى بأن لا تطيعه وتوافقه. وفيه معنى رابع وهو أنه قدمه على الأثيم ليقترن بما قبله وهو وصف المنع للخير، فوصفه بأنه لا خير فيه للناس وأنه مع ذلك معتد عليهم، فهو متأخر عن المناع لأنه يمنع خيره أولًا، ثم يعتدي عليهم ثانيًا، ولهذا يحمد الناس من يوجد لهم الراحة ويكف عنهم الأذى وهذا هو حقيقة التصوف وهذا لا راحة يوجدها ولا أذى يكفه.
وأما تقديم هماز على مشاء بنميم ففيه معنى آخر غير ما ذكره، وهو أن همزه عيب للمهموز وإزراء به وإظهار لفساد حاله في نفسه فإن قاله يختص بالمهموز لا يتعداه إلى غيره. والمشي بالنميمة يتعداه إلى من ينم عنده فهو ضرر متعد والهمز ضرره لازم للمهموز. إذا شعر به ما ينقل من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدي المنتشر.
وأما تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة وهي أن الله شرط في الحج الاستطاعة، ولا بد من السفر إليه لغالب الناس، فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب. وقدم الرجال اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدًا. ومن الناس من يقول: قدمهم جبرًا لهم، لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم. وتقول: إن الله لم يكتبه عليكم ولم يرده منكم، وربما توهموا أنه غير نافع لهم، فبدأ بهم جبرًا لهم ورحمة.
وأما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجلين في الوضوء، فمن يقول إن هذا الترتيب واجب هو الشافعي وأحمد ومن وافقهما. فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقرائن عديدة.
أحدها: أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره، ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح بعدها، فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله.
الثاني: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء، فدخلت الواو عاطفة لإجزائه بعضها إلى بعض. والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض. فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب إذ هو الربط المذكور في الآية، ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينهما، نحو: { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }، [90] أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفه. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه. وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد ولعله أرجح الأقوال.
الثالث: أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة فيجب مراعاتها، وأن لا تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره الله ويؤخر ما قدمه الله. وقد أشار النبي ﷺ إلى أن ما قدمه الله. فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخر، بل يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله. فلما طاف بين الصفا والمروة. بدأ بالصفا وقال: «نبدأ بما بدأ الله به»، وفي رواية للنسائي: «ابدؤا بما بدأ الله به» على الأمر، فتأمل بداءته بالصفا معللًا ذلك، يكون الله بدأ به. فلا ينبغي تأخيره، وهكذا يقول المرتبون للوضوء: سواء نحن نبدأ بما بدأ الله به ولا يجوز تأخير ما قدمه الله. ويتعين البداءة بما بدأ الله به، وهذا هو الصواب لمواظبة المبين عن الله مراده ﷺ على الوضوء المرتب، فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبًا ولم ينقل عنه أحد قط. أنه أخل بالترتيب مرة واحدة فلو كان الوضوء المنكوس مشروعًا لفعله، ولو في عمره مرة واحدة لتبين جوازه لأمته وهذا بحمد الله أوضح.
وأما تقديم النبيين على الصديقين فلما ذكره، ولكون الصديق تابعًا للنبي فإنما استحق اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي فهو تابع محض. وتأمل تقديم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم، وتقديم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم.
وأما تقديم السمع على البصر فهو متقدم عليه حيث وقع في القرآن مصدرًا أو فعلًا أو اسمًا. فالأول كقوله تعالى: { إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا }، [91] الثاني كقوله تعالى: { إنني معكما أسمع وأرى }، [92] والثالث كقوله تعالى: { سميع بصير }، [93] { إنه هو السميع البصير }، [94] { وكان الله سميعًا بصير } [95] فاحتج بهذا من يقول إن السمع أشرف من البصر وهذا قول الاكثرين، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي، وحكوا هم وغيرهم عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل ونصبوا معهم الخلاف وذكروا الحجاج من الطرفين. ولا أدري ما يترتب على هذه المسألة من الأحكام حتى تذكر في كتب الفقه! وكذلك القولان للمتكلمين والمفسرين وحكى أبو المعالي عن ابن قتيبة: تفضيل البصر ورد عليه. واحتج مفضلو السمع بأن الله تعالى يقدمه في القرآن حيث وقع وبأن بالسمع تنال سعادة الدنيا والآخرة. فإن السعادة بأجمعها في طاعة الرسل والإيمان بما جاءوا به، وهذا إنما يدرك بالسمع. ولهذا في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع: ثلاثة كلهم يدلي على الله بحجته يوم القيامة فذكر منهم رجلًا أصم يقول: يا رب لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئًا واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم الحاصلة من البصر. فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر القريبة، والسمع يدرك الموجودات والمعدومات والحاضر والغائب والقريب والبعيد والواجب والممكن والممتنع، فلا نسبة لإدراك البصر إلى إدراكه. واحتجوا بأن فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان، ولهذا كان الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب. وأما فقد البصر فربما كان معينًا على قوة إدراك البصيرة وشدة ذكائها. فإن نور البصر ينعكس إلى البصيرة باطنًا فيقوى إدراكها ويعظم، ولهذا تجد كثيرًا من العميان أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة، وضياء الحس الباطن، ما لا تكاد تجده عند البصير. ولا ريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار ومباشرته للمبصرات على اختلافها يوجب تفرق القلب وتشتيته. ولهذا كان الليل أجمع للقلب والخلوة أعون على إصابة الفكرة. قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر، ولهذا كثير في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى ولم يعرف فيهم واحد أطرش بل لا يعرف في الصحابة أطرش. فهذا ونحوه من احتجاجهم على تفضيل البصر.
قال منازعوهم: يفصل بيننا وبينكم أمران.
أحداهما: أن مدرك البصر النظر إلى وجه الله تعالى في الدار الآخرة، وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم. ولا شيء أكمل من المنظور إليه سبحانه فلا حاسة في العبد أكمل من حاسة تراه بها.
الثاني: أن هذا النعيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة السمع فكان السمع كالوسلية لهذا المطلوب الأعظم. فتفضليه عليه كفضيلة الغايات على وسائلها.
وأما ما ذكرتم من سعة إدراكاته وعمومها فيعارضه كثرة الخيانة فيها ووقوع الغلط. فإن الصواب فيما يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل في كثير ويقابل كثير مدركاته صحة مدركات البصر وعدم الخيانة. وإنما يراه ويشاهده لا يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه فيما يسمعه، وإذا تقابلت المرتبتان بقي الترجيح بما ذكرناه.
قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه: وفصل الخطاب أن إدراك السمع أعم وأشمل وإدراك البصر أتم وأكمل فهذا له التمام والكمال. وذاك له العموم والشمول، فقد ترجح كل منهما على الآخر بما اختص به. تم كلامه.
وقد ورد في الحديث المشهور أن النبي ﷺ قال لأبي بكر وعمر: «هذان السمع والبصر» وهذا يحتمل أربعة أوجه.
أحدها: أن يكون المراد أنهما مني بمنزلة السمع والبصر.
والثاني أن يريد أنهما من دين الاسلام بمنزلة السمع والبصر من الإنسان، فيكون الرسول ﷺ بمنزلة القلب والروح. وهما بمنزلة السمع والبصر من الدين. وعلى هذا فيحتمل وجهين.
أحدهما: التوزيع فيكون أحدهما بمنزلة السمع والآخر بمنزلة البصر.
والثاني: الشركة فيكون هذا التنزيل والتشبيه بالحاستين ثابتًا لكل واحد منهما، فكل منهما بمنزلة السمع والبصر فعلى احتمال التوزيع والتقسيم تكلم الناس. أيهما هو السمع وأيهما هو البصر؟ وبنوا ذلك على أي الصفتين أفضل. فهي صفة الصديق.
والتحقيق أن صفة البصر للصديق وصفة السمع للفاروق. ويظهر لك هذا من كون عمر محدثًا كما قال النبي ﷺ: «قد كان في الإمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر»، والتحديث المذكور هو ما يلقى في القلب من الصواب والحق وهذا طريقة السمع الباطن وهو بمنزلة التحديث والإخبار في الأذن. وأما الصديق فهو الذي كمل مقام الصديقية لكمال بصيرته، حتى كأنه قد باشر بصره مما أخبر به الرسول ما باشر قلبه فلم يبق بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب، فهو كأنه ينظر إلى ما أخبر به من الغيب من وراء ستوره، وهذا لكمال البصيرة وهذا أفضل مواهب العبد وأعظم كراماته التي يكرم بها، وليس بعد درجة النبوة إلا هي ولهذا جعلها سبحانه بعدها فقال: { ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين } [96] وهذا هو الذي سبق به الصديق لا بكثرة صوم ولا بكثرة صلاة. وصاحب هذا يمشي رويدًا ويجيء في الأول. ولقد تعنى من لم يكن سيره على هذا الطريق وتشميره إلى هذا العلم، وقد سبق من شمر إليه وإن كان يزحف زحفًا ويحبو حبوًا، ولا تستطل هذا الفصل فإنه أهم مما قصد بالكلام فليعد إليه.
فقيل: تقديم السمع على البصر له سببان:
أحدهما: أن يكون السياق يقتضيه بحيث يكون ذكرها بين الصفتين متضمنًا للتهديد والوعيد كما جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التي تقتضي الحذر والاستقامة كقوله: { فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم }، [97] وقوله: { من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعًا بصيرًا }، [98] والقرآن مملوء من هذا وعلى هذا، فيكون في ضمن ذلك أني أسمع ما يردون به عليك وما يقابلون به رسالاتي وأبصر ما يفعلون.
ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان.
أحدهما: قابلوها بقولهم صدقت ثم عملوا بموجبها.
والثاني: قابلوها بالتكذيب ثم عملوا بخلافها، فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة البصر. فقدم ما يتعلق به على ما يتعلق بالمبصر. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى لموسى: { إنني معكما أسمع وأرى } [99] هو يسمع ما يجيبهم به، ويرى ما يصنعه. وهذا لا يعم سائر المواضع، بل يختص منها بما هذا شأنه.
والسبب الثاني أن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام مع غاية البعد بين السامع والمسموع أشد من إنكارها لرؤيته مع بعده.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول. فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. ولم يقولوا: أترون الله يرانا، فكان تقديم السمع أهم والحاجة إلى العلم به أمس.
وسبب ثالث وهو أن حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثيرًا في الخير والشر والصلاح والفساد، بل عامة ما يترتب في الوجود من الأفعال إنما ينشأ بعد حركة اللسان. فكان تقديم الصفة المتعلقة به أهم وأولى وبهذا يعلم تقديمه على العليم حيث وقع.
وأما تقديم السماء على الأرض ففيه معنى آخر غير ما ذكره، وهو أن غالبًا تذكر السمرات والأرض في سياق آيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته، ومعلوم أن الآيات في السموات أعظم منها في الأرض لسعتها وعظمها وما فيها من كواكبها وشمسها وقمرها وبروجها وعلومها واستغنائها عن عمد تقلها، أو علاقة ترفعها إلى غير ذلك من عجائبها التي الأرض وما فيها كقطرة في سعتها، ولهذا أمر سبحانه بأن يرجع الناظر البصر فيها كرة بعد كرة، ويتأمل استواءها واتساقها وبراءتها من الخلل والفطور. فالآية فيها أعظم من الأرض، وفي كل شيء له آية سبحانه وبحمده.
وأما تقديم الأرض عليها في قوله: { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء }، [100] وتأخيرها عنها في سبأ فتأمل. كيف وقع هذا الترتيب في سبأ في ضمن قول الكفار: { لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض } [101] كيف قدم السموات هنا، لأن الساعة إنما تأتي من قبلها وهي غيب فيها ومن جهتها تبتدىء وتنشأ، ولهذا قدم صعق أهل السموات على أهل الأرض عندها فقال تعالى: { ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض }. [102]
وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يونس فإنه لما كان السياق سياق تحذير وتهديد للبشر وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم دقيقها وجليلها، وإنه لا يغيب عنه منها شيء. اقتضى ذلك ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء فتبارك من أودغ كلامه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه كلام الله وإن مخلوقًا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا.
وأما تقديم المال على الولد فلم يطرد في القرآن، بل قد جاء مقدمًا كذلك في قوله: { وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم }، [103] وقوله: { إنما أموالكم وأولادكم فتنة }، [104] وقوله: { لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله }، [105] وجاء ذكر البنين مقدمًا كما في قوله: { قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها }، [106] وقوله: { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة }. [107] فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة فلأنها ينتظمها معنى واحد وهو التحذير من الاشتغال بها، والحرص على تحصيلها حتى يفوته حظه من الله والدار الآخرة. فهي في موضع الالتهاب بها وأخبر في موضع أنها فتنة وأخبر في موضع آخر أن الذي يقرب عباده إليه إيمانهم وعملهم الصالح لا أموالهم ولا أولادهم ففي ضمن هذا النهي عن الاشتغال بها عما يقرب إليه. ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بها، أعظم من اشتغالهم بأولادهم، وهذا هو الواقع حتى أن الرجل ليستغرقه اشتغاله بما له عن مصلحة ولده وعن معاشرته وقربه. وأما تقديمهم على الأموال في تينك الآيتين فلحكمة باهرة وهي أن براءة متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن تصور المجاهد فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته ماله، فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهر، نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثر، ولايكاد عند هذا التصور يخطر له مفارقة ماله بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال، فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم المال.
وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته. فبدأ أولا بذكر أصول العبد وهم آباؤه المتقدمون طبعًا وشرفًا ورتبة، وكان فخرًا لقوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم، وحتى عن أبنائهم. ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية ولايشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة ويرغبون عن دينهم لما في ذلك من ازرائهم بهم، ثم ذكر الفروع وهم الأبناء لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم وأعلق بقلوبهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة، ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة وحواشي النسب، فذكر الأصول أولًا، ثم الفروع ثانيًا، ثم النظراء ثالثًا، ثم الأزواج رابعًا. لأن الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرها، وهي إنما تراد للشهوة، وأما الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا عوض عنهم ويرادون للنصرة والدفاع. وذلك مقدم على مجرد الشهوة، ثم ذكر القرابة البعيدة. خامسًا: وهي العشيرة وبنو العم، فإن عشائرهم كانوا بني عمتهم غالبًا. وإن كانوا أجانب فأولى بالتأخير، ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسًا: ووصفها بكونها مقترفة أي مكتسبة، لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل، وله أحب وبقدره أعرف لما حصل له فيه من التعب والمشقة، بخلاف مال جاء عفوًا بلا كسب من ميراث أو هبة أو وصية، فإن حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقائه أعظم من الثاني والحس شاهد بهذا، وحسبك به، ثم ذكر التجارة سابعًا لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التي يحصله بها، فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف. فقدم المال على التجارة تقديم الغايات على وسائلها، ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادها، وهذا يدل على شرفها وخطرها وإنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد، ثم ذكر الأوطان ثامنًا آخر المراتب، لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما تقدم، فإن الأوطان تتشابه. وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه ويكون خيرًا منه فمنها عوض. وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعوض منها بغيرها. فالقلب وإن كان يحن إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم. فمحبة الوطن آخر المراتب وهذا هو الواقع. إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب، فذلك جزئي لا كلي فلا تناقض به. وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع.
وأما آية آل عمران فإنها لما كانت في سياق الإخبار بما زين للناس من الشهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بها قدم ما تعلق الشهوة به أقوى والنفس إليه أشد سعرًا، وهو النساء التي فتنتهن أعظم فتن الدنيا. وهي القيود التي حالت بين العباد وبين سيرهم إلى الله، ثم ذكر البنين المتولدين منهم فالإنسان يشتهي المرأة للذة والولد، وكلاهما مقصود له لذاته، ثم ذكر شهوة الأموال لأنها تقصد لغيرها، فشهوتها شهوة الوسائل. وقدم أشرف أنواعها وهو الذهب، ثم الفضة بعده، ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان الذي لا يعاشر عشرة النساء والأولاد. فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بها. وقدم أشرف هذا النوع وهو الخيل، فإنها حصون القوم ومعاقلهم وعزهم وشرفهم. فقدمها على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ثم ذكر الأنعام وقدمها على الحرث، لأن الجمال بها والانتفاع أظهر وأكثر من الحرث كما قال تعالى: { ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون }، [108] والانتفاع بها أكثر من الحرث فإنها ينتفع بها ركوبًا وأكلًا وشربًا ولباسًا وأمتعة وأسلحة ودواء وقنية إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع، وأيضا فصاحبها أعز من صاحب الحرث وأشرف، وهذا هو الواقع فإن صاحب الحرث لا بد له من نوع مذلة، ولهذا قال بعض السلف وقد رأى سكة ما دخل: هذا دار قوم إلا دخلهم الذل. فجعل الحرث في آخر المراتب وضعًا له في موضعه.
ويتعلق بهذا نوع آخر من التقديم لم يذكره وهو تقديم الأموال على الأنفس في الجهاد، حيث ما وقع في القرآن إلا في موضع واحد. وهو قوله: { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله }. [109]
وأما سائر المواضع فقدم فيها المال نحو قوله: { وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم }، [110] وقوله: { وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم }، [111] وهو كثير فما الحكمة في تقديم المال على النفس؟ وما الحكمة في تأخيره في هذا الموضع وحده؟
وهذا لم يتعرض له السهيلي رحمه الله، فيقال:
أولًا: هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال، كما يجب بالنفس. فإذا دهم العدو وجب على القادر الخروج بنفسه، فإن كان عاجزًا وجب عليه أن يكتري بماله وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والأدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا.
ومن تأمل أحوال النبي ﷺ وسيرته في أصحابه وأمرهم بإخراج أموالهم في الجهاد، قطع بصحة هذا القول.
والمقصود تقديم المال في الذكر وإن ذلك مشعر بإنكار وهم من يتوهم أن العاجز بنفسه إذا كان قادرًا على أن يغزى بماله لا يجب عليه شيء، فحيث ذكر الجهاد قدم ذكر المال. فكيف يقال: لا يجب به. ولو قيل: إن وجوبه بالمال أعظم وأقوى وجوبه بالنفس، لكان هذا القول أصح من قول من قال: لا يجب بالمال وهذا بين وعلى هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الذكر. وفائدة ثانية على تقدير عدم الوجوب وهي أن المال محبوب النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله وترتكب الأخطار وتتعرض للموت في طلبه. وهذا يدل على أنه هو محبوبها ومعشوقها فندب الله تعالى محبيه المجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم ومحبوبهم في مرضاته. فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شيء إليهم، ولا يكون في الوجود شيء أحب إليهم منه، فإذا بذلوا محبوبهم في حبه، نقلهم إلى مرتبة أخرى أكمل منها. وهي بذل نفوسهم له، فهذا غاية الحب. فإن الإنسان لا شيء أحب إليه من نفسه، فإذا أحب شيئًا بذل له محبوبه من نفعه وماله، فإذا آل الأمر إلى بذل نفسه ضن بنفسه وآثرها على محبوبه. هذا هو الغالب وهو مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية، ولهذا يدافع الرجل عن ماله وأهله وولده، فإذا أحس بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه فر وتركهم، فلم يرض الله من محبيه بهذا، بل أمرهم أن يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها، وأيضا فبذل النفس آخر المراتب فإن العبد ييذل ماله أو لا يقي به نفسه، فإذا لم يبق له مال بذل نفسه، فكان تقديم المال على النفس في الجهاد مطابقًا للواقع.
وأما قوله: { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم }. [112] فكان تقديم الأنفس هو الأولى، لأنها هي المشتراة في الحقيقة وهي مورد العقد وهي السلعة التي استامها ربها وطلب شراءها لنفسه وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته. فكانت هي المقصود بعقد الشراء والأموال تبع لها، فإذا ملكها مشتريها ملك مالها. فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه شيء. فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها ومتعلقاتها، فحصن تقديم النفس على المال في هذه الآية حسنًا لا مزيد عليه.
فلنرجع إلى كلام السهيلي رحمه الله وأما ما ذكره من تقديم الغفور على الرحيم فحسن جدًا. وأما تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأ ففيه معنى غير ما ذكره يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلي وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى قوله وهو الرحيم الغفور. فإنه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم، وهو متضمن لجميع صفات كماله، ونعوت جلاله مستلزم لها. كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره. فهو المحمود على كل حال وعلى كل ما خلقه وشرعه، ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد فقال: { الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض }، [113] ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدًا، فإنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه. وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدًا. وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في كلامه. فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهما. فله كمال من ملكه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصًا، والحمد بلا ملك يستلزم عجزًا، والحمد مع الملك غاية الكمال. ونظير هذه العزة والرحمة والعفو والقدرة والغنى والكرم فوسط الملك بين الجملتين فجعله محفوفًا بحمد قبله وحمد بعده، ثم عقب هذا الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدالين على كمال الإرادة، وإنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة وعلى كمال العلم. وإنه كما يتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبره. فنسبة الحكمة إلى الإرادة، كنسبة الخبرة إلى العلم. فالمراد ظاهر والحكمة باطنة والعلم ظاهر والخبرة باطنة، فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة، وكمال العلم أن يكون كاشفًا عن الخبرة. فالخبرة باطن العلم وكماله، والحكمة باطن الإرادة وكمالها فتضمنت الآية إثبات حمده وملكه وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه.
ثم ذكر تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفلي فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها.
ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه وهما الرحمة والمغفرة فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته، ويعفو عن زلتهم ويهب لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته. فقال: { وهو الرحيم الغفور }، [114] فتضمنت هذه الآية سعة علمه ورحمته وحكمه ومغفرته.
وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة. كما يقرن بين العلم والحلم. فمن الأول قوله: { ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا }، [115] ومن الثاني: { والله عليم حليم }، [116] فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم، ومن رحمة إلى علم.
وحملة العرش أربعة؛ اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم، لأن العفو إنما يحسن عند القدرة، وكذلك الحلم والرحمة، إنما يحسنان مع العلم. وقدم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم. فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله: { ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا }. [117]
ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب الخير، ولما كان دفع الشر مقدمًا على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع. ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قبله قدم على الغفور.
وأما قوله تعالى: { يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين }، [118] فقد أبعد النجعة فيما تعسفه من فائدة التقديم وأتى بما ينبو اللفظ عنه. وقال غيره: السجود كان في دينهم قبل الركوع. وهذا قائل ما لا علم له به. والذي يظهر في الآية والله أعلم بمراده من كلامه أنها اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها، فذكر الأعم، ثم ما هو أخص منه، ثم ما هو أخص من الأخص. فذكر القنوت أولا وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة، ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده، كسجود الشكر والتلاوة ويشرع في الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت، ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في الصلاة فلا يسن الإتيان به منفردًا فهو أخص مما قبله.
ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه. وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى الأخص وعكسها وهو الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم.
ونظيرها: { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير }، [119] فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع، ثم السجود أعم منه، ثم العبادة أعم من السجود، ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله.
والذي يزيد هذا وضوحًا الكلام على ما ذكره بعد هذه الآية من قوله: { أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } [120] فإنه ذكر أخص هذه الثلاثة وهو الطواف الذي لا يشرع إلا بالبيت خاصة، ثم انتقل منه إلى الاعتكاف وهو القيام المذكور في الحج وهو أعم من الطواف، لأنه يكون في كل مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداها، ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما منع منه مانع أو استثني شرعًا.
وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت، ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد، ثم الصلاة التي تكون في البلد كله، بل في كل بقعة، فهذا تمام الكلام على ما ذكره من الأمثلة وله رحمه الله مزيد السبق وفضل التقدم.
وابن اللبون إذا ما لز في قرن ** لم يستطع صولة البزل القنا عيسى
(مسائل في المثنى والجمع)
(الواو والألف في يفعلون وتفعلان)
الواو والألف في يفعلون وتفعلان أصل للواو والألف في الزيدون والزيدان، فإنما جعلنا ما هو من الأفعال أصلًا لما هو في الأسماء، لأنها إذا كانت في الأفعال كانت أسماء وعلامة جمع. وإذا كانت في الأسماء كانت علامة محضة لا أسماء، وما يكون اسمًا وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفًا في موضع آخر. إذا كان اللفظ واحدًا نحو كاف الضمير وكاف المخاطبة في ذلك، وهذا أولى بنا من أن نجعل الحرف أصلًا والاسم فرعًا له، يدلك على هذا أنهم لم يجمعوا بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى الفعل، كالمسلمون والصالحون دون رجلون وخيلون.
فإن قيل: فالإعلام ليس فيها معنى الفعل وقد جمعوها كذلك.
قيل: الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف واللام. فلا يقال: جاءني زيدون وعمرون. فدل على أنهم أرادوا معنى الفعل أي الملقبون بهذا الاسم والمعرفون بهذه العلامة. فعاد الأمر إلى ما ذكرنا.
وأما التثنية فمن حيث قالوا: في الفعل فعلًا وصنعًا لمن يعقل وغيره، ولم يقولوا صنعوا إلا لمن يعقل. لم يجعلوا الواو علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل، إذ كان فيه معنى الفعل، ومن حيث اتفق معنى التثنية ولم يختلف. اتفق لفظها كذلك في جميع أحوالها ولم يختلف. واستوى فيها العاقل وغيره.
ومن حيث اختلفت معاني الجموع بالكثرة والقلة، اختلف ألفاظها. ولما كان الإخبار عن جمع ما لا يعقل يجري مجرى الجمّة والأمة والبلد، لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان المجتمعة على التخصيص لا كل منهما على التعيين. كان الإخبار عنها بالفعل كالإخبار عن الأسماء المؤنثة، إذ الجمة والأمة وما هو في ذلك المعنى أسماء مؤنثة، ولذلك قالوا: الجمال ذهبت والثياب بيعت. إذ لا يتعين في قصد الضمير كل واحد منهما في غالب الكلام والتفاهم بين الأنام. ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل بخلاف ذلك، وكان كل واحد من الجمع يتعين غالبًا في القصد إليه والإشارة، وكان اجتماعهم في الغالب عن ملازمتهم وتدبير وأغراض عقلية، جعلت لهم علامة تختص بهم تنبىء عن الجمع المعنوي كما هي في ذاتها جمع لفظي وهي الواو، لأنها ضامة بين الشفتين وجامعة لهما. وكل محسوس يعبر عن معقول فينبغي أن يكون مشاكلًا له. فما خلق الله الأجساد في صفاتها المحسوسة إلا مطابقة للأرواح في صفاتها المعقولة، ولا وضع الألفاظ في لسان آدم وذريته إلا موازنة للمعاني التي هي أرواحها. وعلى نحو ذلك خصت الواو بالعطف لأنه جمع في معناه وبالقسم، لأن واوه في معنى واو العطف.
وأما اختصاص الألف بالتثنية فلقرب التثنية من الواحد في المعنى فوجب أن يقرب لفظها من لفظه. وكذلك لا يتغير بناء الواحد فهما كما لا يتغير في أكثر الجموع وفعل الواحد مبني على الفتح فوجب أن يكون فعل الاثنين كذلك وذلك لا يمكن مع غير الألف، فلما ثبت أن الألف بهذه العلة ضمير الاثنين كانت علامة للاثنين في الأسماء، كما فعلوا في الواو حين كانت ضمير الجماعة في الفعل جعلت علامة للجمع في الأسماء.
وأما إلحاق النون بعد حرف المد في هذه الأفعال الخمسة فحملت على الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السلامة والمثناة نحو مسلمون ومسلمات وهي في تثنية الأسماء وجمعها عوض عن التنوين. كما ذكروا، ثم شبهوا بها هذه الأمثلة الخمسة وألحقوا النون فيها في حال الرفع، لأنها إذا كانت مرفوعة كانت واقعة موقع الاسم فاجتمع فيها وقوعها موقع الاسم ومضارعتها له في اللفظ، لأن آخرها حرف مد ولين، ومشاركتها له في المعنى، فالحق فيها النون عوضًا عن حركة الأعراب حملًا على الأسماء كما حملت الأسماء عليها فجمعت بالواو والياء.
فالنون في تثنية الأسماء وجمعها أصل للنون في تثنية الأفعال وجمعها، أعني علامات الأعراب هي أصل الحروف والمد في تثنية الأسماء، وجمعها التي هي علامات إعراب وحروف إعراب كما تقدم.
فإن قيل: فهلا أثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم من الأمثلة الخمسة؟
قلنا: لعدم العلة المتقدمة وهي وقوعها موقع الإسم. وأنت إذا أدخلت النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء، لأن الأسماء لا تكون بعد عوامل الأفعال فبعدت عن الأسماء ولم يبق فيها إلا مضارعتها لها في اتصال حروف المد بها مع الاشتراك في معنى الفعل.
فإن قيل: فأين الإعراب فيها في حال النصب والجزم؟
قلنا: مقدر، كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مد ولين سواء. وسواء كان حرف المد زائدًا أو أصليًا ضميرًا أو حرفًا كيرمي والقاضي وعصى ورمى وسكري وغلامي، إلا أنه مع هذه الياء مقدر قبلها أعني الإعراب وهو في يرمي ويخشى، ونحوه مقدر في نفس الحرف لا قبله، لأنه لا يتقدر إعراب اسم في غيره.
إذا ثبت ذلك، فقولك: لن تفعلوا ولن تفعلي إعرابه مقدر قبل الضمير في لام الفعل. كما هو كذلك في غلامي. وليس زوال النون وحذفها هو الإعراب، لأنه يستحيل أن يحول بين حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعل أو غير فاعل. مع أن العدم ليس بشيء فيكون إعرابًا وعلامة لشيء في أصل الكلام ومفعوله.
وأما فعل جماعة النساء، فكذلك أيضا إعرابه مقدر قبل علامة الإضمار كما هو مقدر قبل الياء من غلامي فعلامة الإضمار منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل، وإنها لبعض حروفه فلا يمكن تعاقب الحركات على لام الفعل معها، كما لم يمكن ذلك مع ضمائر الفاعلين المذكورين ولا مع الياء في غلامي، ولا يمكن أيضا أن يكون الإعراب في نفس النون، لأنها ضمير الفاعل فهي غير الفعل ولا يكون إعراب شيء في غيره.
ولا يمكن أيضا أن يكون بعدها فإنه مستحيل في الحركات وبعيد كل البعد في غير الحركات أن يكون إعرابًا وبينه وبين حرف الإعراب اسم أو فعل فثبت أنه مقدر كما هو في جميع الأسماء والأفعال المعربة التي لا يقدر على ظهور الإعراب فيها لمانع كما تقدم.
فإن قيل: فقد أثبتم أن فعل جماعة المؤنث معرب وهذا خلاف لسيبويه ومن وافقه من النحويين. فإنهم زعموا أنه مبني وإن اختلفوا في علة بنائه.
قلنا: بل هو وفاق لهم لأنهم علمونا وأصلوا لنا أصلًا صحيحًا. فلا ينبغي لنا أن ننقضه ونكسره عليهم وهو وجود المضارعة الموجبة للإعراب وهي موجودة في يفعلن وتفعلن. فمتى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة وإذا وجدت المضارعة وجد الإعراب.
فإن قيل: فهلا عوضوا من حركة الإعراب في حال رفعه كما فعلوا في يفعلون، لأنه أيضا واقع موقع الاسم؟
قلنا: قد تقدم ما في يفعلون ويفعلان من وجوه الشبه بينه وبين جمع السلامة في الأسماء فمنها الوقوع موقع الاسم، ومنها المضارعة في اللفظ من جهة حروف المد واللين. وهذا الشبه معدوم في يفعلن من جهة اللفظ، لأنه ليس مثل لفظ فاعلين ولا فاعلات وإن كان واقعًا موقعه في حال الرفع.
فائدة: أسماء الأيام
لما كانت الأيام متماثلة لا يتميز يوم من بوم بصفة نفسية ولا معنوية. لم يبق تمييزها إلا بالأعداد، ولذلك جعلوا أسماء أيام الأسبوع مأخوذة من العدد، نحو الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أو بالأحداث الواقعة فيها كيوم بعاث ويوم بدر ويوم الفتح، ومنه يوم الجمعة. وفيه قولان: أحدهما لاجتماع الناس فيه للصلاة. والثاني، وهو الصحيح، لأنه اليوم الذي جمع فيه الخلق وكمل. وهو اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء. وأما يوم السبت فمن القطع كما تشعر به هذه المادة، ومن السبات لانقطاع الحيوان فيه عن التحرك والمعاش. والنعال السبتية التي قطع عنها الشعر، وعلة السبات التي تقطع العليل عن الحركة والنطق، ولم يكن يومًا من أيام تخليق العالم بل ابتداء أيام التخليق الأحد وخاتمتها الجمعة. هذا أصح القولين، وعليه يدل القرآن وإجماع الأمة. على أن أيام تخليق العالم ستة، فلو كان أولها السبت لكانت سبعة.
وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه خلق الله التربة يوم السبت فقد ذكر البخاري في تاريخه أنه حديث معلول وأن الصحيح إنه قول كعب وهو كما ذكر، لأنه يتضمن أن أيام التخليق سبعة والقرآن يرده.
واعلم: أن معرفة أيام الأسبوع لا يعرف بحس ولا عقل ولا وضع يتميز به الأسبوع عن غيره، وإنما يعلم بالشرع. ولهذا لا يعرف أيام الأسبوع إلا أهل الشرائع ومن تلقى ذلك عنهم وجاورهم. وأما الأمم الذين لا يدينون بشريعة ولا كتاب، فلا يتميز الأسبوع عندهم من غيره، ولا أيامه بعضها من بعض. وهذا بخلاف معرفة الشهر والعام فإنه أمر محسوس.
فائدة: الأمس واليوم والغد
في اليوم وأمس وغد وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه
اعلم أن أقرب الأيام إليك يومك الذي أنت فيه، فيقال: فعلت اليوم فذكر الاسم العام، ثم عرف بأداة العهد ولا شيء أعرف من يومك الحاضر. فانصرف إليه ونظيره الآن من آن والساعة من ساعة. وأما أمس وغد فلما كان كل واحد منهما متصلًا بيومك اشتق له اسم من أقرب ساعة إليه، فاشتق لليوم الماضي أمس الملاقي للمساء، وهو أقرب إلى يومك من صاحبه، أعني صباح غد، فقالوا: أمس. وكذلك غد، اشتق الاسم من الغدو وهو أقرب إلى يومك من مسائه أعني مساء غد.
وتأمل كيف بنوا أمس وأعربوا غدًا لأن أمس صيغ من فعل ماض وهو أمسى، وذلك مبني فوضعوا أمس على وزن الأمر من أمسى يمسي. وأما الغد فإنه لم يؤخذ من مبني. إذ لا يمكن أن يقال: هو مأخوذ من غدًا.
كما يمكن أن يقال أمس من أمسى، بل أقصى ما يمكن فيه أن يكون من الغدو والغدوه وليستا بمبنيين. وهذه العلة أحسن من علة النحاة أن أمس بني لتضمنه معنى اللام وأصله الأمس. قالوا: لأنهم يقولون أمسِ الدابر فيصفونه بذي اللام، فدل على أنه معرفة، ولا يمكن أن يكون معرفة إلا بتقدير اللام وهذا أولا منقوض بقولهم غد الآتي فيلزم على طرد علتهم أن يبنوا غدًا.
وأيضا فإن أمس جرى مجرى الأعلام وهو والله أعلم بمنزلة "اصمت" و"أطرقا" مما جاء منها بلفظ الأمر اسم علم لمكان. يقول الرجل لصاحبه: فقد اصمت إذا جاوره، فاصمت في المكان كأمس في الزمان، ولعله أخذ من قولهم أمس بخير وأمس معنا ونحوه. ولا يقال: كيف يدعي فيه العلمية مع شياعه، لأنا نقول: علميته ليست كعلمية زيد وعمرو، بل كعلمية أسامة وذؤالة وبرة وفجار، وبابه مما جعل الجنس فيه بمنزلة الشخص في العلم الشخصي.
فإن قيل: فما الفرق بينه وهو اسم الجنس إذًا؟
قيل: هذا مما أعضل على كثير من النحاة حتى جعلوا الفرق بينهما لفظيًا فقط، وقالوا يظهر تأثيره في منع الصرف ووصفه بالمعرفة وانتصاب الحال عنه ونحو ذلك، ولم يهتدوا لسر الفرق بين أن موضع اللفظ لواحد منهم منكر شائع في الجنس ولمسمى الجنس المطلق. فهنا ثلاثة أمور تتبعها ثلاثة أوضاع:
أحدها معرف معين من الجنس له العلم الشخصي كزيد.
والثاني واحد منهم شائع في الجنس غير معرف فله الاسم النكرة كأسد من الأسد.
الثالث الجنس المتصور في الذهن المنطبق على كل فرد من أفراده وله علم الجنس كأسامة، فنظير هذا أمس في الزمان، ولهذا وصف بالمعرفة فاعلق بهذه الفائدة التي لا تجدها في شيء من كتب القوم. والحمد الله الوهاب المان بفضله.
فائدة: حذف لام يد ودم وغد
المشهور عند النحاة أن حذف لام يد ودم وغد وبابه حذف اعتباطي لا سبب له، لأنهم لم يروه جاريًا على قياس الحذف، وقد يظهر فيه معنى لطيف وهو أن الألفاظ أصلها المصادر الدالة على الأحداث فأصل غد مصدر غدًا يغدو غدوًا بوزن رمى وأصل دم دمي بوزن فرح مصدر دمي يدمى كبقي يبقى. وأصل يد كذلك يدي من يديت إليه يديا، ثم حذفوا: فقالوا: يدًا وكذلك سم أصله سمو من سما يسمو سموًا كعلم يعلم علمًا. فلما زحزحت على أصل موضوعاتها وبقي فيها من المعنى الأول ما يعلم أنها مشتقة منه. حذفت منها لاماتها بإزاء ما نقص من معانيها ليكون النقص في اللفظ موازيًا للنقص في المعنى، فلا يستوفي حروف الكلمة بأسرها إلا عند حصول المعنى بأسره.
فائدة: دخول الزوائد على الحروف
دخول الزوائد على الحروف الأصلية منبئة معان زائدة على معنى الكلمة التي وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه. فإن كان المعنى الزائد آخرًا كانت الزيادة آخرًا كنحو التاء في فعلت، لأنها تنبىء عما رتبته بعد الفعل، وإن كان المعنى الزائد أولًا، كانت الزيادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة كالزوائد الأربع، فإنها تنبىء أن الفعل لم يحصل بعد لفاعله، وإن بينه وبين تحصيله جزءًا من الزمان. وكان الحرف الزائد السابق للفظ مشيرًا في اللسان إلى الجزء من الزمان مرتبًا في البيان على حسب ترتب المعنى في الجنان. وكذلك حكم جميع ما يرد عليك في كلامهم.
فإن قيل: فهلا كانت الياء مكان التاء، والهمزة.
قيل: أصل هذه الزوائد الياء بدليل كونها في الوضع الذي لا يحتاج فيه إلى الفرق بين مذكر ومؤنث وهو فعل جماعة النساء، فإنك إذا قلت: النسوة يقمن، فالفرق حاصل بالنون. وأيضا فأصل الزيادة لحروف المد واللين والواو لا تزاد أولا لئلا يشتبه بواو العطف والألف يتعذر أولا لسكونها فلم يبق إلا الياء فهي الأصل، فلما أريد الفرق كانت الهمزة للمتكلم أولى لإشعارها بالضمير المستتر في الفعل، إذ هي أول حروف ذلك الضمير إذا برز فلتكن مشيرة إليه إذا خفي، وكانت النون لفعل المتكلم أولى لوجودها في أول لفظ الضمير الكامن في الفعل إذا ظهر فلتكن دالة عليه إذا خفي واستتر وكانت التاء من تفعل للمخاطب لكونها في الضمير المستتر فيه، وإن لم تكن في أول اللفظ أعني أتت، ولكنها في آخره. ولم يخصوا بالدلالة عليه ما هو في أول لفظه، أعني الهمزة لمشاركته للمتكلم فيها وفي النون. فلم يبق من لفظ الضمير إلا التاء فجعلوها في أول الفعل علمًا عليه وإيماء إليه.
فإن قيل: فكان يلزم على هذا أن تكون الزيادة في فعل الغائب هاء لوجودها في لفظ ضمير الغائب إذا برز.
قيل: لا ضمير في الغائب في أصل الكلام وأكثر مواضعه، لأن الاسم الظاهر يغني عنه ولا يستتر ضمير الغائب حتى يتقدمه مذكور يعود عليه. وليس كذلك فعل المتكلم والمخاطب والمخبرين عن أنفسهم. فإنه لا يخلو أبدًا عن ضمير ولا يجيء بعده اسم ظاهر يكون علامة ولا مضمرًا أيضا. إلا أن يكون توكيدًا للمضمر المنطوي عليه الفعل.
ومن ههنا ضارعت الأسماء حتى أعربت وجرت مجراها في دخول لام التوكيد وغير ذلك، لأنها ضمنت معنى الأسماء بالحروف التي في أوائلها. فهي من حيث دلت على الحدث والزمان فعل محض، ومن حيث دلت بأوائلها على المتكلم والمخاطب وغير ذلك متضمنة معنى الاسم. فاستحقت الإعراب الذي هو من خواص الاسم، كما استحق الاسم المتضمن معنى الحرف البناء.
فائدة: فعل الحال
فعل الحال لا يكون مستقبلًا وإن حسن فيه عد. كما لا يكون المستقبل حالًا أبدًا ولا الحال ماضيًا. وأما جاءني زيد يسافر غدًا، فعلى تقدير الحكاية له إذا وقع وهي حال مقدرة. ومنه قوله تعالى: { ولو ترى إذ وقفوا }، [121] والوقوف مستقبل لا محالة، ولكن جاء بلفظ الماضي حكاية لحال يوم الحساب فيه لا يترتب على وقوف، قد ثبت وكذلك: { قال الذين حق عليهم القول }، [122] { وقال الذين في النار }، [123] وهو كثير والوقت مستقبل والفعل بلفظ الماضي ونحوه: { فوجد فيها رجلين يقتتلان }، [124] حكاية للحال، فكذلك يقوم زيد غدًا هو على التقرير والتصوير لهيئته إذا وقع، وهذا لأن الأصل أنه لا يحكم للفظين متغايرين بمعنى واحد إلا بدليل، ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل.
فائدة: حروف المضارعة
حروف المضارعة وإن كانت زوائد فقد صارت كأنها من أنفس الكلم، وليست كذلك السين وسوف وإن كانوا قد شبهوهما بحروف المضارعة والحروف الملحقة بالأصول، ولذلك تقول غدًا يقوم زيد فتقدم الظرف على الفعل، كما تفعل ذلك في الماضي الذي لا زيادة فيه، نحو أمس قام زيد ولا يستقيم هذا في المقرون بالسين وسوف لا تقول غدًا سيقوم زيد لوجوه.
منها: أن السين تنبىء عن معنى الاستئناف والاستقبال للفعل، وإنما يكون مستقبلًا بالإضافة إلى ما قبله. فإن كان قبله ظرف أخرجته السين عن الوقوع في الظرف فبقي الظرف لا عامل فيه فبطل الكلام. فإذا قلت: سيقوم غدًا، دلت السين على أن الفعل مستقبل بالإضافة إلى ما قبله، وليس قبله إلا حالة التكلم، ودل لفظ غدًا على استقبال اليوم فتطابقا وصارا ظرفًا له.
الثاني: أن السين وسوف من حروف المعاني الداخلة على الجمل ومعناها في نفس المتكلم، وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر عنه. فوجب أن يكون له صدر الكلام كحروف الاستفهام والنفي والنهي وغير ذلك، ولذلك قبح زيد سأضرب وزيد سيقوم. مع أن الخبر عن زيد، إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه السين. فإن ذلك المعنى مستند إلى المتكلم لا إلى زيد. فلا يجوز أن يخلط بالخبر عن زيد. فتقول: زيد سيفعل.
فإن أدخلت إن على الاسم المبتدأ، جاز دخول السين في الخبر لاعتماد الاسم على أن ومضارعتها للفعل، فصارت في اللفظ مع اسمها كالجملة التامة فصلح دخول السين فيم بعدها. وأما مع عدم أن فيقبح ذلك، وهذا مذهب أبي الحسن شيخ السهيلي. قال السهيلي: فقلت له: أليس قد قال الله تعالى: { والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات }، [125] فقال لي: اقرأ ما قبل الآية فقرأت: { إن الذين كفروا } [126] الآية. فضحك وقال: قد كنت أفزعتني أليست هذه إن في الجملة المتقدمة وهذه الأخرى معطوفة بالواو عليها، والواو تنوب مناب تكرار العامل فسلمت له وسكت.
قال: ونظير هذه المسألة مسألة اللام في إن تقول: إن زيدًا لقائم، ولا تقول زيد لقائم، والمصحح لتقديم الظرف على الفعل الماضي. أن معنى المضي مستفاد من لفظه لا من حرف زائد على الجملة منفصل عن الفعل كالسين وقد. وأما فعل الحال فزوانده ملحقة بالأصل، فإن أدخلت على الماضي قد التي للتوقع كانت بمنزلة السين التي للاستئناف، وقبح حينئذ أمس قد قام زيد، كما قبح غدًا يقوم زيد والعلة حذو النعل بالنعل.
فائدة: السين تشبه حروف المضارعة
السين تشبه حروف المضارعة، ونقرر قبل ذلك مقدمة وهي لم لم تعمل في الفعل وقد اختصت به؟
والجواب أنها فاصلة لهذا الفعل من فعل الحال، كما فصلت الزوائد الأربع فعل الحال عن الماضي فأشبهتها. وإن لم تكن مثلها في اتصالها ولحوقها بالأصل، كما أشبهت لام التعريف العلمية في اتصالها وتعرف الاسم بها. وإن لم تكن ملحقة بحروف الأصل. فلما لم تعمل تلك اللام في الأسماء مع اختصاصها بها، لم تعمل هذه في الأفعال مع استبدادها بها. هذا تعليل الفارسي في بعض كتبه وابن السراج والسهيلي وهو يحتاج إلى بيان وإيضاح.
وتقريره أن الحرف إذا نزل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل فيها، لأن أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض، ولام التعريف مع المعرف بمنزلة اسم علم، فنزلت منزلته جزئه.
و"قد" مع الماضي بمنزلة فعل الحال فنزلت منزلة جزئه. وأما الزوائد الأربع فهي فاصلة لفعل الحال عن الماضي فصارت مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الحال. وكذلك السين مع الفعل فاصلة للمستقبل عن الحال، فصارت مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الاستقبال. وهذا المعنى موجود في سوف أيضا. فاختصاص الحرف شرط عمله ونزوله منزلة الجزء مانع من العمل.
فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن المصدرية فإنها منزلة منزلة الجزء من الكلمة، ولهذا يصير الفعل بها في تأويل كلمة مفردة، ومع هذا فهي عاملة.
قيل: هذا لا ينقض ما أصلناه، لأن هذا الحرف لم ينزل منزلة الجزء من الفعل، وإنما صار به الفعل في تأويل الاسم فلم ينتقض ما ذكرناه.
وعلل السهيلي بطلان عمل سوف بعلة أخرى فقال: وأما سوف فحرف، ولكنه على لفظ السوف الذي هو الشم لرائحة ما ليس بحاضر، وقد وجدت رائحته. كما أن سوف هذه تدل على أن ما بعدها ليس بحاضر. وقد علم وقوعه وانتظر إيابه ولا غرو أن يتقارب معنى الحرف من معنى الاسم المشتق المتمكن في الكلام.
فهذه "ثم" حرف عطف ولفظها كلفظ الثم وهو زم الشيء بعضه إلى بعض. كما قال: كنا أهل ثمة وزمة، وأصله من ثممت البيت إذا كانت فيه فرج فسدد بالثمام، والمعنى الذي في ثم العاطفة قريب من هذا، لأنه ضم شيء إلى شيء بينهما مهلة. كما أن ثم البيت ضم بين شئين بينهما فرجة. ومن تأمل هذا المعنى في الحروف والأسماء المضارعة لها الفاه كثيرًا.
فائدة بديعة: دخول أن على الفعل
في دخول أن على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر ثلاث فوائد:
أحدها: أن المصدر فد يكون فيما مضى وفيما هو آت وليس في صيغته ما يدل عليه. فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع أن ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان.
الثانية: أن أن تدل على إمكان الفعل دون الوجوب والاستحالة.
الثالثة: أنها تدل على مجرد معنى الحدث دون احتمال معنى زائد عليه نفيها تحصين للمعنى من الإشكال وتخليص له من شوائب الاحتمال.
بيانه أنك إذا قلت: كرهت خروجك وأعجبني قدومك، احتمل الكلام معاني.
منها أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته وهيئاته وإن كان لا يوصف في الحقيقة بصفات، ولكنها عبارة عن الكيفيات.
واحتمل أيضا أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة من حالاته. فإذا قلت: أعجبني أن قدمت كانت أن على الفعل بمنزلة الطبايع. والصواب من عوارض الاجمالات المتصورة في الأذهان، وكذلك زادوا أن بعد لما في قولهم لما أن جاء زيد أكرمتك، ولم يزيدوها بغير ظرف سوى لما وذلك أن لما ليست في الحقيقة ظرف زمان، ولكنه حرف يدل على ارتباط الفعل الثاني بالأول، وأن أحدهما كالعلة للآخر بخلاف الظرف. إذا قلت: حين قام زيد قام عمرو فجعلت أحدهما وقتًا للآخر على اتفاق لا على ارتباط. فلذلك زادوا أن بعدها صيانة لهذا المعنى وتخليصًا له من الاحتمال العارض في الظرف، إذ ليس الظرف من الزمان بحرف فيكون قد جاء لمعنى كما جاءت لما.
وقد زعم الفارسي أنها مركبة من لم وما. قال السهيلي: ولا أدري ما وجه قوله، وهي عندي من الحروف التي في لفظها شبه من الاشتقاق وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منها نحو ما تقدم في سوف وثم لأنك تقول: لممت الشيء لما إذا ضممت بعضه إلى بعض. وهذا نحو من هذا المعنى الذي سيقت إليه، لأنه ربط فعل بفعل على جهة التسبيب أو التعقيب فإذا كان التسبيب حسن إدخال إن بعدها زائدة إشعارًا بمعنى المفعول من أجله. وإن لم يكن مفعولًا من أجله نحو قوله: { ولما جاءت رسلنا لوطًا }، [127] و { فلما أن جاء البشير }، [128] ونحوه وإذا كان التعقيب مجردًا من التسبيب لم يحسن زيادة إن بعدها وتأمله في القرآن. وأما أن التي للتفسير فليست مع ما بعدها بتأويل المصدر، ولكنها تشارك أن التي تقدم ذكرها في بعض معانيها لأنها تحصين لما بعدها من الاحتمالات وتفسير لما قبلها من المصادر المجملات التي في معنى المقالات والإشارات. فلا يكون تفسيرًا إلا لفعل في معنى التراجم الخمس الكاشفة عن كلام النفس، لأن الكلام القائم في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة يكشفه للمخاطبين خمسة أشياء: اللفظ والخط والإشارة والعقد والنصب وهي لسان الحال وهي أصدق من لسان المقال، فلا تكون أن المفسرة إلا تفسيرًا لما أجمل من هذه الأشياء. كقولك: كتبت إليه أن اخرج، وأشرت إليه أن اذهب، { نودي أن بورك من في النار }، [129] وأوصيته أن أشكر. وعقدت في يدي أن قد أخذت بخمسين. وزربت على حائطي أن لا يدخلوه. ومنه قول الله عز وجل: { ووضع الميزان * أن لا تطغوا في الميزان }، [130] هي ههنا لتفسير النصبة التي هي لسان الحال.
وإذا كان الأمر فيها كذلك، فهي بعينها التي تقدم ذكرها، لأنها إذا كانت تفسيرًا فإنما تفسر الكلام. والكلام مصدر فهي إذًا في تأويل مصدر إلا أنك أوقعت بعدها الفعل بلفظ الأمر والنهي وذلك مزيد فائدة ومزيد الفائدة لا تخرج الفعل عن كونه فعلًا. فلذلك لا تخرج عن كونها مصدرية كما لا يخرجها عن ذلك صيغة المضي والاستقبال بعدها. إذا قلت: يعجبني أن تقوم وإن قمت فكأنهم، إنما قصدوا إلى ماهية الحدث مخبرًا عن الفاعل لا الحدث مطلقًا، ولذلك لا تكون مبتدأة وخبرها في ظرف أو مجرور، لأن المجرور لا يتعلق بالمعنى الذي يدل عليه أن ولا الذي من أجله صيغ الفعل واشتق من المصدر، وإنما يتعلق المجرور بالمصدر نفسه مجردًا من هذا المعنى كما تقدم. فلا يكون خبرًا عن أن المتقدمة وإن كانت في تأويل اسم، وكذلك أيضا لا يخبر عنها بشيء مما هو من صفة للمصدر. كقولك: قيام سريع أو بطيء ونحوه. لا يكون مثل هذا خبرًا عن المصدر.
فإن قلت: حسن أن تقوم وقبح أن تفعل جاز ذلك، لأنك تريد بها معنى المفعول كأنك تقول: استحسن هذا، أو استقبحه، وكذلك إذا قلت: لأن تقوم خير من أن تقعد جاز لأنه ترجيح وتفصيل فكأنك تأمره بأن يفعل. ولست بمخبر عن الحدث بدليل امتناع ذلك في المضي، فإنك لا تقول: إن قمت خير من أن قعد، ولا إن قام زيد خير من أن قعد، وامتناع هذا دليل على ما قدمناه من أن الحدث هو الذي يخبر عنه.
وأما "أن" وما بعدها فإنها وإن كانت في تأويل المصدر فإن لها معنى زائدًا لا يجوز الإخبار عنه، ولكنه يراد ويلزم ويؤمر به. فإن وجدتها مبتدأة ولها خبر فليس الكلام على ظاهره كما تقدم.
وأما لن فهي عند الخليل مركبة من لا وأن، ولا يلزم ما اعترض عليه سيبويه من تقديم المفعول عليها، لأنه يجوز في المركبات ما لا يجوز في البسائط. واحتج الخليل بقول جابر الأنصاري وهو من شعراء الجاهلية:
فإن أمسك فإن العيش حلو ** إلي كأنه عسل مشوبُ
يرجى المرء ما لا أن يُلاقي ** وتعرضُ دون أبعده خطوبُ [131]
فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان بأن كما تقدم.
وكان ينبغي أن تكون جازمة كلم، لأنها حرف نفي مختص بالفعل فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى. وقد فعل ذلك بعض العرب فجزم بها حين لحظ هذا الأسلوب، ولكن أكثرهم ينصب بها مراعاة، لأن المركبة فيها مع لا. إذ هي من جهة الفعل وأقرب إلى لفظه فهي أحق بالمراعاة من معنى النفي. فرب نفي لا يجزم الأفعال، وذلك إذا لم يختص بها دون الأسماء والنفي في هذا الحرف، إنما جاءه من قبل لا وهي غير عاملة لعدم اختصاصها. فلذلك كان النصب بها أولى من الجزم على أنها قد ضارعت لم لتقارب المعنى واللفظ. حتى قدم عليها معمول فعلها فقالوا: زيدًا لن أضرب، كما قالوا: زيدًا لم أضرب.
ومن خواصها تخليصها الفعل للاستقبال بعد أن كان محتملًا للحال فأغنت عن السين وسوف. وجل هذه النواصب تخلص الفعل للاستقبال.
ومن خواصها أنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معنى النفي في حرف لا. إذا قلت: لا يقوم زيد أبدًا، وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني التي أرواحها يتفرس الفطن فيها حقيقة المعنى بطبعه وحسه كما يتعرف الصادق الفراسة صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته.
وقلت يومًا لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه: قال ابن جني: مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه، ثم أكشفه، فإذا هو كما ظننته أو قريبًا منه، فقال لي رحمه الله: وهذا كثيرًا ما يقع لي.
وتأمل حرف لا كيف تجدها لامًا بعدها ألف يمتد بها الصوت ما لم يقطعه ضيق النفس. فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها ولن يعكس ذلك. فتأمله فإنه معنى بديع.
وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله: { ولا يتمنونه أبدًا } [132] بحرف لا في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل فصار من صيغ العموم فانسحب على جميع الأزمنة. وهو قوله عز وجل: { إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت } [133] كأنه يقول: متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات، أو زمن من الأزمان. وقيل لهم: تمنوا الموت فلا يتمنونه أبدًا. وحرف الشرط دل على هذا المعنى وحرف لا في الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معنى النفي فيها.
وقال في سورة البقرة: { ولن يتمنوه } [134] فقصر من سعة النفي وقرب لأن قبله: { قل إن كانت لكم الدار الآخرة } [135] لأن إن وكان هنا ليست من صيغ العموم، لأن كان ليست بدالة على حدث وإنما هي داخلة على المبتدأ والخبر عبارة عن مضي الزمان الذي كان فيه ذلك الحدث فكأنه يقول عز وجل: إن كان قد وجبت لكم الدار الآخرة وثبتت لكم في علم الله فتمنوا الموت الآن. ثم قال في الجواب: ولن يتمنوه فانتظم معنى الجواب بمعنى الخطاب في الآيتين جميعًا.
وليس في قوله أبدًا ما يناقض ما قلناه. فقد يكون أبدًا بعد فعل الحال تقول: زيد يقوم أبدًا.
ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في لن وطوله في لا يعلم الموفق قصور المعتزلة في فهم كلام الله حيث جعلوا لن تدل على النفي على الدوام واحتجوا بقوله: { لن تراني }، [136] وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي. وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبًا عن فهم القرآن.
وتأمل قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار }، [137] كيف نفى الإدراك بلا الدالة على طول النفي ودوامه في أنه لا يدرك أبدًا وإن رآه المؤمنون فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن يحيط به مخلوق وكيف نفى الرؤية بلن فقال: { لن تراني } [138] لأن النفي بها لا يتأيد وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي بلن صريحًا بقوله وقالوا: { يا مالك ليقض علينا ربك }، [139] فهذا تمن للموت فلو اقتضت لن دوام النفي تناقض الكلام كيف وهي مقرونة بالتأبيد بقوله: { ولن يتمنوه أبدًا }، [140] ولكن ذلك لا ينافي تننيه في النار، لأن التأبيد قد يراد به التأبيد المقيد والتأبيد المطلق. فالمقيد كالتأبيد بمدة الحياة مقيد كقولك: والله لا أكلمه أبدًا والمطلق كقولك: والله لا أكفر بربي أبدًا. وإذا كان كذلك فالآية إنما اقتضت نفي تمني الموت أبد الحياة الدنيا، ولم يتعرض للآخرة أصلًا. وذلك لأنهم لحبهم الحياة وكراهتهم للجزاء لا يتمنون. وهذا منتف في الآخرة.
فهكذا ينبغي أن يفهم كلام الله لا كفهم المحرفين له عن مواضعه.
قال أبو القاسم السهيلي: على أني أقول إن العرب، إنما تنفي بلن ما كان ممكنًا عند المخاطب مظنونًا أن سيكون، فتقول له: لن يكون، لما ظًن أن يكون، لأن لن فيها معنى أن؛ وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظن كأنه يقول أيكون أم لا، قلت في النفي: لا [141] يكون، وهذا كله مقو لتركيبها من لا، وإن وتبين لك وجه اختصاصها في القرآن بالمواضع التي وقعت فيها دون لا.
فائدة: إذا الظرفية الشرطية
قولهم: إذن أُكرمك، قال السهيلي: هي عندي إذا الظرفية الشرطية خلع منها معنى الاسمية، كما فعلوا ذلك بإذا وبكاف الخطاب وبالضمائر المنفصلة، وكذلك فعلوا بإذا إلا أنهم زادوا فيها التنوين فذهبت الألف والقياس إذا وقفت عليها أن يرجع الألف لزوال العلة، وإنما نونوها لما فصلوها عن الإضافة إذ التنوين علامة الانفصال. كما فصلوها عن الإضافة إلى الجملة فيه فصار التنوين معاقبًا للجملة إلا أن إذ في ذلك الموضع لم تخرج عن الاسمية في نحو قوله: { ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون } [142] جعلها سيبويه ههنا حرفًا بمنزلة أن.
فإن قيل: ليس شيء من هذه الأشياء التي صيرت حروفًا بعد أن كانت اسمًا إلا وقد بقي فيها معنى من معانيها، كما بقي في كاف الخطاب معنى الخطاب وفي على معنى الاستعلاء. فما بقي في إذا إذًا من معانيها في حال الاسمية؟
فالجواب أنك إذا قلت: سأفعل كذا إذا خرج زيد. ففعلك مرتبط بالخروج مشروط به، وكذلك إذا قال لك القائل: قد أكرمتك. فقلت: إذا أحسن إليك ربطت إحسانك بإكرامه وجعلته جزاء له، فقد بقي فيها طرف من معنى الجزاء وهي حرف كما كان فيها معنى الجزاء وهو اسم.
وأما "إذ" من قوله: { إذ ظلمتم } [143] ففيها معنى الاقتران بين الفعلين. كما كان فيها ذلك في حال الظرفية تقول: لأضربن زيدًا إذ شتمني فهي وإن لم تكن ظرفًا ففيها معنى الظرف. كأنك تنبهه على أنك تجازيه على ما كان منه وقت الشتم، فإن لم يكن الضرب واقعًا في حال الشتم فله رد إليه وتنبيه عليه، فقد لاح لك قرب ما بينها وبين أن التي هي للمفعول من أجله، ولذلك شبهها سيبويه بها في سواد كتابه.
وعجبًا للفارسي حيث غاب ذلك عنه وجعلها ظرفًا، ثم تحيل في إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها وسوقه إليها.
وأما "إذ" فإذا كانت منونة فإنها لا تكون إلا مضافًا إليها ما قبلها ليعتمد على الظرف المضاف إليها فلا يزول عنها معنى الظرفية. كما زال عن أختها حين نونوها وفصلوها عن الفعل الذي كانت تضاف إليه، والأصل في هذا أن إذ وإذا في غاية من الإبهام والبعد عن شبه الأسماء والقرب من الحروف لعدم الاشتقاق وقلة حروف اللفظ وعدم التمكن وغير ذلك، فلولا إضافتها إلى الفعل الذي يبنى للزمان ويفتقر إلى الظروف لما عرف فيها معنى الاسم أبدًا إذ لا تدل واحدة منهما على معنى في نفسها إنما جاءت لمعنى في غيرها. فإذا قطعت عن ذلك المعنى تمحض معنى الحرف فيها إلا أن إذ لما ذكرنا من إضافة ما قبلها من الظرف إليها لم يفارقها معنى الاسم. وليست الإضافة إليها في الحقيقة، ولكن إلى الجملة التي عاقبها التنوين.
وأما إذن فلما لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما يعضد معنى الاسمية فيها صارت حرفًا لقربها من حروف الشرط في المعنى. ولما صارت حرفًا مختصًا بالفعل مخلصًا له للاستقبال لسائر النواصب للأفعال نصبوا الفعل بعده، إذ ليس واقعًا موقع الاسم فيستحق الرفع ولا غير واجب فيستحق الجزم فلم يبق إلا النصب. ولما لم يكن العمل فيها أصليًا لم تقو قوة أخوتها فألغيت تارة، وأعملت أخرى، وضعفت عن عوامل الأفعال.
فإن قيل: فهلا فعلوا بها ما فعلوا بإذ حين نونوها وحذفوا الجملة بعدها فيضيفوا إليها ظروف الزمان، كما يضيفونها إلى إذ في نحو يومئذ، لأن الإضافة في المعنى إلى الجملة التي عاقبها التنوين.
فالجواب أن إذ قد استعملت مضافة إلى الفعل في المعنى على وجه الحكاية للحال. كما قال تعالى: { ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب } [144] ولم يستعملوا إذا مضافة إلى الماضي بوجه ولا على الحال، فلذلك استغنوا بإضافة الظروف إلى إذ، وهم يريدون الجملة بعدها عن إضافتها إلى إذا، مع أن إذ في الأصل حرفان وإذا ثلاثة أحرف فكان ما هو أقل حروفًا في اللفظ أولى بالزيادة فيه، وإظافة الأوقات إليه زيادة فيه، لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد. وأقوى من هذا أن إذا فيها معنى الجزاء وليس في إذ منه رائحته فامتنع إضافة ظرف الزمان إلى إذا، لأن ذلك يبطل ما فيها من معنى الجزاء، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، فلو أضيف إليه والحين إليهما لغلب عليهما حكمه لضعفهما عن درجة حرف الجزاء فتأمله.
فائدة بديعة: لام كي ولام الجحود
لام كي والجحود حرفان ماضيان بإضمار أن إلا أن لام كي هي لام العلة فلا يقع فيها إلا فعل يكون علة لما بعدها. فإن كان ذلك الفعل منفيًا لم يخرجها عن أن تكون لام كي. كما ذهب إليه الصيمري، لأن معنى العلة فيها باق، وإنما الفرق بين لام الجحود ولام كي وذلك من ستة أوجه:
أحدها أن لام الجحود يكون قبلها كون منفي بشرط المضي. إما ما كان أو لم يكن لا مستقبلًا فلا تقول: ما أكون لأزورك، وتكون زمانية ناقصة لا تامة ولا يقع بعد اسمها ظرف ولا مجرور. لا تقول: ما كان زيد عندك ليذهب ولا أمس ليخرج فهذه أربعة فروق.
والذي يكشف لك قناع المعنى ويهجم بك على الغرض إن كان الزمانية عبارة عن زمان ماض فلا يكون علة لحادث، ولا يتعدى إلى المفعول من أجله، ولا إلى الحال وظروف المكان وفي تعديها إلى ظرف الزمان نظر. وهذا الذي منعها أن تقع قبلها لام العلة أو يقع بعدها المجرور أو الظرف.
وأما الفرق الخامس بين اللامين فهو أن الفعل بعد لام الجحود لا يكون فاعله إلا عائدًا على اسم كان، لأن الفعل بعدها في موضع الخبر فلا تقول: ما كان زيد ليذهب عمرو كما تقول: يا زيد ليذهب عمرو، أو لتذهب أنت، ولكن تقول: ما كان ليذهب وما كنت لأفعل.
والفرق السادس جواز إظهار أن بعد لام كي ولا يجوز إظهارها بعد لام الجحود، لأنها جرت في كلامهم نفيًا للفعل المستقبل بالسين أو سوف فصارت لام الجحود بإزائها فلم يظهر بعدها ما لا يكون بعدها.
وفي هذه النكتة مطلع على فوائد من كتاب الله ومرقاة إلى تدبره كقوله: { وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم } [145] فجاء بلام الجحد حيث كان نفيًا لأمر متوقع وسبب مخوف في المستقبل، ثم قال: { وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون } [146] فجاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب بالمستغفرين على العموم في الأقوال لا يخص مضيًا من استقبال. ومثله: { ما كان ربك ليهلك القرى }، [147] ثم قال: { وما كنا مهلكي القرى }، [148] فالحظ هذه الآية من مطلع الأخرى تجدها كذلك.
وأما لام العاقبة ويسمونها لام الصيرورة في نحو: { ليكون لهم عدوًا } [149] فهي في الحقيقة لام كي، ولكنها لم تتعلق بالخبر لقصد المخبر عنه وإرادته، ولكنها تعلقت بإرادة فاعل الفعل على الحقيقة وهو الله سبحانه أي فعل الله ليكون كذا وكذا. وكذلك قولهم: أعتق ليموت لم يعتق لقصد الموت، ولم بتعلق اللام بالفعل، وإنما المعنى قدر الله أنه يعتق ليموت فهي متعلقة بالمقدور وفعل الله. ونظيره إني أنسى لاسن ومن رواه أنسى بالتشديد فقد كشف قناع المعنى.
وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله، فإنها حيث وردت في الكلام فهي لجهل الفاعل لعاقبة فعله، كالتقاط آل فرعون لموسى فإنهم لم يعلموا عاقبته، أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة نحو "لدوا للموت وابنوا للخراب". فأما في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة. ومن هو على كل شيء قدير، فلا يكون قط إلا لام كي وهي لام التعليل.
ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء.
فائدة: نفي الماضي ونفي المستقبل
كما أن لن لنفي المستقبل كان الأصل أن يكون لا لنفي الماضي وقد استعملت فيه نحو: { فلا اقتحم العقبة } [150] ونحوه: * وأي عبد لك لا ألمّا * ولكن عدلوا في الأكثر إلى نفي الماضي بلم لوجوه:
منها أنهم خصوا المستقبل بلن. فأرادوا أن يخصوا الماضي بحرف، ولا لا تخص ماضيًا من مستقبل، ولا فعلًا من اسم. فخصوا نفي الماضي بلم.
ومنها أن "لا" يتوهم انفصالها مما بعدها، إذ قد تكون نافية لما قبلها ويكون ما بعدها في حكم الوجوب، مثل لا أقسم. حتى لقد قيل في قول عمر: "لا نقضي ما تجانفنا لإثم" إن لا رد لما قبلها ونقضي واجب لا منفي. وقال بعض الناس في قوله ﷺ: «لا ترآى ناراهما». أن لا رد وما بعدها واجب، وهذا خطأ في الأثرين وتلبيس لا يجوز حمل النصوص عليه. وكذلك: { لا أقسم بيوم القيامة } [151] أيضا، بل القول فيها أحد قولين، إما أن يقال هي للقسم وهو ضعيف. وإما أن يقال أقحمت أول القسم إيذانًا بنفي القسم عليه وتوكيدًا لنفيه كقول الصديق لاها الله لا تعمد إلى أسد من أسد الله الحديث.
ومما يدل على حرصهم على إيصال حرف النفي بما بعده قطعًا لهذا التوهم، إنما قلبوا لفظ الفعل الماضي بعد لم إلى لفظ المضارع حرصًا على الاتصال وصرفًا للوهم عن ملاحظة الانفصال.
فإن قيل: وأي شيء في لفظ المضارع مما يؤكد هذا المعنى، أو ليسا سواء هو والماضي؟
قلنا: لا سواء، فاعلم أن الأفعال مضارعة للحروف من حيث كانت عوامل في الأسماء كهي ومن هناك استحقت البناء، وحق العامل أن لا يكون مهيئًا لدخول عامل آخر عليه قطعًا للتسلسل الباطن. والفعل الماضي بهذه الصورة وهو على أصله من البناء ومضارعة الحروف العوامل في الأسماء فليس يذهب الوهم عند النطق به إلا إلى انقطاعه عما قبله إلا بدليل يربطه وقرينة تجمعه إليه. ولا يكون في موضع الحال البتة إلا مصاحبًا لقيد ليجعل هذا الفعل في موضع الحال.
فإن قلت: فقد يكون في موضع الصفتين النكرة، نحو مررت برجل ذهب.
قيل: افتقار النكرة إلى الوصف وفرط احتياجها إلى التخصيص تكملة لفائدة الخبر هو الرابط بين الفعل وبينها بخلاف الحال فإنها تجيء بعد استغناء الكلام وتمامه.
وأما كونه خبرًا للمبتدإ فلشدة احتياج المبتدأ إلى خبره جاز ذلك حتى أنك إذا أدخلت أن على المبتدأ بطل أن يكون الماضي في موضع الخبر إذ قد كان في خبرها اللام لما في الكلام من معنى الابتداء والاستئناف لما بعدها، فاجتمع ذلك مع صيغة الماضي وتعاونا على منع الفعل الماضي من أن يكون خبرًا لما قبلها، وليس ذلك في المضارع.
وليس المضارع كالماضي، لأن مضارعته للاسم هيأته لدخول العوامل عليه والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم وأخرجته عن شبه العوامل التي لها صدر الكلام وصيرته كالأسماء المعمول فيها، فوقع موقع الحال والوصف وموقع خبر المبتدأ وإن لم يقطعه دخول اللام عن أن يكون خبرًا في باب أن. كما قطع الماضي من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الكلام كما تقدم.
فإن قيل: فما وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال؟
قيل: دخول الزوائد ملحقة بالحروف الأصلية متضمنة لمعاني الأسماء كالمتكلم والمخاطب فما تضمن معنى الاسم أعرب كما بني من الأسماء ما تضمن معنى الحرف. ومع هذا فإن الأصل في دخول الزوائد شبه الأسماء وصلح فيها من الوجوه ما لا يصلح في الماضي.
فائدة بديعة: لام الأمر ولا الناهية
لام الأمر ولا في النهي وحروف المجازاة داخلة على المستقبل فحقها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي، ثم لم يوجد ذلك إلا لحكمة. أما حرف النهي فلا يكون فيه ذلك كي لا يلتبس بالنفي لعدم الجزم، ولكن إذا كانت لا في معنى الدعاء. جاز وقوع الفعل بعدها بلفظ الماضي، ثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه:
منها أنهم أرادوا أن يجمعوا التفاؤل مع الدعاء في لفظ واحد فجاءوا بلفظ الفعل الحاصل في معرض الدعاء تفاؤلًا بالإجابة، فقالوا: لا خيبك الله.
وأيضا: فالداعي قد تضمن دعاؤه القصد إلى إعلام السامع وإخبار المخاطب بأنه داع فجاءوا بلفظ الخبر إشعارًا بما تضمنه من معنى الاخبار نحو أعزك الله وأكرمك ولا رحم فلانًا. جمعت بين الدعاء والإخبار فإنك داع.
ويوضح ذلك أنك لا تقول هذا في حال مناجاتك الله ودعائك لنفسك لا تقول: رحمتني رب ورزقتني وغفرت لي كما تقول للمخاطب: رحمك الله ورزقك وغفر لك. إذ لا أحد في حال مناجاتك يقصد إخباره وإعلامه وإنما أنت داع وسائل محض.
فإن قيل: وكيف لم يخافوا اللبس كما خافوه في النهي.
قلنا: للدعاء هيبة ترفع الالتباس وذكر الله مع الفعل، ليس بمنزلة ذكر الناس فتأمله، فإنه بديع في النظر والقياس فقد جاءت أشياء بلفظ الخبر وهي في معنى الأمر والنهي. منها قول عمر: صلى رجل في كذا وكذا من اللباس. وقولهم: أنجز حر ما وعد. وقولهم: اتقى الله امرء. وهو كثير فجاء بلفظ الخبر الحاصل تحقيقًا لثبوته وإنه مما ينبغي أن يكون واقعًا ولا بد فلا يطلب من المخاطب إيجاده، بل يخبر عنه به ليحققه خبرًا صرفًا كالإخبار عن سائر الموجودات.
وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معنى من هذه وهو أن هذا إخبار محض عن وجوب ذلك واستقرار حسنه في العقل والشريعة والفطرة وكأنهم يريدون بقولهم أنجز حر ما وعد، أي ثبت ذلك في المروءة واستقر في الفطرة. وقول عمر صلى رجل في إزار ورداء الحديث أي هذا مما وجب في الديانة وظهر وتحقق من الشريعة، فالإشارة إلى هذه المعاني حسنت صرفه إلى صورة الخبر وإن كان أمرًا زائدًا لا يكاد يجيء الاسم بعده إلا نكرة لعموم هذا الحكم وشيوع النكرة في جنسها، فلو جعلت مكان النكرة في هذه الأفعال أسماء معرفة تمحض فيها معنى الخبر وزال معنى الأمر، فقلت: اتق الله زيد وأنجز عمر وما وعد فصار خبرًا لا أمرًا.
وهذا موضع المسألة المشهورة وهي مجيء الخبر بمعنى الأمر في القرآن في نحو قوله: { والوالدات يرضعن }، [152] { والمطلقات يتربصن }، [153] ونظائره. فمن سلك المسلك الأول جعله خبرًا بمعنى الأمر ومن سلك المسلك الثاني قال: بل هو خبر حقيقة غير مصروف من جهة الخبرية، ولكن هو خبر عن حكم الله وشرعه ودينه ليس خبرًا عن الواقع ليلزم ما ذكروه من الأشكال، وهو احتمال عدم وقوع مخبره، فإن هذا، إنما يلزم من الخبر عن الواقع، وأما الخبر عن الحكم والشرع فهو حق مطابق لمخبره لا يقع خلافه أصلًا.
وضد هذا مجيء الأمر بمعنى الخبر نحو قوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»، فإن هذا صورته صورة الأمر ومعناه معنى الخبر المحض، أي من كان لا يستحي فإنه يصنع ما يشتهي، ولكنه صرف عن جهة الخبرية إلى صورة الأمر لفائدة بديعة. وهي أن العبد له من حيائه آمر يأمره بالحسن وزاجر يزجره عن القبيح، ومن لم يكن من نفسه هذا الأمر لم تنفعه الأوامر، وهذا هو واعظ الله في قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي ﷺ ولا تنفع المواعظ الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن، فمن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ، فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحياء فهو مطيع لا محالة لداعي الغي، والشهوة طاعة لا انفكاك له منها. فنزل منزلة المأمور، وكأنه يقول: إذا لم تأتمر لأمر الحياء فأنت مؤتمر لأمر الغي والسفه وأنت مطيعه لا محالة. وصانع ما شئت لا محالة فأتي بصيغة الامر تنبيهًا على هذا المعنى ولو أنه عدل عنها إلى صيغة الخبر المحض. فقيل: إذا لم تستح صنعت ما شئت لم يفهم منها هذا المعنى اللطيف فتأمله. وإياك والوقوف مع كثافة الذهن وغلظ الطباع فإنها تدعوك إلى إنكار هذه اللطائف وأمثالها فلا تأتمر لها.
وأما وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط نحو: قم أكرمك أي أن تقم أكرمك. فقيل: حكمته أن صيغة الأمر تدل على الاستقبال فعدلوا إليها إيثارًا للخفة، وليست هذه العلة مطردة، فإن الأفعال المختصة بالمستقبل لا يحسن إقامة لفظ الأمر مقام أكثرها. نحوة سيقوم وسوف يقوم ولن تقوم وأريد أن يقوم، ولكن أحسن ما ذكروه أن يقال في قوله: قم اكرمك فائدتان ومطلوبان. أحدهما جعل القيام سببًا للإكرام ومقتضيًا له اقتضاء الأسباب لمسبباتها. والثاني كونه مطلوبًا للآمر مرادًا له. وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل فعدل عنه إلى لفظ الأمر تحقيقًا له، وهذا واضح جدًا.
وأما وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي مع أن الموضع للمستقبل، فقد علل بنحو هذه العلة. وإن الإرادة لا تدل على الاستقبال فعدلوا إلى الماضي، لأنه أخف وهي أيضا غير مطردة ولا مستقلة، ولو لم ينقض عليهم إلا بسائر الأدوات التي لا يكون الفعل بعدها إلا مستقبلًا. ومع ذلك لا يقع بلفظ الماضي.
وأحسن مما ذكروه أن يقال: عدل عن المستقبل هنا إلى صيغة الماضي إشارة إلى نكتة بديعة. وهي تنزيل الشرط بالنسبة إلى الجزاء منزلة الفعل الماضي، فإن الشرط لا يكون سابقًا للجزاء متقدمًا عليه فهو ماض بالإضافة إليه. ألا ترى أنك إذا قلت: إن اتقيت الله أدخلك جنته. فلا يكون إلا سابقًا على دخول الجنة فهو ماض بالإضافة إلى الجزاء فأتوا بلفظ الماضي تأكيدًا للجزاء وتحقيقًا، لأن الثاني لا يقع إلا بعد تحقق الأول ودخوله في الوجود، وأنه لا يكتفي فيه بمجرد العزم وتوطين النفس عليه الذي في المستقبل، بل لا سبيل إلى نيل الجزاء إلا بتقدم الشرط عليه وسبقه له. فأتي بالماضي لهده النكتة البديعة مع أمنهم اللبس بتحصين أداة الشرط لمعنى الاستقبال فيهما.
يبقى أن يقال فهذا تقرير حسن في فعل الشرط فما الذي حسن وقوع الجزاء المستقبل من كل وجه بلفظ الماضي إذا قلت: إن قمتَ قمتُ.
قيل: هذا سؤال حسن، وجوابه: أنهم أبرموا تلك الفائدة في فعل الشرط، قصدوا معها تحسين اللفظ ومشاكلة أوله لآخره وازدواجه واعتدال أجزائه، فأتوا بالجزاء ماضيًا لهذه الحكمة، فإن لفظتي الشرط والجزاء كالأخوين الشقيقين، وأنت تراهم يغيرون اللفظ عن جهته وما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة، فيقولون: أتيته بالغدايا والعشايا، ومأزورات غير مأجورات ونظائره. ألا ترى كيف حسن أن تزرني أزرك. وأن زرتني زرتك وقبح أن تزرني زرتك، وتوسط أن زرتني أزرك. فحسن إلا ولأن للمشاكلة، وقبح الثالث للمنافرة حتى منع منه أكثر النحاة وأجازه جماعة منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره، وهو الصواب لكثرة شواهده وصحة قياسه على الصورة الواقعة، وادعى أنه أولى منها. قال: لأن المستقبل في هذا الباب هو الأصل، والماضي فرع عليه. فإذا أجزتم أن يكون الماضي أولا والمستقبل بعده. فجواز الإتيان بالمستقبل الذي هو الأصل أولا والماضي بعده أولى.
والتقرير الذي قدمناه من كون الشرط سابقًا على الجزاء فهو ماضي بالنسبة إليه يدل على ترجيح قولهم: وإن زرتني أزرك أولى بالجواز من أن تزرني زرتك، والتقرير الذي قرره من جواز المستقبل هو الأصل في هذا الباب والماضي دخيل عليه، فإذا قدم الأصل كان أولى بالجواز، ترجح ما ذكره، فالترجيحان حق ولا فرق بين الصورتين، وكلاهما جائز هذا هو الإنصاف في المسألة والله أعلم.
ولكن هنا دقيقة تشير إلى ترجيح قول الجماعة وهي أن الفعل الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه والاعتماد عليه، فيكون هو مطلوب المعلق، وجعل الجزاء باعثًا ووسيلة إلى تحصيله وفي هذا الموضع يتأكد أو يتعين الإيتان فيه بلفظ المضارع الدال على أن المقصود منه أن يأتي به فيوقعه. وظهور القصد المعنوي إليه أوجب تأثير العمل اللفظي فيه ليطابق المعنى للفظ فيجتمع التأثيران اللفظي والمعنوي. والذي يدل على هذا أنهم قلبوا لفظ الفعل الماضي إلى المستقبل في الشرط لهذا المعنى حتى يظهر تأثير الشرط فيه واقتضاؤه له.
وإذا كان الكلام معتمدًا على الجزاء والقصد إليه والشرط جعل تابعًا ووسيلة إليه كان الإتيان فيه بلفظ الماضي حسنًا أو أحسن من المستقبل، فزن بهذه القاعدة ما يرد عليك من هذا الباب.
فمنه قوله تعالى: { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين }، [154] فانظر كيف جعل فعل الشرط ماضيًا والجزاء مستقبلًا، لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام، وعنايتهم كلها مصروفة، وهمهم معلقة به دون وقوع الأفعال بمشيئة الله تعالى. فإنهم لم يكونوا يشكون في ذلك ولا يرتابون.
وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرط. وهو إما نفس الجزاء على أصح القولين دليلًا كما تقدم تقريره، وإما دال على الجزاء وهو محذوف مقدر تأخيره وعلى القولين فتقدم الجزاء، أو تقديم ما يدل عليه اعتناء بأمره وتجريدًا للقصد إليه.
ويدل عليه أيضا تأكيده باللام المؤذنة بالقسم المضمر كأنه قيل: والله لتدخلن المسجد الحرام، فهذا كله يدلك على أنه هو المقصود المعنى به ومثل هذا قوله تعالى: { لئن شكرتم لأزيدنكم }، [155] ونحوه: { ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك } [156] ومثله: { لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله } [157] وهذا أصل غير منخرم، وفيه نكتة حسنة. وهي اعتماد الكلام في هذا النوع على القسم كما رأيت. فحسن الإتيان بلفظ الماضي إذ القسم أولى به لتحققه ولا يكون الإلغاء مستشنعًا فيه، لأنه مبني. ولما كان الفعل بعد حرف الجزاء يقع بلفظ الماضي لما ذكرناه من الفائدة حسن وقوع المستقبل المنفي بلم بعدها نحو، وان لم تنتهوا وهما جازمتان ولا يجتمع جازمان كما لا يجتمع في شيء من الكلام عاملان من جنس واحد، ولكن لما كان الفعل بعدها ماضيًا في المعنى وكانت متصلة به حتى كأن صيغته صيغة الماضي لقوة الدلالة عليه بلم جاز وقوعه بعد إن، وكان العمل والجزم لحرف لم، لأنها أقرب إلى الفعل وألصق به، وكان المعنى في الاستقبال لحرف إن، لأنها أولى وأسبق لكان اعتبارها في المعنى واعتبار لم في الجزم. ولا ينكر إلغاء إن هنا، لأن ما بعدها في حكم صيغة الفعل الماضي. كما لا ينكر إلغاؤها قبله.
وقد أجازوا في إن النافية من وقوع المستقبل بعدها بلفظ الماضي ما أجازوا في إن التي للشرط كما قال تعالى: { ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد } [158] ولو جعلت مكان إن ههنا غيرها من حروف النفي لم يحسن فيه مثل هذا، لأن الشرطية أصل للنافية كأن المجتهد في النفي، إذا أراد توكيده يقول: إن كان كذا وكذا فعلى كذا أو فأنا كذا، ثم كثر هذا في كلامهم حتى حذف الجواب وفهم القصد. فدخلت أن في باب النفي والأصل ما ذكرناه والله أعلم.
فائدة بديعة: المفرد والجمع وأسباب اختلاف علامات الجمع
في ذكر المفرد والجمع وأسباب اختلاف العلامات الدالة على الجمع واختصاص كل محل بعلامته ووقوع المفرد موقع الجملة وعكسه، وأين يحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه. وهذا فصل نافع جدا يطلعك على سر هذه اللغة العظيمة القدر، المفضلة على سائر لغات الأمم.
اعلم أن الأصل هو المعنى المفرد، وأن يكون اللفظ الدال عليه مفردًا؛ لأن اللفظ قالب المعنى، ولباسه يحتذى حذوه، والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى طولًا وقصرًا وخفة وثقلًا وكثرة وقلة وحركة وسكونًا وشدة ولينًا، فإن كان المعنى مفردًا أفردوا لفظه، وإن كان مركبًا ركبوا اللفظ، وإن كان طويلًا طولوه كالقطنط والعشنق للطويل، فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناه، وانظر إلى لفظ بحتر وما فيه من الضم والاجتماع لما كان مسماه القصير المجتمع الخلق، وكذلك لفظة الحديد والحجر والشدة والقوة ونحوها. تجد في ألفاظها ما يناسب مسمياتها، وكذلك لفظا الحركة والسكون مناسبتهما لمسمياتهما معلوم بالحس، وكذلك لفظ الدوران والنزوان والغليان، وبابه في لفظها من تتابع الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماها، وكذلك الدجال والجراح والضراب والأفاك في تكرر الحرف المضاعف، منها ما يدل على تكرر المعنى. وكذلك الغضبان والظمآن والحيران، وبابه صيغ على هذا البناء الذي يتسع النطق به ويمتلىء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني، فكان الغضبان هو الممتلىء غضبًا الذي قد اتسع غضبه حتى ملأ قلبه وجوارحه، وكذلك بقيتها.
ولا يتسع المقام لبسط هذا، فإنه يطول ويدق جدًا حتى تسكع عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته، فإنه ينشأ من جوهر الحرف تارة، وتارة من صفته. ومن اقترانه بما يناسبه ومن تكرره ومن حركته وسكونه. ومن تقديمه وتأخيره. ومن إثباته وحذفه. ومن قلبه وإعلاله إلى غير ذلك من الموازنة بين الحركات وتعديل الحروف وتوخي المشاكلة والمخالفة والخفة والثقل والفصل والوصل، وهذا باب يقوم من تتبعه سفر ضخم، وعسى الله أن يساعد على إبرازه بحوله وقوته.
ورأيت لشيخنا أبي العباس بن تيمية فيه فهمًا عجيبًا كان إذا انبعث فيه أتى بكل غريبة، ولكن كان حاله فيه كما كان كثيرًا يتمثل:
تألق البرق نجديًا فقلت له ** يا أيها البرق إني عنك مشغول
ولنذكر من هذا الباب مسألة واحدة وهي حال اللفظ في إفراده وتغييره عند زيادة معناها بالتثنية والجمع دون سائر مغيراته، فنقول: لما كان المفرد هو الأصل والتثنية والجمع تابعان له جعل لهما في الاسم علامة تدل عليهما، وجعلت آخره قضاء لحق الأصالة فيه، والتبعية فيهما والفرعية. فالتزموا هذا في التثنية ولم ينخرم عليهم.
وأما الجمع فإنهم ذهبوا به كل مذهب وصرفوه كل مصرف فمرة جعلوه على حد التثنية وهو قياس الباب، كالتثنية والنسب والتأنيث وغيرها، وتارة اجتلبوا له علامة في وسطه كالألف في جعافر والياء في عبيد والواو في فلوس. وتارة جعلوا اختصار بعض حروفه وإسقاطها علامة عليه نحو عنكبوت وعناكب، فإنه لما ثقل عليهم المفرد وطالت حروفه وازداد ثقلًا بالجمع خففوه بحذف بعض حروفه لئلا يجمعوا بين ثقلين، ولا يناقض هذا ما أصلوه من طول اللفظ لطول المعنى وقصره لقصره. فإن هذا باب آخر من المعادلة والموازنة. عارض ذلك الأصل ومنع من طرده.
ومنهم جمعهم فعيل وفعول وفعال على فعل، كرغيف وعمود وقذال على رغف وعمد وقذل لثقل المفرد بالمدة، فإن كان في واحده ياء التأنيث فإنها تحذف في الجمع. فكرهوا أن يحذفوا المدة فيجمعوا عليه بين نقيضين فقلبوا المدة ولم يحذفوها كرسالة ورسائل وصحيفة وصحائف، فجبروا النقص بالفرق لا أنهم تناقضوا.
وتارة يقتصرون على تغيير بعض حركاته فيجعلونها علامة لجمعه، كفلك وفلك وعبد وعبد. وتارة يجتلبون له لفظًا مستقلًا من غير لفظ واحدة كخيل وأيم وقوم ورهط ونحوه. وتارة يجعلون العلامة في التقدير والنية لا في اللفظ كفلك للواحد والجمع، فإن ضمة الواحد في النية كضمة قفل، وضمة الجمع كضمة رسل، وكذلك هجان ودلاص وأسمال وأعشار. مع أن غالب هذا الباب، إنما يأتي في الباب لحصول التمييز والعلامة بموصوفاتها، فلا يقع لبس ولا يكاد يجيء في غير الصفات إلا نادرًا جدًا. ومع هذا، فلا بد أن يكون لمفرده لفظ يغاير جمعه ويكون فيه لغتان، لأنهم علموا أنه يثقل عليهم. أما في الجر والنصب فلتوالي الكسرات. وأما في الرفع فيثقل الخروج من الكسرة إلى الضمة فعدلوا إلى جمع تكسيره ولا يرد هذا عليهم في راحمين وراحمون لفصل الألف الساكنة ومنعها من توالي الحركات فهو كمسلمين وقائمين، وكذلك عدلوا عن جمع فعل المضاعف من صفات العقلاء كفظ وبر، فلم يجمعوه جمع سلامة، ويقولون برون وفظون لئلا بشتبه بكلوب وسفود، لأنه برائبن فكسروه. وقالوا: أبرار، فلما جاءوا إلى غير المضاعف كصعب جمعوه جمع تصحيح، ولم يخافوا التباسًا، إذ ليس في الكلام فعلول، وصعفوق نادر. فتأمل هذا التفريق وهذا التصور الدال، على أن أذهانهم قد فاقت أذهان الأمم، كما فاقت لغتهم لغاتهم.
وتأمل كيف لم يجمعوا شاعرًا جمع سلامة مع استيفائه وشروطه. بل كسروه فقالوا: شعراء إيذانًا منهم بأن واحده على زنة فعيل فجمعوه جمعه كرحيم ورحماء لما كان مقصودهم المبالغة في وصفهم بالشعور.
ثم انظر كيف لم ينطقوا بهذا الوجه المقدر كراهية منهم لمجيئه بلفظ شعير وهو الحب المعروف. فأتوا بفاعل ولما لم يكن هذا المانع في الجمع قالوا شعراء.
فأما التثنية فإنهم ألزموها حالًا واحدًا، فالتزموا فيها لفظ المفرد، ثم زادوا عليه علامة التثنية، وقد قدمنا أن ألف التثنية في الأسماء أصلها ألف الاثنين في فعلا، وذكرنا الدليل على ذلك، فجاءت الألف في التثنية في الأسماء، كما كانت في فعلا علامة الاثنين، وكذلك الواو في جمع المذكر السالم علامة الجمع، نظير واو فعلوا، وتقدم أنك لا تجد الواو علامة للرفع في جميع الأسماء إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال أو ما هو في حكمها. ولما كانت الألف علامة الاثنين في ضمير من يعقل وغيره، كانت علامة التثنية في العاقل وغيره، كانت الألف أولى بضمير الاثنين لقرب التثنية من الواحد. وأرادوا أن لا يغيروا الفعل عن البناء على الفتح في الاثنين، كما كان ذلك في الواحد للقرب المذكور.
ولما كانت الواو ضمير العاقلين خاصة في فعلوا خصوها بجمع العقلاء في نحوهم مسلمون وقائمون، ولما كان في الواو من الضم والجمع ما ليس في غيرها خصوها بالدلالة على الجمع دون الألف.
وسر المسألة أنك إذا جمعت وكان القصد الى تعيين آحاد الجموع، وأنت معتمد الاخبار عن كل واحد منهم وسلم لفظ بناء الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه، فقلت: فعلوا وهم فاعلون وأكثر ما يكون هذا فيمن يعقل، لأن جميع ما لا يعقل من الأجناس يجري مجرى الأسماء المؤنثة المفردة كالثلة والأمة والجملة. فلذلك تقول: الثياب بيعت وذهبت. ولا تقول: بيعوا وذهبوا، لأنك تشير إلى الجملة من غير تعيين آحادها. هذا هو الغالب فيما لا يعقل إلا ما أجرى مجرى العاقل.
وجاءت جموع التكسير معتبرًا فيها بناء الواحد جارية في الإعراب مجراه حيث ضعف الاعتماد على كل واحد بعينه وصار الخبر كأنه عن الجنس الكبير الجاري في لفظه مجرى الواحد، وكذلك جمعوا ما قل عدده من المؤنث جمع السلامة، وإن كان ما لا يعقل نحو الثمرات والسمرات. إلا أنهم لم يجمعوا المذكر منه، وإن قل عدده إلا جمع تكسير، لأنهم في المؤنث لا يزيدوا غير ألف فرقًا بينه وبين الواحد. وأما التاء فقد كانت موجودة في الواحدة، وفي وصفها، وإن كثر جمعوه جمع تكسير، كالمذكر، فإذا كانوا في الجمع القليل فيسلمون لفظ الواحد من أجل الاعتماد في إسناد الخبر على أفراده. فما ظنك به في الاثنين إذا ساغ لهم ذلك في الجمع الذي هو على حدها لقربه منها، فلهذا لا تجد التثنية في العاقل وغيره، إلا على حد واحد، وكذلك ضمير الاثنين في الفعل.
وإذا علم هذا، فحق العلامة في تثنية الأسماء أن يكون على حدها في علامة الإضمار، وأن تكون ألفًا في كل الأحوال.
وكذلك فعلت طوائف من العرب وهم خثعم وطي وبنو الحرث بن كعب وعليه جاءت في قول محققي النحاة: إن هذان لساحران. وأما أكثر العرب فإنهم كرهوا أن يجعلوه كالاسم المبني والمقصور من حيث كان الإعراب قد ثبت في الواحد، والتثنية طارئة على الإفراد، وكرهوا زوال الألف لاستحقاق التثنية لها، فتمسكوا بالأمرين فجعلوا الياء علامة الجر وشركوا النصب معه لما علمت من تعليل النحاة. فكان الرفع أجدر بالألف لا سيما وهي في الأصل، علامة إضمار الفاعل وهي في تثنية الأسماء علامة رفع الفاعل أو ما ضارعه وقام مقامه.
وأما الواو فقد فهمت اختصاصها بالجمع واستحقاق الرفع لها بما قررناه في الألف، ولكنهم حولوا إلى الياء في الجر لما ذكرنا في ألف التثنية. ومتى انقلبت الواو ياء فكأنها، إذ لم يفارقها المد واللين فكأنهما حرف واحد، والانقلاب فيهما يعتبر حال لا تبديل، ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى بالقلب لا بالإبدال. ويقولون في تاء تراث وتخمة وتجاه: إنها بدل من الواو.
فإن قيل: فإذا كان بعض العرب قد جعل التثنية بالألف في كل حال فهلا جعلوا الجمع بالواو في جمع أحواله.
قيل: إن الألف منفردة في كثير من أحكامها عن الواو والياء، والياء والواو أختان فكأنهم لما قلبوها ياء في النصب لم يبعدوا عن الواو، بخلاف الألف فإنهم إذا قلبوها ياء بعدوا عنها.
فإن قيل: فما بال سنين ومئين وبابهما جمع على حد التثنية، وليس من صفات العاقلين ولا أسمائهم.
قيل: إن هذا الجمع لا يوجد إلا فيما كملت فيه أربعة شروط.
أحدها: أن يكون معتل اللام.
الثاني: أن لا يكون المحذوف منه غير حرف مد ولين.
الثالث: أن يكون مؤنثًا.
الرابع: أن لا يكون له مذكر.
فخرج من هذا الضابط شفة، لأن محذوفها هاء. وكذا شاه وعضه وخرج منه أمة، لأن لها مذكرًا وإن لم يكن على لفظها، فقالوا في جمعها أموات ولم يجمعوه جمع سنين كيلا يظن أنه جمع المذكر، إذ كان له مذكر فجمعوا هذا الباب جمع سلامة من أجل أنه مؤنث. والمؤنث يجمع جمع سلامة وأن لم يكن على هذا اللفظ، فلما حصل فيه جمع السلامة بالقياس الصحيح وكانت عادتها رد اللام المحذوفة في الجموع، وكانت اللام المحذوفة واوًا أو ياء أظهر في الجمع السالم لها ياء أو واو ولم يكن في الواحد، وساق القياس إليها سوقًا لطيفًا حتى حصلت له بعد أخذها منه. فما أشبه حال هذا الاسم بحال من أخذ الله منه شيئًا، وعوضه خيرًا منه. وأين الواو والياء الدالة على جمع أولى العلم من ياء أو واو لا تدل على معنى البتة.
فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه في الكتب والألسنة.
ثم انظر كيف كسروا السين من سنين لئلا يلتبس بما هو على وزن فعول من أوزان المبالغة. فلو قالوا: سنون بفتح السين لالتبس بفعول من سن يسن. فكان كسر السين تحقيقًا للجمع، إذ ليس في الكلام اسم مفرد على وزن فعيل وفعول بكسر الفاء.
فإن قيل: فما أنت صانع في الأرضين.
قيل: ليست الأرض في الأصل كأسماء الأجناس مثل ماء وحجر وتمر، ولكنها لفظة جارية مجرى المصدر فهي بمنزلة السفل والتحت وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعلو، ولكنها وصف بها هذا المكان المحسوس فجرت مجرى امرأة زور وضيف، ويدل على هذا قول الراجز: * ولم يقلب أرضها البيطار * يصف قوائم فرس، فأفرد اللفظ وإن كان يريد ما هو جمع في المعنى.
فإذا كانت بهذه المنزلة فلا معنى لجمعها، كما لا يجمع الفوق والتحت والعلو والسفل. فإن قصد المخبر إلى جزء من هذه الأرض الموطوءة وعين قطعة محدودة منها خرجت عن معنى السفل الذي هو في مقابلة العلو، حيث عين جزءًا محسوسًا منها. فجاز على هذا أن يثنى إذا ضممت إليه جزءًا آخر، فتقول: رأيت أرضين. ولا تقول للواحدة: أرضة، كما تقول في واحد التمرة: تمرة، لأن الأرض ليس باسم جنس كما تقدم.
ولا يقال أيضا: أرضة من حيث قلت: ضربة وجرحة، لأنها في الأصل تجري مجرى السفل والتحت، ولا يتصور في العقول أن يقال: سفله وتحته كما يتصور ذلك في بعض المصادر، فلما لم يمكنهم أن يجمعوا أرضًا على أرضات من حيث رفضوا أرضه، ولا أمكنهم أن يقولوا آرض ولا آراض من حيث لم يكن مثل أسماء الأجناس كصخر وكلب وكانوا قد عينوا مجزوءًا محدودًا، فقالوا فيه: أرض وفي تثنيته أرضان لم يستكثروا إذا أضافوا إلى الجزأين بالياء، ورابعًا أن يجمعوه على حد التثنية فقد تقدم السر في الجمع الذي على حد التثنية وأنه مقصود إلى آحاده على التعيين، فإن أرادوا الكثرة والجمع الذي لا يتعين آحاده كأسماء الأجناس لم يحتاجوا إلى الجمع، فإن لفظ أرض يأتي على ذلك كله، لأنها كلها بالإضافة إلى السماء تحت وسفل فعبر عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظًا ومعنى، وكأنه وصف لذاتها لا عبارة عن عينها وحقيقتها إذ يصلح أن يعبر به عن كل ماله فوق وهو بالإضافة إلى ما يقابله سفل كما تقدم فسماء كل شيء أعلاه وأرضه أسفله، وتأمل كيف جاءت مجموعة في قول النبي ﷺ: «طوقه من سبع أرضين» لما اعتمد الكلام على ذات الأرضين وأنفسها على التفصيل والتعيين لآحادها دون الوصف لها بتحت، أو سفل في مقابلة فوق وعلو فتأمله.
فإن قلت: فلم جمعوا السماء فقالوا: سموات وهلا راعوا فيها ما راعوا في الأرض فإنها مقابلة فما الفرق بينهما؟
قيل: بينهما فرقان فرق لفظي وفرق معنوي.
أما اللفظي فإن الأرض على وزن ألفاظ المصادر الثلاثة وهو فعل كضرب، وأما السموات كان نظيرها في المصادر التلاء والجلاء فهي بأبنية الأسماء أشبه، وإنما الذي يماثل الأرض في معناها ووزنها السفل والتحت وهما لا يثنيان ولا يجمعان، وفي مقابلتهما الفوق والعلو، وهما كذلك لا يجمعان على أنه قد قيل: إن السموات ليس جمع سماء، وإنما هي جمع سماوة، وسماوة كل شيء أعلاه. وأما جمع سماء فقياسه اسمية كأكسية وأغطية أو (سماءات [159] في المسلَّم).
وليس هذا بشيء، فإن السماوة هي أعلا الشيء خاصة ليست باسم لشيء عال، وإنما هي اسم لجزئه العالي. وأما السماء فاسم لهذا السقف الرفيع بجملته، فالسموات جمعه لا جمع أجزاء عالية منه على أنه كل عال.
وأحسن من هذا الفرق أن يقال: لو جمعوا أرضًا على قياس جموع التكسير، لقالوا: آرض كأفلس أو آراض كأجمال أو آروض كفلوس فاستثقلوا هذا اللفظ. إذ ليس فيه من الفصاحة والحسن والعذوبة ما في لفظ السموات وأنت تجد السمع ينبو عنه بقدر ما يستحسن لفظ السموات، ولفظ السموات يلج في السمع بغير استئذان لنصاعته وعذوبته. ولفظ الأراضي لا يأذن له السمع إلا على كره، ولهذا تفادوا من جمعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ تدل على التعدد كما قال تعالى: { خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن }، [160] كل هذا تفاديًا من أن يقال أراض وآرض.
وأما الفرق المعنوي فإن الكلام متى اعتمد به على السماء المحسوسة التي هي السقف وقصد به إلى ذاتها دون معنى الوصف صح جمعها جمع السلامة، لأن العدد قليل، وجمع السلامة بالقليل أولى لما تقدم من قربه من التثنية القريبة من الواحد. ومتى اعتمد الكلام على الوصف ومعنى العلا والرفعة جرى اللفظ مجرى المصدر الموصوف به في قولك: قوم عَدل وزور.
وأما الأرض فأكثر ما تجيء مقصودًا بها معنى التحت والسفل دون أن يقصد ذواتها وأعدادها. وحيث جاءت مقصودًا بها الذات والعدد أتى بلفظ يدل على البعد كقوله: { ومن الأرض مثلهن }.
وفرق ثان وهو أن الأرض لا نسبة لها إلى السموات وسعتها، بل هي بالنسبة إليها كحصاة في صحراء فهي وإن تعددت وتكبرت فهي بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل فاختير لها اسم الجنس.
وفرق ثالث أن الأرض هي دار الدنيا التي بالإضافة إلى الآخرة، كما يدخل الإنسان أصبعه في اليم فما تعلق بها هو مثال الدنيا من الآخرة، والله سبحانه لم يذكر الدنيا إلا مقللًا لها محقرًا لشأنها.
وأما السموات فليست من الدنيا هذا على أحد القولين في الدنيا فإنه اسم للمكان فإن السموات مقر ملائكة الرب تعالى ومحل دار جزائه ومهبط ملائكته ووحيه، فإذا اعتمد التعبير عنها عبر عنها بلفظ الجمع. إذ المقصود ذواتها لا مجرد العلو والفوق، وأما إذا أريد الوصف الشامل للسموات وهو معنى العلو والفوق أفردوا ذلك بحسب ما يتصل به من الكلام والسباق فتأمل. قوله: { أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور }، [161] { أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا }، [162] كيف أفردت هنا، لما كان المراد الوصف الشامل والفوق المطلق ولم يرد سماء معينة مخصوصة، ولما لم تفهم الجهمية هذا المعنى أخذوا في تحريف الآية عن مواضعها.
وكذا قوله تعالى: { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء } [163] بخلاف قوله في سبأ: { عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض }، [164] فإن قبلها ذكر سبحانه سعة ملكه ومحله، وهو السموات كلها والأرض، ولما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي أفردها إرادة للجنس.
وتأمل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى: { وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم }، [165] فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة وهي تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلهية. فالمعنى وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السموات ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود، فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد.
ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بها، [166] فقال: الوقف التام على السموات ثم يبتدىء بقوله: { وفي الأرض يعلم }، [167] وغلط في فهم الآية. وإن معناها ما أخبرتك به، وهو قول محققي أهل التفسير. [168]
وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: { فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون }، [169] إرادة لهذين الجنسين أي رب كل ما علا وكل ما سفل، فلما كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم الشامل لكل ما يسمى سماء وكل ما يسمى أرضًا، وهو أمر حقيقي لا يتبدل ولا يتغير. وإن تبدلت عين السماء والأرض. فانظر كيف جاءت مجموعة في قوله: { يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض } [170] في جميع الصور. لما كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم وتباين مراتبهم لم يكن بد من جمع محلهم.
ونظير هذا جمعها في قوله: { وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون }، [171] وكذلك جاءت في قوله: { تسبح له السموات السبع }، [172] مجموعة إخبارًا بأنهاى تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددها، وأكد هذا المعنى بوصفها بالعدد ولم يقتصر على السموات فقط، بل قال: السبع.
وانظر كيف جاءت مفردة في قوله: { وفي السماء رزقكم وما توعدون } [173] فالرزق المطر وما وعدنا به الجنة وكلاهما في هذه الجهة لا أنهما في كل واحدة واحدة من السموات فكان لفظ الأفراد أليق بها.
ثم تأمل كيف جاءت مجموعة في قوله: { قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله }، [174] لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها مجموعة.
وتأمل كيف لم يجىء في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت. لما لم يكن المراد نزوله من ذات السماء بنفسها، بل المراد الوصف.
وهذا باب قد فتحه الله لي ولك، فلجه وانظر إلى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه جمعًا له إفرادًا وتقديمًا وتأخيرًا إلى غير ذلك من أسراره فلله الحمد والمنة لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه.
فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس: { قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار } [175] وبين قوله في سورة سبأ: { قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله }؟ [176]
قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقًا فتدبر السياق تجده نقيضًا لما وقع، فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به، ولم يمكنهم إنكاره من كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم وغيرها، ومخرج الحي من الميت، والميت من الحي. فلما كانوا مقرين بهذا كله، حسن الاحتجاج به عليهم. إن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره، فكيف يعبدون معه غيره ويجعلون له شركاء لا يملكون شيئًا من هذا ولا يستطيعون فعل شيء منه. ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى: { فسيقولون الله } [177] أي لا بد أنهم يقرون بذلك، ولا يجحدونه، فلا بد أن يكون المذكور مما يقرون به.
والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء حتى تنتهي إليهم ولم يصل علمهم إلى هذا. فأفردت لفظ السماء هنا فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منها، لا سيما والرزق ههنا إن كان هو المطر فمجيئه من السماء التي هي السحاب، فإنه يسمى سماء لعلوه.
وقد أخبر سبحانه أنه بسط السحاب في السماء بقوله: { الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء } [178] والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك، وهذا معلوم بالحس فلا يلتفت إلى غيره. فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم، لم يصلح فيه إلا إفراد السماء لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية، وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية. فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف والموارد الربانية والتنزلات الإلهية، وما به قوام العالم العلوي والسفلي من أعظم أنواع الرزق، ولكن القوم لم يكونوا مقرين به فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم، بحيث لا يمكنهم إنكاره.
وأما الآية التي في سبأ فلم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من السموات ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها ولم يذكر عنهم أنهم المجيبون المقرون فقال: { قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله } [179] ولم يقل: سيقولون الله فأمر تعالى نبيه ﷺ أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه، ومنافعه من السموات السبع. وأما الأرض فلم يدع السياق إلى جمعها في واحدة من الاثنين إذ يقربه كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر.
ومن هذا الباب ذكر الرياح في القرآن جمعًا ومفردة فحيث كانت في سياق الرحمة أتت مجموعة وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة، وسر ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب والمنافع، وإذا هاجت منها ريح أنشأ لها ما يقابلها ما يكسر سورتها ويصدم حدتها، فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات، فكل ريح منها في مقابلها ما يعد لها ويرد سورتها فكانت في الرحمة ريحًا، وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد وحمام واحد لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غيرها، حتى تنتهي إلى حيث أمرت لا يرد سورتها ولا يكسر شرتها، فتمتثل ما أمرت به، وتصيب ما أرسلت إليه. ولهذا وصف سبحانه الريح التي أرسلها على عاد بأنها عقيم فقال: { أرسلنا عليهم الريح العقيم }، [180] وهي التي لا تلقح ولا خير فيها، والتي تعقم ما مرت عليه.
ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله في سورة يونس: { هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف }، [181] فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الأفراد، لأن تمام الرحمة هناك، إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافها، فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد سيرها. فإذا اختلف عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو سبب الهلاك. فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح، وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيب دفعًا لتوهم أن تكون ريحًا عاصفة، بل هي مما يفرح بها لطيبها فلينزه الفطن بصيرته في هذه الرياض المونقة المعجبة التي ترقص القلوب لها فرحًا، ويتغذى بها عن الطعام والشراب والحمد لله الفتاح العليم. فمثل هذا الفصل يعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر فإنه يشرف بك على أسرار عجائب تجتنيها من كلام الله. والله الموفق للصواب.
ومما يدخل في هذا الباب جمع الظلمات وإفراد النور وجمع سبل الباطل، وإفراد سبل الحق وجمع الشمائل وإفراد اليمين.
أما الأول فكقوله: { الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور }. [182]
وأما الثاني فكقوله: { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله }. [183]
وأما الثالث فكقوله: { يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل }. [184]
والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة، وسر ذلك والله أعلم أن طريق الحق واحد وهو على الواحد للأحد، كما قال تعالى: { هذا صراط علي مستقيم }، [185] قال مجاهد: الحق طريقه على الله ويرجع إليه كما يقال: طريقك علي، ونظيره قوله: { وعلى الله قصد السبيل } [186] في أصح القولين أي السبيل القصد الذي يوصل إلى الله وهي طريق عليه. قال الشاعر:
فهن المنايا أي واد سلكنه ** عليها طريقي أو علي طريقها
وقد قررت هذا المعنى وبينت شواهده من القرآن، وسر كون الصراط المستقيم على الله، وكونه تعالى على الصراط المستقيم كما في قول هود: { إن ربي على صراط مستقيم في كتاب التحفة المكية. [187]
والمقصود أن طريق الحق واحد إذ مرده إلى الله الملك الحق، وطرق الباطل متشعبة متعددة فإنها لا ترجع إلى شيء موجود ولا غاية لها يوصل إليها، بل هي بمنزلة بنيات الطريق. وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود، فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحد.
ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل والنور بمنزلة طريق الحق، بل هما هما أفرد النور وجمعت الظلمات وعلى هذا جاء قوله: { الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات }، [188] فوحد ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد، وجمع الذين كفروا لتعددهم وكثرتهم، وجمع الظلمات وهي طرق الضلال، وألغي لكثرتها واختلافها، ووحد النور وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه.
ولما كانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون أفردت. ولما كانت الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت في قوله: { عن اليمين والشمائل }. [189]
فإن قيل: فهلا كذلك في قوله: { وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال }، [190] وما بالها جاءت مفردة؟
قيل: جاءت مفردة لأن المراد أهل هذه الجهة ومصيرهم ومآلهم إلى جهة واحدة وهي جهة الشمال مستقر أهل النار، والنار من جهة الشمال فلا يحسن مجيئها مجموعة، لأن الطرق الباطلة وإن تعددت، فغايتها المرد إلى طريق الجحيم وهي جهة الشمال، وكذلك مجيئها مفردة في قوله: { عن اليمين وعن الشمال قعيد } [191] لما كان المراد أن لكل عبد قعيدين: قعيدًا عن يمينه، وقعيدًا عن شماله، يحصيان عليه الخير والشر، فلكل عبد من يختص بيمينه وشماله من الحفظة، فلا معنى للجمع ههنا، وهذا بخلاف قوله تعالى حكاية عن إبليس: { ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم }، [192] فإن الجمع هنا في مقابلة كثرة من يريد إغواءهم، فكأنه أقسم أن يأتي كل واحد واحد من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله ولا يحسن هنا عن يمينهم وعن شمالهم. بل الجمع ههنا من مقابلة الجملة بالجملة المقتضي توزيع الأفراد ونظيره: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق }. [193]
وقد قال بعض الناس: إن الشمائل، إنما جمعت في الظلال وأفرد اليمين، لأن الظل حين ينشأ أول النهار يكون في غاية الطول، يبدو كذلك ظلأً واحدًا من جهة اليمين، ثم يأخذ في النقصان. وأما إذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد شيئًا فشيئًا. والثاني منه غير الأول، فلما زاد منه شيئًا فهو غير ما كان قبله، فصار كل جزء منه كأنه ظل، فحسن جمع الشمائل في مقابلة تعدد الظلال، وهذا معنى حسن.
ومن هذا المعنى مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة مجموعين، وتارة مثنيين، وتارة مفردين لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك. فالأول كقوله: { فلا أقسم برب المشارق والمغارب }، [194] والثاني كقوله: { رب المشرقين ورب المغربين * فبأي آلاء ربكما تكذبان }، [195] والثالث كقوله: { رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا }، [196] فتأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية بحسب موادها. يطلعك على عظمة القرآن وجلالته، وأنه تنزيل من حكيم حميد.
فحيث جمعت كان المراد بها مشارق الأرض ومغاربها في أيام السنة وهي متعددة، وحيث أفردا كان المراد أفقي المشرق والمغرب، وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهما. فإنها تبتدىء صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعها، فهذا مشرق صعودها، وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء. فجعل مشرق صعدوها بجملته مشرقًا واحدًا، ومشرق هبوطها بجملته مشرقًا واحدًا، ويقابلها مغرباها. فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع.
وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أر أحدًا تعرض له ولا فتح بابه وهو بحمد الله بين من السياق، فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن، لما كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات، فذكر أولا نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعظيم، ثم ذكر سراجي العالم ومظهري نوره: وهما الشمس والقمر، ثم ذكر نوعي النبات ما قام منه على ساق، وما انبسط منه على وجه الأرض: وهما النجم والشجر، ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة، والأرض الموضوعة وأخبر أنه رفع هذه، ووضع هذه، ووسط بينما ذكر الميزان، ثم ذكر العدل والظلم في الميزان فأمر بالعدل ونهى عن الظلم، ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض وهما الحبوب والثمار، ثم ذكر خلق نوعي المكلفين وهما: نوع الإنسان ونوع الجان، ثم ذكر نوعي المشرقين ونوعي المغربين، ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب.
فتأمل حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك، وقدر موضعهما اللفظ مفردًا ومجموعًا، تجد السمع ينبو عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم.
ثم تأمل ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر الليل والنهار فأمر رسوله بقيام الليل، ثم أخبره أن له في النهار سبحًا طويلًا. فلما تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه وذكر النهار وما يكون منه فيه عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب الذين هما مظهر الليل والنهار. فكان ورودهما مفردين في هذا السياق أحسن من التثنية والجمع، لأن ظهور الليل والنهار هما واحد فالنهار أبدًا يظهر من المشرق والليل أبدًا يظهر من المغرب، ثم تأمل مجيئهما مجموعين في سورة المعارج في قوله: { فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون * على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين }، [197] لما كان هذا القسم في سياق سعة ربوبيته وإحاطة قدرته والمقسم عليه أرباب هؤلاء، والإتيان بخير منهم ذكر المشارق والمغارب لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة، ونقله سبحانه لها، وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب. فمن فعل هذا، كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم؟
وأيضا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهور، وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا لتبدل أجسام النبات، وأحوال الحيوانات وانتقالها من حال إلى غيره، ويبدل الحر بالبرد. والبرد بالحر. والصيف بالشتاء، والشتاء بالصيف إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والثلوج، وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم. بسبب اختلاف مشارق الشمس ومغاربها. كان ذلك تقدير العزيز العليم. فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خيرًا منهم؟ وأكد هذا المعنى بقوله: { وما نحن بمسبوقين } فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظة الجمع.
ثم تأمل كيف جاءت أيضا في سورة الصافات مجموعة في قوله: { رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق } [198] لما جاءت مع جملة المربوبات المتعددة وهي السموات والأرض وما بينهما. كان الأحسن مجيئها مجموعة لينتظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد، ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب لاقتضاء الحال، لذلك فإن المشارق مظهر الأنوار وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه ومعاشه وانبساطه فهو إنشاء مشهود، فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث، ثم ذكر تعجب بنيه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت، ثم قدر الموت وحالهم فيه وكان الاقتصار على ذكر المشارق ههنا في غاية المناسبة للغرض المطلوب والله أعلم.
فائدة: علامة التثنية والجمع
إنما ظهرت علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد، لأن الفعل يدل على فاعل مطلق ولا يدل على تثنية ولا جمع، لأنهما طارئان على الأفراد وهو الأصل. ففعل الواحد مستغن عن علامة الإضمار لعلم السامع أن له فاعلًا، ولا كذلك في التثنية والجمع لأن السامع لا يعلم أن الفاعل مثنى ولا مجموع.
فإن قيل: فما معنى استتار الضمير في الفعل وهو حروف مركبة من حركات اللسان، فكيف يستتر فيها شيء أو يظهر؟
قيل: أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح، إذ مقصودهم التقريب على المتعلمين.
والتحقيق أن الفاعل مضمر في نفس المتكلم، ولفظ الفعل متضمن له دال عليه، واستغني عن إظهاره لتقدم ذكره، وعبر عنه بلفظ مضمر ولم يعبر عنه بمحذوف، لأن المضمر هو المستتر فهو مضمر في النية مخفي في الخلد، والإضمار هو الإخفاء.
فإن قيل: فهلا سموا ما حذفوه لفظًا وأرادوا نيته مضمرًا مثل الغاية في قولك، الذي رأيت زيد، وما الفرق بينهما وبين زيد قام؟
قيل: الضمير في زيد قام. لم ينطق به، ثم حذف، ولكنه مضمر في الإرادة، ولا كذلك الضمير المحذوف للعلم به، لأنه قد لفظ به في النطق، ثم حذف تخفيفًا. فلما كان قد لفظ به، ثم قطع من اللفظ تخفيفًا. عبر عنه بالحذف، والحذف هو القطع من الشيء فهذا هو الفرق بينهما.
فائدة بديعة: تقدم علامة التثنية والجمع للفعل
لحاق علامة التثنية والجمع للفعل مقدمًا، جاء في لغة قوم من العرب حرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى، إذ كانوا يسمون بالتثنية والجمع نحو فلسطين وقنسرين وحمدان وسلمان مما يشبه لفظه لفظ المثنى والجمع، فهذا ونحوه دعاهم إلى تقديم العلامة في قولهم: أكلوني البارغيث، وقد ورد في الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة» وكما أن هذه العلامة ليست للفعل، إنما هي للفاعلين، وكذلك التاء في قامت هند ليست للفعل إذ هو حيث يذكر لا يلحقه تأنيث إلا في نحو ضربه وقتله. والفعل لم يشتق من المصدر محدودًا، وإنما يدل عليه مطلقًا. فالتاء إذًا بمنزلة علامة التثنية والجمع، إلا أنها ألزم للفعل منها.
وقد ذكر النحاة في ذلك فروقًا وعللًا مشهورة فراجعها، ولكن ينبغي أن تتنبه لأمور تجب مراعاتها.
منها: أنهم قالوا إن الاسم المؤنث لو كان تأنيثه حقيقيًا فلا بد من لحوق تاء التأنيث في الفعل، وإن كان مجازيًا لكنت بالخيار. وزعموا أن التاء في قالت الأعراب ونحوه لتأنيث الجماعة وهو غير حقيقي، وقد كان على لحوق التاء في. وقال نسوة أولى: لأن تأنيثهن حقيقي، واتفقوا أن الفعل إذا تأخر عن فاعله المؤنث فلا بد من إثبات التاء، وإن لم يكن التأنيث حقيقيًا ولم يذكروا فرقًا بين تقدم الفعل وتأخره.
ومما يقال لهم إذ لحقت التاء لتأنيث الجماعة فلم لا يجوز في جمع السلامة المذكر كما جازت في جمع التكسير.
ومما يقال لهم أيضا: إذا كان لفظ الجماعة مؤنثًا فلفظ الجمع مذكر فلم روعي لفظ التأنيث دون لفظ التذكير.
فإن قلتم: أنت مخير، فإن راعيت لفظ التأنيث أنثت، وإن راعيت لفظ التذكير ذكرت.
قيل لهم: هذا باطل. فإن أحدًا من العرب لم يقل الهنداتُ ذهب، ولا الجمال انطلق، ولا الأعراب تكلم، مراعاة للفظ الجمع فبطلت العلة.
فهذه عللهم قد انتقضت كما ترى. فاسمع الآن سر المسألة وكشف قناعها: الأصل في هذا الباب أن الفعل متى اتصل بفاعله، ولم يحجز بينهما حاجز، لحقت العلامة ولا نبالي أكان التأنيث حقيقيًا أم مجازيًا. فتقول: طابت الثمرة وجاءت هند، إلا أن يكون الاسم المؤنث في معنى اسم آخر مذكر كالحوادث والحدثان والأرض والمكان. فلذلك جاء: * فإن الحوادث أودى بها * فإن الحوادث في معنى الحدثان. وجاء: * ولا أرض أبقل إبقالها * فإنه في معنى ولا مكان أبقل إبقالها. وإذا فصلت الفعل عن فاعله فكلما بعد عنه قوي حذف العلامة، وكلما قرب قوي إثباتها وإن توسط توسط فحضر القاضي اليوم امرأة أحسن من حضرت، وفي القرآن: { وأخذ الذين ظلموا الصيحة }. [199]
ومن هنا كان إذا تأخر الفعل عن الفاعل وجب ثبوت التاء طال الكلام أم قصر، لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصلًا به اتصال الجزء بالكل. فلم يكن بد من ثبوت التاء لفرط الاتصال. وإذا تقدم الفعل متصلًا بفاعله الظاهر فليس مؤخر الاتصال كهو مع المضمر، لأن الفاعل الظاهر كلمة، والفعل كلمة أخرى، كان حذف التاء في تأنيث هند وطابت الثمرة أقرب إلى الجواز منه، في قولك الثمرة طابت.
فإن حجز بين الفعل وفاعله حاجز كان حذف التاء حسنًا، وكلما كثرت الحواجز كان حذفها أحسن.
فإن كان الفاعل جمعًا مكسرًا دخلت التاء للتأنيث وحذفت لتذكير اللفظ، لأنه بمنزلة الواحد في أن اعرابه كإعرابه، ومجراه في كثير من الكلام مجرى اسم الجنس.
فإن كان الجمع مسلمًا فلا بد من التذكير لسلامة لفظ الواحد. فلا تقول: قالت الكافرون، كما لا تقول: قالت الكافر، لأن اللفظ بحاله لم يتغير بطر والجمع عليه.
فإن قيل: فلم لا تقول الأعراب. قال: كما تقوله مقدمًا.
قيل: ثبوت التاء إنما كان مراعاة لمعنى الجماعة، فإذا أردت ذلك المعنى أثبت التاء، وإن تأخر الفعل لم يجز حذفه لاتصال الضمير. وإن لم ترد معنى الجماعة حذفت التاء إذا تقدم الفعل ولم يحتج إليها، إذا تأخر لأن ضمير الفاعلين لجماعة في المعنى وليسوا جمعًا، لأن الجمع مصدر جمعت أجمع. فمن قال إن التذكير في ذهب الرجال، وقام الهندات مراعاة لمعنى الجمع فقد أخطأ.
وأما حذف التاء من { وقال نسوة }، فلانة اسم جمع كرهط وقوم، ولولا أن فيه تاء التأنيث لقبحت التاء في فعله. ولكنه قد يجوز أن تقول: قالت نسوة، كما تقول: قالت فِتية وصِبية.
فإن قلت: إذا كانت النسوة باللام كان دخول التاء في الفعل أحسن كما كان ذلك في قالت الأعراب لأن اللام للعهد وكان الاسم قد تقدم ذكره فأشبهت حال الفعل حاله. إذا كان فيه ضمير يعود إلى مذكور من أجل الألف واللام فإنها ترد على معهود.
فإن قلت: فإذا استوى ذكر التاء وتركها في الفعل المتقدم وفاعله مؤنث غير حقيقي فما الحكمة في اختصاصها في قصة شعيب بالفعل وحذفها في قصة صالح: { وأخذ الذين ظلموا الصيحة }.
قلت: الصيحة في قصة صالح في معنى العذاب والخزي إذ كانت منتظمة بقوله سبحانه: { ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز }، [200] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي، وعن العذاب المذكور في الآية. فقوي التذكير بخلاف قصة شعيب فإنه لم يذكر فيها ذلك، وهذا جواب السهيلي.
وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله، وهو أن الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصياح فيحسن فيها التذكير ويراد بها الواحدة من المصدر فيكون التأنيث أحسن.
وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثة اللفظ.
أحدها: الرجفة في قوله في الأعراف: { فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين }. [201]
الثاني: الظلة بقوله: { فأخذهم عذاب يوم الظلة }. [202]
الثالث: الصيحة: { وأخذت الذين ظلموا الصيحة }، [203] وجمع لهم بين الثلاثة. فإن الرجفة بدأت بهم فأصحروا إلى الفضاء خوفًا من سقوط الأبنية عليهم فصهرتهم الشمس بحرها، ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس فنزل عليهم منها العذاب وفيه الصيحة، فكان ذكر الصيحة مع الرجفة، والظلة أحسن من ذكر الصياح وكان ذكر التاء والله أعلم.
فإن قيل: فإن قلتم إن التاء حرف ولم يجعلوها بمنزلة الواو والألف في قاما وقاموا؟
قيل: لإجماع العرب على قولهم: الهندان قامتا بالتاء والضمير، ولا يجوز أن يكون للفعل ضميران فاعلان.
فإن قيل: فما الفرق بين قوله: { فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة } [204] وبين قوله: { فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة }. [205]
قيل: الفرق من وجهين: لفظي ومعنوي. أما اللفظي فهو أن الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله: { حق عليهم الضلالة }، أكثر منها في قوله: { حقت عليه }، وقد تقدم أن الحذف مع كثرة الحواجز أحسن.
وأما المعنوي فإن من في قوله: { ومنهم من حقت عليه الضلالة } واقعة على الأمة والجماعة وهي مؤنثة لفظًا، ألا تراه يقول: { ولقد بعثنا في كل أمة رسولا }، [206] ثم قال: { ومنهم من حقت عليه الضلالة } أي من تلك الأمم أمم حقت عليه بم الضلالة. ولو قال بدل ذلك: ضلت. لتعينت التاء ومعنى الكلامين واحد، وإذا كان معنى الكلامين واحدًا كان إثبات التاء أحسن من تركها، لأنها ثابتة فيما هو في معنى الكلام الآخر.
وأما: { فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة } فالفريق مذكر. ولو قال: فريقا ضلوا لكان بغير تاء. وقوله تعالى: { حق عليهم الضلالة } في معناه فجاء بغير تاء، وهذا أسلوب لطيف من أساليب العربية تدغ العرب حكم اللفظ الواجب له في قياس لغتها إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكم تراهم يقولون: هو أحسن الفتيان وأجمله، لأنه في معنى هو أحسن فتى وأجمله.
ونظيره تصحيحهم حول وعور، لأنه في معنى أحول وأعور. ونظائره كثيرة جدًا فإذا حسن الحمل على المعنى فيما كان القياس لا يجوزه. فما ظنك به حيث يجوزه القياس والاستعمال.
وأحسن من هذا أن يقول: إنهم أرادوا أحسن شيء وأجمله. فجعلوا مكان شيء قولهم الفتيان تنبيهًا على أنه أحسن شيء من هذا الجنس، فلو اقتصروا على ذكر شيء لم يدل على الجنس المفضل عليه ومن هذا قوله ﷺ: «أحناه على ولد في صغره، وأرعاه في ذات يده» فهذا يدل على أن التقدير هذا أحسن شيء وأجمله. لأنه أحسن فتى إذ لو كان التقدير أحسن فتى لكان نظيره هنا أحنى امرأة على ولد. وكان يقال: أحناها وأرعاها. فلما عدل إلى التذكير دل على أنهم أرادوا أحسن شيء من هذا الجنس وأرعاه.
فائدة بديعة: قولهم ضرب القوم بعضهم بعضا
قولك: ضرب القوم بعضهم بعضًا، هذه المسألة مما لم يدخل تحت ضبط النحاة ما يجب تقديمه من الفاعلين فإن كلاهما ظاهر إعرابه وتقديم الفاعل متعين. وسر ذلك وهو الضمير المحذوف فإن الأصل أن يقال: ضرب القوم بعضهم بعضهم، لأن حق البعض أن يضاف إلى الكل ظاهرًا، أو مقدرًا، فلما حذفوه من المفعول استغناء بذكره في الفاعل لم يجوروا تأخير الفاعل، فيقولوا: ضرب بعضًا بعضهم، لأن اهتمامهم بالفاعل قد قوي وتضاعف لاتصاله بالضمير الذي لا بد منه، فبعد أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرة صارت الحاجة إليه مرتين.
فإن قلت: فما المانع من إضافة بعض المفعول إلى الضمير، فتقول: ضرب القوم بعضهم بعض، أو ضرب القوم بعض بعضهم.
قلت: الأصل أن يذكر الضميران منهما جميعًا. فلما أرادوا حذفه من أحدهما تخفيفًا كان حذفه مع، المفعول الذي هو كالفضلة في الكلام. أولى من حذفه مع الفاعل الذي لا بد منه، ولا غناء عنه كقولك: خلطت القوم بعضهم ببعض، لأن رتبة المفعول ههنا التقدم على المجرور، كما كانت رتبة الفاعل التقديم على المفعول. فحق الضمير العائد على الكل أن يتصل بما هو أهم بالتقديم.
فائدة: إنما للنفي والإثبات
إذا قلت: إنما يأكل زيد الخبز، فحققت ما يتصل، ومحقت ما ينفصل هذه عبارة بعض النحاة وهي عبارة أهل سمرقند يقولون: في إنما وضعت لتحقيق المتصل، وتمحيق المنفصل. وتلخيص هذا الكلام أنها لنفي وإثبات. فأثبتت لزيد أكل الخبز المتصل به في الذكر، ونفت ما عداه فمعناه ما يأكل زيدًا إلا الخبز، فإن قدمت المفعول. فقلت: إنما يأكل الخبز زيد انعكس المعنى والقصد.
فائدة بديعة: الوصلات الخمسة
الوصلات في كلامهم التي وضعوها للتوصل بها إلى غيرها خمسة أقسام:
أحدها حروف الجر التي وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور بها، ولولاها لما نفذ الفعل إليها، ولا باشرها.
الثاني: حرف ها التي للتنبيه وضعت ليتوصل بها إلى نداء ذي الألف واللام.
الثالث: ذو وضعوه وصلة إلى وصف النكرات بأسماء الأجناس غير المشتقة كرجل ذي مال.
الرابع: الذي وضوه وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ولولاها لما جرت صفاتها عليها.
الخامس: الضمير الذي جعل وصلة إلى ارتباط الجمل بالمفردات خبرًا وصفة وصلة وحالًا. فأتوا بالضمير وصلة إلى جريان الجمل على هذه المفردات أحوالًا وأخبارًا وصفات وصلات، ولم يصفرا المعرفة بالجملة مع وجود هذه الوصلة المصححة كما وصفوا بها النكرة لوجهين:
أحدهما: أن النكرة مفتقرة إلى الوصف والتبيين. فعلم أن الجملة بعدها مبينة لها ومكملة لفائدتها.
الوجه الثاني: أن الجملة تتنزل منزلة النكرة، لأنها خبر ولا يخبر المخاطب إلا بما يجهله، لا بما يعرفه. فصلح أن يوصف بها النكرة بخلاف المعرفة. فإنك لو قلت: جاءني زيد قائم أبوه على وجه الوصف لما ارتبط الكلام بعضه ببعض لاستقلال كل واحد منهما بنفسه، فجاؤوا بالوصلة التي توصلوا بها إلى وصف النكرة باسم الجنس وهي ذو. فقالوا: جاءني زيد ذو قام أبوه وهذه لغة طيىء وهي الأصل.
ثم إن أكثر العرب لما رآها اسمًا قد وصف بها المعرفة أرادوا تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف. فأدخلوا الألف واللام عليه، ثم ضاعفوا اللام كيلا يذهب لفظها بالإدغام، وتذهب ألف الوصل في الدرج. فلا يظهر التعريف. فجاء منه هذا اللفظ تقديرًا لذو فلما رأوا الاسم قد انفصل عن الإضافة حيث صار معرفة قلبوا الواو منه ياء. إذ ليس في كلامهم واو متطرفة مضموم ما قبلها ألا وتنقلب ياء، كأدل وأحق. فصار الذي.
وإنما صحب الواو في قولهم: ذو لأنها كانت في حكم التوسط؛ إذ المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد.
وفي معنى "ذو" بمعنى الذي طرف من معنى ذا التي للإشارة، لأن كلًا منهما يبين بأسماء الأجناس. كقولك: هذا الغلام، وهذا الرجل فيتصل بها على وجه البيان، كما يتصل بها ذو على جهة الإضافة، وكذلك قالوا: في المؤنث من الذي التي بالتاء، كما قالوا في المؤنث، من هذا هاتا وهاتين.
فإن قيل: فلم أعرب الذي في حال التثنية.
قيل: لأن الألف التي فيه بعضها علامة الرفع في الأسماء المعربة فدار الأمر بين ثلاثة أمور:
أحدها: أن يبنوه وفيه علامة الإعراب وهو مستشنع وصار بمنزلة من تعطل عن التصرف وفيه آلته.
الثاني: أن يسقطوها منه ليعطوه حظه من البناء فيبطل معنى التثنية.
فرأوا الثالث أسهل شيء عليهم وهو إعرابه فكان ترك مراعاة علة البناء أهون عليهم من إبطال معنى التثنية ولهذه بعينها أعربوا اثنى عشر وهذين. وطرد هذا أن يكون هذان معربًا وهو الصحيح. وممن نص عليه السهيلي وأحسن ما بينا فإن الألف لا يكون علامة بناء بخلاف الضمير فانها تكون للبناء كحيث ومنذ، فتأمل هذا الموضع.
فإن قلت: ينتقض عليك بالجمع فإنهم بنوه أعني الذين وهو على حد التثنية وفيه علامة الإعراب؟
قلت: الفرق بين الجمع والتثنية من وجهين:
أحدهما: أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات نعم، وقد يكون الجمع اسمًا واحدًا في اللفظ كقوم ورهط.
الثاني: أن الجمع نصبه وخفضه يضارع لفظه لفظ الواحد من حيث كان آخره باء مكسورًا ما قبلها. فجعلوا الرفع الذي هو أقل حالاته على النصب والخفض، وغلبوا عليه البناء حيث كان لفظه في الإعراب في أغلب أحواله كلفظه في البناء، وليس كذلك التثنية فإن ياءها مفتوح ما قبلها فلا يضارع لفظها في شيء من أحوالها لفظ الواحد.
وأما النون في الذين فلا اعتبار بها، لأنها ليست في الجمع ركنًا من أركان صيغته لسقوطها في الإضافة من الشعر كما قال: * وإن الذي حانت بفلج دماؤهم [207] * هذا تعليل السهيلي.
وعندي فيه علة ثانية وهي أن التثنية في الذين خاصة من خواص الاسم قاومت شبه الحرف فتقابل المقتضيان، فرجع إلى أصله، فأعرب بخلاف الذين فإن الجمع وإن كان من خواص الأسماء، لكن هذه الخاصة ضعيفة في هذا الاسم لنقصان دلالته مجموعًا عما يدل عليه مفردًا فإن الذي يصلح للعاقل وغيره، والذي لا يستعمل إلا للعقلاء خاصة فنقصت دلالته فضعفت خاصية الجمع فيه، فبقي موجب بنائه على قوته وهذا بخلاف المثنى، فإنه يقال على العاقلين وغيرهما فإنك تقول: الرجلان اللذان لقيتهما، والثوبان اللذان لبستهما، ولا تقول: الثياب الذين لبستهم. وعلى هذا التعليل فلا حاجة بنا إلى ركوب ما تعسفه رحمه الله من مضارعة الجمع للواحد وشبهه به وتكلف الجواب عن تلك الإشكالات. والله أعلم.
فائدة بديعة: ما الموصولة
قول النحاة إن "ما" الموصولة بمعنى الذي، إن أرادرا به أنها بمعناها من كل وجه فليس بحق، وإن أرادوا أنها بمعناها من بعض الوجوه فحق. والفرق بينهما أن ما اسم مبهم في غاية الإبهام حتى أنها تقع على كل شيء، وتقع على ما ليس بشيء، ألا تراك تقول: إن الله يعلم ما كان وما لم يكن، ولفرط أبهامها لم يجز الإخبار عنها حتى توصل بما يوضحها، وكل ما وصلت به يجوز أن يكون صلة للذي فهو يوافق الذي في هذا الحكم، ويخالفها في إبهامها. فلا تكون نعتًا لما قبلها ولا منعوتة لأن صلتها بعينها غير النعت. وأيضا فلو نعتت بنعت زائد على الصلة لارتفع إبهامها وفي ارتفاع الأبهام منها جملة بطلان حقيقتها وإخراجها عن أصل موضوعها.
وتفارق الذي أيضا في امتناعها من التثنية والجمع، وذلك أيضا لفرط إبهامها فإذا ثبت الفرق بينهما. فاعلم أنه لا يجوز أن توجد إلا موصولة لإبهامها وموصوفة، ولا يجوز أن توجد إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع، لأنها لا تخلو من الإبهام أبدًا. ولذلك كان في لفظها ألف آخرة لما في الألف من المد والإتساع في هواء الفم مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس. فإذا أوقعوها أعلى نوع بعينه وخصوا به من يعقل وقصروها عليه، أبدلوا الألف نونًا ساكنة. فذهب امتداد الصوت فصار قصر اللفظ موازنًا لقصر المعنى.
وإذا كان أمرها كذلك (ووقعت على جنس من الأجناس) وجب أن يكون ضميرها العائد عليها من الصلة التي لا بد للصلة منه، ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة له فيجب أن يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب والمعنى، فإذا وقعت على ما هو فاعل في المعنى كان ضميرها فاعلًا في المعنى واللفظ، نحو كرهت ما أصابك. فما مفعولة لكرهت في اللفظ وهي فاعلة لأصاب في المعنى، فالضمير الذي في أصاب فاعل في اللفظ والمعنى.
وإذا وقعت على مفعول كان ضميرها مفعولا لفظًا ومعنى نحو: سرني ما أكلته، وأعجبني ما لبسته، فهي في المعنى مفعولة لأنها عبارة عن الملبوس، فضميرها مفعول في اللفظ والمعنى، وكذلك إذا وقعت على اللفظ كان ضميرها مجرورًا بفي، لأن الظرف كذلك في المعنى إلا أنها لا تقع على المصادر إلا على ما تختلف أنواعه للإبهام الذي فيها.
فإن قيل: فكيف وقعت على من يعقل كقوله: { لما خلقت بيدي }، [208] { والسماء وما بناها }، [209] { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، وأمثال ذلك؟
قيل: هي في هذا كله على أصلها من الأبهام والوقوع على الجنس العام لما يراد بما ما يراد بمن من التعيين لما يعقل، والاختصاص دون الشياع، ومن فهم حقيقة الكلام وكان له ذوق عرف هذا واستبان له.
أما قوله تعالى: { ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي }، [210] فهذا كلام ورد في معرض التوبيخ والتبكيت للعين على امتناعه من السجود، ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ حيث كان السجود لمن يعقل، ولكن للمعصية والتكبر على ما لم يخلقه. إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على مثله، إنما التكبر للخالق وحده فكأنه يقول: سبحانه لم عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلقته أنا وشرفته وأمرتك بالسجود له. فهذا موضع ما، لأن معناها أبلغ ولفظها أعم وهو في الحجة أوقع وللعذر والشبهة أقطع.
فلو قال: ما منعك أن تسجد لمن خلقت لكان استفهامًا مجردًا من توبيخ وتبكيت ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل.
ولعله موجود في ذاته وعينه. وليس المراد كذلك، وإنما المراد توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له، ولهذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخص وأتى بالاسم الموصول الدال على جهة التشريف المقتضية لإسجاده له كونه خلقه بيديه، وأنت لو وضعت مكان ما لفظة من، لما رأيت هذا المعنى المذكور في الصلة وإن ما جيء بها وصلة إلى ذكر الصلة. فتأمل ذلك فلا معنى إذًا للتعيين بالذكر. إذ لو أريد التعيين لكان بالاسم العلم أولى وأحرى.
وكذلك قوله: { والسماء وما بناها } [211] لأن القسم تعظيم للمقسم به واستحقاقه للتعظيم من حيث ما. وأظهر هذا الخلق العظيم الذي هو السماء ومن حيث سواها، وزينها بحكمته فاستحق التعظيم، وثبتت قدرته. فلو قال: ومن بناها لم يكن في اللفظ دليل على استحقاقه للقسم من حيث اقتدر على بنائها، ولكان المعنى مقصورًا على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى أفعاله الدالة على عظمته المنبئة عن حكمته المفصحة باستحقاقه للتعظيم من خليقته.
وكذلك قولهم: "سبحان ما يسبح الرعد بحمده"، لأن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم، والمسبَّح به لا محالة أعظم، فاستحقاقه للتسبيح من حيث سبَّحته [212] العظيمات من خلقه لا من حيث كان يعلم، ولا تقل: يعقل في هذا الموضع.
فإذا تأملت ما ذكرناه استبان لك قصور من قال: إن ما مع الفعل في هذا كله سوى الأول في تأويل المصدر، وإنه لم يصدر المعنى حق قدره فلا لصناعة النحو وفق، ولا لفهم التفسير رزق وإنه تابع الحز وأخطا المفصل وحام، ولكن ما ورد المنهل.
(سورة الكافرون)
وأما قوله عز وجل: { لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد }، فما على بابها، لأنها واقعة على معبوده ﷺ على الإطلاق، لأن امتناعهم من عبادة الله ليس لذاته، بل كانوا يظنون أنهم يعبدون الله، ولكنهم كانوا جاهلين به فقوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، أي لا أنتم تعبدون معبودي، ومعبوده هو ﷺ كان عارفًا به دونهم وهم جاهلون به. هذا جواب بعضهم.
وقال آخرون: إنها هنا مصدرية لا موصولة أي لا تعبدون عبادتي ويلزم من تنزيههم عن عبادته تنزيههم عن المعبود، لأن العبادة متعلقة به وليس هذا بشىء إذ المقصود براءته من معبوديهم، وإعلامه أنهم بريئون من معبوده تعالى. فالمقصود المعبود لا العبادة.
وقيل: إنهم كانوا يقصدون مخالفته ﷺ حسدًا له، وأنفة من أتباعه، فهم لا يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود، ولكن كراهية لأتباعه ﷺ وحرصًا على مخالفته في العبادة. وعلى هذا فلا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ ما لإبهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية.
وقيل في ذلك وجه رابع. وهو قصد ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة مثل قوله: { نسوا الله فنسيهم }، [213] { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه }، [214] فكذلك: { لا أعبد ما تعبدون } ومعبودهم لا يعقل، ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد } فاستوى اللفظان وإن اختلف المعنيان، ولهذا لا يجيء في الإفراد مثل هذا، بل لا يجيء إلا من كقوله: { قل من ينجيكم قل من يرزقكم }، [215] { أمن يملك السمع }، [216] { أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر }، [217] { أمن يجيب المضطر إذا دعاه }، [218] { أمن يبدأ الخلق }، [219] إلى أمثال ذلك.
وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا كله، وهو أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقًا لها، فأتى بما الدالة على هذا المعنى كأنه قيل: ولا أنتم عابدون معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق، ولو أتى بلفظة من لكانت إنما تدل على الذات فقط، ويكون ذكر الصلة تعريفًا لا أنه هو جهة العبادة ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلًا، لأن يعبد تعريف محض أو وصف مقتضي لعبادته. فتأمله فإنه بديع جدًا.
وهذا معنى قول محققي النحاة أن "ما" تأتي لصفات من يعلم، ونظيره: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } [220] لما كان المراد الوصف وإن هو السبب الله الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده وهو الطيب فتنكح المرأة الموصوفة به أتى بما دون من وهذا باب لا ينخرم وهو من ألطف مسالك العربية.
وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هنا. فلنذكر فائدة ثانية على ذلك وهي تكرير الأفعال في هذه السورة.
ثم فائدة ثالثة وهي كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في الموضعين، وأتى في حقهم بالماضي.
ثم فائدة رابعة: وهي أنه جاء في نفي عبادة معبودهم عنه بلفظ الفعل المستقبل، وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل.
ثم فائدة خامسة وهي كون إيراده النفي هنا "لا" دون لن.
ثم فائدة سادسة: وهي أن طريقة القرآن في مثل هذا. أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته. وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد. وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات وهذا حقيقة لا إله إلا الله. فلم جاءت هذه السورة بالنفي المحض وما سر ذلك؟
وفائدة سابعة: وهي ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم، ثم نفي عبادتهم عن معبوده.
وفائدة ثامنة: وهي أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين كفروا والذين هادوا كقوله: { يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم }، [221] { قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله }، [222] و { يا أيها الكافرون } في هذا الموضع فما وجه هذا الاختصاص؟
وفائدة تاسعة: وهي هل في قوله: { لكم دينكم ولي دين }، معنى زائد على النفي المتقدم فإنه يدل على اختصاص كل بدينه ومعبوده وقد فهم هذا من النفي فما أفاد التقسيم المذكور؟ وفائدة عاشرة: وهي تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم والاختصاص. وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة.
وفائدة حادية عشرة وهي أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من الإخبار.
أحدهما: براءته من معبودهم وبراءتهم من معبوده وهذا لازم أبدًا.
الثاني: إخباره بأن له دينه ولهم دينهم، فهل هذا متاركة وسكوت عنهم فيدخله النسخ بالسيف، أو التخصيص ببعض الكفار، أم الآية باقية على عمومها وحكمها غير منسوخة ولا مخصوصة.
فهذه عشر مسائل في هذه السورة فقد ذكرنا منها مسألة واحدة وهي وقوع ما فيها بدل من. فنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الله مستعينين بحوله وقوته متبرئين إليه من الخطأ. فما كان من صواب فمنه وحده لا شريك له وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه.
فأما المسألة الثانية: وهي فائدة تكرار الأفعال فقيل فيه وجوه أحدها إن قوله: { لا أعبد ما تعبدون }، نفي للحال والمستقبل وقوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، مقابله أي لا تفعلون ذلك. وقوله: { ولا أنا عابد ما عبدتم }، أي لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي. ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي فقال: ما عبدتم فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم. وقوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، مقابله أي لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائمًا. وعلى هذا فلا تكرار أصلًا، وقد استوفت الآيات أقسام النفي ماضيًا وحالًا ومستقبلًا عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه. وهذا إن شاء الله أحسن ما قيل فيها فلنقتصر عليه، ولا نتعداه إلى غيره، فإن الوجوه التي قيلت في مواضعها فعليك بها.
وأما المسألة الثالثة: وهي تكريره الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم. ففي ذلك سر وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله له عن الزيغ والإنحراف عن عبادة معبوده، والاستبدال به غيره. وأن معبوده واحد في الحال والمآل على الدوام لا يرضى به بدلًا ولا يبغي عنه حولًا بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون أهواءهم، ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم. فهم يصددان يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيره فقال: { لا أعبد ما تعبدون } يعني الآن: { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، أنا الآن أيضا، ثم قال: { ولا أنا عابد ما عبدتم } يعني ولا أنا فيما يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. وأشبهت ما هنا رائحة الشرط، فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل في المعنى. كما يجيء ذلك بعد حرف الشرط، كأنه يقول: مهما عبدتم من شيء فلا أعبده أنا.
فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط وقد عمل فيها الفعل ولا جواب لها وهي موصولة. فما أبعد الشرط منها؟
قلنا: لم نقل أنها شرط نفسها، ولكن فيها رائحة منه وطرف من معناه لوقوعها على غير معين، وإبهامها في المعبودات وعمومها. وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديًا على صفحاته. فإذا قلت لرجل: ما تخالفه في كل ما يفعل أنا لا أفعل ما تفعل. ألست ترى معنى الشرط قائمًا في كلامك وقصدك. وإن روح هذا الكلام مهما فعلت من شيء فإني لا أفعله. وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى: { قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيًا }، [223] كيف تجد معنى الشرطية فيه حتى وقع الفعل بعد من بلفظ الماضي، والمراد به المستقبل. وإن المعنى من كان في المهد صبيًا فكيف نكلمه؟ وهذا هو المعنى الذي حام حوله من قال من المفسرين والمعربين: أنه كان نبيًا بمعنى يكون، لكنهم لم يأتوا إليه من بابه، بل ألقوه عطلًا من تقدير وتنزيل وعزب فهم غيرهم عن هذا للطفه ودقته. فقالوا: كان زائدة والوجه ما أخبرتك فخذه عفوًا لك عزمه، وعلى سواك غرمه. هل على من في الآية قد عمل فيها الفعل. وليس لها جواب. ومعنى الشرطية قائم فيها، فكذلك في قوله: { ولا أنا عابد ما عبدتم }، وهذا كله مفهوم من كلام فحول النحاة كالزجاج وغيره.
فإذا ثبت هذا، فقد صحت الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي من قوله: { ولا أنا عابد ما عبدتم } بخلاف قوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد } لبعد ما فيها عن معنى الشرط. تنبيهًا من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه، وأن ينتقل في المعبودات تنقل الكافرين.
وأما المسألة الرابعة: وهي أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة، وباسم الفاعل أخرى، فذلك والله أعلم لحكمة بديعة وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وفي كل وقت، فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد، ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت. فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع مني، وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلًا لي، ولا وصفًا، فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي. وأما في حقهم، فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوب دون الفعل. أي إن الوصف الثابت اللازم العائد لله ملتف عنكم. فليس هذا الوصف ثابتًا لكم، وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدًا، وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه وإن عبدوه في بعض الأحيان فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، كما قال أهل الكهف: { وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله } [224] أي اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه، وكذا قال المشركون عن معبودهم: { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } [225] فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ونفي الوصف، لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتًا على عبادة الله موصوفًا بها.
فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد الله، وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته، وتبتل إليه تبتيلًا لم يلتفت إلى غيره، ولم يشرك به أحدًا في عبادته وإنه وإن عبده وأشرك به غيره، فليس عابدًا لله ولا عبدًا له. وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتي الإخلاص التي تعدل ربع القرآن كما جاء في بعض السنن. وهذا لا يفهمه كل أحد، ولا يدركه إلا من منحه الله فهمًا من عنده فله الحمد والمنة.
وأما المسألة الخامسة: وهي أن النفي في هذه السورة أتى بأداة لا دون لن فلما تقدم تحقيقه عن قرب إن النفي بلا أبلغ منه بلن، وإنها أدل على دوام النفي وطوله من لن وإنها للطول والمد الذي في نفيها طال النفي بها واشتد وإن هذا ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن لن إنما تنفي المستقبل، ولا تنفي الحال المستمر النفي في الاستقبال. وقد تقدم تقرير ذلك بما لا تكاد تجده في غير هذا التعليق. فالإتيان بلا متعين هنا والله أعلم.
وأما المسألة السادسة: وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك. [226] فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتي بالنفي في الجانبين تحقيقًا للبراءة المطلوبة مع أنها متضمنة للإثبات صريحًا فقوله: { لا أعبد ما تعبدون براءة محضة ولا أنتم عابدون ما أعبد إثبات أن له معبودًا يعبده وأنتم بريئون من عبادته فتضمنت النفي والإثبات، وطابقت قول إمام الحنفاء: { إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني }، [227] وطابقت قول الفئة الموحدين: { وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله } [228] فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله ولهذا كان النبي ﷺ يقرنها بسورة { قل هو الله أحد } في سنة الفجر وسنة المغرب، فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص، وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد، ولا فلاح إلا بهما. وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد. وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم يولد فيكون له أصل، ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظير، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها؛ فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلًا وفرعًا ونظيرًا، فهذا توحيد العلم والاعتقاد. والثاني: توحيد القصد والإرادة وهو أن لا يعبد إلا إياه فلا يشرك به في عبادته سواه بل يكون وحده هو المعبود وسورة { قل يا أيها الكافرون } مشتملة على هذا التوحيد، فانتظمت السورتان نوعي التوحيد، وأخلصتا له فكان ﷺ يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ويختم بهما في سنة المغرب، وفي السنن أنه كان يوتر بهما فيكونا خاتمة عمل الليل، كما كانا خاتمة عمل النهار.
ومن هنا تخريج جواب المسألة السابعة وهي تقديم براءته من معبودهم، ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده. فتأمله.
وأما المسألة الثامنة: وهي إثباته هنا بلفظ يا أيها الكافرون. دون يا أيها الذين كفروا. فسره والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفًا ثابتًا له لازمًا لا يفارقه، فهو حقيق أن يتبرأ الله منه، ويكون هو أيضا بريئًا من الله. فحقيق بالموحد البراءة منه، فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد، والمجانبة بحققة حاله التي هي غاية الكفر. وهو الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائمًا أبدًا. ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر وهذا واضح.
وأما المسألة التاسعة: وهي ما هي الفائدة في قوله: { لكم دينكم ولي دين }، وهل أفاد هذا معنى زائدًا على ما تقدم؟ فيقال في ذلك من الحكمة والله أعلم أن النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا يتصور منه، ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم وهم أيضا لا يكونون عابدين لمعبوده، وأفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك، والكفر الذي هو حظهم، وقسمهم ونصيبهم فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضًا. فقال له: لا تدخل في حدي، ولا أدخل في حدك، لك أرضك ولي أرضي. فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت إنا اقتسمنا خطتنا بيننا فأصابنا التوحيد والإيمان فهو نصيبنا، وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه، وأصابكم الشرك بالله والكفر به، فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصون به لا نشرككم به.
فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه. وهذه المعاني ونحوها، إذا تجلت للقلوب رافلة في حللها فإنها تسبي القلوب وتأخذ بمجامعها، ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي: * خود تزف إلى ضرير مقعد * فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لها ونسأله إتمام نعمته.
وأما المسألة العاشرة: وهي تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه وفي أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهم. فهذا من أسرار الكلام، وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانها. فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم ورضي كل بقسمه وكان المحق هو صاحب القسمة، وقد برز النصيبين وميزا القسمين، وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون الذي لا أردى منه وإنه هو قد استولى على القسم الأشرف. والحظ الأعظم بمنزلة من اقتسم هو وغيره سمًا وشفاء فرضي مقاسمه بالسم. فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي، ولا أشاركك في قسمك، لك قسمك ولي قسمي. فتقديم ذكر قسمه ههنا أحسن وأبلغ. كأنه يقول: هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقديم، وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما بالتقديم. فكان في تقديم ذكر قسمه من اللهم به، والنداء على سوء اختياره، وقبح ما رضيه لنفسه من الحسن والبيان ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسه، والحاكم في هذا هو الذوق والفطن يكتفي بأدنى إشارة، وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان.
ووجه ثان وهو أن مقصود السورة براءته ﷺ من دينهم ومعبودهم، هذا هو لبها ومغزاها. وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكملًا لبراءته، ومحققًا لها فلما كان المقصود براءته من دينهم، بدأ به في أول السورة ثم جاء قوله: { لكم دينكم } مطابقًا لهذا المعنى أي لا أشارككم في دينكم، ولا أوافقكم عليه، بل هو دين تختصون أنتم به لا أشرككم فيه أبدًا. فطابق آخر السورة أولها فتأمله.
وأما المسألة الحادية عشرة: وهي أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه، هل هو إقرار فيكون منسوخًا أو مخصوصًا، أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟
فهذه مسألة شريفة ومن أهم المسائل المذكورة، وقد غلط في السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب. وكلا القولين غلط محض فلا نسخ في السورة ولا تخصيص، بل هي محكمة عمومها نص محفوظ. وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها، فإن أحكام التوحيد التى اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه. وهذه السورة أخلصت التوحيد. ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم، ومنشأ الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم، ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف فقالوا: منسوخ. وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم، فقالوا: هذا مخصوص. ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا لهم أو إقرارا على دينهم أبدًا. بل لم يزل رسول الله ﷺ في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد على الإنكار عليهم، وعيب دينهم وتقبيحه، والنهي عنه والتهديد والوعيد كل وقت وفي كل ناد. وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه فأبى إلا مضيًا على الإنكار عليهم وعيب دينهم. فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره لهم. معاذ الله من هذا الزعم الباطل. وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة كما تقدم، وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدًا فإنه دين باطل فهو مختص بكم لا نشرككم فيه، ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق. فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم. فأين الإقرار حتى يدعي النسخ أو التخصيص. أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال لهم: لكم دينكم ولي دين. بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين، إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده.
وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول ﷺ أهل سنته، وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته. إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته: لكم دينكم ولنا ديننا. لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم، بل يقولون لهم: هذه براءة منها، وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان.
فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة، والنبذة المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها، وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير، ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه. بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها، ولبالغت في استحسانها وعسى الله المان بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين أن يعين على تعليق تفسير هذا النمط، وهذا الأسلوب، وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا الغمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس. والله المرجو إتمام نعمته.
ولنذكر تمام الكلام على أقسام ما ومواقعها فقد ذكرنا منها الموصولة. ومن أقسامها المصدرية، ومعنى وقوعها عليه أنها إذا دخلت على الفعل كان معها في تأويل المصدر. هكذا أطلق النحاة. وهنا أمور يجب التنبيه عليها والتنبه لها:
أحدها: الفرق بين المصدر الصريح والمصدر المقدر مع ما. والفرق بينههما. أنك إذا قلت: يعجبني صنعك. فالإعجاب هنا واقع على نفس الحدث بقطع النظر عن زمانه ومكانه، وإذا قلت: يعجبني ما صنعك فالإعجاب واقع على صنع ماض، وكذلك ما تصنع واقع على مستقبل فلم تتحد دلالة ما والفعل والمصدر.
الثاني: أنها لا تقع مع كل فعل في تأويل المصدر وإن وقع المصدر في ذلك الموضع. فإنك إذا قلت: يعجبني قيامك كان حسنًا. فلو قلت: يعجبني ما تقوم، لم يكن كلامًا حسنًا، وكذلك يعجبني ما تقوم وما تجلس، أي قيامك وجلوسك. ولو أتيت بالمصدر كان حسنًا، وكذلك إذا قلت: يعجبني ما تذهب لم يكن في الجوازة والاستعمال مثل يعجبني ذهابك.
فقال أبو القاسم السهيلي: الأصل في هذا أن ما. لما كانت اسمًا مبهمًا لم يصح وقوعها إلا على جنس تختلف أنواعه. فإن كان المصدر مختلف الأنواع جاز أن تقع عيه ويعبر بها عنه، كقولك: يعجبني ما صنعت، وما عملت، وما حكمت لاختلاف الصنعة والعلم والحكم. فإن قلت: يعجبني ما جلست، وما قعدت وما نطلق زيد كان غثًا من الكلام لخروج ما عن الإبهام ووقوعها على ما لا يتنوع من المعاني، لأنه يكون التقدير يعجبني الجلوس الذي جلست، والقعود الذي قعدت فيكون آخر الكلام مفسرًا لأوله رافعًا للأبهام. فلا معنى حينئذ لما فأما قوله تعالى: { ذلك بما عصوا } [229] فلأن المعصية تختلف أنواعها. وقوله: { بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون }، [230] فهو كقولك: لأعاقبنك بما ضربت زيدًا، وبما شتمت عمرًا أوقعتها على الذنب والذنب مختلف الأنواع ودل ذكر المعاقبة والمجازاة على ذلك وكأنك قلت: لأجزينك بالذنب الذي هو ضرب زيد، أو شتم عمرو فما على بابها غير خارجة عن إبهامها.
هذا كلامه، وليس كما زعم رحمه الله فإنه لا يشترط في كونها مصدرية ما ذكر من الإبهام، بل تقع على المصدر الذي لا تختلف أنواعه، بل هو نوع واحد فإن إخلافهم ما وعد الله كان نوعًا واحدًا مستمرًا معلومًا. وكذلك كذبهم.
وأصرح من هذا كله قوله تعالى: { كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون } [231] فهذا مصدر معين خاص لا إبهام فيه بوجه وهو علم الكتاب ودرسه، وهو فرد من أفراد العمل والصنع، فهو كما منعه من الجلوس والقعود والانطلاق. ولا فرق بينهما في إبهام، ولا تعيبن إذ كلاهما معين متميز غير مبهم ونظيره: { بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون }، [232] فاستكبارهم وقولهم على الله غير الحق مصدر أن معيان غير مبهمين، واختلاف أفرادهما كاختلاف أفراد الجلوس والانطلاق، ولو أنك قلت: في الموضع الذي منعه هذا بما جلست، وهذا بما نطقت، كان حسنًا غير غث، ولا مستكره وهو المصدر بعينه فلم يكن الكلام غثًا بخصوص المصدر، وإنما هو لخصوص التركيب. فإن كان ما يقدر امتناعه واستكراهه إذا صغته في تركيب آخر زالت الكراهية والغثاثة عنه كما رأيت.
والتحقيق أن قوله: يعجبني ما تجلس، وما ينطلق زيد. إنما استكره وكان غثًا، لأن ما المصدرية والموصولة يتعاقبان غالبًا، ويصلح أحدهما في الموضع الذي يصلح فيه الآخر، وربما احتملها كلام واحد ولا يميز بينهما فيه إلا بنظر وتأمل. فإذا قلت: يعجبني ما صنعت فهي صالحة، لأن تكون مصدرية أو موصولة، وكذلك: { والله عليم بما يفعلون }، [233] { والله بصير بما يعملون }، [234] فتأمله تجده كذلك.
ولدخول إحداهما على الأخرى. ظن كثير من الناس أن قوله تعالى: { والله خلقكم وما تعملون }، [235] إنها مصدرية واحتجوا بها على خلق الأعمال، وليست مصدرية، وإنما هي موصولة، والمعنى والله خلقكم، وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من الأصنام، فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله، ولو كانت مصدرية لكان الكلام إلى أن يكون حجة لهم أقرب من أن يكون حجة عليهم. إذ يكون المعنى: { أتعبدون ما تنحتون } [236] والله خلق عبادتكم لها فأي معنى في هذا وأي حجة عليهم.
والمقصود أنه كثيرًا ما تدخل إحداهما على الأخرى ويحتملها الكلام سواء.
وأنت لو قلت: تعجبني الذي يجلس. لكان غثًا من المقال إلا تأتي بموصوف يجري هذا صفة له فتقول: يعجبني الجلوس الذي تجلس، وكذلك إذا قلت: يعجبني الذي ينطلق زيد كان عثًا. فإذا قلت: يعجبني الانطلاق الذي ينطلق زيد كان حسنًا. فمن هنا استغث يعجبني ما ينطلق وما تجلس إذا أردت به المصدر.
وأنت لو قلت: آكل ما يأكل كانت موصولة وكان الكلام حسنًا. فلو أردت بها المصدرية، والمعنى آكل أكلك كان غثًا حتى تأتي بضميمة تدل على المصدر. فتقول: آكل كما يأكل فعرفت أنه لم يكن الاستكراه الذي أشار إليه من جهة الإبهام والتعيين، فتأمله.
وأما طالما يقوم زيد، وقل ما يأتي عمرو فما هنا واقعة على الزمان. والفعل بعدها متعد إلى ضميره بحرف الجر. والتقدير طال زمان يقوم فيه زيد وقل زمان يأتينا فيه عمر، وثم حذف الضمير فسقط الحرف هذا تقدير طائفة من النحاة منهم السهيلي وغيره.
ويحتمل عندي تقديرين آخرين هما أحسن من هذا.
أحدهما: أن تكون مصدرية وقتية والتقدير طال قيام زيد وقل إتيان عمرو. وإنما كان هذا أحسن، لأن حذف العائد من الصفة قبيح بخلاف حذفه إذا لم يكن عائدًا على شيء فإنه أسهل. وإذا جعلت مصدرية كان حذف الضمير حذف فضلة غير عائد على موصوف.
والتقدير الثالث وهو أحسنها: إن ما ههنا مهيئة لدخول الفعل على الفعل ليست مصدرية ولا نكرة، إنما أتى بها لتكون مهيئة لدخول طال على الفعل. فإنك لو قلت: طال يقوم زيد وقل يجنىء عمرو لم يجز. فإذا أدخلت ما استقام الكلام وهذا كما دخلت على رب مهيئة لدخولها على الفعل نحو قوله: { ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين }، [237] وكما دخلت على إن مهيئة لدخولها على الفعل نحو: { إنما يخشى الله من عباده العلماء }. [238] فإذا عرفت هذا فقول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، هو من هذا الباب ودخلت ما بين كاف التشبيه وبين الفعل مهيئة لدخولها عليه فهي كافة للخافض ومهيئة له أن تقع بعد الفعل، وهذا قد خفي على أكثر النحاة حتى ظن كثير منهم أن ما ههنا مصدرية. وليس كما ظن فإنه لم يقع التشبيه بالرؤية. وأنت لو صرحت بالمصدر هنا، لم يكن كلامًا صحيحًا فإنه لو قيل: صلوا كرؤيتكم صلاتي لم يكن مطابقًا للمعنى المقصود فلو قيل: إنها موصولة والعائد محذوف، والتقدير صلوا كالتي رأيتموني أصلي أي كالصلوات التي رأيتموني أصليها كان أقرب من المصدرية على كراهته. فالصواب ما ذكرته لك.
ونظير هذه المسألة قوله ﷺ للصديق: «كما أنت»، فأنت مبتدأ والخبر محذوف فلا مصدر هنا إذ لا فعل، فمن قال إنها مصدرية فقد غلظ، وإنما هي مهيئة لدخول الكاف على ضمير الرفع، والمعنى كما أنت صانع أو كما أنت مصل فدم على حالتك.
ونظير ذلك أيضا وقوعها بين بعد والفعل نحو قوله تعالى: { من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم }، [239] ليست مصدرية كما زعم أكثر النحاة، بل هي مهيئة لدخول بعد على فعل كاد إذ لا يصاغ من كاد وما مصدر إلا أن يتشجم له فعل بمعناه يسبك منها. ومن ذلك الفعل مصدر، وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى ذلك ويؤيد هذا قول الشاعر:
أعلَاقَةٌ أمَّ الوليد بعدما ** أفنانُ رأسك كالثَّغام المُخلِس
أفلا تراها ههنا حيث لا فعل ولا مصدر أصلًا، فهي كقوله "كما أنت" مهيئة لدخول "بعد" على الجملة الإبتدائية، ولكن الخبر في البيت مذكور، وهو في قوله "كما أنت" محذوف.
فإن قلت: فما بالهم لم يدخلوها في قبل كافة لها مهيئة لدخولها على الفعل والجملة قبلما يقوم زيد وقبل ما زيد قائم.
قلت: لا تكون ما كافة لأسماء الإضافة، وإنما تكون كافة للحروف وبعد أشد مضارعة للحروف من قبل، لأن قبل كالمصدر في لفظها ومعناها تقول: جئت قبل الجمعة تريد الوقت الذي تستقبل في الجمعة. فالجمعة بالإضافة إلى ذلك الوقت قابله كما قال الشاعر: * نحج معًا، قالت أعامًا وقابله * فإذا كان العام الذي بعد عامك يسمى قابلًا فعامك الذي أنت فيه قبل، ولفظه من لفظ قابل. فقد بان لك من جهة اللفظ والمعنى أن "قبل" مصدر في الأصل، والمصدر كسائر الأسماء لا يكف به ولا يهيأ لدخول الجمل بعد، وإنما ذلك في بعض العوامل لا في شيء من الأسماء، وأما "بعد" فهي أبعد عن شبه المصدر، وإن كانت تقرب من لفظ بعد ومن معناه. فليس قربها من لفظ المصدر كقرب قبل؛ ألا ترى أنهم لم يستعملوا من لفظها اسم فاعل فيقولون للعام الماضي الباعد، كما قالوا للمستقبل القابل.
فإن قلت: فما تقول في قوله: { كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم }، [240] وقوله: { واذكروه كما هداكم }، [241] وقوله: { وأحسن كما أحسن الله إليك }، [242] فإنها لا يمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلها فهل هي كافة مهيئة أو مصدرية؟
قلت: التحقيق أنها كافة لحرف التشبيه عن عمله مهيئة لدخوله على الفعل. ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وإن لم تكن مصدرية محضة، ويدل على أن ما لا تقع مصدرية على حد أن إنك تجدها لا تصلح في موضع تصلح فيه أن. فإذا قلت: أريد أن تقوم كان مستقيمًا، فلو قلت: أريد ما تقوم لم يستقم، وكذلك أحب أن تأتيني. لا تقول موضعه أحب تأتيني.
وسر المسألة أن المصدرية ملحوظ فيها معنى الذي كما تقدم بخلاف أن.
فإن قلت: فما تقول في كلما قمت أكرمتك أمصدرية هنا أم كافة أم نكرة؟
قلت: هي ههنا نكرة وهي ظرف زمان في المعنى. والتقدير كل وقت تقوم فيه أكرمك.
فإن قلت: فهلا جعلتها كافة لإضافة كل إلى الفعل مهيئة لدخولها عليه.
قلت: ما أحراها بذلك لولا ظهور الظرف، والوقت، وقصده من الكلام فلا يمكن إلغاؤه مع كونه هو المقصود. ألا ترى أنك تقول: كل وقت يفعل كذا أفعل كذا. فإذا قلت: كلما فعلت فعلت. وجدت معنى الكلامين واحدًا، وهذا قول أئمة العربية وهو الحق.
فصل: الرد على المعتزلة
قال أبو القاسم السهيلي: اعلم أن ما إذا كانت موصولة بالفعل الذي لفظه عمل أو صنع أو فعل وذلك الفعل مضاف إلى فاعل غير الباري سبحانه فلا يصح وقوعها إلا على مصدر، لإجماع العقلاء من الأنام في الجاهلية والإسلام على أن أفعال الآدميين لا تتعلق بالجواهر والأجسام، لا تقول: عملت جملًا، ولا صنعت جبلًا ولا حديدًا ولا حجرًا ولا ترابًا. فاذا قلت: أعجبني ما عملت وما فعل زيد، فإنما يعني الحدث. فعلى هذا لا يصح في تأويل قوله تعالى: { والله خلقكم وما تعملون } [243] إلا قول أهل السنة أن المعنى والله خلقكم وأعمالكم، ولا يصح قول المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول لأنهم زعموا أن ما واقعة على الحجارة التي كانوا ينحتونها أصنامًا. وقالوا: تقدير الكلام خلقكم والأصنام التي تعلمون إنكارًا منهم أن تكون أعمالنا مخلوقة لله سبحانه، واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالوا لأنه تقدم قوله: { أتعبدون ما تنحتون } فما واقعة على الحجارة المنحوتة، ولا يصح غير هذا من جهة النحو، ولا من جهة المعنى. أما النحو فقد تقدم أن ما لا تكون مع الفعل الخاص مصدرًا. وأما المعنى فإنهم لم يكونوا يعبدون النحت، وإنما كانوا يعبدون المنحوتات، فلما ثبت هذا وجب أن تكون الآية التي هي رد عليهم وتقييد لهم واقعة على الحجارة المنحونة والأصنام المعبودة. ويكون التقدير تعبدون حجارة منحوتة والله خلقكم وتلك الحجارة التي تعملون!
هذا كله معنى قول المعتزلة وشرح ما شبهوا به، والنظم على تأويل أهل الحق أبدع والحجة أقطع. والذي ذهبوا إليه فاسد محال، لأنهم أجمعوا معنا على أن أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام.
فإن قيل: فقد تقول عملت الصحيفة وصنعت الجفنة، وكذلك الأجسام معمولة على هذا.
قلنا: لا يتعلق الفعل فيما ذكرتم إلا بالصورة التي هي التأليف والتركيب، وهي نفس العمل. وأما الجوهر المؤلف المركب فليس بمعمول لنا. فقد رجع العمل والفعل إلى الأحداث دون الجواهر. هذا إجماع منا ومنهم، فلا يصلح حملهم على غير ذلك.
وأما ما زعموا من حسن النظم وإعجاز الكلام فهو ظاهر، وتأويلنا معدوم في تأويلهم، لأن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده بالخلق، وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم يخلقون فقال: { أتعبدون ما تنحتون }، [244] أي من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون، وتدعون عبادة من خلقكم وأعمالكم التي تعملون، ولو لم يضف خلق الأعمال إليه في الآية وقد نسبها إليهم بالمجاز ما قامت له حجة من نفس الكلام، لأنه كان يجعلهم خالقين لأعمالهم وهو خالق لأجناس أخر فيشركهم معه في الخلق تعالى الله عن قول الزائغين ولا لعا لعثرات المبطلين، فما أدحض حجتهم، وما أوهى قواعد مذهبهم، وما أبين الحق لمن اتبعه، جعلنا الله من أتباعه وحزبه.
وهذا الذي ذكرناه قاله أبو عبيد في قول حذيفة: إن الله يخلق صانع الخَزَم وصنعته واستشهد بالآية. وخالفه القتيبي في إصلاح الغلط فغلط أشد الغلط ووافق المعتزلة في تأويلها، وإن لم يقل بقيلها. هذا آخر كلام أبي القاسم.
ولقد بالغ في رد ما لا تحتمل الآية سواه أو ما هو أولى بحملها وأليق بها، ونحن وكلُّ محق مساعدوه على أن الله خالق العباد وأعمالهم، وأن كل حركة في الكون فالله خالقها. وعلى صحة هذا المذهب أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة والمعقول والفطر. ولكن لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بها حرصًا على جعلها عليهم حجة. ففي سائر الأدلة غنية عن ذلك على أنها حجة عليهم من وجه آخر مع كون ما بمعنى الذي سنبينه إن شاء الله تعالى.
والكلام إن شاء الله في الآية قي مقامين:
أحدهما في سلب دلالتها على مذهب القدرية. والثاني في إثبات دلالتها على مذهب أهل الحق خلاف قولهم. فههنا مقامان: مقام إثبات ومقام سلب.
فأما مقام السلب فزعمت القدرية أن الآية حجة لهم في كونهم خالقين أعمالهم. قالوا: لأن الله سبحانه أضاف الأعمال إليهم. وهذا يدل على أنهم هم المحدثون لها، وليس المراد ههنا نفس الأعمال، بل الأصنام المعمولة فأخبر سبحانه أنه خالقهم، وخالق تلك الأصنام التي عملوها. والمراد مادتها وهي التي وقع الخلق عليها.
وأما صورتها وهي التي صارت بها أصنامًا فإنها بأعمالهم وقد أضافها إليهم فتكون بأحداثهم وخلقهم فهذا وجه احتجاجهم بالآية.
وقابلهم بعض المثبتين للقدر، وأن الله هو خالق أفعال العباد. فقالوا: الآية صريحة في كون أعمالهم مخلوقة الله فإن ما ههنا مصدرية والمعنى والله خلقهم وخلق أعمالهم. وقرروه بما ذكره السهيلي وغيره، ولما أورد عليهم القدرية كيف تكون ما مصدرية هنا وأي وجه يبقى للاحتجاج عليهم إذا كان المعنى والله خلقكم وخلق عبادتكم وهل هذا إلا تلقين لهم الاحتجاج بأن يقولوا: فإذا كان الله قد خلق عبادتنا للأصنام فهي مرادة له، فكيف ينهانا عنها؟ وإذا كانت مخلوقة مرادة فكيف يمكننا تركها؟ فهل يسوغ أن يحتج على إنكار عبادتهم؟ أجابهم المثبتون بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية. ومقصودها لعرفتم صحة الاحتجاج، فإن الله سبحانه أنكر عليهم عبادة من لا يخلق شيئًا أصلًا، وترك عبادة من هو خالق لذواتهم وأعمالهم. فإذا كان الله خالقكم وخالق أعمالكم. فكيف تدعون عبادته وتعبدون من لا يخلق شيئًا لا ذواتكم ولا أعمالكم؟ وهذا من أحسن الاحتجاج.
وقد تكرر في القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا ما لا يخلق شيئًا وسوى بينه وبين الخالق لقوله: { أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون }، [245] وقوله: { والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون }، [246] وقوله: { هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه }، [247] إلى أمثال ذلك فصح الاحتجاج وقامت الحجة بخلق الأعمال مع خلق الذوات، فهذا منتهى اقدام الطائفتين في الآية كما ترى.
والصواب أنها موصولة، وأنها لا تدل على صحة مذهب القدرية. بل هي حجة عليهم مع كونها موصولة، وهذا يتبين بمقدمة نذكرها قبل الخوض في التقرير. وهي أن طريقة الحجاج والخطاب أن يجرد القصد والعناية بحال ما يحتج له وعليه، فإذا كان المستدل محتجًا على بطلان ما قد ادعى في شيء وهو يخالف ذلك، فإنه يجرد العناية إلى بيان بطلان تلك الدعوى، وأن ما ادُّعي له ذلك الوصف هو متصف بضده لا متصف به. فأما أن يمسك عنه ويذكر وصف غيره فلا.
وإذا تقرر هذا فالله سبحانه أنكر عليهم عبادتهم الأصنام، وبين أنها لا تستحق العبادة. ولم يكن سياق الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته وأن ما هو في معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادة، فلو أنه قال: لا تعبدون الله وقد خلقكم وما تعملون لتعينت المصدرية قطعًا، ولم يحسن أن يكون بمعنى الذي إذ يكون المعنى كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وأوجد أعمالكم فهو المنعم عليكم بنوعي الإيجاد والخلق، فهذا وزان ما قرروه من كونها مصدرية، فأما سياق الآية فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق العبادة فلا بد أن يبين فيه معنى ينافي كونه معبودًا. فبين هذا المعنى بكونه مخلوقًا له، ومن كان مخلوقًا في بعض مخلوقاته فإنه لا ينبغي أن يعبد ولا تليق به العبادة.
وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله: { والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون }، [248] كيف أنكر عليهم عبادة الهة مخلوقة له سبحانه وهي غير خالقة. فهذا يبين المراد من قوله: { والله خلقكم وما تعملون }، [249] ونظيره قوله في سورة الأعراف: { إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم }، [250] أي هم عباد مخلوقون كما أنتم كذلك. فكيف تعبدون المخلوق.
وتأمل طريقة القرآن لو أراد المعنى الذي ذكروه من حسن صفاته وانفراده بالخلق كقول صاحب يس: { وما لي لا أعبد الذي فطرني }، [251] فهنا لما كان المقصود إخبارهم بحسن عبادته واستحقاقه لها. ذكر الموجب لذلك وهي كونه خالقًا لعابده فاطرًا له، وهذا إنعام منه عليه. فكيف يترك عبادته. ولو كان هذا هو المراد من قوله: { والله خلقكم وما تعملون }، [252] كان يقتضي أن يقال ألا يعبدون الله وهو خالقهم وخالق أعمالهم. فتأمله فإنه واضح.
وقول أبي القاسم رحمه الله في تقرير حجة المعتزلة من الآية، إنه لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل. من جهة النحو ليس كذلك.
أما قوله: أن ما لا تكون مع الفعل الخاص مصدرًا، فقد تقدم بطلانه إذ مصدريتها تقع مع الفعل الخاص المبهم لقوله تعالى: { بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون }، [253] وقوله: { بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون } [254] إلى أضعاف ذلك، فإن هذه كلها أفعال خاصة وهي أخص من مطلق العمل فإذا جاءت مصدرية مع هذه الأفعال فمجيئها مصدرية مع العمل أولى.
قولهم إنهم لم يكونوا يعبدون النحت وإنما عبدوا المنحوت حجة فاسدة فإن الكلام في ما المصاحبة للفعل دون المصاحبة لفعل النحت فإنها لا تحتمل غير الموصولة ولا يلزم من كون الثانية مصدرية كون الأولى كذلك فهذا تقرير فاسد * وأما تقريره كونها مصدرية أيضا بما ذكره فلا حجة له فيه.
أما قوله أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام، فيقال ما معنى عدم وقوعها على الجواهر والأجسام؟ أتعني به أن أفعالهم لا تتعلق بإيجادها، أم تعني به أنها لا تتعلق بتغييرها وتصويرها، أم تعني به أعم من ذلك وهو المشترك بين القسمين؟
فإن عنيت الأول فمسلم لكن لا يفيدك شيئا، فإن كونها موصولة لا يستلزم ذلك، فإن كون الأصنام معمولة لهم يقتضي أن تكون مادتها معمولة لهم، بل هو على حد قولهم "عملت بيتا، وعملت بابا، وعملت حائطا، وعملت ثوبا" وهذا إطلاق حقيقي ثابت عقلا ولغة وشرعا وعرفا لا يتطرق إليه رد، فهذا ككون الأصنام معمولة سواء.
وإن عنيت أن أفعالهم لا تتعلق بتصويرها فباطل قطعا. وإن عنيت القدر المشترك فباطل أيضا، فإنه مشتمل على نفي حق وباطل فنفي الباطل صحيح ونفي الحق باطل.
ثم يقال إيقاع العمل منهم على الجواهر والأجسام يجوز أن يطلق فيه العمل الخاص وشاهده في الآية: { أتعبدون ما تنحتون } [255] فما ههنا موصولة فقد أوقع فعلهم وهو النحت على الجسم وحينئذ فأي فرق بين إيقاع أفعالهم الخاصة على الجوهر والجسم وبين إيقاع أفعالهم العامة عليه لا بمعنى أن ذاته مفعولة له، بل بمعنى أن فعلهم هو الذي صار به صنما واستحق أن يطلق عليه اسمه كما أنه بعملهم صار منحوتا واستحق هذا الاسم وهذا بين.
وأما قوله بجواب النقض بعملت الصحيفة وصنعت الجفنة أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التأليف والتركيب وهي نفس العمل، فكذلك هو أيضا متعلق بالتصوير الذي صار الحجر به صنما منحوتا سواء.
وأما قوله الآية في بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده بالخلق فقد تقدم جوابه وأن الآية وردت لبيان عدم استحقاق معبوديهم للعبادة لأنها مخلوقة لله وذكرنا شواهده من القرآن.
فإن قيل كان يكفي في هذا أن يقال أتعبدون ما تنحتون والله خالقه فلما عدل إلى قوله: { والله خلقكم وما تعملون } [256] علم أنه أراد الاحتجاج عليهم في ترك عبادته سبحانه وهو خالقهم وخالق أفعالهم.
قيل: في ذكر خلقه سبحانه لآلهتهم ولعابديها من بيان تقبيح حالهم وفساد رأيهم وعقولهم في عبادتها دونه تعالى ما ليس في الاقتصار على ذكر خلق الآلهة فقط فإنه إذا كان الله تعالى هو الذي خلقكم وخلق معبوديكم فهي مخلوقة أمثالكم، فكيف يعبد العاقل من هو مثله ويتألهه ويفرده بغاية التعظيم والإجلال والمحبة؟ وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسكم وفي حق ربكم!
وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: { إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم }، [257] ومن حق المعبود أن لا يكون مثل العابد، فإنه إذا كان مثله كان عبدا مخلوقا، والمعبود ينبغي أن يكون ربا خالقا. فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه. فقد أسفر لك من المعنى المقصود بالسياق صبحه ووضح لك شرحه وانجلى بحمد الله الإشكال وزال عن المعنى غطاء الإجمال وبان أن ابن قتبية في تفسير الآية وفق للسداد كما وفق لموافقة أهل السنة في خلق أعمال العباد. ولا تستطل هذا الفصل فإنه يحقق لك فصولا لا تكاد تسمعها في خلال المذاكرات ويحصل لك قواعد وأصولا لا تجدها في عامة المصنفات.
فإن قيل فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد على تقدير كون ما موصولة؟
قيل: نعم قد سبق الوعد بذلك وقد حان انجازه وآن ابرازه. ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير أن الله سبحانه أخبر أنه خالقهم وخالق الأصنام التي عملوها وهي إنما صارت أصناما بأعمالهم فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم فإذا كان سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها بجملتها أعني مادتها وصورتها، فإذا كانت صورتها مخلوقة لله كما أن مادتها كذلك، لزم أن يكون خالقا لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة لأنه متولد عن نفس حركاتهم. فإذا كان الله خالقها كانت أعمالهم التي تولد عنها ما هو مخلوق الله مخلوقة له، وهذا أحسن استدلالا وألطف من جعل ما مصدرية.
ونظيره من الاستدلال سواء قوله: { وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما يركبون }. [258] والأصح أن المثل المخلوق هنا هو السفن وقد أخبر أنها مخلوقة وهي إنما صارت سفنا بأعمال العباد. وأبعد من قال إن المثل ههنا هو سفن البر وهي الإبل لوجهين:
أحدهما أنها لا تسمي مثلا للسفن لا لغة ولا حقيقة، فإن المثلين ما سد أحدهما مسد الآخر، وحقيقة المماثلة أن يكون بين فلك وفلك لا بين جمل وفلك.
الثاني أن قوله: { إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم }، [259] عقب ذلك دليل على أن المراد الفلك التي إذا ركبوها قدرنا على إغراقهم فذكرهم بنعمه عليهم من وجهين: أحدهما ركوبهم إياها، والثاني أن يسلمهم عند ركوبها من الغرق.
ونظير هذا الاستدلال أيضا قوله تعالى: { والله جعل لكم مما خلق ظلالًا وجعل لكم من الجبال أكنانًا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم } [260] والسرابيل التي يلبسونها وهي مصنوعة لهم، وقد أخبر بأنه سبحانه هو جاعلها، وإنما صارت سرابيل بعملهم. ونظيره: { والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتًا } [261] والبيوت التي من جلود الأنعام هي الخيام، وإنما صارت بيوتًا بعملهم.
فإن قلت: المراد من هذا كله المادة لا الصورة.
قلت: المادة لا تستحق هذه الأسماء التي أطلق الخلق عليها، وإنما تستحق هذه الأسماء بعد عملها وقيام صورها بها، وقد أخبر أنها مخلوقة له في هذه الحال. والله أعلم.
فائدة: ضمير من يكرمني
الذي يدل على أن الضمير من يكرمني ونحوه الياء دون ما معها وجوه:
أحدها: القياس على ضمير المخاطب، والغائب في أكرمك وأكرمه.
الثاني: أن الضمير في قولك أني وأخواته هو الياء وحدها لسقوط النون اختيارًا في بعضها، وجوازًا في أكثرها، وسماعًا في بعضها، ولو كان الضمير هو الحرفين لم يسقطوا أحدهما.
الثالث: إدخالهم هذه النون في بعض حروف الجر وهي من وعن. ولو كانت جزءًا من الضمير لأطردت في إلي وفي وسائر حروف الجر. فإن قلت: فما وجه اختصاصها ببعض الحروف والأسماء، والجواب: أنهم أرادوا فصل الفعل والحروف المضارعة له من توهم الإضافة إلى الياء، فألحقوها علامة للانفصال. وهي في أكثر الكلام نون ساكنة وهو التنوين. فإنه لا يوجد في الكلام إلا علامة لانفصال الاسم. ولذلك ألحقوها في القوافي المعرفة باللام أبدًا بإتمام البيت وانفصاله مما بعده نحو العتابا والزرافا، ولذلك زادوها قبل علامة الإنكار حين أرادوا فصل الاسم من العلامة كي لا يتوهم أنها تمام الاسم، أو علامة جمع. ففصل بين الاسم وبينها بنون زائدة، وأدخل عليها ألف الوصل لسكونها، ثم حركتها بالكسر لالتقاء الساكنين. فلما كان من أصلهم تخصيص النون بعلامة الانفصال واجبًا وأرادوا فصل الفعل وما ضارعه عن الإضافة إلى الياء، جاؤوا بهذه النون الساكنة ولولا سكون الياء لكانت ساكنة كالتنوين، ولكنهم كسروها لالتقاء الساكنين.
فائدة: حذف الألف من ما الاستفهامية
السر في حذف الألف من ما الاستفهامية عند حرف الجر أنهم أرادوا مشاكلة اللفظ للمعنى فحذفوا الألف، لأن معنى قولهم فيم ترغب في أي شيء وإلى م تذهب إلى أي شيء، وحتام لا ترجع حتى أي غاية تستمر ونحوه، فحذفوا الألف مع الجار ولم يحذفوها في حال النصب والرفع كيلا تبقى الكلمة على حرف واحد. فإذا اتصل بها حرف الجر، أو اسم مضاف اعتمدت عليه، لأن الخافض والمخفوض بمنزلة كلمة واحدة.
وربما حذفوا الألف في غير موضع الخفض، ولكن إذا حذفوا الخبر. فيقولون: مه يا زيد؟ أي ما الخبر وما الأمر؟ فلما كثر الحذف في المعنى كثر في اللفظ، ولكن لا بد من هاء السكت لتقف عليها.
ومنه قولهم: مهيم كان الأصل ما هذا يا امرؤ؟ فاقتصروا من كل كلمة على حرف. وهذا غاية الاختصار والحذف. والذي شجعهم على ذلك أمنهم من اللبس لدلالة حال المسؤول والمسؤول عنه على المحذوف، فيهم المخاطب من قوله مهيم ما يفهم من تلك الكلمات الأربع. ونظير هذا قولهم "أيش" في "أي شيء"، و"م الله" في و"أيمين الله".
فائدة بديعة: قوله ثم لننزعن من كل شيعة
قوله عز وجل: { ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيًا }، [262] الشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعضًا أي تابعه. ومنه الأشياع أي الأتباع. فالفرق بين الشيعة والأشياع: أن الأشياع هم التبع. والشيعة القوم الذين شايعوا أي تبع بعضهم بعضًا، وغالب ما يستعمل في الذم، ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك كهذه الآية وكقوله: { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا }، [263] وقوله: { وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل }، [264] وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتماع، ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. والمعنى لننزعن من كل فرقة أشدهم عتوًا على الله وأعظمهم فسادًا، فنلقيهم في النار. وفيه إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولا ثم تكون الأتباع تبعًا لهم فيه، كما كانوا تبعًا لهم في الدنيا.
و { أيهم أشد } للنحاة فيه أقوال:
أحدها: قول الخليل أنه مبتدأ وأشد خبره، ولم يعمل لننزعن فيه، لأنه محكي، والتقدير الذي يقال فيه: { أيهم أشد على الرحمن عتيًا وعلى هذا فأي استفهامية.
الثاني: قول يونس أنه رفع على جهة التعليق للفعل السابق. كما لو قلت علمت أنه أخوك فعلق الفعل عن الفعل كما تعلق أفعال القلوب.
الثالث: قول سيبويه إن أي هنا موصولة مبنية على الضم والمسوغ لبنائها حذف صدر صلتها وعنده أصل الكلام أيهم هو أشد. فلما حذف صدر الصلة بنيت على الضم تشبيهًا لها بالغايات، التي قد حذفت مضافاتها كقبل وبعد. وعلى كل واحد من الأقوال إشكالات نذكرها، ثم نبين الصحيح إن شاء الله.
فأما قول الخليل: فقيل يلزمه ستة أمور:
أحدها: حذف الموصول.
الثاني: حذف الصلة.
الثالث: حذف العائد، لأن تقديره الذي يقال لهم: إنهم أشد، وهذا لا عهد لنا فيه باللغة. وأما ما يحذف من القول فإنه إنما يكون قولًا مجردًا عن كونه صلة لموصول نحو قوله: { والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم }، [265] أي: يقولون أو قائلين. ومثله: { والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى }. [266]
الرابع: أنه إذا قدر المحذوف هكذا لم يستقم الكلام فإنه يصير { لننزعن من كل شيعة } الذي يقال فيهم: { أيهم أشد } وهذا فاسد فإن ذلك المنزوع لا يقال فيه أيهم أشد بل هو نفسه أشد، أو من أشد الشيعة على الرحمن فلا يقع عليه الاستفهام بعد نزعه، فتأمله.
الخامس: أن الاستفهام لا يقع إلا بعد أفعال العلم والقول على الحكاية، ولا يقع بعد غيره من الأفعال. تقول: علمت أزيد عندك، أم عمرو، ولو قلت: ضربت أزيد أم عمرو ولم يجز وننزعن ليس من أفعال العلم. فإذا قلت: ضربت أيهم قام لم تكن إلا موصولة ولا يصح أن يقال ضربت الذي يقال فيه أيهم قال، وإنما توهم مثل ذلك لكون اللفظ صالحًا لجهة أخرى مستقيمة فيتوهم متوهم أن حمله على الجهة الأخرى يسقيم. والذي يدل عليه أنه لو قدرت موضعه استفهامًا صريحًا ليس له جهة أخرى لم يجز. فلو قلت: ضرب أزيد عندك أم عمرو لم يجز بخلاف ضرب أيهم عندك. فلو كان أيهم استفهامًا لجاز الكلام مع الاستفهام الذي بمعناهما، وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم والقول. أما القول فلأنه يحكي به كل جملة خبرية كانت أو إنشائية. وأما أفعال العلم فإنما وقع بعدها الاستفهام لكون الاستفهام مستعلمًا به. فكأنك إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو كان معناه اعلمني. وإذا قلت: علمت أزيد عندك أم عمرو؟ كان معناه علمت ما يطلب استعلامه فلهذا صح وقوع الاستفهام بعد العلم. لأنه استعلام، ثم حمل الحسبان والظن عليهما لكونهما من بابه. ووجه آخر وهو كثرة استعمال أفعال العلم فجعل لها شأن ليس لغيرها.
السادس: أن هذا الحذف الذي قدره في الآية حذف لا يدل عليه سياق فهو مجهول الوضع. وكل حذف كان بهذا المنزلة كان تقديره من باب علم الغيب.
وأما قول يونس فإشكاله ظاهر فإن التعليق، إنما يكون في أفعال القلوب نحو العلم والظن والحسبان دون غيرها. ولا يجوز أن تقول: ضربت أيهم. قام على أن تكون أيهم استفهامًا وقد علق الفعل عن العمل فيه.
وأما قول سيبويه فإشكاله أنه بناء خارج عن النظائر ولم يوجد في اللغة شاهد له.
قال السهيلي: ما ذكره سيبويه لو استشهد عليه بشاهد من نظم أو نثر أو وجدنا بعده في كلام فصيح شاهدًا له لم نعدل به قولًا ولا رأينا لغيره عنه طولًا، ولكنا لم نجز ما بين لمخالفته غيره، لا سيما مثل هذه المخالفة فإنا لا نسلم أنه حذف من الكلام شيء. وإن قال: إنه حذف ولا بد والتقدير أيهم هو أخوك؛ فيقال: لم لم يبنوا في النكرة فيقولون: مررت برجل أخوك، أو رأيت رجلًا أبوك أي هو أخوك وأبوك. ولم خصوا أيًا هذا دون سائر الأسماء أن يحذف من صلته، ثم يبنى للحذف. ومتى وجدنا شيئًا من الجملة يحذف، ثم يبنى الموصوف بالجملة من أجل ذلك الحذف. وذلك الحذف لا نجعله متضمنًا لمعنى الحرف، ولا مضارعًا له. وهذه علة البناء وقد عدمت في أي.
قال: والمختار قول الخليل لكنه يحتاج إلى شرح، وذلك أنه لم يرد بالحكاية ما يسبق إلى الفهم من تقدير معنى القول، ولكنه أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو أصل في أي كما يحكيه بعد العلم. إذا قلت: قد علمت من أخوك وأقام زيد أم قعد فقد تركت الكلام على حاله قبل دخول الفعل لبقاء معنى الاختصاص والتعيين في أي الذي كان موجودًا فيها وهي استفهام، لأن ذلك المعنى هو الذي وضعت له استفهامًا كانت، أو خبرًا كما حكوا لفظ النداء في قولهم اللهم اغفر لي أيها الرجل، وارحمنا أيتها العصابة. فنحكي لفظ هذا إشعارًا بالتعيين والاختصاص الموجود في حال النداء لوجود معنى الاختصاص والتعيين فيه.
قال: وقول يونس: إن الفعل ملغى حق وإن لم تكن من أفعال القلب وعلة إلغائه ما قدمناه من حكاية لفظ الاستفهام للاختصاص.
فإذا أتممت لفظة الصلة وقلت: ضربت أيهم أخوك، زالت مضارعة الاستفهام وغلب فيه معنى الخبر لوجود الصلة التامة بعده.
قال وأما قوله تعالى: { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون }، [267] وإجماعهم على أنها منصوبة بينقلبون لا بسيعلم. وقد كان يتصور فيها أن تكون منصوبة بسيعلم على جهة الاستفهام، ولكن تكون موصولة والجملة صلتها والعائد محذوف. ولكن منع من هذا أصل أصلناه ودليل أقمناه على أن الاسم الموصول إذا عني به المصدر ووصل بفعل مشتق من ذلك المصدر لم يجز لعدم الفائدة المطلوبة من الصلة وهي إيضاح الموصول وتبيينه. والمصدر لا يوضح فعله المشتق من لفظه، لأنه كأنه هو لفظًا ومعنى إلا في المختلف الأنواع كما تقدم.
قال: ووجه آخر أقوى من هذا وهو أن أيًا لا تكون بمعنى الذي حتى تضاف إلى معرفة. فتقول: لقيت أيهم في الدار إذ من المحال أن يكون بمعنى الذي وهو نكرة. والذي لا ينكر وهذا أصل يبنى عليه في "أي".
فائدة: تحقيق معنى أي
فصل في تحقيق معنى أي
وهو أن لفظ الألف والياء المكررة راجع في جميع الكلام إلى معنى التعيين والتمييز للشيء من غيره، فمنه أياة الشمس لضوءها لأنه يبينها ويميزها من غيره، ومنه الآية العلامة، ومنه خرج القوم بآيهم أي بجماعتهم التي يتميزون بها عن غيرهم، ومنه تأييت بالمكان أي تثبت لتبيين شيء، أو تمييزه ومنه قول امرىء القيس:
قف بالديار وقوف حابسْ ** وتأيَّ إنك غير يائسْ
وقال الكميت: * وتأيَّ إنك غير صاغر *
ومنه إياك في المضمرات، لأنه في أكثر الكلام مفعول مقدم، والمفعول إنما يتقدم على فعله قصدًا إلى تعيينه وحرصًا على تمييزه من غيره وصرفًا للذهن عن الذهاب إلى غيره، ولذلك تقدم في ( إياك نعبد ) إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقيق الوحدانية ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره، ولهذا اختصت أي بنداء ما فيه الألف واللام تمييزًا له وتعيينًا، وكذلك أي زيد، ومنه إياك المراء والأسد أي ميز نفسك وأخلصها عنه. ومنه وقوع أي تفسيرًا كقولك: عندي عهن أي صوف.
وأما وقوعها نفيًا لما قبلها نحو مررت برجل أي رجل. فأي تدرجت إلى الصفة من الاستفهام كان الأصل أي رجل هو على الاستفهام الذي يراد به التفخيم والتهويل، وإنما دخله التفخيم لأنهم يريدون إظهار العجز والإحاطة لوصفه فكأنه مما يستفهم عنه بجهل كنهه. فأدخلوه في باب الاستفهام الذي هو موضوع لما يجهل. وكذلك جاء: { القارعة * ما القارعة } [268] و { الحاقة * ما الحاقة } [269] أي أنها لا يحاط بوصفها. فلما ثبت هذا اللفظ في باب التفخيم والتعظيم للشيء قرب من الوصف حتى أدخلوه في باب النعت، وأخروه في الإعراب عن ما قبله ومنه: * جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط * أي كأنه في لون الذئب إن كنت رأيت الذئب. ومنه "مررت بفارس هل رأيت الأسد"، وهذا التقدير أحسن من قول بعض النحويين أنه معمول وصف مقدر، وهو قول محذوف أي مقول فيه هل رأيت كذا، وما ذكرته لك أحسن وأبلغ فتأمله.
فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب
ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام.
أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات وموجود وشيء.
الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع.
الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرزاق.
الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتًا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام.
الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والغفار وأمجد الناقة علفًا. ومنه { ذو العرش المجيد } [270] صفة للعرض لسعته وعظمه وشرفه.
وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه ﷺ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء، وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا يحسن أنك أنت السميع البصير فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه.
ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام». ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام». فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده وإنه الذي لا إله إلا هو المنان. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله.
ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد، وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: "لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم". واشتقاقه يدل على هذا، فإنه في الجمع والقصد الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا أصله في اللغة كما قال:
ألا بكر الناعي بخير بني أسد ** بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد
والعرب تسمى أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه.
السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو: الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر. فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية. والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتًا كقوله تعالى: { لا تأخذه سنة ولا نوم }، [271] فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى: { وما مسنا من لغوب } [272] متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله: { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة }، [273] متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: { لم يلد ولم يولد } متضمن لكمال صمديته وغناه وكذلك قوله: { ولم يكن له كفوًا أحد } متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، وكذلك قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار } [274] متضمن لعظمته. وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به. وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب.
(في أسماء الله وصفاته)
ويجب أن يعلم هنا أمور:
أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى، أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا.
الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق. بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلًا وخبرًا.
الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم.
الرابع: أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف. والوصف بها لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى.
الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات. دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. ودلالة على أحدهما بالتضمن. ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم.
السادس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة.
السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية، أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع.
الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلًا ومصدرًا نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: { قد سمع الله }، [275] { فقدرنا فنعم القادرون }. [276] هذا إن كان الفعل متعديًا. فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به نحو الحي. بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حيي.
التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملًا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به.
العاشر: احصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه، إما أن تكون خلقًا له تعالى أو أمرًا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه. فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به، ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلًا ولا سدى ولا عبثًا. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده. فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى ولهذا لا تجد فيها خللًا ولا تفاوتًا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله. إما أن يكون لجهله به، أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض.
الحادي عشر: إن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلًا، وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم. ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل. فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلًا ولا وصفًا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول. فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح.
المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها.
المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها.
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها } [277] وهو مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال: يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلًا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل، ولا سيما خاتمهم وإمامهم، وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال التخلق. وأحسن منها عبارة من قال التعبد. وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن.
الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. فقالت طائفة من المتكلمين. هي حقيقة في العبد مجاز في الرب. وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادًا. الثاني: مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول أبي العباس الناشي. الثالث: أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها. فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر.
الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات. اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. الاعتبار الثاني: اعتباره مضافًا إلى الرب مختصًا به. الثالث: اعتباره مضافًا إلى العبد مقيدًا به فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتًا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه، ولا يشابههم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برىء من فرث التشبيه ودم التعطيل. وهذا طريق أهل السنة، وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولًا به مفتقرًا إليه محاطًا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى، وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها. فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فاذا أحطت بهذه القاعدة خبرًا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتن هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل، وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت الله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة فخلصت من التعطيل، ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه، فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب.
الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره، والمعنويان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره، ولا يكون خبرًا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من ذلك مثالًا واحدًا وهو صفة الكلام، فإنه إذا قامت بمحل كانت هو التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها، وعاد حكمها إليه دون غيره. فيقال: قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك. وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردًا وعكسًا.
السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي ﷺ في حديث الشفاعة: «فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن» وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله ﷺ: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». وأما قوله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة». فالكلام جملة واحدة. وقوله: «من أحصاها دخل الجنة»، صفة لا خبر مستقبل. والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.
السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره، وهو غالب الأسماء. فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وهذا يسوغ أن يدعا به مفردًا ومقترنًا بغيره، فتقول: يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم. وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، بل مقرونًا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو. فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا وانتقامًا. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. ولذلك لم تجىء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت: يا مذل، يا ضار، يا مانع، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه، ولا حامدًا له حتى تذكر مقابلها.
الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال. وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالًا، ولا نقصًا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا وهو ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها كمال محض فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب، أو نقص، فله من صفة الإدراكات العلم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر، الرحيم، الودود، دون الرفيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارىء المصؤر دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه، فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا نعدل عما سمي به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون.
التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالًا على عدة صفات ويكون ذلك الاسم متناولًا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما. تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفوًا أحد وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار هذا لفظه.
وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى. ففسر الاسم بدون معناه، ونقصه من حيث لا يعلم، فمن لم يحط بهذا علمًا بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره.
العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون } [278] والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته ل ح د. فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد: وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: { ولن تجد من دونه ملتحدًا } [279] أي من تعدل إليه، وتهرب إليه، وتلتجىء إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه.
(أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى)
إذا عرف هذا. فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:
أحدها: أن يسمي الأصنام بها كتسمتيهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إلهًا، وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.
الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبًا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك.
وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه، ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود أنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه.
وقولهم: { يد الله مغلولة }، [280] وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات، ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين. فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه.
ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب. وكل من جحد شيئًا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر.
وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا كبيرًا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة. فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد، وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنى. بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. فكان إثباتهم بريًا من التشبيه، وتنزيههم خليًا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنمًا أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا.
وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعته رسوله إنه قريب مجيب.
فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به تبارك وتعالى فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبًا عاقلًا ولسانًا قائلًا ومحلًا قابلًا وإلا فالسكوت أولى بك فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: { وفوق كل ذي علم عليم } [281] حتى ينتهى العلم إلى من أحاط بكل شيء علمًا. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيًا فيه أحكام هذه القواعد بريئًا من الإلحاد في أسمائه، وتعطيل صفاته فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم.
فائدة: المعنى المفرد لا يكون نعتا
المعنى المفرد لا يكون نعتًا ونعني بالمفرد ما دل لفظه على معنى واحد نحو: علم وقدرة، لأنه لأ رابط بينه وبين المنعوت، لأنه اسم جنس على حياله. فإذا قلت: ذو علم وذو قدرة. كان الرابط ذو. فإذا قلت: عالم وقادر. كان الرابط الضمير فكل نعت وإن كان مفردًا في لفظه فهو دال على معلومين: حامل ومحمول. فالحامل هو الاسم المضمر، والمحمول هو الصفة، وإنما أضمر في الصفة، ولم يضمر في المصدر وهو الصفة في الحقيقة لأن هذا الوصف مشتق من الفعل، والفعل هو الذي يضمر فيه دون المصدر، لأنه إنما صيغ من المصدر ليخبر به عن فاعل. فلا بد له مما صيغ لأجله، إما ظاهرًا وإما مضمرًا. ولا كذلك المصدر لأنه اسم جنس فحكمه حكم سائر الأجناس، ولذلك ينعت الاسم بالفعل لتحمله الضمير.
فإن قلت: فأيهما هو الأصل في باب النعت؟
قلت: الاسم أصل للفعل في باب النعت، والفعل أصل لذلك الاسم لي غير باب النعت، وإنما قلنا: ذلك لأن حكم النعت أن يكون جاريًا على المنعوت في إعرابه، لأنه هو مع زيادة معنى ولأن الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام لعمله في الاسم. وحق العامل التقدم لا سيما إن قلنا إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. وعلى هذا لا يتصور أن يكون الفعل أصلًا في باب النعت، لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال فعلى هذا لا ينبغي أن ينعت النعت. فتقول: مررت برجل عاقل كريم على أن يكون كريمًا صفة للعاقل، بل للرجل لأن النعت ينبىء عن الاسم المضمر وعن الصفة والمضمر لا ينعت، ولأنه قد صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل والجملة لا تنعت ولأنه يجري مجرى الفعل في رفع الأسماء، والفعل لا ينعت قاله ابن جني. وبعد فلا يمتنع أن ينعت النعت، إذا جرى النعت الأول مجرى الاسم الجامد ولم يرد به ما هو جار على الفعل.
فصل: إقامة النعت مقام المنعوت
ولما علم من افتقاره إلى الضمير لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين:
أحدهما: احتماله الضمير فإذا حذفت المنعوت لم يبق للضمير ما يعود عليه.
الثاني: عموم الصفة فلا بد من بيان الموصوف بها ما هو.
فإن أجريت الصفة مجرى الاسم مثل: جاءني الفقيه وجالست العالم، خرج عن الأصل الممتنع وصار كسائر الأسماء، وإن جئت بفعل يختص بنوع من الأسماء وأعملته في نوع يختص بذلك النوع، كان حذف المنعوت حسنًا، كقولك: أكلت طيبًا ولبست لينًا وركبت فارها ونحوه. أقمت طويلًا وسرت سريعًا، لأن الفعل يدل على المصدر والزمان فجاز حذف المنعوت ههنا لدلالة الفعل عليه.
وقريب منه قوله تعالى: { ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين } [282] لدلالة الذرية عليه الموصوف بالصفة.
وإن كان في كلامك حكم منوط بصفة اعتمد [283] الكلام على تلك واستغنى عن ذكر الموصوف كقولك: مؤمن خير من كافر، وغني أحظى من فقير، والمؤمن لا يفعل كذا، ولعنة الله على الظالمين، والمؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وقولهم وأبيض كالمخراق.. البيت، وقول الآخر وأسمر خطي.. لأن الفخر والمدح إنما يتعلق بالصفة دون الموصوف. فمضمون هذا الفصل ينقسم خمسة أقسام:
نعت لا يجوز حذف منعوته كقولك لقيت سريعًا وركبت خفيفًا.
ونعت يجوز حذف منعوته على قبح نحو لقيت ضاحكًا ورأيت جاهلًا فجوازه لاختصاص الصفة بنوع واحد من الأسماء.
وقسم يستوي فيه الأمران: نحو أكلت طيبًا وركبت فارهًا ولبست لينًا وشربت عذبًا لاختصاص الفعل بنوع من المفعولات.
وقسم يقبح فيه ذكر الموصوف لكونه حشوًا في الكلام. نحو أكرم الشيخ ووقر العالم وارفق بالضعيف وارحم المسكين وأعط الفقير وأكرم البر وجانب الفاجر. ونظائره لتعليق الأحكام بالصفات واعتمادها عليها بالذكر.
وقسم لا يجوز فيه البتة ذكر الموصوف كقوله: دابة أبطح وأجرع. وأبرق للمكان وأسود للحية وأدهم للقيد وأخيل للطائر. فهذه في الأصول نعوت ولكنهم لا يجرونها نعتًا على منعوت فنقف عند ما وقفوا، ونترك القياس إذا تركوا.
فائدة بديعة: النعت السببي
إذا نعت الاسم بصفة هي لسببه ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو الأصل أن تقول مررت برجل حسن أبوه بالرفع، لأن الحسن ليس صفة له فتجري عليه، وإنما ذكرت الجملة ليميز بها بين الرجل، وبين من ليس عنده أب كأبيه. فلما تميز بالجملة من غيره صارت في موضع النعت وتدرجوا من ذلك إلى أن قالوا: حسن أبوه بالجر وأجروه نعتًا على الأول وإن كان الأب من حيث تميز وتخصص كما يتخصص بصفة نفسه.
والوجه الثالث مررت برجل حسن الأب فيصير نعتًا للأول ويضمر فيه ما يعود عليه حتى كان الحسن له، وإنما فعلوا ذلك مبالغة وتقريبًا للنسب وحذفًا للمضاف وهو الأب وإقامة المضاف إليه مقامه وهو الهاء. فلما قام الضمير مقام الاسم المرفرع صار ضميرًا مرفوعًا فاستتر في الفعل فقلت برجل حسن، ثم أضفته إلى النسب الذي من أجله كان حسنًا وهو الأب ودخول الألف واللام على النسب، إنما هي لبيان الحسن. وهذا الوجه لا يجوز إلا في الموضع الذي يجوز فيه حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وذلك غير مطرد الجواز وإنما يجوز حيث يقصدون المبالغة تفخيم الأمر وإن بعد النسب كان الجواز أبعد كقولك: نابح الكلب وصاهل فرس العبد. وما امتنع في هذا الفصل فإنه يجوز في الفصل الذي قبله من حيث لم يقيموا فيه مضافًا مقام المضاف إليه.
وإنما حكمنا باختلاف المعاني في هذه الوجوه الثلاثة. من حيث اختلف اللفظ فيها، لأن الأصل أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف المعنى، ولا يحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. فمعنى الوجه الأول تمييز الاسم من غيره بالجملة التي بعده. ومعنى الوجه الثاني تمييز الاسم من غيره مع انجرار الوصف إليه بمدح أو ذم. ومعنى الوجه الثالث نقل الصفة كلها إلى الأول على حذف المضاف مع تبيين السبب الذي صيره، كذلك وأكثر ما يكون هذا الوجه فيما قرب سببه جدًا. نحو عظيم القدر وشريف الأب، لأن شرف الأب شرف له، وكذلك القدر والوجه، وههنا يحسن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
فائدة: اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه
إن قيل: لم اكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه، ولم يكتسب المضاف إليه التنكير من المضاف وهو مقدم عليه في اللفظ، لا سيما والتنكير أصل في الأسماء والتعريف فرع عليه؟
قيل: الجواب من وجهين:
أحدهما: أنهم قد حكم غلبوا المعرفة على النكرة في غير هذا الموضع نحو هذا زيد ورجل ضاحكين على الحال، ولا يجوز ضاحكان على النعت تغليبًا لحكم المعرفة، لأنهم رأوا الاسم المعرفة يدل على معنيين الرجل وتعيينه، والشيء وتخصيصه من غيره، والنكرة لا تدل إلا على معنى مفرد فكان ما يدل على معنيين أقوى مما يدل على معنى واحد وهذا أصل نافع فحصله.
الثاني: أن المضاف إليه بمنزلة آلة التعريف فصار كالألف واللام. ألا ترى أنك إذا قلت: غلام زيد فهو بمنزلة قولك الغلام لمن تعرفه بذلك. وكذلك إذا قلت: كتاب سيبويه فهو بمنزلة قولك الكتاب، وكذلك إذا قلت: سلطان المسلمين فهو بمنزلة قولك السلطان فتعريفه باللام في أوله وتعريفه بالإضافة من آخره.
فإن قيل: فإذا اكتسب التعريف من المضاف إليه فكان ينبغي أن يعطي حكمه.
قيل: وإن استفاد منه التعريف لم يستفد منه خصوصية تعريفه، وإنما اكتسب منه تعريفًا آخر كما اكتسبه من لام التعريف. ألا ترى أنه إذا أضيف إلى المضمر لم يكتسب منه الإضمار، وإذا أضيف إلى المبهم لم يكتسب منه الإبهام، فلا الأول اقتبس من الثاني خصوصية تعريفه، ولا الثاني اقتبس من الأول تنكيره والمضاف إليه في ذلك كالآلة الداخلة على الاسم.
فائدة: تفسير الكلام
من كلام السهيلي: الكلام هو تعبير عما في نفس المتكلم من المعاني. فإذا أضمر ذلك المعنى في نفسه أي أخفاه، ودل المخاطب عليه بلفظ خاص، سمي ذلك اللفظ ضميرًا تسمية له باسم مدلوله. ولا يقال فكان ينبغي أن يسمي كل لفظ ضميرًا على ما ذكرتم، لأن هنا مراتب ثلاثة:
أحدها المعنى المضمر وهو حقيقة الرجل مثلا.
والثاني اللفظ المميز له عن غيره وهو زيد وعمرو.
والثالث: اللفظ المعبر عن هذا الاسم الذي إذا أطلق كان المراد به ذلك الاسم بخلاف قولك زيد وعمرو. فإنه ليس ثم إلا لفظ ومعنى فخصوا اسم الضمير بما ذكرناه. والمضمرات في كلامهم ستين ضميرًا وأحوالها معلومة، لكن ننبه على أسرارها من أحكام المضمرات.
اعلم أن المتكلم لما استغنى عن اسم الظاهر في حال الأخبار لدلالة المشاهدة عليه جعل مكانه لفظًا يومىء به إليه وذلك اللفظ مؤلف من همزة ونون. أما الهمزة فلأن مخرجها من الصدر وهو أقرب مواضع الصوت إلى المتكلم إذ المتكلم في الحقيقة محله وراء حبل الوريد. قال الله تعالى: { ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد }، [284] ألا تراه يقول: { ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد }، [285] يعني ما يلفظ المتكلم، فدل على أن المتكلم أقرب شيء إلى حبل الوريد، فإذا كان المتكلم على الحقيقة. محله هناك وأردت من الحروف ما يكون عبارة عنه. فأولاها بذلك ما كان مخرجه من جهته، وأقرب المواضع إلى محله وليس إلا الهمزة أو الهاء، والهمزة أحق بالمتكلم لقوتها بالجهر والشدة وضعف الهاء بالخفاء فكان ما هو أجهر أقوى وأولى بالتعبير عن اسم المتكلم الذي الكلام صفة له وهو أحق بالاتصاف به.
وأما تآلفها مع النون؛ فلما كانت الهمزة بانفرادها لا تكون اسمًا منفصلًا كان أولى ما وصلت به النون أو بحرف المد واللين إذ هي أمهات الزوائد. ولم يمكن حروف المد مع الهمزة لذهابها عند التقاء الساكنين نحو أنا الرجل فلو حذف الحرف الثاني لبقيت الهمزة في أكثر الكلام منفردة مع لام التعريف فتلتبس بالألف التي هي أخت اللام، فيختل أكثر الكلام، فكان أولى ما قرن به النون لقربها من حرف المد واللين ثم ثبتوا النون لخفائها بالألف في حال السكت، أو بهاء في لغة من قال: إنه.
ثم لما كان المخاطب مشاركًا للمتكلم في حال معنى الكلام، إذ الكلام مبدأه من المتكلم، ومنتهاه عند المخاطب، ولولا المخاطب ما كان كلام المتكلم لفظًا مسموعًا، ولا احتاج إلى التعبير عنه، فلما اشتركا في المقصود بالكلام وفائدته اشتركا في اللفظ الدال على الاسم الظاهر وهو الألف والنون، وفرق بينهما بالتاء خاصة، وخصت التاء بالمخاطب لثبوتها علامة الضمير في قمت، إلا أنها اسم، وفي أنت حرف.
فإن قلت: فهي علامة لضمير المتكلم في قمت فلم كان المخاطب أولى بها.
قلت: الأصل في التاء للمخاطب، وإنما المتكلم دخيل عليه، ولما كان دخيلًا عليه خصوه بالضم، لأن فيه من الجمع والإشارة إلى نفسه ما ليس في الفتحة، وخصوا المخاطب بالفتح، لأن في الفتحة من الإشارة إليه ما ليس في الضمة. وهذا معلوم في الحس.
وأما ضمير المتكلم المخفوض فإنما كان ياء، لأن الاسم الظاهر لما ترك لفظه استغناء ولم يكن بد من علامة دالة عليه كان أولى الحروف بذلك حرف من حروف الاسم المضمر وذلك لا يمكن لاختلاف أسماء المتكلمين، وإنما أرادوا علامة تختص بكل متكلم في حال الخفض والأسماء مختلفة الألفاظ متفقة في حال الإضافة إلى الياء في الكسرة التي هي علامة الخفض إلا أن الكسرة لا تستقل بنفسها حتى تمكن فتكون ياء، فجعلوا الياء علامة لكل متكلم مخفوض، ثم شركوا النصب مع الحفظ في علامة الإضمار لاستوائها في المعنى إلا أنهم زادوا نونًا في ضمير المنصوب وقاية للفعل من الكسر.
وأما ضمير المتكلم المتصل فعلامته التاء المضمومة. وأما المتكلمون فعلامتهم نافي الأحوال كلها.
وسره أنهم لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف ما يكون علامة عليه أخذوا من الاسم الظاهر ما يشترك جميع المتكلمين فيه في حال الجمع والتثنية وهي النون التي في آخر اللفظ وهي موجودة في التثنية والجمع رفعًا ونصبًا وجرًا، فجعلوها علامة للمتكلمين جمعًا كانوا أو تثنية وزادوا بعدها ألفًا كيلا تشبه التنوين، أو النون الخفيفة. ولحكمة أخرى وهي القرب من لفظ أنا، لأنها من ضمير المتكلمين فإنها ضمير متكلم فلم يسقط من لفظة أنا إلا الهمزة التي هي أصل في المتكلم الواحد. وأما جمع المتكلم وتثنيته ففرع طار عن الأصل فلم تمكن فيه الهمزة التي تقدم اختصاصها بالمتكلم حتى خصت به في أفعل وخص المخاطب لتاء في تفعل لما ذكرناه.
وأما ضمير المرفوع المتصل فإنما خص بالتاء، لأنهم حين أرادوا حرفًا يكون علامة على الاسم الظاهر المستغنى عن ذكره كان أولى الحروف بذلك حرفًا من الاسم وهو مختلف كما تقدم، فأخذوا من الاسم ما لا تختلف الأسماء فيه في حال الرفع وهي الضمة. وهي لا تستقل بنفسها ما لم تكن واوًا، ثم رأوا الواو لا يمكن تعاقب الحركات عليها لثقلها وهم يحتاجون إلى الحركات في هذا الضمير فرقًا بين المتكلم والمخاطب المؤنث، والمخاطب المذكر فجعلوا التاء مكان الواو لقربها من مخرجها، ولأنها قد تبدل منها في كثير من الكلام كتراث وتجاه. فاشترك ضمير المتكلم والمخاطب في التاء، كما اشتركا في الألف والنون من أنا وأنت، لأنهما شريكان في الكلام لأن الكلام من حيث كان للمخاطب كان لفظًا، ومن حيث كان للمتكلم كان معنى، ثم وقع الفرق بين ضميريهما بالحركة دون الحروف لما تقدم.
وأما ضمير المخاطب نصبًا وجرًا فكان كافًا دون الياء، لأن الياء قد اختص بها المتكلم نصبًا وخفضًا فلو أمكنت فيه الحركات، أو وجد ما يقوم مقامها في البدل كما كانت التاء مع الواو اشترك المخاطب مع المتكلم في حال الخفض، كما اشترك معه في الباقي حال الرفع. فلما لم يمكن ذلك، ولم يكن بد من حروف تكون علامة إضمار كان الكاف أحق بهذا الموطن، لأن المخاطبين وإن اختلف أسماؤهم الظاهرة فكل واحد منهم متكلم ومقصود في الكلام الذي هواللفظ ومن أجله احتيج إلى التعبير بالألفاظ عما في النفس فجعل الكلام المبدوء بها في لفظ الكلام علامة إضمار المخاطب. ألا تراه لا يقع علامة إضمار له إلا بعد كلام كالفعل والفاعل نحو أكرمتك، لأنهما كلام والفعل وحده ليس كلامًا فلذلك لم تكن علامة الضمير كافًا إلا بعد كلام من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر.
فإن قيل: فالمتكلم أيضا هو صاحب الكلام فهو أحق بأن تكون الكاف المأخوذة من لفظ الكلام علامة للاسم.
قيل: الكاف لفظ فهي أحق بالمخاطب، لأن الكلام إنما لفظ به من أجله.
وأما ضمير الغائب المنفصل فهاء بعدها واو، لأن الغائب لما كان مذكورًا بالقلب واستغني عن اسمه الظاهر بتقدمه، كانت الهاء التي مخرجها من الصدر قريبًا من محل الذكر أولى بأن تكون عبارة على مذكور بالقلب، ولم تكن الهمزة لأنها مجهورة شديدة فكانت أولى بالمتكلم الذي هو أظهر، والهاء لخفائها أولى بالغائب الذي هو أخفى وأبطن، ثم وصلت بالواو لأنه لفظ يرمز به إلى المخاطب ليعلم ما في النفس من المذكور والرمز بالشفتين، والواو مخرجها من هناك فخصت بذلك.
ثم طردوا أصلهم في ضمير الغائب المنفرد فجعلوه في جميع أحواله هاء إلا في الرفع، وإنما فعلوا ذلك لأنهم رأوا الفرق بين الحالات واقعًا باختلاف حال الضمير، لأنه إذا دخل عليها حرف الجر كسرت الهاء وانقلبت واوه ياء، وإذا لم يدخل عليه بقي مضمومًا على أصله. وإذا كان في حال الرفع لم يكن له علامة في اللفظ، لأن الاسم الظاهر قبل الفعل علم ظاهر يغني المخاطب عن علامة إضمار في الفعل بخلاف المتكلم. والمخاطب لأنك تقول في الغائب: زيد قائم فتجد الاسم الذي يعود عليه الضمير موجودًا ظاهرًا في اللفظ. ولا تقول في المتكلم: زيد قمت، ولا في المخاطب زيد قمت. فلما اختلف أحوال الضمير الغائب لسقوط علامته في الرفع وتغير الهاء بدخول حروف الخفض قام ذلك عندهم مقام علامات الإعراب في الظاهر وما هو بمنزلتها في المضمر، كالتاء المبدلة من الواو والياء المثبتة والكسرة والكاف المختصة بالمفعول والمجرور الواقعين بعد الكلام التام، ولا يقع بعد الكلام إلا منصوب أو مجرور. فكانت الكاف المأخوذة من لفظ الكلام علامة على المنصوب والمجرور إذا كان مخاطبًا.
وأما نحن فضمير منفصل للمتكلمين تثنية وجمعًا وخصت بذلك لما لم يمكنهم التثنية والجمع في المتكلم المضمر، لأن حقيقة التثنية ضم شيء إلى مثله في اللفظ. والجمع ضم شيء إلى أكثر منه مما يماثله في اللفظ، فإذا قلت: زيدان فمعناه زيد وزيد. وأنتم معناه أنت وأنت وأنت، والمتكلم لا يمكنه أن يأتي باسم مثنى، أو مجموعًا في معناه لأنه لا يمكنه أن يقول: أنا فيضم إلى نفسه مثله في اللفظ. فلما عدم ذلك ولم يكن بد من لفظ يشير إلى ذلك المعنى وإن لم يكنه في الحقيقة جاءوا بكلمة تقع على الاثنين والجمع في هذا الموطن، ثم كانت الكلمة آخرها نون. وفي أولها إشارة إلى الأصل المتقدم الذي لم يمكنهم الإتيان به وهو تثنية أنا التي هي بمنزلة عطف اللفظ على مثله، فإذا لم يمكنهم ذلك في اللفظ مثنى كانت النون المكررة تنبيهًا عليه وتلويحًا عليه. وخصت النون بذلك دون الهمزة لما تقدم من اختصاص ضمير الجمع بالنون وضمير المتكلم بالهمزة، ثم جعلوا بين النون حاء ساكنة لقربها من مخرج الألف الموجودة في ضمير المتكلم قبل النون وبعدها، ثم بنوها على الضم دون الفتح والكسر، إشارة إلى أنه ضمير مرفوع وشاهده ما قلناه في الباب من دلالة الحروف المقطعة على المعاني والرمز بها إليها وقوع ذلك في منثور كلامهم ومنظومه. فمنه: * قلت لها قفي، قالت قاف * ومنه: ألاتا، فيقول الآخر: ألافا؛ يعني ألا ترتحل، فيقول: ألا فارحل. ومنه:
بالخير خيرات وإن شرا فا ** ولا أريد الشر إلا أن تا
وكقولهم مهيم في ما هذا يا امرؤ. وأيش في أي شيء. وم الله في أيمن الله.
ومن هذا الباب حروف التهجي في أوائل السور.
وقد رأيت لابن فورك نحو من هذا في اسم الله. قال: الحكمة في وجود الألف في أوله أنها من أقصى مخارج الصوت قريبًا من القلب الذي هو محل المعرفة إليه، ثم الهاء في آخره مخرجها من هناك أيضا، لأن المبتدأ منه والمعاد إليه، والإعادة أهون من الابتداء. وكذلك لفظ الهاء أهون من لفظ الهمزة هذا معنى كلامه. فلم يقل ما قلناه في المضمرات إلا اقتضابًا من أصول أئمة النحاة واستنباطًا من قواعد اللغة.
فتأمل هذه الأسرار ولا يزهدنك فيها نبو طباغ أكثر الناس عنها، واستغناؤهم بظاهر من الحياة الدنيا عن الفكر فيها، والتنبيه عليها. فإني لم أفحص عن هذه الأسرار وخفي التعليل في الظواهر والإضمار إلا قصد التفكر، والاعتبار في حكمة من خلق الإنسان وعلمه البيان، فمتى لاح لك من هذه الأسرار سر، وكشف لك عن مكنونها فكر فاشكر الواهب للنعمى وقل: رب زدني علمًا.
فائدة بديعة: اسم الإشارة
الاسم من هذا الذال وحدها دون الألف على أصح القولين، بدليل سقوط الألف في التثنية والمؤنث. وخصت الذال بهذا الاسم، لأنها الخارج من طرف اللسان والمبهم مشار إليه، فالمتكلم يشير نحوه بلفظه أو بيده، ويشير مع ذلك بلسانه، فإن الجوارح خدم القلب فإذا ذهب القلب إلى شيء ذهابًا معقولًا. ذهبت الجوارح نحوه ذهابًا محسوسًا.
والعمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان، ولا يمكن إشارته إلا بحرف يكون مخرجه من عذبة اللسان التي هي آلة الإشارة دون سائر أجزائه. فأما الذال أو التاء فالتاء مهموسة رخوة، فالمجهور أو الشديد من الحروف أولى منها للبيان والذال مجهورة فخصت بالإشارة إلى المذكر، وخصت التاء بالإشارة إلى المؤنث لأجل الفرق. وكانت التاء به أولى لهمسها وضعف المؤنث، ولأنها قد ثبتت علامة التأنيث في غير هذا الباب، ثم بينوا حركة الذال بالألف كما فعلوا في النون من أنا، وربما شركوا المؤنث مع المذكر في الذال فاكتفوا بالكسرة فرقًا بينهما، وربما اكتفوا بمجرد لفظ التاء في الفرق بينهما، وربما جمعوا بين لفظ التاء والكسرة حرصًا على البيان.
وأما في المؤنث الغائب فلا بد من التاء مع الكسرة، لأنه أحوج إلى البيان لدلالة المشاهدة على الخاطر ققول: تيك، وربما زادوا اللام توكيدًا كما زادوها في المذكر الغائب إلا أنهم سكنوها في المؤنث لئلا تتوالى الكسرات مع التاء وذلك ثقيل عليهم. وكانت اللام أولى بهذا الموطن حين أرادوا الإشارة إلى البعيد فكثرت الحروف حين كثرت مسافة هذه الإشارة. وقللوها حين قلت لأن اللام قد وجدت في كلامهم توكيدًا. وهذا الموطن موطن توكيد وقد وجدت بمعنى الإضافة للشيء، وهذا الموطن شبيه بها، لأنك إذا أومأت إلى الغائب بالاسم المبهم فأنت مشير إلى من يخاطب ويقبل عليه لينظر إلى من تشير، إما بالعين وإما بالقلب. وكذلك جئت بكاف الخطاب فكأنك تقول له: لك أقول ولك أرمز بهذا الاسم ففي اللام طرف من هذا المعنى كما كان ذلك في الكاف، وكما لم يكن الكاف ههنا اسمًا مضمرًا لم يكن اللام حرف جر، وإنما كل منهما طرف من المعنى دون جميعه فلذلك خلعوا من المكان معنى الاسمية، وأبقوا فيها معنى الخطاب واللام كذلك، إنما اجتلبت لطرف من معناها الذي وضعت له في باب الإضافة.
وأما دخول هاء التنبيه، فلأن المخاطب يحتاج إلى تنبيه على الاسم الذي يشير به إليه، لأن للإشارة قرائن حال يحتاج إلى أن ينظر إليها. فالمتكلم كأنه آمر له بالإلتفات إلى المشار إليه، أو منبه له. فلذلك اختص هذا الموطن بالتنبيه وقلما يتكلمون به في المبهم الغائب، لأن كاف الخطاب يغني عنها مع أن المخاطب مأمور بالإلتفات بلحظه إلى المبهم الحاضر. فكان التنبيه في أول الكلام أولى بهذا الموطن، لأنه بمنزلة الأمر الذي له صدر الكلام.
وعندي أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء. وسائر حروف المعاني لا يجوز أن تعمل معانيها في الأحوال، ولا في الظروف كما لا يعمل معنى الاستفهام والنفي في هل وما في ذلك. ولا نعلم حرفًا يعمل معناه في الحال والظرف إلا كان وحدها على أنها فعل، فدع عنك ما شعبوا به في مسائل الحال في هذا الباب من قولهم: هذا قائمًا زيد وقائمًا. هذا زيد فإنه لا يصلح من ذلك إلا تأخير الحال عن الاسم الذي هو ذا، لأن العامل فيها معنى الإشارة دون معنى التنبيه وكلاهما معنوي.
فإن قيل: لم جاز أن يعمل فيه معنى الإشارة دون معنى التنبيه وكلاهما معنوي.
قيل: معنى الإشارة يدل عليه قرائن الأحوال من الإيماء باللحظ واللفظ من طرف اللسان، وهيئة المتكلم. فقامت تلك الدلالة مقام التصريح بلفظ الإشارة، لأن الدال على المعنى إما لفظ، وإما إشارة وإما لحظ فقد جرت الإشارة مجرى اللفظ فلتعمل فيما عمل فيه اللفظ، وإن لم تقو قوته في جميع أحكام العمل.
وأصح من هذا أن يقال معنى الإشارة ليس هو العامل إذ الاسم الذي هو هذا ليس بمشتق من أشار يشير. ولو جاز أن تعمل أسماء الإشارة لجاز أن تعمل علامات الإضمار، لأنها أيضا إيماء وإشارة إلى مذكور. وإنما العامل فعل مضمر تقديره انظر، وأضمر لدلالة الحال عليه من التوجه واللفظ. وقد قالوا لمن الدار مفتوحًا بابها، فأعملوا في الحال معنى انظر وابصر، ودل عليه التوجه من المتكلم بوجهه نحوها وكذلك هذا بعلي شيخًا وهو قوي في الدلالة لاجتماع اللفظ مع التوجه. وإذا ثبت هذا فلا سبيل إلى تقديم الحال، لأن العامل المعنوي (لا يعمل) حتى يدل عليه الدليل اللفظي أو التوجه، أو ما شاكله.
فائدة: العامل في النعت
العامل في النعت هو العامل في المنعوت. وكان سيبوبه إلى هذا ذهب حين منع أن يجمع بين نعتين للاسمين إذا اتفق إعرابهما، واختلف عاملاهما نحو جاء زيد وهذا عمرو العاقلان.
وذهب قوم إلى أن العامل في النعت معنوي وهو كونه في معنى الاسم المنعوت، فإنما ارتفع أو انتصب من حيث كان هو الأول في المعنى. لا من حيث كان الفعل عاملًا فيه. وكيف يعمل فيه وهو لا يدل عليه. إنما يدل على فاعل، أو مفعول، أو مصدر دلالة واحدة من جهة اللفظ.
وأما الظروف فمن دليل آخر. قال السهيلي: وإلى هذا أذهب. وليس فيه نقض لما منعه سيبويه من النجاح بين نعتي الاسمين المتفقين في الإعراب. إذا اختلف العامل فيهما، لأن العامل في النعت وإن كان هو المنعوت فلولا العامل في المنعوت لما صح رفع النعت، ولا نصبه فكان الفعل هو العامل في النعت فامتنع اشتراك عاملين في معمول واحد. وإن لم يكونا عاملين فيه في الحقيقة، ولكنهما عاملان فيما هو في المعنى.
وإنما قوي عندنا هذا القول الثاني لوجوه. منها امتناع تقديم النعت على المنعوت ولو كان الفعل عاملًا فيه لما امتنع أن يليه معموله كما يليه المعمول تارة، والفاعل أخرى، وكما يليه الحال والظرف. ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيره، لو قلت: قام زيدًا ضارب، تريد ضارب زيدًا أو ضربت عمرًا رجلًا ضاربًا. تريد ضربت رجلًا ضاربًا عمر. لم يجز فلا يلي العامل إلا ما عمل فيه، فكذلك لا يلي كان إلا ما عملت فيه، ولذلك تقول خبر: إن المرفوع ليس بمعمول، لأن وإنما هو على أصله في باب المبتدإ والخبر ولولا ذلك لجاز أن يليها، وإنما وليها إذا كان مجرورًا، لأنها ممنوعة من العمل فيه بدخول حرف الجر، مع أن المجرور رتبته التأخير فلم يبالوا بتقديمه في اللفظ إذ كان موضه التأخير، ولأن المجرور ليس هو بخبر على الحقيقة، وإنما هو متعلق بالخبر والخبر منوي في موضعه أعني بعد الاسم المنصوب بإن.
فإن قيل: ولعل امتناع النعت من التقديم على المنعوت إنما هو من أجل الضمير الذي فيه، والمضمر حقه أن يترتب بعد الاسم الظاهر.
قلنا: هذا ليس بمانع، لأن خبر المبتدأ حامل للضمير ويجوز تقديمه ورب مضمر يجوز تقديمه على الظاهر إذا كان موضعه التأخير.
فإن قيل: ولعل امتناع تقديم النعت، إنما وجب من أجل أنه تبيين للمنعوت وتكملة لفائدته فصار كالصلة مع الموصول.
قلنا: هذا باطل، لأن الاسم المنعوت يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى النعت افتقار الموصول إلى الصلة.
ومما يبين لك أن الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته إذ النعت صفة للمنعوت لازمة له قبل وجود الفعل وبعده فلا تأثير للفعل فيه ولا تسلط له عليه، وإنما التأثير فيه للاسم المنعوت إذ بسببه يرفع وينصب. وإن لم يجز أن تكون الأسماء عوامل في الحقيقة. وهذا بخلاف الحال، لأنها وإن كانت صفة كالنعت وفيها ضمير يعود إلى الاسم فإنها ليست بصفة لازمة للاسم كالنعت، وإنما هي صفة للاسم في حيز وجود الفعل خاصة. فالفعل بها أولى من الاسم فعمل فيه دونه. فلما عمل فيها جاز تقديمها عليه نحو ضاحكًا جاء زيد وجاء ضاحكًا زيد. وتأخيرها بعد الفاعل، لأنها كالمفعول يعمل الفعل فيها والنعت بخلاف هذا كله.
وسنبين بعد هذا إن شاء الله فصلًا عجيبًا في أن الفعل لا يعمل بنفسه إلا بثلاثة أشياء الفاعل، والمفعول به، والمصدر، أو ما هو صفة لأجل هذه الثلاثة في حيز وقوع الفعل ويخرج من هذا الفصل ظرفًا المكان والزمان والنعوت والإبدال والتوكيدات وجميع الأسماء المعمول فيها، ونقيم هنالك البراهين القاطعة على صحة هذه الدعوى.
فائدة بديعة: حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة
حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة أن تكون جارية عليها ليتفق اللفظ، وأما نصب الصفة على الحال فيضعف عندهم لاختلاف اللفظ من غير ضرورة. ورد بعض محققي النحاة هذا القول بالقياس والسماع. قال: أما القياس، فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة والحال، كما إذا قلت: جاء زيد الكاتب وكاتبًا بينهما من الفرق ما تراه فما المانع من الاختلاف؟ كذلك في النكرة. إذا قلت: مررت برجل كاتب أو كاتبًا، لأن الحاجة قد تدعو إلى الحال من النكرة، كما تدعو إلى الحال من المعرفة ولا فرق. وأما السماع فأكثر من أن يحصر فمنه وصلى خلفه رجال قيامًا. وأما نحو وقع أمر فجأة فحال من مصدر وقع لا من أمر، وكذلك أقبل رجل مشيًا. حال من الإقبال.
وهذا صحيح، ولكن الأكثر ما قاله النحاة إيثارًا لاتفاق اللفظ ولتقارب ما بين المعنيين في النكرة، ولتباعد ما بينهما في المعرفة، لأن الصفة في النكرة مجهولة عند المخاطب حالًا كانت أو نعتًا وهي في المعرفة بخلاف ذلك، ولو كانت الحال من النكرة ممتنعة لأجل تنكيرها لما اتفقت العرب على صحتها حالًا إذا تقدمت عليها كما أنشده سيبويه: * لمية موحشًا طلل * وقوله:
وتحت العوالي والقنا مستكنة ** ظباء أعارتها العيون الجآذر
قإن قيل: حمل سيبويه وغيره على أن جعلوا موحشًا حالًا من طلل، وقائمًا حالًا من قولك فيها قائمًا رجل وهو لا يقول بقول الأخفش: إن رجلًا وطللًا فاعل بالإستقرار الذي تعلق به الجار. فلو قال بهذا القول كان عذرًا له في جعلها حالًا منه، ولكن الاسم النكرة عنده مبتدأ وخبره في المجرور قبله، ولا بد في خبر المبتدأ من ضمير يعود على المبتدأ تقدم الخبر، أو تأخر فلم لا تكون هذه الحال من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة. وما الذي دعاهم إلى هذا؟
قيل: هذا سؤال حسن جدًا يجب التقصي عنه والاعتناء به. فقد كع عند أكثر الشارحين للكتاب والمؤلفين في هذا الباب، وما رأيت أحدًا منهم أشار فيه إلى جواب مقنع وأكثرهم لم ينتبه للسؤال ولا تعرض له.
والذي أقوله وبان التوفيق: أن هذه المسألة في النحو بمنزلة مسائل الدور في الفقه، ونضرب فيه مثالًا فنقول: رجل شهد مع آخر في عبد أنه حر فعتق العبد وقبلت شهادته، ثم شهد ذلك الرجل مرة أخرى فأريد تجريحه فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة، فإن قبلت شهادته ثبت جرح الشاهد وبطل العتق، وإذا بطل العتق سقطت الشهادة. وإن سقطت شهادته لم يصح جرح الشاهد، ودارت المسألة هكذا، وكل فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن يسقط في نفسه، وكذلك مسألة هذا الفصل. فإنك إن جعلت الحال من قولك فيها قائمًا رجل من الضمير لم يصح تقدير المضمر إلا مع تقدير فعل يتضمنه، ولا يصح تقدير فعل بعده مبتدأ، لأن معنى الابتداء يبطل ويصير المبتدأ فاعلًا، وإذا صار فاعلًا بطل أن يكون في الفعل ضمير لتقدم الفعل على الفاعل، وإذا بطل وجود الضمير بطل وجود الحال منه وهذا بديع في النظر.
فإن قيل: إن المجرور ينوي به التأخير، لأن خبر المبتدأ حقه أن يكون مؤخرًا.
قيل: وإذا نويت به التأخير لم يصح وجود الحال مقدمة على المبتدأ لأنها لا تتقدم على عاملها إذا كان معنويًا فبطل كون الحال من شيء غير الاسم النكرة الذي هو مبتدأ عند سيبويه، وفاعل عند الأخفش، وهذا السؤال لا يلزم الأخفش على مذهبه، وإنما يلزم سيبويه ومن قال بقوله، ولولا الوحشة من مخالفة الإمام أبي بشر لنصرت قول الأخفش نصرًا مؤزرًا وجلوت مذهبه في منصب التحقيق مفسرًا، ولكن النفس إلى مذهب سيبويه أميل. هذا كلام الفاضل وهو كما ترى كأنه سيل ينحط من صبب.
قلت: والكلام معه في ثلاث مقامات: أحدها: ثحقيق مذهب الأخفش في أن قولك في الدار رجل ارتفاع رجل بالظرف لا بالابتداء. والمقام الثاني أن الحال من النكرة يمتنع أن يكون. حالًا من الضمير في الظرف: والمقام الثالث: الكلام فيما ذكره من الدور في المسألة النحوية وإنه ليس مطابقًا للدور في المسألة الفقهية.
فأما المقام الأول: فاعلم أن الأخفش مذهبه إذا تقدم الظر ف على الاسم المرفوع نحو قي الدار زيد. كان مرفوعًا ارتفاع الفاعل بفعله ومذهبه أيضا، أن المبتدأ إذا كان نكرة لا يسو غ الابتداء به إلا بتقديم الخبر عليه وجب تقديمه عليه نحو: في الدار رجل. تقديم الظرف عنده واجب وجوب تقديم الخبر على المبتدأ به وعلى هذا فلا ضمير في الظرف بحال لو كان مذهبه أن المسألتين سواء في أن الاسم مرفوع بالظرف لم يلزم سببويه أن يقول بقوله حتى يجعل الحال من النكرة، وذلك أن قولك: في الدار رجل ليس في الظرف ضمير فإنه ليس بمشتق، ولا يتحمل ضميرًا بوجه أقصى ما يقال: إن عامله وهو الاستقرار يتضمن الضمير وهذا لا يقتضي رجوع حكم الضمير إلى الظرف حتى ينصب عنه الحال، فإنه ليس واقعًا موقعه، ولا بدل من اللفظ به،. ألا ترى أنك لو صرحت بالعامل لم نستغن عن الظرف، فلو قلت: زيد مستقر، لم تستغن عن قولك في الدار. فعلم أنه إنما حذف حذفًا مستقرًا لمكان العلم به، وليس الظرف نائبًا عنه ولا واقعًا موقعه ليصح تحمله الضمير فتأمله فإنه من بديع النحو، وإذا كان كذلك فلا ضمير في الظرف فينصب عنه الحال بوجه فلم يبق معك ما يصح أن يكون صاحب الحال إلا تلك النكرة الموجودة فلهذا جعل الإمام أبو بشر وأئمة أصحابه الحال منها لا من غيرها.
وأما المقام الثاني: فاعلم أن الظرف إذا تقدم وقدرت فيه الضمير صار بمنزلة الفعل العامل. فإنه لا يتحمل الضمير إلا وهو بمنزلة الفعل أو ما أشبهه، وإذا صار بمنزلة الفعل وهو مقدم وجب أن يتجرد عن الضمير قضاء لحق التشبيه بالفعل وقيامه مقامه. فتعدي الضمير فيه ينافي تقديره.
فإن قيل: إنما قدرنا فيه الضمير الذي كان يستحقه وهو خبر فلما قدم وفيه ما يستحقه من الضمير، بخلاف ما إذا كان عاملا محضًا.
قيل: فهلا قدرت مثل هذا في زيد قام. إنه يجوز أن يقدم قام وتقول قام زيد ويكون مبتدأ وخبرًا فلما أجمع النحاة على امتناع ذلك وقالوا لا يجوز تقديم الخبر هنا لأنه لا يعرف هل المسألة من باب الابتداء والخبر أو من باب الفعل والفاعل. وكذلك ينبغي في نائب الفعل من الظرف سواء فتأمله.
وأما المقام الثالث وهو ما ذكره من الدور، فالدور أربعة أقسام دور حكمي. ودور علمي. ودور معي. ودور سبقي تقدمي.
فالحكمي توقف ثبوت حكمين كل منهما على الآخر من الجهة التي توقف الآخر منها. وأخص من هذه العبارة توقف كل من الحكمين على الآخر من جهة واحدة.
والدور العلمي توقف العلم بكل من المعلومين على العلم بالآخر.
والإضافي المعي تلازم شيئين في الوجود لا يكون أحدهما إلا مع الآخر.
والدور السبقي التقدمي توقف وجود كل واحد منهما على سبق الآخر له وهذا المحال.
والإضافي واقع. والدوران الآخران فيهما كلام ليس هذا موضعه.
وإذا عرف هذا فما ذكره في الصورتين الفقهية والنحوية ليس بدور إذ ليس فيه توقف كل من الشيئين في ثبوته على الآخر فإن قبول شهادة العبد موقوفة على قبول شهادة شاهد عتقه، وليس شهادة شاهد العتق موقوفة على شهادته، ولذلك تحمل الظرف للضمير موقوف على تقدير فعل يتضمنه، وتقدير الفعل غير موقوف على تحمل الظرف للضمير فتأمله.
وإنما هذا من باب ما يقتضي إثباته إلى إسقاطه فهو من باب الفروع التي لا تعود على أصولها بالإبطال. وإذا بطلت أصولها بطلت هي فهي موقوفة على صحة أصولها، وصحة أصولها لا تتوقف عليها، ولكن وجه الدور في هذا أنها لو أبطلت أصولها لتوقف صحة أصولها على عدم إفسادها لها وهي متوقفة على اقتضاء أصولها لها. فجاء الدور من هذا الوجه. وكذلك نظائره.
فائدة: النعت
النعت إذا كان تمييزًا للمنعوت مثبتًا له لم يقطع برفع ولا نصب، لأنه من تمامه وإن كان غير تمييز له، بل هي من أداة المدح له، أو الذم المحض شاع قطعه تكررت النعوت، أو لم تتكرر. وإنما يشترط تكرر النعوت إذا كانت للتمييز والتبيين فيحصل الاتباع ببعضها ويسوغ قطع الباقي فتفطن لهذه النكتة، والذي يدلك على ذاك قول سيبويه سمعت العرب يقولون: ( الحمد لله رب العالمين ) فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية.
وفائدة القطع من الأول أنهم إذا أرادوا تجديد مدح، أو ذم جددوا الكلام، لأن تجديد غير اللفظ الأول دليل على تجدد المعنى، وكلما كثرت المعاني وتجدد المدح كان أبلغ.
فائدة بديعة: الشيء لا يعطف على نفسه
القاعدة أن الشيء لا يعطف على نفسه، لأن حروف العطف بمنزلة تكرار العامل لأنك إذا قلت: قام زيد وعمرو فهي بمعنى قام زيد وقام عمرو. والثاني غير الأول فإذا وجدت مثل قولهم كذبًا ومينًا فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني، وإن خفي عنك.
ولهذا يبعد جدًا أن يجيء في كلامهم جاءني عمر وأبو حفص ورضي الله عن أبي بكر وعتيقه، فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء الواحد. فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العطف وتركه. فإن عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات وهب متغايرة، وإن لم تعطف فمن حيث كان في كل منهما ضمير هو الأول فعلى الوجه الأول تقول: زيد فقيه شاعر كاتب. وعلى الثاني فقيه وشاعر وكاتب كأنك عطفت بالواو الكتابة على الشعر وحيث لم تعطف أتبعت الثاني الأول، لأنه هو هو من حيث اتحد الحامل للصفات.
وأما في أسماء الرب تبارك وتعالى فأكثر ما يجيء في القرآن بغير عطف نحو السميع العليم، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، الملك القدوس، السلام إلى آخرها وجاءت معطوفة في موضعين:
أحدهما في أربعة أسماء: وهي { الأول والآخر والظاهر والباطن }.
والثاني: في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله: { الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى }، [286] ونظيره: { الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون * والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون * والذي خلق الأزواج }، [287] فأما ترك العطف في الغالب فلتناسب معاني تلك الأسماء وقرب بعضها من بعض وشعور الذهن بالثاني منها شعوره بالأول. ألا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمة، وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر وكذلك: { الخالق البارئ المصور }. [288]
وأما تلك الأسماء الأربعة فهي ألفاظ متباينة المعاني متضادة الحقائق في أصل موضوعها وهي متفقة المعاني متطابقة في حق الرب تعالى لا يبقى منها معنى بغيره. بل هو أول كما أنه آخر وظاهر كما أنه باطن. ولا يناقض بعضها بعضًا في حقه فكان دخول الواو صرفًا لوهم المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال واحتمال الأضداد، لأن الشيء لا يكون ظاهرًا باطنًا من وجه واحد، وإنما يكون ذلك باعتبارين فكان العطف ههنا أحسن من تركه لهذه الحكمة هذا جواب السهيلي.
وأحسن منه أن يقال: لما كانت هذه الألفاظ دالة على معاني متباينة، وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات إيذانًا بأن هذه المعاني مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بها.
ووجه آخر وهو أحسن منهما، وهو أن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم. وتقريره يكون في الكلام متضمنًا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير. وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه، إذا كان لرجل مثلًا أربع صفات هو: عالم وجواد وشجاع وغني وكان المخاطب لا يعلم ذلك، أو لا يقربه ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل، فإذا قلت: زيد عالم وكان ذهنه استبعد ذلك. فتقول: وجواد أي وهو مع ذلك جواد. فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت: وشجاع أي وهو مع ذلك شجاع وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الإنكار.
وإذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد. فإذا قيل: هو الأول ربما سرى الوهم إلى أن كونه أولا يقتضي أن يكون الآخر غيره، لأن الأولية والآخرية من المتضايفات. وكذلك الظاهر والباطن إذا قيل: هو ظاهر ربما سرى الوهم إلى أن الباطن مقابله. فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية فكأنه قيل: هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه، فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها.
والذي يوضح لك ذلك أنه إذا كان للبلد مثلًا قاض وخطيب وأمير فاجتمعت في رجل حسن أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضي والأمير وكان للعطف هنا مزية ليست للنعت المجرد. فعطف الصفات ههنا أحسن قطعًا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الأمير غيره.
وأما قوله تعالى: { غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو } [289] فعطف في الاسمين الأولين دون الآخرين. فقال السهيلي: إنما حسن العطف بين الاسمين الأولين لكونهما من صفات الأفعال وفعله سبحانه في غيره، لا في نفسه. فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين ولتنزلهما منزلة الجملتين، لأنه يريد تنبيه العياد على أنه يفعل هذا، ويفعل هذا ليرجوه ويؤملوه، ثم قال: { شديد العقاب } بغير واو، لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة والقدرة وهو معنى خارج عن صفات الأفعال فصار بمنزلة قوله: { العزيز العليم }، [290] وكذلك قوله: { ذي الطول } لأن لفظ ذي عبارة عن ذاته.
هذا جوابه، وهو كما ترى غير شاف، ولا كاف. فإن شدة عقابه من صفات الأفعال. وطوله من صفات الأفعال، ولفظه ذي فيه لا تخرجه عن كونه صفة فعل كقوله: { عزيز ذو انتقام }، [291] بل لفظ الوصف بغافر وقابل أدل على الذات من الوصف بذي، لأنها بمعنى صاحب كذا. فالوصف المشتق أدل على الذات من الوصف بها فلم يشف جوابه، بل زاد السؤال سؤالًا.
فاعلم أن هذه الجملة مشثملة على ستة أسماء كل اثنين منها قسم. فابتدأها بالعزيز العليم وهما اسمان مطلقان، وصفتان من صفات ذاته، وهما مجردان على العاطف.
ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أفعاله، فأدخل بينهما العاطف، ثم ذكر اسمين آخرين بعدهما وجردهما من العاطف، فاما الأولان فتجردهما من العاطف لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم الله وهما متلازمان. فتجريدهما عن العطف هو الأصل وهو موافق لبيان ما في الكتاب العزيز من ذلك، كالعزيز العليم، والسميع والبصير والغفور الرحيم.
وأما: { غافر الذنب وقابل التوب } فدخل العاطف بينهما، لأنهما في معنى الجملتين وإن كانا مفردين لفظًا فهما يعطيان معنى يغفر الذنب ويقبل التوب أي هذا شأنه ووصفه في كل وقت فأتى بالاسم الدال على أن وصفه ونعته المتضمن لمعنى الفعل الدال على أنه لا يزال يفعل ذلك فعطف أحدهما على الآخر على نحو عطف الجمل بعضها على بعض، ولا كذلك الاسمان الأولان، ولما لم يكن الفعل ملحوظًا في قوله: { شديد العقاب ذي الطول إذ لا يحسن وقوع الفعل فيهما وليس في لفظ ( ذي ) ما يصاغ منه فعل جرى مجرى المفردين من كل وجه، ولم يعطف أحدهما على الآخر كما لم يعطف في العزيز العليم، فتأمله فإنه واضح.
وأما العطف في قوله: { الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى } [292] فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملة دخلت الواو عاطفة جملة على جملة وإن كانت الجملة مع الموصول في تقدير المفرد. فالفعل مراد مقصود، والعطف يصير كلًا منها جملة مستقلة مقصودة بالذكر بخلاف ما لو أتى بها في خبر موصول واحد فقيل: { الذي جعل لكم الأرض مهدا } و { نزل من السماء ماء } و { خلق الأزواج كلها } [293] كانت كلها في حكم جملة واحدة. فلما غاير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دل على أن المقصود وصفه بكل من هذه الجمل على حدتها وهذا قريب من باب قطع النعوت، والفائدة هنا كالفائدة ثم وقد تقدمت الإشارة إليها فراجعها، بل قطع النعوت. إنما كان لأجل هذه الفائدة فذلك المقدر في النعوت المقطوعة لهذا المحقق به وأنعم، فإنه ذو الطول والإحسان.
تتمة
تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي رحمة قبله وصفة رحمة بعده. فقبله: { غافر الذنب وقابل التوب } وبعده: { ذي الطول }، [294] ففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له وهو قوله ﷺ: «إن الله كتب كتابًا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي»، وفي لفظ: «سبقت غضبي»، وقد سبقت صفتا الرحمة هنا وغلبت.
وتأمل كيف افتتح الآية بقوله: { تنزيل الكتاب } [295] والتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده لا تعقل العرب من لغتها. بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك. وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين: أحدهما: علوه تعالى على خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره. فإنه أخبر أنه منه. وهذا يقتضي أن يكون منه قولًا كما أنه منه تنزيلًا فإن غيره. لو كان هو ا لمتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير فإن الكلام، إنما يضاف إلى المتكلم به.
ومثل هذا: { ولكن حق القول مني }، [296] ومثله: { قل نزله روح القدس من ربك }، [297] ومثله: { تنزيل من حكيم حميد } [298] فاستمسك بحرف من في هذه المواضع فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية.
وتأمل كيف قال تعالى: { تنزيل من ولم يقل تنزيله فتضمنت الآية إثبات علوه وكلامه وثبوت الرسالة ثم قال: { العزيز العليم } [299] فتضمن هذان الإسمان صفتي القدرة والعلم وخلق أعمال العباد وحدوث كل ما سوى الله لأن القدرة هي قدرة الله كما قال أحمد بن حنبل فتضمنمت إثبات القدر، ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه، أو أن يشاء ما لا يكون فكان عزته تبطل ذلك. وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء. وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه، لأن كمال قدرته وعزته يبطل ذلك.
ثم قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، والذنب مخالفة شرعه وأمره، فتضمن هذان الإسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله، ثم قال: شديد العقاب، وهذا جزاؤه للمذنبين وذو الطول جزاؤه للمحسنين فتضمنت الثواب والعقاب.
ثم قال تعالى: { لا إله إلا هو إليه المصير }، [300] فتضمن ذلك التوحيد والمعاد.
فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلو والكلام والقدرة والعلم والقدر وحدوث العالم والثواب والعقاب والتوحيد والمعاد. وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة، فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان تجلي على سمعك في هذه الآية العظيمة، ولكن * خود تزف إلى ضرير مقعد *
فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها، وسماعك إياها. وهكذا سائر آيات القرآن، فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم، ثم يخرج من الدنيا، وما فهم حقائق القرآن، ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. فالله المستعان.
فائدة جليلة: تقدير العامل في المعطوف
العامل في المعطوف مقدر في معنى المعطوف عليه، وحرف العطف أغنى عن إعادته وناب منابه، وإنما قلنا ذلك للقياس والسماع.
أما القياس فإن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله، ولا يتعلق به إلا في باب المفعول معه، لأنه قد أخذ معموله ولا يقتضي ما بعد حرف العطف، ولا يصح تسليطه عليه بوجه فلا تقول: ضربت وعمرًا. فكيف يقال: إن عاملًا يعمل في شيء فلا يصح مباشرته إياه، وأيضا فالنعت هو المنعوت في المعنى ولا واسطة بينه، وبين المنعوت، ومع ذلك فلا يعمل فيه ما يعمل في المنعوت على القول الذي نصرناه سالفًا وهو الصحيح، فكيف بالمعطوف الذي هو غير المعطوف عليه من كل وجه.
وأما السماع فإظهار العامل قبل المعطوف في مثل قوله:
بل بنو النجار إن لنا ** فيهم قتلى وإن تره
يريد: لنا فيهم قتلى وترة، وهذا مطرد في سائر حروف العطف ما لم يمنع مانع كما منع في المعطوف على اسم لا يصح انفراده عنه نحو: اختصم زيد وعمرو، وجلست بين زيد وعمرو. فإن الواو هنا تجمع بين الاسمين في العالم. فكأنك قلت: اختصم هذان واجتمع الرجلان في قولك: اجتمع زيد وعمرو. ومعرفة هذه الواو أصل يبنى عليه فروع كثيرة فمنها. أنك تقول: رأيت الذي قام زيد وأخوه، على أن تكون الواو جامعة وإن كانت عاطفة لم يجز، لأن التقدير يصير قام زيد وقام أخوه فخلت الصلة من العائد. ومنها قوله سبحانه: { وجمع الشمس والقمر } [301] غلب المذكر على المؤنث لاجتماعهما، ولو قلت طلع الشمر والقمر لقبح ذلك، كما يقبح قام هند وزيد إلا أن تريد الواو الجامعة لا العاطفة، وأما في الآية فلا بد أن تكون الواو جامعة، ولفظ الفعل يقتضي ذلك.
وأما الفاء فهي موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترتيب وهما راجعان إلى معنى التعقيب، لأن الثاني بعدهما أبدًا. إنما يجيء في عقب الأول، فالسبب نحو ضربته فبكى. والترتيب: { أهلكناها فجاءها بأسنا } [302] دخلت الفاء لترتيب اللفظ، لأن الهلاك يجب تقديمه في الذكر لأن الاهتمام به أولى وإن كان مجيء البأس قبله في الوجود. ومن هذا:
إن من ساد، ثم ساد أبوه ** ثم قد ساد بعد ذلك جده
دخلت "ثم" لترتيب الكلام لا لترتيب المعنى في الوجود، وهذا معنى قول بعض النحاة: إنها تأتي للترتيب في الخبر لا في المخبر.
وعندي في الآية تقديران آخران أحسن من هذا:
أحدهما: أن يكون المراد بالإهلاك إرادة الهلاك. وعبر بالفعل عن الإرادة وهو كثير فترتب مجيء البأس على الإرادة ترتب المراد على الإرادة.
والثاني: وهو ألطف أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على جملة. فذكر الإهلاك ثم فصله بنوعين أحدهما مجيء البأس بياتًا أي ليلًا. والثاني: مجيئه وقت القائلة، وخص هذين الوقتين، لأنهما وقت راحتهم وطمأنيتهم، فجاءهم بأس الله أسكن ما كانوا وأروحه في وقت طمأنينتهم وسكونهم على عادته سبحانه في أخذ الظالم في وقت بلوغ آماله وكرمه وفرحه وركونه إلى ما هو فيه. وكذلك قوله تعالى: { حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا }. [303] والمقصود أن الترتيب هنا، ترتيب التفصيل على الجمل وهو ترتيب علمي لا خارجي، فإن الذهن يشعر بالشيء جملة أولًا، ثم يطلب تفصيله بعد ذلك. وأما في الخارج فلم يقع إلا مفصلًا، فتأمل هذا الموضع الذي خفي على كثير من الناس حتي ظن أن الترتيب في الآية كترتيب الأخبار. أي: إنا أخبرناكم بهذا قبل هذا.
وأما قوله تعالى: { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } [304] فعلى ما ذكرنا من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور.
وفيه وجه ألطف من هذا، وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة، وتعبر عن انتهائه تارة، فيقولون: فعلت عند الشروع، وفعلت عند الفراغ وهذا استعمال حقيقي وعلى هذا فيكون معنى قرأت في الآية ابتداء الفعل أي إذا شرعت وأخذت في القراءة فاستعذ فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادىء الفعل ومقدمته وطليعته. ومنه قوله: فصلى الصبح حتى طلع الفجر أي أخذ في الصلاة عند طلوعه.
وأما قوله: ثم صلاها من الغد بعد أن أسفر. فالصحيح أن المراد به الابتداء وقالت طالفة: المراد الانتهاء منهم السهيلي وغلطوا في ذلك، والحديث صريح في أنه قدمها في اليوم الأول، وأخرها في اليوم الثاني ليبين أول الوقت وآخره.
وقوله في حديث جبريل: صلى الظهر حين زالت الشمس هذا ابتداؤها ليس إلا.
وقوله: صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، فذلك مراد به الابتداء.
وأما قوله: وصلى الظهر من الغد حين صار ظل الرجل مثله، فقيل: المراد به الفراغ منها أي فرغ منها في هذا الوقت، وقيل: المراد به الابتداء أي أخرها إلى هذا الوقت بيانًا لا آخر الوقت وعلى هذا. فتمسك به أصحاب مالك في مسألة الوقت المشترك والكلام في هذه المسائل ليس هذا موضعه.
فصل: حتى
وأما حتى فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها، وغاية كل شيء حده. وذلك كان لفظها كلفظ الحد فإنها حاء قبل تاءين. كما أن الحد حاء قبل دالين والدال كالتاء في المخرج والصفة إلا في الجهر فكانت لجهرها أولى بالاسم لقوته. والتاء لهمسها أولى بالحرف لضفه ومن حيث كانت حتى كانت للغاية خفضوا بها كما يخفضون بإلى التي للغاية والفرق بينهما أن حتى غاية لما قبلها وهو منه وما بعد إلى ليس مما قبلها بل عنده انتهى من قبل الحرف، ولذلك فارقتها في أكثر أحكامها ولم تكن إلى عاطفة لانقطاع ما بعدها عما قبلها بخلاف حتى. ومن ثم دخلت حتى في حروف. العطف ولم يجز دخولها على المضمر المخفوض. إذا كانت خافضة لا تقول قام القوم حتاك، كما لا تقول قاموا وك، ومن حيث كانت ما بعدها غاية لما قبلها لم يجز في العطف قام زيد حتى عمرو، ولا أكلت خبزًا حتى تمرًا، لأن الثاني ليس بحد للأول ولا ظرف.
تنبيه
ليس المراد من كون حتى لانتهاء الغاية وإن ما بعدها ظرفًا. أن يكون متأخرًا في الفعل عما قبلها، فإذا قلت: مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحاج حتى المشاه لم يلزم تأخر موت الأنبياء عن الناس، وتأخر قدوم المشاة عن الحاج.
ولهذا قال بعض الناس: إن حتى مثل الواو لا تخالفها إلا في شيئين. أحدهما: أن يكون المعطوف من قبيل المعطوف عليه فلا تقول: قدم الناس حتى الخيل بخلاف الواو. الثاني: أن تخالفه بقوة أو ضعف أو كثرة أو قلة، وأما أن يفهم منها الغاية والحد فلا والذي حمله على ذلك ما تقدم من المثالين، ولكن فاته أن يعلم المراد بكون ما بعدها غاية وظرفًا. فاعلم أن المراد به أن يكون غاية في المعطوف عليه لا في الفعل. فإنه يجب أن يخالفه في الأشد والأضعف والقلة والكثرة. وإذا فهمت هذا، فالأنبياء غاية للناس في الشرف والفضل، والمشاة غاية للحجاج في الضعف والعجز وأنت إذا قلت: أكلت السمكة حتى رأسها. فالرأس غاية لانتهاء السمكة، وليس المراد أن غاية أكلك كان الرأس فلا يجوز أن يتقدم أكلك للرأس.. وهذا مما أغفله كثير من النحويين لم ينبهوا عليه.
فائدة: أو للدلالة على أحد الشيئين
"أو" وضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين معها ولذلك وقعت في الخبر المشكوك فيه من حيث كان الشك ترددًا بين أمرين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر لا أنها وضعت للشك. فقد تكون في الخبر الذي لا شك فيه. إذا أبهمت على المخاطب ولم تقصد أن تبين له كقوله سبحانه: { إلى مائة ألف أو يزيدون }. [305] أي أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم: هم مائة ألف أو يزيدون. فأو على بابها دالة على أحد الشيئين. إما مائة ألف بمجردها وإما مائة ألف مع زيادة. والمخبر في كل هذا لا يشك.
وقوله: { فهي كالحجارة أو أشد قسوة }، [306] ذهب في هذه الزجاج كالتي في قوله: { أو كصيب من السماء }، [307] إلى أنها أو التي للإباحة أي أبيح للمخاطبين أن يشبهوا بهذا أو هذا، وهذا فاسد، فإن أو لم توضع للإباحة في شيء من الكلام، ولكنها على بابها. أما قوله: { أو كصيب من السماء } فإنه تعالى ذكر مثلين مضروبين للمنافقين في حالتين مختلفتين. فهم لا يخلون من أحد الحالتين فأو على بابها من الدلالة على أحد المعنيين. وهذا كما تقول: زيد لا يخلو أن يكون في المسجد، أو الدار ذكرت، أو لأنك أردت أحد الشيئين. وتأمل الآية بما قبلها وافهم المراد منها تجد الأمر كما ذكرت لك، وليس المعنى ابحت لكم أن تشبهوهم بهذا وهذا.
وأما قوله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإنه ذكر قلوبًا ولم يذكر قلبًا واحدًا. فهي على الجملة قاسية أو على التعيين لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون كالحجارة. وإما أن تكون أشد قسوة. ومنها ما هو كالحجارة ومنها ما هو أشد قسوة منها، ومن هذا قول الشاعر:
فقلت لهم ثنتان لا بد منهما ** صدور رماح أشرعت أو سلاسل
أي لا بد منهما في الجملة، ثم فصل الاثنين بالرماح والسلاسل فبعضهم له الرماح قتلًا، وبعضهم له السلاسل أسرًا. فهذا على التفصيل والتعيين. والأول على الجملة فالأمران واقعان جملة، وتفصيلهما بما بعد أو. وقد يجوز في قوله تعالى: أو أشد قسوة مثل أن يكون مائة ألف، أو يزيدون.
وأما أو التي للتخيير فالأمر فيها ظاهر.
وأما "أو" التي زعموا أنها للإباحة نحو جالس مر الذي هو للإباحة ويدل على هذا أن القائلين بأنها للإباحة يلزمهم أن يقولوا إنها للوجوب إذا دخلت بين شيئين لا بد من أحدهما نحو قولك للمكفر أطعم عشرة مساكين، أو اكسهم، فالوجوب هنا لم يوجد من "أو" وإنما اخذ من الأمر. فكذا جالس الحسن أو ابن سيرين.
فصل: لكن
وأما لكن فقال السهيلي: أصح القولين فيها أنها مركبة من لا وإن وكاف الخطاب في قول الكوفيين. قال السهيلي: وما أراها إلا كاف التشبيه، لأن المعنى يدل عليها. إذا قلت: ذهب زيد، لكن عمرو مقيم تريد لا ينتقل عمرو فلا لتوكيد النفي عن الأول. وإن لإيجاب الفعل الثاني وهو النفي عن الأول، لأنك ذكرت الذاهب الذي هو ضده فدل على انتفائه به.
قلت: وفي هذا من التعسف والبعد عن اللغة والمعنى ما لا يخفى وأي حاجة إلى هذا، بل هي حرف شرط موضوع للمعنى المفهوم منها، ولا تقع إلا بين كلامين متنافيين.
ومن هنا قال: إنها ركبت من لا والكاف وإن، إلا أنهم لما حذفوا الهمزة المذكورة كسروا الكاف إشعارًا بها، ولا بد بعدها من جملة، إذا كان الكلام قبلها موجبًا شددت نونها، أو خففت فإن كان ما قبلها منفيًا اكتفيت بالاسم المفرد بعدها، إذا خففت النون منها لعلم المخاطب أنه لا يضاد النفي إلا الإيجاب فلما اكتفيت باسم مفرد وكانت إذا خففت نونها لا تعمل مطيرت كحروف العطف فألحقوها بها، لأنهم حين استغنوا عن خبرها بما تقدم من الدلالة كان إجراء ما بعدها على ما قبلها أولى وأحرى ليتفق اللفظ كما اتفق المعنى.
فإن قيل: أليس مضادة النفي للوجوب بمثابة مضادة الوجوب للنفي. وهي في كل حال لا تقع إلا بين كلامين متضادين. فلم قالوا: ما قام زيد، لكن قام عمرو، اكتفاء بدلالة النفي على نقيضه وهو الوجوب، ولم يقولوا: قام زيد لكن قام عمرو، اكتفاء بدلالة الوجوب على نقيضه من النفي.
قيل: إن الفعل الموجب قد تكون له معان تضاده وتناقض وجوده، كالعلم. فإنه يناقض وجود الشك والظن والغفلة والموت، وأخص أضداده به الجهل. فلو قلت: قد علمت الخبر، لكن زيد لم يدر ما أضفت إلى زيدًا ظن أو شك أم غفلة أم جهل؟ فلم يكن بد من جملة قائمة بنفسها لعلم ما تريد، فإذا تقدم النفي نحو قولك ما علمت الخبر لكن زيد اكتفى باسم واحد لعلم المخاطب أنه لا يضاد نفي العلم إلا وجوده، لأن النفي مشتمل على جمبع أضداده المنافية للعلم.
فإن قيل: فام إذا خففت وجب الغاؤها بخلاف أن وإن وكأن فإنه يجوز فيها الوجهان مع التخفيف، كما قال: * كأن ظبية تَعطُو إلى وارِق السَّلَم *
قيل: زعم الفارسي أن القياس فيهن كلهن الإلغاء إذا خففن. فلذلك ألزموا لكن إذا خففت الإلغاء تنبيهًا على أن ذلك هو الأصل في جميع الباب. وهذا القول مع ما يلزم عليه من الضعف والوهن ينكسر عليه بأخواتها. فيقال له: فلم خصت، لكن بذلك دون إن وإن ولا جواب له عن هذا.
قال السهيلي: وإنما الجواب عن ذلك أنها لما ركبت من لا وإن، ثم حذفت الهمزة اكتفاء بكسر الكاف بقي عمل أن لبقاء العلة الموجبة للعمل وهي فتح آخرها، وبذلك ضارعت الفعل. فلما حذفت النون المفتوحة وقد ذهبت الهمزة للتركيب ولم يبق إلا النون الساكنة وجب إبطال حكم العمل بذهاب طرفها وارتفاع علة المضارعة للفعل بخلاف أخواتها إذا خففن فإن معظم لفظها باق فجاز أن يبقى حكمها على أن الأستاذ أبا القاسم الرمان قد حكى رواية عن يونس أنه حكى الأعمال في لكن مع تخفيفها. وكان يستغرب هذه الرواية.
واعلم أن لكن لا تكون حرف عطف مع دخول الواو عليها، لأنه لا يجتمع حرفان من حروف العطف. فمتى رأيت حرفًا من حروف العطف مع الواو قالوا هي العاطفة دونه فمن ذلك. أما إذا قلت: إما زيد، وإما عمرو، وكذلك لا. إذا قلت: ما قام زيد ولا عمرو. ودخلت لا لتوكيد النفي. ولئلا يتوهم أن الواو جامعة، وإنك نفيت قيامهما في وقت واحد.
(فصل في لا العاطفة)
ولا تكون "لا" عاطفة إلا بعد إيجاب. وشرط آخر وهو أن يكون الكلام قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفي الفعل عما بعدها. كقولك: جاءني رجل لا امرأة ورجل عالم لا رجل جاهل، ولو قلت: مررت برجل لا زيد لم يجز، وكذلك مررت برجل لا عاقل، لأنه ليس في مفهوم الكلام ما ينفي الفعل عن الثاني وهي لا تدخل إلا لتوكيد نفي. فإن أردت ذلك المعنى جئت بلفظ غير فتقول: مررت برجل غير زيد ورجل غير عالم، ولا تقول برجل غير امرأة ولا بطويل غير قصير، لأن في مفهوم الخطاب ما يغنيك عن مفهوم النفي الذي في غير وذلك المعنى الذي دل عليه المفهوم حتى قلت بطويل لا قصير.
وأما إذا كانا اسمين معرفين نحو مررت بزيد لا عمرو فجائز هنا. دخول غير لجمود الاسم العلم. فإنه ليس له مفهوم خطاب عند الأصوليين بخلاف الأسماء المشتقة، وما جرى مجراها كرجل. فإنه بمنزلة قولك ذكر ولذلك دل بمفهومه على انتقال الخبر عن المرأة ويجوز أيضا مررت بزيد لا عمرو لأنه اسم مخصوص بشخص وكأنه حين خصصته بالذكر نفيت المرور عن عمرو، ثم أكدت ذلك النفي بلا.
وأما الكلام المنفي فلا يعطف عليه بلا، لأن نفيك الفعل عن زيد إذا قلت ما قام زيد لا يفهم منه نفيه عن عمرو فيؤكد بلا.
فإن قلت: أكد بها النفي المتقدم.
قيل لك: وأي شيء يكون حينئذ إعراب عمرو وهو اسم مفرد ولم يدخل عليه عاطف يعطف على ما قبله. فهذا لا يجوز إلا أن تجعله مبتدأ وتأتي بخبر. فتقول: ما قام زيد لا عمرو هو القائم. وإما إن أردت تشريكهما في النفي فلا بد من الواو إما وحدها. وإما مع لا فلا تكون الواو عاطفة ومعها لا.
وأما قوله: { غير المغضوب عليهم ولا الضالين }، فإن معنى النفي موجود في غير.
فإن قيل: فهلا قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين.
قيل: في ذكر غير بيان للفضيلة للذين أنعم عليهم وتخصيص لنفي صفة الضلال والغضب عنهم، وأنهم الذين أنعم عليهم بالنبوة والهدى دون غيرهم، ولو قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين، لم يكن في ذلك إلا تأكيد نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم. كما تقول: هذا غلام زيد لا عمرو. أكدت نفي الإضافة عن عمرو بخلاف قولك، هذا غلام الفقيه غير الفاسق، ولا الخبيث. وكأنك جمعت بين إضافة الغلام إلى الفقيه دون غيره. وهي نفي الصفة المذمومة عن الفقيه فافهمه.
فإن قيل: وأي شيء أكدت لا حتى أدخلت عليها الواو وقد قلت إنها لا تؤكد المنفي المتقدم، وإنما تؤكد نصبًا يدل عليه اختصاص الفعل الواجب بوصف ما كقولك: جاءني رجل عالم لا جاهل.
فالجواب أنك حين قلت: ما جاءني زيد، لم يدل الكلام على نفي المجيء عن عمرو كما تقدم. فلما عطفت بالواو دل الكلام على انتفاء الفعل عن عمرو كما انتفى عن الأول لقيام الواو مقام تكرار حرف النفي، فدخلت لا لتوكيد النفي عن الثاني.
فائدة بديعة: أم على ضربين
"أمْ" تكون على ضربين؛ متصلة وهي المعادلة لهمزة الاستفهام وإنما جعلوها معادلة للهمزة دون هل ومتى وكيف، لأن الهمزة هي أم الباب والسؤال بها استفهام بسيط مطلق غير مقيد بوقت ولا حال، والسؤال بغيرها استفهام مركب مقيد، إما بوقت كمتى، وإما بمكان كأين، وإما بحال نحو كيف، وإما بنسبة نحو هل زيد عندك. ولهذا لا يقال "كيف زيد أم عمرو"، ولا "أين زيد أم عمرو"، ولا "من زيد أم عمرو".
وأيضا فلأن الهمزة وأم يصطحبان كثيرًا كقوله تعالى: { سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم }، [308] ونحو قوله تعالى: { أأنتم أشد خلقًا أم السماء }. [309]
وأيضا فلأن اقتران أم بسائر أدوات النفي غير الهمزة يفسد معناها فإنك إذا قلت كيف زيد فأنت سائل عن حاله. فإذا قلت: أم عمرو كان خلفًا من الكلام، وكذلك إذا قلت: من عندك فأنت سائل عن تعيينه، فإذا قلت: أم عمرو فسد الكلام، وكذلك الباقي.
وأيضا فإنما عادلت الهمزة دون غيرها، لأن الهمزة من بين حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات نحو ألم أحسن إليك. فإذا قلت: أعندك زيد أم عمرو فأنت مقر بأن أحدهما عنده، ومثبت لذلك، وطالب تعيينه فأتوا بالهمزة التي تكون للتقرير دون هل التي لا تكون لذلك، إنما يستقبل بها الاستفهام استقبالًا.
وسر المسألة أن أم هذه مشربة معنى أي. فإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو كأنك قلت: أي هذين عندك. ولذلك تعين الجواب بأحدهما أو بنفيهما أو بإثباتهما، ولو قلت: نعم، أو لا. كان خلفًا من الكلام وهذا بخلاف أو فإنك إذا قلت أزيد عندك أو عمرو كنت سائلًا عن كون أحدهما عنده بخبر معين فكأنك قلت: أعندك أحدهما. فيتعين الجواب بنعم أو لا.
وتفصيل ذلك أن السؤال على أربع مراتب في هذا الباب الأول السؤال بالهمزة منفردة نحو أعندك شيء مما يحتاج إليه فتقول: نعم. فينتقل إلى المرتبة الثانية. فتقول: ما هو؟ فتقول: متاع، فينتقل إلى المرتبة الثالثة بأي فتقول: أي متاع؟ فتقول: ثياب فتنتقل إلى المرتبة الرابعة. فتقول: أكتان هي أم قطن أم صوف؟ وهذه أخص المراتب وأشدها طلبًا للتعيين فلا يحسن الجواب إلا بالتعيين وأشدها إبهامًا السؤال الأول لأنه لم يدع فيه أن عنده شيئًا، ثم الثاني أقل إبهامًا منه، لأن فيه ادعاء شيء عنده وطلب ماهيته، ثم الثالث أقل إبهامًا وهو السؤال بأي، لأن فيه طلب تعيين ما عرف حقيقته، ثم السؤال الرابع بأم أخص من ذلك كله، لأن فيه طلب تعيين فرد من أفراد قد عرفها وميزها. والثالث: إنما فيه تعيين جنس عن غيره.
ولا بد في أم هذه من ثلاثة أمور تكون بها متصلة:
أحدها: أن تعادل بهمزة الاستفهام.
الثاني: أن يكون السائل عنده علم أحدها دون تعيينه.
الثالث: أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر نحو قولك: أزيد عندك، أم عندك عمرو فقولك أم عندك عمرو. يقتضي أن تكون منفصلة بخلاف ما، إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو فإذا وقعت الجملة بعدها فعلية لم تخرجها عن الاتصال نحو أعطيت زيدًا أم حرمته.
وسر ذلك كله أن السؤال قام عن تعيين أحد الأمرين أو للأمر. فإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو كأنك قلت: أيهما عندك وإذا قلت: أزيد عندك؟ أم عندك عمر؟ وكان كل واحد منهما جملة مستقلة بنفسها، وإن سائل هل عنده زيد أو لا، ثم استأنفت سؤالا آخر هل عندك عمرو أم لا. فتأمله فإنه من دقيق النحو وفقهه، ولذلك سميت متصلة لاتصال ما بعدها بما قبلها وكونه كلامًا واحد.
وفي السؤال بها معادلة وتسوية، فأما المعادلة فهي بين الاسمين أو الفعلين، لأنك جعلت الثاني عديل الأول في وقوع الألف على الأول، وأم على الثاني. وأما التسوية فإن الشيئين المسؤول عن تعيين أحدهما مستويان في علم السائل وعلى هذا فقوله تعالى: { أأنتم أشد خلقًا أم السماء بناها }، هو على التقرير والتوبيخ والمعنى أي المخلوقين أشد خلقًا وأعظم. ومثله: { أهم خير أم قوم تبع }. [310]
فإن قيل: هذا ينقض ما أصلتموه فإنكم ادعيتم أنها إنما يسأل بها عن تعيين ما علم وقوعه، وهنا لا خير فيهم ولا في قوم تبع.
قيل: هذا لا ينقض ما ذكرناه، بل يشده ويقويه، فإن مثل هذا الكلام يخرج خطابًا على تقرير دعوى المخاطب وظنه أن هناك خيرًا، ثم يدعي أنه هو ذلك المفصل فيخرج الكلام معه والتقريع والتوبيخ على زعمه وظنه. أي ليس الأمر كما زعمتم، وهذا كما تعاقب شخصًا على ذنب لم يفعله مثله وتدعي أنك لا تعاقبه.
فتقول: أنت خير أم فلان؟ وقد عاقبته بهذا الذنب ولست خيرًا منه.
فصل: أم المنقطعة للإضراب
وأما أم التي للإضراب وهي المنقطعة فإنها قد تكون أم إضرابًا، ولكن ليس بمنزلة بل كما زعم بعضهم، ولكن إذا مضي كلامك على اليقين، ثم أدركك الشك مثل قولهم إنها لا بل أم شاء كأنك أضربت عن اليقين ورجعت إلى الاستفهام حين أدركك الشك.
ونظيره قول الزباء: * عسى الغوير أبؤسا * فتكلمت بعسى الغوير، ثم أدركها اليقين فختمت كلامها بحكم ما غلب على ظنها لا بحكم عسى، لأن عسى لا يكون خبرها اسمًا عن حدث فكأنها لما قالت: عسى الغوير قالته متوقعة شرًا تريد الإخبار بفعل مستقبل متوقع كما تقتضيه عسى، ثم هجم عليها اليقين فعدلت إلى الإخبار باسم حدث يقتضي جملة ثبوتية محققة. فكأنها قالت: أصار الغوير؟ أبؤسا؟ فابتدأت كلامها على الشك، ثم ختمته بما يقتضي اليقين والتحقيق.
فكذا أم إذا قلت: إنها لأبل ابتدأت كلامك باليقين والجزم، ثم أدركك الشك في أثنائه فاتيت بام الدالة على الشك فهو عكس طريقة عسى الغوير أبؤسا، ولذلك قدرت ببل لدلالتها على الاضراب، فإنك أضربت عن الخبر الأول إلى الاستفهام والشك. فإنك أخبرت أولا عما توهمت، ثم أدركك الشك فأضربت عن ذلك الإخبار. وإذا وقع بعد أم هذا الاسم المفرد فلا بد من تقدير مبتدأ محذوف وهمزة استفهام. فإذا قلت: إنها لا بل أم شاء كان تقديره لا بل أهي شاء وليس الثاني خبرًا ثبوتيًا كما توهمه بعضهم وهو من أقبح الغلط. والدليل عليه قوله تعالى: { أم له البنات ولكم البنون }. [311]، وقوله تعالى: { أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين }، [312] وقوله تعالى: { أم لهم إله غير الله أم لهم سلم يستمعون فيه }، [313] { أم لكم سلطان مبين } [314] { أم خلقوا من غير شيء }، [315] فهذا ونحوه يدلك على أن الكلام بعدها استفهام محض وأنه لا يقدر ببل وحدها، ولا يقدر أيضا بالهمزة وحدها. إذ لو قدر بالهمزة وحدها لم يكن بينه وبين الأول علقة، لأن الأول خبر، وأم المقدرة بالهمزة وحدها لا تكون إلا بعد استفهام، فتأمله.
هذا شرح كلام التحاة وتقريره في هذا الحرف. والحق أن يقال: إنها على بابها، وأصلها الأول من المعادلة والاستفهام حيث وقعت وإن لم يكن قبلها أداة استفهام في اللفظ وتقديرها ببل. والهمزة خارج عن أصول اللغة والعربية فإن أم للاستفهام وبل للإضراب ويا بعد ما بينهما والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على أصح الطريقتين. وهي طريقة إمام الصناعة والمحققين من أتباعه. ولو قدر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معناهما كمعنى على وفي ومعنى إلى ومع. ونظائر ذلك، وأما في ما لا جامع بينهما فلا. ومن هنا كان زعم من زعم أن لا قد تأتي بمعنى الواو باطلًا لبعد ما بين معنيهما، وكذلك أو بمعنى الواو فأين معنى الجمع بين الشيئين إلى معنى الإثبات لأحدهما؟ وكذلك مسألتنا أين معنى أم من معنى بل، فاسمع الآن فقه المسألة وسرها:
اعلم أن ورود أم هذه على قسمين. أحدهما ما تقدمه استفهام صريح بالهمزة وحكمها ما تقدم وهو الأصل فيها والأخية التي يرجع إليها ما خرج عن ذلك كله. والثاني ورودها مبتدأة مجردة من استفهام لفظي سابق عليها نحو قوله تعالى: { أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا }، [316] وقوله تعالى: { أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون }، [317] وقوله: { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة }، [318] { أم لم يعرفوا رسولهم }، [319] { أم اتخذ مما يخلق بنات }، [320] { أم له البنات }، [321] { أم أنا خير من هذا الذي هو مهين } [322] { أم أنزلنا عليهم سلطانًا }، [323] وهو كثير جدًا تجد فيه أم مبتدأ بها ليس قبلها استفهام في اللفظ، وليس هذا استفهام استعلام بل تقريع وتوبيخ وإنكار. وليس بإخبار فهو إذًا متضمن لاستفهام سابق مدلول عليه بقوة الكلام وسياقه ودلت أم عليه لأنها لا تكون إلا بعد تقدم استفهام كأنه يقول: أيقولون صادق أم يقولون شاعر، وكذلك أم يقولون تقوله أي أتصدقونه أم تقولون تقوله. وكذلك: { أم حسبت أن أصحاب الكهف }، [324] أي أبلغك خبرهم أم حسبت أنهم كانوا من آياتنا عجبًا. وتأمل كيف تجد هذا المعنى باديًا على صفحات قوله تعالى: { ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين }، [325] كيف تجد المعنى: أحضَرَ أم كان من الغائبين. وهذا بظهر كل الظهور فيما إذا كان الذي دخلت عليه أم له ضد وقد حصل التردد بينهما، فإذا ذكر أحدهما استغنى به عن ذكر الآخر، لأن الضد يخطر بالقلب وهو عند شعوره بضده.
فإذا قلت: ما لي لا أرى زيدًا أم هو في الأموات كان المعنى الذي لا معنى للكلام سواه، أحي هو أم في الأموات؟ وكذلك قوله تعالى: { أم أنا خير من هذا الذي هو مهين } [326] معناه أهو خير مني أم أنا خير منه. وكذلك قوله تعالى: { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم }، [327] هو استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدر في قوة الكلام، فإذا قلت: لم فعلت هذا أم حسبت أن لا أعاقبك؟ كان معناه أحسبت أن أعاقبك فأقدمت على العقوبة، أم حسبت أني لا أعاقبك فجهلتها.
وكذلك قوله: { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم }، [328] أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير جهاد فتكونوا جاهلين أم لم تحسبوا ذلك فتكونوا مفرطين. وكذلك إذا قلت: أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهاد معناه أحسبت أن تناله بالبطالة والهوينا؟ فأنت جاهل، أم لم تحسب ذلك؟ فأنت مفرط.
وكذلك: { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات }، [329] أي أحسبوا هذا فهم مغترون أم لم يحسبوه فما لهم مقيمون على السيئات، وعلى هذا سائر ما يرد عليك من هذا الباب.
وتأمل كيف يذكر سبحانه القسم الذي يظنونه ويزعمونه فينكره عليهم وإنه مما لا ينبغي أن يكون ويترك ذكر القسم الآخر الذي لا يذهبون إليه. فتردد الكلام بين قسمين فيصرح بإنكار أحدهما وهو الذي سيق لإنكاره، ويكتفي منه بذكر الآخر. وهذه طريقة بديعة عجيبة في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرها، وهي من باب الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليه. فأحدهما مذكور صريحًا والآخر ضمنًا. ولذلك أمثلة في القرآن يحذف منها الشيء للعلم بموضعه.
فمنها قوله تعالى: { وإذ قلنا }، [330] { وإذ نجيناكم }، [331] { وإذ فرقنا }، [332] وإذ فعلنا وهو كثير جدًا بواو العطف من غير ذكر عامل يعمل في إذ، لأن الكلام في سياق تعداد النعم وتكرار الأقاصيص فيشير بالواو العاطفة إليها كانها مذكورة في اللفظ لعلم المخاطب بالمراد. ولما خفي هذا على بعض ظاهرية النحاة قال: إن أو زائدة هنا، وليس كذلك.
ومن هذا الباب الواو المتضمنة معنى رب. فإنك تجدها في أول الكلام كثيرًا إشارة منهم إلى تعداد المذكور بعدها من فخر، أو مدح، أو غير ذلك. فهذه كلها معان مضمرة في النفس وهذه الحروف عاطفة عليها، وربما صرحوا بذلك المضمر كقول ابن مسعود: دع ما في نفسك وإن أفتوك عنه وأفتوك.
ومن هذا الباب حذف كثير من الجوابات في القرآن لدلالة الواو عليها لعلم المخاطب أن الواو عاطفة ولا يعطف بها إلا على شيء كقوله تعالى: { فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب }، [333] وكقوله تعالى: { حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها } [334] وهذا الباب واسع في اللغة.
فهذا ما في هذه المسألة، وكان قد وقع لي هذا بعينه أمام المقام بمكة وكان يجول في نفسي فأضرب عنه صفحًا، لأني لم أره في مباحث القوم، ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة. أحدهما حام حوله وما ورد ولا أعرف اسمه. والثاني أبو القاسم السهيلي رحمه الله فإنه كشفه وصرح به. وإذا لاحت الحقائق فكن أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار. والله الموفق للصواب.
فائدة بديعة: لا يجوز إضمار حرف العطف
لا يجوز إضمار حرف العطف خلافًا للفارسي ومن تبعه لأن الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم فلو أضمرت لاحتاج المخاطب إلى وحي يسفر له عما في نفس مكلمه. وحكم حروف العطف في هذا حكم حروف النفي والتوكيد والترجي والتمني وغيرهم اللهم إلا أن حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض المواطن لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر وهذا على قلته.
فإن قيل: فكيف تصنعون بقول الشاعر:
كيف أصبحت كيف أمسيت مما يثبت الود في فؤاد الكريم
أليس على إضمار حرف العطف وأصله كيف أصبحت وكيف أمسيت؟
قيل: ليس كذلك، وليس حرف العطف مرادًا هنا البتة. ولو كان مرادًا لانتقض الغرض الذي أراده الشاعر، لأنه لم يرد انحصار الود في هاتين الكلمتين من غير مواظبة عليهما. بل أراد أن تكرار هاتين الكلمتين دائمًا يثبت المودة، ولولا حذف الواو لانحصر إثبات الود في هاتين الكلمتين من غير مواظبة ولا استمرار عليها، ولم يرد الشاعر ذلك، وإنما أراد أن يجعل أول الكلام ترجمة على سائر الباب يريد الاستمرار على هذا الكلام والمواظبة عليه. كما تقول: قرأت ألفًا بابا جمعت هذه الحروف ترجمة لسائر الباب وعنوانًا للغرض المقصود. ولو قلت قرأت ألفًا وباء لأشعرت بانقضاء المقروء حيث عطفت الباء على الألف دون ما بعدها، فكان مفهوم الخطاب أنك لم تقرأ غير هذين الحرفين.
وأحسن من هذا أن يقال: دخول الواو هنا يفسد المعنى، لأن المراد أن هذا اللفظ وحده يثبت الود وهذا وحده يثبته بحسب اللقاء فأيهما وجد مقتضيه وواظب عليه أثبت الود ولو أدخل الواو لكان لا يثبت الود إلا باللفظين معًا. ونظير هذا أن تقول: أطعم فلانًا شيئًا فيقول: ما أطعمه؟ فيقول: أطعمه تمرًا أقطا زبيبًا لحمًا، لم ترد جمع ذلك، بل أردت أطعمه واحدًا من هذه أيهما تسير. ومنه الحديث الصحيح المرفوع: «تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره»، ومنه قول عمر: صلى رجل في إزار ورداء في سراويل ورداء في تبان ورداء.. الحديث. يتعين ترك العطف في هذا كله لا المراد الجمع.
فإن قيل: فما تقولون: في قولهم أضرب زيدًا عمرًا خالدًا أليس على حذف الواو؟
قيل: ليس كذلك إذ لو كان على تقدير الواو لاختص الأمر بالمذكورين ولم يعدهم إلى سواهم، وإنما المراد الإشارة بهم إلى غيرهم. ومنه قولهم: بوبت الكتاب بابًا بابًا وقسمت المال درهمًا درهمًا وليس على إضمار حرف العطف ولو كان كذلك، لانحصر الأمر في درهمين وبابين.
وأما ما احتجوا به من قوله تعالى: { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه }، [335] والذي دعاهم إلى ذلك أن جواب إذا هو قوله تعالى: { تولوا وأعينهم تفيض من الدمع } والمعنى، إذا أتوك ولم يكن عندك ما تحملهم عليه تولوا يبكون فيكون الواو في قلت مقدرة، لأنها معطوفة على فعل الشرط وهو أتوك هذا تقرير احتجاجهم ولا حجة فيه لأنه جواب إذا في قوله قلت لا أجد. والمعنى إذا أتوك لتحملهم لم يكن عندك ما تحملهم عليه فعبر عن هذا بقوله قلت: لا أجد ما أحملكم عليه لنكتة بديعة وهي الإشارة إلى تصديقهم له، وأنهم اكتفوا من علمهم بعدم الإمكان بمجرد إخباره لهم بقوله: { لا أجد ما أحملكم عليه } بخلاف ما لو قيل: لم يجدوا عندك ما تحهلهم عليه فإنه يكون تبيين حزنهم خارجًا عن إخباره. وكذلك لو قيل: لم تجد ما تحملهم عليه لم يؤد هذا المعنى فتأمله فإنه بديع.
فإن قيل: فبأي شيء يرتبط قوله: { تولوا وأعينهم تفيض }، وهذا عطف على ما قبله فإنه ليس بمستأنف.
فالجواب أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما قبله ووقوعه منه موقع التفسير حتى كأنه هو وتأمل مثل هذا في قوله تعالى: { أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين }، [336] كيف لم يعطف فعل القول بأداة عطف لأنه كالتفسير لتعجبهم والبدل من قوله تعالى: { أكان للناس عجبًا }، فجرى مجرى قوله: { ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا }، [337] فلما كان مضاعفة العذاب بدلًا وتفسيرًا لأثامًا لم يحسن عطفه عليه.
وزعم بعض الناس أن من هذا الباب قول عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله ﷺ لها فقال: المعنى أعجبها حسنها وحب رسول الله ﷺ وليس الأمر كذلك، ولكن قوله: حب رسول الله ﷺ، بدل من قوله: هذه وهو من بدل الاشتمال والمعنى: لا يغرنك حب رسول الله ﷺ لهذه التي قد أعجبها حسنها. ولا عطف هناك، ولا حذف، وهذا واضح بحمد الله.
فائدة بديعة: كل لفظ دال على الإحاطة بالشيء وكأنه من لفظ الإكليل
"كل" لفظ دال على الإحاطة بالشيء وكأنه من لفظ الإكليل والكلالة والكلة مما هو في معنى الإحاطة بالشيء وسر اسم واحد في لفظه جمع في معناه ولو لم يكن معناه معنى الجمع لما جاز أن يؤكد به الجمع، لأن التوكيد تكرار للمؤكد فلا يكون إلا مثله إن كان جمعًا فجمع، وإن كان واحدًا فواحد.
وحقه أن يكون مضافًا إلى اسم منكر شائع في الجنس من حيث اقتضى الإحاطة، فإن أضفته إلى معرفة كقولك كل إخوتك ذاهب قبح إلا في الابتداء، لأنه إذا كان مبتدأ في هذا الموطن كان خبره بلفظ الإفراد تنبيهًا على أن أصله أن يضاف إلى نكرة، لأن النكرة شائعة في الجنس، وهو أيضا يطلب جنسًا يحيط به فأما أن تقول: كل واحد من إخوتك ذاهب فيدل إفراد الخبر على المعنى الذي هو الأصل وهو إضافته إلى اسم مفرد نكرة.
فإن لم تجعله مبتدأ وأضفته إلى جملة معرفة كقولك: رأيت كل إخوتك وضربت كل القوم لم يكن في الحسن بمنزلة ما قبله لأنك لم تضفه إلى جنس ولا معك في الكلام خبر مفرد يدل على معنى إضافته إلى جنس كما كان في قولهم كلهم ذاهب وكل القوم عاقل فإن أضفته إلى جنس معرف باللام نحو قوله تعالى: { فأخرجنا به من كل الثمرات } [338] حسن ذلك، لأن اللام للجنس لا للعهد، ولو كانت للعهد لقبح. كما إذا قلت: خذ من كل الثمرات التي عندك، لأنها إذا كانت جملة معرفة معهودة وأردت معنى الإحاطة فيها فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصله فتؤكد المعرفة بكل فتقول: خذ من الثمرات التي عندك كلها، لأنك لم تضطر عن إخراجها عن التوكيد كما اضطررت في النكرة حين قلت: لقيت كل رجل، لأن النكرة لا تؤكد، وهي أيضا شائعة في الجنس كما تقدم.
فإن قيل: فإذا استوى الأمران كقولك كل من كل الثمرات وكل من الثمرات كلها. فلم اختص أحد النظمين بالقرآن في موضع دون موضع؟
قيل: هذا لا يلزم، لأن كل واحد منه فصيح، ولكن لا بد من فائدة في الاختصاص.
أما قوله تعالى: { فأخرجنا به من كل الثمرات }، [339] فمن ههنا لبيان الجنس لاللتبعيض والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرف، وإنما تريد الثمرات نفسها إلا أنه أخرج منها شيئًا وأدخل من لبيان الجنس كله. ولو قال: أخرجنا به من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف وأن مفعول أخرجنا فيما بعد، ولم يتوهم ذلك مع تقديم كل لعلم المخاطبين. أن كلًا إذا تقدمت تقتضي الإحاطة بالجنس. وإذا تأخرت وكانت توكيدًا اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة جنسًا شائعًا كان أو معهودًا معروفًا.
وأما قوله تعالى: { كلي من كل الثمرات } [340] ولم يقل من الثمرات كلها ففيها الحكمة التي في الآية قبلها ومزيد فائدة. وهو أنه تقدمها في النظم قوله تعالى: { ومن ثمرات النخيل والأعناب }، [341] فلو قال بعدها: كلي من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذا. أعني ثمرات النخيل والأغاب، لأن اللام إنما تنصرف إلى المعهود. فكان الابتداء بكل أحصن للمعنى، وأجمع للجنس، وأرفع للبس، وأبدع في النظم فتأمله.
وإذا قطعت عن الإضافة وأخبر عنها فحقها أن تكون ابتداء ويكون خبرها جمعًا، ولا بد من مذكورين قبلها، لأنها إن لم تذكر قبلها جملة ولا أضيفت إلى جملة بطل معنى الإحاطة فيها ولم يعقل لها معنى، وإنما وجب أن يكون خبرها جمعًا لأنها اسم في معنى الجمع فتقول: كل ذاهبون إذا تقدم ذكر قوم، لأنك معتمد في المعنى عليهم. وإن كنت مخبرًا عن كل فصارت بمنزلة قولك الرهط ذاهبون والنفر منطلقون، لأن الرهط والنفر اسمان مفردان، ولكنهما في معنى الجمع. والشاهد لما بيناه قوله سبحانه: { كل في فلك يسبحون }، [342] { كل إلينا راجعون }، [343] { وكل كانوا ظالمين }، [344] وإن كانت مضافة إلى ما بعدها في اللفظ لم تجد خبرها إلا مفردًا للحكمة التي قدمتها قبل. وهي أن الأصل إضافتها إلى النكرة المفردة. فتقول: كل إخوتك ذاهب أي كل واحد منهم ذاهب ولم يلزم ذلك حين قطعتها عن الإضافة فقلت: كل ذاهبون، لأن اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلها وعلى ما في معناها من معنى الجمع واعتمادها إذا أضفتها على الاسم المفرد إما لفظًا وإما تقديرًا كقوله ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، ولم يقل راعون ومسؤولون. ومنه: «كلكم سيروي». ومنه قول عمر أوكلكم يجد ثوبين ولم يقل تجدون. ومثله قوله تعالى: { كل من عليها فان }، [345] وقال تعالى: { كل له قانتون }، [346] فجمع وقال تعالى: { إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا }. [347]
فإن قيل: فقد ورد في القرآن: { كل يعمل على شاكلته }، [348] { كل كذب الرسل } [349] وهذا يناقض ما أصلتم.
قيل: إن في هاتين الآيتين قرينة تقتضي تخصيص المعنى بهذا اللفظ دون غيره، أما قوله تعالى: { قل كل يعمل على شاكلته } فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين، ذكر مؤمنين وظالمين. فلو قال: يعملون وجميعهم في الإخبار عنهم لبطل معنى الاختلاف فكان لفظة الأفراد أدل على المعنى المراد. كأنه يقول: كل فهو يعمل على شاكلته.
وأما قوله: { كل كذب الرسل }، فلأنه ذكر قرونًا وأمما وختم ذكرهم بذكر قوم تبع. فلو قال: كل كذبوا. وكل إذا أفردت، إنما تعتمد على أقرب المذكورين إليها فكان يذهب الوهم إلى أن الإخبار عن قوم تبع خاصة بأنهم كذبوا الرسل فلما قال: { كل كذب } علم أنه يريد كل فريق منهم، لأن إفراد الخبر عن كل حيث وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم. ومثل: { كل آمن بالله }، [350].
وأما قولنا في كل إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون مبتدأة، فإنما يريد أنها مبتدأة يخبر عنها، أو مبتدأة باللفظ منصوبة بفعل بعدها لا قبلها، أو مجرورة يتعلق خافضها بما بعد نحو: { وكلًا وعد الله الحسنى }، [351] وقول الشاعر: بكل تداوينا..
ويقبح تقديم الفعل العامل فيها إذا كانت مفردة كقولك: ضربت كلا ومررت بكل وإن لم يقبح كلا ضربت وبكل مررت من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها في اللفظ، لأن العامل اللفظي له صدر الكلام. وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ لم يكن لها شيء تعتمد عليه قبلها، ولا بعدها فقبح ذلك.
وأما إذا كان العامل معنويًا نحو كل ذاهبون، فليس بقاطع لها عما قبلها من المذكورين، لأنه لا وجود له في اللفظ. فإذا قلت: ضربت زيدًا وعمرًا وخالدًا وشتمت كلًا وضربت كلًا. لم يجز ولم يعد يخبر لما قدمناه.
إذا عرفت هذا فقولك كل إخوتك ضربت سواء رفعت، أو نصبت يقتضي وقوع الضرب بكل واحد منهم وإذا قلت: كل إخوتك ضربني يقتضي أيضا أن كل واحد واحد منهم ضربك. فلو قلت: كل إخوتي ضربوني وكل القوم جاؤوني احتمل ذلك، واحتمل أن يكونوا اجتمعوا في الضرب والمجيء، لأنك أخبرت عن جملتهم يخبر واقع عن الجملة بخلاف قولك، كل إخوانك جاءني فإنما هو إخبار عن كل واحد منهم وإن الإخبار بالمجيء عم جميعهم. فتأمل على هذا قوله تعالى: { قل كل يعمل على شاكلته } كيف أفرد الخبر، لأنه لم يرد اجتماعهم فيه. وقال تعالى: { كل إلينا راجعون }، [352] فجمع لما أريد الاجتماع في المجيء وهذا أحسن مما تقدم من الفرق فتأمله.
ولا يرد على هذا قوله تعالى: { وله من في السموات والأرض كل له قانتون } [353] بل هو تحقيق له وشاهد، لأن القنوت هنا هو العبودية العامة التي تشترك فيها أهل السموات والأرض لا يختص بها بعضهم عن بعض، ولا يختص بزمان دون زمان وهي عبودية القهر. فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحبة، وهذا بخلاف قوله تعالى: { كل من عليها فان }، [354] فإنه أفرد لما لم يهجتمعوا في الفناء. ونظيره قوله ﷺ: «وكلكم مسؤول عن رعيته»، فإن الله يسأل كل راع راع بمفرده.
ومما جاء مجموعًا لاجتماع الخبر قوله تعالى: { كل في فلك يسبحون }، [355] وما أفرد لعدم اجتماع الخبر قوله تعالى: { كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد * وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب * إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب }، [356] فأفرد ما لم يجتمعوا في التكذيب.
ونظيره في سورة ق: { كل كذب الرسل فحق وعيد }، [357] وتأمل كيف كشف قناع هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله تعالى: { وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا }. [358] كيف أفرد آتيه لما كان المقصود الإشارة إلى أنهم وإن أتوه جميعًا فكل واحد منهم منفرد عن كل فريق من صاحب أو قريب أو رفيق. بل هو وحده منفرد فكأنه، إنما أتاه وحده وإن أتاه مع غيره لانقطاع تبعيته للغير وانفراده بشأن نفسه، فهذا عندي أحسن من الفرق بالإضافة وقطعها. والفرق بذلك فرقه السهيلي رحمه الله تعالى. فتأمل الفرقين واستقر الأمثلة والشواهد.
فصل: كل ذلك لم يكن ولم يكن كل ذلك
وأما مسألة كل ذلك لم يكن ولم يكن كل ذلك، ولم أصنع كله وكله لم أصنعه فقد أطالوا فيها القول وفرقوا بين دلالتي الجملة الفعلية والاسمية. وقالوا: إذا قلت كل ذلك لم يكن وكله لم أصنعه فهو نفي للكل بنفي كل فرد من أفراده فينا قض الإيجاب الجزئي. وإذا قلت لم أصنع الكل ولم يكن كل ذلك فهو نفي للكلية دون التعرض لنفي الأفراد فلا يناقضه الإيجاب الجزئي ولا بد من تقرير مقدمة تبنى عليها هذه المسألة وأمثالها وهي أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدإ بل يجوز أن يكون أعم منه أو مساويًا له إذ لو كان أخص منه لكان ثابتًا لبعض افراده ولم يكن خبرًا عن جملته فإن الأخص، إنما يثبت لبعض أفراد الأعم.
وأما إذا كان أعم منه فإنه لا يمتنع، لأنه يكون ثابتًا لجملة افراد المبتدأ وغيرها، وهذا غير ممتنع، فإذا عرف ذلك، فإذا كان المبتدأ لفظة كل الدال على الإحاطة والشمول. وجب أن يكون الخبر المثبت حاصلًا لكل فرد من أفراد كل والخبر المنفي مثبتًا لكل فرد من أفراده سواء أضفت كلا، أو قطعتها عن الإضافة، فإن الإضافة فيها منوية معنى وإن سقطت لفظًا، فإذا قلت: كلهم ذهب، وكلكم سيروي، أو كل ذهب وكل سيروي عم الحكم افراد المبتدأ فإذا كان الحكم سلبًا نحو كلهم لم يأت وكل لم يقم فكذلك، ولهذا يصح مقابلته بالإيجاب الجزئي نحو قوله ﷺ: وقد سأل أقصرت الصلاة أم نسيت. فقال: كل ذلك لم يكن فقال: ذو اليدين بلى قد كان بعض ذلك.
ومن هذا ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى:
قد أصبحت أم الخيار تدعي ** علي ذنبًا كله لم أصنع
أنشده برفع كل، واستقبحه لحذف الضمير العائد من الخبر، وغير سيبويه يمنعه مطلقًا وينشد البيت منصوبًا فيقول: كلَّه لم أصنع. والصواب إنشاده بالرفع محافظة على النفي العام الذي أراده الشاعر وتمدح به عند أم الخيار، ولو كان منصوبًا لم يحصل له مقصوده من التمدح فإنه لم يفعل ذلك الذنب، ولا شيئًا منه، بل يكون المعنى لم أفعل كل الذنب بل بعضه، وهذا ينافي غرضه. ويشهد لصحة قول سيبويه قراءة ابن عامر في سورة الحديد: { أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلٌّ وعد الله الحسنى }، [359] فهذا يدل على أن حذف العائد جائز، وأنه غير قبيح.
ومن هذا على أحد القولين: { قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون }، [360] أجاز الزجاج أن تكون الجملة ابتدائية وقد حذف العائد من يستعجل وتقديره يستعجله منه المجرمون، كما يحذف من الصلة والصفة والحال. إذا دل عليه دليل ودعوى قبح حذفه من الخبر مما لا دليل عليها. وللكلام في تقرير هذه المسألة موضع آخر.
والمقصود أن إنشاد البيت بالنصب محافظة على عدم الحذف اخلال شديد المعنى. وأما إذا تقدم النفي. وقلت: لم أصنع كله ولم أضرب كلهم، كأنك لم تتعرض للنفي عن كل فرد فرد. وإنما نفيت فعل الجميع، ولم تنف فعل البعض ألا ترى أن قولك لم أصنع الكل مناقض لقولك صنعت الكل. والإيجاب الكلي يناقضه السلب الجزئي. ألا ترى إلى قولهم لم أرد كل هذا فيما إذا فعل ما يريده وغيره، فتقول: لم أرد كل هذا، ولا يصح أن تقول: كل هذا لم أرده، فتأمله فهذا تقرير هذه المسألة وقد أغناك عن ذلك التطويل المتعب القليل الفائدة.
فصل: إضافة كل للمخاطبين
واعلم أن كلًا من ألفاظ الغيبة فإذا أضفته إلى المخاطبين جاز لك أن تعيد المضمر عليه بلفظ الغيبة مراعاة للفظه وأن تعيده بلفظ الخطاب مراعاة لمعناه، فتقول: كلكم فعلتم، وكلكم فعلوا. فإن قلت: أنتم كلكم فعلتم وأنتم كلكم بينكم درهم، فإن جعلت أنتم مبتدأ وكلكم تأكيد. قلت: أنتم كلكم فعلتم وبينكم درهم لتطابق المبتدأ، وإن جعلت كلكم مبتدأ ثانيًا جاز لك وجهان. أحدهما: أن تقول فعلوا وببنهم درهم مراعاة للفظ كل. وإن تقول فعلتم وبينكم درهم عملًا على المعنى، لأن كلًا في المعنى للمخاطبين.
فائدة: كلا وكلتا بين الكوفيين والبصريين
اختلف الكوفيون والبصريون في كلا وكلتا فذهب البصريون إلى أنها اسم مفرد دال على الاثنين. فيجوز عود الضمير إليه باعتبار لفظه وهو الأكثر، ويجوز عوده باعتبار معناه وهو الأقل وألفها لام الفعل ليست ألف تثنية عندهم.
ولهم حجج؛ منها أنها في الأحوال الثلاثة مع الظاهر على صورة واحدة، والمثنى ليس كذلك، وأما انقلابها ياء مع الضمير فلا يدل على أنها ألف تثنية، كألف على وإلى ولدي هذا قول الخليل وسيبويه، واحتجوا أيضا بقولهم كلاهما ذاهب دون ذاهبان. وسيبويه لم يحتج بهذه الجملة لما تقدم من إنك إذا أضفت لفظ كل أفردت خبره مع كونه دالًا على الجمع حملًا على المعنى، لأن قولك: كلكم راع بمنزلة كل واحد منكم راع. فكذا قولك: كلا كما قائم أي كل واحد منكما قائم.
فإن قيل: بل أفرد الخبر عن كل وكلا، لأنهما اسمان مفردان.
قيل: هذا يبطل بتوكيد الجمع والتثنية بهما، وكما لا ينعت الجمع والمثنى بالواحد، فكذلك لا يؤكد به بطريق الأولى، لأن التوكيد تكرار للمؤكد بعينه بخلاف النعت فإنه عينه بوجه.
والمعول عليه لمن نصر مذهب سيبويه على الحجة الأولى على ما فيها وعلى معارضتها بتوكيد الاثنين. وكلا والمثنى لا يؤكد بالمفرد كما قررناه.
فإن قيل: الجواب عن هذا أن كلا اسم للمثنى فحسن التوكيد به، وحصلت المطابقة باعتبار مدلوله وهو المقصود من الكلام، فلا يضر إفراد اللفظ.
قيل: هذا يمكن في الجمع أن يكون لفظه واحدًا ومعناه جمعًا نحو كل وأسماء الجموع كرهط وقوم، لأن الجموع قد اختلفت صورها أشد اختلاف فمذكر ومؤنث مسلم ومكسر على اختلاف ضروبه، وما لفظه على لفظ واحده كما تقدم بيانه، فليس ببدع أن يكون صورة اللفظ مفردًا ومعناه جمعًا. وأما التثنية فلم تختلف قط. بل لزمت طريقة واحدة أي وقعت فبعيد جدًا. بل ممتنع أن يكون منها اسم مفرد معناه مثنى، وليس معكم إلا القياس على الجمع. وقد وضح الفرق بينهما، فتعين أن تكون كلا لفظًا مثنى ينقلب ألفه ياء مع المضمر دون المظهر، لأنك إذا أضفته إلى ظاهر استغنيت عن قلب ألفه ياء بانقلابها في المضاف إليه لتنزله منزلة الجزئية لدلالة اللفظ على مدلول واحد، لأن كلًا هو نفس ما يضاف إليه، بخلاف قولك: ثوبا الرجلين وفرسا الزيدين. فلو قلت: مررت بكلى الرجلين، جمعت بين علامتي تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنهما لا ينفصلان أبدًا، ولا تنفك كلا هذه عن الإضافة بحال. ألا ترى كيف رفضوا ضربت رأسي الزيدين. وقالوا: رؤوسهما لما رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم واحد هذا مع أن الرؤوس تنفصل عن الإضافة كثيرًا. وكذلك القلوب من قوله: { صغت قلوبكما } [361] فإذا كانوا قد رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة عارضة فما ظنك بهذا الموضع الذي لا تفارقه الإضافة، ولا تنفك عنه. فهذا الذي حملهم على أن ألزموها الألف على كل حال وكان هذا أحسن من إلزام طيء وخثعم وبني الحرث وغيرهم المثنى للألف في كل حال نحو الزيدان والعمران. فإذا أضافوه إلى الضمير قلبوا ألفه في النصب والجر، لأن المضاف إليه ليس فيه علامة إعراب، ولا يثنى بالباء، ولكنه أبدًا بالألف. فقد زالت العلة التي رفضوها في الظاهر وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله كما ترى. وإن كان سيبويه المعظم المقدم في الصناعة، فمأخوذ من قوله ومتروك.
ومما يدل على صحة هذا القول أن كلًا يفهم من لفظه ما يفهم من لفظ كل، وهو موافق له في فاء الفعل وعينه. وأما اللام فمحذوفة كما حذفت في كثير من الأسماء. فمن ادعى أن لام الفعل واو وإنه من غير لفظ كل، فليس دلبل يعضده، ولا اشتقاق يشهد له.
فإن قيل: فلم رجع الضمير إليها بلفظ الافراد إذا كانت مثناة؟
قيل: لما تقدم من رجوع الضمير على كل، لذلك إيذانًا بأن الخبر عن كل واحد واحد. فكأنك قلت: كل واحد من الرجلين قام وفيه نكتة بديعة. وهي أن عود الضمير بلفظ الافراد أحسن، لأنه يتضمن صدور الفعل عن كل واحد منفردًا به ومشاركًا للآخر.
فإن قيل: فلم كسرت الكاف من كلا وهي من كل مضمومة؟
قيل: هذا لا يلزمهم، لأنهم لم يقولوا إنها لفظة كل بعينها ولهم أن يقولوا: كسرت تنبيهًا على معنى الاثنين كما يبتدأ لفظ الاثنين بالكسر، ولهذا كسروا العين من عشرين إشعارًا بتثنية عشر.
ومما يدل على صحة هذا القول أيضا أن كلتا بمنزلة قولك ثنتا، ولا خلاف أن ألف ثنتا ألف تثنية، فكذلك ألف كلتا. ومن ادعى أن الأصل فيها كلواهما فقد ادعى ما تستبعده العقول ولا يقوم عليه برهان.
ومما يدل أيضا على صحته أنك تقول في التوكيد مررت بإخوتك ثلاثتهم وأربعتهم فتؤكد بالعدد فاقتضى القياس أن تقول أيضا في التثنية كذلك مررت بأخويك اثنيهما. فاستغنوا عنه بكليهما لأنه في معناه. وإذا كان كذلك فهو مثنى مثله.
فإن قيل فإنك تقول كلا أخويك جاء، ولا تقول: اثنا أخويك جاء فدل على أنه ليس في معناه.
قيل العدد الذي يؤكد به، إنما يكون تأكيدًا مؤخرًا تابعًا لما قبله، فأما إذا قدم لم يجز ذلك لأنه في معنى الوصف. والوصف لا يقدم على الموصوف، فلا تقول ثلاثة أخوتك جاؤوني وهذا بخلاف كل وكلا وكلتا، لأن فيهما معنى الإحاطة فصارت كالحرف الداخل لمعنى فيما بعذه فحسن تقديمهما في حال الإخبار عنها، وتأخيرهما في حال التوكيد فهذا في هذا المذهب كما ترى.
فائدة: تأكيد المفرد بأجمع
لا يؤكد بأجمع المفرد مما يعقل ولا ما حقيقته لا تتبعض. وهذا إنما يؤكد به ما يتبعض كجماعة من يعقل فجرى مجرى كل.
فإن قيل: فقد تقول: رأيت زيدًا أجمع إذا رأيته بارزًا من طاقة ونحوه.
قيل: ليس هذا توكيدًا في الحقيقة لزيد، لأنك لا تريد حقيقته وذاته، وإنما تريد به ما تدرك العين منه.
وأجمع هذه اسم معرفة بالإضافة، وإن لم يكن مضافًا في اللفظ، لأن معنى قبضت المال أجمع أي كله، فلما كان مضافًا في المعنى تعرف وأكد به المعرفة، وإنما استغنوا عن التصريح بلفظ المضاف إليه معه ولم يستغن عن لفظ المضاف مع كل إذا قلت: قبضت المال كله لأن كلًا تكون توكيد وغير توكيد، وتتقدم في أول الكلام. نحو كلكم ذاهب فصار بمنزلة نفسه وعينه، لأن كل واحد منهما يكون توكيدًا وغير توكيد. فإذا أكدته لم يكن بد من إضافته إلى ضمير المؤكد حتى يعلم أنه توكيد. وليس كذلك أجمع لأنه لا يجيء إلا تابعًا لما قبله. فاكتفى بالاسم الظاهر المؤكد واستغنى به عن التصريح بضميره، كما فعل بسحر حين أردته ليوم بعينه فإنه عرف بمعنى الإضافة واستغني عن التصريح بالمضاف إليه اتكالًا عن ذكر اليوم قبله.
فإن قيل: ولم لم تقدم أجمع كما قدم كل؟
قيل الجواب: إن فيه معنى الصفة، لأنه مشتق من جمعت فلم يكن يقع تابعًا بخلاف كل.
ومن أحكامه أنه لا يثنى ولا يجمع على لفظه. أما امتناع تثنيته، فلأنه وضع لتأكيد جملة تتبعض فلو ثنيته لم يكن في قولك أجمعا توكيد لمعنى التثنية كما في كليهما، لأن التوكيد تكرار المعنى المذكور، إذا قلت درهمان أفدت أنهما اثنان فإذا قلت: كلاهما كأنك قلت: اثناهما ولا يستقيم ذلك في أجمعان لأنه بمنزلة من يقول: أجمع وأجمع كالزيدان بمنزلة زيد وزيد فلم يفدك أجمعان تكرار معنى التثنية، وإنما أفادك تثنية واحدة بخلاف كلاهما فإنه ليس بمنزلة قولك: كل وكل، وكذلك أثناهما المستغنى عنه بكليهما لا يقال فيها اثن واثن. فإنما هي تثنية لا تنحل ولا تنفرد فلم يصلح لتأكيد معنى التثنية غيرها. فلا ينبغي أن يؤكد معنى التثنية والجمع إلا بما لا واحد له من لفظه كيلا يكون بمنزلة الأسماء المفردة المعطوف بعضها على بعض بالواو وهذه علة امتناع الجمع فيه لأنك لو جمعته كان جمعًا لواحد من لفظه ولا يؤكد معنى الجمع إلا بجمع لا ينحل إلى الواحد.
فإن قيل: هذا ينتقض بأجمعين وأكتعين فإن واحده أجمع وأكتع؟
قيل: سيأتي جوابه وإن شئت قلت إن أجمع في معنى كل وكل لا يثنى ولا يجمع إنما يثنى ويجمع الضمير الذي يضاف إليه كل.
وأما قولهم في تأنيثه جمعاء فلأنه أقرب إلى باب أحمر، وحمراء من باب أفضل وفضلى. فلذلك لم يقولوا: في تأنيثه جمعى ككبرى. ودليل ذلك أنه ل يدخله الألف واللام، ولا يضاف صريحًا فكان أقرب إلى باب أفعل وفعلي. وإن خالفه في غير هذا.
وأما أجمعون أكتعون فليس بجمع لأجمع وأكتع ولا واحد له من لفظه، وإنما هو لفظ وضع لتأكيد الجمع بوزن الاسمين بمنزلة اثينون تصغير الاثنان فإنه جمع مسلم، ولا واحد له من لفظه، والدليل على ذلك أنه لو كان واحد أجمعين أجمع لما قالوا في المؤنث: جمعاء، لأن فعل بفتح العين لا يكون واحده فعلًا. وجمعاء التي هي مؤنث أجمع، لو جمعت لقيل: جمعاوات، أو جمع بوزن حمر. وأما فعل بوزن كبر فجمع لفعلى، وإنما جاء أجمعون على وزن أكرمون وأرذلون، لأن فيه طرفًا من معنى التفضيل كما في الأكرمين والأرذلين، وذلك أن الجموع تختلف مقاديرها، فإذا كثر العدد احتيج إلى كثرة التوكيد حرصًا على التحقيق ورفعًا للمجاز. فإذا قلت: جاء القوم كلهم وكان العدد كثيرًا توهم إنه قد شذ منهم البعض فاحتيج إلى توكيد أبلغ من الأول. فقالوا: أجمعون، أكتعون فمن حيث كان أبلغ من التوكيد الذي قبله دخله معنى التفضيل، ومن حيث دخله معنى التفضيل جمع جمع السلامة كما يجمع أفعل الذي فيه ذلك المعنى جمع السلامة كأفضلون ويجمع مؤنثه على فعل كما يجمع مؤنث ما فيه من التفضيل.
وأما أجمع الذي هو توكيد الاسم الواحد فليس فيه من معنى التفضيل شيء وكان كباب أحمر، ولذلك استغنى أن يقال: كلاهما أجمعان كما يقال كلهم أجمعون، لأن التثنية أدنى من أن يحتاج إلى توكيدها إلى هذا المعنى. فثبت أن أجمعون لا واحد له من لفظه لأنه توكيد لجمع من يعقل، وأنت لا تقول فيمن يعقل جاءني زيد أجمع. فكيف يكون جاءني الزيدون أجمعون جمعًا له وهو غير مستعمل في الإفراد.
وسر هذا ما تقدم وهو أنهم لا يؤكدون مع الجمع والتثنية إلا بلفظ لا واحد له ليكون توكيدًا على الحقيقة، لأن كل جمع ينحل لفظه إلى الواحد فهو عارض في معنى الجمع فكيف يؤكد به معنى الجمع والتوكيد تحقيق وتثبيت ورفع للبس والإبهام فوجب أن يكون مما يثبت لفظًا ومعنى.
وأما حذف التنوين من جمع فكحذفه من سحر، لأنه مضاف في المعنى.
فإن قيل: ونون الجمع محذوفة في الإضافة أيضا فهلا حذفت من أجمعين، لأنه مضاف في المعنى.
قيل: الإضافة المعنوية لا تقوى على حذف النون المتحركة التي هي كالعرض من الحركة والتنوين. ألا ترى أن نون الجمع تثبت مع الألف واللام وفي الوقف والتنوين بخلاف ذلك. فقويت الإضافة المعنوية على حذفه، ولم تقو على حذف النون إلا الإضافة اللفظية.
فإن قيل: ولم كانت الإضافة اللفظية أقوى من المعنوية، والعامل اللفظي أقوى من المعنوي.
قيل: اللفظي لا يكون إلا متضمنًا لمعناه، فإذا اجتمعا معًا كان أقوى من المعخى المفرد عن اللفظ فوجب أن تكون أضعف. وهذا ظاهر لمن عدل وأنصف.
هامش
[التحريم: 4]
بدائع الفوائد
المجلد الأول | المجلد الثاني | المجلد الثالث | المجلد الرابع
==============
[البقرة: 185]
[البروج: 9]
[الطلاق: 1]
[المجادلة: 2]
[المجادلة: 2]
[المجادلة: 3]
[المجادلة: 2]
[المجادلة: 1]
[يوسف: 4]
[الواقعة: 74]
[الأعلى: 1]
[الحديد؛ الحشر؛ الصف: 1]
[النحل: 49]
[الأعراف: 206]
[طه: 5]
[الرحمن: 2]
[الملك: 20]
[الأحزاب: 43]
[التوبة: 117]
[البقرة: 157]
[البلد: 14]
[البقرة: 177، التوبة: 18]
[البقرة: 6]
[الأعراف: 193]
[القيامة: 1]
[الطور: 23]
[البقرة: 187]
في النتائج: ابنات.
[النحل: 1]
[ق: 2]
[المائدة: 116]
[يوسف: 26 - 27]
[البقرة: 23]
[البقرة: 24]
[الشورى: 48]
[الإسراء: 67]
[فصلت: 51]
[الإسراء: 83]
[فصلت: 51]
[النساء: 176]
[الأعراف: 160]
[الأنعام: 118]
[الأنعام: 118]
[المؤمنون: 16]
[الزخرف: 81]
[الأنبياء: 22]
[الإسراء: 42]
[الأنبياء: 34]
[آل عمران: 144]
[الأعراف: 160]
[الأنعام: 118]
[آل عمران: 118]
[لقمان: 27]
مفقود
[الإسراء: 100]
[النساء: 64]
[النساء: 66]
[لقمان: 27]
[الأنبياء: 22]
[لقمان: 27]
[البقرة: 38]
[هود: 34]
[الأحزاب: 50]
[النحل: 78]
[الزمر: 6]
الصحيحة 1076
[المجادلة: 7]
[البقرة: 222]
[الجاثية: 7]
[المطففين: 12]
[الحج: 27]
[المائدة: 6]
[الصافات: 158]
[الرحمن: 56]
[الرحمن: 39]
[الجن: 5]
[يونس: 61]
[يونس: 61]
[الرحمن: 68]
[البقرة: 98]
[آل عمران: 43]
[الحج: 26]
[آل عمران: 75]
[الحجر: 26]
[الرحمن: 56]
[الجن: 1]
[الجن: 5]
[البقرة: 222]
[الجاثية: 7]
[المزمل: 20، المجادلة: 13]
[الإسراء: 36]
[طه: 46]
[الإسراء: 36]
[غافر: 56]
[النساء: 134]
[النساء: 69]
[البقرة: 209]
[النساء: 134]
[طه: 46]
[يونس: 61]
[سبأ: 3]
[الزمر: 68]
[سبأ: 37]
[الأنفال: 28]
[المنافقون: 9]
[التوبة: 24]
[آل عمران: 14]
[النحل: 6]
[التوبة: 111]
[الصف: 11]
[التوبة: 25]
[التوبة: 111]
[سبأ: 1]
[سبأ: 2]
[غافر: 7]
[النساء: 12]
[غافر: 7]
[آل عمران: 43]
[الحج: 77]
[الحج: 126]
[الأنعام: 27، 30]
[القصص: 63]
[غافر: 49]
[القصص: 15]
[النساء: 57، 122]
[النساء: 56]
[هود: 77]
[يوسف: 96]
[النمل: 8]
[الرحمن: 7 - 8]
التصويب من المصادر.
[الجمعة: 7]
[الجمعة: 6]
[البقرة: 95]
[البقرة: 94]
[الأعراف: 143]
[الزخرف: 77]
[الأعراف: 143]
[الزخرف: 77]
[البقرة: 95]
الأصل: لن، والتصويب من نتائج الفكر.
[الزخرف: 39]
[الزخرف: 39]
[البقرة: 165]
[الأنفال: 33]
[الأنفال: 33]
[هود: 117]
[القصص: 59]
[القصص: 8]
[البلد: 11]
[القيامة: 1]
[البقرة: 233]
[البقرة: 238]
[الفتح: 27]
[إبراهيم: 7]
[الإسراء: 86]
[الإسراء: 88]
[فاطر: 41]
من النتائح؛ فالأصل: سماوات.
[الطلاق: 12]
[الملك: 16]
[الملك: 17]
[يونس: 61]
[سبأ: 3]
[الأنعام: 3]
الطبري
[الأنعام: 3]
تفسير القرطبي ومجموع الفتاوى.
[الذاريات: 23]
[التغابن: 1، الجمعة: 1]
[الأنبياء: 19]
[الإسراء: 44]
[الذاريات: 22]
[النمل: 65]
[يونس: 31]
[سبأ: 24]
[يونس: 41]
[الروم: 48]
[سبأ: 24]
[الذاريات: 41]
[يونس: 22]
[الأنعام: 1]
[الأنعام: 153]
[النحل: 48]
[الحجر: 41]
[النحل: 9]
مفقود
[البقرة: 257]
[النحل: 48]
[الواقعة: 41]
[ق: 17]
[الأعراف: 17]
[المائدة: 6]
[المعارج: 40]
[الرحمن: 13]
[المزمل: 9]
[المعارج: 41]
[الصافات: 5]
[هود: 67]
[هود: 66]
[الأعراف: 78]
[الشعراء: 189]
[هود: 94]
[النحل: 36]
[الأعراف: 30]
[النحل: 36]
عجزه: (هم القوم كل القوم يا أم خالد)
[ص: 75]
[الشمس: 5]
[ص: 75]
[الشمس: 5]
الأصل: يستحقه، والمثبت من النتائج.
[التوبة: 67]
[البقرة: 194]
[يونس: 31]
[يونس: 31]
[النمل: 63]
[النمل: 62]
[النمل: 64]
[النساء: 3]
[التحريم: 7]
[الجمعة: 6]
[مريم: 29]
[الكهف: 16]
[الزمر: 3]
أبو داود والترمذي.
[الزخرف: 26]
[الكهف: 16]
[البقرة: 61]
[التوبة: 77]
[آل عمران: 79]
[الأنعام: 93]
[النور: 41]
[آل عمران: 163]
[الصافات: 96]
[الصافات: 95]
[الحجر: 2]
[فاطر: 28]
[التوبة: 117]
[البقرة: 151]
[البقرة: 198]
[القصص: 77]
[الصافات: 96]
[الصافات: 95]
[النحل: 17]
[النحل: 20]
[لقمان: 11]
[النحل: 20]
[الصافات: 96]
[الأعراف: 194]
[يس: 22]
[الصافات: 96]
[التوبة: 77]
[غافر 75]
[الصافات 95]
[الصافات 96]
[الأعراف 194]
[يس 41 - 42]
[يس 43]
[النحل 81]
[النحل: 80]
[مريم: 69]
[الأنعام: 159]
[سبأ: 54]
[الأنعام: 93]
[الزمر: 3]
[الشعراء: 227]
[القارعة: 1، 2]
[الحاقة: 1، 2]
[البروج: 15]
[البقرة: 155]
[ق: 38]
[يونس: 62]
[الأنعام: 103]
[المجادلة: 1]
[المرسلات: 23]
[الأعراف: 180]
[الاعراف: 180]
[الكهف: 27]
[المائدة: 64]
[يوسف: 76]
[الصافات: 113]
الأصل: احتمل، والمثبت من النتائج.
[ق: 16]
[ق: 18]
[الأعلى: 2 - 4]
[الزخرف: 10 - 12]
[الحشر: 24]
[غافر: 3]
[النمل: 78]
[آل عمران: 4]
[الأعلى: 2، 3]
[الزخرف: 10، 11، 12]
[غافر: 3]
[غافر: 2]
[السجدة: 13]
[النحل: 102]
[فصلت: 42]
[فصلت: 12]
[غافر: 3]
[القيامة: 9]
[الأعراف: 4]
[يونس: 24]
[النحل: 98]
[الصافات: 47]
[البقرة: 74]
[البقرة: 19]
[البقرة: 6]
[النازعات: 27]
[الدخان: 37]
[الطور: 39]
[الزخرف: 16]
[الطور: 38]
[الصافات: 156]
[الطور: 35]
[الكهف: 9]
[الطور: 30]
[البقرة: 214، آل عمران: 142]
[الزخرف: 52]
[المؤمنون: 69]
[الطور: 39]
[الزخرف: 52]
[الروم: 35]
[الكهف: 9]
[النمل: 20]
[الزخرف: 52]
[البقرة: 214]
[آل عمران: 142]
[الجاثية: 21]
[البقرة: 34]
[البقرة: 49]
[البقرة: 50]
[يوسف: 15]
[الزمر: 73]
[التوبة: 92]
[يونس: 2]
[الفرقان: 69]
[الأعراف: 57]
[الأعراف: 57]
[النحل: 69]
[النحل: 67]
[الأنبياء: 33]
[الأنبياء: 93]
[الأنفال: 54]
[الرحمن: 26]
[البقرة: 116]
[مريم: 93]
[الإسراء: 84]
[ق: 14]
[البقرة: 285]
[النساء: 95]
[الأنبياء: 93]
[البقرة: 116]
[الرحمن: 26]
[الأنبباء: 33]
[ص: 12]
[ق: 14]
[مريم: 95]
[الحديد: 10]
[يونس: 50]
===========
[أغلق]
* اقرأ * * نزّل * استشهد * شارك في ويكي مصدر *
بدائع الفوائد/المجلد الثاني
< بدائع الفوائد اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
→ المجلد الأول بدائع الفوائد
المجلد الثاني
ابن القيم المجلد الثالث ←
محتويات
1 فائدة بديعة: دلالات العين
2 فائدة: إبدال النكرة من المعرفة
3 فائدة بديعة: تفسير اهدنا الصراط المستقيم
3.1 فصل: تعريف الصراط باللام
3.2 فصل: اشتقاق الصراط
3.3 فصل: إضافة الصراط إلى الموصول المبهم
3.4 فصل: قال أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم
3.5 فصل: تعدية الفعل بنفسه
3.6 فصل: تخصيص أهل السعادة بالهداية
3.7 فصل: قال غير المغضوب ولم يقل لا المغضوب عليهم
3.8 فصل: جريان غير صفة على المعرفة
3.9 فصل: إخراج صراط مخرج البدل
3.10 فصل: تفسير المغضوب عليهم والضالين
3.11 فصل: تقديم المغضوب عليهم على الضالين
3.12 فصل: اسم المفعول في المغضوب واسم الفاعل في الضال
3.13 فصل: زيادة لا بين المعطوف والمعطوف عليه
3.14 فصل: معنى الهداية
3.15 فصل: الإتيان بالضمير في قوله اهدنا
3.16 فصل: ما هو الصراط المستقيم
4 فائدة: بدل البعض وبدل المصدر
5 فائدة بديعة: ولله على الناس حج البيت
6 فائدة بديعة: يسألونك عن الشهر الحرام
7 فائدة: مجيء الحال من المضاف إليه
8 فائدة بديعة: إضمار الناصب
9 فائدة: مصدر الفعل اللازم
10 فائدة: فعل المطاوعة
11 فائدة: المتعدي إلى مفعولين
12 فائدة: اخترت يتعدى بحرف الجر
13 فائدة: تقديم المجرور وتأخير المفعول
14 فائدة بديعة: استغفر زيد ربه ذنبه
15 فائدة: ألبست زيدا الثوب
16 فائدة: حذف الباء من أمرتك الخير
17 فائدة بديعة: أصل وضع عرفت كذا
18 تنبيه
19 فصل: حروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيه ما بعدها
20 فصل: العامل في قولك لو أنك ذاهب فعلت
21 فائدة: الاقتصار على المفعول الأول من باب أعلمت
22 فائدة: الفعل الذي يطلب مفعولا ولا يصل إليه بنفسه
23 فصل: سمع الله لمن حمده
24 فصل: قولهم قرأت الكتاب واللوح
25 فصل: كفى بالله شهيدا
26 فائدة: تعدي الفعل إلى المصدر
27 فصل فيما يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكد
28 فصل: توكيد الفعل وتوكيد النكرة
29 فصل: فيما يحدد من المصادر بالهاء
30 فصل: تثنية المصادر وجمعها
31 فائدة: لفظ سحر وتقسيمه
32 فصل: ضحوة وعشية ومساء
33 فصل: غدوة وبكرة
34 فصل: عمل الفعل وشروطه
35 فصل: تعدي الفعل واشتقاقه
36 فصل: جلست خلفك وأمامك
37 فصل: تعدي الفعل إلى الحال بنفسه
38 فصل: إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم
39 فائدة: قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا
40 فصل: صاحب الحال
41 فصل: تقديم معمول أفعل التفضيل عليه
42 فصل: عمل العامل الواحد في حالين
43 فصل: التقديم والتأخير في الحالين
44 فصل: تصور الحال في غير المشتق
45 فصل: مدلول الإشارة بقولك هذا
46 فصل: هل النصب على أنه خبر كان
47 فصل: اتحاد المفضل والمفضل عليه
48 (مسألة سلام عليكم ورحمة الله)
48.1 فصل: إطلاق السلام على الله تعالى
48.2 فصل: هل السلام مصدر أو اسم مصدر
48.3 فصل: هل السلام عليكم إنشاء أم خبر
48.4 فصل: معنى السلام المطلوب عند التحية
48.5 فصل: الحكمة في السلام عند اللقاء
48.6 فصل: تعدية السلام بعلى
48.7 فصل: الابتداء بالنكرة في السلام
48.8 فصل: تقديم السلام في جانب المسلم
48.9 فصل: ابتداء السلام بالنكرة والجواب بالمعرفة
48.10 فصل: السلام في المكاتبة
48.11 فصل: نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة
48.12 فصل: نصب السلام ورفعه
48.13 فصل: تسليم الله أنبيائه ورسله
48.14 فصل: التسليم بلفظ النكرة أو المعرفة
48.15 فصل: التسليم على يحيى والمسيح
48.16 فصل: تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح
48.17 فصل: تسليم نبينا وتسليم موسى
48.18 فصل: قل الحمد لله وسلام على عباده
48.19 فصل: عليك السلام تحية الموتى
48.20 فصل: إذا سلم أهل الكتاب فقولوا وعليكم
48.21 فصل: اقتران الرحمة والبركة بالسلام
48.22 فصل: لماذا نهاية السلام عند قوله وبركاته
48.23 فصل: إضافة الرحمة لله وتجريد السلام عن الإضافة
48.24 فصل: الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة
48.25 فصل: الرحمة المضافة إلى الله
48.26 فصل: البركة المضافة لله
48.27 فصل: تأكيد السلام على النبي دون الصلاة عليه
48.28 فصل: تقديم السلام على النبي في الصلاة قبل الصلاة عليه
48.29 فصل: السلام بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة
48.30 فصل: الثناء على الله في التشهد
48.31 فصل: السلام في آخر الصلاة وتعريفه
49 (تفسير المعوذتين)
49.1 الفصل الأول: الاستعاذة وبيان معناها
49.2 الفصل الثاني: المستعاذ به هو الله
49.3 الفصل الثالث: الشرور المستعاذ منها
49.4 فصل: الشر المستعاذ منه نوعان
49.5 فصل: الشر ومصدره ومنتهاه
49.6 فصل: الشرور المستعاذ منها في المعوذتين
49.7 فصل: حديث لبيك وسعديك
49.8 فصل: من شر ما خلق
49.9 فصل: شر غاسق إذا وقب
49.10 فصل: سبب الاستعاذة من شر الليل
49.11 فصل: سر الاستعاذة برب الفلق
49.12 فصل: تفسير الفلق
49.13 فصل: شر النفاثات في العقد
49.14 فصل: تأثيرات السحر
49.15 فصل: شر الحاسد إذا حسد
49.16 فصل: العائن والحاسد
49.17 فصل: الحاسد من الجن والإنس
49.18 فصل: تقييد الحاسد بقوله إذا حسد
49.19 فصل: دفع شر الحاسد عن المحسود
49.20 فصل: تأثير نفوس الحاسدين وأعينهم والأرواح الشيطانية
49.21 (سورة الناس)
49.22 فصل: الاستعاذة من الشر
49.23 فصل: الوسواس
49.24 فصل: هل الوسواس وصف أو مصدر
49.25 فصل: الخناس وبيان اشتقاقه
49.26 فصل: الصفة الثالثة للوسواس
49.27 فصل: الصدور والقلوب
49.28 فصل: الجار والمجرور من الجنة والناس
50 قاعدة نافعة: اعتصام العبد من الشيطان
فائدة بديعة: دلالات العين
العين: يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان، وليست اللفظة على أصل موضوعها، لأن أصلها أن يكون مصدرًا وصفة لمن قامت به، ثم عبر عن حقيقة الشيء بالعين، كما عبر عن الوحش بالصيد، وإنما الصيد في أصل موضوعه مصدر من صاد يصيد ومن ههنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري سبحانه وتعالى، لأن نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم. وأما عين القبلة وعين الذهب وعين الميزان فراجعة إلى هذا المعنى. وأما العين الجارية فمشبهة بعين الإنسان لموافقتها لها في كثير من صفاتها. وأما عين الإنسان فمسماة بما أصله أن يكون صفة ومصدرًا، لأن العين في أصل الوضع مصدر كالدين والزين والبين والأين وما جاء على بنائه. ألا تراهم يقولون: رجل عيون وعاين، ويقولون: عنته أصبته بالعين وعاينته رأيته بالعين، وفرقوا بين المعنيين وكأن عاينته من الرؤية أولى من عنته، لأنه بمنزلة المفاعلة والمقابلة فقد تقابلتما وتعاينتما بخلاف عنته. فإنك تفرد إصابته العين من حيث لا يشعر.
ومما يدلك على أنها مصدر في الأصل قوله تعالى: { عين اليقين كما قال: { علم اليقين }، [1] و { حق اليقين }، [2] فالعلم والحق مصدران مضافان إلى اليقين، فكذلك العين. هكذا قال السهيلي رحمه الله تعالى. وفيه نظر، لأن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم نفس الشيء وذاته. فعين اليقين نفس اليقين، والعين التي هي عضو سميت عينًا، لأنها آلة ومحل لهذه الصفة التي هي العين. وهذا من باب قولهم امرأة ضيف وعدل تسمية للفاعل باسم المصدر والعين التي هي حقيقة الشيء ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدر كصيد.
قال السهيلي: إذا علمت هذا، فاعلم أن العين أضيفت إلى الباري تعالى كقوله: { ولتصنع على عيني }، [3] حقيقة لا مجازًا كما توهم أكثر الناس، لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك، وإنما المجاز في تسمية العضو بها وكل شيء يوهم الكفر والتجسيم فلا يضاف إلى الباري تعالى لا حقيقة ولا مجازًا. ألا ترى كيف كفر الرومية من النصارى حيث قالوا في عيسى إنه ولد، على المجاز لا على الحقيقة، فكفروا ولم يدروا. [4] ألا ترى كيف لم يضف سبحانه إلى نفسه ما هو في معنى عين الإنسان كالمقلة والحدقة حقيقة، ولا مجازًا نعم ولا لفظ الإبصار، لأنه لا يعطي معنى البصر والرؤية مجردًا، ولكنه يقتضي مع معنى البصر معنى التحديق والملاحظة ونحوهما.
قلت: كأنه رحمه الله غفل عن وصفه بالسميع البصير وغفل عن قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه»، [5] وأما إلزامه التحديق والملاحظة ونحوها فهو كإلزام المعتزلة نظيره في الرؤية فهو منقول من هناك حرفًا بحرف. وجوابه من وجوه.
أحدها: ما تعني بالتحديق والملاحظة. أمعنى البصر والإدراك أو قدرًا زائدًا عليهما غير ممتنع وصف الرب به. أو معنى زائدًا يمتنع وصفه به. فإن عنيت الأولين منعنا انتفاء اللازم، وإن عنيت الثالث منعنا الملازمة، ولا سبيل إلى إثباتها بحال.
الثاني: إن هذا التحديق والملاحظة، إنما تلزم الصفة من جهة إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة إلى الرب تعالى. وهذا كسائر خصائص المخلوقين التي تطرقت الجهمية بها إلى نفي صفات الرب وهذا من جهلهم وتلبيسهم. فإن خصانص صفات المخلوقين لا تلزم الصفة مضافة إلى الرب تعالى، كما لا يلزم خصائص وجودهم وذاتهم وهذا مقرر في موضعه. وهذا الأصل الذي فارق به أهل السنة طائفتي الضلال من المشبهة والمعطلة فعليك بمراعاته.
الثالث: قوله لا يعطي الأبصار معنى البصر والرؤية مجردًا كلام لا حاصل تحته ولا تحقيق فإنه قد تقرر عقلًا ونقلًا أن لله تعالى صفة البصر ثابتة كصفة السمع. فإن كان لفظ الإبصار لا يعطي الرؤية مجردة. فكذلك لفظ السمع وإن أعطى السمع إدراك المسموعات مجردًا. فكذلك البصر. فالتفريق بينهما تحكم محض.
ثم نعود إلى كلامه، قال: وكذلك لا يضاف إليه سبحانه وتعالى من آلات الإدراك الأذن ونحوها، لأنها في أصل الوضع عبارة عن الجارحة لا عن الصفة التي هي محلها فلم ينقل لفظها إلى الصفة أعني السمع مجازًا ولا حقيقة إلا أشياء وردت على جهة المثل بما يعرف بأدنى نظر أنها أمثال مضروبة نحو الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن مما عرفت العرب المراد به بأول وهلة.
قال: وأما اليد فهي عندي في أصل الوضع كالمصدر عبارة عن صفة لموصوف قال:
يديتُ على ابن حَصحاصِ بن عمرو ** بأسفل ذي الجذاة يدَ الكريم
فيديت فعل مأخوذ من مصدر لا محالة والمصدر صفة موصوف. ولذلك مدح سبحانه بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله: { أولي الأيدي والأبصار }، [6] ولم يمدحهم بالجوارح، لأن المدح لا يتعلق إلا بالصفات لا بالجواهر.
قلت: المراد بالأيدي والأبصار هنا القوة في أمر الله والبصر بدينه فأراد أنهم من أهل القوى في أمره، والبصائر في دينه، فليست من يديت إليه يدًا فتأمله.
قال: وإذا ثبت هذا فصح قول أبي الحسن الأشعري إن اليد من قوله: خلق آدم بيده، وقوله تعالى: { لما خلقت بيدي }، [7] صفة ورد بها الشرع؛ ولم يقل إنها في معنى القدرة كما قال المتأخرون من أصحابه، ولا في معنى النعم، ولا قط بشيء من التأويلات تحرزًا منه عن مخالفة السلف. وقطع بأنها صفة تحرزًا عن مذهب المشبهة. فإن قيل: وكيف خوطبوا بما لا يفهمون ولا يستعملون، إذ اليد بمعنى الصفة لا يفهم معناه؟ قلنا: ليس الأمر كذلك. بل كان معناها مفهومًا عند القوم الذين نزل القرآن بلغتهم، ولذلك لم يستفت واحد من المؤمنين عن معناها، ولا خاف على نفسه توهم التشبيه، ولا احتاج إلى شرح وتنبيه. وكذلك الكفار لو كانت (اليد) عندهم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض واحتجوا بها على الرسول ﷺ ولقالوا له زعمت أن الله تعالى ليس كمثله شيء ثم تخبر أن له يدًا كأيدينا وعينًا كأعيننا؛ ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر، علم أن الأمر كان فيهم عندهم جليًا ولا خفيًا، وأنها صفة سميت الجارحة بها مجازًا، ثم استمر المجاز فيها حتى نسيت الحقيقة. ورب مجاز كثر واستعمل حتى نسي أصله وتركت حقيقته. والذي يلوح في معنى هذه الصفة أنها قريب من معنى القدرة، إلا أنها أخص منها معنى والقدرة أعم كالمحبة مع الإرادة والمشيئة. وكل شيء أحبه الله فقد أراده، وليس كل شيء أراده أحبه، وكذلك كل شيء حادث فهو واقع بالقدرة، وليس كل واقع بالقدرة واقعًا باليد. فاليد أخص من معنى القدرة، ولذلك كان فيها تشريف لآدم.
قلت: أما قوله: ليس كل شيء أراده فقد أحبه. فهذا صحيح. وهوأحد قولي الأشعري وقول المحققين من أصحابه، وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول كما هو مقرر في موضعه.
وأما قوله: كل شيء أحبه فقد أراده، فإن كان المراد أنه أراده بمعنى رضيه وأراده دينا فحق. وإن كان المراد أنه أراده كونًا فغير لازم. فإنه سبحانه يحب طاعة عباده كلهم ولم يردها ويحب التوبة من كل عاص ولم يرد ذلك كله تكوينًا إذ لو أراده لوقع فالمحبة والإرادة غير متلازمين فإنه يريد كون ما لا يحبه ويحب ويرضى بأشياء لا يريد تكوينها، ولو أرادها لوقعت وهذا مقرر في غير هذا الموضع.
قال: ومن فوائد هذه المسألة أن يسأل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى: { ولتصنع على عيني }، [8] بحرف على، وقال تعالى: { تجري بأعيننا } [9] بالباء، { واصنع الفلك بأعيننا }، [10] وما الفرق؟ فالفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيًا وإبداء ما كان مكتومًا، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرًا. فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستسرار، دخلت على في اللفظ تنبيهًا على المعنى، لأنها تعطي الاستعلاء والاستعلاء ظهور وإبداء فكأنه يقول سبحانه وتعالى: ولتصنع على أمن لا تحت خوف وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. وأما قوله تعالى: { تجري بأعيننا }، { واصنع الفلك بأعيننا } فإنه إنما يريد برعاية منا حفظ، ولا يريد إبداء شيء، ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم.
هذا كلامه، ولم يتعرض رحمه الله لوجه الإفراد هناك والجمع هنا، وهو من ألطف معاني الآية. والفرق بينهما يظهر من الاختصاص الذي خص به موسى في قوله تعالى: { واصطنعتك لنفسي }، [11] فاقتضى هذا الاختصاص الاختصاص الآخر في قوله: { ولتصنع على عيني } [12] فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص.
وأما قول تعالى: { تجري بأعيننًا }، { واصنع الفلك بأعيننا }، فليس فيه من الاختصاص ما في صنع موسى على عينه سبحانه واصطناعه إياه لنفسه، وما يسنده سبحانه إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع قد يريد به ملائكته كقوله تعالى: { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه }، [13] وقوله: { نحن نقص عليك }، [14] ونظائره فتأمله.
قال: وأما النفس فعلى أصل موضوعها، إنما هي عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد، وقد استعمل أيضا من لفظها النفاسة والشيء النفيس، فصلحت للتعبيرعنه سبحانه وتعالى بخلاف ما تقدم من الألفاظ المجازية. وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس، ولا سيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة. ويقولون: ذات الباري هي نفسه، ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله ﷺ: «في قصة إبراهيم ثلاث كذبات كلهن في ذات الله»، وقول خبيب: * وذلك في ذات الإله.. *
قال: وليست هذه اللفظة إذا ستقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا. ولو كان كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله واحذر ذات الله كما قال تعالى: { ويحذركم الله نفسه }، [15] وذلك غير مسموع ولا يقال إلا بحرف ( في ) الجارة وحرف ( في ) للوعاء وهو معنى مستحيل على نفس الباري تعالى. إذا قلت: جاهدت في الله تعالى وأحببتك في الله تعالى محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، وإنما هو على حذف المضاف أي في مرضاة الله وطاعته فيكون الحرف على بابه. كأنك قلت: هذا محسوب في الأعمال التي فيها مرضاة الله وطاعته. وإما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال.
وإذا ثبت هذا فقوله: في ذات الله، أو في ذات الإله، إما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله فذات وصف للديانة، وكذلك هي في الأصل موضوعها نعت لمؤنث. ألا ترى أن فيها تاء التأنيث، وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله تعالى عز وجل لا عن نفسه سبحانه. وهذا هو المفهوم من كلام العرب. ألا ترى إلى قول النابعة: * بجلتهم ذات الإله ودينهم * فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه.
وهذا من كلامه من المرقِّصات، فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب. فذات صاحبة كذا في الأصل، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه. فكأنه يقول: صاحبة هذه الصفات والنعوت. ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن هان وغيره على الأصوليين قولهم "الذات" وقالوا: لا مدخل للألف واللام هنا، كما لا يقال: "الذو" في ذو. وهذا إنكار صحيح، والاعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها، ومن هنا غلطهم السهيلي فإن هذا الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول: رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه ومن جهته، وهذا كجنب الشيء. إذا قالوا هذا في جنب الله، لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته - لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله: «ثلاث كذبات في ذات الله»، وقوله: * وذلك في ذات الإله * فغلط واستحق التغليط، بل الذات هنا كالجنب في قوله تعالى: { يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله }، [16] ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال ههنا: فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال: فرط في ذات الله، كما يقال: فعل كذا في ذات الله، وقتل في ذات الله، وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر، والله الموفق المعين.
فائدة: إبدال النكرة من المعرفة
ما الفائدة في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بها، فإن كانت الفائدة في النكرة فلم ذكرت المعرفة، وإن كانت في المعرفة فما بال ذكر النكرة.
قيل: هذا فيه نكتة بديعة. وهي أن الحكم قد يعلق بالنكرة السابقة فتذكر. ويكون الكلام في معرض أمر معين من الجنس مدحًا، أو ذمًا، فلو اقتصر على ذكر المعرفة لاختص الحكم به، ولو ذكرت النكرة وحدها لخرج الكلام عن التعرض لذلك المعين. فلما أريد الجنس أتى بالنكرة ووصفت إشعارًا بتعليق الحكم بالوصف. ولما أتى بالمعرفة كان تنبيهًا على دخول ذلك المعين قطعًا. ومثال ذلك قوله تعالى: { لنسفعا بالناصية * ناصية كاذبة خاطئة }، [17] فإن الآية كما قيل: نزلت في أبي جهل، ثم تعلق حكمها بكل من اتصف به فقال: { لنسفعا بالناصية } تعيينًا { ناصية كاذبة } لعدمه وتنبيهًا، ولذلك اشترط في النكرة في هذا الباب أن تكون منعوتة لتحصل الفائدة المذكورة وليتبين المراد.
وأما قوله تعالى: { ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا }، [18] ففيها قولان:
أحدهما: أن شيئًا بدل من رزقه ورزقًا أبين من شيئًا، لأنه أخص منه، والأخص أبين من الأعم، وجاز هذا من أجل تقدم النفي، لأن النكرة إنما تفيد بالإخبار عنها بعد النفي، فلما اقتضى النفي العام ذكر الاسم العام الذي هو أنكر النكرات ووقعت الفائدة به من أجل النفي صلح أن يكون بدلًا من رزق. ألا ترى أنك لو طرحت الاسم الأول واقتصرت على الثاني لم يكن إخلالًا بالكلام.
والقول الثاني: أن شيئًا هنا مفعول المصدر الذي هو الرزق وتقديره لا يملكون أن يرزقوا شيئًا وهذا قول الأكثرين إلا أنه يرد عليهم. أن الرزق هنا اسم لا مصدر، لأنه بوزن الذبح والطحن للمذبوح والمطحون. ولو أريد المصدر لجاء بالفتح نحو قول الشاعر: يخاطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعفا عنه:
واقصد إلى الخير ولا توقه ** وارزق عيال المسلمين رزقه
وقد يجاب عن هذا بأن الرزق من المصادر التي جاءت على فعل بكسر أوائلها كالفسق، ويطلق على المصدر والاسم بلفظ واحد، كالنسخ للمصدر والمنسوخ وبابه وهذا أحسن. والبيت لا نسلم أن راءه مفتوحة، وإنما هي مكسورة. وهذا اللائق بحال عمر بن عبد العزيز والشاعر فإنه طلب منه أن يرزق عيال المسلمين رزق الله الذي هو المال المرزوق لا أنه يرزقهم كرزق الله الذي هو المصدر، هذا مما لا يخاطب به أحد، ولا يقصده عاقل والله أعلم.
فائدة بديعة: تفسير اهدنا الصراط المستقيم
قوله تعالى: { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم } فيها عشرون مسألة.
أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء، والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيان والبدل القصد به بيان الاسم الأول.
الثانية: ما فائدة تعريف { الصراط المستقيم }، باللام، وهلا أخبرعنه بمجرد اللفظ دونها كما قال: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }.
الثالثة: ما معنى الصراط ومن أي شيء اشتقاقه ولم جاء على وزن فعال ولم ذكر في أكثر المواضع في القران بهذا اللفظ. وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ الطريق فقال: { يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم }. [19]
الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: { الذين أنعمت عليهم } بهذا اللفظ ولم يذكرهم بخصوصهم فيقول صراط النبيين والصديقين فلم عدل إلى لفظ المبهم دون المفسر.
الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذي مع صلتها دون أن يقال المنعم عليهم وهو أخصر كما قال: { المغضوب عليهم }، وما الفرق.
السادسة: لم فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم. فقال في أهل النعمة، الذين أنعمت وفي أهل الغضب المغضوب بحذف الفاعل.
السابعة لم قال: { اهدنا الصراط المستقيم }، فعدى الفعل بنفسه، ولم يعده بإلى كما قال تعالى: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }، [20] وقال تعالى: { واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم } [21]
الثامنة: أن قوله تعالى: { الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم } يقتضي أن نعمته مختصة بالأولين دون المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا حجة لمن ذهب إلى أنه لا نعمة له على كافر. فهل هذا استدلال صحيح أم لا.
التاسعة: أن يقال لم وصفهم بلفظ غير وهلا قال تعالى: لا المغضوب عليهم كما قال والضالين. وهذا كما تقول: مررت بزيد لا عمرو وبالعاقل لا الأحمق.
العاشرة: كيف جرت غير صفة على الموصول وهي لا تتعرف بالإضافة، وليس المحل محل عطف بيان إذ بابه الإعلام ولا محل لذلك. إذ المقصود في باب البدل هو الثاني والأول توطئة وفي باب الصفات المقصود الأول. والثاني بيان وهذا شأن هذا الموضع. فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم معنى الغضب والضلال.
الحادية عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل، فالصراط المستقيم مقصود الإخبار عنه بذلك، وليس في نية الطرح، فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلًا منه؟ وما فائدة البدل هنا.
الثانية عشرة: إنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو حاتم تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود، والنصارى بأنهم الضالون، فما وجه هذا التقسيم والاختصاص؟ وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليه.
الثالثة عشرة: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالين؟
الرابعة عشرة: لم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعل؟ ولم يأت في أهل الضلال بذلك. فيقال المضلين. بل أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من فعل.
الخامسة عشرة: ما فائدة العطف بلا هنا. ولو قيل المغضوب عليهم والضالين لم يختل الكلام وكان أوجز.
السادسة عشرة: إذ قد عطف بها فيأتي العطف بها مع الواو للمنفي. نحو ما قام زيد ولا عمرو وكقوله تعالى: { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } إلى قوله تعالى: { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم }، [22] وأما بدون الواو فبابها الإيجاب. نحو مررت بزيد لا عمرو. فهذه ستة عشرة مسألة في ذلك.
السابعة عشرة: هل الهداية هنا هداية التعريف والبيان، أو هداية التوفيق والإلهام.
الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرًا لازمًا لا يقوم غيره مقامه، ولا بد منه. وهذا إنما نسأله في الصلاة بعد هدايته. فما وجه السؤال لأمر حاصل؟ وكيف يطلب تحصيل الحاصل؟
التاسعة عشرة: ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في اهدنا؟ والداعي يسأل ربه لنفسه في الصلاة وخارجها ولا يليق به ضمير الجمع ولهذا يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي.
العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد وقت سؤاله؟ فهذه أربع مسائل حقها أن تقدم أولًا، ولكن جر الكلام إليها بعد ترتيب المسائل الستة عشر.
فالجواب بعون الله وتعليمه فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه، ولا قوة له إلا بإعانته.
أما المسألة الأولى وهي فائدة البدل من الدعاء، أن االآية وردت في معرض التعليم للعباد والدعاء وحق الداعي أن يستشعر عند دعائها ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به. إذ الدعاء مخ العبادة والمخ لا يكون إلا في عظم، والعظم لا يكون إلا في لحم ودم. فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء وجب أن يكون الطلب ممزوجًا بالثناء. فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها مثوبًا بالخير تصريحًا من الداعي بمعتقده وتوسلًا منه بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربه. فكأنه متوسل! ليه بإيمانه واعتقاده. إن صراط الحق هو الصراط المستقيم وإنه صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضا، والداعي يجب عليهم اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه. فلذلك أبدل وبين لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجنان. ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين إحداهما فائدة الخبر، والثانية فائدة لازم الخبر.
فأما فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالاستقامة وإنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته. وأما فائدة لازم الخبر فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه، فهذه أربع فوائد الدعاء بالهداية إليه. والخبر عنه بذلك. والإقرار والتصديق لشأنه. والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق. وفيه فائدة خامسة وهي أن الداعي، إنما أمر بذلك لحاجته إليه وإن سعادته وفلاحه لا تتم إلا به فهو مأمور بتدبر ما يطلب وتصور معناه. فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في خلده وقام بقلبه كان أشد طلبًا له وأعظم رغبة فيه، وأحرص على دوام الطلب والسؤال له، فتأمل هذه النكت البديعة.
فصل: تعريف الصراط باللام
وأما المسألة الثانية وهي تعريف الصراط باللام هنا. فاعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره. ألا ترى أن قولك جالس فقيهًا، أو عالمًا، ليس كقولك جالس الفقيه أو العالم. ولا قولك أكلت طيبًا كقولك الطيب. ألا ترى إلى قوله ﷺ: «أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق»، ثم قال: «ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق»، فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه.
فإذا عرفت هذا، فلو قال: اهدنا صراطًا مستقيمًا لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق. وليس المراد ذلك بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته، وهو دينه الذي لا دين له سواه. فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن لا شيء مطلق منكر واللام هنا للعهد العلمي الذهني وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهود قد قام في القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال فلم يكن بد من التعريف.
فإن قيل: لم جاء منكرًا في قوله لنبيه ﷺ: { ويهديك صراطا مستقيمًا }، [23] وقوله تعالى: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }، [24] وقوله تعالى: { واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم }، [25] وقوله تعالى: { قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم }. [26]
فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو أنها ليست في مقام الدعاء والطلب، وإنما هي في مقام الإخبار من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم وهداية رسوله إليه. ولم يكن للمخاطبين عهد به، ولم يكن معروفًا لهم فلم يجىء معرفًا بلام العهد المشيرة إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في خلده، ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام معروفة إليه، وإنما تأتي لام العهد ني أحد هذين الموضعين أعني أن يكون لها معهود ذهني أو ذكري لفظي. وإذ لا واحد منهما في هذه المواضع. فالتنكير هو الأصل وهذا بخلاف قوله: { اهدنا الصراط المستقيم }، فإنه لما تقررعندالمخاطبين. إن لله صراطًا مستقيمًا هدى إليه أنبياءه ورسله. وكان المخاطب سبحانه المسؤول من هدايته عالمًا به دخلت اللام عليه فقال: { اهدنا الصراط المستقيم }.
وقال أبو القاسم السهيلي: إن قوله تعالى: { ويهديك صراطًا مستقيمًا } نزلت في صلح الحديبية وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خلافه. وكان الله تعالى عما يقولون ورسوله ﷺ أعلم فأنزل على رسوله ﷺ هذه الآية. فلم يرد صراطًا مستقيمًا في الدين، وإنما أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة. وقوله تبارك وتعالى: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }، [27] أي تهدي من الكفر والضلال إلى صراط مستقيم. ولو قال في هذا الموطن إلى الصراط المستقيم لجعل للكفر وللضلال حظًا من الاستقامة إذ الألف واللام تنبىء أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصلة أحق بذلك المعنى مما تلاه في الذكر، أو ما قرب به في الوهم، ولا يكون أحق به إلا والآخر فيه طرف منه.
وغير خاف ما في هذين الجوابين من الضعف والوهن، أما قوله إن المراد بقوله: ويهديك صراطًا مستقيمًا في الحرب والمكيدة. فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله وأخبر النبي ﷺ أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها ومتى سمى الله الحرب والمكيدة صراطًا مستقيمًا، وهل فسر هذه الآية أحد من السلف أو الخلف بذلك؟ بل الصراط المستقيم ما جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر بأن الله تعالى هداه إليه في قوله: { قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم } ثم فسره بقوله تعالى: { دينًا قيمًا ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين } ونصب دينًا هنا على البدل من الجار والمجرور. أي هداني دينًا قيمًا. أفتراه يمكنه ههنا أن يقول: إنه الحرب والمكيدة؟ فهذا جواب فاسد جدًا.
وتأمل ما جمع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من أنواع العطايا وذلك خمسة أشياء أحدها الفتح المبين. والثاني مغفرة ماتقدم من ذنبه وما تأخر. والثالث هدايته الصراط المستقيم. والرابع إتمام نعمته عليه. والخامس إعطاء النصر العزيز وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر، لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح. فإن الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته. فهو العلم النافع والعمل الصالح والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه. فالحجة والبيان والسيف والسنان فهو النصر بالحجة واليد، وقهر قلوب المخالفين له بالحجة، وقهر أبدانهم باليد.
وهو سبحانه كثيرًا ما يجمع بين هذين الأصلين إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله كقوله تعالى: { هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله } [28] في موضعين في سورة براءة وفي سورة الصف. وقال تعالى: { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط }، فهذا الهدى ثم قال: { وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد }، [29] فهذا النصر فذكر الكتاب الهادي والحديد الناصر. وقال تعالى: { الم * الله لا إله إلا هو الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان }، [30] فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل.
وسر اقتران النصر بالهدى. إن كلًا منهما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل. ولهذا سمي تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانًا. كما قال تعالى: { إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان }، [31] فذكر الأصلين ما أنزله على رسوله يوم الفرقان وهو يوم بدر. وهو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم ومن هذا قوله تعالى: { ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين }، [32] فالفرقان نصرة له على فرعون وقومه والضياء والذكر والتوراة هذا هو معنى الآية. ولم يصب من قال: إن الواو زائدة، وإن ضياء منصوب على الحال كما بينا فساده في الأمالي المكية. فبين أن آية الفتح تضمنت الأصلين الهدى والنصر، وإنه لا يصح فيها غير ذلك البتة.
وأما جوابه الثاني عن قوله: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بأنه لوعرف لجعل للكفر والضلال حظًا من الاستقامة. فما أدري من أين جاء له هذا الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع رحمه الله تعالى؟ وما هي إلا كبوة جواد ونبوة صارم افترى قوله تعالى: { وآتيناهما الكتاب المستبين }، [33] { وهديناهما الصراط المستقيم } [34] يفهم منه أن لغيره حظًا من الاستقامة، وما ثم غيره إلا طرق الضلال. وإنما الصراط المستقيم واحد وهو ما هدى الله إليه أنبيائه ورسله أجمعين وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وكذلك تعريفه في سورة الفاتحة هل يقال: إنه يفهم منه إن لغيره حظًا من الاستقامة. بل يقال تعريفه ينبىء أن لا يكون لغيره حظ من الاستقامة. فإن التعريف في قوة الحصر فكانه قيل الذي لا صراط مستقيم سواه، وفهم هذا الاختصاص من اللفظ أقوى من فهم المشاركة، فتأمله هنا وفي نظائره.
فصل: اشتقاق الصراط
وأما المسألة الثالثة وهي اشتقاق الصراط. فالمشهور أنه من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته بلعًا سهلًا فسمي الطريق صراطًا، لأنه يشترط المارة فيه. والصراط ما جمع خمسة أوصاف أن يكون طريقًا مستقيمًا سهلًا مسلوكًا واسعًا موصلًا إلى المقصود. فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطًا، ولا الصعب المشق، ولا المسدود غير الموصل. ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم تبين له ذلك. قال جرير:
أمير المؤمنين على صراط ** إذا اعوج الموارد مستقيم
وبنوا الصراط على زنة فعال لأنه مشتمل على سالكه اشتمال الحلق على الشيء المشروط وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء، كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش والكتاب إلى سائر الباب يأتي لثلاثة معان. أحدها: المصدر كالقتال والضراب، والثاني المفعول نحو الكتاب والبناء والغرا س، والثالث إنه يقصد به قصد الآلة التي يحصل بها الفعل ويقع بها كالخمار والغطاء والسداد لما يخمر به ويغطي ويسد به، فهذا الة محضة والمفعول هو الشيء المخمر والمغطى والمسدود. ومن هذا القسم الثالث إله بمعنى مألوه.
وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة، فهذا حكاية الله تعالى لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: { إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم }، [35] وتعبيرهم عنه ههنا بالطريق فيه نكتة بديعة، وهي أنهم قدموا قبله ذكر موسى وإن الكتاب الذي سمعوه مصدقًا لما بين بديه من كتاب موسى وغيره، فكان فيه كالنبأ عن رسول الله ﷺ في قوله لقومه: { ما كنت بدعًا من الرسل } [36] أي لم أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرض بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم، وإنما بعثت مصدقًا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان فقال مؤمنو الجن: { إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم }. [37] أي إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله، وإنه ليس ببدع كما قال في أول السورة نفسها فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق، لأنه فعيل بمعنى مفعول أي مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبل. فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن يؤمن به ويصدقه. فذكر الطريق ههنا إذًا أولى، لأنه أدخل في باب الدعوة. والتنبيه على تعين أتباعه والله أعلم. ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره السهيلي فوافق فيه الخاطر الخاطر.
فصل: إضافة الصراط إلى الموصول المبهم
وأما المسألة الرابعة وهي إضافته إلى الموصول المبهم دون أن يقول: صراط النبيين والمرسلين ففيه ثلاث فوائد:
إحداها: إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذا، فإن استحقاق كونهم من المنعم عليهم هو بهدايتهم إلى الصراط فيه صاروا من أهل النعمة وهذا كما يعلق الحكم بالصلة دون الاسم الجامد لما فيه من الإنعام باستحقاق ما علق عليها من الحكم بها. وهذا كقوله تعالى: { الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم }، [38] { والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون }، [39] { إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم }، [40] وهذا الباب مطرد فالإتيان بالاسم موصولًا على هذا المعنى من ذكر الاسم الخاص.
الفائدة الثانية: فيه إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من هدى إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه. فالسائل مستشعر سؤال الهداية وطلب الإنعام من الله عليه. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل الهداية إليه. والثاني يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون منه.
الفائدة الثالثة: إن الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليهم، ولو أتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع المنعم عليهم. فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة. إن المسؤول الهدي إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا أجل مطلوب وأعظم مسؤول. ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه وقرنه بأنفاسه. فإنه لم يدع شيئًا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. ولما كان بهذه المثابة فرضه الله على جميع، عباده فرضا متكررًا في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه، ومن ثم يعلم تعين الفاتحة في، الصلاة وإنها ليس منها عوض يقوم مقامها.
فصل: قال أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم
وأما المسألة الخامسة وهي أنه قال: { الذين أنعمت عليهم } ولم يقل المنعم عليهم. كما قال: { المغضوب عليهم } فجوابها وجواب المسألة السادسة واحد وفيه فوائد عديدة.
أحدها: إن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القران. وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فيذكر فاعلها منسوبة إليه، ولا يبني الفعل معها للمفعول، فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة. حذف الفاعل وبنى الفعل معها للمفعول أدبًا في الخطاب، وإضافته إلى الله أشرف فسمى أفعاله، فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه، ولم يحذف فاعلها. ولما ذكر الغضب حذف الفاعل، وبنى الفعل للمفعول. فقال: المغضوب عليهم وقال في الإحسان: الذين أنعمت عليهم. ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: { الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين } [41] فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام. والسقي إلى الله تعالى. ولما جاء إلى ذكر المرض قال: وإذا مرضت. ولم يقل أمرضني. وقال: فهو يشفين ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: { وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا }، [42] فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول. ومنه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة فأردت أن أعيبها. فأضاف العيب إلى نفسه. وقال في الغلامين: { فأراد ربك أن يبلغا أشدهما }، [43] ومنه قوله تعالى: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }، [44] فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال: { وأحل الله البيع وحرم الربا }، [45] لأن في ذكر الرفث ما يحسن منه أن لا يقترن بالتصريح بالفاعل ومنه: { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير }، [46] وقوله: { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا } [47] إلى آخرها. ومنه وهو ألطف من هذا وأدق معنى قوله: { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم } [48] إلى آخرها، ثم قال: { وأحل لكم ما وراء ذلكم }، [49] وتأمل قوله: { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع. وقال في حق المؤمنين: { حرمت عليكم الميتة والدم }. [50]
الفائدة الثانية: أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بها وأصل الشكر ذكر النعم والعمل بطاعته. وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر وكان في قوله: { أنعمت عليهم } من ذكر وإضافته النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله. فضمن هذا اللفظ الأصلين وهما الشكر والذكر المذكوران في قوله: { فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون }. [51]
الفائدة الثالثة: أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده وهو المنعم بالهداية دون أن يشركه أحد في نعمته، فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد فيقال: أنعمت عليهم أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة، وأما الغضب فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم، وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة لغضب ربهم عليهم فموافقته تعالى تقتضي أن يغضب على من غضب عليه ويرضى عمن رضي عنه فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وهذا حقيقة العبودية واليهود قد غضب الله عليهم، فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم. فحذف فاعل الغضب وقال: المغضوب عليهم لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من غضب الله عليه بخلاف الإنعام فإنه لله وحده. فتأمل هذه النكتة البديعة.
الفائدة الرابعة: أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الإلتفات إليهم والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليها. وأما أهل النعمة فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشارة بذكرهم وإذا ثبت هذا فالألف واللام في المغضوب وإن كانتا بمعنى الذين. فليست مثل الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين ذات المسمى. فإن قولك الذين فعلوا معناه القوم الذين فعلوا وقولك الضاربون والمضروبون ليس فيه ما في قولك الذين ضربوا أو ضربوا فتأمل ذلك. فالذين أنعمت عليهم إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم بخلاف المغضوب عليهم. فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عنهم وعدم الإلتفات إليهم والمعول عليه من الأجوبة ما تقدم.
فصل: تعدية الفعل بنفسه
وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إلى، فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة، وبحرف إلى تارة وباللام تارة. والثلاثة في القرآن. فمن المعدى بنفسه هذه الآية. وقوله: { ويهديك صراطًا مستقيمًا }، [52] ومن المعدى بإلى قوله: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }، [53] وقوله تعالى: { قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم }، [54] ومن المعدى باللام قوله قول أهل الجنة: { الحمد لله الذي هدانا لهذا }، [55] وقوله تعالى: { إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم }. [56]
والفرق بين هذه المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماء، ولكن نذكر قاعدة تشير إلى الفرق، وهي أن الفعل المعدي بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف. فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو رغبت عنه ورغبت فيه، وعدلت إليه وعدلت عنه، وملت إليه وعنه وسعيت إليه وبه، وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق نحو قصدت إليه وقصدت له، وهديته إلى كذا وهديته لكذا، وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة، بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف، ومعنى مع غيره. فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال، فيشربون الفعل المتعدي به معناه، هذه طريقة أمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى، وطريقة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معنى الفعل لا يقيمون الحرف مقام الحرف. وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. وهذا نحو قوله تعالى: { عينًا يشرب بها عباد الله }، [57] فإنهم يضمنون بشرب معنى يروي فيعدونه بالباء التي تطلبها. فيكون في ذلك دليل على الفعلين أحدهما بالتصريح به، والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. ومنه قوله في السحاب: شربن بماء البحر حتى روين، ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن من أن يقال يشرب منها. فإنه لا دلالة فيه على الري وإن يقال: يروي بها لأنه لا يدل على الشرب بصريحه، بل باللزوم، فإذا قال: يشرب بها. دل على الشرب بصريحه وعلى الري بخلاف الباء فتأمله. ومن هذا قوله تعالى: { ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه }، [58] وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء، ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذا وهو أبلغ من الإرادة. فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة، وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه ويكفي المثالان المذكوران. فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. فإذا قلت: هديته لكذا. فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذا، وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى، الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. هو طالب من الله أن يعرفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه، فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه. فجرد الفعل من الحرف وأتى به مجردًا معدى بنفسه ليتضمن هذه المراتب كلها. ولو عدى بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف. فتأمله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها.
فصل: تخصيص أهل السعادة بالهداية
وأما المسألة الثامنة وهي أنه خص أهل السعادة بالهداية دون غيرهم. فهذه مسألة اختلف الناس فيها وطال الحجاج من الطرفين وهي أنه هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ فمن ناف محتج بهذه وبقوله: { ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا }، [59] فخص هؤلاء بالإنعام فدل على أن غيرهم غير منعم عليه، ولقوله لعباده المؤمنين: { ولأتم نعمتي عليكم } [60] وبأن الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة فأي نعمة على من خلق للعذاب الأبدي. ومن مثبت محتج بقوله: { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها }، [61] وقوله لليهود: { يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم }، [62] وهذا خطاب لهم في حال كفرهم وبقوله في سورة النحل التي عدد فيها نعمه المشتركة على عباده من أولها إلى قوله: { كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون * فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين * يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون }، [63] وهذا نص صريح لا يحتمل صرفًا. واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يعيش في نعمة الله وكل أحد مقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته. وهذا معلوم بالاضطرار عند جميع أصناف بني آدم إلا من كابر وجحد حق الله تعالى وكفر بنعمته.
وفصل الخطاب في المسألة أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم فيها سواهم. ومطلق النعمة عام للخليفة كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم. فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم، فهذه غير مشتركة ومطلق النعمة عام مشترك. فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصاب، وإن أراد سلب مطلق النعمة أخطأ. وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطأ. وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب، وبهذا تتفق الأدلة ويزول النزاع ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ وصواب، والله الموفق.
وأما قوله تعالى: { يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم }، [64] فإنما يذكرهم بنعمته على آبائهم ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة بأن أنجاهم من آل فرعون وإن فرق بهم البحر وإن وعد موسى أربعين ليلة. فضلوا بعده ثم تاب عليهم، وعفا عنهم، وبأن ظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم، وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته، والإيمان برسله، والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه وطاعته، وكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكرًا فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه؟ وهذا لا يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم والله أعلم.
فصل: قال غير المغضوب ولم يقل لا المغضوب عليهم
وأما المسألة التاسعة وهي أنه قال غير المغضوب، ولم يقل لا المغضوب عليهم. فيقال: لا ريب أن لا يعطف بها بعد الإيجاب، كما تقول: جاءني زيد لا عمرو وجاءني العالم لا الجاهل. وأما غير فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس إلا كما سيأتي. وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف وهذا إنما يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع والوصف. فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف، وقيل: صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم. لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم. كما هو مقتضي العطف. فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا الجاهل لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم. وأما الإتيان بلفظ غير فهي صفة لما قبلها فأفاد الكلام معها. وصفهم بشيئين أحدهما أنهم منعم عليهم. والثاني أنهم غير مغضوب عليهم. فأفاد ما يفيد العطف مع زيادة الثناء عليهم، ومدحهم فإنه يتضمن صفتين صفة ثبوتية وهي كونهم منعمًا عليهم وصفة سلبية وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغضب وإنهم مغايرون لأهله. ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المنعم عليهم، ولم تكن صفة منصوبة على الاستثناء لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود.
وفيه فائدة أخرى وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم هم المنعم عليهم دون أهل الإسلام. فكأنه قيل لهم: المنعم عليهم غيركم لا أنتم. وقيل للمسلمين المغضوب عليهم غيركم لا أنتم. فالإتيان بلفظة غير في هذا السياق أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة. فتأمله وتأمل كيف قال المغضوب عليهم ولا الضالين. ولم يقل: اليهود والنصارى مع أنهم هم الموصوفون بذلك تجريدًا لوصفهم بالغضب والضلال الذي به غايروا المنعم عليهم ولم يكونوا منهم بسبيل، لأن الإنعام المطلق ينافي الغضب والضلال فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال. فتبارك من أودع كلامه من الأسرار ما يشهد بأنه تنزيل من حكيم حميد.
فصل: جريان غير صفة على المعرفة
وأما المسألة العاشرة وهي جريان غير صفة على المعرفة. وهي لا تتعرف بالإضافة ففيه ثلاثة أجوبة:
أحدها: أن غير هنا بدل لا صفة وبدل النكرة من المعرفة جائز، وهذا فاسد من وجوه ثلاثة.
أحدها: أن باب البدل المقصود فيه الثاني والأول توطئة له ومهاد أمامه وهو المقصود بالذكر فقوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }، [65] المقصود هو أهل الاستطاعة خاصة وذكر الناس قبلهم توطئة، وقولك: أعجبني زيد علمه، إنما وقع الإعجاب على علمه وذكرت صاحبه توطئة لذكره وكذا قوله: { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه }، [66] المقصود إنما هو السؤال عن القتال في الشهر الحرام لا عن نفس الشهر. وهذا ظاهر جدًا في بدل البعض وبدل الاشتمال، ويراعى في بدل الكل من الكل. ولهذا سمي بدلًا إيذانًا بأنه المقصود فقوله: { لنسفعا بالناصية * ناصية كاذبة خاطئة }، [67] المقصود لنسفعن بالناصية الكاذبة الخاطئة وذكر المبدل منه توطئة لها، وإذا عرف هذا، فالمقصود هنا ذكر المنعم عليهم وإضافة الصراط إليهم ومن تمام هذا المقصود وتكميله الإخبار بمغايرتهم للمغضوب عليهم. فجاء ذكر غير المغضوب مكملًا لهذا المعنى ومتممًا، لأن أصحاب الصراط المسؤول هدايته هم أهل النعمة فكونهم غير مغضوب عليهم وصف محقق وفائدته فائدة الوصف المبين للموصوف المكمل له وهذا واضح.
الوجه الثاني: أن البدل يجري مجرى توكيد المبدل وتكريره وتثنيته ولهذا كان في تقدير تكرار العامل وهو المقصود بالذكر كما تقدم فهو الأول بعينه ذاتًا ووصفًا، وإنما ذكر بوصف آخر مقصود بالذكر كقوله: { اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم }، ولهذا يحسن الاقتصار عليه دون الأول ولا يكون مخلًا بالكلام، ألا ترى أنك لو قلت: في غير القرآن لله حج البيت على من استطاع إليه السبيل لكان كاملًا مستقيمًا لا خلل فيه. ولو قلت في دعائك: رب اهدني صراط من أنعمت عليه من عبادك لكان مستقيمًا. وإذا كان كذلك فلو قدر الاقتصار على غير، وما في حيزها لاختل الكلام وذهب معظم المقصود منه. إذ المقصود إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لا إضافته إلى غير المغضوب عليهم. بل أتى بلفظ غير زيادة في وصفهم والثناء عليه فتأمله.
الوجه الثالث: أن غير لا يعقل ورودها بدلًا، وإنما ترد استثناء أو صفة أو حالًا. وسر ذلك أنها لم توضع مستقلة بنفسها بل لا تكون إلا تابعة لغيرها ولهذا قلما يقال: جاءني غير زيد ومررت بغير عمرو. والبدل لا بد أن يكون مستقلًا بنفسه كما تبين أنه المقصود ونكتة الفرق أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إليه قد جعلت الأول سلمًا ومرقاة إليه. فهو موضع قصدك ومحط إرادتك وفي باب الصفة بخلاف ذلك، إنما أنت قاصد الموصوف موضح له بصفته. فاجعل هذه النكتة معيارًا على باب البدل والوصف، ثم زن بها غير المغضوب عليهم. هل يصح أن يكون بدلًا أو وصفًا؟
الجواب الثاني: أن غير ههنا صح جريانه صفة على المعرفة لأنها موصولة والموصول مبهم غير معين. ففيه رائحة من النكرة لإبهامه فإنه غير دال على معين فصلح وصفه بغير لقربه من النكرة وهذا جواب صاحب الكشاف قال: فإن قلت: كيف صح أن يقع غير صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وان أضيف إلى المعارف قلت: الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه فهو كقوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني ** فمضيت ثمت قلت لا يعنيني
ومعنى قوله: لا توقيت فيه، أي لا تعيين لواحد من واحد كما تعين المعرفة. بل هو مطلق في الجنس فجرى مجرى النكرة واستشهاده بالبيت. معناه أن الفعل نكرة وهو يسبني وقد أوقعه صفة للئيم المعرفة باللام لكونه غير معين فهو في قوة النكرة، فجاز أن ينعت بالنكرة وكأنه قال على لئيم: يسبني وهذا استدلال ضعيف فإن قوله يسبني حال منه لا وصف والعامل فيه فعل المرور المعنى أمر على اللئيم سابًا لي أي أمر عليه في هذه الحال فأتجاوزه ولا أحتفل بسبه.
الجواب الثالث: وهو الصحيح أن غير هنها قد تعرفت بالإضافة. فإن المانع لها من تعريفها شدة إبهامها أو عمومها في كل مغاير للمذكور فلا يحصل بها تعيين. ولهذا تجري صفة على النكرة فتقول: رجل غيرك يقول كذا، ويفعل كذا، فتجرى صفة للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة. ومعلوم أن هذا الإبهام يزول لوقوعها بين متضادين يذكر أحدهما، ثم تضيفها إلى الثاني. فيتعين بالإضافة ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال:
نحن بنو عمرو الهجان الأزهر ** النسب المعروف غير المنكر
أفلا تراه أجرى غير المنكر صفة على النسب، كما أجرى عليه المعروف صفتان معينتان فلا إبهام في غير لأن مقابلها المعروف وهو معرفة وضده المنكر متميز متعين، كتعين المعروف أعني تعين الجنس.
وهكذا قوله: { صراط الذين أنعمت عليهم }، فالمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم. فإذا كان الأول معرفة كانت غير معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير مبهم. فاكتسبت منه التعريف.
وينبغي أن تتفطن هنها لنكتة لطيفة في غير تكشف لك حقيقة أمرها. فأين تكون معرفة وأين تكون نكرة؟ وهي أن "غيرًا" هي نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه. فإن المعروف هو تفسير غير المنكر والمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم هذا حقيقة اللفظة. فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة، وإن أضيفت. كما إذا قلت: رجل غيرك فعل كذا وكذا، وإذا كان متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة، كما إذا قيل المحسن غير المسيء محبوب معظم عند الناس والبر غير الفاجر مهيب والعادل غير الظالم مجاب الدعوة. فهذا لا تكون فيه غير إلا معرفة، ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط وقال: ما لا دليل عليه إذ لا إبهام فيها بحال فتأمله.
فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر. وهي أنها بمعنى مغاير اسم فاعل عن غاير كمثل بمعنى مماثل وشبه بمعنى مشابه وأسماء الفاعلين لا تعرف بالإضافة، وكذا ما ناب عنها.
قلت: اسم الفاعل، إنما لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله، لأن الإضافة في تقدير الانفصال نحو هذا ضارب زيد غدًا. وليست غير بعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال الإضافة في تقدير الانفصال، بل إضافتها إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات. ألا ترى أن قولك غيرك بمنزلة قولك سواك ولا فرق بينهما والله أعلم.
فصل: إخراج صراط مخرج البدل
وأما المسألة الحادية عشرة: وهي ما فائدة إخراج الكلام في قوله: { اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم }، مخرج البدل مع أن الأول في نية الطرح.
فالجواب أن قولهم الأول في البدل في نية الطرح كلام لا يصح أن يؤخذ على إطلاقه. بل البدل نوعان: نوع يكون الأول فيه في نية الطرح وهو بدل، البعض من الكل، وبدل الاشتمال لأن المقصود هو الثاني لا الأول، وقد تقدم، ونوع لا ينوي فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل، بل يكون الثاني بمنزلة التذكير واالتوكيد وتقوية النسبة مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة المتجددة الزائدة على الأول. فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف المبدل للمبدل منه إنه لما قال: { اهدنا الصراط المستقيم }، فكأن الذهن طلب معرفة ما إذا كان الصراط مختص بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله. فقال: { صراط الذين أنعمت عليهم } وهذا كما إذا دللت رجلًا على طريق لا يعرفها، وأردت توكيد الدلالة وتحريضه على لزومها وأن لا يفارقها. فأنت تقول: هذه الطريق الموصلة إلى مقصودك، ثم تزيد ذلك عنده توكيدًا وتقوية، فتقول: وهي الطريق التي سلكها الناس والمسافرون وأهل النجاة. أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين الناجين قدرًا زائدًا على وصفك لها بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة مستقيمة. فإن النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة. فإذا ذكر لها من تتأسى به في سلوكها أنست واقتحمتها فتأمله.
فصل: تفسير المغضوب عليهم والضالين
وأما المسألة الثانية عشرة: وهي ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب والضلال.
فالجواب أن يقال هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة الأخرى، فإن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه، لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بها، وأن ذلك هو الوصف الغالب عليهما وهذا مطابق، لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن والنصارى بالضلال. فهو تفسير للآية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع.
أما اليهود فقال تعالى في حقهم: { بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين }، [68] وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال.
أحدها: أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول الله ﷺ والبغي عليه ومحاربته. فاستحقوا بكفرهم غضبًا، وبالبغي والحرب والصد عنه غضبًا آخر. ونظيره قوله تعالى: { الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب } [69] فالعذاب الأول بكفرهم، والعذاب الذي زادهم إياه بصدهم الناس عن سبيله.
القول الثاني أن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياء، والغضب الثاني بكفرهم بالمسيح.
والقول الثالث أن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح والغضب الثاني بمحمد ﷺ.
والصحيح في الآية أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع الواحد، بل المراد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء وكفرهم بالمسيح وبمحمد ﷺ، ومعاداتهم لرسل الله، إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبًا على حدته. وهذا كما في قوله: { فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين }، [70] أي كرة بعد كرة لا مرتين فقط.
وقصد التعدد في قوله: { فباءوا بغضب على غضب }، [71] أظهر ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضبًا، وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبًا آخر وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا آخر، وتكذيبهم المسيح وطلبهم قتله ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضبًا، وتكذيبهم النبي ﷺ يستدعي غضبًا، ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضبًا، وصدهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبًا. فهم الأمة الغضبية أعاذنا الله من غضبه فهي الأمة التي باءت بالغضب المضاعف المتكرر وكانوا أحق بهذا الاسم والوصف من النصارى. وقال تعالى في شأنهم: { قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت }، [72] فهذا غضب مشفوع باللعنة والمسخ وهو أشد ما يكون من الغضب. وقال تعالى: { لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون * ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون }. [73]
وأما وصف النصارى بالضلال ففي قوله تعالى: { قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل }، [74] فهذا خطاب للنصارى، لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: { لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم } وقال المسيح: { يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم } [75] إلى قوله: { وضلوا عن سواء السبيل }، فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولًا، ثم أضلوا كثيرًا وهم أتباعهم. فهذا قبل مبعث النبي في ﷺ حيث ضلوا في أمر المسيح وأضلوا أتباعهم، فلما بعث النبي ﷺ ازدادوا ضلالًا آخر بتكذيبهم له وكفرهم به فتضاعف الضلال في حقهم. هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغيره، وهو ضعيف. فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع فوصفهم بثلاث صفات. أحدها أنهم قد ضلوا من قبلهم. والثاني أنهم أضلوا أتباعهم، والثالث أنهم ضلوا عن سواء السبيل فهذه صفات لأسلافهم الذين نهى هؤلاء عن اتباع أهوائهم فلا يصح أن يكون وصفًا للموجودين في زمن النبي ﷺ، لأنهم هم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنهم. فتأمله.
وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالًا بعد ضلال لفرط جهلهم بالحق. وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق اليهود ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود، ووجه تكرار هذا الضلال. إن الضلال قد أخطأ نفس مقصوده فيكون ضالًا فيه فيقصد ما لا ينبغي أن يقصده، ويعبد من لا ينبغي أن يعبده وقد يصيب مقصودًا حقًا، لكن يضل في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليه، فالأول ضلال في الغاية. والثاني ضلال في الوسيلة، ثم إذا دعى غيره إلى ذلك فقد أضله.
وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة:
فضلوا عن مقصودهم، حيث لم يصيبوه وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي وأنه قتل وصلب وصفع؛ فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به.
وضلوا عن السبيل الموصلة إليه، فلا اهتدوا إلى المطلوب، ولا إلى الطريق الموصل إليه.
ودعوا أتباعهم إلى ذلك، فضلوا عن الحق وعن طريقه، وأضلوا كثيرًا، فكانوا أدخل في الضلال من اليهود. فوصفوا بأخص الوصفين.
والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان لهم على قومهم من السحت والرياسة، فخافوا أن يذهب بالإسلام فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق. فإنهم كانوا يعرفون أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار السحت والبغي وقتل الأنبياء؛ ووبخ النصارى بالضلال، والجهل الذي هو عدم العلم بالحق. فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة، ومن عدم إرادته والعمل بها أخرى يتركب منها، فكفر اليهود ينشأ من عدم إرادة الحق والعمل به، وإيثار غيره عليه بعد معرفته، فلم يكن ضلالًا محضًا. وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه، فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين.
ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على غيره، وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق. والبغي يمنعه من إرادته كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم تعريفًا وبيانًا وإرشادًا وإلهامًا وتوفيقًا وإعانة، فيعلمه ويعرفه، ثم يجعله مريدًا له قاصدًا لأتباعه، فيخرج بذلك عن طريق المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلم، والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال.
وكان السلف يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا كما قالوا: فإن من فسد من العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف، الكلم عن مواضعه، وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه، وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكفر واللي والكتمان والتحريف والتحيل على المحارم، وتلبيس الحق بالباطل. فهذا شبهه باليهود ظاهر. وأما من فسد من العباد فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به رسوله ﷺ وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد فشبهه بالنصارى ظاهر.
فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه، ولا أوجب منه عليه. وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس، لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنه قريب مجيب.
فصل: تقديم المغضوب عليهم على الضالين
وأما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم المغضوب عليهم على الضالين فلوجوه عديدة:
أحدها: أنهم متقدمون عليهم بالزمان.
الثاني: أنهم كانوا هم الذين يلون النبي ﷺ من أهل الكتابين فإنهم كانوا جيرانه في المدينة، والنصارى كانت ديارهم نائية عنه. ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النصارى، كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرهما من السور.
الثالث: أن اليهود أغلظ من النصارى ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة والعقوبة. فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم. فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أحق وأهم بالتقديم، وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند.
الرابع: وهو أحسنها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم، والغضب ضد الإنعام والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليه فيه من الإزدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين. فقولك: الناس منعم عليه ومغضوب عليه فكن من المنعم عليهم أحسن من قولك منعم عليه وضال.
فصل: اسم المفعول في المغضوب واسم الفاعل في الضال
وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول وفي الضالين باسم الفاعل فجوابهما ظاهر، فإن أهل الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم، وأما أهل الضلال. فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه. ولهذا استحقوا العقوبة عليه، ولا يليق أن يقال ولا المضلين مبنيًا للمفعول لما في رائحته من إقامة عذرهم، وإنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم. بل فعل فيهم، ولا حجة في هذا للقدرية. فإنا نقول: إنهم هم الذين ضلوا وإن كان الله أضلهم بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلًا إلا على جهة المجاز لا الحقيقة فتضمنت الآية الرد عليهم، كما تضمن قوله: اهدنا الصراط المستقيم الرد على القدرية. ففي الآية إبطال قول الطائفتين والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون وهم المثبتون للقدر توحيدًا وخلقًا والقدرة لإضافة أفعال العباد إليهم عملًا وكسبًا وهو متعلق الأمر والعمل، كما أن الأول متعلق الخلق والقدرة. فاقتضت الآية إثبات الشرع والقدر والمعاد والنبوة فإن النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه، فالمنعم عليهم رسله واتباعهم ليس إلا وهدى اتباعهم، إنما يكون على أيديهم. فاقتضت إثبات النبوة بأقرب طريق وأبينها وأدلها على عموم الحاجة وشدة الضرورة إليها، وإنه لا سبيل للعبد أن يكون من المنعم عليهم إلا بهداية الله له، ولا تنال هذه الهداية إلا على أيدي الرسل، وإن هذه الهداية لها ثمرة وهي النعمة التامة المطلقة في دار النعيم، ولخلافها ثمرة وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبدي، فتأمل كيف اشتملت هذه الآية مع وجازتها واختصارها على أهم مطالب الدين وأجلها. والله الهادي إلى سواء السبيل وهو أعلم.
فصل: زيادة لا بين المعطوف والمعطوف عليه
وأما المسألة الخامسة عشرة: وهي ما فائدة زيادة لا بين المعطوف والمعطوف عليه ففي ذلك أربع فوائد:
أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه غير فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف عليها بلا مع الواو، فهو في قوة لا المغضوب عليهم ولا الضالين، أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفائدة الثانية: إن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده، فلو لم يذكر لا وقيل: غير المغضوب عليهم والضالين. أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين لا ما غاير كل نوع بمفرده. فإذا قيل: ولا الضالين كان صريحًا أو أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمر فإنما نفيت القيام عنهما، ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده.
الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم وإنهما صنف واحد وصفوا بالغضب والضلال ودخل العطف بينهما، كما يدخل في عطف الصفات بعضها على بعض نحو قوله تعالى: { قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون }، [76] إلى آخرها فإن هذه صفات للمؤمنين. ومثل قوله: { سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى }، [77] ونظائره فلما دخلت لا علم أنهما صنفان متغايران مقصودان بالذكر وكانت لا أولى بهذا المعنى من غير لوجوه. أحدها: أنها أقل حروفًا. الثاني: التفادي من تكرار اللفظ. الثالث: الثقل الحاصل بالنطق بغير مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة، ولا ريب أنه ثقيل على اللسان الرافع أن لا، إنما يعطف بها بعد النفي، فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم كما نفى عنهم الضلال وغيره. وإن أفهمت هذا فلا أدخل في النفي منها، وقد عرف بهذا جواب المسألة السادسة عشرة وهي أن لا إنما يعطف بها في النفي.
فصل: معنى الهداية
وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ فاعلم أن أنواع الهداية أربعة:
أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: { الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى }، [78] أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال وهذب هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به. كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك كل عضو له هداية تليق به. فهدى الرجلين للمشي واليدين للبطش والعمل واللسان للكلام والأذن للاستماع والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين.
وهدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومن الأبنية، ثم تسلك سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليها، ثم تأوي إلى بيوتها وهداها إلى طاعة يعسوبها وأتباعه والائتمام به أين توجه بها، ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البناء.
ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة، وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة، فإن من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة، بل هداها إلى هذه التي تعجز عقول العقلاء عنها كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه مهملًا، وسدى معطلًا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته. بل يتركه معطلًا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه، وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته له. مما لا يليق بجلاله. ولهذا أنكر ذلك على من زعمه، ونزه نفسه عنه، وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه، وأنه يتعالى عنه فقال تعالى: { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق }، [79] فنزه نفسه عن هذا الحسبان فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل، وإنه مما تظاهر عليه العقل والشرع. كما هو أصح الطريقين في ذلك ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى: { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون }، [80] بقوله: { وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون }، [81] وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة، وإن من لم يهمل أمر كل دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه. بل جعلها أممًا وهداها إلى غاياتها ومصالحها، كيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم. فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها.
النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر، وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينبغي الهدى معها كقوله تعالى: { وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى }، [82] أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }. [83]
النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للإهتداء. فلا يتخلف عنها وهي المذكورة في قوله: { يضل من يشاء ويهدي من يشاء }، [84] وفي قوله: { إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل }، [85] وفي قول النبي ﷺ: «من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له»، وفي قوله تعالى: { إنك لا تهدي من أحببت }، [86] فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }. [87]
النوع الرابع: غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما قال تعالى: { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم }، [88] وقال أهل الجنة فيها: { الحمد لله الذي هدانا }، [89] لهذا. وقال تعالى عن أهل النار: { احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون * من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم }. [90]
إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة في قوله الصراط المستقيم، إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام.
فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له، وكذلك الإلهام والتوفيق؟
قيل هذه هي المسألة الثامنة عشرة. وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبت ودوام الهداية. ولقد أجاب وما أجاب! وذكر فرعًا لا قوام له بدون أصله، وثمرة لا وجود لها بدون حاملها. ونحن نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به، وأعظم من ذلك بحول الله.
فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور وهو محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها:
الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبًا للرب تعالى مرضيًا له، فيؤثره، وكونه مغضوبًا له مسخوطًا عليه فيجتنبه، فإن نقص من هذا العلم والمعرفة شيء نقص من الهداية التامة بحسبه.
الأمر الثاني: أن يكون مريد الجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازمًا عليه ومريدًا لترك جميع ما نهى الله. عازمًا على تركه بعد خطوره بالبال مفصلًا، وعازمًا على تركه من حيث الجملة مجملًا. فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة.
الأمر الثالث: أن يكون قائمًا به فعلًا وتركًا. فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه بحسبه.
فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها:
أحدها: أمور هدي إليها جملة، ولم يهتد إلى تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل فيها.
الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها لتكمل له هدايتها.
الثالث: الأمور التي هدى إليها تفصيلًا من جميع وجوهها فهو محتاج إلى الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها.
فهذه ستة أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه ويتعلق بالماضي أمر سابع وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها، وتبديلها بغيرها، وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسأل الهداية وهي موجودة له، ثم يجاب عن ذلك، بأن المراد التثبييت والدوام عليها، إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له بالفعل فحينئذ يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام، فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده، ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعلية فيه، فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوام تعليمًا وتوفيقًا وخلقًا للإرادة فيه وإقدارًا له وخلقًا للفاعلية وتثبيتًا له على ذلك، فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها وتفصيلها علمًا وعملًا والتثبيت عليها والدوام إلى الممات.
وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلًا وتفصيلًا وتثبيتًا، ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام، فليس له أنفع ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهداية. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يثبت قلوبنا على دينه.
فصل: الإتيان بالضمير في قوله اهدنا
وأما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير في قوله: { اهدنا الصراط } ضمير جمع. فقد قال بعض الناس في جوابه: أن كل عضو من أعضاء العبد، وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به. فأتى بصيغة الجمع تنزيلًا، لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه. وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فاستركه واستضعفه جدًا، وهو كما قال: فإن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه، وعضو من أعضائه، والقائل إذا قال: اغفر لي وارحمني واجبرني واصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه فلا يحتاج أن يستشعرلكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظة.
فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم. فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته فأتى به بصيغة ضمير الجمع، أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك. فيكون هذا أحسن وأعظم موقعًا عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك ولهذا، لو قال: أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدًا، وأنا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك الاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأمله، وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } [91] ونحو دعاء آخر البقرة. وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية القرآن.
فصل: ما هو الصراط المستقيم
وأما المسألة العشرون، وهي ما هو الصراط المستقيم؟
فتذكر فيه قولًا وجيزًا. فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلًا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه. بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا وهو إفراده بالعبودية، وإفراد رسوله بالطاعة. فلا يشرك به أحدًا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدًا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول.
وهذا معنى قول بعض العارفين إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين صدق محبته وحسن معاملته. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. والأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله. والثاني يحصل بالتحقيق بشهادة أن محمدًا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق. والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به.
فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها. وهي معنى قول من قال: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة، ومعنى قول من قال متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا وعملًا ومعنى قول من قال: الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره. وأما ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال: الصلوات الخمس. وقول من قال: حب أبي بكر وعمر، وقول من قال: هو أركان الإسلام الخمس التي بني عليها فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع لا تفسير مطابق له. بل هي جزء من أجزائه وحقيقته الجامعة ما تقدم. والله أعلم.
فائدة: بدل البعض وبدل المصدر
في بدل البعض من الكل وبدل المصدر من الاسم وهما جميعًا يرجعان في المعنى والتحصيل إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة، إلا أن البدل في هذين الموضعين لا بد من إضافته إلى ضمير المبدل منه بخلاف بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة.
أما اتفاقهما في المعنى فإنك إذا قلت: رأيت القوم أكثرهم أو نصفهم، فإنما تكلمت بالعموم وأنت تريد الخصوص وهو كثير شائع فأردت بعض القوم وجعلت أكثرهم أو نصفهم تبيينًا لذلك البعض وأضفته إلى ضمير القوم، كما كان الاسم المبدل مضافًا إلى القوم فقد آل الكلام إلى أنك أبدلت شيئًا من شيء وهما لعين واحدة. وكذلك بدل المصدر من الاسم لأن الاسم من حيث كان جوهرًا لا يتعلق به المدح والذم والإعجاب والحب والبغض، إنما متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة به. فإذا قلت: نفعني عبد الله علمه دل أن الذي نفعك منه صفة وفعل من أفعاله، ثم بينت ذلك الوصف فقلت علمه أو إرشاده أو رويته. فأضفت ذلك إلى ضمير الاسم كما كان الاسم المبدل منه مضافًا إليه في المعنى. فصار التقدير نفعني صفة زيد أو خصلة من خصاله، ثم بينتها بقولك علمه أو إحسانه أو لقاؤه فآل المعنى إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة.
وإذا تقرر هذا فلا يصح في بدل الاشتمال أن يكون الثاني جوهرًا، لأنه لا يبدل جوهر من عرض، ولا بد من إضافته إلى ضمير الاسم، لأنه بيان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم في التقدير والعجب من الفارسي يقول في قوله تعالى: { النار ذات الوقود } [92] إنها بدل من الأخدود بدل اشتمال والنار جوهر قائم بنفسه، ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود وليس فيها شرط من شرانط الاشتمال، وذهل أبو علي عن هذا وترك ما هو أصح في المعنى وأليق بصناعة النحو، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فكأنه قيل: أصحاب الأخدود أخدود النار ذات الوقود فيكون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة كما قال الشاعر: * رضيعَي لِبان ثديِ أُمٍّ تحالفا * على رواية الجر في ثدي أم، أراد لبان ثدي فحذف المضاف.
فائدة بديعة: ولله على الناس حج البيت
قوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا }. [93] حج البيت مبتدأ وخبره في أحد المجرورين قبله والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله عى الناس، لأنه وجوب، والوجوب يقتضي على ويجوز أن يكون في قوله ولله، لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق، ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير وكان الأحق أن يكون ولله ويرجع الوجه الأول بأن يقال قوله: { على الناس حج البيت أكثر استعمالًا في باب الوجوب من أن يقال: حج البيت لله أي حق واجب لله، فتأمله.
وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول، وليس بخبر، فائدتان:
إحداهما: أنه اسم للموجب للحج فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب. فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع. أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدىء بذكره. والثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس. والثالث: النسبة والحق المتعلق به إيجابًا وبهم وجوبًا وأداء وهو الحج.
والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان لله اسمًا سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه وتخويفًا من تضييعه. إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره.
وأما قوله من فهي بدل. وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل المصدر كأنه قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلًا. وهذا القول يضعف من وجوه:
منها أن الحج فرض عين ولو كان معنى الآية ما ذكروه لأفهم فرض الكفاية، لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم، لأن المعنى يؤول إلي ولله على الناس أن يحج البيت مستطيعهم. فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبًا على غير المستطيعين، وليس الأمر كذلك، بل الحج فرض عين على كل أحد حج المستطيعون أو قعدوا، ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه. فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه، وليس حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين.
وإن أردت زيادة إيضاح فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعة للجهاد. فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب عن غيرهم.
وإذا قلت: واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع كان الوجوب متعلقًا بالجميع، وعذر العاجز بعجزه. ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين. هذه النكتة البديعة فتأملها.
الوجه الثاني أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إصافته إلى المفعول ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول، فلو كان من هو الفاعل لأضيف المصدر إليه، وكان يقال: ولله على الناس حج من استطاع. وحمله على باب يعجبني ضرب زيدًا عمرو. مما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول، والظرف حمل على المكثور المرجوح وهي قراءة ابن عامر قتل أولادهم بفتح الدال شركائهم فلا يصار إليه.
وإذا ثبت أن من بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى الناس، كأنه قيل: من استطاع منهم وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن وحسنه ههنا أمور:
منها أن من واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به.
ومنها أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد. ومثال ذلك. إذا قلت رأيت اخوتك من ذهب إلى السوق، تريد من ذهب منهم لكان قبيحًا، لأن الذاهب إلى السوق أعم من الاخوة، وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل، تريد منها ولم تذكر الضمير لكان أبعد في الجواز، لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب وباب بدل البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه. فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوص.
ومما حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول.
وأما المجرور من قوله إليه فيحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون في موضع حال من سبيل كأنه نعت نكرة قدم عليها، لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل.
والثاني: أن يكون متعلقًا بسبيل.
فإن قيل: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟
قيل: السبيل كان ههنا عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهما كان فيه رائحة الفعل ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق فصلح تعلق المجرور به، واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور، وإن كان موضعه التأخير، لأنه ضمير يعود على البيت. والبيت هو المقصود به الاعتناء. وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعنى.
هذا تعبير السهيلي وهو بعيد جدًا. بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين ولا يليق بالآية سواه وهو الوجوب المفهوم من قوله على الناس، أي يجب على الناس الحج، فهو حق واجب، وأما تعليقه بالسبيل أو جعله حالًا منها ففي غاية البعد فتأمله، ولا يكاد يخطر بالبال من الآية. وهذا كما يقول لله: عليك الحج ولله عليك الصلاة والزكاة.
ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويجرمه، يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو: { كتب عليكم الصيام }، [94] { حرمت عليكم الميتة }، [95] { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم }، [96] وفي الحج أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه:
أحدها: أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على، ثم أبدل منه أهل الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلًا، ثم اتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: ومن كفر أي بعدم التزام هذا الواجب وتركه، ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه والله تعالى هو الغني الحميد، ولا حاجة به إلى حج أحد، وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه، ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عمومًا ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار، وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الدالة على التوكيد.
فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين. مرة بإسناده إلى عموم الناس. ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين. وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرار الإسناد. ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته.
ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال، وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناءً به وتأكيدًا لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه وإن لم يطلب ذلك منها فقال: { إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدىً للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا }. [97] فوصفه بخمس صفات:
أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض.
الثاني: أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرًا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق.
الثالث: أنه هدى ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى.
الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية.
الخامس: الأمن الحاصل لداخله.
وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار، ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات، وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم، والتنويه بذكره، والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره. ولو لم يكن له شرف إلا ضافته إياه إلى نفسه بقوله: { وطهر بيتي للطائفين } [98] لكفى بهذه الإضافة فضلًا وشرفًا. وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه، وسلبت نفوسهم حبًا له وشوقًا إلى رؤيته فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه، ولا يقضون منه وطرًا أبدًا كلما ازدادوا له زيادة، ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقًا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، كما قيل:
أطوف به والنفس بعد مشوقة ** إليه وهل بعد الطواف تداني
وألثم منه الركن أطلب برد ما ** بقلبي من شوق ومن هيمان
فوالله ما أزداد إلا صَبابة ** ولا القلب إلا كثرة الخفقان
فيا جنة المأوى وياغاية المنى ** ويا مُنيتي من دون كل أمان
أبَتْ غلبات الشوق إلا تقربًا ** إليك فما لي بالبعاد يدان
وما كل صَدّي عنك صد ملالة ** ولي شاهد من مقلتي ولساني
دعوتُ اصطباري عنك بعدك والبُكا ** فلبى البكا والصبر عنك عصاني
وقد زعموا أن المحب إذا نأى ** سيَبلى هواه بعد طول زمان
ولو كان هذا الزعم حقًا لكان ذا ** دواء الهوى في الناس كل أوان
بل إنه يبلى التصبر والهوى ** على حاله لم يُبله المَلَوان
وهذا محب قاده الشوق والهوى ** بغير زمامٍ قائدٍ وعنان
أتاك على بُعد المزار ولو وَنَت ** مطيته جاءت به القدمان
فائدة بديعة: يسألونك عن الشهر الحرام
قوله تعالى: { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه } [99] من باب بدل الاشتمال، والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم إنهم يقدمون ما هم ببيانه أهمّ وهم به أعنى؟
قيل السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر، وتشنيع أعدائهم عليهم، وانتهاك حرمته، فكان اعتناؤهم واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال. فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر. فلذلك قدم في الذكر وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من القاعدة.
فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر وهلا اكتفى بضميره، فقال: قل هو كبير، وأنت إذا قلت: سألته عن زيد أهو في الدار كان، أوجز من أن تقول أزيد في الدار؟
قيل: في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة وهي تعلق الحكم الخبري باسم القتال فيه عمومًا. ولو أتى بالمضمر. وقال: هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه. وليس الأمر كذلك، وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام.
ونظير هذه الفائدة قوله ﷺ: وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». [100] فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله نعم توضؤوا به، لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص. فعدل عن قوله نعم توضؤوا إلى جواب عام يقتضي تعلق الحكم والطهورية بنفس مائه من حيث هو، فأفاد استمرار الحكم على الدوام وتعلقه بعموم الآية، وبطل توهم قصره على السبب. فتأمله فإنه بديع.
فكذلك في الآية لما قال قتال فيه كبير فجعل الخبر بكبير واقعًا على قتال فيه فيطلق الحكم به على العموم، ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك.
وقريب من هذا قوله تعالى: { والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين }، [101] ولم يقل: أجرهم تعليقًا لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين، وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور.
وقريب منه وهو ألطف معنى قوله تعالى: { يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }، [102] ولم يقل فيه تعليقًا لحكم الاعتزال بنفس الحيض وأنه هو سبب الاعتزال. وقال تعالى: { قل هو أذى }، ولم يقل الحيض، لأن الآية جارية على الأصل، ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره ثلاث مرات وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالإعتزال أحسن من ذكره مضمرًا ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضًا بخلاف قوله: { قل هو أذى } فإنه إخبار بالواقع، والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضًا بخلاف تعليق الحكم به. فإنه إنما يعلم بالشرع فتأمله.
فائدة: مجيء الحال من المضاف إليه
إنما امتنع مجيء الحال من المضاف إليه، لأن الحال شبه الظرف والمفعول. فلا بد لها من عامل ومعنى الإضافة أضعف من لامها. ولامها لا تعمل في ظرف ولو مفعول. فمعناها أولى بعدم العمل.
فإن قلت: فاجعل العامل فيها هو العامل في المضاف.
قلت: هو محال لا يجب اتحاد العامل في الحال وصاحبها، فلو كان العامل فيها هو العامل في المضاف لكانت حالًا منه دون المضاف إليه فتستحيل المسألة. فإما إذا كان المضاف فيه معنى الفعل نحو قولك: هذا ضارب هند قائمة، وأعجبني خروجها راكبة، جاز انتصاب الحال من المضاف إليه، لأن ما في المضاف من معنى الفعل واقع على المضاف إليه وعامل فيما هو حال منه وعلى هذا جاء قوله تعالى: { قال النار مثواكم خالدين فيها }، [103] وقوله: { أولئك أصحاب النار خالدين فيها } [104] فإن ما في مثوى وأصحاب من معنى الفعل يصحح عمله في الحال بخلاف قولك: رأيت غلام هند راكبة فإنه ليس في الغلام شيء من رائحة الفعل. وقد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه، إذا كان المضاف جزءه أو منزلًا منزلة جزءه نحو رأيت وجه هند قائمة، لأن البعض يجري عليه حكم الكل في اقتضاء العامل له. فجاز أن يعمل في الحال ما يعمل في بعض صاحبها لتنزله منزلته. وسريان حكم البعض إلى الكل لا ينكر لا لغة ولا شرعًا ولا عقلًا. فاللغة نحو هذا ونحو قوله: ذهبت بعض أصابعه وسرقت صدر القناة وتواصفت سور المدينة وهو كثير. وأما الشرع فكسريان العتق في الشقص المشترك. وأما العقل فإن الارتباط الذي بين الجزء والكل يقتضي أن يثبت لأحدهما ما يثبت للآخر وعلى هذا جاء قول الشاعر: * كان حواء منه مدبرًا * وقول حبيب: * والعلم في شهب الأرماح لامعة *
فائدة بديعة: إضمار الناصب
إن قيل كيف يضمرون الناصب في مثل: * للبسُ عباءة وتقرَّ عيني * وبابه، ولا يجوزون إضمار الخافض ولا الجازم، ولا إضمار نواصب الأسماء، وعواملُ الأسماء عندكم أقوى من عوامل الأفعال؟
قيل: نحن لا نجيز إضمار أن الناصبة إلا بإحدى شرائط إما مع الواو العاطفة على مصدر نحو: * تقضي لُبانات ويسأم سائمُ * و * لبس عباءة وتقر عيني * ألا ترى أنك لو جعلت مكان اللبس والتقضي اسمًا غير مصدر فقلت: يعجبني زيد ويذهب عمرو لم يجز، وإنما جاز هذا مع المصدر لأن الفعل المنصوب بأنه مشتق من المصدر ودال عليه بلفظه فكأنك عطفت مصدرًا على مصدر.
فإن قيل: فكان ينبغي أن يستغني بمجرد لفظ الفعل عن ذكر المصدر وإضمار أن فقال: ألبس عباءة وتقر عيني وأقضي لبانات ويسأم سائم؟
قيل: هذا سؤال حسن يستدعي جوابًا قويًا، وقد أجيب عنه بأن الأول لو جعل فعلًا مضارعًا لكان مرفوعًا. فإذا عطفت عليه الثاني شاركه في إعرابه وعامله. ورافع المضارع ضعيف لا يقوى على العمل في الفعلين. فإن العامل في المعطوف والمعطوف عليه واحد ولا يخفى فساد هذا الجواب فإنه منتقض بالطم والرم مما يعطف فيه المضارع على مثله كقوله: زيد يذهب ويركب، وإنما يذهب ويخرج زيد وأمثال ذلك.
فالجواب الصحيح أن يقال: المراد ما في المصدر من الدلالة على ثبوت نفس الحدث، وتعليق الحكم به دون تقييده بزمان دون زمان فلو أتى بالفعل المقيد بالزمان لفات الغرض. ألا ترى أن قولها بولبس عباءة وتقر عيني. المراد به حصول نفس اللبس مع كونها تقر عينها كل وقت شيئًا بعد شيء. فقرة العين مطلوب تجددها بحسب تجدد الأوقات وليس هذا مرادًا في لبس العباءة. وكذا قولك: آكل الشعير وأكف وجهي عن الناس أحب إلي من أكل البر وأبذل وجهي لهم. أفلا ترى تفضيل أكل الشعير على أكل البر ويدوم له كف وجهه عن الناس، كما أن تلك فضلت لبس العباءة على لبس الشفوف وتدوم لها قرة العين. فعلمت أن المقصود ماهية المصدر وحقيقته لا تقييده بزمان دون زمان. ولما كانت أن والفعل تقع موقع المصدر ويؤولان به في الإخبار عنهما كما يخبر عن الاسم نحو قوله: { وأن تصوموا خير لكم }، [105] أي صيامكم أول المصدر بأن والفعل في صحة عطف الفعل عليه وهذا من باب المقابلة والموازنة وقد جاء عطف الفعل على الاسم إذا كان فيه معنى الفعل نحو صافات ويقبضن. وإن المصدقين والمصدقات واقرضوا الله. ومنه وجيهًا ومن المقربين ويكلم الناس في المهد، لأن الاسم المعطوف عليه لما كان حاملًا للضمير صار بمنزلة الفعل ولو كان مصدرًا لم يجز عطف الفعل عليه إلا بإضمار أن، لأن المصادر لا تتحمل الضمائر.
فإن قيل: فلم جاز عطف الفعل على الاسم الحامل للضمير، ولم يعطف الاسم على الفعل. فتقول: مررت برجل يقعد وقائم، كما تقول: قائم ويقعد.
قيل: هذا سؤال قوي ولما رأى بعض النحاة أنه لا فرق بينهما أجاز ذلك وهو الزجاج فإنه أجازه في معاني القرآن والصحيح أنه قبيح. والفرق بينهما أنك إذا عطفت الفعل على الاسم المشتق منه رددت الفرع إلى الأصل، لأن الاسم أصل الفعل، والفعل متفرع عنه فجاز عطف الفعل عليه، لأنه ثان والثواني فروع على الأوائل. وإذا عطفت الاسم على الفعل كنت قد رددت الأصل فرعًا وجعلته ثانيًا وهو أحق بأن يكون مقدما لأصالته.
وسر المسألة: أن عطف الفعل على الاسم في مثل قوله: { صافات ويقبضن } ومررت برجل قائم، وبقعد أن الاسم معتمد على ما قبله. وإذا كان اسم الفاعل معتمدًا عمل عمل الفعل وجرى مجراه والاعتماد أن يكون نعتًا أو خبرًا، أو حالًا، والذي بعد الواو ليس بمعتمد بل هو اسم محض فيجري مجرى الفعل.
فائدة: مصدر الفعل اللازم
لما كان الفعل اللازم هو الذي لزم فاعله ولم يجاوزه إلى غيره، جاء مصدره مثقلًا بالحركات. إذ المثقل من صفة ما لزم محله، ولم ينتقل عنه إلى غيره. والخفة من صفة المنتقل من محله إلى غيره، فكان خفة اللفظ في هذا الباب وثقله موازنًا للمعنى فما لزم مكانه ومحله فهو الثقيل لفظًا ومعنى، وما جاوزه وتعداه فهو الخفيف لفظًا ومعنى.
ومن ههنا يرجح قول سيبويه: إن دخلت الدار غير متعد، لأن مصدره دخول فهو كالخروج والقعود وبابه، إلا أن الفعل منه لم يجىء على فعل، لأنه ليس بطبع في الفاعل ولا خصلة ثابتة فيه، فإن كان الفعل عبارة عما هو طبع وخصلة ثابتة نقلوه بضم العين كظرف وكرم، فهذا الباب ألزم للفاعل من باب قعد ودخل فكان أثقل منه لفظًا وباب قعد وخرج ألزم للفاعل من الفعل المتعدي كضرب. فكان أثقل منه مصدرًا، وإن اتفقا في لفظ الفعل.
ولزم مصدر فعل الذي هو طبع وخصلة وزن الفعال، كالجمال والكمال والبهاء والسناء والجلال والعلاء، هذا إذا كان المعنى عاملًا مشتملًا على خصال لا تختص بخصلة واحدة، فإن اختص المعنى بخصلة واحدة صار كالمحدود ولزمته تاء التأنيث، لأنها تدل على نهاية ما دخلت عليه كالضربة من الضرب، وحذفها في هذا الباب وفي أكثر الأبواب. يدل على انتفاء النهاية. ألا ترى أن الضرب يقع على القليل والكثير إلى غير نهاية، وإنما استحقت التاء ذلك لأن مخرجها منتهى الصوت وغايته فصلحت للغايات، ولذلك قالوا: علامة ونسابة أي غاية في هذا الوصف، فإذا عرفت هذا. فالجمال والكمال كالجنس العام من حيث لم تكن فيه التاء المخصوصة بالتحديد والنهاية، وقولك: ملح ملاحة وفصح فصاحة هو على وزنه إلا في التاء، لأن الفصاحة خصلة من خصال الكمال، وكذلك الملاحة فحددت بالتاء، لأنها ليست بجنس عام كالكمال والجمال فصارت كباب الضربة والثمرة من الضرب والثمر، ألا ترى إلى قول خالد بن صفوان، وقد قالت له امرأته: إنك لجميل، فقال: أتقولين ذلك وليس عندي عمود الجمال ولا رداؤه ولا برنسه: ولكن قولي إنك لمليح ظريف، فجعل الملاحة خصلة من خصال الجمال، فبان صحة ما قلناه.
وعلى هذا قالوا: الحلاوة والأصالة والرجاحة والرزانة والمهابة، وفي ضد ذلك السفاهة والوضاعة والحماقة والرذالة، لأنها كلها خصال محدودة بالإضافة إلى السفال الذي هو في مقابلة العلاء والكمال، لأنه جنس يجمع الأنواع التي تحته، وهذا هو الأصل في هذا الباب، فمتى شذ عنه منه شيء. فلمانع وحكمة أخرى كقولهم: شرف الرجل شرفًا، ولم يقولوا: شرافًا لأن الشرف رفعة في آبائه وهو شيء خارج عنه بخلاف كمل كمالًا، وجمل جمالًا، فإن جماله وكماله وصف قائم به وهذا، لأن شرف مستعار من شرف الأرض وهو ما ارتفع منها فاستعير للرجل الرفيع في قومه كأن آباءه الذين ذكر بهم وارتفع بسببهم شرف له.
وكذلك قولهم في هذا الباب الحسب، لأنه من باب القبص والنقص والقنص لا من باب المصادر لأن الحسب ما يحسبه الإنسان ويعده لنفسه من الخصال الحميدة والأخلاق الشريفة. واستحق الاسم الشامل في هذا الباب اسم الفعال بفتح الفاء والعين وبعدهما ألف وهي فتح ليكون اللفظ الذي يتوالى فيه الفتح موازنًا لانفتاح المعنى واتساعه، ولذلك اطرد في الجمع الكثير نحو مفاعل وفعايل وبابه واطرد في باب تفاعل نحو تقاتل وتخاصم وتمارض وتغافل وتناوم، لأنه إظهار الأمر ونشر له.
ومن هذا الباب حلم فإنه يوافقه في وجه ويخالفه في وجه، لأنه يدل على إثبات الصفة، فوافق شرف وكرم في الضم وخالفه في المصدر لمخالفته له في المعنى، لأنه صفة تقتضي كف النفس وجمعها عن الانتقام والمعاقبة، ولا يقتضي انفتاحًا ولا انتشًارا فقالوا: حلم لأنه من بناء الخصال والطبائع. وقالوا: حلماء، لأن الصفة صفة جمع النفس وضمها وعدم إرسالها في الانتقام فتأمله. ومن هذا الباب كبر وصغر موافق لما قبله في الفعل مخالف له في المصدر، لأن الكبر والصغر عبارة عن اجتماع أجزاء الحمم في قلة أو كثرة، وليس من الصفات والأحداث المنتشرة. وهذا تنبيه لطيف على ما هو أضعاف ذلك.
فائدة: فعل المطاوعة
فعل المطاوعة هو الواقع مسببًا عن سبب اقتضاه نحو كسرته فانكسر. فزيدت النون في أوله قبل الحروف الأصلية ساكنة كيلا يتوالى الحركات، ثم وصل إليها بهمزة الوصل. وقد تقدم أن الزوائد في الأفعال والأسماء موازنة للمعاني الزائدة على معنى الكلمة. فإن كان المعنى الزائد مترتبًا قبل المعنى الأصلي كانت الحروف الزائدة قبل الحروف الأصلية كالنون في الفعل، وكحروف المضارعة في بابها، وإن كان المعنى الزائد في الكلمة آخرًا كان الحرف الزائد على الحروف الأصلية آخرًا، كعلامة التأنيث وعلامة التثنية الجمع.
ومن هذا الباب تفعلل وتفاعل. وأما تفعل فلا يتعدى البتة، لأن التاء فيه بمثابة النون في الفعل إلا أنهم خصوا الرباعي بالتاء وخصوا الثلاثي بالنون فرقًا بينهما ولم تكن التاء هنا ساكنة كالنون لسكون عين الفعل. فلم يلزم منها من توالي الحركات ما لزم هناك.
وأما تفاعل فقد توجد متعدية لأنها لا يراد بها المطاوعة كما أريد بتفعلل، وإنما هو فعل دخلته التاء زيادة على فاعل المتعدي فصار حكمه إن كان متعديًا إلى مفعولين قبل دخول التاء، أن يتعدى بعد دخول التاء إلى مفعول نحو نازعت زيدًا الحديث، ثم تقول، وتنازعنا الحديث، وإن كان متعديًا إلى مفعول لم يتعد بعد دخول التاء إلى شيء نحو خاصمت زيدًا وتخاصمنا.
وهذا عكس دخول همزة التعدية على الفعل فإنها تزيده واحدًا أبدًا، وإن كان لازمًا صيرته متعديًا إلى مفعول، وإن كان متعديًا إلى واحد صيرته متعديًا إلى اثنين، وأما أحمر واحمار ففعل مشتق من الاسم كانتعل من النعل، وتمسكن من المسكن، وتمدرع وتمندل وتمنطق.
وزعم الخطابي أن معنى أحمر مخالف لمعنى احمار وبابه، وذهب إلى أن أفعل يقال فيما لم يخالطه لون آخر وأفعال. يقال لما خالطه لون آخر وهو ثقة في نقله والقياس يقتضي ما ذكر، لأن الألف لم يزد في إضاف حروف الكلمة إلا لدخول معنى زائد بين إضعاف معناها، والذي قاله غيره أحسن من هذا وهو أن أحمر يقال لما أحمر وهلة نحو أحمر الثوب ونحوه.
وأما احمارَّ فيقال لما يبدو فيه اللون شيئًا بعد شيء على التدريح نحو احمار البسر واصفار، ويدخل أفعل في هذا على أفعال. فيقال: احمر البسر، إذا تكامل لون الحمرة فيه واحمار، إذا ابتدأ صاعدًا إلى كماله.
فائدة: المتعدي إلى مفعولين
اختلفوا في المتعدي إلى مفعولين من باب كسى هل هو قياسي بالهمزة أم سماعي؟ والثاني قول سيبويه وهو الصحيح، فإنك لا تقول: آكلت زيدًا الخبز، ولا آخذته الدراهم، ولا أطلقت زيدًا امرأته وأعتقته عبده، ولكن ينبغي التفطن لضابط حسن وهو أنه ينظر إلى كل فعل منه في الفاعل صفة ما، فهو الذي يجوز فيه النقل، لأنك إذا قلت: أفعلته فإنما تعني جعلته على هذه الصفة، وقلما ينكسر هذا الأصل في غير المتعدي إذا كان ثلاثيًا. نحو قعد وأقعدته، وطال وأطلته.
وأما المتعدي فمنه ما يحصل للفاعل منه صفة في نفسه، ولا يكون اعتماده في الثاني على المفعول فيجوز نقله مثل طعم زيد الخبز وأطعمته، وكذلك جرع الماء وأجرعته، وكذلك بلع وشم وسمع وذلك، لأنها كلها تجعل في الفاعل منها صفة في نفسه غير خارجة عنه، ولذلك جاءت أو أكثرها على فعل بكسر العين مشابهة لباب فزع وحذر وحزن ومرض إلى غير ذلك مما له أثر في باطن الفاعل وغموض معنى. ولذلك كانت حركة العين كسرة، لأن الكسرة خفض للصوت وإخفاء له فشاكل اللفظ المعنى. ومن هذا الباب لبس الثوب وألبسته إياه، لأن الفعل وإن كان متعديًا فحاصل معناه في نفس الفاعل كأنه لم يفعل بالثوب شيئًا، وإنما فعل بلابسه. ولذلك جاء على فعل مقابلة عرى وقالوا: كسوته الثوب ولم يقولوا: أكسيته إياه وإن كان اللازم منه كسى. ومنه: * واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي * فهذا من كسى يكسي لا من كسا يكسو. وسر ذلك أن الكسوة ستر للعورة فجاء على وزن سترته وحجبته، فعدوه بتغيير الحركة لا بزيادة الهمزة.
وأما أكل وأخذ وضرب فلا ينقل، لأن الفعل واقع بالمفعول ظاهر أثره فيه غير حاصل في الفاعل منه صفة، فلا تقول: أضربت زيدًا عمرًا وأقتلته خالدًا، لأنك لم تجعله على صفة في نفسك كما تقدم.
وأما أعطيته فمنقول من عطا يعطو إذا أشار للتناول وليس معناه الأخذ والتناول. ألا تراهم يقولون: عاط بغير أنواط، أي يشير إلى التناول من غير شيء فنفوا أن يكون وقع هذا الفعل لشيء. فلذلك نقل كما نقل المتعدي لقربه منه فقالوا: أعطيته أي جعلته عاطيًا.
وأما أنلت من نال المتعدية وهي بمنزلة عطا يعطو لا تنبىء إلا عن وصول إلى المفعول دون تأثير فيه ولا وقوع ظاهر به، ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى: { لن ينال الله لحومها }، [106] ولو كان فعلًا مؤثرًا في مفعوله لم يجز هذا، إنما هو شيء منبىء عن الوصول فقط، أو ما أتيت المال زيدًا، فمنقول من أتى، لأنها غير مؤثرة في المفعول وقد حصل منها في الفاعل صفة.
فإن قيل: يلزمك أن تجيز أتيت زيدًا عمرًا أو المدينة أي جعلته يأتيها؟
قلت: بينهما فرق وهو أن ايتاء المال كسب وتمليك فلما اقترن به هذا المعنى صار كقوله أكسبته مالًا أو ملكته إياه وليس كقولك: آتي عمرًا.
وأما شرب زيد الماء فلم يقولوا فيه: أشربته الماء، لأنه بمثابة الأكل والأخذ ومعظم أثره في المفعول، وإن كان قد جاء على فعل كبلع، ولكنه ليس مثله إلا أن يريد أن الماء خالط أجزاء الشارب له وحصل من الشرب صفة من الشارب. فيجوز حينئذ نحو قوله تعالى: { وأشربوا في قلوبهم العجل }، [107] وعلى هذا يقال: أشربت الدهن الخبز، لأن شرب الخبز الدهن ليس كشرب زيد الماء فتأمله.
وأما ذكر زيد عمرًا فإن كان في ذكر اللسان لم ينقل، لأنه بمنزلة شتم ولطم وإن كان من ذكر القلب نقل فقلت أذكرته الحديث بمنزلة أفهته وأعلمته أي جعلته على هذه الصفة.
فائدة: اخترت يتعدى بحرف الجر
اخترت: أصله أن يتعدى بحرف الجر وهو من، لأنه يتضمن إخراج شيء من شيء. وجاء محذوفًا في قوله تعالى: { واختار موسى قومه }، [108] لتضمن الفعل معـنا فعل غير متعد كأنه نخل قومه وميزهم وسبرهم ونحو ذلك. فمن ههنا والله أعلم أسقط حرف الجر كما سقط من أمرتك الخير أي ألزمتك وكلفتك، لأن الأمر إلزام وتكليف. ومنه تمرون الديار أي تعدونها وتجاوزونها. ومنه رحبتك الديار أي وسعتك.
فائدة: تقديم المجرور وتأخير المفعول
الاختيار تقديم المجرور في باب اخترت وتأخير المفعول المجرد عن حرف الجر. فتقول: اخترت من الرجال زيدًا ويجوز فيه التأخير. فإذا أسقطت الحرف لم يحسن تأخير ما كان مجرورًا به في الأصل فيقبح أن تقول: اخترت زيدًا الرجال، واخترت عشرة الرجال أي من الرجال لما يوهم من كون المجرور في موضع النعت للعشرة، وإنه ليس في موضع المفعول الثاني، وأيضا فإن الرجال معرفة فهو أحق بالتقديم للاهتمام به كما لزم في تقديم المجرور الذي هو خبر عن النكرة من قولك: في الدار رجل لكون المجرور معرفة وكأنه المخبر عنه. فإذا حذفت حرف الجر لم يكن بد من التقديم للاسم الذي كان مجرورًا نحو اخترت الرجال عشرة.
والحكمة في ذلك أن المعنى الداعي الذي من أجله حذف حرف الجر هو معنى غير لفظ فم يقو على حذف حرف الجر إلا مع اتصاله به وقربه منه.
ووجه ثان وهو أن القليل الذي اختير من الكثير إذا كان مما يتبعض، ثم ولي الفعل الذي هو اخترت توهم أنه مختار منه أيضا لأن كل ما يتبعض يجوز فيه أن يختار منه وأن يختار، فألزموه التأخير وقدموا الاسم المختار منه وكان أولى بذلك لما سبق من القول. فإن كان مما لا يتبعض نحو زيد وعمرو، فربما جاز على قلة في الكلام نحو قوله: * ومنا الذي اختير الرجال سماحة * وليس هذا كقولك: اخترت فرسًا الخيل، لأن الفرس اسم جنس فقد يتبعض مثله ويختار منه وزيد من حيث كان جسمًا يتبعض، ومن حيث كان علمًا على شيء بعينه لا يتبعض فتأمل هذا الموضع.
فائدة بديعة: استغفر زيد ربه ذنبه
قولهم: استغفر زيد ربه ذنبه، فيه ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. والثاني: استغفره من ذنبه. والثالث: استغفره لذنبه وهذا موضع يحتاج إلى تدقيق نظر وأنه هل الأصل حرف الجر وسقوطه داخل عليه؟ أو الأصل سقوطه وتعديه بنفسه وتعديته بالحرف مضمن هذا مما ينبغي تحقيقه. فقال السهيلي: الأصل فيه سقوط حرف الجر. وأن يكون الذنب نفسه مفعولًا بأستغفر غير متعد بحرف الجر، لأنه من غفرت الشيء إذا غطيته وسترته مع أن الاسم الأول هو فاعل بالحقيقة وهو الغافر.
ثم أورد على نفسه سؤالًا فقال: فإن قيل: فإن كان سقوط حرف الجر هو الأصل فيلزمكم أن تكون من زائدة كما قال الكسائي. وقد قال سيبويه والزجاجي: أن الأصل حرف الجر، ثم حذف فنصب الفعل. وأجاب بأن سقوط حرف الجر أصل في الفعل المشتق منه نحو غفر. وأم استغفر ففي ضمن الكلام ما لا بد منه من حرف الجر، لأنك لا تطلب غفرًا مجردًا من معنى التوبة والخروج من الذنب، وإنما تريد بالاستغفار خروجًا من الذنب وتطهيرًا منه. فلزمت من في هذا الكلام لهذا المعنى فهي متعلقة بالمعنى لا بنفس اللفظ، فإن حذفتها تعدى الفعل فنصب وكان بمنزلة أمرتك الخير.
فإن قيل: فما قولكم في نحو قوله تعالى: { يغفر لكم من ذنوبكم } [109] و { نغفر لكم خطاياكم }؟ [110]
قلنا هي متعلقة بمعنى الإنقاذ والإخراج من الذنوب فدخلت منه لتؤذن بهذا المعنى، ولكن لا يكون ذلك في القرآن إلا حيث يذكر الفاعل والمفعول الذي هو الذنب نحو قوله: ( لكم ) لأنه المنقذ المخرج من الذنوب بالإيمان. ولو قلت: يغفر من ذنوبكم دون أن يذكر الاسم المجرور. لم يحسن إلا على معنى التبعيض، لأن الفعل الذي كان في ضمن الكلام وهو الإنقاذ قد ذهب بذهاب الاسم الذي هو واقع عليه.
فإن قلت: فقد قال تعالى: { وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا }، [111] وفي سورة الصف: { يغفر لكم ذنوبكم }، [112] فما الحكمة في سقوطها هنا وما الفرق؟
قلت: هذا إخبار عن المؤمنين الذين قد سبق لهم الإنقاذ من ذنوب الكفر بأيمانهم، ثم وعدوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في الإسلام من الذنوب وهي غير محبطة كإحباط الكفر المهلك للكافر فلم يتضمن الغفران معنى الاستنقاذ إذ ليس، ثم إحاطة من الذنب بالمذنب، وإنما يتضمن معنى الإذهاب والإبطال للذنوب، لأن الحسنات يذهبن السيئات بخلاف الآيتين المتقدمتين فإنهما خطاب للمشركين وأمر لهم بما ينقذهم ويخلصهم مما أحاط بهم من الذنوب وهو الكفر. ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة بأنهم واقعون في مهلكة قد أحاطت بهم. وأن لا ينقذهم منها إلا المغفرة المتضمنة للإنقاذ الذي هو أخص من الإبطال والإذهاب. وأما المؤمنون فقد أنقذوا.
وأما قوله تعالى: { يكفر عنكم من سيئاتكم }، فهي في موضع من التي للتبعيض، لأن الآية في سياق ثواب الصدقة فإنه قال: { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم }، [113] والصدقة لا تذهب جميع الذنوب.
ومن هذا النحو قوله ﷺ: «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». فأدخل عن في الكلام إيذانًا بمعنى الخروج عن اليمين لما ذكر الفاعل وهو الخارج فكأنه قال: فليخرج بالكفارة عن يمينه ولما لم يذكر الفاعل المكفر في قوله: { ذلك كفارة أيمانكم } لم يذكر من وأضاف الكفارة إلا الأيمان وذلك من إضافة المصدر إلى المفعول وإن كانت الأيمان لا تكفر، وإنما يكفر الحنث والإثم، ولكن الكفارة حل لعقد اليمين. فمن هنالك أضيفت إلى اليمين، كما يضاف الحل إلى العقد إذ اليمين عقد والكفارة حل له. والله أعلم.
فائدة: ألبست زيدا الثوب
قولك: ألبست زيدًا الثوب ليس الثوب منتصبًا بألبست كما هو السابق إلى الأوهام لما تقدم. من أنك لا تنقل الفعل عن الفاعل ويصير الفاعل مفعولًا حتى يكون الفعل حاصلًا في الفاعل، ولكن المفعول الثاني منتصب بما تضمنه ألبست من معنى، لبس فهو منتصب بما كان منتصبًا به قبل دخول الهمزة والنقل. وذلك أنهم اعتقدوا طرحها حين كانت زائدة، كما فعلوا في تصغير حميد وزهير. ومنه قولهم: أحببت حبيبًا فجاؤوا بحبيب على اعتقاد طرح الهمزة وهي لغية. ومنه أدرست البيت فهو دارس على تقدير درسته. ومنه: { والله أنبتكم من الأرض نباتًا }، [114] فجاء المصدر على نبت.
ومما يوضح هذا أنهم أعلوا الفعل. فقالوا: أطال الصلاة وأقامها مراعاة لإعلاله قبل دخول الهمزة. ولهذا حيث نقلوه في التعجب. فاعتقدوا إثبات الهمزة لم يعدوه إلى مفعول ثان. بل قالوا: ما أضرب زيدًا لعمرو باللام، لأن التعجب تعظيم لصفة المتعجب منه. وإذا كان الفعل صفة في الفاعل لم ينقل، ومن ثم صححوه في التعجب فقالوا: ما أقومه وأطوله، حيث لم يعتقدوا سقوط الهمزة، كما صححوا الفعل من استحوذ واستنوق الجمل حيث كانت الهمزة والزوائد لازمة غير عارضة. والله أعلم.
فائدة: حذف الباء من أمرتك الخير
حذف الباء من أمرتك الخير ونحوه إنما يكون بشرطين:
أحدهما: اتصال الفعل بالمجرور. فإن تباعد منه لم يكن بد من الباء نحو أمرت الرجل يوم الجمعة بالخير، لأن المعنى الذي من أجله حذفت الباء معنى وليس بلفظ وهو تضمنها معنى كلفتك. فلم يقو على الحذف إلا مع القرب من الاسم كما كان ذلك في اخترت. ألا ترى إلى قوله تعالى: { قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم }، [115] كيف أعاد حرف الجر في البدل لما طال بالصلة وكذلك: { يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها }، [116] على أحد القولين أي يخرج لنا من بقل الأرض وقثائها. وقوله: { مما تنبت } توطئة وتمهيد. والقول الثاني أنها متعلقة بقوله: { تنبت } أي ما تنبت من هذا الجنس. فمن الأولى لابتداء الغاية، والثانية لبيان الجنس، وهذا الثاني أظهر فإذا أعيد حرف الجر مع البدل لطول الاسم الأول فإثبات الحرف من نحو أمرتك الخير إذا طال الاسم أجدر.
الشرط الثاني: أن يكون المأمور به حدثًا. فإن قلت: أمرتك بزيد لم يحذف، لأن الأمر في الحقيقة ليس به، وإنما هو على غيره. كأنك قلت، أمرتك بضربه أو إكرامه. وأما نهيتك عن الشر فلا يحذف الحرف منه، لأنه ليس في الكلام ما يتضمن الفعل الناصب، لأن النهي عنه كف وزجر وإبعاد وهذه المعاني التي يتضمنها نهي تطلب من الحرف ما يطلبه نهي بخلاف أمر فإنه كلف وألزم لا تطلب الباء.
فائدة بديعة: أصل وضع عرفت كذا
قولهم: عرفت، كذا أصل وضعها لتمييز الشيء وتعيينه حتى يظهر للذهن منفردًا عن غيره. وهذه المادة تقتضي العلو والظهور كعرف الشيء لأعلاه ومنه الأعراف ومنه عرف الديك.
وأما علمت فموضوعة للمركبات لا لتمييز المعاني المفردة. ومعنى التركيب فيها إضافة الصفة إلى المحل وذلك أنك تعرف زيدًا على حدته. وتعرف معنى القيام على حدته، ثم تضيف القيام إلى زيد. فإضافة القيام إلى زيد هو التركيب وهو متعلق العلم.
فإذا قلت: علمت فمطلوبها ثلاثة معان محل وصفة وإضافة الصفة إلى المحل، وهن ثلاث معلومات. إذا عرف هذا فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله سبحانه إلا العلم لا المعرفة، لأن علمه متعلق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلقًا واحدًا بخلاف علم المحدثين. فإن معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير علمهم ومعرفتهم بشيء آخر.
وهذا بناء منه على أن الله تعالى يعلم المعلومات كلها بعلم واحد، وأن علمه بصدق في رسول الله ﷺ هو عين علمه بكذب مسيلمة. والذي عليه محققو النظار خلاف هذا القول وأن العلوم متكثرة متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرها، فلكل معلوم علم يخصه. ولإبطال قول أولئك وذكر الأدلة الراجحة على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به. وعلى هذا فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم، وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناها فإنها في مجاري استعمالها، إنما تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب. فإذا تصور وحصل في الذهن قيل: عرفه، أو وصف له صفته ولم يره. فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل: عرفه ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد زمان فتبينت أنه هو قلت: عرفته، وكذلك عرفت اللفظة وعرفت الديار وعرفت المنزل وعرفت الطريق.
وسر المسألة: أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره. فاشتبه، فالمعرفة تمييز له وتعيين ومن هذا قوله تعالى: { يعرفونه كما يعرفون أبناءهم }، [117] فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته، وجاء كما يعرفون أبناءهم من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر فتأمله. وقد بسطنا هذا في كتاب التحفة المكية وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل عليه مصنف.
وأما ما زعموا من قولهم إن علمت قد يكون بمعنى عرفت واستشهادهم بنحو قوله تعالى: { لا تعلمهم نحن نعلمهم }، [118] وبقوله: { وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم }، فالذي دعاهم إلى ذلك، أنهم رأوا علمت قد تعدت إلى مفعول واحد. وهذا هو حقيقة العرفان. فاستشهاد ظاهر على أنه قد قال بعض الناس: إن تعدي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى مفعول واحد لا يخرجها عن كونها علمًا على الحقيقة. فإنها لا تتعدى إلى مفعول واحد على نحو تعدى عرفت، ولكن على جهة الحذف والاختصار فقوله: لا تعلمهم نحو نعلمهم لا تنفي عنه معرفة أعيانهم وأسمائهم، وإنما تنفي عنه العلم بعدوانهم ونفاقهم، وما تقدم من الكلام يدلك على ذلك، وكذلك قوله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، فربما كانوا يعرفونهم ولا يعلمونهم أعداء لهم، فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف لا بعينه وذاته. قال: هذا وإنما مثل من يقول: إن علمت بمعنى عرفت من أجل أنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ كمثل من يقول: إن سألت يتعدى إلى غير العقلاء بقولهم: سألت الحائط وسألت الدار ويحتج بقوله: واسأل القرية، قال: وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف، وكذلك ما تقدم.
وليس ما قاله هؤلاء بقوي. فإن الله سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان أولئك المنافقين، هذا صريح اللفظ، وإنما جاء نفي معرفة نفاقهم من جهة اللزوم، فهو ﷺ كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين وهو موجود في غيرهم، ولا يعرف أعيانهم. وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا على النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم، فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه.
والظاهر بل المتعين أنه ﷺ لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسيماهم وفي لحن القول: ولم يكن يخفى عليه نفاق من يظهر له الإسلام ويبطن عداوته وعداوة الله عز وجل. والذي يزيد هذا وضوحًا الآية الأخرى فإن قوله: { ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم }، [119] فيهم قولان:
أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على محاربة الله ورسوله وعلى هذا. فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفة، ولا يمكن أن يقال: إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولئك جاهلين عداوتهم كما أمكن مثله في الإنس.
والقول الثاني أنهم المنافقون وعلى هذا فقوله: لا تعلمونهم إنما ينبغي حمله على معرفة أشخاصهم لا على معرفة نفاقهم، لأنهم كانوا عالمين بنفاق كثير من المنافقين يعلمون نفاقهم ولا يشكون فيه. فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم عالمون به. وإنما ينفي عنهم معرفة أشخاص من هذا الضرب. فيكون كقوله تعالى: { لا تعلمهم نحن نعلمهم } فتأمله.
ويزيده وضوحًا أن هذه الأفعال لا يجوز فيها الاقتصار على أحد المفعولين بخلاف باب أعطى وكسى للعلة المذكورة هناك وهي تعلق هذه الأفعال بالنسبة. فلا بد من ذكر المنتسبين بخلاف باب أعطى فإنه لم يتعلق بنسبة، فيصح الاقتصار فيه على أحد مفعولين وهذا واضح كما تراه والله أعلم.
وأما تنظيرهم بـ"سألتُ الحائط والدار" فيا بعد ما بينهما، فإن هذا سؤال بلسان الحال وهو كثير في كلامهم جدًا على أنه لا يمتنع أن يكون سؤالًا بلسان المقال صريحًا. كما يقول الرجل للدار الخربة. ليت شعري ما فعل أهلك. وليت شعري ما صيرك إلى هذه الحال! وليس هذا سؤال استعلام بل سؤال تعجب وتفجع وتحزن.
وأما قوله: { واسأل القرية } فالقرية إن كانت هنا اسمًا للسكان كما هو المراد بها في أكثر القرآن والكلام، فلا مجاز ولا حذف وإن كان المراد بها المسكن. فعلى حذف المضاف فأين التسوية والتنظير.
تنبيه
قولهم: علمت وظننت يتعدى إلى مفعولين ليس هنا مفعولان في الحقيقة. وإنما هو المبتدأ والخبر وهو حديث إما معلوم. وإما مظنون فكان حق الاسم الأول أن يرتفع بالابتداء والثاني بالخبر ويلغي الفعل لأنه لا تأثير له في الاسم، إنما التأثير لعرفت الواقعة على الاسم المفرد تعيينًا وتمييزًا ولكن أرادوا تثبيت علمت بالجملة التي هي الحديث كيلا يتوهم الانقطاع بين المبتدأ وبين ما قبله، لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع له مما قبله. وهم إنما يريدون إعلام المخاطب بأن هذا الحديث معلوم، فكان أعمال علمت فيه ونصبه له إظهارًا لتشبثها ولم يكن عملهما في أحد الاسمين أولى من الآخر. فعملت فيهما جميعًا.
وكذلك ظننت لأنه لا يتحدث بحديث حتى يكون عند المتكلم إما مظنونًا، وإما معلومًا، فإن كان مشكوكًا فيه أو مجهولًا عنده لم يسعه التحدث به، فمن ثم لم يعملوا شككت ولا جهلت فيما عملت فيه ظننت، لأن الشك تردد بين أمرين من غير اعتماد على أحدهما بخلاف الظن فإنه معتمد على أحد الأمرين. وأما العلم فأنت فيه قاطع بأحدهما، ومن ثم تعدى الشك بحرف في، لأنه مستعار من شككت الحائط بالمسمار وشك الحائط إيلاج فيه من غير ميل إلى أحد الجانبين، كما أن الشك في الحديث تردد فيه من غير ترجيح لأحد الجانبين.
ونظير أعماله علمت وأخواتها في المبتدإ والخبر اللذين هما بمعنى الحديث أعمالهم كان وأخواتها في الجملة. وإنما كان أصلها أن ترفع فاعلًا واحدًا نحو كان الأمر أي حدث، فلما خلعوا منها معنى الحدث ولم يبق فيها إلا معنى الزمان، ثم أرادوا أن يخبروا بها عن الحدث الذي هو زيد قائم أي زمان هذا الحدث ماض أو مستقبل أعملوها في الجملة ليظهر تشبثها بها ولئلا يتوهم انقطاعها عنها، لأن الجملة قائمة بنفسها وكان كلمة يوقف عليها، أو يكون خبرًا عما قبلها. فكان عملها في الجملة دليلًا على تشبثها بها وإنها خبر عن هذا الحدث، ولم تكن لتنصب الاسمين لأن أصلها أن ترفع ما بعدها، ولم تكن لترفعهما معًا فلا يظهر عملها، ولذلك رفعت أحدهما ونصبت الآخر.
نعم، ومنهم من يقول: كان زيد قائم فيجعل الحديث هو الفاعل لكان فيكون معمولها معنويًا لا لفظيًا كأنك قلت: كان هذا الحديث، و(إن) أضمرت الشأن والحديث، ودلت عليه قرينة الحال والمسألة على حالها، لأن الجملة حينئذ بدل من ذلك الضمير، لأنها في معنى الحديث. وذلك الحديث هو الأمر المضمر. فهذا بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة.
ونظير هذا المعمول المعنوي الذي هو الحديث معمول علمت وظننت إذا الغيت نحو زيد ظننت قائم كأنك قلت: ظننت هذا الحديث فلم تعملها لفظًا، إنما أعملتها معنى.
ومن هذا الباب إعمالهم إن وأخواتها، وإنما دخلت لمعان في الجملة والحديث: ألا ترى أن كلمة أن وأخواتها كلمات يصح الوقف عليها، لأن حروفها ثلاثة فصاعدًا كما قال: *.. فقلت: إنه * وقال آخر: * ليت شعري وأين مِني ليتُ * وقال حبيب: * عسى وطن يدنو بهم ولعلما *
وإذا كان هذا حكمها، فلو رفع ما بعدها على الأصل بالابتداء لم يظهر تشبثها بالحديث الذي دخلت لمعنى فيه. فكان إعمالها في الاسم المبتدإ إظهارًا لتشبثها بالجملة كي لا يتوهم انقطاعها عنها وكان عملها نصبًا، لأن المعاني التي تضمنتها لو لفظ بها لنصبت نحو أؤكد وأترجى وأتمنى. وليست هذه المعاني مضافة إلى الاسم المخبر عنه، ولكن الحديث هو المؤكدة والمتمني والمترجي فكان عملها نصبًا بها وبقي الاسم الآخر مرفوعًا لم تعمل فيه حيث لم تكن أفعالًا كعلمت وظننت فتعمل في الجملة كلها.
وأيضا أرادوا إظهار تشبثها بالجملة، فاكتفوا بتأثيرها في الاسم الأول يدلك على أنها لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا يليها لأنه لا يلي العامل ما عمل فيه غيره. فلو عملت فيه لوليها كما يلي كان خبرها ويلي الفعل مفعوله.
نعم، ومن العرب من أعملها في الاسمين جميعًا وهو أقوى في القياس، لأنها دخلت لمعان في الجملة، فليس أحد الاسمين أولى بأن تعمل فيه من الآخر قال:
إن العجوزَ خَبّةً جَروزًا ** تأكل كل ليلة قَفيزا
وقال:
كان أُذنيه إذا تشوَّفا ** قادمةً أو قلما محرفا
وقال:
وليس هذا من باب حذف فعل التشبيه كما قال بعضهم: فإن هذا لغة قائمة بنفسها.
واعلم أن معاني هذه الحروف لا تعمل في حال ولا ظرف، ولا يتعلق بها مجرور لأنها معان في نفس المتكلم كالاستفهام والنفي وسائر المعاني التي جعلت الحروف إمارات لها وليس لها وجود في اللفظ فإذا قلت: هل زيد قائم؟ فمعناه استفهم عن هذا الحديث، وكذلك لا معناها النفي، وكذلك ليس، ولذلك لما أرادوا تشبثها بالجملة لم ينصبوا بها الاسم الأول كما نصبوا بأن حيث لم يكن معناها يقتضي نصبًا إذا لفظ به كما يقتضي معنى أن لعل إذا لفظ به.
وأما كأن للتشبيه فمفارقة لأخواتها من جهة أنها تدل على التشبيه وهو معنى في نفس المتكلم واقع على الاسم الذي بعدها فكأنك تخبر عن الاسم أنه يشبه غيره فصار معنى التشبيه مسندًا إلى الاسم بعدها كما أن معاني الأفعال مسندة إلى الأسماء بعدها. فمن ثم عملت في الحال والظرف تقول: كأن زيدًا يوم الجمعة أمير فيعمل التشبيه في الظرف. ومن ذلك قوله:
كأنه خارجًا من جنب صفحته ** سفودُ شربٍ نَسُوه عند مُفتأدِ
ومن ثم وقعت في موضع الحال والنعت كما تقع الأفعال المخبر بها عن الأسماء تقول: مررت برجل كأنه أسد وجاءني رجل كأنه أمير. وليس ذلك في أخواتها، لأنها لا تكون في موضع نعت، ولا في موضع حال. بل لها صدر الكلام كما لحروف الشرط والاستفهام، لأنها داخلة لمعان في الجمل فانقطعت عما قبلها، وإنما كانت كأن مخالفة لأخواتها من وجه وموافقة من وجه من حيث كانت مركبة من كاف التشبيه وأن التي للتوكيد. وكان أصلها أن زيدًا الأسد أي مثل الأسد، ثم أرادوا أن يبينوا أنه ليس هو بعينه فأدخلوا الكاف على الحديث المؤكد بأن لتؤذن أن الحديث مشبه به. وحكم أن إذا أدخل عليها عامل أن تفتح الهمزة منها فصار اللفظ بها كأن زيدًا الأسد.
فلما في الكلمة من التشبيه المخبر به عن زيد صار زيد بمنزلة من أخبر عنه بالفعل فوقع موقع النعت والحال وعمل ذلك المعنى وتعلقت به المجرورات، ومن حيث كان في الكلمة معنى أن دخلت في هذا الباب ووقع في خبرها الفعل نحو قولك: كأن زيدًا يقوم. والجملة نحو كأن زيدًا أبوه أمير. ولو لم يكن إلا مجرد التشبيه لم يجز هذا، لأن الاسم لا يشبه بفعل ولا بجملة. ولكنه حديث مؤكد بأن والكاف تدل على أن خبرًا أشبه من خبر وذلك الخبر المشبه هو الذي عليه زيد فكان المعنى زيد قائم وكأنه قاعد وزيد أبوه وضيع وكأنه أبوه أمير فشبهت حديثًا بحديث. والذي يؤكد الحديث أن والذي يدل على التشبيه الكاف فلم يكن بد من اجتماعهما.
فصل: حروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيه ما بعدها
وكل هذه الحروف تمنع ما قبلها أن بعمل فيه ما بعدها لفظًا أو معنى. أما اللفظ. فلأنه لا يجتمع عاملان في اسم واحد وهذه الحروف عوامل. وأما المعنى فلا تقول: سرني زيد قائم أي سرني هذا الحديث ولا كرهت زيد قائم أي كرهت هذا الحديث كما يكون ذلك في كان وليس، لأنها ليست بفعل محض فجاز أن تقول: كان زيد قائم أي كان هذا الحديث. ولم يجز في سرني ولا بلغني. فإن أدخلت ليت، أو لعل، أو إن المكسورة لم يجز أيضا، لأن هذه المعاني ينبغي أن يكون لها صدر الكلام فلا يقع بعدها فعل يعمل ولا يلغى فإن جئت بأن المفتوحة قلت: بلغني أن زيدًا منطلق فأعملت الفعل في معمول معنوي وهو الحديث، لأن الجملة الملفوظ بها حديث في المعنى، وإنما جاز هذا لامتناع الفعل أن يعمل فيما عملت فيه أن. ولا بد له من معمول فتسلط على المعمول المعنوي وهو الحديث حيث لم يمكن أن يعمل في اللفظي الذي عملت فيه أن. وكذلك كرهت أن زيدًا منطلق المفعول هو الحديث وهو معنى لا لفظ.
فإن قيل: ولم لا جعلوا لأن المفتوحة صدر الكلام كما جعلوا لليت ولعل ولجميع الحروف الداخلة على الجمل؟
قيل: ليس في أن معنى زائد على الجملة أكثر من التوكيد. وتوكيد الشيء بمثابة تكراره لا بمثابة معنى زائد فيه، فصح أن يكون الحديث المؤكد بها معمولًا لما قبلها حيث منعت هي من عمل ما قبلها في اللفظ الذي بعدها فتسلط العامل الذي قبلها على الحديث ولم يكن له مانع في صدر الكلام يقطعه عنه كما كان ذلك في غيرها، فإن كسرت همزتها كان الكسر فيها إشعارًا بتجريد المعنى الذي هو التوكيد عن توطئة الجملة للعمل في معناها، فليس بين المكسورة والمفتوحة فرق في المعنى إلا أنهم أرادوا توطئة الجملة، لأن يعمل الفعل الذي قبلها في معناها وإن صيروها في معنى الحديث فتحوا الهمزة، وإذا أرادوا قطع الجملة مما قبلها وأن يعتمدوا على التوكيد اعتمادهم على الترجي والتمني كسروا الهمزة لتؤذن بالابتداء والانقطاع عما قبل. وأنهم قد جعلوا التوكيد صدر الكلام، لأنه معنى كسائر المعاني وإن لم يكن في الفائدة مثل غيره، وكان الكسر في هذا الموطن أولى، لأنه أثقل من الفتح والثقل أولى أن يعتمد عليه ويصدر الكلام به، والفتح أولى بما جاء بعد كلام لخفته وأن المتكلم ليس في عنفوان نشاطه وجمامه، مع أن المفتوحة قد يليها الضم والكسر كقولك لأنك وعلمت أنك فلو كسرت لتوالي الثقل.
فإن قيل: فما المانع أن تكون هي وما بعدها في موضع الابتداء كما كانت في موضع الفاعل والمفعول والمجرور. أليس قد صيرت الجملة في معنى الحديث فهلا تقول: إنك منطلق يعجبني وما الفرق بينها وبين أن التي هي وما بعدها في تأويل الاسم. نحو أن تقوم خير من أن تجلس فلم تكون تلك في موضع المبتدأ ولا تكون هذه كذلك؟
قيل: إن المبتدأ يعمل فيه عامل معنوي. والعامل المعنوي لولا أثره في المعمول اللفظي لما عقل. وهذه الجملة المؤكدة بأن إنما يصح أن تكون معمولًا لعامل لفظي، لأن المعمول معنى أيضا. فهذا لا يفهمه المخاطب ولا يصل إلى علمه إلا بوحي. فامتنع أن تكون هذه الجملة المؤكدة في موضع المبتدأ، لأنه لا ظهور للعامل ولا للمعمول، ومن ثم لم تدخل عليه عوامل الابتداء من كان وأخواتها وإن وأخواتها، لأنها قد استغنت بظهور عملها في الجملة عن حرف يصير الجملة في معنى الحديث المعمول فيه، فلا تقول كان إنك منطلق لا حاجة إلى أن مع عمل هذه الحروف في الجملة.
وجواب آخر وهو أنهم لو جعلوها في موضع الابتداء لم يسبق إلى الذهن إلا الاعتمادعلى مجرد التوكيد دون توطئة الجملة للإخبار عنها فكانت تكسر همزتها. وقد تقدم أن الكسر إشعار بالانقطاع عما قبل، واعتماد على المعنى الذي هو التوكيد. فلم يتصور فتحها في الابتداء إلا بتقديم عامل لفظي يدل على المراد بفتحها، لأن العامل اللفظي يطلب معموله فإن وجده لفظًا غير ممنوع منه وإلا تسلط على المعنى والابتداء بخلاف هذا.
فإن قيل: فلم قالوا: علمت أن زيدًا منطلق وظننت أنه ذاهب هلا اكتفوا بعمل هذه الأفعال في الأسماء عن تصيير الجملة في معنى الحديث كما اكتفوا في باب كان، وإن فقالوا: كان زيدًا قائمًا. قيل: يقولوا: كان إن زيدًا قائمًا.
قيل: الفرق بينهما أن هذه الأفعال تدل على الحدث والزمان وليست بمنزلة كان وليس ولا بمنزلة إن وليت فجرت مجرى كرهت وأحببت، فلذلك قالوا: علمت أنك منطلق كما قالوا: أحببت أنك منطلق إلا أنها تخالف كرهت وسائر الأفعال لأنها لا تطلب إلا الحديث خاصة ولا تتعلق إلا به فمن، ثم قالوا: علمت زيدًا منطلقًا وزيد، علمت منطلق ولم يقولوا كرهت زيدًا أخاك لأنه لا متعلق لكرهت وسائر الأفعال بالحديث، إنما متعلقها الأسماء إلا أن يمنعها من العمل من الأسماء مانع فتصير متعلقة بالحديث فافهمه.
فصل: العامل في قولك لو أنك ذاهب فعلت
فإن قيل: فما العامل في هذا الحديث المؤكد بأن من قولك: لو أنك ذاهب فعلت لا سيما ولو لا يقع بعدها إلا الفعل. ولا فعل ههنا فما موضع إن وما بعدها؟
فالجواب: أن إن في معنى التأكيد وهو تحقيق وتثبيت، فذلك المعنى الذي هو التحقيق اكتفت به لو حتى كأنه فعل وليها، ثم عمل ذلك المعنى في الحديث، كأنك قلت: لو ثبت أنك منطلق فصارت إن كأنها من جهة اللفظ عاملة في الاسم الذي هو لفظ. ومن جهة المعنى عاملة في المعنى الذي هو الحديث.
فإن قيل: ألم يتقدم أنه لا يعمل عامل معنوي في معمول معنوي؟
قيل: هذا في الابتداء حيث لا لفظ يسد مسد العامل اللفظي. فأما ههنا فلو لشدة مقارنتها للفعل وطلبها له تقوم مقام اللفظ، فالعامل الذي هو التحقيق والتثبيت اللتي دلت عليه إن بمعناها، ومن ثم عمل حرف النفي المركب مع لو من قولك: لولا زيد عمل المصدر فصار زيد فاعلًا بذلك المعنى حتى كأنك قلت: لو عدم زيد وفقد وغاب لكان كذا وكذا، ولولا مقارنة لو لهذا الحرف لما جاز هذا، لأن الحروف لا تعمل معانيها في الأسماء أصلًا. فالعامل في هذا الاسم الذي بعد لو كالعامل في هذا الاسم الذي هو الحديث من قولك: لو أنك ذاهب لفعلت كذا.
وأما اختصاص لا بالتركيب معها في باب لولا زيد لزرتك، فلأن لا قد تكون منفردة معنى عن الفعل إذا قيل لك: هل قام زيد؟ فتقول لا، فقد أخبرت عنه بالقعود. وإذا قيل هل قعد؟ قلت: لا فكأنك مخبر بالقيام وليس شيء من حروف النفي يكتفي به في الجواب حتى يكون بمنزلة الإخبار إلا هذا الحرف. فمن ثم صلح للاعتماد عليه في هذا الباب وساغ تركيبه مع حرف لا يطلب إلا الفعل فصارت الكلمة بأسرها بمنزلة حرف وفعل. وصار زيد بعدها بمنزلة الفاعل، ولذلك قال سيبويه: إنه مبني على لولا وهذا هو الحق، لأن ما يهذون به من أنه مبتدأ وخبره محذوف لا يظهر وخامل لا يذكر هذا الفصل كله كلام السهيلي إلى آخره.
فائدة: الاقتصار على المفعول الأول من باب أعلمت
قول سيبويه: لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول من باب أعلمت تأوله أصحابه بمعنى لا يحسن الاقتصار عليه. قالوا: لأنه هو الفاعل في المعنى فإنه هو علم ما أعلمته به من كون زيد قائمًا قالوا: والفاعل يجوز الاقتصار عليه لتمام الكلام به. فهكذا ما في معناه بخلاف المفعول الأول من باب علمت فإنه ليس فاعلًا لفظلًا ولا معنى. هذا تقرير قولهم. وقول إمام النحو هو الصواب؛ ولا حاجة إلى تأويله هذا التأويل البارد.
وممن أنكر هذا التأويل السهيلي وقال: عندي أن قول سيبويه محمول على الظاهر، لأنك لا تريد بقولك أعلمت زيدًا. أي جعلته عالمًا على الإطلاق هذا محال، إنما تريد أعلمته بهذا الحديث. فلا بد إذًا من ذكر الحديث الذي أعلمته به.
فإن قيل: فهل يجوز أظننت زيدًا عمرًا قائمًا؟
قيل: الصحيح امتناعه، لأن الظن إن كان بعد علم ضروري فمحال أن ينقلب ظنًا. وإن كان بعد علم نظري لم يرجع العالم إلى الظن إلا بعد النسيان والذهول عن ركن من أركان النظر. وهذا ليس من فعلك أنت به فلا تقول: أظننته بعد إن كان عالمًا. وإن كان قبل الظن شاكًا، أو جاهلًا، أو عاقلًا لم يتصور أيضا أن تقول أظننته، لأن الظن لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خبر صادق يخبره به كما يكون العلم، لأن الدليل لا يقتضي ظنًا، ولا يقتضي أيضا شبهة. كما بينه الأصوليون فثبت أن الظن لا تفعله أنت به، ولا تفعل شيئًا من أسبابه، فلم يجز أظننته أي جعلته ظانًا، وكذلك يمتنع أشككته أي جعلته شكًا، ولكنهم يقولون: شككته إذا جذبته بحديث يصرفه عن حال الظن إلى حال الشك.
هذا كلام السهيلي. وليس الأمر كما قال ولا فرق بين أعلمته وأظننته إلا من جهة السماع.
وأما الجواب عما ذكرناه فيقال: ما المانع أن يكون أظننته أي جعلته ظانًا بعد أن كان جاهلًا أو شاكًا مما ذكرته له من الأمارات والأدلة الظنية. وقولك: إن الظن لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خبر صادق يخبر به دعوى مجردة بل ظاهرة البطلان. فإن الظن هو الرجحان. فإذا ذكرت له أمارة ظاهرة لا توجب اليقين أفادته الرجحان وهو الظن، وهذا كما إذا أخبرك من يثير خبره لك ظنًا راجحًا ولا ينتهي إلى قطع، كالشاهد وغيره، فدعوى أن الظن لا يكون عن دليل دعوى باطلة. وإن أردت أنه لا يكون عن دليل قاطع لم يفدك شيئًا فإنه يكون عن إمارة تحصل له. ولا يلزم من كون الدليل لا يقتضي الظن إلا تقتضيه الإمارة.
وقوله: فثبت أن الظن لا تفعله أنت، ولا تفعل شيئًا من أسبابه - يقال: وكذلك العلم لم تفعله أنت به، ولا شيئًا من أسبابه إن أردت أنك لم تحدثه فيه، وإن أردت أنك لم تتسبب إلى حصوله فيه فباطل، فإن ذكر الأمارات والأدلة الظنية سبب إلى حصول الظن له. وهذا أظهر من أن يحتاج إلى تقريره ويدل عليه. قولهم شككته. فإن معناه أحدثت له شكًا بما ذكرته له من الأمور التي تستلزم شكه.
فائدة: الفعل الذي يطلب مفعولا ولا يصل إليه بنفسه
كل فعل يقتضي مفعولًا ويطلبه ولا يصل إليه بنفسه. توصلوا إليه بأداة وهي حرف الجر، ثم أنهم قد يحذفون الحرف لتضمن الفعل معنى فعل متعد بنفسه كما تقدم.
لكن هنا دقيقة ينبغي التفطن لها وهي أنه قد يتعدى الفعل بنفسه إلى مفعول وإلى آخر بحرف الجر، ثم يحذف المفعول الذي وصل إليه بنفسه لعلم السامع به، ويبقى الذي وصل إليه بحرف الجر كما قالوا: نصحت لزيد وكلت له ووزنت له وشكرت له. المفعول في هذا كله محذوف والفعل واصل إلى الآخر بحرف الجر ولا يسمع قولهم أربعة أفعال تتعدى بنفسها تارة، وبحرف الجر أخرى، ويذكرون هذه فإنه كلام مجرد عن تحقيق بل المفعول في الحقيقة محذوف. فإن قولك: نصحت له مأخوذ من نصح الخياط الثوب إذا أصلحه وضم بعضه إلى بعض. ثم استعير في الرأي فقالوا: نصحت له أي نصحت له رأيه أي أخلصته له وأصلحته.
والتوبة النصوح إنما هي من هذا، فإن الذنب يمزق الدين، فالتوبة النصوح بمنزلة نصح الخياط الثوب إذا أصلحه وضم أجزاءه ويقولون: نصحت زيدًا فيسقطون الحرف، لأن النصيحة إرشاد فكأنك قلت: أرشدته وكذلك شكرت، إنما هو تفخيم للفعل وتعظيم له من شكر بطنه إذا امتلأ. فالأصل شكرت لزيد إحسانه وفعله، ثم تحذف المفعول فتقول: شكرت لزيد ثم تحذف الحرف، لأن شكرت متضمنة لحمدت أو مدحت.
وأما كلت لزيد ووزنت له فمفعولهما غير زيد، لأن مطلوبهما ما يكال أو يوزن فالأصل دخول اللام، ثم قد يحذف لزيادة فائدة، لأن كيل الطعام ووزنه يتضمن معنى المبايعة والمقاوضة إلا مع حرف اللام، فإن قلت: كلت لزيد اخبرت بكيل الطعام خاصة. وإذا قلت: كلت زيدًا فقد أخبرت بمعاملته ومبايعته مع الكيل كأنك قلت: بايعته بالكيل والوزن. قال تعالى: { وإذا كالوهم أو وزنوهم } [120] أي بايعوهم كيلًا أو وزنًا.
وأما قوله: { اكتالوا على الناس } [121] فإنما دخلت على لتؤذن أن الكيل على البائع للمشتري ودخلت التاء في اكتالوا، لأن افتعل في هذا الباب كله للأخذ، لأنها زيادة على الحروف الأصلية تؤذن بمعنى زائد على معنى الكلمة، لأن الآخذ للشيء كالمبتاع والمكتال والمشتري. ونحو ذلك يدخل فعله من التناول والاجترار إلى نفسه والاحتمال إلى رحله ما لا يدخل فعل المعطي والمبايع. ولهذا قال سبحانه: { لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت }، [122] يعني من السيئات، لأن الذنوب يوصل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوى والحسنة تنال بهبة الله من غير واسطة شهوة، ولا إغراء عدو، فهذا الفرق بينهما على ما قاله السهيلي.
وفيه فرق أحسن من هذا، وهو أن الاكتساب يستدعي التعمل والمحاولة والمعاناة فلم يجعل على العبد إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمله. وأما الكسب فيحصل بأدنى ملابسة حتى بالهم بالحسنة ونحو ذلك فخص الشر بالاكتساب والخير بأعم منه. ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح: «إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها وإن هم بسيئة فلا تكتبوها». وأما حديث الواسطة وعدمها فضعيف، لأن الخير أيضا بواسطة الرسول والملك والإلهام والتوفيق. فهذا في مقابلة وسائط الشر فالفرق ما ذكرناه. والله أعلم.
فصل: سمع الله لمن حمده
وأما سمع الله لمن حمده، فقال السهيلي: مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام على بابها إلا أنها تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهي الاستجابة لمن حمده وهذا مثل قوله: عسى أن يكون ردف لكم ليست اللام لام المفعول كما زعموا، ولا هي زائدة، ولكن ردف فعل متعد ومعموله غير هذا الاسم كما كان مفعول سمع غير المجرور، ومعنى ردف تبع وجاء على الأثر فلو حملته على الاسم المجرور لكان المعنى غير صحيح إذا تأملته، ولكن المعنى ردف لكم استعجالكم وقولكم لأنهم قالوا: متى هذا الوعد، ثم حذف المفعول الذي هو القول والاستعجال اتكال على فهم السامع ودلت اللام على الحذف لمنعها الاسم الذي دخلت عليه أن يكون مفعولًا، وآذنت أيضا بفائدة أخرى وهي معنى عجل لكم. فهي متعلقة بهذا المعنى فصار معنى الكلام. قل: عسى أن يكون عجل لكم بعض الذي تستعجلون فردف قولكم واستعجل لكم. فدلت ردف على أنهم قالوا: واستعجلوا ودلت اللام على المعنى الآخر فانتظم الكلام أحسن انتظام واجتمع الإيجاز مع التمام.
قلت: فعل السمع يراد به أربعة معان:
أحدها: سمع إدراك ومتعلقه الأصوات.
الثاني: سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني.
الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سأل.
الرابع: سمع قبول وانقياد.
فمن الأول: { سمع الله قول التي تجادلك في زوجها }، [123] { قد سمع الله قول الذين قالوا }، [124] ومن الثاني قوله: { لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا }، [125] ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل. ومنه سمعنا وأطعنا، ومن الثالث سمع الله لمن حمده، وفي الدعاء المأثور اللهم اسمع أي أجب واعط ما سألتك. ومن الرابع قوله تعالى: { سماعون للكذب } [126] أي قابلون له ومنقادون غير منكرين له. ومنه على أصح القولين { وفيكم سماعون لهم }، [127] أي قابلون ومنقادون وقيل: عيون وجواسيس وليس بشيء فإن العيون والجواسيس، إنما تكون بين الفئتين غير المختلطتين فيحتاج إلى الجواسيس والعيون وهذه الآية، إنما هي في حق المنافقين وهم كانوا مختلطين بالصحابة بينهم فلم يكونوا محتاجين إلى عيون وجواسيس. وإذا عرف هذا فسمع الإدراك يتعدى بنفسه، وسمع القبول يتعدى باللازم تارة، وبمن أخرى، وهذا بحسب المعنى. فإذا كان السياق يقتضي القبول عدى بمن، وإذا كان يقتضي الانقياد عدى باللام. وأما سمع الإجابة فيتعدى باللام نحو سمع الله لمن حمده لتضمنه معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. وأما سمع الفهم فيتعدى بنفسه، لأن مضمونه يتعدى بنفسه.
فصل: قولهم قرأت الكتاب واللوح
ومما يتعلق بهذا قولهم: قرأت الكتاب واللوح ونحوهما مما يتعدى بنفسه. وأما قرأت بأم القرآن وقرأت بسورة كذا كقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ففيه نكتة بديعة قل من يتفطن لها وهي أن الفعل إذا عدى بنفسه فقلت: قرأت سورة كذا، اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكر وأما إذا عدى بالباء فمعناه لا صلاة لمن لم يأت بهذا السورة في قراءته، أو في صلاته أي في جملة ما يقرأ به. وهذا لا يعطي الاقتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها معها. وتأمل قوله: في الحديث كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة كيف تجد المعنى أن يقرأ فيما يقرأ به بعد الفاتحة بهذا العدد، وكذلك قوله: قرأ بالأعراف، إنما هي بعد الفاتحة، وكذلك قرأ بسورة ق ونحو هذا. وتأمل كيف لم يأت بالباقي قوله: قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون فقال: قرأ سورة النجم ولم يقل بها لأنه لم يكن في صلاة فقرأها وحدها، وكذلك قوله: قرأ على الجن سورة الرحمن، ولم يقل بسورة الرحمن، وكذلك قرأ على أبي سورة لم يكن ولم يقل بسورة ولم تألت الباء إلا في قراءة في الصلاة كما ذكرت لك. وإن شئت قلت: هو مضمن معنى صلى بسورة كذا وقام بسورة كذا، وعلى هذا فيصح على الإطلاق وإن أتى بها وحدها وهذا أحسن من الأول وعلى هذا فلا يقال: قرأ بسورة كذا. إذا قرأها خارج الصلاة وألفاظ الحديث تتنزل على هذا فتدبرها.
فصل: كفى بالله شهيدا
وأما كفى بالله شهيدًا. فالباء متعلقة بما تضمنه الخبر عن معنى الأمر بالاكتفاء، لأنك إذا قلت: كفى بالله أو كفاك الله زيدًا، فإنما تريد أن يكتفي هو به. فصار اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر فدخلت الباء لهذا السبب. فليست زائدة في الحقيقة، وإنما هي كقولك حسبك بزيد، ألا ترى أن حسبك مبتدأ وله خبر. ومع هذا فقد يجزم الفعل في جوابه فتقول: حسبك يتم الناس فيتم جزم على جواب الأمر الذي في ضمن الكلام. حكى هذا سيبويه عن العرب.
فائدة: تعدي الفعل إلى المصدر
تعدي الفعل إلى المصدر على ثلاثة أنحاء: أحدها: أن يكون مفعولًا مطلقًا لبيان النوع؛ الثاني: أن يكون توكيدًا؛ الثالث: أن يكون حالًا.
قال سيبويه: وإنما تذكره لتبين أي فعل فعلت أو توكيدًا. وأما الحال فنحو جاء زيد مشيًا وسعيًا تريد ماشيًا وساعيًا وفيه قولان: أحدهما هذا. والثاني: أن الحال محذوف ومشيًا معمولها أي يمشي مشيًا، وقد تقول: مشيت ماشيًا وقعدت قاعدًا تجعلها حالًا مؤكدة. وقد تقول: مشيت مشيًا بطيئًا ومسرعًا فلك فيها وجهان: أحدهما: أن يكون المصدر حالًا فيكون من باب قوله تعالى: { لسانًا عربيًا }، [128] وهي الحال الموطئة، لأن الصفة وطأت الاسم الجامد أن يكون حالًا. فإن حذفت الاسم وبقيت الصفة وحدها لم يكن في الحال إشكال. نحو سرت شديدًا.
ويبين ما قلناه إن قولك سرت شديدًا هي حال من المصدر الذي دل عليه الفعل. فإذا أردت بالمصدر هذا المعنى كان بمنزلة الحال. ويجوز تقديمه وتأخيره. إذا كان مفعولًا مطلقًا، أو حالًا، ولا يجوز تقديمه على الفعل إذا كان توكيدًا له، لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد. والعامل فيه، إذا أردت معنى الحال الفعل نفسه. والعامل فيه إذا كان مفعولًا مطلقًا ليس هو لفظ الفعل بنفسه، وإنما هو ما يتضمنه من معنى فعل الذي هو فاء وعين ولام، لأنك إذا قلت: ضربًا فالضرب ليس بمضروب ولكنك حين قلت: ضربت تضمن ضربت معنى فعلت، لأن كل ضرب فعل وليس كل فعل ضربًا فصار هذا بمنزلة تضمن الإنسان الحيوان. وإذا كان كذلك فضربًا منصوب بفعلت المدلول عليها بضربت حتى كأنك قلت: فعلت ضربًا. ولا يكون المصدر مفعولًا مطلقًا بل يكون منعوتًا أو في حكم المنعوت، وإنما يكون توكيدًا للفعل، لأن الفعل يدل عليه دلالة مطلقة ولا يدل عليه محدودًا ولا منعوتًا، وقد يكون مفعولًا مطلقا وليس، ثم نعت في اللفظ إذا كان في حكم المنعوت كأنك تريد ضربًا تامًا فلا يكون حينئذ توكيدًا إذ لا يؤكد الشيء بما فيه معنى زائد على معناه، لأن التوكيد تكرار محض.
وقد احتج بعض أهل السنة على القائلين من المعتزلة بأن تكليم الله لموسى مجاز بقوله: { وكلم الله موسى تكليما } [129] فأكد الفعل بالمصدر ولا يصح المجاز مع التوكيد. قال السهيلي: فذاكرت بها شيخنا أبا الحسن فقال: هذا حسن لولا أن سيبويه أجاز في مثل هذا أن يكون مفعولًا مطلقًا وإن لم يكن منعوتًا في اللفظ. فيحتمل على هذا أن يريد تكليمًا ما فلا يكون في الآية حجة قاطعة والحجاج عليهم كثيرة.
قلت: وهذا ليس بشيء والآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاء، فإنه ذكر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك، ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص وهو كلم تكليمًا، ورفع توهم إرادة التكليم العام عن الفعل بتأكيده بالمصدر، وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكليم. ولو كان المراد تكليمًا ما لكان مساويًا لما تقدم من الوحي أو دونه وهو باطل. وأيضا فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة الكلام والتكليم فعلًا ومصدرًا ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق فتأمله. وأيضا فإن الله سبحانه قال لموسى: { إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي } [130] فلو كان التكليم الذي حصل له تكليمًا ما كان مشاركًا لسائر الأنبياء فيه فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى. وأيضا فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته وإن نوعًا من أنواع التكليم حصل له وهذا محال ههنا فإن الإلهام تكليم ما ولهذا سماه الله تعالى وحيًا والوحي تكليم ما فقال: { وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه }، [131] { وإذ أوحيت إلى الحواريين }، [132] ونظائره. وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه. هذه الأنواع تسمى تكليمًا ما. وقد خص الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر بكلامه له. وأيضا فإن الله سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم الخاص دون الاسم العام كقوله: { ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني }، [133] ذكر تكليمه له بأخص من ذلك وهو تكليم خاص كقوله: { وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيًا }، [134] فناداه وناجاه، والنداء والنجاء أخص من التكليم، لأنه تكليم خاص، فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى والنجاء تكليم من القرب. وأيضا فإنه اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على ما ذكره وهو أنه ذكر الوحي المشترك، ثم ذكر عموم الأنبياء بعد محمد ونوح، ثم ذكر موسى بعينه بعد ذكر النبيين عمومًا، ثم ذكر خصوص تكليمه، ثم أكده بالمصدر وكل من له أدنى ذوق في الألفاظ ودلالتها على معانيها يجزم بأن هذا السياق يقتضي تخصيص موسى بتكليم لم يحصل لغيره. وأنه ليس تكليمًا ما. فما ذكره أبو الحسن غير حسن بل باطل قطعًا والذي غره ما اختاره سيبويه من حذف صفة المصدر وإرادتها، وسيبويه لم يذكر هذا في كل مصدر كان هذا شأنه، وإنما ذكر أن هذا مما يسوغ في الجملة، فإذا كان في الكلام ما يدل على إرادة التأكيد دون الصفة لم يقل سيبويه ولا أحد أنه موصوف محذوف يدل على تقليله كما إذا قيل: صدقت الرسول تصديقًا وآمنت به إيمانًا. أو قيل: قاتل فلان مع رسول الله ﷺ قتالًا ونصره نصرًا وبين الرسول لأمته تبيينًا وأرشدهم إرشادًا وهداهم هدى فهل يقول سيبويه أو أحد أن هذا يجوز أن يكون موصوفًا. والمراد تصديقًا وإيمانًا ما وتبيينًا ما وهدى ما. فهكذا الآية والله الموفق للصواب.
قال السهيلي: وسألته عن العامل في المصدر إذا كان توكيدًا للفعل. والتوكيد لا يعمل فيه المؤكد إذ هو هو في المعنى فما العامل فيه؟
فسكت قليلًا، ثم قال ما سألني عنه أحد قبلك وأرى أن العامل فيه ما كان يعمل في الفعل قبله، لو كان اسمًا لأنه لو كان اسمًا لكان منصوبًا بفعلت المتضمنة فيه، ثم عرضت كلامه على نفسي وتأملت الكتاب. فإذا هو قد ذهل عما لوح إليه سيبويه في باب المصادر بل صرح، وذلك أنه جعل المصدر المؤكد منصوبًا بفعل هو التوكيد على الحقيقة واختزل ذلك الفعل وسد المصدر الذي هو معموله مسده. كما سدت إياك وزيدًا مسد العامل فيهما فصار التقدير ضربت ضربت ضربًا. فضربت الثانية هي التوكيد على الحقيقة وقد سد ضربًا مسدها وهو معمولها، وإنما يقدر عملها فيه على أنه مفعول مطلق لا توكيد. هذا معنى قول صاحب الكتاب مع زيادة شرح. ومن تأمله هناك وجده كذلك.
والذي أقول به الآن قول الشيخ أبي الحسن لأن الفعل المختزل معنى والمعانى لا يؤكد بها، إنما يؤكد بالألفاظ وقولك: ضربت فعل مشتق من المصدر فهو يدل عليه فكأنك قلت: فعلت الضرب. فضربت يتضمن المصدر ولذلك تضمره فتقول: من كذب فهو شر له وتقيده بالحال. نحو قمنا سريعًا فسريعًا حال من القيام. فكما جاز أن تقيده بالحال وأن تكنى عنه. جاز أيضا أن تؤكده بضربًا كأنك قلت: ضربًا ضربًا أو نصب ضربًا المتضمن ضربًا المصرح به وبه يعمل في الثاني يعني فعلت كما كان ذلك في المفعول المطلق. إذا قلت: ضربت ضربًا شديدًا أي فعلت ضربًا شديدًا وليس المؤكد كذلك، إنما ينتصب كما ينتصب زيد الثاني في قولك: ضربت زيدًا زيدًا مكررًا انتصب من حيث كان هو الأول لا أنك أضمرت له فعلًا، فتأمله. تم كلامه.
ثم قال:
فصل فيما يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكد
قد أشرنا إلى أن الفعل قسمان: خاص وعام، فالعام فعلت وعملت وفعلت أعم، لأن عملت عبارة عن حركات الجوارح الظاهرة مع دؤب. ولذلك جاء على وزن فعل كتعب ونصب، ومن ثم لم تجدها يخبر بها عن الله سبحانه إلا أن يراد بها سمع فيحمل على المجاز المحض ويلتمس له التأويل.
قلت: وقد ورد قوله تعالى: { أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًا }، [135] وقد تقدم له كلام أن اليد صفة أخص من القدرة والنعمة كما هو مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله ونصر ذلك المذهب وارتضاه، وعلى هذا فلا تأويل في الآية، بل هي على حقيقتها على قوله. وأما الدؤب والنصب وإثبات الجارحة فمن خصائص العبد والله تعالى منزه عن ذلك متعال عنه. وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لرب العالمين. بل الصفة المضافة إلى الله لا يلحقه فيها شيء من خصائصهم، فإثباتها له كذلك يحتاج معه إلى تأويل فإن الله ليس كمثله شيء. وقد تقدم أن خصائص المخلوقين غير داخلة في الاسم العام فضلًا عن دخولها في الاسم الخاص المضاف إلى الرب تعالى، وأنها لا يدل اللفظ عليها بوضعه حتى يكون نفيها عن الرب تعالى صرفًا للفظ عن حقيقته. ومن اغتفر دخولها في الاسم المضاف إلى الرب، ثم توسل بذلك إلى نفي الصفة عنه. فقد جمع بين التشبيه والتعطيل. وأما من لم يدخلها في مسمى اللفظ الخاص ولا أثبتها للموصوف. فقوله محض التنزيه وإثبات ما أثبت الله لنفسه. فتأمل هذه النكتة ولتكن منك على ذكر في باب الأسماء والصفات فإنها تزيل عنك الاضطراب والشبهة والله الموفق للصواب.
عاد كلامه، قال: إذا ثبت هذا ففعلت وما كان نحوها من الأحداث العامة الشائعة لا تؤكد بمصدر، لأنها في الأفعال بمنزلة شيء وجسم في الأسماء فلا يؤكد، لأنه لم يثبت له حقيقة معينة عند المخاطب، وإنما يؤكد ما ثبت حقيقة والمخاطب أحوج إلى ذكر المفعول المطلق الذي تقع الفائدة منه إلى توكيد فعلت فلو قلت له: فعلت فعلت وأكدته بغاية ما يمكن من التوكيد ما كان الكلام إلا غير مفيد، وكذلك لو قال: فعلت فعلًا على التوكيد، لأن المصدر الذي كنت تؤكد به، لو أكدت قياسه أن يكون مفتوح الفاء، لأنه ثلاثي والمصدر الثلاثي قياسه فتح فائه، كما أن فعله كذلك.
قلت: هذا ليس على اطلاقه. فإن فعلت إذا أريد بها الفعل العام لم تتحصل حقيقته عند المخاطب امتنع تأكيدها. بل مثل هذا لا يقع في التخاطب، وأما إذا أريد بها فعل خاص قد تحصلت حقيقته وتميزت عندهما، كما إذا قال له: أنت فعلت هذا وأشار إلى فعل معين. فإنه إذا أكد الفعل وقال: فعلت فعلت كان الكلام مفيدًا أبلغ فائدة. وهذا إنما جاء من حيث كانت فعلت مرادًا بها الحدث الخاص. وأكثر ما يجيء فعلت في الخطاب، كذلك فتأمله.
قال: إذا ثبت هذا فلا يقع بعد فعلت إلا مفعول مطلق إما من لفظها فيكون عامًا نحو فعلت فعلًا حسنًا. ومن ثم جاء مكسور الفاء، لأنه كالطحن والذبح ليس بمصدر اشتق منه الفعل، بل هو مشتق من فعلت. وإما أن يكون خاصًا نحو فعلت ضربًا. فضربًا أيضا مفعول مطلق من غير لفظ فعل، فصار فعلت فعلًا كطحنت طحنًا وفعلت ضربًا كطحنت دقيقًا.
فإن قيل: ألم يجيزوا في ضربت ضربًا وقتلت قتلًا أن يكون مفعولًا مطلقًا فلم لم يكن مكسور الأول إذا كان مفعولًا مطلقًا، ومفتوحًا إذا كان مصدرًا مؤكدًا؟
قيل: "حدِّث حديثين امرأةً"، ألم يقدم في أول الفائدة أنه لا يعمل في ضربًا إذا كان مفعولًا مطلقًا؟ إلا معنى فعلت لا لفظ ضربت، فلو عمل فيه لفظ ضربت لقلت، ضربًا بالكسر كطحن وهو محال، لأن الضرب لا يضرب. ولكنك إذا شققت له اسمًا من فعلت التي هي عاملة فيه على الحقيقة فقلت هو فعل وإن شققت له اسمًا من ضربت التي لا يعمل لفظها فيه لم يجز أن يجعلها كالطحن والذبح، لأن الاسم القابل لصورة الفعل. إنما يشتق لفظه من لفظ ما عمل فيه. فثبت من هذا كله إن فعلت وعملت استغنى بمفعولها المطلق عن مصدرها، لأنها لا تتعدى إلا إلى حدث وذلك الحدث يشتق له اسم من لفظها فيجتمع اللفظ والمعنى ويكون أقوى عند المخاطب من المصدر الذي يشتق منه الفعل. ولذلك لم يقولوا: صنعت صنعًا بفتح الصاد، ولا عملت عملًا بسكون الميم، ولا فعلت فعلًا، بفتح الفاء استغناء عن المصادر بالمفعولات المطلقة، لأن العمل مثل القصص والنغص والصنع مثل الدهن والخبز والفعل مثل الطحن وكلها بمعنى المفعول لا بمعنى المصدر الذي اشتق منه الفعل.
وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدى إلى الجواهر والأجسام إلا أن يخبر بها عن خالقها. وإنما تتعدى إلى الجواهر بعض الأفعال الخاصة نحو ضربت زيدًا فهو مضروب على الإطلاق وإن اشتق له من لفظ فعلت مفعول به أي فعل به الضرب، ولم يفعل هو جاز.
وأما حلمت في النوم حلمًا فهو بمنزلة فعلت وصنعت في اليقظة، لأن جميع أفعال النوم تشتمل عليها حلمت وكان جميع أفعال اليقظة يشتمل عليها فعلت، فمن ثم لم يقولوا حلمًا بوزن ضربًا، لأن حلمت مغنية عن المصدر كما كانت فعلت مغنية عنه. وإنما مطلوب المخاطب معرفة المحلوم والمفعول، فلذلك قالوا: حلمًا ولذلك جمعوه على أحلام وحلوم، لأن الأسماء هي التي تجمع وتثنى. وأما الفعل أو ما فائدته كفائدة الفعل من المصادر فلا يجمع ولا يثنى. وقولهم: إنما جمعت الحلوم والأشغال لاختلاف الأنواع. بل يقال لهم: (وهل) اختلفت الأنواع إلا من حيث كانت بمثابة الأسماء المفعولة؟ ألا ترى أن الشغل على وزن فعل كالدهن هو عبارة عما يشتغل المرء عنه. فهو اسم مشتق من الفعل وليس الفعل مشتقًا منه. إنما هو مشتق من الشغل والشغل هو المصدر كما أن الجعل كذلك. فعلى هذا ليس الأشغال والأحلام بجمع المصدر. وإنما هو جمع اسم والمصدر على الحقيقة لا يجمع، لأن المصادر كلها جنس واحد من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل، والحركة تماثل الحركة، ولا تخالفها بذاتها. ولولا هاء التأنيث في الحركة ما ساغ جمعها فلو نطقت العرب بمصدر حلمت الذي استغنى عنه بالحلم وبمصدر شكرت الذي استغني عنه بالشكر لما جاز جمعه، لأن اختلاف الأنواع ليس راجعًا إليه وإنما هو راجع إلى المفعول المطلق ألا ترى أن الشكر عبارة عما يكافأ به المنعم من ثناء أو فعل، وكذلك نقيضه وهو الكفر عبارة عما يقابل به المنعم من جحد وقبح فعل فهو مفعول مطلق لا مصدر اشتق منه الفعل إلا أن الكفر يتعدى بالباء لتضمنه معنى التكذيب، وشكرت يتعدى باللام التي هي لام الإضافة، لأن المشكور في الحقيقة هي النعمة وهي مضافة إلى المنعم، وكذلك المكفور في الحقيقة هي النعمة. لكن كفرها تكذيب وجحد، فلذلك قالوا: كفر بالله وكفر نعمته وشكر له وشكر نعمته. وإذا ثبت أن الشكر من قولك شكرت شكرًا مفعول مطلق وهو مختلف الأنواع، لأن مكافأة النعم تختلف جاز أن يجمع، كما جمع الحلم والشغل، فيحتمل قوله سبحانه حكاية عن المخلصين من عباده: { لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا }، [136] أن يكون جمعًا لشكر وليس كالقعود والجلوس، لأنه متعد. ومصدر المتعدي لا يجيء على الفعول.
قلت: الصحيح أنه مصدر جاء على الفعول، لأن مقابله وهو الكفر والجحد والنفار تجيء مصادرها على الفعول نحو كفور وجحود ونفور، ويبعد كل البعد أن يراد بالكفور جمع الكفر والكفر لا يعهد جمعه في القرآن قط ولا في الاستعمال. فلا يعرف في التخاطب أكفار وكفور، وإنما المعروف الكفر والكفران. والكفور مصادر ليس إلا فحسن مجيء الشكور على الفعول حمله على مقابله وهو كثير في اللغة، وقد تقدم الإشارة إليه وحتى لو كان الشكور سائغًا استعماله جمعًا واحتمل الجمع والمصدر لكان الأليق بمعنى الآية المصدر لا الجمع، لأن الله تعالى وصفهم بالإخلاص، وإنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه ولم يريدوا من المطعمين جزاءً ولا شكورًا، ولا يليق بهذا الموضع أن يقول: لا نريد منكم أنواعًا من الشكر وأصنافًا منه. بل الأليق بهم وبإخلاصهم أن يقولوا: لا نريد منكم شكرًا أصلًا فينفوا إرادة نفس هذه الماهية منهم وهو أبلغ في قصد الإخلاص من نفي الأنواع فتأمله، فإنه ظاهر فلا يليق بالآية إلا المصدر. وكذلك قوله تعالى: { لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا }، [137] إنما هو مصدر وليس بالمعهود البين جمع الشكر على الشكور واستعماله كذلك. كما لم يعهد ذلك في الكفور.
عاد كلامه، قال ويزيد هذا وضوحًا قولهم: أحببت حبًا. فالحب ليس بمصدر لأحببت. إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب. ولذلك جاء على وزنه مضموم الأول، ومن ثم جمع كما يجمع الشغل قال:
ثلاثة أحباب فحب علاقة ** وحب تملاق وحب هو القتل
فقد انكشف لك بقولهم أحببت حبًا ولم يقولوا: إحبابًا استغناء بالمفعول المطلق الذي هو أفيد عند المخاطب من الأحباب. أن حلمت حلمًا وشكرت شكرًا وكفر كفرًا وصنع صنعًا كلها واقعة على ما هو اسم للشيء المفعول وناصب له نصب المفعول المطلق. وهو في هذه الأفعال أجدر أن يكون كذلك، لأنها أعم من أحببت إذ الشكر واقع على أشياء مختلفة، وكذلك الكفر والشغل والحلم، وكلما كان الفعل أعم وأشيع لم يكن لذكر مصدره معنى وكان فعل ويفعل مغنيًا عنه. ولولا كشف الشاعر لاختلاف أنواع الحب ما كدنا نعرف ما فيه من العموم وإنه في معنى الشغل صار أحببت كشغلت وصار الحب كالشغل. ولو قال: أحبابًا لكان بمنزلة شغلت شغلًا بفتح الشين ألا ترى أنهم لا يجمعون من المصادر ما كان على وزن الأفعال. نحو الإكرام. وعلى وزن الإنفعال والافتعال والفعل ونحوها إلا أن يكون محدودًا كالتمرة من التمر.
وأما جمعه لاختلاف الأنواع فلا اختلاف للأنواع فيه، إنما اختلاف الأنواع فيما كان اسمًا مشتقًا من الفعل استغنى به عن المصدر لخصوصه وعموم المصدر. وذلك لا تجده في الثلاثي إلا على وزن فعل وفعل. ألا ترى أنهم لا يجمعون نحو الحذر والرمد والخدر والخفس والبرص والعمى وبابه.
قلت: فعل الحب فيه لغتان فعل وأفعل، وقد أنشدوا في الصحاح بيتين على اللغتين وهما:
أحب أبا مروان من أجل تمره ** وأعلم أن الحب بالمرء أرفق
ووالله لولا تمره ما حببته ** وكان عياض منه أدنى ومشرق
هكذا أنشده المبرد. والذي في الصحاح: * ولا كان أدنى من عبيد ومشرق * بالاقواء. [138] والبيتان لغيلان بن شجاع النهشلي وهو عربي فصيح. وإذا ثبت أنهما لغتان في أحببته حبًا فأنا له محب وهو محبوب على تداخل اللغتين فأتوا في المصدر بمصدر الثلاثي كالشكر والشغل، واستعملوا من الفعلين الرباعي في غالب كلامهم حتى كأنهم هجروا الثلاثي وأتوا بمصدره حتى كأنهم هجروا الرباعي، فلما جاؤوا إلى اسم الفاعل أتوا بالاسم من الرباعي حتى كأنهم لم ينطقوا بالثلاثي، فقالوا: محب ولم يقولوا: حاب أصلًا وجاؤوا إلى المفعول فأتوا به من الفعل الثلاثي في الأكثر فقالوا: محبوب، ولم يقولوا محب إلا نادرًا كما قال:
ولقد نزلت فلا تظني غيره ** مني بمنرلة المحب المكرم
هذا من أحببت كما أن المحبوب من حببت ثم استعملوا لفظ الحبيب في المحبوب أكثر من استعمالهم إياه في المحب مع أنه يطلق عليهما، فمن مجيئه بمعنى المفعول قول ابن الدمينة:
وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى ** إلي وإن لم آته لحبيبُ
أي لمحبوب. ومن مجيئه للفاعل قول المجنون:
أتهجر ليلى للفراق حبيبَها ** وما كان نفسًا بالفراق تطيبُ
فهذا بمعنى محبها. وربما قالوا للحبيب: حِبّ مثل خدن. فخِدْن وخَدِين مثل حب وحبيب. وإذا ثبت هذا فقوله هذا رحمه الله: الحب ليس بمصدر لأحببت. إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب ليس الأمر كما قال: بل هي مصدر للثلاثي أجروه على الفعل الرباعي استغناء عن مصدره وهذا لكثرة ولوع أنفسهم بالحب وألسنتهم به، استعملوا منه أخف المصدرين استغناء به عن أثقلهما.
وأما مجيئه بالضم دون الفتح فكثير في ذلك وهو قوة هذا المعنى، وتمكنه من نفس المحب وقهره وإذلاله إياه. حتى إنه ليذل الشجاع الذي لا يذل لأحد فينقهر لمحبوبه ويستأسر له كما هو معروف في أشعارهم ونثرهم، وكما يدل عليه الوجود. فلما كان بهذه المثابة أعطوه أقوى الحركات وهي الضمة. فإن حركة المحب أقوى الحركات فأعطوا أقوى حركات المتحرك أقوى الحركات اللفظية ليتشاكل اللفظ والمعنى. فلهذا عدلوا عن قياس مصدره وهو الحب إلى نضمه.
وأيضا فإنهم كرهوا أن يجيئوا بمصدره على لفظ الحب الذي هو اسم جنس للمحبة ولم يكن بد من عدولهم إما إلى الضم أو إلى الكسر وكان الضم أولى لوجهين. أحدهما: قوته وقوة الحب. الثاني: أن في الضمة مع الجمع ما يوازي ما في معنى الحب من جمع الهمة والإرادة على المحبوب. فكأنهم دلوا السامع بلفظه وحركته وقوته على معناه.
وتأمل كيف أتوأ في هذا المسمى بحرفين أحدهما الحاء التي هي من أقصا الحلق مبدأ الصوت ومخرجها قريب من مخرج الهمزة من أصل المصدر الذي هو معدن الحب وقراره. ثم قرنوها بالباء التي هي من الشفتين وهي آخر مخارج الصوت ونهايته. فجمع الحرفان بداية الصرت ونهايته كما اشتمل معنى الحب على بداية الحركة ونهايتها. فإن بداية حركة المحب من جهة محبوبه ونهايتها إلى الوصول إليه، فاختاروا له حرفين هما بداية الصوت ونهايته، فتأمل هذه النكت البديعة تجدها ألطف من النسيم ولا تعلق إلا بذهن يناسبها لطافة ورقة.
فقل لكثيف الطبع ويحك ليس ذا ** بعشك فادرج سالمًا غير غانم
واشتقاقه في الأصل من الملازمة والثبات من قولهم: أحبَّ البعير فهو محب، إذا برك فلم يثر. قال:
حلت عليه بالقطيع ضربًا ** ضرب بعيرالسوء إذا حبا
فلما كان المحب ملازمًا لذكر محبوبه ثابت القلب على حبه مقيمًا عليه لا يروم عنه انتقالًا، ولا يبغي عنه زوالًا. وقد اتخذ له في سويداء قلبه وطنًا وجعله له سكنًا.
تزول الجبال الراسيات وقلبه ** على العهد لا يلوي ولا يتغير
فلذلك أعطوه هذا الاسم الدال على الثبات واللزوم، ولما جاؤوا إلى المحبوب أعطوه في غالب استعمالهم لفظ فعيل الدال على أن هذا الوصف وهو كون متعلق المحب أمر ثابت له لذاته، وإن لم يحب فهو حبيب سواء أحبه غيره أم لا. وهذا الوزن موضوع في الأصل لهذا المعنى الشريف وإن لم يشرفه غيره وهو من بناء الأوصاف الثابتة اللازمة كطويل وقصير وكريم وعظيم وحليم وجميل وبابه. وهذا بخلاف مفعول، فإن حقيقته لمن تعلق به الفعل ليس إلا مضروب لمن وقع عليه الضرب ومقتول ومأكول وبابه، فهجروا في أكثر كلامهم لفظ محبوب لما يؤذن من أنه الذي تعلق به الحب فقط، واختاروا له لفظ حبيب الدال على أنه حبيب في نفسه تعلق به الحب أم لا، ثم جاؤوا إلى من قام به الحب، فأعطوه لفظة محب دون حاب لوجهين:
أحدهما: أن الأصل هو الرباعي والنطق به أكثر فجاء على الأصل.
الثاني: أن حروفه أكثر من حروف حاب، والمحل محل تكثير لا محل تقليل.
فتأمل هذه المعاني التي لا تجدها في كتاب، وإنما هي روضة أنف منح العزيز الوهاب فهمها وله الحمد والمنة. وقد ذكرنا من هذا وأمثاله في كتاب التحفة المكية ما لو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقه من الاستحسان والمدح ولله الفضل والمنة.
وأما جمع الشاعر له على ثلاثة أحباب فلا يخرجه عن كونه مصدرًا لأنه أراد أن الحب ثلاثة أنواع وثلاثة ضروب وهذا تقسيم للمصدر نفسه وهو تقسيم صحيح فإن للحب بداية وتوسطًا ونهاية فذكر الشاعر الأقسام الثلاثة فحب البداية هو حب العلاقة ويسمى علاقة لتعلق القلب بالمحبوب قال الشاعر:
أعلاقة أم الوليد بعدما ** أفنانُ رأسِكِ كالثَّغام المُخلِس
والحب المتوسط، وهو حب التملق وهو التذلل والتواضع للمحبوب والانكسار له. وتتبع مواقع رضاه وإيقاعها على ألطف الوجوه فهذا هو التملق وهو إنما يكون بعد تعلق القلب به.
والحب الثالث الذي هو يباشر القلب ويصطلم العقل ويذهب اللب ويمنع القرار. وهذه المحبة تنقطع دونها العبارة وتمتنع إليها الإشارة. ولي فيها من أبيات:
وما هي إلا الموتُ أو هو دونها ** وفيها المنايا ينقلبن أمانيا
فقد بان لك أن الشاعر إنما أراد جمع الحب الذي هو المصدر باعتبار أنواعه وضروبه. ولنقطع الكلام في هذه المسألة فمن لم يشبع من هذه الكلمات ففي كتاب التحفة أضعاف ذلك والله الموفق.
عاد كلامه، قال: فإن قيل فقد قالوا: سقم وأسقام، والسقم مصدر سقم فهذا جمع لاختلاف الأنواع، لأنه اسم كما ذكرت.
قيل: هذه غفلة أليس قد قالوا: سقم بضم السين فهو عبارة عن الداء الذي يسقم الإنسان فصار كالدهن والشغل. وهو في ذاته مختلف الأنواع فجمع.
وأما المرض فقد يكون عبارة عن السقم والعلة فيجمع على أمراض، وقد يكون مصدرًا كقولك مرض فلا يجمع.
فإن قيل: تفريقك بين الأمرين دعوى فما دليلها؟
قلنا: قولك عرق يعرق عرقًا لا يخفى على أحد أنه مصدر عرق، والعرق الذي هو جسم سائل مائع سائل من الجسد لا يخفى على أحد أنه غير العرق الذي هو المصدر. وإن كان اللفظ واحدًا، فكذلك المرض يكون عبارة عن المصدر وعبارة عن السقم والعلة. فعلى هذا تقول: تصبب زيد عرقًا فيكون له إعرابان تمييز إذا أردت المائع ومفعول من أجله، أو مصدر مؤكد إذا أردت المصدر. وكذلك دميت أصبعي دمًا إذا أردت المصدر فهي مثل العمى، وإن أردت الشيء المائع. فهو دم مثل يد وقد يسمى المائع بالمصدر قال:
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومُنا ** ولكن على أعقابنا تقطر الدما
فهذا مقصور كالعصا. وعليه قول الآخر: * جرى الدميان بالخبر اليقين *
فصل: توكيد الفعل وتوكيد النكرة
ومن حيث امتنع أن يؤكد الفعل العام بالمصدر لشيوعه، كما يمتنع توكيد النكرة لشيوعها، وأنها لم تثبت لها عين لم يجز أن يخبر عنه، كما لا يخبر عن النكرة لا تقول من فعل: كان شرًا له بخلاف من كذب كان شرًا له، لأن كذب فعل خاص، فجاز الأخبار عما تضمنه من المصدر، ومن ثم لم يقولوا: فعلت سريعًا ولا عملت طويلًا. كما قالوا: سرت سريعًا وجلست طويلًا على الحال من المصدر، كما يكون الحال من الاسم الخاص، ولا يكون من النكرة الشائعة.
فإن قلت: اجعله نعتًا للمفعول المطلق كأنك قلت: فعلت فعلًا سريعًا وعملت عملًا كثيرًا.
قيل: لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت إلا على شروط مذكورة في موضعها فليس قولهم سرت سريعًا نعتًا لمصدر نكرة محذوفة، إنما هو حال من مصدر في حكم المعرفة بدلالة الفعل الخاص عليه. فقد استقام الميسم للناظر في فصول هذه المسألة واستتب القياس فيها من كل وجه.
فإن قيل: فما قولكم في علمت علمًا أليس هو مصدرًا لعلمت فلم جاء مكسور الأول كالطحن والذبح.
قيل: العلم يكون عبارة عن المعلوم كما تقول: قرأت العلم وعبارة عن المصدر نفسه الذي اشتق منه علمت. إلا أن ذلك المصدر مفعول لعلمت، لأنه معلوم بنفس العلم لأنك إذا علمت الشيء فقد علمته، وعلمت أنك علمته بعلم واحد فقد صار العلم معلومًا بنفسه، فلذلك جاء على وزن الطحن والذبح وليس له نظير في الكلام إلا قليل لا اعلم فعلًا يتناول المفعول ويتناول نفسه إلا العلم والكلام، لأنك تقول للمخاطب: تكلم، فيقول: قد تكلمت فيكون صادقًا وإن لم ينطق قبل ذلك ولهذا قال النبي ﷺ للأعرابي: لما قال له: يا ابن عبد المطلب قد أجبتك، وكان قد أجبتك جوابًا وخبرًا عن الجواب. فتناول القول نفسه، ولذلك تعبدنا في التلاوة أن نقول: قل هو الله أحد، لأن قل أمر يتناول ما بعده ويتناول نفسه، فمن ثم جاء مصدر القول على القيل، كما جاء مصدر علمت على العلم، وجاء أيضا على القال وهو على وزن القبض، لأن القول قد يكون مقولًا بنفسه، وجاء أيضا على الأصل مفتوح الأول، وأما العلم فلم يجىء إلا مكسورًا مصدرًا كان أو مفعولًا، لأنه لا يكون أبدًا إلا معلومًا بنفسه، والقول بخلاف ذلك قد يتناول نفسه في بعض الكلام وقد لا يتناول إلا المفعول وهو الأغلب.
وأما الفكر فليس باسم عند سيبويه. ولذلك منع من جمعه. فقال: لا يجمع الفكر على أفكار حمله على المصادر التي لا تجمع. وقد استهوى الخطباء والقصاص خلاف هذا وهو كالعلم لقربه منه في معناه ومشاركته له في محله، وأما الذكر فبمنزلة العلم لأنه نوع منه.
فصل: فيما يحدد من المصادر بالهاء
فيما يحدد من المصادر بالهاء وفيه بقايا من الفصل الأول.
قد تقدم أن الفعل لا يدل على مصدره إلا مطلقًا غير محدد ولا منعوت، وإنك إذا قلت ضربته ضربة. فإنما هو مفعول مطلق لا توكيد، لأن التوكيد لا يكون في معناه زيادة على المؤكد، ومن ثم لا تقول سير بزيد سريعة حسنة تريد سيرة، كذلك ولا قعدت طويلة لأن الفعل لا يدل بلفظه على المرة الواحدة، ومن ثم بطل ما أجازه النحاس وغيره من قوله: زيد ظننتها منطلق تريد الظنة، لأن الفعل لا يدل عليها.
وإذا ثبت هذا فالتحديد في المصادر ليس يطرد في جميعها. ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديد غالبًا، لأنه مضارع للأجناس الظاهرة التي يقع الفرق بين الواحد منه والجنس بهاء التأنيث نحو تمرة وتمر ونخلة ونخل، وكذلك تقول: ضربة وضرب.
وأما ما كان من الأفعال الباطنة نحو علم وحذر وفرق ووجل أو ما كان طبعًا نحو ظرف وشرف لا يقال في شيء من هذا فعلة لا يقال: فهم فهمة، ولا ظرف ظرفة. وكذلك ما كان من الأفعال عبارة عن الكثرة والقلة نحو طال وقصر وكبر وصغر وقل وكثر لا تقول فيه فعلة،
وأما قولهم الكبرة في الهرم. فعبارة عن الصفة وليست بواحدة من الكبر، وكذلك الكثرة ليست كالضربة من الضرب، لأنك لا تقول: كثر كثرا.
وأما حمدًا فما أحسبه يقال في تحديده حمدة، كما يقال مدحة، والفرق بينهما أن حمد يتضمن الثناء مع العلم بما يثنى به فإن تجرد عن العلم كان مدحًا ولم يكن حمدًا فكل حمد مدح دون العكس. ومن حيث كان يتضمن العلم بخصال المحمود جاء فعله على حمد بالكسر موازنًا لعلم ولم يجىء كذلك مدح، فصار المدح في الأفعال الظاهرة كالضرب ونحوه، ومن ثم لم تجد في الكتاب والسنة حمد ربنا فلانًا. ويقول: مدح الله فلانًا وأثنى على فلان ولا تقول: حمد إلا نفسه. ولذلك قال سبحانه: { الحمد لله } بلام الجنس المفيدة للاستغراق، فالحمد كله له إما ملكًا، وإما استحقاقًا، فحمده لنفسه استحقاق وحمد العباد له، وحمد بعضهم لبعض ملك له، فلو حمد هوغيره، لم يسع أن يقال في ذلك: الحمد ملك له، لأن الحمد كلامه، ولم يسغ أن يضاف إليه على جهة الاستحقاق وقد تعلق بغيره.
فإن قيل: أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما علم. فلم لا يجوز أن يسمى حمد؟
قيل: لا يسمى حمدًا على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن على الكمال، وذلك معدوم في غيره سبحانه، فإذا مدح فإنما يمدح بخصلة هي ناقصة في حق العبد وهو أعلم بنقصانها. وإذا حمد نفسه حمد بما علم من كمال صفاته.
قلت: ليس ما ذكره من الفرق بين الحمد والمدح باعتبار العلم وعدمه صحيحًا. فإن كل واحد منهما يتضمن العلم بما يحمد به غيره ويمدحه، فلا يكون مادحًا ولا حامدًا. من لم يعرف صفات المحمود والممدوح. فكيف يصح قوله إن تجرد عن العلم كان مادحًا. بل إن تجرد عن العلم كان كلامًا بغير علم. فإن طابق فصدق وإلا فكذب.
وقوله: ومن ثَم لم يجىء في الكتاب والسنة: حمد ربنا فلانًا، يقال: وأين جاء فيهما مدح الله فلانًا؟ وقد جاء في السنة ما هو أخص من الحمد، وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد كما في قول النبي ﷺ لأهل قباء: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فإذا كان قد أثنى عليهم والثناء حمد متكرر فما يمنع حمده لمن شاء من عباده.
ثم الصحيح في تسمية النبي ﷺ محمدًا أنه الذي يحمده الله وملائكته وعباده المؤمنون. وأما من قال: الذي يحمده أهل السموات وأهل الأرض، فلا ينافي حمد الله تعالى، بل حمد أهل السموات والأرض له بعد حمد الله له؛ فلما حمده الله حمده أهل السموات والأرض.
وبالجملة لما كان الحمد ثناء خاصًا على المحمود لم يمتنع أن يحمد الله من يشاء من خلقه كما يثنى عليه. فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون أخبارًا مجردًا من حب وإرادة أو مقرونًا بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد فالقائل إذا قال: الحمد الله، أو قال: ربنا لك الحمد. تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد.
ولما كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تتقوم حقيقته إلا به فسره من فسره بالرضى والمحبة. وهو تفسير له بجزء مدلوله. بل هو رضاء ومحبة مقارنة للثناء. ولهذا السر والله أعلم. جاء فعله على بناء الطبائع والغرائز فقيل: حمد، لتضمنه الحب الذي هو بالطبائع والسجايا أولى وأحق من فهم وحذر وسقم ونحوه بخلاف الأخبار المجرد عن ذلك وهو المدح. فإنه جاء على وزن فعل فقالوا: مدحه لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع، فتأمل هذه النكتة البديعة، وتأمل الإنشاء الثابت في قولك: ربنا لك الحمد، وقولك: الحمد الله كيف تجده تحت هذه الألفاظ، ولذلك لا يقال موضعها المدح لله، ولا ربنا لك المدح، وسره ما ذكرت لك من الأخبار بمحاسن المحمود اخبارًا مقترنًا بحبه وإرادته وإجلاله وتعظيمه.
فإن قلت: فهذا ينقض قولكم أنه لا يمتنع أن يحمد الله تعالى من شاء من خلقه. فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، ولا يستحق التعظيم غيره، فكيف يعظم أحد من عباده؟
قلت: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله، وكذلك محبة الوالدين والعلماء وملوك العدل، وأما محبة الرب عبده. فإنها تستلزم إعزازه لعبده، وإكرامه إياه، والتنويه بذكره وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه، فهذا المعنى ثابت في محبته. وحمده لعبده سمي تعظيمًا وإجلالًا أو لم يسم، ألا ترى أن محبته سبحانه لرسله كيف اقتضت أن نوه بذكرهم في أهل السماء والأرض، ورفع ذكرهم على ذكر غيرهم، وغضب على من لم يحبهم ويوقرهم ويجلهم، وأحل به أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، وجعل كرامته في الدنيا والآخرة لمحبيهم وأنصارهم وأتباعهم. أو لا ترى كيف أمر عباده وأولياءه بالصلاة التي هي تعظيم وثناء على خاتمهم، وأفضلهم صلوات الله عليه وسلامه. أفليس هذا تعظيمًا لهم وإعزازًا وإكرامًا وتكريمًا.
فإن قيل: فقد ظهر الفرق بين الحمد والمدح. واستبان صبح المعنى وأسفر وجهه. فما الفرق بينهما وبين الثناء والمجد؟
قيل: قد تعدينا طورنا فيما نحن بصدده. ولكن نذكر الفرق تكميلًا للفائدة فنذكر تقسيمًا جامعًا لهذه المعاني الأربعة أعني الحمد والمدح والثناء والمجد. فنقول:
الإخبار عن محاسن الغير له ثلاثة اعتبارات. اعتبار من حيث المخبر به. واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر. واعتبار من حيث حال المخبر، فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد. فإن المخبر به أما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها، أو من أوصاف الجمال والاحسان وتوابعها. فإن كان الأول فهو المجد، وإن كان الثاني فهو الحمد. وهذا، لأن لفظ م ج د في لغتهم يدور على معنى الاتساع والكثرة فمنه قولهم أمجد الدابة علفًا أي أوسعها علفًا، ومنه مجد الرجل فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه إلى الناس. قال الشاعر:
أنت تكون ماجد نبيلُ ** إذا تهبُّ شَمأل بليلُ
ومنه قولهم: في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار، أي كثرت النار فيهما.
ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد. فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو ص لا. فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض ومنه ثنيت الثوب ومنه التثنية في الاسم فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة.
ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد، فإن المخبر عن محاسن الغير أما أن يقترن بإخباره حب له وإجلالًا أو لا. فإن اقترن به الحب فهو الحمد والإ فهو المدح، فحصل هذه الأقسام وميزها، ثم تأمل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه رسول الله ﷺ حين يقول العبد: { الحمد لله رب العالمين } فيقول الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، لأنه كرر حمده، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي فإنه وصفه بالملك والعظمة والجلال.
فاحمد الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عفوًا لم تسهر فيها عينك، ولم يسافر فيها فكرك عن وطنه ولم تتجرد في تحصيلها عن مألوفاتك. بل هي عرائس معان تجلى عليك وتزف إليك فلك لذة التمتع بها، ومهرها على غيرك، لك غنمها وعليه غرمها.
فصل: تثنية المصادر وجمعها
فلنرجع إلى كلامه، قال: وكل ما حدد من المصادر تجوز تثنيته وجمعه وما لم يحدد فعل الأصل الذي تقدم لا يثنى، ولا يجمع وقولهم: إلا أن تختلف أنواعه لا تختلف أنواعه، إلا إذا كان عبارة عن مفعول مطلق اشتق من لفظ الفعل لا عن مصدر اشتق الفعل منه، ولذلك تجده على وزن فعل بالكسر وعلى وزن فعل نحو عمل. والذي هو مصدر حقيقة ما تجده على وزن فعل نحو ضرب وقتل. وأما الشرب بالفتح والضم والكسر فالشرب بالفتح هو المصدر، والشرب بالضم عبارة عن المشروب، أو عن الحدث الذي هو مفعول مطلق في الأصل، وربما اتسع فيه فأجرى مجرى المصدر الذي اشتق الفعل منه كما قال تعالى: { فشاربون شرب الهيم }، [139] بالضم والفتح.
قلت: هذه كبوة من جواد ونبوة من صارم، فإن الشرب بالضم هو المصدر، وأما المشروب فهو الشرب بكسر الشين. قال تعالى في الناقة: { لها شرب ولكم شرب يوم معلوم }، [140] فهذا هو المشروب كما تقول: قسم من الماء وحظ ونصيب تشربه في يومها، ولكم حظ وقسم تستوفونه في يومكم وهذا هو القياس في الباب، كالذبح بمعنى المذبوح، والطحن للمطحون والحب للمحبوب والحمل للمحمول والقسم للمقسوم والعرب للزوجة التي قد عرس بها ونظائره كثيرة جدًا.
وأما الشرب بالفتح فقياسه أن يكون جمع شارب كصاحب وصحب وتاجر وتجر، وهو يستعمل كذلك وإطلاق لفظ الجمع عليه جريًا على عادتهم، والصواب أنه اسم جمع فإن فعلًا ليس من صيغ الجموع، واستعمل أيضا مصدرًا وقد قرئت الآية بالوجوه الثلاثة، فمن قرأ بالضم أو الفتح فهو مصدر، ومن قرأ بالكسر فهو بمعنى المشروب. وعلى الأول يقع التشبيه بين الفعلين وهو المقصود بالذكر شبه شربهم من الحميم بشرب الإبل العطاش التي قد أصابها الهيام وهو داء تشرب منه ولا تروى وهو جمع أهيم وأصله هيم بضم الهاء كأحمر وحمر، ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل الياء فقالوا: هيم. وأما قراءة الكسر فوجهها أنه شبه مشروبهم بمشروب الإبل الهيم في كثرته وعدم الري به والله أعلم.
عاد كلامه قال: فإن قيل: فإن الفهم والعقل والوهم والظن مصادر وليست مما ذكرت. وقد جمعت فقالوا: أفهام وأوهام وعقول.
قيل: هذه مصادر في أصل وضعها. ولكنها قد أجريت مجرى الأسماء حيث صارت عبارة عن صفة لازمة وعن حاسة ناطقة كالبصر. ألا ترى أنك إذا قلت: عقلت البعير عقلًا، لم يجز في هذا المصدر الجمع. فإذا أردت به المعنى الذي استعير له وهو عقل الإنسان جاز جمعه إذا صار للإنسان كأنه حاسة ناطقة كالبصر. ألا ترى أن البصر حيثما ورد في القرآن مجموع، والسمع غير مجموع في أجود الكلام لبقاء السمع على أصله من بناء المصادر الثلاثية ولكون البصر على وزن فعل كالأسماء، ولأنه يراد به الحاسة. وقد يجوز في السمع على ضعف أن تجمعه إذا أردت به الحاسة دون المصدر، كما تجمع الفهم على أفهام. ولكن لا يكون ذلك إلا بشرط. وهو أن تكون الأفهام والأسماع ونحوها مضافة إلى جمع نحو أفهام القوم وأسماع الزيدين ولو كان هذا الجمع. إنما هو لاختلاف أنواع المصدر لما جاز أن تقول: عرفت أفهام القوم في هذه المسألة وعرفت علومهم، لأن الصفة لا تختلف عند اتحاد متعلقها بل هي مماثلة. وإن اختلفت محالها فعلم زيد وعلم عمرو وإذا تعلقا بشيء واحد فهما مثلان وعلم زيد بشيء واحد، وعلمه بشيء آخر مختلفان لاختلاف المعلومين.
والمقصود أن الأفهام والعقول لا تجمع لاختلاف أنواعها، لأنها قد تجمع حيث لا تختلف. وهي عند اتفاق أفهام على مفهوم واحد وتجيء مفردة عند اختلافها نحو فهم زيد الحساب والنحو وغيرهما. لا يقال فيه: عرفت أفهام زيد بالعلوم، ولكن تقول: فهم زيد بالافراد مع اختلاف متعلقه. واختلاف متعلقه يوجب اختلافه.
وإذا ثبت هذا فلم يجمع الفهم على أفهام إلا من حيث كان بمنزلة حاسة ناطقة للإنسان. فإذا أضيف إلى أكثرين جمع، وإذا أضيف إلى واحد لم يجمع، لأنه كالحاسة الواحدة وإن كان في أصله مصدرًا فرب مصدر أجرى مجرى الأسماء كضيف وضيفان وعدل وعدول وصيد وصيود.
وأما رؤية العين فليست التاء فيها للتحذير بل هي لتأنيث الصفة كالقدرة والصفرة والحمرة وكان الأصل فيها رأيًا، ولكنهم إنما يستعملون هذا الأصل مضافًا إلى العين نحو قوله تعالى: { رأي العين } [141] فاذا لم تضف استعمل في الرأي المعقول، واستعملت الرؤية في المعنى الآخر للفرق.
وأما الظن فمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا أن تريد به الأمور المظنونة نحو قوله تعالى: { وتظنون بالله الظنونا }، [142] أي يظنون أشياء كاذبة. والظنون على هذا مفعول مطلق. لا عبارة عن الظن الذي هو المصدر في الأصل. والله أعلم.
فائدة: لفظ سحر وتقسيمه
سحر على قسمين: أحدهما يراد به سحر يوم بعينه معرفة كان اليوم أو نكرة. وهو في هذا ظرف غير منون، بشرط أن يكون اليوم ظرفًا لا فاعلًا ولا مفعولًا. وفيه وجهان:
أحدهما: أن تعريفه لما فيه من معنى الإضافة فإنك تريد سحر ذلك اليوم، فحذف التنوين منه، كما حذف في أجمع وأكتع لما كان مضافًا في المعنى.
والوجه الثاني: وهو اختيار سيبويه أن تعريفه باللام المقدرة كأنك حين ذكرت يومًا قبله وجعلته ظرفًا، ثم ذكرت سحر فكأنك أردت السحر الذي من ذلك اليوم فاستغنيت عن الألف واللام بذكر اليوم. وهذا القول أصح للفرق الذي بين سحر وبين أجمع، فإن أجمع توكيد بمنزلة كله ونفسه فهو مضاف في المعنى إلى ضمير المؤكد، واستغنى عن إظهار الضمير بذكر المؤكد، لأن أجمع لا يكون إلا تابعًا له ولا يكون مخبرًا عنه بحال. وليس كذلك السحر، لأنه بمنزلة الفرس والجمل، فإن أضفته لم يكن بد من إظهار المضاف إليه. وإنما هو معرف باللام كما قال سيبويه وهذا كله لما كان اليوم ظرفًا لا مفعولًا. فلو قلت: كرهت يوم السبت سحر كان بدلًا، كما تقول: أكلت الشاة رأسها.
فإن قيل: فهلا قلتم أنه بدل إذا كان ما قبله ظرفًا أيضا، لأنه بعض اليوم فيكون بدل البعض من الكل كما كان ذلك إذا كان اليوم مفعولًا.
قيل: الفرق بينهما. أن البدل يعتمد عليه ويكون المبدل منه في حكم الطرح، ويكون الفعل مخصوصًا بالبدل بعد ما كان عمومًا في المبدل منه. فإذا قلت: أكلت السمكة رأسها. لم يتناول الأكل إلا رأسها وخرج سائرها من أن يكون مأكولًا، وليس كذلك خرجت يوم الجمعة سحر، لأن الظرف مقدر بفي وجعل سحر ظرفًا لا يخرج اليوم عن أن يكون ظرفًا بل يبقى على حاله، لأنه ليس من شرط الظرف أن يملأه ما يوضع فيه، فالكلام معتمد عليه كما كان قبل ذكر سحر نعم وما هو أوسع من اليوم في المعنى نحو الشهر والعام الذي فيه ذكر اليوم وماهو أوسع من العام، كالزمان كل واحد من هذه ظرف للفعل الذي وقع في سحر بالذكر، فذكر سحر لا يخرج شيء منها أن يكون ظرفًا للفعل فلذلك اعتمد الكلام على اليوم واستغني به عن تجديد آلة التعريف بخلاف كرهت يوم السبت سحرًا، أو السحر منه. لا بد من البدل فيه.
فقد بان الفرق وبانت علة ارتفاع التنوين، لأنه لا يجامع الألف واللام ولا معناها. وإن كان في حكم المضاف كما زعم بعضهم، فلذلك أيضا امتنع تنوينه.
وأما مانع تصرفه وتمكنه فإنك لما أردته ليوم هو ظرف فلو تمكن خرج عن أن يكون من ذلك اليوم، لأن الظرفية كانت رابطة بينهما ومشعرة بأن السحر من ذلك اليوم، فإذا قلت: سير يزيد يوم الجمعة سحر وجعلته مفعولًا على السعة لم يجز لعدم الرابط بينه وبين اليوم، فإن أردت هذا المعنى فقل: سير يزيد يوم الجمعة سحر، أو السحر منه حتى يرتبط به، لأنك لا تقدر الألف واللام من غير أن يلفظ بهما إلا إذا كان في الكلام ما يغني عنهما، وأما إذا كان اسمًا متمكنًا كسائر الأسماء فلا بد من تعريفه بما تعرف به الأسماء، أو تجعله نكرة فلا يكون من ذلك اليوم.
فإن قلت: فقد أجازوا سير يزيد يوم الجمعة سحر برفع اليوم ونصب سحر فلم لا يجوز أيضا يوم الجمعة سحر بنصب اليوم ورفع سحر.
قيل: لأن اليوم وإن اتسع فيه فهو ظرف في معناه وهو يشتمل على السحر ولا يشتمل السحر عليه. فلا يجوز إذًا أن يتعرف السحر تعريفًا معنويًا جتى يكون ظرفًا بمنزلة اليوم الذي هو منه ليكون تقديم اليوم مع كونه ظرفًا مغنيًا عن آلة التعريف.
فصل: ضحوة وعشية ومساء
وأما ضحوة وعشية ومساء ونحو ذلك، فإنها مفارقة لسحر من حيث كانت منونة، وإن أردتها ليوم بعينه وهي موافقة له في عدم التصرف والتمكن. والفرق بينهما أن هذه أسماء فيها معنى الوصف، لأنها مشتقة مما توصف به الأوقات التي هي ساعات اليوم، فالعشي من العشاء والضحوة من قولك فرس أضحى وليلة أضحيان يريد البياض والصباح من الصبح وهو لون بين لونين. فإذا قلت: خرجت اليوم عشاء وظلامًا وضحى وبصرًا حكاه سيبويه، فإنما تريد خرجت اليوم في ساعة وصفها كذا. وخرجت وقتًا مظلمًا أو مبصرًا ونحو ذلك. فقد بان لك أنها أوصاف لنكرات، وتلك النكرات هي أجزاء اليوم وساعاته. ألا ترى أنك إذا قلت: خرجت اليوم ساعة منه أو مسيت اليوم وقتًا منه لم يكن إلا منونًا إلا أن ساعة ووقتًا غير معين. وضحوة وعشية قد تخصصا بالصفة، ولكنه لم يتعرف وإن كان ليوم بعينه، لأنه غير معرف بالألف واللام كما كان سحر، لأن سحر اسم جامد يتعرف كالأسماء ويخبر عنه، وأما نعته فلا يكون كذلك لأن النعت لا يكون فاعلًا ولا مفعولًا. ولا يقام مقام المنعوت إلا على شروط مخصوصة.
فإن قلت: أليس هذه الأوقات معروفة عند المخاطب من حيث كانت ليوم بعينه فلم لا تكون معرفة كما كان سحر إذا كان ليوم بعينه؟
قيل: إن سحر لم يتعرف بشيء إلا بمعنى الألف واللام. لا من حيث كان ليوم بعينه فقد تعرف المخاطب الشيء بصفته كما تعرفه بآلة التعريف، فتقول: رأيت رجلًا من صفته كذا وكذا حتى يعرفه المخاطب فيسري إليه التعريف. وهو مع ذلك نكرة، وكذلك ضحوة وعشية، وإنما استغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدم ذكر اليوم الذي هو مشتمل على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني، كما استغني عن ذكر المنعوت إذا قلت: زيد قائم، ولا شك أن المعنى زيد رجل قائم ولكن ترك ذكر الرجل، لأنه زيد. وكذلك جاءني زيد صالحًا أي رجلًا صالحًا. ولكن زيد هو الرجل فأغناك عن ذكره، وكذلك ما نحن بسبيله من هذه الأسماء التي هي في نفسها أوصاف لأوقات أغنى ذكر اليوم الذي هي له عن ذكرها لاشتمالها عليه، ولم يكن ذلك في سحر، ومن ثم أيضا لم تتمكن فتقول: سير عليه يوم الجمعة ضحوة وعشية، لأن تمكنها يخرجها إلى حيز الأسماء ويبطل منها معنى الصفة. فلا ترتبط حينئذ باليوم الذي أردتها له، وينضاف إلى هذه العلة علة أخرى قد تقدمت في فصل سحر. وكذلك كل ما كان من الظروف نعتًا في الأصل نحو ذا حاج وكلت مرة وأقمت طويلًا وجلست قريبًا لا يتمكن ولا يخرج من الظرف.
ويلحق بهذا الفصل نهارًا إذا قلت: خرجت اليوم نهارًا، لأنه مشتق من أنهر الدم بما تشتت تريد الانتشار والسعة ومنه النهر من الماء، لأنه بالإضافة إلى موضع تفجره كالنهار بالإضافة إلى فجره، لأن النهر ما ينتشر ويتسع فما انفجر من الماء والنهر بمنزلة ما انتشر، واتسع من فجر الضياء واليوم أوسع من النهار في معناه. فصار قولك خرجت اليوم نهارًا كقولك خرجت اليوم ظهرًا أو عشيًا، معنى الاشتقاق فيها كلها بين فجرت مجرى الأوصاف للنكرات في تنوينها وعدم تمكنها.
قلت: ولما كان النهار أوسع من النهر خص بالألف المعطية اتساع النطق وانفتاح الفم دون النهر.
فصل: غدوة وبكرة
وأما غدوة وبكرة فهما اسمان علمان وعدم التنوين فيهما للتعريف والتأنيث، والذي أخرجهما عن باب ضحوة وعشية وإن كان فيهما معنى الغدو والبكور كما كان في أخواتهما معاني الفعل. إنهما قد بنيا بناء لا يكون عليه المصادر ولا النعوت وغيرها للعلمية. كما غير عمارة وعمر وأشباههما، وكما غير الدبران وفيه معنى الدبور إيذانًا بالعلمية وتحقيقًا لمعناها. ألا ترى أن ضحوة على وزن صعبة من النعوت وضربة من المصادر، والمصادر ينعت بها، وضحى على وزن هدى وعلى وزن حطم من النعت، وكذلك سائر تلك الأسماء وغدوة وبكرة بخلاف ذلك قد غيرنا عن لفظ الغدو والبكور تغييرًا بينًا، ففارقتا الفصل المتقدم.
فإن قيل: فلعل امتناع التنوين فيهما بمثابة امتناعه في سحر ليوم بعينه.
قيل: كلام العرب يدل على خلاف ذلك، لأنهم لا يكادون يقولون: خرجت اليوم في الغدوة وللغدوة خير من أول الليل. كما يقال: السحر خير من أول الليل. فالسحر كسائر الأجناس في تنكيره وتعريفه وغدوة وبكرة من اليوم بمنزلة رجب وصفر من العام، فقد تبين مخالفتهما لسحر وضحوة وأخواتهما، وإنهما بمنزلة أسماء الشهور الأعلام وأسماء الأيام نحو السبت والجمعة.
وإذا ثبت هذا فهما اسمان متمكنان يجوز إقامتهما مقام الفاعل. إذا قلت سير بزيد يوم الجمعة غدوة فلا يحتاج إلى إضافة، ولا إلى لام تعريف، وتقول: سير به يوم الجمعة غدوة على الظرف فيهما جميعًا، لأنها بعض اليوم كما تقول: سرت العام رجبًا كله. وتقول أيضا سير به يوم الجمعة غدوة برفعهما كأنهما بدل من اليوم، ولا تحتاج أيضا إلى الضمير كما تحتاج في بدل البعض من الكل، لأنها ظرف في المعنى. ولو قلت: كره يوم السبت غدوة على البدل لم يكن بد من إضافة غدوة إلى ضمير المبدل منه، لأن اليوم ليس بظرف فيكون كقولك: كرهت الخميس سحره إذا أردت البدل، لأن المكروه هو السحر دون سائر اليوم، وإنما يستغنى عن ضمير يعود على اليوم إذا تركته ظرفًا على حاله، لأن بعض اليوم إذا كان ظرفًا لفعل كان جميع ذلك اليوم ظرفًا لذلك الفعل.
واعلم أنه ما كان من الظروف له اسم علم. فإن الفعل إذا وقع فيه تناول جميعه وكان الظرف مفعولًا على سعة الكلام. فإذا قلت: سرت غدوة فالسير وقع في الوقت كله، وكذلك سرت السبت والجمعة وصفر والمحرم كله مفعول على سعة الكلام لا ظرف للفعل، لأن هذه الأسماء لا يطلبها الفعل، ولا هي في أصل موضوعها زمان. إنما هي عبارة عن معان أخر. فإن أردت أن تجعل شيئًا منها ظرفًا ذكرت لفظ الزمان وأضفته إليها كقولك سرت يوم السبت وشهر المحرم. فالسير واقع في الشهر ولا يتناول جميعه إلا بدليل والشهر ظرف، وكذلك اليوم.
قال سيبويه: ومما لا يكون الفعل إلا واقعًا به كله سرت المحرم وصفر، هذا معنى كلامه. وإذا ثبت هذا فرجب ورمضان أسماء أعلام إذا أردتها لعام بعينه، أو كان في كلامك ما يدل على عام تضيفها إليه، فإن لم يكن كذلك صار الاسم نكرة تقول: صمت رمضان ورمضانًا آخر، وصمت الجمعة وجمعة أخرى، إنما أردت جمعة أسبوعك ورمضان عامك. وإذا كان نكرة لم يكن إلا شهرًا واحدًا كما تكون النكرة من قولك ضربت رجلًا إنما تريد واحدًا، وإذا كان معرفة يكون ما يدل على التمادي وتوالي الأعوام. لم يكن حينئذ واحدًا كقولك المؤمن يصوم رمضان فهو معرفة، لأنك لا تريده لعام واحد بعينه إذ المعنى يصوم رمضان من كل عام على التمادي وذكر الإيمان قرينة تدل على أن المراد ولو لم يكن في الكلام ما يدل على هذا لم يكن محمله إلا على العام الذي أنت فيه.
وإذا ثبت هذا فانظر إلى قوله تعالى: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن }، [143] وفي الحديث: «من صام رمضان»، وإذا دخل رمضان بدون لفظ الشهر، ومحال أن يكون فعل ذلك إيجازًا واختصارًا، لأن القرآن أبلغ إيجازًا وأبين إعجازًا، ومحال أيضا أن يدع لفظ القرآن مع تحريه لألفاظه وما علم من عادته من الاقتداء به فيدع ذلك لغير حكمة بل فائدة جسيمة ومعان شريفة اقتضت الفرق بين الموضعين.
وقد ارتبك الناس في هذا الباب فكرهت طائفة أن تقول: صمت رمضان بل شهر رمضان، واستهوى ذلك الكتاب واعتل بعضهم في ذلك برواية منحولة إلى ابن عباس: رمضان اسم من أسماء الله. قالوا: ولذلك أضيف إليه الشهر وبعضهم يقول: إن رمضان من الرمضاء وهو الحر وتعلق الكراهية بذلك، وبعضهم يقول: إن هذا استحباب واقتداء بلفظ القرآن.
وقد اعتنى بهذه المسألة أبو عبد الرحمن النسائي لعلمه وحذقه فقال في السنن: باب جواز أن يقال دخل رمضان أو صمت رمضان، وكذلك فعل البخاري وأورد الحديث المتقدم من صام رمضان.
وإذا أردت معرفة الحكمة والتحقيق في هذه النكتة فقد تقدم أن الفعل إذا وقع على هذه الأسماء الأعلام فإنه يتناول جميعها ولا يكون ظرفًا مقدرًا بفي حتى يذكر لفظ الشهر، أو اليوم الذي أصله أن يكون ظرفًا. وأما الاسم العلم فلا أصل له في الظرفية.
وإذا ثبت هذا فقوله سبحانه: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } فيه فائدتان أو أكثر:
إحداهما أنه لو قال: رمضان الذي أنزل فيه القرآن لاقتضى اللفظ وقوع الإنزال على جميعه كما تقدم من قول سيبويه. وهذا خلاف المعنى. لأن الإنزال كان في ليلة واحدة منه في ساعة منها. فكيف يتناول جميع الشهر وكان ذكر الشهر الذي هو غير علم موافقًا للمعنى كما تقول: سرت في شهر كذا فلا يكون السير متناولًا لجميع الشهر.
والفائدة الأخرى أنه لو قال: رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكان حكم المدح والتعظيم مقصورًا على شهر بعينه. إذ قد تقدم أن هذا الاسم وما هو مثله إذا لم تقترن به قرينة تدل على توالي الأعوام التي هو فيها لم يكن محله إلا العام الذي أنت فيه أو العام المذكور قبله، فكان ذكر الشهر الذي هو الهلال في الحقيقة كما قال الشاعر: * والشهر مثل قلامة الظفر * يريد الهلال، مقتضيًا لتعليق الحكم الذي هو التعظيم بالهلال والشهر المسمى بهذا الاسم متى كان في أي عام كان. مع أن رمضان وما كان مثله لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن، لأنه لم يرد لعام بعينه. ألا ترى أن الآية في سورة البقرة وهي من آخر ما نزل. وقد كان القرآن أنزل قبل ذلك بسنين. ولو قلت: رمضان حج فيه زيد تريد فيما سلف لقيل لك أي رمضان كان ولزمك أن تقول: حج في رمضان من الرمضانات حتى تريد عامًا بعينه كما سبق.
وفائدة ثالثة في ذكر الشهر وهو التبيين في الأيام المعدودات، لأن الأيام تبين بالأيام وبالشهر ونحوه، ولا تبين بلفظ رمضان لأن لفظه مأخوذ من مادة أخرى. وهو أيضا علم فلا ينبغي أن يبين به الأيام المعدودات حتى يذكر الشهر الذي هو في معناها، ثم تضاف إليه.
وأما قوله ﷺ: «من صام رمضان»، ففي حذف الشهر فائدة أيضا، وهى تناول الصيام لجميع الشهر. فلو قال: من صام أو قام شهر رمضان لصار ظرفًا مقدرًا بفي، ولم يتناول القيام والصيام جميعه. فرمضان في الحديث مفعول على السعة نحو قوله: { قم الليل } لأنه لو كان ظرفًا لم يحتج إلى قوله: { إلا قليلًا }. [144]
فإن قيل: فينبغي أن يكون قوله من قام رمضان مقصورًا على العام الذي هو فيه لما تقدم من قولكم إنه إنما يكون معرفة علمًا. إذا أردته لعامك، أو لعام بعينه.
قيل: قوله: من صام رمضان على العموم خطاب لكل فرد ولأهل كل عام فصار بمنزلة قولك: من صام كل عام رمضان كما تقول: إن جئتني كل يوم سحر أعطيتك فقد مر قرينة تدل على التمادي وتنوب مناب ذكر كل عام. وقد اتضح الفرق بين الحديثين والآية فاذا فهمت فرق ما بينهما بعد تأمل هذه الفصول وتدبرها، ثم لم تعدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرها. فما قدرتها حق قدرها والله المستعان على واجب شكرها. هذا نص كلام السهيلي بحروفه. ثم قال:
فصل: عمل الفعل وشروطه
الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فيما يدل عليه لفظه، كالمصدر والفاعل والمفعول به، أو فيما كان صفة لواحد من هذه. نحو سرت سريعًا وجاء زيد ضاحكًا، لأن الحال هي صاحب الحال في المعنى، وكذلك النعت والتوكيد والبدل كل واحد من هذه هو الاسم الأول في المعنى فلم يعمل الفعل إلا فيما دل عليه لفظه، لأنك إذا قلت: ضرب اقتضى هذا اللفظ ضربًا وضاربًا ومضروبًا، وأقوى دلالته على المصدر، لأنه هو الفعل في المعنى ولا فائدة في ذكره مع الفعل إلا أن تريد التوكيد، أو تبيين النوع منه وإلا فلفظ الفعل مغن عنه، ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول به من وجهين:
أحدهما: أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه نحو فعل زيد وعمل عمرو. وأما الخصوص فنحو ضرب زيد عمرًا، ولا تقول: فعل زيد عمرًا إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه.
والوجه الآخر أن الفعل هو حركة الفاعل والحركة لا تقوم بنفسها. وإنما هي متصلة بمحلها، فوجب أن يكون الفعل متصلًا بفاعله لا بمفعوله، ومن ثم قالوا: ضرب زيد لعمرو وضرب زيد عمرًا فأضافوه إلى المفعول باللام تارة، وبغير لام أخرى. ولم يضيفوه إلى الفاعل باللام أصلًا، لأن اللام تؤذن بالانفصال، ولا يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظًا، كما لا ينفصل عنه معنى.
قلت: وفي صحة قوله ضرب زيد لعمرو نظر، والمعروف الإتيان بهذه اللام إذا ضَعُف الفعل بالتأخير، نحو قوله تعالى: { إن كنتم للرؤيا تعبرون }، [145] أو كان اسمًا نحو أنا ضارب لزيد، أو يعجبني ضربك لزيد، لضعف العامل في هذه المواضع دعم باللام. ولا يكادون يقولون: شربت للماء وأكلت للخبز.
قال: فإن قيل: فإن الفعل لا يدل على الفاعل معينًا، ولا على المفعول معينًا. وإنما يدل عليهما مطلقًا، لأنك إذا قلت: ضرب لم يدل على زيد بعينه. وإنما يدل على ضارب، وكذلك المضروب وكان ينبغي أن لا يعمل حتى تقول ضرب ضارب مضروبًا بهذا اللفظ، لأن لفظ زيد لا يدل عليه لفظ الفعل، ولا يقتضيه.
قيل: الأمر كما ذكرت، ولكن لا فائدة عند المخاطب في الضارب المطلق، ولا في المفعول المطلق، لأن لفظ الفعل قد تضمنهما. فوضع الاسم المعين مكان الاسم المطلق تبيبنًا له. فيعمل فيه الفعل، لأنه هو في المعنى وليس بغيره.
قلت: الواضع لم يضع هذه الألفاظ في أصل، الخطاب مقتضية فاعلًا مطلقًا ومفعولًا مطلقًا. وإنما جاء اقتضاء المطلق من العقل لا من الوضع. والواضع إنما وضعها مقتضيات لمعين من فاعل ومفعول طالبة له. فما لم يقترن بها المعين كان اقتضاؤها وطلبها بحاله، لأن الأخبار والطلب، إنما يقعان على المعين.
فإن قيل: فلو كانت قد وضعت مقتضية لمعين لم يصح إضافتها إلى غيره، فلما صح نسبتها وإضافتها إلى كل معين علم أنها وضعت مقتضية للمطلق.
قيل: الفرق بين المعين على سبيل البدل والمعين على سبيل التعيين بحيث لا يقوم غيره مقامه. والسؤال إنما يلزم أن لو قيل: إنها مقتضية للثاني. أما إذا كانت مقتضية لمعين من المعينات على سبيل البدل لم يلزم ذلك السؤال والله أعلم.
قال: وإذا ثبت ما قلناه فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه الفعل إلا بواسطة حرف نحو المفعول معه والظرف المكاني نحو قمت في الدار، لأنه لا يدل عليه بلفظه، وأما ظرف الزمان فكذلك أيضا، لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه ولا بنسبته، وإنما يدل بنسبته على اختلاف أنواع الحدث وبلفظه على الحدث نفسه. وهكذا قال سيبويه في أول الكتاب، وإن تسامح في موضع آخر.
وأما الزمان فهو حركة الفلك فلا ارتباط بينه وبين حركة الفاعل إلا من جهة الإتفاق والمصاحبة، إلا أنهم قالوا: فعلت اليوم، لأن اليوم ونحوه أسماء وضعت للزمان يؤرخ بها الفعل الواقع فيها. فإذا سمعها المخاطب علم المراد منها واكتفى بصيغتها عن الحرف الجار. فإن أضمرتها لم يكف لفظ الإضمار ولا أغنى عن الحرف، لأن لفظ الإضمار يصلح للزمان ولغيره فقلت: يوم الجمعة خرجت فيه. وقد تقول: خرجت في يوم الجمعة، لأنها وإن كانت أسماء موضوعة للتاريخ فقد يخبر عنها كما يخبر عن المكان. إلا أن الأخبار عن المكان المحدود أكثر وأقوى، لأن الأمكنة أشخاص كزيد وعمرو وظروف الزمان بخلاف ذلك، فمن ثم قالوا: سرت اليوم وسرت في اليوم ولم يقولوا: جلست الدار.
فصل: تعدي الفعل واشتقاقه
فإن كان الظرف مشتقًا من فعل تعدى إليه بنفسه، لأنه في معنى الصفة التي لا تتمكن ولا يخبر عنها، وذلك كقبل وبعد وقريبًا لمنك، لأن في قبل معنى المقابلة وهي من لفظ قبل وبعد من لفظ بعد وهذا المعنى هو من صفة المصدر، لأنك إذا قلت: جلست قبل جلوسي زيد فما في قبل من معنى المقابلة فهو في صفة جلوسك، ولم يمتنع الاخبار عن قبل وبعد من حيث كان غير محدود، لأن الزمان والدهر قد يخبر عنهما وهما غير محدودين. تقول: قمت في الدهر مرة، وإنما امتنع قمت في قبلك للعلة التي ذكرناها.
ومن هذا النحو ما تقدم في فصل غدوة وعشية من امتناع تلك الأسماء من التمكن لما فيها من معنى الوصف. نحو خرجت بصرًا وظلامًا وعشاء وضحى، وإن كنا قد قدمنا أن هذه المعاني أوصاف للأوقات فليس بمناقض لما قلناه آنفًا، لأن الأوقات قد توصف بهذه المعاني مجازًا، وأما في الحقيقة فالأوقات هي الفلك والحركة لا توصف بصفة معنوية، لأن العرض لا يكون حاملًا لوصف.
ومن هذا الفصل خرجت ذات يوم وذات مرة، لأن ذات في أصل وضعها وصف للخرجة ونحوها كأنك قلت: خرجت خرجة ذات يوم أي لم يكن إلا في يوم واحد فمن ثم لم يجز فيها إلا النصب ولم يجز دخول الجار عليها، وكذلك ذا صباح وذا مساء في غير لغة خثعم.
فإن قيل: فلم أعربها النحويون ظرفًا إذا كانت في الأصل مصدرًا؟
قيل لأنك إذا قلت: ذات يوم علم أنك تريد يومًا واحدًا. وقد اختزل المصدر ولم يبق إلا لفظ اليوم مع الذات، فمن ثم أعربوه ظرفًا. وسر المسألة في اللغة ما تقدم.
وأما مرة فإن أردت بها فعلة واحدة من مرور الزمان فهي ظرف زمان. وإن أردت بها فعلة واحدة من المصدر مثل قولك لقيته مرة أي لقيه فهي مصدر وعبرت عنها بالمرة، لأنك لما قطعت اللقاء ولم تصله بالدوام صار بمنزلة شيء مررت به ولم تقم عنده. فإذا جعلت المرة ظرفًا. فاللفظ حقيقة، لأنها من مرور الزمان، وإذا جعلتها مصدرًا. فاللفظ مجاز إلا أن تقول: مررت مرة فيكون حينئذ حقيقة.
فصل: جلست خلفك وأمامك
ومن هذا القبيل جلست خلفك وأمامك وفوق وتحت، (وإزاءَ وتِلقاء وحِذاء، وكذلك قربك وعندك، لأن) وعندك في معنى القرب لأنها من لفظ العَنَد. قال الراجز:
وكل شيء قد يحب ولدَه ** حتى الحبارى فتطير عَنَدَه
أي إلى جنبه. وهذه الألفاظ غير خاف أنها مأخوذة من لفظ الفعل؛ فخلف من خلفت، وقدام من تقدمت، وفوق من فقت، وأمام من أممت أي قصدت، وكذلك سائرها. إلا أنهم لم يستعملوا فعلًا من تحت. ولكنها مصدر في الأصل أُميت فعله.
وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت كقبل وبعد في الزمان (وكعشي) وقريب، وصار فيها كلها معنى الوصف. فلذلك عمل الفعل فيها بنفسه كما يعمل فيما هو وصف للمصدر، أو وصف للفاعل أو المفعول به، لأن الوصف هو الموصوف في المعنى فلا يعمل الفعل إلا في هذه الثلاثة أو ما هو في معناها، لأنها لا تدل بلفظها إلا عليها كما تقدم، فقد بان لك أنه لم يتمنع الإخبار عنها، ولا دخول الجار عليها من جهة الإبهام كما قا لوا: لأنه لا فرق بينهما وبين غير المبهم في انقطاع دلالة الفعل عنها. إذ لا يدل الفعل بلفظه على مبهمها، ولا على محدودها، ولا على حركة فلك. وإنما يدل بلفظه على مصدره وفاعله إذا كان الفاعل مطلقًا وعلى المفعول به كذلك.
فإن قيل: فأين لفظ الفعل في ميل وفرسخ وأي معنى للوصف فيه والفعل قد تعدى إليه بغير حرف وعمل فيه بلا واسطة؟
قيل: المراد بالميل والفرسخ تبيين مقدار المشي لا تبيين مقدار الأرض. فصار الميل عبارة عن عدة خطى كأنك قلت: سرت خطى عدتها كيت وكيت. فلم يتعد الفعل في الحقيقة إلا إلى المصدر المقدر بعدد معلوم كقولك: ضربت ألف ضربة، ومشيت ألف خطوة. ألا ترى أن الميل عبارة عن ثلاثة آلاف وخمسمائة خطوة، والفرسخ أضعاف ذلك ثلاث مرات. فلم ينكسر ما أصلناه من أن الفعل لا يتعدى إلا إلى ما ذكرنا. وإنما سموا هذا المقدار من الخطى والأذرع ميلًا، لأنهم كانوا ينصبون في رأس ثلث كل فرسخ كهيئة الميل الذي يكتحل به إلا أنه كبير، ثم يكتبون في رأسه عدد ما مشوه ومقدار ما تخطوه.
وذكر قاسم بن ثابت أن هشام بن عبد الملك مر في بعض أسفاره بميل فأمر أعرابيًا أن ينظر في الميل كم فيه مكتوبًا. وكان الأعرابي أميًا فنظر فيه، ثم رجع إليه فقال فيه محجن وحلقة وثلاثة كأطباء الكلبة وهامة كهامة القطا. فضحك هشام وقال: معناه خمسة أميال.
فقد وضح لك أن الأميال مقادير المشي وهو مصدر. فمن ثم عمل فيها الفعل، ومن ثم عمل في المكان نحو جلست مكان زيد، لأنه مفعل من الكون فهو في أصل وضعه مصدر عبر به عن الموضع. والموضع أيضا من لفظ الوضع فلا يعمل المفعل في شيء من هذا القبيل بغير حرف.
والذي قلناه في مكان أنه من الكون هو قول الخليل في كتاب العين. إلا أنهم شبهوا الميم بالحرف الأصلي للزومها فقالوا في الجمع، أمكنة حتى كأنه على وزن فعال، وقد فعلوا ذلك في ألفاظ كثيرة شبهوا الزائد بالأصلي نحو تمدرع وتمسكن.
وأما جلست يمينك وشمالك، فليس من هذا الفصل، ولكنه مما حذف منه الجار لعلم السامع أرادوا عن يمينك، وعن شمالك أي الناحيتين، ثم حذف الجار فتعدى الفعل فنصب فهو من باب أمرتك الخير، وإنما حذف الحرف لما تضمنه الفعل من معنى الناصب، لأنك إذا قلت: جلست عن يمينك، فمعنى الكلام قابلت يمينك وحاذيته ونحو ذلك.
فصل: تعدي الفعل إلى الحال بنفسه
ومن هذا الباب تعدي الفعل إلى الحال بنفسه. ونعني بالحال صفة الفاعل التي فيها ضميره، أو صفة المفعول، أو صفة المصدر الذي عمل فيها، لأن الصفة هي الموصوف من حيث كان فيها الضمير الذي هو الموصوف. وذلك نحو سرت سريعًا وجاء ضاحكًا وضربته قائمًا. فلم يعمل الفعل في هذا النحو من حيث كان حالًا، لأن الحال غير الاسم الذي نزل عليه الفعل، ألا ترى أنك إن صرحت بلفظ الحال لم يعمل فيها الفعل إلا بواسطة الحرف نحو جاء زيد في حال ضحك، ولا تقول: جاء زيد حال ضحك، لأن الحال غير زيد. ولذلك لا تقول: جاء زيد ضحكًا لأنه غيره وغير المجيء فلا يعمل جاء فيه إلا بواسطة. فإن قلت: ضاحكًا عمل فيه، لأن الضاحك هو زيد. وإذا قلت: جاء مشيًا عمل فيه أيضا. لا من حيث كان صفة لزيد، لأنه لا ضمير فيه يعود على زيد. ولكن من حيث كان صفة للمصدر الذي هو المجيء فعمل فيه جاء كما يعمل في المصدر.
وأما عمله في المفعول من أجله فإنه لم يعمل فيه بلفظ عندي. ولكنه دل على فعل باطن من أفعال النفس والقلب وإلا قلت آثار هذا الفعل الظاهر وصار ذلك الفعل الباطن عاملًا في المصدر الذي هو المفعول من أجله في الحقيقة والفعل الظاهر دال عليه. ولذلك لا يكون المفعول من أجله منصوبًا إلا بثلاثة شرائط: أن يكون مصدرًا، وأن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة، وأن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. نحو جاء زيد خوفًا مثلًا ورغبة، ولو قلت: جاء قراءة للعلم وقتلًا للكافر لم يجز، لأنها أفعال ظاهرة، فقد بان لك أن المجي إنما يظهر ما كان باطنًا خفيًا حتى كأنك قلت: جاء زيد مظهرًا بمجيئه الخوف، أو الرغبة أو الحرص أو أشباه ذلك، فهذه الأفعال الظاهرة تبدي تلك الأفعال الباطنة فهي مفعولات في المعنى والظاهرة دالة على ما تتضمنها. فإن جئت بمفعول من أجله من غير هذا القبيل الذي ذكرناه لم يصل الفعل إليه إلا بحرف نحو جئت لكذا، أو من أجل كذا. والله أعلم.
قلت: ما أدري أي ضرورة به إلى هذا التعسف والتكلف الظاهر الذي لا يصح لفظًا ولا معنى. وأما اللفظ فإنه لو كان معمولًا لعامل مقدر وهو قولك يظهر الخوف والمحبة ونحوه لتلفظوا به ولو مرة في كلامهم فإنه لا دليل عليه من سياق ولا قرينة، ولا هو مقتضى الكلام، فيصح إضماره فدعوى إضماره ممتنعة. وأما فساده من جهة المعنى فمن وجوه عديدة:
منها: أن المتكلم لا يخطر بباله هذا المعنى بحال فلا يخطر ببال القائل زرتك محجة لك زرتك مظهرًا لمحبتك، ولا بقوله: تركت هذا خوفًا من الله، تركته مظهرًا خوفي من الله. وهذا أظهر من أن يحتاج إلى تقديره.
الثاني: أنه إذا كان التقدير ما ذكر خرج الكلام عن حقيقته. ومقصوده إذ لا يبقى فيه دليل على أنه علة الفعل الباعثة عليه. فإنه إذا قال: خرجت مظهرًا ابتغاء مرضات الله مثلًا لم يدل ذلك على أن الباعث له على الخروج ابتغاء مرضات الله تعالى، لأن قوله مظهر كذا حال أي خرجت في هذه الحال، فأين مسألة الحال من مسألة المفعول لأجله.
الثالث: أن المفعول له هو علة الفعل وهي إما علة فاعلية، أو غائية. وكلاهما ينتصب على المفعولية تقول فعلت ذلك خوفًا وقعدت عن الحرب جبنًا، وأمسك عن الإنفاق شحًا. فهذه أسباب حاملة على الفعل والترك لا أنها هي الغايات المقصودة منه. وتقول: ضربته تأديبًا وزرته إكرامًا، وحبسته صيانة، فهذه غايات مطلوبة من الفعل، إذا ثبت هذا فالمعلل إذا ذكر الفعل طلب المخاطب منه الباعث عليه لما في النفوس من طلب الأسباب والغايات في الأفعال الاختيارية شاهدًا، أو غائبًا، فإذا ذكر الباعث أو الغاية وهو المراد من الفعل كان مخبرًا بأن هذا هو مقصوده وغايته، والباعث له على الفعل. فكان اقتضاء الفعل اللفظي كاقتضاء الفعل الذي هو حدث له فصح نصبه له كما كان واقعًا لأجله، وهذا بحمد الله واضح، فتأمله.
فصل: إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم
قال: إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم كان حملها عليه على جهة النعت أولى بها. وإذا كانت مساوية للفعل غير لازمة للاسم إلا في وقت الإخبار عنه بالفعل. مع أن تكون حالًا، لأنها مشتقة من التحول فلا تكون إلا صفة يتحول عنها، ولذلك لا تكون إلا مشتقة من فعل، لأن الفعل حركة غير ثابتة، وقد تجيء غير مشتقة، لكن في معنى المشتق كقوله ﷺ: «وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا»، أي يتحول عن حاله ويعود منصورًا في صورة الرجل، فقوله رجلًا في قوة متصورًا بهذه الصورة. وأما قولهم: جاءني زيد رجلًا صالحًا. فالصفة وطأت الاسم للحال ولولا صالحًا ما كان رجل حالًا، وكذلك قوله تعالى: { لسانًا عربيًا }. [146]
قلت: وعلى هذا فيكون أقسام الحال أربعة: مقيدة ومقدرة ومؤكدة وموطئة.
فإن قيل: وما فائدة ذكر الاسم الجامد في الموطئة وهلا اكتفي بالمشتق فيها؟
قيل: في ذكر الاسم موصوفًا بالصفة في هذا الموطن دليل على لزوم هذه الحال لصاحبها، وإنها مستمرة له وليس كقولك: جاءني زيد صالحًا، لأن صالحًا ليس فيه غير لفظ الفعل. والفعل غير دائم، وفي قولك رجلًا صالحًا لفظ رجل وهو دائم. فلذلك ذكر.
فإن قيل: كيف يصح في لسانًا عربيًا أن يكون حالًا وليست وصفًا منتقلًا ولهذا لو قلت: جاءني زيد قرشيًا أو عربيًا لم يجز.
قيل: قوله: { لسانًا عربيًا } حال من الضمير في { مصدق } لا من { كتاب }، لأنه نكرة، والعامل في الحال ما في مصدق من معنى الفعل. فصار المعنى أنه مصدق لك في هذه الحال والاسم الذي هو صاحب الحال قديم، وقد كان غير موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى ومن خلا من الرسل. وإنما كان عربيًا حين أنزل على محمد ﷺ مصدقًا لما بين يديه من الكتاب. فقد أوضحت فيه معنى الحال وبرح الإشكال.
قلت: كلا بل زدت الإشكال إشكالًا. وليس معنى الآية ما ذهبت إليه، وإنما { لسانًا عربيًا } حال من كتاب، وصح انتصاب الحال عنه مع كونه نكرة لكونه قد وصف. والنكرة إذا وصفت انتصب عنها الحال لتخصصها بالصفة، كما يصح أن يبتدأ بها.
وأما قوله: إن المعنى مصدق لك، فلا ريب أنه مصدق له. ولكن المراد من الآية أنه مصدق لما تقدم من كتب الله تعالى كما قال: { وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب }، [147] وقال: { الم * الله لا إله إلا هو الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه }، [148] وقال: { وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه }. [149] أفلا ترى كيف اطرد في القرآن وصف الكتاب بأنه مصدق لما بين يديه. وقال: وباتفاق الناس: أن المراد مصدق لما تقدمه من الكتب. وبهذه الطريق يكون مصدقا للنبي ﷺ، ويكون أبلغ في الدليل على صدقه من أن يقال: هذا كتاب مصدق لك فإنه إذا كانت الكتب المتقدمة تصدقها وتشهد بصحة ما فيها مما أنزله الله من غير مواطأة ولا اقتباس منها، دل على أن الذي جاء به رسول الله ﷺ صادق كما أن الذي جاء بها كذلك، وأن مخرجهما من مشكاة واحدة.
ولهذا قال النجاشي حين قرىء عليه القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة، يعني فإذا كان موسى صادقًا وكتابه حق فهذا كذلك، إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة ويكون أحدهما باطلًا محضًا والآخر حقًا محضًا. فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر. فالقرآن صدق الكتب المتقدمة وهي بشرت به وبمن جاء به فقام الدليل على صدقه من الوجهين معًا من جهة بشارة من تقدمه به، ومن جهة تصديقه ومطابقته له فتأمله.
ولهذا كثيرًا ما يتكرر هذا المعنى في القرآن، إذ في ضمنه الاحتجاج على الكتابيينَ بصحة نبوة محمد ﷺ بهذه الطريق. وهي حجة أيضا على غيرهم بطريق اللزوم، لأنه إذا جاء بمثل ما جاؤوا به من غير أن يتعلم منهم حرفًا واحدًا، دل على أنه من عند الله. وحتى لو أنكروا رسالة من تقدم لكان في مجيئه بمثل ما جاؤوا به إثبات لرسالته ورسالة من تقدمه ودليل على صحة الكتابينِ وصدق الرسولين، لأن الثاني قد جاء بأمر لا يمكن أن ينال بالتعليم أصلًا ولا البعض منه.، فجاء على يدي أمي لا يقرأ كتابًا ولا خطه بيمينه، ولا عاشر أحدًا من أهل الكتاب، بل نشأ بينكم وأنتم شاهدون حاله حضرًا وسفرًا وظعنًا وإقامة. فهذا من أكبر الأدلة على أن ما جاء به ليس من عند البشر ولا في قدرتهم، وهذا برهان بين أبين من برهان الشمس. وقد تضمن ما جاء به تصديق من تقدمه، وتضمن ما تقدمه البشارة به فتطابقت حجج الله وبيناته على صدق أنبيائه ورسله، وانقطعت المعذرة وثبتت الحجة. فلم يبق لكافر إلا العناد المحض أو الإعراض والصد.
وقوله: إن الاسم الذي هو صاحب الحال قديم وكان غير موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى وداود هذا بناء منه على الأصل الذي انفردت به الكلابية عن جميع طوائف أهل الأرض من أن معاني التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وسائر كتب الله معنى واحد. فالعين لا اختلاف فيها ولا تعدد. وإنما تتعدد وتتكرر العبارات الدالة على ذلك المعنى الواحد فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا وهو نفس التوراة. وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وهو نفس القرآن. وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا وهو أيضا نفس القرآن ونفس التوراة، وكذلك سائر الكتب.
وهذا قول يقوم على بطلانه تسعون برهانًا لا تندفع ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة المصرية وكيف تكون معاني التوراة والإنجيل هي نفس معاني القرآن وأنت تجدها إذا عربت لا تدانيه ولا تقاربه فضلًا عن أن تكون هي إياه. وكيف يقال إن الله تعالى أنزل هذا القرآن على داود وسليمان وعيسى بعينه بغير هذه العبارات. أم كيف يقال إن معاني كتب الله كلها معنى واحد يختلف التعبير عنها دون المعنى المعبر عنه. وهل هذا إلا دعوى يشهد الحس ببطلانها؟ أم كيف يقال إن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآنًا مع تميز القرآن عن سائر الكلام بمعانيه وألفاظه تميزًا ظاهرًا لا يرتاب فيه أحد؟ وبالجملة فهذا الجواب منه بناء على ذلك الأصل.
والجواب الصحيح أن يقال الحال المؤكدة لا يشترط فيها الاشتقاق والانتقال، بل التنقل مما ينافي مقصودها فإنما أتى بها لتأكيد ما تقدمها وتقريره فلا معنى لوصف الاشتقاق والانتقال فيها أصلًا وتسميتها حالًا تعبير نحوي اصطلاحي وإلا فالعرب لم تقل: هذه حال حتى يقال: كيف سميتموها حالًا؟ وهي وصف لازم. وإنما النحاة سموها حالًا فيا لله العجب! من أن تكون تسميتهم الحادثة الاصطلاحية موجبة لاشتراط التنقل والاشتقاق فلو سماها مسم بغير هذا الاسم. وقال: هذه نصب على القطع من المعرفة إذا جاءت بعد معرفة أكان يلزمه هذا السؤال فقد بان لك ضعف ما اعتمده من الجواب وبالله التوفيق.
عاد كلامه، قال: وأما قوله تعالى: { وهو الحق مصدقًا }، [150] فقد حكموا أنها حال مؤكدة. ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها كمعنى الفعل، لأن التوكيد هو المؤكد في المعنى. وذلك نحو قم قائمًا وأنا زيد معروفًا هذه هي الحال المؤكدة في الحقيقة. وأما وهو الحق مصدقًا فليس بحال مؤكدة لأنه قال: { مصدقًا لما معهم } وتصديقه لما معهم ليس في معنى الحق إذ ليس من شرط الحق أن يكون مصدقًا لفلان ولا مكذبًا له بل الحق في نفسه حق وإن لم يكن مصدقًا لغيره. ولكن مصدقًا هنا حال من الاسم المجرور من قوله تعالى: { ويكفرون بما وراءه }، وقوله: { وهو الحق } جملة في معنى الحال أيضا. والمعنى كيف تكفرون بما وراءه وهو في هذه الحال أعني مصدقًا لما معكم كما تقول: لا تشتم زيدًا وهو أمير محسنًا إليك. فالجملة حال ومحسنًا حال بعددها. والحكمة في تقديم الجملة التي في موضع الحال على قولك محسنًا ومصدقًا إنك لو أخرتها لتوهم أنها في موضع الحال من الضمير الذي في محسن ومصدق. ألا ترى أنك لو قلت: أشتم زيدًا محسنًا إليك وهو أمير لذهب الوهم إلى أنك تريد محسنًا إليك في هذه الحال. فلما قدمتها اتضح المراد وارتفع اللبس.
ووجه آخر يطرد في هذه الآية وفي الآية التي في سورة فاطر: { والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقًا لما بين يديه } [151] وهو أن يكون مصدقًا ههنا حالًا يعمل فيها ما دلت عليه الإشارة المنبئة عنها الألف واللام، لأن الألف واللام قد تنبىء عما تنبىء عنه أسماء الإشارة. حكى سيبويه لمن الدار مفتوحًا بابها فقولك مفتوحًا بابها حال. لا يعمل فيها الاستقرار الذي يتعلق به لمن، لأن ذلك خلاف المعنى المقصود وتصحيح المعنى لمن هذه الدار مفتوحًا بابها فقد استغني بذكر الألف واللام، وعلم المخاطب أنه مشير وتنبه المخاطب بالإشارة إلى النظر وصار ذلك المعنى المنبه عليه عاملًا في الحال.
وكذلك قوله: { وهو الحق مصدقًا } كأنه يقول: ذلك هو الحق مصدقًا، لأن الحق قديم ومعروف بالعقول والكتب المتقدمة، فلما أشار نبهت الإشارة على العامل في الحال، كما إذا قلت: هذا زيد قائمًا، نبهت الإشارة المخاطب على النظر فكأنك قلت: انظر إلى زيد قائمًا، لأن الاسم الذي هو ذا هو العامل. ولكن مشعر ومنبه على المعنى العامل في الحال. وذلك المعنى هو انظر.
ومما أغنت فيه الألف واللام على الإشارة قولهم اليوم قمت، والساعة جئت، والليلة فعلت والآن قعدت. اكتفيت بالألف واللام عن أسماء الإشارة.
قلت: ليس المراد بقول النحاة حال مؤكدة ما يريدون بالتأكيد في باب التوابع. فالتأكيد المبوب له هناك أخص من التأكيد المراد من الحال المؤكدة. وإنما مرادهم بالحال المؤكدة المقررة لمضمون الجملة بذكر الوصف الذي لا يفارق العامل ولا ينفك عنه. وإن لم يكن معنى ذلك الوصف هو معنى الجملة بعينه وهذا كقولهم زيد أبوك عطوفًا. فإن كونه عطوفًا ليس معنى كونه أباه، ولكن ذكر أبوته تشعر بما يلازمها من العطف، وكذلك قوله: { هو الحق مصدقًا لما بين يديه } فإن ما بين يديه حق، والحق يلازمة تصديق بعضه بعضًا.
وقوله: ليس من شرط الحق أن يكون مصدقًا لفلان. يقال: ليس هذا بنظير لمسألتنا. بل الحق يلزمه لزومًا لا انفكاك عنه تصديق بعضه بعضًا. فتصديق ما بين يديه من الحق هو من جهة كونه حقًا. فهذا معنى قولهم: إنها حال مؤكدة فافهمه. والمعنى أنه لا يكون إلا على هذه الصفة وهي مقررة لمضمون الجملة. فإن كونه مصدقًا للحق المعلوم الثابت مقررًا ومؤكدًا ومبينًا لكونه حقًا في نفسه.
وأما قوله: إنها حال من المجرور في قوله: { ويكفرون بما وراءه }، والمعنى يكفرون به مصدقًا لما معهم. فهذا المعنى وإن كان صحيحًا، لكن ليس هو معنى الحال في القرآن حيث وقعت بهذا المعنى وهب أن هذا يمكن دعواه في هذا الموطن. فكيف يقول في قوله تعالى: { والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقًا لما بين يديه }، والكلام والنظم واحد. وأيضا فالمعنى مع جعل مصدقًا حال من قوله: { وهو الحق } أبلغ وأكمل منه إذا جعل حالًا من المجرور. فإنه إذا جعل حالًا من المجرور يكون الإنكار قد توجه عليهم في كفرهم به حال كونهم مصدقًا لما معهم، وحال كونه حقًا. فيكونان حالًا من المجرور أي يكفرون به في هذه الحال وهذه الحال. وإذا جعل حالًا من مضمون قوله: { وهو الحق } كان المعنى يكفرون به حال كونه حقًا مصدقًا لما معهم فكفروا به في أعظم أحواله المستلزمة للتصديق والإيمان به وهو اجتماع كونه حقًا في نفسه وتصديقه لما معهم. فالكفر به عند اجتماع الوصفين فيه يكون أغلظ وأقبح وهذا المعنى والمبالغة لا تجده فيما إذا قيل يكفرون به حال كونه حقًا وحال كونه مصدقًا لما معهم. فتأمله بديع جدًا فصح قول النحاة والمفسرين في الآية والله أعلم.
فائدة: قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا
قولهم هذا بسرًا أطيب منه رطبًا فيه أسئلة عشرة:
أحدها: ما جهة انتصاب بسرًا ورطبًا أعلى الحال أم خبر كان؟
الثاني: إذا كانا حالين فما هو صاحبهما؟
الثالث: ما العامل في الحالين؟ هل هو أفعل التفضيل، أو اسم الإشارة أو غير ذلك؟
الرابع: إنكم إذا جعلتم العامل أفعل التفضيل لزم تقديم معمول أفعل التفضيل عليه والاتفاق واقع على امتناع زيد منك أحسن وإذا لم يتقدم منك لم يتقدم الحال؟
الخامس: متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين ومتى لا يجوز وما ضابط ذلك؟
السادس: هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين جميعًا أم لا؟
السابع: كيف تصورت الحال في غير المشتق؟
الثامن: إلى أي شيء وقعت الإشارة بقولهم هذا؟
التاسع: هلا قلتم إن بسرًا ورطبًا منصوبان علن خبر كان، وتخلصتم من هذا كله؟
العاشر: هل يشترط في هذه المسألة أن يكون الأسمان المنصوبان اسمين لشيء واحد باعتبار صفتين أو يجوز أن يقع بين شيئين مختلفين نحو هذا بسرًا أطيب منه عنبًا؟
فالجواب في هذه المسائل.
أما السؤال الأول: فجهة انتصابه على الحال في أصح القولين وهو اختيار سيبويه ومحققي أصحابه خلافًا لمن زعم أنه خبر كان، وسيأتي إبطاله في جواب السؤال التاسع وإنما جعله سيبويه حالًا، لأن المعنى عليه فإن المخبر إنما يفضله على نفسه باعتبار حالين من أحواله. ولولا ذلك لما صح تفضيل الشيء على نفسه. فالتفضيل إنما صح باعتبار الحالين فيه. فكان جهة انتصابهما على الحال لوجود شروط الحال وسيأتي الكلام على شرط الاشتقاق. فلما كان هذا الباب لا يذكر إلا لتفضيل شيء في زمان، أو على حال على نفسه في زمان، أو على حال أخرى وسائر وجوه النصب متعذرة فيه إلا الحال، أو كونه خبرًا لكان. وسيأتي بطلان الثاني فيتعين أن يكون حالًا. فإن قلت: فهلا جعلته تمييزًا. قلت. يأتي ذلك أنه ليس من قسمي التميير فإنه ليس من المقادير المنتصبة عن تمام الاسم، ولا من التمييز المنتصب عن تمام الجملة فلا يصح أن يكون تمييزًا.
فصل: صاحب الحال
وأما السؤال الثاني: وهو ما هو صاحب الحال ههنا فجوابه أنه الاسم المضمر في أطيب الذي هو راجع إلى المبتدأ من خبره. فبسرًا حال من ذلك الضمير، ورطبًا حال من المضمر المجرور بمن. وإن كان المجرور بمن هو المرفوع المستتر في أطيب من جهة المعنى. ولكنه نزل منزلة الأجنبي، ألا ترى أنك لو قلت: زيد قائمًا أخطب من عمرو قاعدًا. لكان قاعدًا حال من الاسم المخفوض بمن وهو عمرو، فكذلك رطبًا حال من الاسم المجرور بمن.
هذا قول جماعة من البصريين. وقال أبو علي الفارسي: صاحب الحالين المضمر المستكن في كان المقدرة التامة. وأصل المسألة هذا إذا كان أي وجد بسرًا أطيب منه. إذا كان أي وجد رطبًا فبسرًا ورطبًا حالان من المضمر المستكن في كان.
وهذان القولان مبنيان على المسألة الثالثة: وهو ما هو العامل في هذه الحال، وفيه أربعة أقوال:
أحدها: أنه ما في أطيب من معنى الفعل، لأنك تريد أن طيبه في حال البسرية يزيد على طيبه في حال الرطبية، فالطيب أمر واقع في هذه الحال.
القول الثاني: إن العامل فيها كان الثانية المقدرة وهذا اختيار أبي علي.
والقول الثالث: إن العامل فيها ما في اسم الإشارة من معنى الفعل أي أشير إليه بسرًا.
والقول الرابع: إنه ما في حرف التنبيه من معنى الفعل.
والمختار القول الأول وهو العامل فيها ما في أطيب من معنى الفعل. وإنما اخترناه لوجوه:
أحدها: أنهم متفقون على جواز زيد قائمًا أحسن منه راكبًا، وثمرة نخلتي بسرًا أطيب منه رطبًا. والمعنى في هذا كالمعنى في الأول سواء وهو تفضيل الشيء على نفسه باعتبار حالين: فانتفى اسم الإشارة وحرف التنبيه ودار الأمر بين القولين الباقيين: أن يكون العامل كان مقدرة أو أطيب. والقول بإضمار كان ضعيف فإنها لا تضمر إلا حيث كان في الكلام دليل عليها. نحو قولهم: إن خيرًا فخير وبابه، لأن الكلام هناك لا يتم إلا بإضمارها بخلاف هذا، وأيضا فإن كان الزمانية ليس المقصود منها الحدث. وإنما هي عبارة عن الزمان، والزمان لا يضمر، وإنما يضمر الحدث إذا كان في الكلام ما يدل عليه وليس في الكلام ما يدل على الزمان الذي يقيد به الحدث إلا أن يلفظ به. فإن لم يلفظ به لم يعقل.
فإن قلت: فمن ههنا قالوا: إن كان ههنا تامة غير ناقصة. بل قد خلعوا منها الدلالة على الزمان وجردوها لنفس الحدث.
قلت: هذا كلام من لم يحصل معنى كان التامة والناقصة كما ينبغي. فإن كان الناقصة والتامة يرجعان إلى أصل واحد، ولا يجوز إضمار واحد منهما وكشف ذلك يطول، لكن نشير إلى بعض وهو أن القائل إذا قال كان برد وكان مطر فهو بمنزلة وقع وحدث، وكذا غيرهما من الأفعال اللازمة، والزمان جزء مدلول الفعل فلا يجوز أن يخلعه ويجرد عنه. وإنما الذي خلع من كان التامة اقتضاؤها خبرًا يقارن زمانها وبقيت تقتضيه مرفوعًا يقارن زمانها، كما كان يقارنه الخبر، فلا فرق بينهما أصلًا فإن الزمان الذي كان الخبر يقترن به هو بعينه الزمان الذي اقترن به مرفوعًا وينزل مرفوعها في تمامها به منزلة خبرها إذا كانت ناقصة فتأمل هذا السر الذي أغفله كثير عن النحاة.
ويبطل هذا المذهب أيضا بشيء آخر وهو كثرة الإضمار. فإن القائل به يضمر ثلاثة أشياء إذا والفعل والضمير، وهذا تعد لطور الإضمار، وقول بلا دليل عليه.
الوجه الثاني من وجوه الترجيح: أن العامل في الحال لو كان معنى الإشارة إلى الحال لا إلى الجوهر وهذا باطل. فإنه إنما يشير إلى ذات الجوهر ولهذا يصح إشارته إليه. وإن لم يكن على تلك الحال. كما إذا أشار إلى تمر يابس. وقال: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا. فإنه يصح ولو كان العامل في الحال هو الإشارة لم تصح المسألة.
الوجه الثالث: أنه لو كان العامل معنى الإشارة لوجب أن يكون الخبر عن الذات مطلقًا، لأن تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان مبتدأ لا يوجب تقديم خبره إذا أخبرت عنه. ولهذا تقول: هذا ضاحكًا أبي. فالإخبار عنه بالأبوة غير مقيد بحال ضحكه. بل التقييد للإشارة فقط. والإخبار بالأبوة وقع مطلقًا عن الذات. فاعتصم بهذا الموضع فإنه ينفعك في كثير من المواضع. وإذا عرف هذا وجب أن يكون الخبر بأطيب وقع عن المشار إليه مطلقًا.
الوجه الرابع: إن العامل لو لم يكن هو أطيب لم تكن إلا طيبية مقيدة بالبسرية. بل تكون مطلقة. وإذا لم تكن مقيدة فسد المعنى، لأن الغرض تقييد الأطيبية بالبسرية مفضلة على الرطبية وهذا معنى العامل. وإذا ثبت أن الأطيبية مقيدة بالبسرية وجب أن يكون بسرًا معمولًا لأطيب.
فإن قلت: فلأجل هذا قدرنا الظرف المقيد حتى يستقيم المعنى، وقلنا: تقديره هذا إذا كان بسرًا أطيب منه إذا كان رطبًا أي هذا في وقت بسريته أطيب منه في وقت رطبيته.
قلت: هذا يحتاج إليه إذا لم يكن في اللفظ ما يغني عنه ويقوم مقامه. فأما إذا كان معنا ما يغني عنه فلا وجه لتكلف إضماره وتقديره.
فإن قلت: لو كان العامل هو أطيب لزم منه المحال، لأنه يستلزم تقييده بحالين مختلفين وهذا ممتنع.
قلت: الجواب عن هذا أن العامل في الحالين وصاحبهما متعدد ليس متحدًا. أما العامل في الحال الأولى فهو ما في أطيب من معنى الفعل، لأنك إذا قلت: هذا أطيب من هذا تريد أنه طاب وراد طيبه عليه، والطيب أمر ثابت له في حال البسرية قال سيبويه: هذا باب ما ينصب من الأسماء على أنها أحوال وقعت فيها الأمور.
وأما الحال الثانية وهي رطبًا، فالعامل فيها معنى الفعل الذي هو متعلق الجار في قولك منه. فإن منه متعلق بمعنى غير الطيب، لأن طاب يطيب لا يتعدى بمن. ولكن صيغة الفعل تقتضي التفضيل بين شيئين مشتركين في صفه واحدة إلا أن أحدهما متميز من الآخر منفصل منه بزيادة في تلك الصفة. فمعنى التميز والانفصال الذي تضمنه افعل هو الذي تعلق به حرف الجر، وهو الذي يعمل في الحال الثانية. كما عمل معنى الفعل الذي تعلق به حرف الجر من قولك زيد في الدار قائمًا في الحال التي هي قائمًا.
فإن قلت: فهلا أعملت فيهما جميعًا ما في أطيب.
قلت: لاستلزامه لمحال المذكور، لأن الفعل الواحد لا يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين. لا تقول: زيد قائم يوم الجمعة يوم الخميس، ولا جالس خلفك أمامك. فإذا قلت: زيد يوم الجمعة أطيب منه يوم الخميس جاز، لأن العامل في أحد اليومين غير العامل في اليوم الثاني، لأنك فضلت حين قلت: أطيب، أو أصح، أو أقوم صحة وقيامًا على صحة أخرى وقيام آخر. وفضلت حال من حال بمزية وزيادة، وكذلك حين قلت: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا. ولا يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا ظرفين إلا أن يتداخلا ويصح الجمع بينهما نحو قولك: زيد مسافر يوم الخميس ضحوة، لأن الضحوة داخلة في اليوم، وكذلك سرت راكبًا مسرعًا لدخول الإسراع في السير وتضمنه له ولو قلت: سرت مسرعًا مبطيًا لم يجز لاستحالة الجمع بينهما إلا على تقدير الواو أي مسرعًا تارة ومبطئًا أخرى، وكذلك بسرًا ورطبًا يستحيل أن يعمل فيهما عامل واحد، لأنهما غير متداخلين. هذا هو الجواب الصحيح عندي.
وأجاب طائفة بأن قالوا: أفعل التفضيل في قوة فعلين، لأن معناه حسن وزاد حسنه وطاب وزاد طيبه. وإذا كان في قوة فعلين فهو عامل في بسرًا باعتبار حسن وطاب، وفي رطبًا باعتبار زاد. حتى لو فككت ذلك لقلت هذا زاد بسرًا في الطيب على طيبه في حال كونه رطبًا. فاستقام المعنى المطلوب. وهذا جواب حسن والأول أمتن، فتأملهما.
فصل: تقديم معمول أفعل التفضيل عليه
وأما السؤال الرابع: وهو تقديم معمول أفعل التفضيل عليه. فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: لا نسلم امتناع تقديم معموله عليه. وقولكم: الإتفاق واقع على امتناع زيد منك أحسن غير صحيح لا اتفاق في ذلك، بل قد جوز بعض النحاة ذلك واستدل عليه بقول الشاعر: * كأنه جنى النحل أو ما زودت منه أطيب *
قال هؤلاء: وأفعل التفضيل لما كان في قوة فعلين جاز تقديم معموله عليه. قالوا وتقديمه أقوى من قولك أنا لك محب، وفيك راغب وعندك مقيم. ولاستقصاء الحجج في هذه المسألة موضع آخر.
الوجه الثاني: سلمنا امتناع تقديم معموله، ولا يقال زيد منك أحسن. فهذا الأمر يختص بقولهم منك لا يتعدى إلى الحال والظرف وذلك لأن منك في معنى المضاف إليه بدليل أن قولهم زيد أحسن منك بمنزلة زيد أحسن الناس في قيام أحدهما مقام آخر وأنهم لا يجمعون بينهما، فلما قام المضاف إليه مقامه لكونه المفضل عليه في المعنى كرهوا تقديمه على المضاف، لأنه خلاف لغتهم، فلا يلزم من امتناع تقديم معمول هو كالمضاف إليه امتناع تقديم معمول، ليس كهو. وهذا بين.
وجواب ثالث: وهو أنهم إذا فضلوا الشيء على نفسه باعتبار حالين. فلا بد من تقديم أحدهما على العامل وإن كان مما لا يسوغ تقديمه لو لم يكن كذلك فإذا فضلوا ذاتًا باعتبار حالين قدموا أحدهما على العامل، وأخروا الآخر عنه. فقالوا: زيد قائمًا أحسن منه قاعدًا، وكذلك في التشبيه أيضا، يقولون: زيد قائمًا كعمرو قاعدًا. وإذا جاز تقديم هذا المعمول على الكاف التي هي أبعد في العمل من باب أحسن. فتقديم معمول أحسن أجدر. والغرض هنا بهذا الكلام تفضيل هذه التمرة في حال كونها بسرًا عليها في حال كونها رطبًا.
فصل: عمل العامل الواحد في حالين
وأما السؤال الخامس: وهو متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين، فقد فرغنا من جوابه فيما تقدم. وأن ذلك يجوز إذا كانت إحدى الحالين متضمنة للأخرى نحو جاء زيد راكبًا مسرعًا، وكذلك يعمل في الظرفين إذا تضمن أحدهما الآخر. نحو سرت يوم الخميس بكرة.
فصل: التقديم والتأخير في الحالين
وأما السؤال السادس: وهو هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين أم لا؟ فالجواب عنه أن الحال الأولى يجوز فيها ذلك، لأن العامل فيها لفظي وهو ما في أطيب من معنى الفعل فلك أن تقول: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا، وأن تقول: هذا أطيب بسرًا منه رطبًا وهو الأصل.
فإن قلت: إذا كان هذا هو الأصل فلم مثل سيبويه بها مقدمة وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها.
قلت: كأنه أراد تأكيد معنى الحال فيها، لأنه ترجم عن الحال فلو أخرها لأشبهت التمييز، لأنك إذا قلت: هذا الرجل أطيب بسرًا من فلان، فبسرًا لا محالة تمييز، وإذا قدمت بسرًا على أطيب، من كذا فبسرًا لا محالة حال ولا يصح أن يخبر بهذا الكلام عن رجل، ولا عن شيء سوى التمر وما هو في معناه. فإذا قلت: هذا بسرًا احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر في قرائن أحواله أن يكون بسرًا تمييزًا، وأن يكون حالًا وبينهما في المعنى فرق عظيم. فاقتضى تخصيص المعنى والحرص على البيان للمراد تقديم الحال الأولى على عاملها. ولو أخرت لجاز.
وأما الحال الثانية فلا سبيل إلى تقديمها على عاملها، لأنه معنوي والعامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه، لأن العامل اللفظي إذا تقدم على منصوبه الذي حقه التأخير. قلت: فيه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى، فقسمت العبارة بين اللفظ والمعنى فإن لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم يتصور تقديم المعمول عليه، لأنه لا بد من تأخير المعمول على عامله في المعنى. فلا يوجد تعد إلا وعامله متقدم عليه، لأنه منوي غير ملفوظ به فلا تذهب النية والوهم إلى غير موضعه بخلاف اللفظي. فإن محل اللفظ اللسان ومحل المعنى القلب. فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير موضعه لم يذهب القلب بالمعنى إلا إلى موضعه وهو التقديم.
فصل: تصور الحال في غير المشتق
وأما السؤال السابع: وهو كيف يتصور الحال في غير المشتق فاعلم أنه ليس لاشتراط الاشتقاق حجة ولا يقوم على هذا الشرط دليل. ولهذا كان الحذاق من النحاة على أنه لا يشترط بل كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالًا. فلا يشترط فيها إلا أن تكون دالة على معنى متحول. ولهذا سميت حالًا كما قال:
لو لم تحل ما سميت حالًا ** وكل ما حال فقد زالا
فإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفعل في صفة غير لازمة للفعل فلا تبالي. أكانت مشتقة أم غير مشتقة فقد جاء في الحديث يتمثل لي الملك رجلًا فوقع رجلًا هنا حالًا، لأن صورة الرجلية طارئة على الملك في حال التمثل وليست لازمة للملك إلا في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل فهي إذًا حال، لأنه قد تحول إليها ومثله: { يخرجكم طفلًا }، [152] ومثله: { هذه ناقة الله لكم آية }، [153] ومثله: { فتمثل لها بشرًا }. [154] ويقولون: مررت بهذا العود شجرًا، ثم مررت به رمادًا وهذا زيد أسدًا، وتأويل هذا كله بأنه معمول الحال والتقدير يشبه بعيد جدًا، وكذا تأويل ذلك كله بمشتق تعسف ظاهر والتحقيق ما تقدم وأنها كلها أحوال وإن كانت جامدة، لأنها صفات يتحول الفاعل إليها وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فعلية بل فيها نفسية ومعنوية وعدمية وهي صفة النفي، وإضافية وفعلية ولا يكون من جميعها حالًا إلا ما كان الفعل واقعا فيه وجاز خلوه عنها. فأما ما كان لازمًا للاسم مما لا يجوز خلوه عنه فلا يكون حالًا منتصبة بالفعل. نحو قولك: قرشي وعربي وحبشي وابن وبنت وأخ وأخت، فكل هذه لا يتصور وقوعها أحوالًا، لأنها لا تتحول.
فصل: مدلول الإشارة بقولك هذا
وأما السؤال الثامن: وهو إلى أي شيء وقعت الإشارة بقولك هذا؟
فالجواب أن متعلق الإشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه الأحوال وهو ما تخرجه النخل من أكمامها فيكون بلحًا، ثم يكون سيابًا ثم جدالًا، ثم بسرًا إلى أن يكون رطبًا. فمتعلق الإشارة المحل الحامل لهذه الأوصاف. فالإشارة إلى شيء ثالث غير البسر والرطب وهو حامل االبسرية والرطبية، وقد عرفت بهذا أنه لا ينبغي تخصيص الإشارة بقولهم إنها إلى البلح والطلع والجدال كل ذلك تمثيل، والتحقيق أن الإشارة إلى الحقيقة الحاملة لهذه الصفات والذي يدل على هذا أنك تقول: زيد قائمًا أخطب منه قاعدًا. وقال عبد الله بن سلام لعثمان: أنا خارجًا أنفع لك مني داخلًا، فلا إشارة ولا مشار هنا، وإنما هو إخبار عن الاسم الحامل للصفات التي منها القيام والقعود، ولا يصح أن يكون متعلق الإشارة صفة البسرية، ولا الجوهر بقيد تلك الصفة، لأنك لو أشرت إلى البسرية وكان الجوهر بقيدها لم يصح تقييده بحال الرطبية، فتأمله فلم تبق إلا أن تكون الإشارة إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه الأحوال. وقد تبين لك بطلان قول من زعم أن متعلق الإشارة في هذا هو العامل في بسر. فإن العامل فيها إما ما تضمنه أطيب من الفعل، وإما كان المقدرة وكلاهما لا يصح تعلق الإشارة به.
فصل: هل النصب على أنه خبر كان
وأما السؤال التاسع وهو قوله: هلا قلتم إنه منصوب على أنه خبر كان.
فجوابه إن كان لو أضمرت لأضمر ثلاثة أشياء. الظرف الذي هو إذا وفعل كان ومرفوعها، وهذا لا نظير له إلا حيث يدل عليه الدليل وقد تقدم ذلك، وقد منع سيبويه من إضمار كان فقال: لو قلت عبد الله المقتول تريد كان عبد الله المقتول لم يجز. وقد تقدم ما يدل على امتناع إضمار كان فلا نطول بإعادته وإذا لم يجز إضمار كان على انفرادها فكيف يجوز اضمار إذ وإذا معها وأنت لو قلت: آتيك جاء زيد تريد إذا جاء زيد كان خلفًا من الكلام بإجماع، وإذا كان كذلك كان الإضمار من هذا الموطن أبعد، لأنه لا يدري ههنا أئذ تريد أم إذا وفي قولك: سآتيك لا يحتمل إلى أحدهما بخلاف قولك زيد قائمًا أخطب منه قاعدًا، وإذا بعد كل البعد إضمار الظرف ههنا. فإضماره مع كان أبعد ومن قدره من النحاة، فإنما أشار إلى شرح المعنى بضرب من التقريب.
فإن قيل: الذي يدل على أنه لا بد من إضمار كان. أن هذا الكلام لا يذكر إلا لتفضيل شيء في زمان من أزمانه على نفسه في زمان آخر، ويجوز أن يكون الزمان المفضل فيه ماضيًا، وأن يكون مستقبلًا، ولا بد من إضمار ما يدل على المراد منهما فيضمر للماضي إذ وللمستقبل إذا. وإذ وإذا يطلبان الفعل وأعم الأفعال وأشملها فعل الكون الشامل لكل كائن ولهذا كثير ما يضمرونه، فلا بد من فعل يضاف إليه الظرف لاستحالة أن تقول: هذا إذ بسرًا أطيب منه إذ رطبًا فتعين إضمار كان لتصحيح الكلام.
قيل: هذا السؤال إنما يلزم إذ أضمرنا الظرف. وأما إذا لم نضمره لم نحتج إلى كان ويكون. وأما قولكم إنه يفضل الشيء على نفسه باعتبار زمانين وإذ وإذا للزمان. فجوابه أن في التصريح بالحالين المفضل أحدهما على الآخر غنية عن ذكر الزمان وتقدير إضماره. ألا ترى أنك إذا قلت: هذا في حال بسريته أطيب منه في حال رطبيته استقام الكلام ولا إذ هنا، ولا إذا لدلالة الحال على مقصود المتكلم من أن التفضيل باعتبار الوقتين، وكذلك تقول: هذا في حال شبوبيته أعقل منه في حال شيخوخته، ونظائر ذلك مما يصح فيه التفضيل باعتبار زمانين من غير ذكر ظرف، ولا تقديره فافهمه.
فصل: اتحاد المفضل والمفضل عليه
وأما السؤال العاشر: وهو أنه هل يشترط اتحاد المفضل والمفضل عليه بالحقيقة؟
فجوابها أن وضعها كذلك. ولا يجوز أن يقال: هذا بسرًا أطيب منه عنبًا، لأن وضع هذا الباب لتفضيل الشيء على نفسه باعتبارين وفي زمانين. قال الأخفش كل ما لا يتحول إلى شيء فهو رفع نحو هذا بسر أطيب منه عنب. فأطيب مبتدأ وعنب خبره. وفي هذا التركيب إشكال. وتوجيهه أن الكلام جملتان إحداهما قولك هذا بسر. والثانية قولك أطيب منه عنب، والمعنى العنب أطيب منه فأفدت خبرين. أحدهما أنه بسر. والثاني أن العنب أطيب منه. ولو قلت هذا البسر أطيب منه عنب لاتضحت المسألة وانكشف معناها والله أعلم.
فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث علقتها صيدًا لسوانح الخاطر فيها خشية أن لا يعود فليسامح الناظر فيها فإنها علقت على حين بعدي من كتبي وعدم تمكني من مراجعتها وهكذا غالب هذا التعليق. إنما هو صيد خاطر والله والمستعان.
(مسألة سلام عليكم ورحمة الله)
سلام عليكم ورحمة الله
في هذا التسليم ثمانية وعشرون سؤالًا.
السؤال الأول: ما معنى السلام وحقيقته؟
السؤال الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟
السؤال الثالث: هل قول المسلم سلام عليكم خبر أو إنشاء وطلب؟
السؤال الرابع: ما معنى السلام المطلوب عند التحية وإذا كان دعاء وطلبًا فما الحكمة في طلبه عند التلاقي والمكاتبة دون غيره من المعاني؟
السؤال الخامس: إذا كان من السلامة فمعلوم أن الفعل منها لا يتعدى بعلى فلا يقال سلامة عليك وسلمت عليك بكسر اللام وإنما يقال سلام لك كما قال تعالى: { فسلام لك من أصحاب اليمين }. [155]
السؤال السادس: ما الحكمة في الابتداء بالنكرة في السلام مع كون الخبر جارًا ومجرورًا وقياس العربية تقديم الخبر في ذلك نحو في الدار رجل؟
السؤال السابع: لم اختص المسلم بهذا النظم والراد بتقديم الجار والمجرور على السلام وهلا كان رده بتقديم السلام مطلقًا كابتدائه؟
السؤال الثامن: ما الحكمة في كون سلام المبتدي بلفظ النكرة وسلام الراد عليه بلفظ المعرفة وكذلك ما الحكمة في ابتداء السلام قف المكاتبة بالنكرة وفي آخرها بالمعرفة فيقال أولا سلام عليكم، وفي انتهاء المكاتبة والسلام عليكم. وهل هذا التعريف لأجل العهد وتقدم السلام أم لحكمة سوى ذلك.
السؤال التاسع: ما الفائدة في دخول الواو العاطفة في السلام الآخر؟ فيقول أولا سلام عليكم، وفي الانتهاء والسلام عليكم، وعلى أي شيء هذا العطف؟
السؤال العاشر: ما السر في نصب السلام في تسليم الملائكة ورفعه في تسليم إبراهيم وهل هو كما تقول: النحاة أن سلام إبراهيم أكمل لتضمنه جملة إسمية دالة على الثبوت وتضمن سلام الملائكة صيغة جملة فعلية دالة على الحدوث أم لسر غير ذلك؟
السؤال الحادي عشر: ما السر في نصب السلام؟ من قوله تعالى: { وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا }، [156] ورفعه من قوله: { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم }، [157] أو ما الفرق بين الموضعين؟
السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله والسلام إنما هو طلب السلامة للمسلم عليه فكيف يتصور هذا المعنى في حق الله؟ وهذا من أهم الأسئلة وأحسنها.
السؤال الثالث عشر: إذا ظهرت حكمة سلامه تعالى عليهم فما الحكمة في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ فيقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكذلك سلامهم على أنفسهم وعلى عباد الله الصالحين.
السؤال الرابع عشر: ما السر في تسليم الله على يحيى بلفظ النكرة في قوله: وسلام عليه وتسليم المسيح نفسه بلفظ المعرفة بقوله: { والسلام علي }، وأي السلامين أتم وأعم.
السؤال الخامس عشر: ما الحكمة في تقييد هذين السلامين بهذه الأيام الثلاثة: { يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا }، [158] خاصة مع أن السلام مطلوب في جميع الأوقات فلو أتى به مطلقًا. أما كان أعم. فإن هذا التقييد خص السلام بهذه الأيام خاصة؟
السؤال السادس عشر: ما الحكمة في تسليم النبي ﷺ على من اتبع الهدى في كتاب هرقل بلفظ النكرة، وتسليم موسى على من اتبع الهدى بلفظ المعرفة ليطابق القرآن وما الفرق بينهما؟
السؤال السابع عشر: قوله تعالى: { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى }، [159] هل هذا سلام من الله فيكون الكلام قد تضمن جملتين طلبية وهي الأمر بقوله: قل الحمد لله، وخبرية وهي سلامه تعالى على عباده وعلى هذا، فيكون من باب عطف الخبر على الطلب أو هو أمر من الله بالسلام عليهم. وعلى هذا فيكون قد أمر بشيئين أحدهما قول الحمد لله، والثاني قول سلام على عباده الذين اصطفى ويكون كلاهما معمولًا لفعل القول وأي المعنيين أليق بالآية.
السؤال الثامن عشر: روى أبو داود في سننه من حديث أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال: «لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى»، قال الترمذي: حديث صحيح وقد صح عنه في السلام على الأموات فعلًا وأمرًا السلام عليكم دار قوم مؤمنين فما وجه هذا الحديث وكيف الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة؟
السؤال التاسع عشر: ما وجه دخول الواو في قول النبي ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» وقد استشكل كثير من الناس أمر هذه الواو حتى أنكر بعضهم من الحذاق أن تكون ثابتة، قال: لأن الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الأول وتصديقه. كما إذا قلت زيد كاتب. فقال: المخاطب وفقيه فإنه يقتضي إثبات الأول وزيادة وصف فقيه. فكيف دخلت في هذا الموضع وما وجهها؟
السؤال العشرون: ما السر في اقتران الرحمة والبركة بالسلام دون غيرها من الصفات كالمغفرة والبر والإحسان ونحو هذا؟
السؤال الحادي والعشرون: لم كانت نهاية السلام عند قوله وبركاته ولم تشرع الزيادة عليها.
السؤال الثاني والعشرون: ما الحكمة في إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى وتجريد السلام عن هذه الإضافة ولم لا أضيفت كلها أو جردت كلها.
السؤال الثالث والعشرون: ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة.
السؤال الرابع والعشرون: ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي ﷺ بالمصدر دون الصلاة في قوله تعالى: { صلوا عليه وسلموا تسليمًا }، [160] ولم يقل صلوا صلاة.
السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقديم السلام عليه في الصلاة على الصلاة عليه، وهلا وقعت البداءة بالصلة عليه أولًا، ثم اتبعت بالسلام لتصح البداءة بما بدأ الله به من تقديم الصلاة على السلام؟
السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام عليه في الصلاة بصيغة خطاب المواجهة؟ وأما الصلاة عليه فجاءت بصيغة الغيبة لذكره باسم العلم.
السؤال السابع والعشرون: وهو ما جر إليه طرد الكلام ما الحكمة في كون الثناء على الله ورد بصيغة الغيبة في قولنا التحيات الله مع أنه سبحانه هو المناجي المخاطب الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا، وجاء السلام على النبي ﷺ بصيغة الخطاب. مع أن الحال كان يقتضي العكس فما الحكمة في ذلك؟
السؤال الثامن والعشرون: وهو خاتمة الأسئلة ما السر في كون السلام خاتمة الصلاة وهلا كان في ابتدائها. وإذا كان كذلك. فما السر في مجيئه معرفًا وهلا جاء منكرًا؟
أما السؤال الأول: وهو ما حقيقة هذه اللفظة. فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها فمن ذلك، قولك: سلمك الله وسلم فلان من الشر. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم اللهم سلم ومنه سلم الشيء لفلان. أي خلص له وحده. فخلص من ضرر الشركة فيه قال تعالى: { ضرب الله مثلًا رجلًا فيه شركاء متشاكسون ورجلًا سلمًا لرجل }. [161] أي خالصًا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب قال تعالى: { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها }، [162] لأن كلًا من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ولهذا يبني منه على المفاعلة. فيقال: المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الغل والدغل. وحقيقته الذي قد سلم الله وحده. فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات. بل هو المستقيم على صدق حبه، وحسن معاملته. فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته، ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله، والتخلص من شوائب الشرك فسلم لربه، وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون، ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم المخلص الخالص لربه والمشرك به.
ومنه السَّلَم للسَّلَف، وحقيقته العوض المسلم فيه، لأن من هو في ذمته قد ضمن سلامته لربه، ثم سمى العقد سلمًا وحقيقته ما ذكرناه.
فإن قيل: فهذا ينتقض بقولهم للديغ سليما.
قيل: ليس هذا بنقض له. بل طرد لما قلناه فإنهم سموه سليمًا باعتبار ما يهمه ويطلبه ويرجو أن يؤول إليه حاله من السلامة. فليس عنده أهم من السلامة ولا هو أشد طلبًا منه لغيرها. فسمي سليمًا لذلك. وهذا من جنس تسميتهم المهلكة مفازة، لأنه لا شيء أهم عند سالكها من فوزه منها أي نجاته. فسميت مفازة لأنه يطلب الفوز منها. وهذا أحسن من قولهم: إنما سميت مفازة وسمي اللديغ سليمًا تفاؤلًا، وإن كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذي ذكرناه وداخل فيه فهو أعم وأحسن.
فإن قيل: فكيف يمكنكم رد السلم إلى هذا الأصل.
قيل: ذلك ظاهر، لأن الصاعد إلى مكان مرتفع لما كان متعرضًا للهوي والسقوط طالبًا للسلامة راجيًا لها سميت الآلة التي يتوصل بها إلى غرضه سلمًا لتضمنها سلامته. إذ لو صعد بتكلف من غير سلم لكان عطبه متوقعًا. فصح أن السلم من هذا المعنى.
ومنه تسمية الجنة بدار السلام وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني: أنها إضافة إلى تحية أهلها فإن تحيتهم فيها سلام. الثالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة، أي دار السلامة من كل آفة ونقص وشر والثلاثة متلازمة. وإن كان الثالث أظهرها فإنه لو كانت الإضافة إلى مالكها لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلام. وكان يقال دار الرحمن، أو دار الله، أو دار الملك. ونحو ذلك. فإذا عهدت إضافتها إليه، ثم جاء دار السلام حملت على المعهود، وأيضا فإن المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتها، أو إلى أهلها.
أما الأول فنحو دار القرار دار الخلد جنة المأوى جنات النعيم جنات الفردوس. وأما الثاني فنحو دار المتقين ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القرآن فالأولى حمل الإضافة على المعهود في القرآن.
وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين؛ أحدهما: أن التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة وما يضاف إلى الجنة لا يكون إلا مختصًا بها كالخلد والقرار والبقاء. الثاني: أن من أوصافها غير التحية ما هو أكمل منها مثل كونها دائمة وباقية، ودار الخلد والتحية فيها عارضة عند التلاقي والتزاور بخلاف السلامة من كل عيب ونقص وشر. فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام التي لا يتم النعيم فيها إلا به فإضافتها إليه أولى وهذا ظاهر.
فصل: إطلاق السلام على الله تعالى
وإذا عرف هذا فإطلاق السلام على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى من هذا كله وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به، لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه. فهو السلام الحق بكل اعتبار والمخلوق سلام بالإضافة، فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه. وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله، فهو السلام من الصاحبة والولد والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل والسلام من الشريك. وكذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها، فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه وإلاهيته سلام من مشارك له فيها بل هو الله الذي لا إله إلا هو وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذلك أو مصانعة كما يكون من غيره بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه.
وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه علي إحسانه وثوابه ونعمه بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته.
وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل.
وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى. ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق. بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز.
واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرض ولا غيره بوجه ما. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه وسلام مما يضاد غناه وكماله، وسلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصورا في شيء - تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه. وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل.
وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذلك كما يوالي المخلوق المخلوق بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر كما قال تعالى: { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل }. [163] فلم ينف أن يكون له ولي مطلقا بل نفي أن يكون له ولي من الذل.
وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه وسلام مما يتقوله المعطلون فيها وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل.
فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني والله المستعان المسئول أن يوفق للتعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط إنه قريب مجيب
فصل: هل السلام مصدر أو اسم مصدر
وأما السؤال الثاني، وهو هل السلام مصدر أو اسم؟
فالجواب أن السلام الذي هو التحية اسم مصدر من سلَّم، ومصدره الجاري عليه تسليم كعلَّم تعليما وفهم تفهيما وكلم تكليما. والسلام من سلم كالكلام من كلم.
فإن قيل: وما الفرق بين المصدر والاسم؟
قلنا: بينهما فرقان لفظي ومعنوي.
أما اللفظي فإن المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قياسه كالأفعال من أفعل والتفعيل من فعل والإنفعال من انفعل والتفعلل من تفعلل وبابه. وأما السلام والكلام فليسا بجاريين على فعليهما ولو جريا عليه لقيل تسليم وتكليم.
وأما الفرق المعنوي فهو أن المصدر دال على الحدث وفاعله. فإذا قلت تكليم وتسليم وتعليم ونحو ذلك دل على الحدث ومن قام به، فيدل التسليم على السلام والمسلم وكذلك التكليم والتعليم. وأما اسم المصدر فإنما يدل على الحدث وحده، فالسلام والكلام لا يدل لفظه على مسلِّم ولا مكلم، بخلاف التكليم والتسليم.
وسر هذا الفرق أن المصدر في قولك سلم تسليما وكلم تكليما بمنزلة تكرار الفعل فكأنك قلت سلم سلم وتكلم تكلم والفعل لا يخلو عن فاعله أبدا. وأما اسم المصدر فإنهم جردوه لمجرد الدلالة على الحدث. وهذه النكتة من أسرار العربية، فهذا السلام الذي هو التحية.
وأما السلام الذي هو اسم من أسماء الله ففيه قولان:
أحدهما: أنه كذلك اسم مصدر وإطلاقه عليه كإطلاق العدل عليه والمعنى أنه ذو السلام وذو العدل على حذف المضاف.
والثاني أن المصدر بمعنى الفاعل هنا أي السالم كما سميت ليلة القدر سلاما أي سالمة من كل شر بل هي خير لا شر فيها.
وأحسن من القولين وأقيس في العربية أن يكون نفس السلام من أسمائه تعالى كالعدل وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه غالبا عليه مكررا منه كقولهم رجل صوم وعدل وزور وبابه.
وأما السلام الذي هو بمعنى السلامة فهو مصدر نفسه وهو مثل الجلال والجلالة فإذا حذفت التاء كان المراد نفس المصدر وإذا أتيت بالثاء كان فيه إيذان بالتحديد بالمرة من المصدر كالحب والحبة فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث لم يكن فيه تاء التحديد. والسلامة والجلالة والملاحة والفصاحة كلها تدل على الخصلة الواحدة.
ألا ترى أن الملاحة خصلة من خصال الكمال والجلالة من خصال الجلال، ولهذا لم يقولوا كمالة كما قالوا مَلاحة وفصاحة، لأن الكمال اسم جامع لصفات الشرف والفضل فلو قالوا كمالة لنقضوا الغرض المقصود من اسم الكمال فتأمله.
وعلى هذا جاءت الحلاوة والأصالة والرزانة والرجاحة لأنها خصلة من مطلق الكمال والجمال محدودة فجاءوا فيها بالتاء الدالة على التحديد؛ وعكسه الحماقة والرقاعة والنذالة والسفاهة فإنها خصال محدودة من مطلق العيب والنقص فجاءوا في الجنس الذي يشمل الأنواع بغير تاء فجاءوا في أنواعه وأفراده بالتاء، وقد تقدم تقرير هذا المعنى وأيضا فلا حاجة إلى إعادته.
فتأمل الآن كيف جاء السلام مجردا عن التاء إيذانا بحصول المسمى التام إذ لا يحصل المقصود إلا به، فإنه لو سلم من آفة ووقع في آفة لم يكن قد حصل له السلام فوضح أن السلام لم يخرج عن المصدرية في جميع وجوهه.
فإن قيل: فما الحكمة في مجيئه اسم مصدر ولم يجيء على أصل المصدر؟
قيل: هذا السر بديع وهو أن المقصود حصول مسمى السلامة للمسلَّم عليه على الإطلاق من غير تقييد بفاعل، فلما كان المراد مطلق السلامة من غير تعرض لفاعل أتوا باسم المصدر الدال على مجرد الفعل ولم يأتوا بالمصدر الدال على الفعل والفاعل معًا، فتأمله.
فصل: هل السلام عليكم إنشاء أم خبر
وأما السؤال الثالث: وهو أن قول المسلم سلام عليكم هل هو إنشاء أم خبر؟
فجوابه: أن هذا ونحوه من ألفاظ الدعاء متضمن للإنشاء والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض جهة الإنشائية. وهذا موضع بديع يحتاج إلى كشف وإيضاح. فنقول: الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم به نفسه، ونسبة إلى المتكلم فيه إما طلبًا، وإما خبرًا. وله نسبة ثالثة إلى المخاطب لا يتعلق بها هذا الغرض. وإنما يتعلق تحقيقه بالنسبتين الأوليين فباعتبار تينك النسبتين نشأ التقسيم إلى الخبر، والإنشاء ويعلم أين يجتمعان وأين يفترقان. فله بنسبته إلى قصد المتكلم وإرادته لثبوت مضمونه وصف الإنشاء، وله بنسبته إلى المتكلم فيه والإعلام بتحققه في الخارج وصف الأخبار، ثم تجتمع النسبتان في موضع وتفترقان في موضع. فكل موضع كان المعنى فيه حاصلًا بقصد المتكلم وإرادته فقط. فإنه لا يجامع فيه الخبر الإنشاء نحو قوله: بعتك كذا، ووهبتكه وأعتقت وطلقت. فإن هذه المعاني لم يثبت لها وجود خارجي إلا بإرادة المتكلم وقصده. فهي إنشاءات وخبريتها من جهة أخرى وهي تضمنها إخبار المتكلم عن ثبوت هذه النسبة في ذهنه. لكن ليست هذه هي الخبرية التي وضع لها لفظ الخبر وكل موضع كان المعنى حاصلًا فيه من غير جهة المتكلم. وليس للمتكلم إلا دعاؤه بحصوله ومحبته. فالخبر فيه لا يناقض الإنشاء وهذا نحو سلام عليكم. فإن السلامة المطلوبة لم تحصل بفعل المسلم، وليس للمسلم إلا الدعاء بها ومحبتها فإذا قال: سلام عليكم تضمن الإخبار بحصول السلامة والإنشاء للدعاء بها وإرادتها وتمنيها، وكذلك ويل له قال سيبويه: هو دعاء وخبر ولم يفهم كثير من الناس قول سيبويه على وجهه. بل حرفوه عما أراده به. وإنما أراد سيبويه هذا المعنى أنها تتضمن الإخبار بحصول الويل له مع الدعاء به، فتدبر هذه النكتة التي لا تجدها محررة في غير هذا الموضع هكذا. بل تجدهم يطلقون تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء من غير تحرير. وبيان لمواضع اجتماعهما وافتراقهما. وقد عرفت بهذا أن قولهم سلام عليكم وويل له وما أشبه هذا أبلغ من إخراج الكلام في صورة الطلب المجرد نحو اللهم سلمه.
فصل: معنى السلام المطلوب عند التحية
وأما السؤال الرابع: وهو ما معنى السلام المطلوب عند التحية ففيه قولان مشهوران:
أحدهما: أن المعنى اسم السلام عليكم والسلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام نزنت بركة اسمه عليكم، وحلت عليكم ونحو هذا واختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء لما يأتي في جواب السؤال الذي بعده، واحتج أصحاب هذا القول بحجج منها ما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على فلان فقال النبي ﷺ: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام». ولكن قولوا: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فنهاهم النبي ﷺ أن يقولوا: السلام على الله، لأن السلام على المسلم عليه دعاء له، وطلب أن يسلم والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له. فيستحيل أن يسلم عليه. بل هو المسلم على عباده كما سلم عليهم في كتابه. حيث يقول: { سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين }، [164] وقوله: { سلام على إبراهيم }، [165] { سلام على نوح }، [166] { سلام على إل ياسين }، [167] وقال في يحيى: { وسلام عليه } وقال لنوح: { اهبط بسلام منا وبركات عليك }، [168] ويسلم يوم القيامة على أهل الجنة كما قال تعالى: { لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون * سلام قولًا من رب رحيم }، [169] فقولًا منصوب على المصدر، وفعله ما تضمنه سلام من القول، لأن السلام قول.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة من، حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم». وقال: «يا أهل الجنة سلام عليكم»، ثم قرأ قوله: { سلام قولًا من رب رحيم }، [170] ثم يتوارى عنهم فتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم.
وفي سنن ابن ماجة مرفوعًا أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر، وقال تعالى: { تحيتهم يوم يلقونه سلام }، [171] فهذا تحيتهم يوم يلقونه تبارك وتعالى. ومحال أن تكون هذه تحية منهم له. فإنهم أعرف به من أن يسلموا عليه، وقد نهوا عن ذلك في الدنيا، وإنما هذا تحية منه لهم. والتحية هنا مضافة إلى المفعول فهي التحية التي يحيون بها لا التحية التي يحيونه هم بها. ولولا قوله تعالى في سورة يس: { قولًا من رب رحيم }، لاحتمل أن تكون التحية لهم من الملائكة كما قال تعالى: { والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم }. [172] ولكن هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازلهم من الجنة يدخلون مسلمين عليهم، وأما التحية المذكورة في قوله: { تحيتهم يوم يلقونه سلام }، فتلك تحية لهم وقت اللقاء كما يحيي الحبيب حبيبه، إذا لقيه. فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ؟
يكفي الذي غاب عنك غيبته ** فذاك ذنب عقابه فيه
والمقصود أن الله تعالى يطلب منه السلام. فلا يمتنع في حقه أن يسلم على عباده ولا يطلب له، فلذلك لا يسلم عليه. وقوله ﷺ: «إن الله هو السلام» صريح في كون السلام اسمًا من أسمائه.
قالوا: فإذا قال المسلم: سلام عليكم كان معناها اسم السلام عليكم. ومن حججهم ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلًا سلم على النبي ﷺ فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار، ثم تيمم ورد عليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»، قالوا: ففي هذا الحديث بيان أن السلام ذكر الله. وإنما يكون ذكرًا إذا تضمن اسمًا من أسمائه.
ومن حججهم أيضا أن الكفار من أهل الكتاب لا يُبدأون بالسلام. فلا يقال لهم: سلام عليكم. ومعلوم أنه لايكره أن يقال لأحدهم: سلمك الله وما ذاك إلا أن السلام اسم من أسماء الله. فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة ذلك الاسم عليه. فهذه حجج كما ترى قوية ظاهرة.
القول الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أن يذكر بلا ألف ولام. بل يقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسمًا من أسماء الله لم يستعمل كذلك. بل كان يطلق عليه معرفًا كما يطلق عليه سائر أسمائه الحسنى فيقال: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فإن التنكير لايصرف اللفظ إلى معين فضلًا عن أن يصرفه إلى الله وحده، بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينًا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى.
ومن حججهم أيضا أن عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدل على أن المراد به المصدر ولهذا عطف عليه مصدرين مثله.
ومن حججهم أيضا أنه لو كان السلام هنا اسمًا من أسماء الله لم يستقم الكلام إلا بإضمار وتقدير يكون به مقيدًا، ويكون المعنى بركة اسم السلام عليكم. فإن الاسم نفسه ليس عليهم، ولو قلت: اسم الله عليك كان معناه بركة هذا الاسم ونحو ذلك من التقدير، ومعلوم أن هذا التقدير خلاف الأصل ولا دليل عليه.
ومن حججهم أيضا أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرًا ودعاء كما يأتي في جواب السؤال الذي بعد هذا. ولهذا كان السلام أمانًا لتضمنه معنى السلامة وأمن كل واحد من المسلم والراد عليه من صاحبه. قالوا: فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وحذفت تاؤه، لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه، والتاء تفيد التحديد كما تقدم.
وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما وإنما نبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارًا وهي أن من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه بإسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، وكذلك قول النبي ﷺ لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» وكذلك قوله للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» وهذا كثيرًا جدًا فلا نطول بإيراد شواهده.
وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي يطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله كما في حديث ابن عمر. والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسمًا من أسماء الله، وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة.
وقريب من هذا ما روى عن بعض السلف. إنه قال في آمين: إنه اسم من أسماء الله تعالى. وأنكر كثير من الناس هذا القول. وقالوا: ليس في أسمائه آمين، ولم يفهموا معنى كلامه فإنه، إنما أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تبارك وتعالى، فإن معناها استجب وأعط ما سألناك فهي متضمنة لإسمه مع دلالتها على الطلب. وهذا التضمن في سلام عليكم أظهر، لأن السلام من أسمائه تعالى. فهذا كشف سر المسألة.
فصل: الحكمة في السلام عند اللقاء
إذا عرف هذا، فالحكمة في طلبه عند اللقاء دون غيره من الدعاء. إن عادة الناس الجارية بينهم أن يحيي بعضهم بعضًا عند لقائه، وكل طائفة لهم في تحيتهم ألفاظ وأمور اصطلحوا عليها. وكانت العرب تقول في تحيتهم بينهم في الجاهلية. أنعم صباحًا وأنعموا صباحًا. فيأتون بلفظة أنعموا من النعمة بفتح النون. وهي طيب العيش والحياة ويصلونها بقولهم صباحًا، لأن الصباح في أول النهار. فإذا حصلت فيه النعمة استصحب حكمها واستمرت اليوم كله فخصوها بأوله إيذانًا لتعجيلها وعدم تأخرها إلى أن يتعالى النهار، وكذلك يقولون: أنعموا مساء. فإن الزمان هو صباح ومساء. فالصباح في أول النهار إلى بعد انتصافه. والمساء من بعد انتصافه إلى الليل. ولهذا يقول الناس: صبحك الله بخير، ومساك الله بخير، فهذا معنى أنعم صباحًا ومساء، إلا أن فيه ذكر الله.
وكانت الفرس يقولون في تحيتهم: "هزار سال بيمائي" [173] أي تعيش ألف سنة. وكل أمة لهم تحية من هذا الجنس أو ما أشبهه، ولهم تحية يخصون بها ملوكهم من هيئات خاصة عند دخولهم عليهم، كالسجود ونحوه، وألفاظ خاصة تتميز بها تحية الملك من تحية السوقة وكل ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامها. ولهذا سميت تحية وهي تفعلة من الحياة كتكرمة من الكرامة. لكن أدغم المثلان فصار تحية فشرع الملك القدوس السلام تبارك وتعالى لأهل السلام تحية بينهم سلام عليكم وكانت أولى من جميع تحيات الأمم، التي منها ما هو محال وكذب نحو قولهم تعيش ألف سنة، وما هو قاصر المعنى، مثل أنعم صباحًا ومنها ما لا ينبغي إلا لله مثل السجود. فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها. فهي الأصل المقدم على كل شيء.
ومقصود العبد من الحياة إنما يحصل بشيئين؛ بسلامته من السر وحصول الخير كله، والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهي الأصل. ولهذا إنما يهتم الإنسان بل كل حيوان بسلامته أولًا، ثم غنيمته ثانيًا. على أن السلامة المطلقة تضمن حصول الخير. فإنه لو فاته حصل له الهلاك والعطب أو النقص والضعف. ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة فتضمنت السلامة نجاته من كل شر وفوزه بالخير. فانتظمت الأصلين الذين لا تتم الحياة إلا بهما مع كونها مشتقة من اسمه السلام ومتضمنة له وحذفت التاء منها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا السلامة الواحدة. ولما كانت الجنة دار السلامة من كل عيب وشر وآفة، بل قد سلمت من كل ما ينغص العيش، والحياة كانت تحية أهلها فيها سلام، والرب يحييهم فيها بالسلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا سر التحية بالسلام عند اللقاء.
وأما عند المكاتبة فلما كان المراسلان كل منهما غائب عن الآخر ورسوله إليه كتابه يقوم مقام خطابه له، استعمل في مكاتبته له من السلام ما يستعمله معه لو خاطبه لقيام الكتاب مقام الخطاب.
فصل: تعدية السلام بعلى
وأما السؤال الخامس: وهو تعدية هذا المعنى بعلى.
فجواب بذكر مقدمة وهي ما معنى قوله سلمت. فإذا عرف معناها عرف أن حرف على أليق به. فاعلم أن لفظ سلمت عليه، وصليت عليه، ولعنت فلانًا موضوعها ألفاظ هي جمل طلبية وليس موضوعها معاني مفردة. فقولك: سلمت، موضوعه: قلت: السلام عليك. وموضوع صليت عليه قلت: اللهم صل عليه أو دعوت له. وموضوع لعنته قلت: اللهم العنه.
نظير هذا سبحت الله قلت: سبحان الله. ونظيره وإن كان مشتقًا من لفظ الجملة هلل إذا قال: لا إله إلا الله، وحمدل إذا قال: الحمد الله، وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل إذا قال: حي على الصلاة وبسمل إذا قال بسم الله. قال:
وقد بسملت ليلى غداة لقيتها ** ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل
وإذا ثبت هذا فقولك: سلمت عليه أي ألقيت عليه هذا اللفظ وأوضعته عليه إيذانًا باشتمال معناه عليه كاشتمال لباسه عليه. وكان حرف على أليق الحروف به فتأمله.
وأما قوله تعالى: { وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين }، [174] فليس هذا سلام تحية ولو كان تحية لقال: فسلام عليه كما قال: { سلام على إبراهيم }، [175] { سلام على نوح }، [176] ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله. فذكر أنهم ثلاثة أقسام. مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة ووعد المقرب بالغنيمة والفوز. وإن كان كل منهما سالمًا غانمًا... وظالم بتكذيبه وضلاله. فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم. فلما لما يكن المقام مقام تحية، وإنما هو مقام أخبار عن حاله ذكر ما يحصل له من السلامة.
فإن قيل: فهذا فرق صحيح. لكن ما معنى اللام في قوله لك، ومن هو المخاطب بهذا الخطاب، وما معنى حرف من في قوله من أصحاب اليمين؟ فهذه ثلاثة أسئلة في الآية.
قيل: قد وفينا بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية، وبين سلام التحية وهو الذي كان المقصود. وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودنا، ولكن نجيب عنها إكمالًا للفائدة بحول الله وقوته، وإن كنا لم نر أحدًا من المفسرين شفى في هذا الموضع الغليل، ولا كشف حقيقة المعنى واللفظ، بل منهم من يقول المعنى فمسلم لك إنك من أصحاب اليمين ومنهم من يقول غير ذلك مما هو حرم على معناها من غير ورود.
فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى صاحبه بلام الإضافة الدالة على حصوله له. ومن ذلك قوله تعالى: { أولئك لهم اللعنة }، [177] ولم يقل عليهم اللعنة إيذانًا بحصول معناها وثبوته لهم. وكذلك قوله: { ولكم الويل مما تصفون }. [178] ويقول في ضد هذا: لك الرحمة، ولك التحية، ولك السلام. ومنه هذه الآية: { فسلام لك }، أي ثبت لك السلام وحصل لك.
وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو خطاب للجنس، أي فسلام لك يا من هو من أصحاب اليمين، كما تقول هنيئًا لك يا من هو منهم. ولهذا والله أعلم أتى بحرف من في قوله: { من أصحاب اليمين }. [179] والجار والمجرور في موضع حال أي سلام لك كائنًا من أصحاب اليمين، كما تقول: هنيئًا لك من أتباع رسول الله وحزبه، أي: كائنًا منهم، والجار والمجرور بعد المعرفة ينتصب على الحال كما تقول: أحببتك من أهل الدين والعلم، أي: كائنًا منهم. فهذا معنى هذا الآية، وهو وإن خلت عنه كتب أهل التفسير فقد حام عليه منهم من حام وما ورد ولا كشف المعنى ولا أوضحه. فراجع ما قالوه والله الموفق المان بفضله.
فصل: الابتداء بالنكرة في السلام
وأما السؤال السادس: وهو ما الحكمة في الابتداء بالنكرة ههنا مع أن الأصل تقديم الخبر عليها؟ هذا سؤال قد تضمن سؤالين؛ أحدهما: حكمة الابتداء بالنكرة في هذا الموضع. الثاني: أنه إذ قد ابتدىء بها فهلا قدم الخبر على المبتدأ، لأنه قياس الباب، نحو: في الدار رجل؟
والجواب عن السؤال الأول أن يقال: النحاة قالوا: إذا كان في النكرة معنى الدعاء مثل سلام لك وويل له جاز الابتداء بها، لأن الدعاء معنى من معاني الكلام. فقد تخصصت النكرة بنوع من التخصيص. فجاز الابتداء بها وهذا كلام لا حقيقة تحته. فإن الخبر أيضا نوع من أنواع الكلام ومع هذا فلا تكون جهة الخبر مسوغة للابتداء بالنكرة، فكيف تكون جهة الدعاء مسوغة للابتداء بها؟
وما الفرق بين كون الدعاء نوعًا والخبر نوعًا والطلب نوعًا، وهل يفيد ذلك تعيين مسمى النكرة حتى يصلح الإخبار عنها؟ فإن المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من تحصيلها عند المخاطب في ذهنه حتى يستفيد نسبة الإسناد الخبري إليها. ولا فرق في ذلك بين كون الكلام دعاء أو خبرًا. وقول من قال: إن الابتداء بالنكرة. إنما امتنع حيث لا يفيد نحو رجل في الدنيا ورجل مات ونحو ذلك. فإذا أفادت جاز الابتداء بها من غير تقييد بضابط ولا حصر بعد. وأحسن من تقييد ذلك يكون الكلام دعاء، أو في قوة كلام آخر وغير ذلك من الضوابط المذكورة. وهذه طريقة إمام النحو سيبويه. فإنه في كتابه لم يجعل للابتداء بها ضابطًا ولا حصره بعدد. بل جعل مناط الصحة الفائدة وهذا هو الحق الذي لا يثبت عند النظر سواه. وكل من تكلف ضابطًا فإنه ترد عليه ألفاظ خارجة عنه. فأما أن يتمحل لردها إلى ذلك الضابط. وإما أن يفردها بضوابط آخر حتى آل الأمر ببعض النحاة إلى أن جعل في الباب ثلاثين ضابطًا، وربما زاد غيره عليها، وكل هذا تكلف لا حاجة إليه. واسترحت من "شَرٌّ أَهَرَّ ذا نابٍ" [180] وبابه.
فإن قلت: فما عندك من الضابط إذا سلكت طريقتهم في ذلك؟
قلت: اسمع الآن قاعدة جامعة في هذا الباب لا يكاد يشذ عنها شيء منه. أصل المبتدأ أن يكون معرفة أو مخصوصًا بضرب من ضروب التخصيص بوجه تحصل الفائدة من الإخبارى عنه. فإن انتفت عنه وجوه التخصيص بأجمعها فلا يخبر عنه إلا أن يكون الخبر مجرورًا مفيدًا معرفة، مقدمًا عليه بهذه الشروط الأربعة، لأنه إذا تقدم وكان معرفة صار كان الحديث عنه وكأن المبتدأ المؤخر خبر عنه.
ومثال ذلك إذا قلت على زيد دين، فإنك تجد هذا الكلام في قوة قولك زيد مديان أو مدين. فمحط الفائدة هو الدين وهو المستفاد من الأخبار فلا تنحبس في قيود الأوضاع. وتقول على زيد، جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ فأنت تراه هو المخبر عنه في الحقيقة وليس المقصود الإخبار عن الدين بل عن زيد بأنه مديان، وإن كثف ذهنك عن هذا. فراجع شروط المبتدأ وشروط الخبر. وإن لم يكن الخبر مفيدًا لم تفد المسألة شيئًا. وكان لا فرق بين تقديم الخبر وتأخيره، كما إذا قلت في الدنيا: رجل كان في عدم الفائدة بمنزلة قولك رجل في الدنيا. فهنا لم تمتنع الفائدة بتقديم ولا تأخير. وإنما امتنعت من كون الخبر غير مفيد. ومثل هذا قولك في الدار امرأة فإنه كلام مفيد، لأنه بمنزلة قولك الدار فيها امرأة. فأخبرت عن الدار بحصول المرأة فيها في اللفظ والمعنى. فإنك لم ترد الإخبار عن المرأة بأنها في الدار، ولو أردت ذلك لحصلت حقيقة المخبر عنه أولًا، ثم أسندت إليه الخبر. وإنما مقصودك الإخبار عن الدار بأنها مشغولة بامرأة، وأنها اشثملت على امرأة فهذا القدر هو الذي حسن الإخبار عن النكرة ههنا فإنها ليست خبرًا في الحقيقة. وإنما هي في الحقيقة خبر عن المعرفة المتقدمة فهذا حقيقة الكلام، وأما تقديره الإعرابي النحوي فهو أن المجرور خبر مقدم، والنكرة مرفوعة بالابتداء.
فإن قلت: فمن أين امتنع تقديم هذا المبتدأ في اللفظ، فلا تقول: امرأة في الدار ودين على زيد؟
قلت: لأن النكرة تطلب الوصف طلبًا حثيثًا فيسبق الوهم إلى أن الجار والمجرور وصف لها لا خبر عنها إذ ليس من عادتها الإخبار عنها إلا بعد الوصف لها. فيبقى الذهن متطلعًا إلى ورود الخبر عليه وقد سبق إلى سمعه. ولكن لم يتيقن أنه الخبر بل يجوز أن يكون وصفًا فلا تحصل به الفائدة بل يبقى في ألم الانتظار للخبر والترقب له. فإذا قدمت الجار والمجرور عليها استحال أن يكون وصفًا لها، لأنه لا يتقدم موصوفه فذهب وهمه إلى أن الاسم المجرور المقدم هو الخبر والحديث عن النكرة وهو محط الفائدة.
إذا عرفت هذا. فمن التخصيصات المسوغة للابتداء بها، أن تكون موصوفة نحو: { ولعبد مؤمن خير من مشرك }، [181] أو عامة نحو "ما أحد خير من رسول الله"، وهل أحد عندك؟
ومن ذلك أن تقع في سياق التفضيل نحو قول عمر: تمرة خير من جرادة. فإن التفضيل نوع من التخصيص بالعموم. إذ ليس المراد واحدة غير معينة من هذا الجنس. بل المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة إيذانًا بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد فرد من أفراد الجنس، ومنه تأويل سيبويه في قوله تعالى: { طاعة وقول معروف }، [182] فإنه قدره طاعة أمثل وقول معروف أشبه وأجدر بكم وهذا أحسن من قول بعضهم: أن المسوغ للابتداء بها ههنا العطف عليها، لأن المعطوف عليها موصوف فيصح الابتداء به. وإنما كان قول سيبويه أحسن، لأن تقييد المعطوف بالصفة لا يقتضي تقييد المعطوف عليه بها. ولو قلت: طاعة أمثل، لساغ ذلك وإن لم يعطف عليها.
ومنه وقوع النكرة في سياق تفصيل بعد إجمال. كما إذا قلت: أقسم هذه الثياب بين هؤلاء فثوب لزيد وثوب لعمرو وثوب لبكر. فإن النكرة ههنا تخصصت وتعينت وزال إبهامها وشياعها في جنس الثياب. بل تخصصت بتلك الثياب المعية فكأنك قلت: ثوب منها لزيد وثوب منها لعمرو وهذا تقييد وتخصيص.
ومنه الابتداء بالنكرة إذا لم يكن الكلام خبرًا محضًا بل فيه معنى التزكية والمدح فمن ذلك قولهم أمت في الحجر لافيك، لأنهم لم يقولوا: أمت في الحجر وسكتوا حتى قرنوه بقولهم لا فيك. فصار معنى الكلام نسبة الأمت إلى الحجر أقرب من نسبته إليك، والأمت بالحجر أليق به منك، لأنهم أرادوا تزكية المخاطب ونفي العيب عنه ولم يريدوا الإخبار عن أمت بأنه في الحجر. بل هو في حكم النفي عن الحجر وعن المخاطب معًا إلا أن نفيه عن المخاطب أوكد، وإذا دخل الحديث معنى النفي فلا غروان يبتدأ بالنكرة لما فيه من العموم والفائدة.
ومن هذا قولهم: "شر أهر ذا ناب" وفيه تقديران. أحدهما أنه على الوصف أي شر عظيم، أو شر مخوف أهره. والثاني: أنه في معنى كلام آخر وهو ما أهر ذا ناب الأشر، أو إنما أهره شر، ولا ريب في صحة المسألة على وجه الفاعلية. فهكذا إذا كانت على وجه المبتدأ والخبر الذي في معناه.
ومنه قولهم "شرٌّ ما جاء به"، لأن معنى الكلام ما جاء به الأشر فأدت ما الزائدة هنا معنى شيئين النفي والإيجاب، كما أدته في قولك إنما جاء به شر وفي قوله تعالى: { فقليلًا ما يؤمنون } [183] أي ما يؤمنون إلا قليلًا وقليلًا ما يذكرون. وقوله: { فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم }، [184] أي ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم ونحو فبما رحمة من الله لنت لهم أي ما لنت لهم إلا برحمة من الله، ولا تسمع قول من يقول من النحاة: إن ما زائدة في هذه المواضع فإنه صادر عن عدم تأمل.
فإن قيل: فمن أين لكم أفادة؟ ما هذه المعنيين المذكورين من النفي؟ والإيجاب: وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح لم تفد إلا معنى واحدًا وهو النفي. فإذا لم يكن النفي صريحًا فيها كيف تفيد معنيين؟
قيل: نحن لم ندع أنها أفادت النفي والإيجاب بمجردها. ولكن حصل ذلك منها ومن القرائن المحتفة بها في الكلام.
أما قولهم شر ما جاء به، فلما انتظمت مع الاسم النكرة، والنكرة لا يبتدأ بها فلما قصد إلى تقديمها علم أن فائدة الخبر مخصوصة بها، وأكد ذلك التخصيص بما، فانتفى الأمر عن غير الاسم المبتدأ، ولم يكن إلا له حتى صار المخاطب يفهم من هذا ما يفهم من قوله ما جاء به الأشر، واستغنوا هنا بما هذه عن ما النافية وبالابتداء بالنكرة عن إلا.
وأما قولك: إنما زيد قائم فقد انتظمت بأن وامتزجت معها وصارتا كلمة واحدة، وأن تعطي الإيجاب الذي تعطيه إلا وما تعطي النفي. ولذلك جاز إنما يقوم أنا، ولا تكون أنا فاعلة إلا إذا فصلت من الفعل بالأ تقول ما يقوم إلا أنا، ولا تقول: يقوم أنا. فإذا قلت: إنما قام أنا صرت كأنك لفظت بما مع إلا. قال:
أدافع عن أعراض قومي وإنما ** يدافع عن أعراضهم أنا أو مثلي
فإذا عرفت أن زيادتها مع أن واتصالها بها اقتضى هذا النفي والإيجاب. فانقل هذا المعنى إلى اتصالها بحرف الجر من قوله: { فبما رحمة من الله } [185] و { فبما نقضهم ميثاقهم }. [186] وتأمل كيف تجد الفرق بين هذا التركيب وبين أن يقال: فبرحمة من الله، وفبنقضهم ميثاقهم. وأنك تفهم من تركيب الآية ما لنت لهم إلا برحمة من الله، وما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم، وكذلك قوله: { فقليلًا ما يؤمنون دلت على النفي بلفظها وعلى الإيجاب بتقديم ما حقه التأخير من المعمول وارتباط ما به مع تقديم. كما قرر في قولهم شر ما جاء به، وقد بسطنا هذا في كتاب الفتح المكي، وبينا هناك أنه ليس في القرآن حرف زائد وتكلمنا على كل ما ذكر في ذلك، وبينا أن كل لفظة لها فائدة متجددة زائدة على أصل التركيب. ولا ينكر جريان القلم إلى هذه الغاية وإن لم يكن من غرضنا فإنها أهم من بعض ما نحن فيه وبصدده.
فلنرجع إلى المقصود. فنقول: الذي صحح الابتداء بالنكرة في سلام عليكم. إن المسلم لما كان داعيًا وكان الاسم المبتدأ النكرة هو المطلوب بالدعاء صار هو المقصود المهتم به، وينزل منزلة قولك أسأل الله سلامًا عليكم، وأطلب من الله سلامًا عليك. فالسلام نفس مطلوبك ومقصودك. ألا ترى أنك لو قلت: أسأل الله عليك سلامًا لم يجز وهذا في قوته ومعناه. فتأمله فإنه بديع جدًا.
فإن قلت: فإذا كان في قوته فهلا كان منصوبًا مثل سقيًا ورعيًا، لأنه في معنى سقاك الله سقيًا ورعاك رعيًا؟
قلت: سيأتي جواب هذا في جواب السؤال العاشر في الفرق بين سلام إبراهيم، وسلام ضيفه إن شاء الله. وأيضا فالذي حسن الابتداء بالنكرة ههنا. إنها في حكم الموصوفة، لأن المسلم إذا قال: سلام عليكم فإنما مراده سلام مني عليك كما قال تعالى: { اهبط بسلام منا }، [187] ألا ترى أن مقصود المسلم إعلام من سلم عليه بأن التحية والسلام منه نفسه لما في ذلك من حصول مقصود السلام من التحيات والتواد والتعاطف فقد عرفت جواب السؤالين لما ابتدىء بالنكرة، ولم قدمت على الخبر بخلاف الباب في مثل ذلك والله أعلم.
فصل: تقديم السلام في جانب المسلم
وأما السؤال السابع وهو أنه لم كان في جانب المسلم تقديم السلام، وفي جانب الراد تقديم المسلم عليه.
فالجواب عنه: أن في ذلك فوائد عديدة.
أحدها: الفرق بين الرد والابتداء. فإنه لو قال له في الرد: السلام عليكم أو سلام عليكم لم يعرف أهذا رد لسلامه عليه أم ابتداء تحية منه؟ فإذا قال: عليك السلام. عرف أنه قد رد عليه تحيته ومطلوب المسلم من المسلم عليه أن يرد عليه سلامه. ليس مقصوده أن يبدأه بسلام كما ابتدأه به. ولهذا السر والله أعلم نهى النبي ﷺ المسلم عليه بقوله: عليك السلام عن ذلك فقال: «لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى»، وسيأتي الكلام على هذا الحديث ومعناه في موضعه. أفلا ترى كيف نهاه النبي ﷺ عن ابتداء السلام بصيغة الرد التي لا تكون إلا بعد تقديم سلام وليس في قوله: «فإنها تحية الموتى»، ما يدل على أن المشروع في تحايا الموتى، كذلك كما سنذكره، وإذا كانوا قد اعتمدوا الفرق بين سلام المبتدىء وسلام الراد، خصوا المبتدأ بتقديم السلام، لأنه هو المقصود، وخصوا الراد بتقديم الجار والمجرور.
الفائدة الثانية: وهي أن سلام الراد يجري مجرى الجواب. ولهذا يكتفي فيه بالكلمة المفردة الدالة على أختها. فلو قال: وعليك، لكان متضمنًا للرد كما هو المشروع في الرد على أهل الكتاب مع أنا مأمورون أن نرد على من حيانا بتحية مثل تحيته. وهذا من باب العدل الواجب لكل أحد فدل على أن قول الراد، وعليك مماثل لقول المسلم سلام عليك. لكن اعتمد في حق المسلم إعادة اللفظ الأول بعينه تحقيقًا للماثلة، ودفعًا لتوهم المسلم عدم رده عليه لاحتمال أن يريد عليك شيء آخر.
وأما أهل الكتاب فلما كانوا يحرفون السلام ولا يعدلون فيه، وربما سلموا سلامًا صحيحًا غير محرف ويشتبه الأمر في ذلك على الراد ندب إلى اللفظ المفرد المتضمن لرده عليهم نظير ما قالوه. ولم تشرع له الجملة التامة، لأنها إما أن تتضمن من التحريف مثل ما قالوا، ولا يليق بالمسلم تحريف السلام الذي هو تحية أهل الإسلام. ولا سيما وهو ذكر الله كما تقدم لأجل تحريف الكافر له، وإما أن يرد سلامًا صحيحًا غير محرف مع كون المسلم محرفًا للسلام فلا يستحق الرد الصحيح. فكان العدول إلى المفرد وهو عليك هو مقتضى العدل والحكمة مع سلامته من تحريف ذكر الله. فتأمل هذه الفائدة البديعة. والمقصود أن الجواب يكفي فيه قولك وعليك وإنما كمل تكميلًا للعدل وقطعًا للتوهم.
الفائدة الثالثة: وهي أقوى مما تقدم أن المسلم لما تضمن سلامة الدعاء للمسلم عليه بوقوع السلامة عليه، وحلولها عليه. وكان الرد متضمنًا لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل ما دعا به. فإنه إذا قال: وعليك السلام كان معناه وعليك من ذلك مثل ما طلبت لي. كما إذا قال: غفر الله لك. فإنك تقول له: ولك يغفر ويكون هذا أحسن من قولك وغفر لك. وكذا إذا قال: رحمة الله عليك، تقول: وعليك وإذا قال: عفا الله عنك. تقول: وعنك، وكذلك نظائره لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعو له للداعي في ذلك الدعاء لا إلى إنشاء دعاء مثل ما دعا به فكأنه قال: ولك أيضا، وعنك أيضا. أي وأنت مشارك لي في ذلك مماثل لي فيه لا أنفرد به عنك، ولا اختص به دونك، ولا ريب أن هذا المعنى يستدعي تقديم المشارك المساوي فتأمله.
فصل: ابتداء السلام بالنكرة والجواب بالمعرفة
وأما السؤال الثامن: وهو ما الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة وجوابه بلفظ المعرفة، فيقول: سلام عليكم فيقول الراد: وعليك السلام؟
فهذا سؤال يتضمن لمسألتين. إحداهما هذه. والثانية اختصاص النكرة بابتداء المكاتبة والمعرفة بآخرها، والجواب عنها بذكر أصل نمهده ترجع إليه مواقع التعريف والتنكير في السلام. وهو أن السلام دعاء وطلب وهم في ألفاظ الدعاء والطلب. إنما يأتون بالنكرة إما مرفوعة على الابتداء، أو منصوبة على المصدر، فمن الأول ويل له. ومن الثاني خيبة له وجدعًا وعقرًا وتربًا وجندلًا هذا في الدعاء عليه. وفي الدعاء له سقيًا ورعيًا وكرامة ومسرة فجاء سلام عليكم بلفظ النكرة، كما جاء سائر ألفاظ الدعاء. وسر ذلك أن هذه الألفاظ جرت مجرى النطق بالفعل. ألا ترى أن سقيًا ورعيًا وخيبة جرى مجرى سقاك الله ورعاك وخيبه، وكذلك سلام عليك جار مجرى سلمك الله والفعل نكرة فأحبوا أن يجعلوا اللفظ الذي هو جار مجراه كالبدل منه نكرة مثله.
وأما تعريف السلام في جانب الراد فنذكر أيضا أصلًا يعرف به سره وحكمته، وهو أن الألف واللام إذا دخلت على اسم السلام تضمنت أربعة فوائد.
أحدها: الإشعار بذكر الله تعالى، لأن السلام المعرف من أسمائه كما تقدم تقريره.
الفائدة الثانية: إشعارها بطلب معنى السلامة منه للمسلم عليه، لأنك متى ذكرت اسمًا من أسمائه فقد تعرضت به، وتوسلت به إلى تحصيل المعنى الذي اشتق منه ذلك الاسم.
الفائدة الثالثة: إن الألف واللام يلحقها معنى العموم في مصحوبها والشمول فيه في بعض المواضع.
الفائدة الرابعة: أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين، كما تقول: ناولني الكتاب واسقني الماء وأعطني الثوب لما هو حاضر بين يديك. فإنك تستغني بها عن قولك هذا فهي مؤدية معنى الإشارة.
وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع فقول الراد وعليك السلام بالتعريف متضمن للدلالة على أن مقصوده من الرد مثل ما ابتدىء به وهو هو بعينه فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته لي مردود عليك وواقع عليك فلو أتى بالرد منكرًا لم يكن فيه إشعار بذلك، لأن المعرف وأن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكر. ومن فهم هذا فهم معنى قول النبي ﷺ: «لن يغلب عسر يسرين». فإنه أشار إلى قوله تعالى: { فإن مع العسر يسرًا * إن مع العسر يسرًا }، [188] فاليسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة، فهو يسران. فالعسر محفوف بيسربن يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين.
وفائدة ثانية وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة. مقام فضل. ومقام عدل. ومقام ظلم، فالفضل أن يرد عليه أحسن من تحيته، والعدل أن ترد عليه نظيرها، والظلم أن تبخسه حقه وتنقصه منها. فاختير للراد أكمل اللفظين وهو المعرف بالأداة التي تكون للاستغراق والعموم كثيرًا ليتمكن من الإتيان بمقام الفضل.
وفائدة ثالثة وهي أنه قد تقدم أن المناسب في حقه تقديم المسلم عليه على السلام فلو نكره وقال عليك سلام لصار بمنزلة قولك عليك دين وفي الدار رجل فخرجه فخرج الخبر المحض. وإذا صار خبرًا بطل معنى التحية، لأن معناها الدعاء والطلب. فليس بمسلم من قال: عليك سلام. إنما المسلم من قال: سلام عليك. فعرف سلام الراد باللام إشعارًا بالدعاء للمخاطب. وإنه راد عليه التحية طالب له السلامة من اسم السلام. والله أعلم.
فصل: السلام في المكاتبة
وأما السؤال التاسع: وهو ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة، واختتامها بالمعرفة، فابتداؤها بالنكرة كما تقدم في ابتداء السلام النطقي بها سواء. فإن المكاتبة قائمة مقام النطق.
وأما تعريفه في آخر المكاتبة ففيه ثلاث فوائد.
أحدها: أن السلام الأول قد وقع الأنس بينهما به وهو مؤذن بسلامه عليه خصوصًا فكأنه قال: سلام مني عليك كما تقدم. وهذا أيضا من فوائد تنكر السلام الابتدائي للإيذان بأنه سلام مخصوص من المسلم. فلما استقر ذلك. وعلم في صدر الكتاب كان الأحسن أن يسلم عليه سلامًا هو أعم من الأول لئلا يبقى تكرارًا محضًا. بل يأتي بلفظ يجمع سلامه وسلام غيره. فيكون قد جمع له بين السلامتين الخاص منه، والعام منه ومن غيره. ولهذه الفائدة استحسنوا أن يكون قول الكاتب: وفلان يقرئك السلام، وفلان في آخر المكاتبة بعد والسلام عليك لهذا الغرض.
الفائدة الثانية: أنه قد تقدم أن السلام المعرف اسم من أسماء الله، وقد افتتح الكاتب رسالته بذكر الله فناسب أن يختمها باسم من أسمائه وهو السلام ليكون اسمه تعالى في أول الكتاب وآخره. وهذه فائدة بديعة.
الفائدة الثالثة: بديعة جدًا وهي جواب السؤال التاسع بعد هذا، وهي أن دخول الواو العاطفة في قول الكاتب: والسلام عليكم ورحمة الله فيها وجهان:
أحدهما: قول ابن قتيبة إنها عطف على السلام المبدوء به فكأنه قال: والسلام المتقدم عليكم.
والقول الثاني: إنها لعطف فصول الكتاب بعضه على بعض. فهي عطف لجملة السلام على ما قبلها من الجمل، كما تدخل الواو في تضاعيف الفصول وهذا أحسن من قول ابن قتيبة لوجوه؛ منها أن الكلام بين السلامين قد طال فعطف آخره بعد طوله على أوله قبيح غير مفهوم من السياق. الثاني: إنه إذا حمله على ذلك كان السلام الثاني هو الأول بعينه. فلم يفد فائدة متجددة. وفي ذلك شح بسلام متجدد وإخلال بمقاصد المتكاتبين من تعداد الجمل والفضول واقتضاء كل جملة لفائدة غير الفائدة المتقدمة. حتى أن قارىء الكتاب كلما قرأ جملة منه لفائدة غير الفائدة المتقدمة تطلعت نوازع قلبه إلى استفادة ما بعدها. فإذا كررت له فائدة واحدة مرتين سئمتها نفسه فكان اللائق بهذا المقصود أن يجدد له سلامًا غير الأول يسره به كما سره بالأول وهو السلام العام الشامل.
ولما فرغ الكاتب من فصول كتابه، وختمها أتى بالواو العاطفة مع السلام المعرف فقال: والسلام عليكم. أي وبعد هذا كله السلام عليكم. وقد تقدم أن السلام إذا انبنى على اسم مجرور قبله وكان سلام رد لا ابتداء فإنه يكون معرفًا نحو وعليك السلام، ولما كان سلام المكاتب ههنا ليس بسلام رد قدم السلام على المجرور فقال: والسلام عليكم وأتى باللام لتفيد تجديد سلام آخر والله أعلم.
وهذه فصاحة غريبة وحكمة سلفية موروثة عن سلف الأمة وعن الصحابة في مكاتباتهم. وهكذا كانوا يكتبون إلى نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد فرغنا من جواب السؤال التاسع المتعلق بواو العطف.
فصل: نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة
وأما السؤال العاشر: وهو السر في نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة ورفع سلامه.
فالجواب: أنك قد عرفت قول النحاة فيه. أن سلام الملائكة تضمن جملة فعلية، لأن نصب السلام يدل على سلمنا عليك سلامًا، وسلام إبراهيم تضمن جمل إسمية، لأن رفعه يدل على أن المعنى سلام عليكم. والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر والفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه وكان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه ﷺ وهو مقام الفضل إذ حياهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما قالوه.
وعندي فيه جواب أحسن من هذا، وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة. فنصب قوله سلامًا انتصاب مفعول القول المفرد كأنه قيل: قالوا قولًا سلامًا، وقالوا سدادًا وصوابًا ونحو ذلك. فإن القول إنما تحكي به الجمل. وأما المفرد فلا يكون محكيًا به. بل منصوب به انتصاب المفعول به ومن هذا قوله تعالى: { وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا }، [189] ليس المراد أنهم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوب، وإنما معناه قالوا: قولًا سلامًا مثل سدادًا وصوابًا، وسمي القول سلامًا، لأنه يؤدي معنى السلام ويتضمنه من رفع الوحشة وحصول الاستئناس.
وحكي عن إبراهيم لفظ سلامه فأتى به على لفظه مرفوعًا بالابتداء محكيًا بالقول. ولولا قصد الحكاية لقال سلامًا بالنصب، لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلى الحكاية ليس إلا. فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم، ورفعه ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدًا. وهو أن قوله: سلام عليكم من دين الإسلام المتلقي عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وأنه من ملة إبراهيم التي أمر الله بها وباتباعها. فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له، ولم يحك قول أضيافه، وإنما أخبر به على الجملة دون التفصيل. والله أعلم فزن هذا الجواب والذي قبله بميزان غير جائر يظهر لك أقواهما وبالله التوفيق.
فصل: نصب السلام ورفعه
وأما السؤال الحادي عشر: وهو نصب السلام من قوله تعالى: { وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا } ورفعه في قوله حكاية عن مؤمني أهل الكتاب { سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين }.
فالجواب عنه أن الله سبحانه مدح عباده الذين ذكرهم في هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم فقال: { وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا }، [190] فسلامًا هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه. أي قالوا: قولًا سلامًا أي سدادًا وصوابًا وسليمًا من الفحش والخنا ليس مثل قول الجاهلين الذين يخاطبونهم بالجهل، فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه المدح المذكور. بل كان يتضمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون سلموا عليهم، وليس هذا معنى الآية ولا مدح فيه، وإنما المدح في الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون الجهل بجهل مثله بل يقابلونه بالقول السلام فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن التي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم وتفسير السلف. وألفاظهم صريحة بهذا المعنى.
وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسن بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرها، فقال: الذين يمشون على الأرض هونًا أي بسكينة ووقار. والهون بفتح الهاء من الشيء الهين وهو مصدر هان هونًا. أي سهل. ومنه قولهم: يمشي على هينته ولا أحسبها إلا مولدة. ومع هذا فهي قياس اللفظة فإنها على بناء الحالة والهيئة فهي فعلة من الهون وأصلها هونة فقلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها، فاللفظة صحيحة المادة والتصريف.
وأما الهون بالضم فهو الهوان فأعطوا حركة الضم القوية للمعنى الشديد وهو الهوان، وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنى السهل وهو الهون. فوصف مشيهم بأنه مشي حلم ووقار وسكينة لامشي جهل وعنف وتبختر. ووصف نطقهم بأن سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهل وفحش وخناء وغلظة. فلهذا جمع بين المشي والنطق في الآية. فلا يليق بهذا المعنى الشريف العظيم الخطير أن يكون المراد منه سلام عليكم. فتأمله.
وأما قوله تعالى: { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين }، [191] فإنها وصف لطائفة من مؤمني أهل الكتاب قدموا على رسول الله ﷺ مكة فآمنوا به فعيرهم المشركون. وقالوا: قبحتم من وفد بعثكم قومكم لتعلموا خبر الرجل ففارقتم دينكم وتبعتموه ورغبتم عن دين قومكم. فأخبر عنهم بأنهم خاطبوهم خطاب متاركة وإعراض وهجر جميل. فقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم. لا نبتغي الجاهلين. وكان رفع السلام متعينًا، لأنه حكاية ما قد وقع ونصب السلام في آية الفرقان متعينًا، لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل. والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل. فتأمل هذه الأسرار التي أدناها يساوي رحلة، والله المحمود وحده على ما منَّ به وأنعم.
وهي المواهب من رب العباد فما ** يقال لولا ولا هلّا ولا فَلِما
فصل: تسليم الله أنبيائه ورسله
وأما السؤال الثاني عشر: وهو ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله، والسلام هو طلب ودعاء فكيف يتصور من الله؟
فهذا سؤال له شأن ينبغي الاعتناء به، ولا يهمل أمره وقل من يدرك سره إلا من رزقه الله فهمًا خاصًا وعناية، وليس هذا من شأن أبناء الزمان الذين غاية فاضلهم نقلًا أن يحكي قيلًا وقالًا. وغاية فاضلهم بحثًا أن يبدي احتمالًا، ويبرز أشكالًا، وأما تحقيق العلم كما ينبغي.
فللحروب أناس قائمون بها ** وللدواوين كتاب وحساب
وقد كان الأولى بنا الإمساك وكف عنان القلم. وأن نجري معهم في ميدانهم ونخاطبهم بما يألفونه. وأن لا نجلو عرائس المعاني على ضرير، ولا نزف خودها إلى عنين. ولكن هذه سلعة وبضاعة لها طلاب وعروس لها خطاب فستصير إلى أهلها، وتهدى إلى بعلها ولا تستطل الخطابة، فإنها نفثة مصدور.
فلنرجع إلى المقصود فنقول: لا ريب أن الطلب يتضمن أمورًا ثلاثة طالبًا ومطلوبًا ومطلوبًا منه، ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان الثلاثة وتغاير هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئًا من غيره. كما هو الطلب المعروف مثل من يأمر غيره وينهاه ويستفهمه. وأما إذا كان طالبًا من نفسه فهنا يكون الطالب هو المطلوب منه، ولم يكن هنا إلا ركنان طالب ومطلوب والمطلوب منه هو الطالب نفسه.
فإن قيل: كيف يعقل اتحاد الطالب والمطلوب منه وهما حقيقتان متغايرتان. فكما لا يتحد المطلوب والمطلوب منه ولا المطلوب والطالب. فكذلك لا يتحد الطالب والمطلوب منه، فكيف يعقل طلب الإنسان من نفسه؟
قيل: هذا هو الذي أوجب غموض المسألة وأشكالها، ولا بد من كشفه وبيانه، فنقول: الطلب من باب الإرادات والمريد كما يريد من غيره أن يفعل شيئًا، فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله والطلب النفسي وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها، والإرادة كالجنس له، فكما يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه، فكذلك يطلب من نفسه، وللفرق بين الطلب والإرادة وما قيل في ذلك مكان غير هذا. والمقصودان طلب الحي من نفسه أمر معقول يعلمه كل أحد من نفسه. وأيضا فمن المعلوم أن الإنسان يكون آمرًا لنفسه ناهيًا لنفسه قال تعالى: { إن النفس لأمارة بالسوء }، [192] وقال: { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى }. [193] وقال الشاعر:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله ** عار عليك إذا فعلت عظيم
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ** فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
وهذا أكثر من إيراد شواهده. فإذا كان معقولًا أن الإنسان يأمر نفسه وينهاها. والأمر والنهي طلب مع أن فوقه آمرًا وناهيًا، فكيف يستحيل ممن لا آمر فوقه ولا ناه أن يطلب من نفسه فعل ما يحبه وترك ما يبغضه.
وإذا عرف هذا عرف سر سلامه تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، وأنه طلب من نفسه لهم السلامة، فإن لم يتسع لهذا ذهنك فسأزيدك إيضاحًا وبيانًا وهو أنه قد أخبر سبحانه في كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا إيجاب منه على نفسه فهو الموجب وهو متعلق الإيجاب الذي أوجبه، فأوجب بنفسه على نفسه. وقد أكد النبي ﷺ هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاح ويكشف حقيقته بقوله في الحديث الصحيح: «لما قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»، وفي لفظ: «سبقت غضبي». فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة وصفة اليد ومحل الكتابة. وأنه كتاب وذكر مستقر الكتاب، وأنه عنده فوق العرش. فهذا إيجاب مؤكد بأنواع من التأكيد وهو إيجاب منه على نفسه. ومنه قوله تعالى: { وكان حقًا علينا نصر المؤمنين } [194] فهذا حق أحقه على نفسه فهو طلب وإيجاب على نفسه بلفظ الحق ولفظ على.
ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لمعاذ: «أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت الله ورسوله أعلم، قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار»، ومنه قوله ﷺ في غير حديث: «من فعل كذا وكذا كان حقًا على الله أن يفعل به كذا وكذا»، في الوعد والوعيد، فهذا الحق هو الذي أحقه على نفسه. ومنه الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي ﷺ في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. فهذا حق للسائلين عليه هو أحقه على نفسه لا أنهم هم أوجبوه ولا أحقوه. بل أحق على نفسه أن يجب من سأله كما أحق على نفسه في حديث معاذ أن لا يعذب من عبده. فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، والحقان هو الذي أحقهما وأوجبهما لا السائلون ولا العابدون، فإنه سبحانه:
ما للعباد عليه حق واجب ** كلا ولا سعى لديه ضائع
إن عذبوا فبعد له أو نعموا ** فبفضله وهو الكريم الواسع
ومنه قوله تعالى: وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن فهذا الوعد هو الحق الذي أحقه على نفسه وأوجبه. ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه ليفعلنه نحو: { فوربك لنسألنهم أجمعين }، [195] وقوله: { فوربك لنحشرنهم والشياطين }، [196] وقوله: { لنهلكن الظالمين }، [197] وقوله: { فالحق والحق أقول * لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين }، [198] وقوله: { فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار }، [199] وقوله: { فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين }، [200] إلى أمثال ذلك مما أخبر أنه يفعله أخبارًا مؤكدًا بالقسم. والقسم في مثل هذا يقتضي الحض والمنع بخلاف القسم على ما فعله تعالى مثل قوله: { يس * والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين }، [201] والقسم على ثبوت ما ينكره المكذبون، فإنه توكيد للخبر وهو من باب القسم المتضمن للتصديق. ولهذا تقول الفقهاء اليمين ما اقتضى حقًا، أو منعًا، أو تصديقًا، أو تكذيبًا. فالقسم الذي يقتضي الحض والمنع هو من باب الطلب، لأن الحض والمنع طلب ومن هذا ما أخبر به أنه لا بد أن يفعله لسبق كلماته به كقوله: { ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون }، [202] وقوله: { وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين }، [203] وقوله: { ولولا كلمة سبقت من ربك }، [204] فهذا إخبار عما يفعله ويتركه أنه لسبق كلمته به فلا يتغير.
ومن هذا تحريمه سبحانه ما حرمه على نفسه كقوله فيما يرويه عنه رسوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا». فهذا التحريم نظير ذلك الإيجاب ولا يلتفت إلى ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلة، فإن الناظر في سياق هذه المواضع. ومقصودها به يجزم ببعد المراد منها كقول بعضهم: إن معنى الإيجاب والكتابة في ذلك كله هو إخباره به، ومعنى كتب ربكم على نفسه الرحمة أخبر بها عن نفسه وقوله: حرمت الظلم على نفسي أي أخبرت أنه لا يكون ونحو ذلك مما يتيقن المرء أنه ليس هو المراد بالتحريم، بل الإخبار ههنا هو الإخبار بتحريمه وإيجابه على نفسه. فمتعلق الخبر هو التحريم والإيجاب، ولا يجوز إلغاء متعلق الخبر فإنه يتضمن إبطال الخبر ولهذا إذا قال القائل: أوجبت على نفسي صومًا فإن متعلقه وجوب الصوم على نفسه، فإذا قيل: إن معناه أخبرت بأني أصوم كان ذلك إلغاء وإبطالًا لمقصود الخبر فتأمله.
وإذا كان معقولًا من الإنسان أنه يوجب على نفسه ويحرم ويأمرها وينهاها مع كونه تحت أمر غيره ونهيه، فالآمر الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه ويكتب على نفسه وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له ورضاه به، وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته له وإرادة أن لا يفعله. فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه وكراهته، لأن يفعله تمنع وقوعه منه وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عباده ويكرهه. فإن محبة ذلك منهم لا تستلزم وقوعه، وكراهته منهم لا تمنع وقوعه. ففرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي يقع مع كراهته وبغضه له ويتخلف مع محبته له ورضاه به بخلاف فعله هو سبحانه، فهذا نوع وذاك نوع، فتدبر هذا الموضع الذي هو منزلة أقدام الأولين والآخرين إلا من عصم الله وهداه إلى صراط مستقيم. وتأمل أين تكون محبته وكراهته موجبة لوجود الفعل، ومانعة من وقوعه وأين تكون المحبة منه والكراهة لا توجب وجود الفعل، ولا تمنع وقوعه.
ونكتة المسألة هو الفرق بين ما يريد أن يفعله هو سبحانه وما لا يريد أن يفعله، وبين ما يحبه من عبده أن يفعله العبد، أو لا يفعله ومن حقق هذا المقام زالت عنه شبهات ارتبكت فيها طوائف من النظار والمتكلمين والله الهادي إلى سواء السبيل.
واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف.
فطائفة منعت أن يجب عليه شيء، أو يحرم عليه شيء بإيجابه وتحريمه. وهم كثير من مثبتي القدر الذين ردوا أقوال القدرية النفاة وقابلوهم أعظم مقابلة، نفوا لأجلها الحكم والأسباب والتعليل وأن يكون العبد فاعلًا أو مختارًا.
الطائفة الثانية بإزاء هؤلاء، أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم جعلوها شريعة له يجب عليه مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمها، وأوجبوا عليه من جنس ما يجب على العباد، وحرموا عليه من جنس ما يحرم عليهم، ولذلك كانوا مشبهة في الأفعال والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين تعطيل صفاته وجحد نعوت كماله والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه، وحرموه فشبهوا في أفعاله وعطلوا في صفات كماله فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال، وسموه توحيدًا وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح من الأفعال، وسموا ذلك عدلًا، وقالوا: نحن هل العدل والتوحيد فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شتى من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها وتوحيدهم إلحادهم في أسمائه الحسنى، وتحريف معانيها عما هي عليه. فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلًا وعدلهم شركًا وهذا مقرر في موضعه.
والمقصود أن هذه الطائفة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، وهدى الله الأمة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فلم يقيسوه بخلقه، ولم يشبهوه بهم في شيء من صفاته ولا أفعاله، ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك، ولم يوجبوا عليه شيئًا، ولم يحرموا عليه شيئًا، بل أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايات المحمودة التي يستحق عليها كمال الحمد والثناء، فإن العباد لا يحصون ثناء عليه أبدا بل هو كما أثنى على نفسه. وهذا بين بحمد الله عند أهل العلم والإيمان مستقر في فطرهم ثابت في قلوبهم يشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين وهم لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء. بل هم إلى الله ورسوله متحيزون، وإلى محض سنته منتسبون يدينون دين الحق أنى توجهت ركائبه، ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه لا تستفزهم بداوات آراء المختلفين، ولا تزلزلهم شبهات المبطلين. فهم الحكام على أرباب المقالات والمميزون لما فيها من الحق والشبهات، يردون على كل باطله ويوافقونه فيما معه في الحق، فهم في الحق سلمه وفي الباطل حربه. لا يميلون مع طائفة على طائفة، ولا يجحدون حقها لما قالته من باطل سواه. بل هم ممتثلون قول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون }. [205]
فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله، فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطىء على أن لا يعدلوا عليهم. بل يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله، وما جاء به منه علمًا وعملًا. ودعوة إلى الله على بصيرة، وصبرًا من قومهم على الأذى في الله، وإقامة لحجة الله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل لا كمن نصب معالمه صادرة عن آراء الرجال، فدعا إليها وعاقب عليها وعادى من خالفها بالعصبية وحمية لجاهلية، والله المستعان وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا به. وليكن هذا تمام الكلام في هذا السؤال. فقد تعدينا به طوره وإن لم نقدره قدره.
فصل: التسليم بلفظ النكرة أو المعرفة
وأما السؤال الثالث عشر: وهو ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة. وكذلك تسليمهم على نفوسهم وعلى عباده الصالحين؟
فقد تقدم بيان الحكمة في كون السلام ابتداء بلفظ النكرة، ونزيد هنا فائدة أخرى وهي أنه قد تقدم أن في دخول اللام في السلام أربعة فوائد وهذا المقام مستغن عنها، لأن المتكلم بالسلام هو الله تعالى. فلم يقصد تبركًا بذكر الاسم كما يقصده العبد فإن التبرك استدعاء البركه واستجلابها. والعبد هو الذي يقصد ذلك، ولا قصد أيضا تعرضًا وطلبًا على ما يقصده العبد، ولا قصد العموم. وهو أيضا غير لائق هنا، لأن سلامًا منه سبحانه كاف من كل سلام، ومغن عن كل تحية ومقرب من كل أمنية. فأدنى سلام منه ولا أدنى هناك يستغرق الوصف ويتم النعمة ويدفع البؤس ويطيبب الحياة ويقطع مواد العطب والهلاك، فلم يكن لذكر الألف واللام هناك معنى. وتأمل قوله تعالى: { وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر }، [206] كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرًا مخبرًا عنه بأنه أكبر من كل وعدوا به. فأيسر شيء من رضوانه أكبر الجنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته، ولهذا لما يتجلى لأوليائه في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون. فيقولون: ربنا وأي شيء نريد أفضل مما أعطيتنا. فيقول تبارك وتعالى: إن لكم عندي أفضل من ذلك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا.
وقد بان بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده وبين سلام العباد عليهم. فإن سلام العباد لما كان متضمنًا لفوائد الألف واللام التي تقدمت من قصد التبرك باسمه السلام والإشارة إلى طلب السلام له وسؤالها من الله باسم السلام، وقصد عموم السلام كان الأحسن في حق المسلم على الرسول. أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن كان قد ورد سلام عليك، فالمعرفة أكثر وأصح وأتم معنى. فلا ينبغي العدول عنه ويشح في هذا المقام بالألف واللام والله أعلم.
فصل: التسليم على يحيى والمسيح
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابع عشر: وهو ما الحكمة في تسليم الله تعالى على يحيى بلفظ النكرة، وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة لا ما يقوله من لا تحصيل له إن سلام يحيى جرى مجرى ابتداء السلام في الرسالة والمكاتبة فنكر، وسلام المسيح جرى مجرى السلام في آخر المكاتبة فعرف. فإن السورة كالقصة الواحدة. ولا يخفى فساد هذا الفرق فإنهما سلامان متغايران من مسلمين. أحدهما سلام الله تعالى على عباده. والثاني سلام العبد على نفسه. فكيف يبنى أحدهما على الآخر؟ وكذلك قول من قال: إن الثاني عرف لتقدم ذكره في اللفظ فكانت الألف واللام فيه للعهد وهذا أقرب من الأول لإمكان أن يكون المسيح أشار إلى السلام الذي سلمه الله على يحيى، فأراد أن لي من السلام في مثل هذه المواطن الثلاثة مثل ما حصل له. والله أعلم.
فصل: تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح
وأما السؤال الخامس عشر: وهو ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلاثة؟
فسره والله أعلم أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة. وكلما كان الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامة، وتعلقت بها الهمة، فذكرت هذه المواطن الثلاثة، لأن السلامة فيها آكد وطلبها أهم والنفس عليها أحرص، لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها موطن النفس على صحبتها وسكناها إلى دار هو فيها معرض للآفات والمحن والبلاء. فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارها كما أفصح الشاعر بهذا المعنى حيث يقول:
تأمل بكاء الطفل عند خروجه ** إلى هذه الدنيا إذا هو يولد
تجد تحته سرًا عجيبًا كأنه ** بكل الذي يلقاه منها مهدد
وإلا فما يبكيه منها وإنها ** لأوسع مما كان فيه وأرغد
ولهذا من حين خرج ابتدرته طعنه الشيطان في خاصرته فبكى لذلك، ولما حصل له من الوحشة بفراق وطنه الأول، وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون، وأما ما أخبر به الرسول، فليس في صناعتهم ما يدل عليه، كما ليس فيها ما ينفيه. فكان طلب السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور.
الموطن الثاني: خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت، ونسبة الدنيا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريبًا وتمثيلًا وإلا فالأمر أعظم من ذلك، وأكبر، وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور.
الموطن الثالث: موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياء ولا نسبة لما قبله من الدار إليه وطلب السلامة فيه آكد من جميع ما قبله. فإن عطبه لا يستدرك وعثرته لا تقال، وسقمه لا يداوى. وفقره لا يسد. فتأمل كيف خص هذه المواطن بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيها وأعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارها، وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس وذهاب الوحشة، ثم نزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم الابتلاء، وعند معاينته هول المطلع. إذا قدم على الله وحيدًا مجردًا عن كل مؤنس إلا ما قدمه من صالح عمل وعند موافاته القيامة مع الجمع إلا أعظم ليصير إلى إحدى الدارين التي خلق لها، واستعمل بعمل أهلها، فأي موطن أحق بطلب السلامه من هذه المواطن. فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه.
فصل: تسليم نبينا وتسليم موسى
وأما السؤال السادس عشر: وهو ما الحكمة في تسليم النبي ﷺ على من اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليهم بلفظ المعرفة؟
فالجواب عنه أن تسليم النبي ﷺ تسليم ابتدائي. ولهذا صدر به الكتاب حيث قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى ففي تنكيره ما في تنكير سلام من الحكمة، وقد تقدم بيانها. وأما قول موسى: السلام على من اتبع الهدى، فليس بسلام تحية فإنه لم يبتدىء به فرعون بل هو خبر محض. فإن من اتبع الهدى له السلام المطلق دون من خالفه فإنه قال له: { فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى * إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى }. [207]
أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته. وإنما وقع متوسطًا بين الكلامين إخبار محضًا عن وقوع السلامة، وحلولها على من اتبع الهدى. ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه. وإيثاره من السلامة. وإنه إن اتبع الهدى الذي جاءه به، فهو من أهل السلام والله أعلم.
وتأمل حسن سياق هذه الجمل، وترتيب هذا الخطاب، ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته. كيف ابتدأ الخطاب بقول: أنا رسولا ربك وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك لننازعك ملكك ولا لنشركك فيه. بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك. وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله. كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك واستاذك وإن كان أستاذهما معا، ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له، ثم إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل ويخلي بينهم وبينهما، ولا يعذبهم ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم، وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شططًا ولم يرهقه من أمره عسرًا. بل طلب منه غاية النصف.
ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات أحدها قوله تعالى: { قد جئناك بآية من ربك }، [208] فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة. فقد قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى والسلام على من اتبع الهدى، وإما أن يكذب ويتولي، فالعذاب على من كذب وتولى فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة، وبيان ما يستحقه السامع المطيع. وما يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب.
فصل: قل الحمد لله وسلام على عباده
وأما السؤال السابع عشر: وهو أن قوله: { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى } هل السلام من الله فيكون المأمور به الحمد والوقف التام عليه، أو هو داخل في القول والأمر بهما جميعًا؟
فالجواب عنه أن الكلام يحتمل الامرين ويشهد لكل منهما هذا ضرب من الترجيح فيرجح كونه داخلًا في جملة القول بأمور:
منها اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل. وهذا يقتضي أن يكون فعل القول واقعًا على كل واحد منهما هذا هو الأصل ما لم يمنع منه مانع، ولهذا إذا قلت: الحمد الله وسبحان الله، فإن التسبيح هنا داخل في المقول.
ومنها أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبر على خبر وهو الأصل. ولو كان منقطفًا عنه كان عطفًا على جملة الطلب، وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب.
ومنها أن قوله: { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى }، [209] ظاهر في أن المسلم هو القائل الحمد لله ولهذا أتى بالضمير بلفظ الغيبة، ولم يقل سلام على عبادي.
ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور. أحدها: مطابقته لنظائره في القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفى كقوله: { سلام على نوح في العالمين }، [210] { سلام على إبراهيم }، [211] { سلام على موسى وهارون }، [212] { سلام على إل ياسين }. [213]
ومنها أن عباده الذين اصطفى هم المرسلون والله سبحانه يقرن بين تسبيحه لنفسه. وسلامه عليهم، وبين حمده لنفسه، وسلامه عليهم. أما الأول فقال تعالى: { سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين }، [214] وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما لا يليق بجلاله، ثم سلامه على رسله.
وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع فإنه نزه نفسه تنزيهًا مطلقًا، كما نزه نفسه عما يقول خلقه فيه، ثم سلم المرسلين. وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون لهم المخالفون لهم. وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاؤوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاؤوا به التوحيد ومعرفة الله ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد فهو الحق المحض. وما خالفه هو الباطل والكذب المحال. وهذا المعنى بعينه في قوله: { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى } فإنه يتضمن حمده بما من نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة، والأسماء الحسنى، وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذب. وذلك يتضمن سلامة ما جاؤوا به كل باطل. فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه. فهذا يشهد لكون السلام هنا من الله تعالى. كما هو في آخر الصافات.
وأما عطف الخبر على الطلب فما أكثره فمنه قوله تعالى: { قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان }، [215] وقوله: { وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين }، [216] وقوله: { ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين }، [217] ونظائره كثيرة جدًا.
وفصل الخطاب في ذلك أن يقال الآية تتضمن الأمرين جميعًا وتنتظمهما انتظامًا واحدًا. فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامه وليس فيه إلا البلاغ. والكلام كلام الرب تبارك وتعالى فهو الذي حمد نفسه وسلم على عباده. وأمر رسوله بتبليغ ذلك، فإذا قال الرسول: الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حمد الله وسلم على عباده بما حمد به نفسه، وسلم به هو على عباده. فهو سلام من الله ابتداء ومن المبلغ بلاغًا، ومن العباد اقتداء وطاعة. فنحن نقول كما أمرنا ربنا تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ونظير هذا قوله تعالى: { قل هو الله أحد }، فهو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده. فإذا قال العبد: قل هو الله أحد كان قد وحد الله بما وحد به نفسه وأتى بلفظة قل تحقيقًا لهذا المعنى. وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله والله أعلم.
وهذا بخلاف قوله: { قل أعوذ برب الناس } فإن هذا أمر محض ط بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله أعوذ برب الناس، فإن الله لا يستعيذ من أحد، وذلك عليه محال بخلاف قوله: { قل هو الله أحد } فإنه خبر عن توحيده وهو سبحانه يخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحد، فتأمل هذه النكتة البديعة والله المستعان.
فصل: عليك السلام تحية الموتى
وأما السؤال الثامن عشر: وهو نهي النبي ﷺ من قال له عليك السلام عن ذلك وقال: لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، فما أكثر من ذهب عن الصواب في معناه وخفي عليه مقصوده وسره. فتعسف ضروبًا من التأويلات المستنكرة الباردة ورد بعضهم الحديث وقال: وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال في تحية الموتى: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»، قالوا: وهذا أصح من حديث النهي. وقد تضمن تقديم ذكر لفظ السلام فوجب المصير إليه، وتوهمت طائفة. أن السنة في سلام الموتى أن يقال: عليكم السلام. فرقًا بين السلام على الأحياء والأموات.
وهؤلاء كلهم إنما أتوا ما أتوه من عدم فهمهم لمقصود الحديث. فإن قوله ﷺ: «عليك السلام تحية الموت»، ليس تشريعًا منه وإخبارًا عن أمر شرعي، وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة الشعراء والناس. فإنهم كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء كما قال قائلهم:
عليك سلام الله قيس بن عاصم ** ورحمته ما شاء أن يترحما
وقول الذي رثى عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
عليك سلام من أمير وباركت ** يدُ الله في ذاك الأديم الممزق
وهذا أكثر في أشعارهم من أن نذكره ههنا. والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه فضلًا عن كونه سنة، بل نهيه عنه مع إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته، وأن السنة في السلام تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه في السلام على الأحياء وعلى الأموات. فكما لا يقال في السلام على الأحياء عليكم السلام، فكذلك لا يقال في سلام الأموات كما دلت السنة الصحيحة على الأمرين، وكأن الذي تخيله القوم من الفرق. أن المسلم على غيره لما كان يتوقع الجواب. وأن يقال له: وعليك السلام بدأوا باسم السلام على المدعو له توقعًا لقوله وعليك السلام. وأما الميت فما لم يتوقعوا منه ذلك قدموا المدعو له على الدعاء، فقالوا عليك السلام.
وهذا الفرق لو صح كان دليلًا على التسوية بين الأحياء والأموات في السلام. فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع الجواب أيضا. قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»، وبالجملة فهذا الخيال قد أبطلته السنة الصحيحة.
وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها وهي أن السلام شرع على الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلم عليهم، لأنه دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعو له كقوله تعالى: { رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت }، [218] وقوله: { سلام على إبراهيم }، [219] { سلام على نوح }، [220] { سلام على إل ياسين }، [221] { سلام عليكم بما صبرتم }. [222]
وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه على المدعو به غالبًا كقوله تعالى لإبليس: { وإن عليك لعنتي }، [223] وقوله: { وإن عليك اللعنة }، [224] وقوله: { عليهم دائرة السوء }، [225] وقوله: { وعليهم غضب }.
وسر ذلك والله أعلم أن في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذي تشتهيه النفوس، وتطلبه ويلذ للسمع لفظه فيبدأ السمع بذكر الاسم المحبوب المطلوب، ويبدأ القلب بتصوره فيفتح له القلب والسمع. فيبقى السامع كالمنتظر لمن يحصل هذا وعلى من يحل، فيأتي باسمه فيقول: عليك أو لك. فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحل الذي هو المقصود بالسلام.
وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء وأنه عليه وحده كأنه قيل له: هذا عليك وحدك لا يشركك فيه السامعون بخلاف الدعاء بالخير. فإن المطلوب عمومه وكل ما عم به الداعي كان أفضل.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فضل عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء في الأرض. وذكر في ذلك حديثا مرفوعا عن علي أن النبي ﷺ مر به وهو يدعو فقال: "يا علي فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض". [226]
وفيه فائدة ثانية أيضا، وهي أنه في الدعاء عليه. إذا قال له: عليك انفتح سمعه وتشوف قلبه إلى أي شيء يكون عليه. فإذا ذكر له اسم المدعو به صادف قلبه فارغًا متشوفًا لمعرفته. فكان أبلغ في نكايته. ومن فهم هذا فهم السر في حذف الواو في قوله تعالى: { وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها }، [227] ففاجأهم وبغتهم عذابها وما أعد الله فيها فهم بمنزلة من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من أنواع الشر إلا أنه متوقع منه شرًا عظيمًا ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه. وهذا كما تجد في الدنيا من يساق إلى السجن فإنه يساق إليه وبابه مغلق. حتى إذا جاءه فتح الباب في وجهه. ففاجأته روعته وألمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه.
وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا مساقين إلى دار الكرامة وكان من تمام إكرام المدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحًا، فلا يلحق ألم الانتظار فقال في أهل الجنة: { حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها }، [228] وحذف الجواب تفخيمًا لأمره وتعظيمًا لشأنه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو، ومن دعوى كونها واو الثمانية. لأن أبواب الجنة ثمانية. فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحدًا بعد واحد فينتهون إلى السبعة، ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو وهنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية، ولا عدها فتأمله. على أن في كون الواو تجيء للثمانية كلام آخر قد ذكرناه في الفتح المكي وبينا المواضع التي ادعى فيها. أن الواو للثمانية وأين يمكن دعوى ذلك وأين يستحيل؟
فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن سيد الخلائق ﷺ يأتي باب الجنة فيلقاه مغلقًا حتى يستفتحه.
قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق أن الجنة تكون مغلقة. فلا تفتح لأهلها إلا على يديه فلو جاءها وصادفها مفتوحة فدخلها هو وأهلها لم يعلم الداخلون أن فتحها كان على يديه وأنه هو الذي استفتحها لهم. ألا ترى أن الخلق إذا راموا دخول باب مدينة، أو حصن وعجزوا، ولم يمكنهم فتحه حتى جاء رجل ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه كان في ذلك من ظهور سيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم فوجدوه مفتوحًا.
وقد خرجنا عن المقصود وما أبعدنا، ولا تستطل هذه النكت، فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق والله المان بفضله وكرمه.
فصل: إذا سلم أهل الكتاب فقولوا وعليكم
وأما السؤال التاسع عشر: وهو دخول الواو في قوله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم»، فقد استشكلها كثير من الناس كما ذكر في السؤال. وقالوا: الصواب حذفها. وأن يقال: عليكم. قال الخطابي: يرويه عامة المحدثين بالواو وابن عيينة: يرويه بحذفها وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوا بعينه مردودًا عليهم وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين.
قلت: معنى ما أشار إليه الخطابي: إن الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الجملة وزيادة الثانية عليها، كما إذا قلت: زيد كاتب. فقال المخاطب وشاعر: فإنه يقتضي إثبات الكتابة له وزيادة وصف الشعر، وكذلك إذا قلت لرجل: فلان محب لك، فقال: ومحسن إلي.
ومن هنا استنبط السهيلي في الروض أن عدة أصحاب الكهف سبعة. قال: لأن الله تعالى عطف عليهم الكلب بحرف الواو فقال: وثامنهم كلبهم، ولم يذكر الواو فيما قبل ذلك من كلامهم. والواو تقتضي تقرير الجملة الأولى. وما استنبطه حسن غير أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلًا في جملة قولهم. بل يكون قد حكى سبحانه أنهم قالوا: سبعة، ثم أخبر تعالى أن ثامنهم الكلب فحينئذ يكون ذلك تقريرًا لما قالوه وإخبارًا يكون الكلب ثامنًا، وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة قولهم، وأنهم قالوا: هذا وهذا لم يظهر ما قاله، ولا تقتضي الواو في ذلك تقريرًا ولا تصديقًا فتأمله.
وأما قوله: المتحدثون يروونه بالواو. فهذا الحديث رواه عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا وعليكم». قال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار وقال فيه: وعليكم. انتهى كلامه.
وأخرجه الترمذي والنسائي كذلك. ورواه مسلم وفي بعض طرقه فقل عليك. ولم يذكر الواو.
وحديث مالك الذي ذكره أبو داود وأخرجه البخاري في صحيحه، وحديث سفيان الثوري متفق عليه كلها بالواو.
وأما ما أشار إليه الخطابي من حديث ابن عيينة فرواه النسائي في سننه بإسقاط الواو.
وإذا عرف هذا فإدخال الواو في الحديث لا تقتضي محذورًا البتة، وذلك لأن التحية التي يحيون بها المسلمين غايتها الإخبار بوقوع الموت عليهم وطلبه، لأن السام معناه الموت، فإذا حيوا به المسلم فرده عليهم كان من باب القصاص والعدل وكان مضمون رده أنا لسنا نموت دونكم. بل وأنتم أيضا تموتون فما تمنيتموه لنا حالٌّ بكم واقع عليكم.
وأحسن من هذا أن يقال: ليس في دخول الواو تقرير لمضمون تحيتهم، بل فيه ردها وتقريرها لهم أي ونحن أيضا. ندعو عليكم بما دعوتم به علينا. فإن دعاءهم قد وقع. فإذا رد عليهم المجيب بقوله: وعليكم. كان في إدخال الواو سر لطيف وهو الدلالة على أن هذا الذي طلبتموه لنا، ودعوتم به هو بعينه مردود عليكم لا تحية غيره، فإدخال الواو مفيد لهذه الفائدة الجليلة.
وتأمل هذا في مقابلة الدعاء بالخير. إذا قال: غفر الله لك، فقال له: ولكن المعنى أن هذه الدعوة بعينها مني لك. ولو قلت: غفر الله لك، فقال: لك لم يكن فيه إشعار بأن الدعاء الثاني هو الأول بعينه فتأمله فإنه بديع جدًا. وعلى هذا فيكون الصواب إثبات الواو كما هو ثابت في الصحيح والسنن. فهذا ما ظهر لي في هذه اللفظة فمن وجد شيئًا فليلحقه بالهامش، فيشكر الله له وعباده سعيه. فإن المقصود الوصول إلى الصواب، فإذا ظهر وضع ما عداه تحت الأرجل. وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة بما أمكننا في كتاب تهذيب السنن.
فصل: اقتران الرحمة والبركة بالسلام
وأما السؤال العشرون: وهو ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام؟
فالجواب عنه أن يقال: لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء. أحدها: سلامته من الشر ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. والثاني: حصول الخير له. والثالث: دوامه وثباته له؛ فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعه بالحياة شرعت التحية متضمنة للثلاثة، فقوله: سلام عليكم يتضمن السلامة من الشر وقوله: ورحمة الله يتضمن حصول الخير. وقوله: وبركاته يتضمن دوامه وثباته كما هو موضوع لفظ البركة وهو كثرة الخير واستمراره. ومن هنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور الرحيم في عامة القرآن. ولما كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحد. بل هي متضمنة لكل مطالبه وكل المطالب دونها ووسائل إليها، وأسباب لتحصيلها جاء لفظ التحية دالًا عليها بالمطابقة تارة وهو كمالها، وتارة دالًا عليها بالتضمن، وتارة دالًا عليها باللزوم فدلالة اللفظ عليها مطابقة إذا ذكرت بلفظها، ودلالته بالتضمن إذا ذكر السلام والرحمة فإنهما يتضمنان الثالث، ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على السلام وحده، فإنه يستلزم حصول الخير وثباته إذ لوعدم لم تحصل السلامة المطلقة. فالسلامة مستلزمة لحصول الرحمة كما تقدم تقريره.
وقد عرف بهذا فضل هذه التحية وكمالها على سائر تحيات الأمم ولهذا اختارها الله لعباده وجعلها تحيتهم بينهم في الدنيا وفي دار السلام. وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكماله. فإذا كان هذا في فرع من فروع الإسلام وهو التحية التي يعرفها الخاص والعام. فما ظنك بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبهجته التي شهدت بها العقول والفطر. حتى أنها من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على نبوة محمد ﷺ وكمال دينه وفضله وشرفه على جميع الأدايان، وأن معجزته في نفس دعوته فلو اقتصر عليها كانت آية وبرهانًا على صدقه. وأنه لا يحتاج معها إلى خارق، ولا آية منفصلة. بل دينه وشريعته ودعوته وسيرته من أعظم معجزاته عند الخاصة من أمته حتى أن إيمانهم به، إنما هو مستند إلى ذلك. والآيات في حقهم مقويات بمنزلة تظاهر الأدلة. ومن فهم هذا انفتح له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان، بل باب من أبواب الجنة العاجلة يرقص القلب فيها طربًا ويتمنى أنه له بالدنيا وما فيها.
وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيساعد على تعليق كتاب يتضمن ذكر بعض محاسن الشريعة وما فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته، وبره بعباده ولطفه بهم، وما اشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد إليها، وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها. وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا برحمة، ولم يحسن إليهم إحسانًا أعظم من إحسانه إليهم، بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة، ولهذا لم يذكر في القرآن لفظة المن عليهم إلا في سياق ذكرها كقوله: { لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين }، [229] وقوله: { يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين } [230] فهي محض الإحسان إليهم والرأفة بهم، وهدايتهم إلى ما به صلاحهم في الدنيا والآخرة. لا أنها محض التكليف والامتحان الخالي عن العواقب الحميدة التي لا سبيل إليها إلا بهذه الوسيلة فهي لغاياتها المجربة المطلوبة بمنزلة الأكل للشبع والشرب للري والجماع لطلب الولد. وغير ذلك من الأسباب التي ربطت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعزة. فلذلك نصب هذا الصراط المستقيم وسيلة وطريقًا إلى الفوز الأكبر والسعادة، ولا سبيل إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق، كما لا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالعبور على الصراط. فالشريعة هي حياة القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والمشقة الحاصلة فيها. والتكليف وقع بالقصد الثاني كوقوعه في الأسباب المفضية إلى الغايات المطلوبة لا أنه مقصود لذاته فضلًا عن أن يكون هو المقصود لا سواه. فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من الفكر في مصادرها ومواردها يفتح لك بابًا واسعًا من العلم والإيمان. فتكون من الراسخين في العلم لا من الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
وكما أنها آية شاهدة له على ما وصف به نفسه من صفات الكمال. فهي آية شاهدة لرسوله بأنه رسوله حقًا، وأنه أعرف الخلق وأكملهم وأفضلهم وأقواهم إلى الله وسيلة، وأنه لم يؤت عبد مثل ما أوتي فوالهفاه على مساعد على سلوك هذه الطريق، واستفتاح هذا الباب والإفضاء إلى ما وراءه ولو بشطر كلمة، بل والهفاه على من لا يتصدى لقطع الطريق والصد عن هذا المطلب العظيم ويدع المطي وحاديها، ويعطي القوس باريها، ولكن إذا عظم المطلوب قل المساعد وكثر المعارض والمعاند وإذا كان الاعتماد على مجرد مواهب الله وفضله يغنيه ما يتحمله المتحمل من أجله. فلا يثنك شنآن من صد عن السبيل وصدف. ولا تنقطع مع من عجز عن مواصلة السرى ووقف، فإنما هي مهجة واحدة فانظر فيما تجعل تلفها وعلى من تحتسب خلفها.
أنت القتيل بكل من أحببته ** فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي
وانفق أنفاسك فيما شئت فإن تلك النفقة مردودة بعينها عليك وصائرة لا سواها إليك وبين العبد وبين السعادة والفلاح صبر ساعة لله وتحمل ملامة في سبيل الله.
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ** ويذهب هذا كله ويزول
وقد أطلنا ولكن ما أمللنا. فإن قلبًا فيه أدنى حياة يهتز إذا ذكر الله ورسوله ويود أن لو كان المتكلم كله ألسنة تالية والسامع كله آذانًا واعية، ومن لم يجد قلبه ثَم، فليشتغل بما يناسبه، فكل ميسر لما خلق له وكل يعمل على شاكلته.
وكل امرىء يهفو إلى من يحبه ** وكل امرىء يصبو إلى ما يناسبه
فصل: لماذا نهاية السلام عند قوله وبركاته
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الحادي والعشرون، وأن كمال التحية عند ذكر البركات إذ قد استوعبت هذه الألفاظ الثلاث جميع المطالب من دفع الشر، وحصول الخير وثباته وكثرته ودوامه؛ فلا معنى للزيادة عليها ولهذا جاء في الأثر المعروف انتهى السلام إلى وبركاته.
فصل: إضافة الرحمة لله وتجريد السلام عن الإضافة
وأما السؤال الثاني والعشرون: وهو ما الحكمة في إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى وتجريد السلام عن الإضافة؟
فجوابه أن السلام لما كان اسمًا من أسماء الله تعالى استغنى بذكره مطلقًا عن الإضافة إلى المسمى، وأما الرحمة والبركة فلو لم يضافا إلى الله لم يعلم رحمة من، ولا بركة من تطلب، فلو قيل: عليكم ورحمة وبركة لم يكن في هذا اللفظ إشعار بالراحم المبارك الذي تطلب الرحمة والبركة منه. فقيل: رحمة الله وبركاته، وجواب ثان: أن السلام يراد به قول المسلم سلام عليكم. وهذا في الحقيقة مضاف إليه ويراد به حقيقة السلامة المطلوبة من السلام سبحانه وتعالى. وهذا يضاف إلى الله فيضاف هذا المصدر إلى الطالب الذاكر تارة، وإلى المطلوب منه تارة، فأطلق ولم يضف، وأما الرحمة والبركة فلا يضافان إلا إلى الله وحده. ولهذا لا يقال: رحمتي وبركتي عليكم، ويقال: سلام مني عليكم وسلام من فلان على فلان.
وسر ذلك أن لفظ السلام اسم للجملة القولية، بخلاف الرحمة والبركة، فإنهما اسمان لمعناهما دون لفظهما. فتأمله فإنه بديع.
وجواب ثالث: وهو أن الرحمة والبركة أتم من مجرد السلامة. فإن السلامة تبعيد عن الشر. وأما الرحمةوالبركة فتحصيل للخير وإدامة له وتثبيت وتنمية، وهذا أكمل فإنه هو المقصود لذاته والأول وسيلة إليه، ولهذا كان ما يحصل لأهل الجنة من النعيم أكمل من مجرد سلامتهم من النار، فأضيف إلى الرب تبارك وتعالى أكمل المعنيين وأتمهما لفظًا، وأطلق الآخر وفهمت إضافة إليه من العطف وقرينة الحال، فجاء اللفظ على أتم نظام وأحسن سياق.
فصل: الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة
وأما السؤال الثالث والعشرون: وهو ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة؟
فجوابه: إن السلام إما مصدر محض فهو شيء واحد فلا معنى لجمعه. وإما اسم من أسماء الله. فيستحيل أيضا جمعه. فعلى التقديرين لا سبيل إلى جمعه.
وأما الرحمة فمصدر أيضا بمعنى العطف والحنان فلا تجمع أيضا والتاء فيها بمنزلتها في الخلة والمحبة، والرقة ليست للتحديد بمنزلتها في ضربة وتمرة. فكما لا يقال: رقات ولا خلات ولا رأفات، لا يقال: رحمات، وهنا دخول الجمع يشعر بالتحديد والتقييد بعدد وإفراده يشعر بالمسمى مطلقًا من غير تحديد، فالإفراد هنا أكمل وأكثر معنى من الجمع، وهذا بديع جدًا أن يكون مدلول المفرد أكثر من مدلول الجمع، ولهذا كان قوله تعالى: { قل فلله الحجة البالغة }، [231] أعم وأتم معنى من أن يقال: فلله الحجج البوالغ وكان قوله: { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها }. [232] أتم معنى من أن يقال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وقوله: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة }، [233] أتم معنى من أن يقال حسنات. وكذا قوله: { يستبشرون بنعمة من الله وفضل } [234] ونظائره كثيرة جدًا، وسنذكر سر هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما البركة فإنها لما كان مسماها كثرة الخير واستمراره شيئًا بعد شيء كلما انقضى منه فرد خلفه فرد آخر، فهو خير مستمر بتعاقب الأفراد على الدوام شيئًا بعد شيء كان لفظ الجمع أولى بها لدلالته على المعنى المقصود بها، ولهذا جاءت في القرآن، كذلك في قوله تعالى: { رحمة الله وبركاته عليكم }، [235] أهل البيت فأفرد الرحمة وجمع البركة. وكذلك في السلام في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
فصل: الرحمة المضافة إلى الله
واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان:
أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله.
والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها.
فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: «احتجت الجنة والنار»، فذكر الحديث وفيه: «فقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة وخص بها أهل الرحمة وإنما يدخلها الرحماء ومنه قوله ﷺ: «خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض»، ومنه قوله تعالى: { ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة }، [236] ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: { وهو الذي أرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته }، [237] وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثًا وهو قول الداعي. اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له عن بعض السلف وحكى فيه الكراهة. قال: لإن مستقر رحمته ذاته وهذا بناء على أن الرحمة صفة، وليس مراد الداعي ذلك، بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة.
ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدًا وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليها، ولهذا لا يحسن أن يقال اجمعنا في مستقر جنتك، فإن الجنة نفسها هي دار القرار وهي المستقر نفسه. كما قال: حسنت مستقرًا ومقامًا، فكيف يضاف المستقر إليها والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه الشيء، ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة، فتأمله ولهذا قال: مستقر رحمته ذاته، والصواب أن هذا لا يمتنع وحتى لو قال صريحًا: اجمعنا في مستقر جنتك لم يمتنع. وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة، أو عذابًا. فإن أضيف إلى أحد أنواعه أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره، كأنه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لا في المستقر الآخر، ونظير هذا أن يقول: اجلس في مستقر المسجد. أي المستقر الذي هو المسجد، والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرهة وأيضا فإن الجنة وإن سميت رحمة لم يمتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رحمة، ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة، فالداعي أن يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة وهذا ظاهر جدًا، فلا يمتنع الدعاء بوجه والله أعلم.
وهذا بخلاف قول الداعي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى وهي متعلق الاستغاثة. فإنه لا يستغاث بمخلوق ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين متوسلًا إليه بإسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما مرجع معانيها جميعها، وهو اسم الحي القيوم، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة، وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال.
وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته وعزته. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإنالة الطلبات.
والمقصود إن الرحمة المستغاث بها هي صفة الرب تعالى لا شيء من مخلوقاته، كما أن المستعيذ بعزته في قوله: أعوذ بعزتك، مستعيذ بعزته التي هي صفته لا بعزته التي خلقها يعز بها عباده المؤمنين. وهذا كله يقرر قول أهل السنة إن قول النبي ﷺ: «أعوذ بكلمات الله التامات» يدل على أن كلماته تبارك وتعالى غير مخلوقة، فإنه لا يستعاذ بمخلوق، وأما قوله تعالى حكاية عن ملائكته: { ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا } [238] فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء كما قال تعالى: { ورحمتي وسعت كل شيء }، [239] وسعتها عموم تعلقها بكل شيء. كما أن سعة علمه تعالى عموم تعلقه بكل معلوم.
فصل: البركة المضافة لله
وأما البركة. فكذلك نوعان أيضا:
أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة على تارة، وبأداة في تارة. والمفعول منها مبارك وهو ما جعل. كذلك فكان مباركًا بجعله تعالى.
والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح: { وجعلني مباركا أين ما كنت }، [240] فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك.
وأما صيغة تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: { تبارك الله رب العالمين }، [241] { تبارك الذي بيده الملك }، [242] { فتبارك الله أحسن الخالقين }، [243] { وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون }، [244] { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده }، [245] { تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك }، [246] { تبارك الذي جعل في السماء بروجًا }. [247]
أفلا تراها كيف أطردت في القرآن جارية عليه غير مختصة به لا تطلق على غيره. وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما. فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك وتعاظم. وقال آخر معناه أن تجيء البركات من قبله. فالبركة كلها منه. وقال غيره: كثر خيره وإحسانه إلى خلقه. وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقيل تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله، ومن هنا قيل معناه تعالى وتعاظم وقيل: تبارك تقدس والقدس الطهارة، وقيل: تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء. وقيل: تبارك ارتفع والمبارك المرتفع ذكره البغوي. وقيل: تبارك أي البركة تكتسب وتنال بذكره. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. وقيل: معناه ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال، ذكره البغوي أيضا.
وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفًا وفعلًا منه تبارك وتعالى، وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم.
ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيمًا، وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس. فكذلك تبارك، لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظًا ومعنى، هذا لازم وهذا متعد، فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره، لم يصب معناها وإن كان هذا من لوازم كونه متباركًا فتبارك من باب مجد والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل وبارك من باب أعطى وأنعم ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس. فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين. فقال: مجيء البركة كلها من عنده، أو البركة كلها من قبله. وهذا فرع على تبارك في نفسه.
وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركًا ورسوله مباركًا وبيته مباركًا، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة. فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة، وتدبر قول النبي ﷺ في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام»، فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء أعني ثناء التنزيه والتسبيح، وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى. فأخبر أنه السلام ومنه السلام، فالسلام له وصفًا وملكًا، وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام. وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسماءه كلها سلام، وكذا الحمد كله له وصفًا وملكًا فهو المحمود في ذاته وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودًا، فيهبه حمدًا من عنده، وكذلك العزة كلها له وصفًا وملكًا وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه ومن عز من عباده فبإعزازه له. وكذلك الرحمة كلها له وصفًا وملكًا. وكذلك البركة فهو المتبارك في ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك مباركًا. { فتبارك الله رب العالمين }، [248] { وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون }. [249]
وهذا بساط؛ وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه. وأما ما وراء ذلك فكما قال: أعلم الخلق بالله، وأقربهم إلى الله وأعظمهم عنده جاهًا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال في حديث الشفاعة الطويل فأخرساجدًا لربي فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن وفي دعاء الهم والغم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك فدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل. وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك فلا نغلو فيه، ولا نجفو عنه وبالله التوفيق.
فصل: تأكيد السلام على النبي دون الصلاة عليه
وأما السؤال الرابع والعشرون: وهو ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي ﷺ بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله: { صلوا عليه وسلموا تسليما }؟
فجوابه أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام. وإن اختلفت جهة التأكيد فإنه سبحانه أخبر في أول الآية بصلاته عليه وصلاة ملائكته عليه مؤكدًا لهذا الاخبار بحرف أن مخبرًا عن الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه وهذا يفيد العموم والاستغراق. فإذا استشعرت النفوس أن شأنه ﷺ عند الله، وعند ملائكته هذا الشأن بادرت إلى الصلاة عليه، وإن لم تؤمر بها، بل يكفي تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة، وإذا أمرت بها لم تحتج إلى تأكيد الأمر بل إذاجاء مطلق الآمر بادرت وسارعت إلى موافقة الله وملائكته في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يحتج إلى تأكيد الفعل بالمصدر. ولما خلا السلام عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر المجرد دون الخبر، حسن تأكيده بالمصدر ليدل على تحقيق المعنى وتثبيته، ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره كما حصل التكرير في الصلاة خبرًا أو طلبًا، فكذلك حصل التكرير في السلامة فعلًا ومصدرًا. فتأمله فإنه بديع جدًا والله أعلم.
وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم العجيبة في كتاب تعظيم شأن الصلاة، والسلام على خير الأنام وأتينا فيه من الفوائد بما يساوي أدناها رحلة مما لا يوجد في غيره. ولله الحمد فلنقتصر على هذه النكتة الواحدة.
فصل: تقديم السلام على النبي في الصلاة قبل الصلاة عليه
وأما السؤال الخامس والعشرون: وهو ما الحكمة في تقديم السلام على النبي ﷺ في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ وهلا وقعت البداءة بما بدأ الله به في الآية؟
فهذا سؤال أيضا له شأن لا ينبغي الإضراب عنه صفحًا وتمشية. والنبي ﷺ كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة بما بدأ به. فلهذا بدا بالصفا في السعي. وقال: نبدأ بما بدا الله به. وبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس في الوضوء. ولم يخل بذلك مرة واحدة. بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا لم يقدم منه مؤخرًا ولم يخل منه مقدمًا قط. ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف ذلك لا بإسناد صحيح، ولا حسن ولا ضعيف. ومع هذا فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام، وتأخير الصلاة. وذلك لسر من أسرار الصلاة نشير إليه بحسب الحال إشارة. وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب، فلكل عضو منها نصيب من العبودية. فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة عبودية لله وذلًا له وخضوعًا، فلما أكمل المصلي هذه العبودية وانتهت حركاته ختمت بالجلوس بين يدي الرب تعالى جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته عز وجل. كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده، وكان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعًا وتذللًا. فإذن للعبد في هذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم بما يليق بهم، وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه. فجمع العبد في قوله التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء على الله، وأخبر أن ذلك له وصفًا وملكًا، وكذلك الصلوات كلها لله فهو الذي يصلي له وحده لا لغيره، وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال كلها له فكلماته طيبات وأفعاله كذلك وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب والكلم الطيب إليه يصعد. فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه له ملكًا ووصفًا، ومنه مجيئها وابتداؤها. وإليه مصعدها ومنتهاها والصلاة مشتملة على عمل صالح وكلم طيب، والكلم الطيب إليه يصعد، والعمل الصالح يرفعه. فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إلى الله تعالى. فلما أتى بهذا الثناء على الرب تعالى التفت إلى شأن الرسول الذي حصل هذا الخير على يديه. فسلم عليه أتم سلام معرف باللام التي للاستغراق مقرونًا بالرحمة والبركة. هذا هو أصح شيء في السلام عليه فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام.
ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين وبدأ بنفسه، لأنها أهم، والإنسان يبدأ بنفسه، ثم بمن يعول، ثم ختم هذا المقام يعقد الإسلام وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول الأمر وآخره. وعندها كل الثناء والتشهد.
ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب، فالتشهد يجمع نوعي الدعاء. دعاء الثناء والخير، ودعاء الطلب والمسألة والأول أشرف النوعين، لأنه حق الرب ووصفه، والثاني حظ العبد ومصلحته وفي الأثر: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»، لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها شرع فيها النوعين. وقدم الأول منهما لفضله، ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو دعاء الطلب والمسألة.. فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه له وهو طلب الصلاة من الله على رسوله ﷺ وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، كما ذكرنا في كتاب تعظيم شأن الصلاة على النبي ﷺ، وفيه أيضا أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه، وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى في قوله، ثم لينتخب من الدعاء أعجبه إليه، وكذلك في حديث فضالة بن عبيد إذا دعا أحدكم. فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع فتأمل، كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقًا لهذا منتظمًا له أحسن النظام، فحديث فضالة هذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه، وأتم برسالته علينا نعمته، وجعله رحمة للعالمين وحسرة على الكافرين.
فصل: السلام بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة
وأما السؤال السادس والعشرون: وهو ما الحكمة في كون السلام وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة؟
فجوابه يظهر مما تقدم، فإن الصلاة عليه طلب وسؤال من الله أن يصلي عليه فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة إذ لا يقال: اللهم صل عليك. وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلًا له منزلة المواجه لحكمة بديعة جدًا وهي أنه ﷺ لما كان أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه وأولى به منها وأقرب وكانت حقيقته الذهنية ومثاله العلمي موجودًا في قلبه بحيث لا يغيب عنه إلا شخصه كما قال القائل:
مثالك في عيني وذكرك في فمي ** ومثواك في قلبي فأين تغيب
ومن كان بهذه الحال فهو الحاضر حقًا وغيره. وإن كان حاضرًا للعيان فهو غائب عن الجنان. فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور بالسلام عليه أولى من سلام الغيبة تزيلًا له منزلة المواجه المعاين لقربه من القلب، وحلوله في جميع أجزائه بحيث لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته وذكره فيه كما قيل: لو شق عن قلبي يرى وسطه ذكرك.
والتوحيد في سطر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تستنكر استيلاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه، حتى كأنه يراه، ولهذا تجدهم في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور، والمشاهدة مع غاية البعد العياني لكمال القرب الروحي، فلم يمنعهم بعد الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتها ومن كثفت طباعه فهو عن هذا كله بمعزل. وإنه ليبلغ الحب ببعض أهله أن يرى محبوبه في القرب إليه بمنزلة روحه التي لا شيء أدنى إليه منها كما قيل:
يا مقيمًا مدى الزمان بقلبي ** وبعيدًا عن ناظري وعِياني
أنت روحي إن كنت لست أراها ** فهي أدنى إلي من كل داني
وقال آخر:
يا ثاويًا بين الجوانح والحشا ** مني وإن بعدت علي دياره
وإنه ليلطف شأن المحبة حتى يرى أنه أدنى إليه وأقرب من روحه. ولي من أبيات تلم بذلك:
وأدنى إلى الصب من نفسه ** وإن كان عن عينه نائيا
ومن كان مع حبه هكذا ** فأنى يكون له ساليا
ثم يلطف شأنها ويقهر سلطانها حتى يغيب المحب بمحبوبه عن نفسه، فلا يشعر إلا بمحبوبه ولا يشعر بنفسه، ومن هنا نشأت الشطحات الصوفية التي مصدرها عن قوة الوارد وضعف التمييز. فحكم صاحبها فيها الحال على العلم وجعل الحكم له وعزل علمه من البين وحكم المحفوظون فيها حاكم العلم على سلطان الحال. وعلموا أن كل حال لا يكون العلم حاكمًا عليه، فإنه لا ينبغي أن يغتر به، ولا يسكن إليه إلا كما يساكن المغلوب المقهور لما يرد عليه مما يعجز عن دفعه. وهذه حال الكمل من القوم الذين جمعوا بين نور العلم، وأحوال المعاملة. فلم تطفىء عواصف أحوالهم نور علمهم، ولم يقصر بهم علمهم عن الترقي إلى ما وراءه من مقامات الإيمان والإحسان، فهؤلاء حكام على الطائفتين ومن عداهم فمحجوب يعلم لا نفوذ له فيه، أو مغرور بحال لا علم له بصحيحه من فاسده والله المسؤول من فضله إنه قريب مجيب.
فالكامل من يحكّم العلم على الحال فيتصرف في حاله بعلمه، ويجعل العلم بمنزلة النور الذي يميز به الصحيح من الفاسد لا من يقدح في العلم بالحال، ويجعل الحال معيارًا عليه وميزانًا، فما وافق حاله من العلم قبله وما خالفه رده ونفاه، فهذا أضل الضلال في هذا الباب، بل الواجب تحكيم العلم والرجوع إلى حكمه، وبهذا أوصى العارفون من شيوخ الطريق كلهم وحرضوا على العلم أعظم تحريض لعلمهم بما في الحال المجرد عنه من الغوائل والمهالك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
فصل: الثناء على الله في التشهد
وأما السؤال السابع والعشرون: وهو ما الحكمة في ورود الثناء على الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه سبحانه هو المخاطب الذي يناجيه العبد والسلام على النبي ﷺ بلفظ الخطاب مع كونه غائبًا؟
فجوابه أن الثناء على الله عامة ما يجيء مضافًا إلى أسمائه الحسنى الظاهرة دون الضمير إلا أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر فيجيء بعده المضمر. وهذا نحو قول المصلي: { الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد }، وقوله في الركوع: سبحان ربي العظيم وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وفي هذا من السر أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى هو لما تضمنت معانيها من صفات الكمال ونعوت الجلال. فأتى بالاسم الظاهر الدل على المعنى الذي يثنى به ولأجله عليه تعالى ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك. ولهذا إذا كان ولابد من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرونًا بميم الجمع الدالة على جمع الأسماء والصفات نحو قوله في رفع رأسه من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد وربما اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى. فتأمله فإنه لطيف المنزع جدًا.
وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة اللهم. كما في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك الحديث. وجاء الدعاء المجرد مصدرًا بلفظ الرب نحو قول المؤمنين: { ربنا اغفر لنا ذنوبنًا }، [250] وقول آدم: { ربنا ظلمنا أنفسنا }، [251] وقول موسى: { رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي }، [252] وقول نوح: { رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم }، [253] وكان النبي ﷺ يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي».
وسر ذلك أن الله تعالى يسأل بربوبيته المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره ويثنى عليه بالاهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبر طريقة القرآن تجدها كما ذكرت لك.
فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة وهو في القرآن حيث وقع لا يكاد، يجيء إلا مصدرًا باسم الرب.
وأما الثناء فحيث وقع فمصدر بالأسماء الحسنى وأعظم ما يصدر به اسم الله جل جلاله نحو: { الحمد لله } حيث جاء ونحو: { فسبحان الله } وجاء: { سبحان ربك رب العزة }، ونحوه: { سبح لله ما في السموات وما في الأرض } [254] حيث وقعت ونحو: { تبارك الله رب العالمين }، [255] { تبارك الله أحسن الخالقين }، [256] { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده }، [257] ونظائره.
وجاء في دعاء المسيح: { اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء }، [258] فذكر الأمرين ولم يجىء في القرآن سواه ولا رأيت أحدًا تعرض لهذا ولا نبه عليه. وتحته سر عجيب دال على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له. فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه له: { هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء }، [259] فخوفهم بالله وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه. وأن الإيمان يرده. فلما ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألوا بدأ في السؤال باسم ( اللهم ) الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثنى الحامد الذاكر لأسماء ربه المثى عليه بها. وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة. إنما هو أن يثنى على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهد قدرته وربوبيته، ويكون برهانًا على صدق رسوله. فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء على الله أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر فيه فأتى بالاسمين: اسم الله الذي يثنى عليه به. واسم الرب الذي يدعي ويسأل به لما كان المقام مقام الأمرين. فتأمل هذا السر العجيب، ولا ينب عنه فهمك فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه وله الحمد.
وأما السلام على النبي ﷺ بلفظ الخطاب فقد ذكرنا سره في الوجه الذي قبل هذا فالعهد به قريب.
فصل: السلام في آخر الصلاة وتعريفه
وأما السؤال الثامن والعشرون: فقد تضمن سؤالين. أحدهما ما السر في كون السلام في آخر الصلاة، والثاني لم كان معرفًا؟
والجواب: أما اختتام الصلاة به فإنه قد جعل الله لكل عبادة تحليلًا منها. فالتحليل من الحج بالرمي وما بعده، وكذلك التحلل من الصوم بالفطر بعد الغروب، فجعل السلام تحليلًا من الصلاة كما قال النبي ﷺ: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، تحريمها هنا هو بابها الذي يدخل منه إليها وتحليلها بابها الذي يخرج به منها. فجعل التكبير باب الدخول، والتسليم باب الخروج لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم، وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره وبدائعه، وتغرب عن عالم العادة والألف، فلم يقنع بمجرد الأشباح حتى يعلم ما يقوم بها من الأرواح. فإن الله لم يشرع شيئًا سدى، ولا خلوًا من حكمة بالغة. بل في طوايا ما شرعه وأمر به من الحكم والأسرار التي تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه، فيسجد القلب خضوعًا وإذعانًا.
فنقول وبالله التوفيق: لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل، وقطع جميل العلائق وتطهر، وأخذ زينته وتهيأ للدخول على الله ومناجاته. شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على الملوك، فيدخل بالتعظيم والإجلال. فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى وهو قول الله أكبر. فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب المحذوف المجرور بمن ما لا يوجد في غيره، ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه، ولا يؤدي معناه، ولا تنعقد الصلاة إلا به كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. فجعل هذا اللفظ واستشعار معناه. والمقصود به باب الصلاة الذي يدخل العبد على ربه منه. فإنه إذا استشعر بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيي منه أن يشغل قلبه في الصلاة بغيره. فلا يكون موفيًا لمعنى الله أكبر، ولا مؤديا لحق هذا اللفظ، ولا أتى الببت من بابه، بل الباب عنه مسدود. وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه.
وما أحسن ما قال أبو الفرج بن الجوزي في بعض وعظه: حضور القلب أول منزل من منازل الصلاة فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى، فإذا رحلت عنها أنخت بباب المناجاة فكان أول قرى الضيف اليقظة، وكشف الحجاب لعين القلب، فكيف يطمع في دخول مكة من لا خرج إلى البادية، وقد تبعث قلبك في كل واد، فربما تفجأك الصلاة وليس قلبك عندك، فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه، فتدخل في الصلاة بغير قلب.
والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبر. وقد امتلأ قلبه بغير الله فهو قبلة قلبه في الصلاة، ولعله لا يحضر بين يدي ربه في شيء منها. فلو قضي حق الله أكبر وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات. فهذا الباب الذي يدخل منه المصلي وهو التحريم.
وأما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام المتضمن أحد الأسماء الحسنى، فيكون مفتتحًا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ومختتمًا لها باسمه فيكون ذاكرًا لاسم ربه أول الصلاة وآخرها. فأولها باسمه، وآخرها باسمه. فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمه مع ما في اسم السلام من الخاصية، والحكمة المناسبة لانصراف المصلي من بين يدي الله، فإن المصلي ما دام في صلاته بين يدي ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره. بل هو في حمى من جميع الآفات والشرور. فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن، وتعرضت له من كل جانب وجاءه الشيطان بمصائده وجنده، فهو متعرض لأنواع البلايا والمحن. فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوبًا بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى. وكان من تمام النعمة عليه أن يكون انصرافه من بين يدي ربه بسلام يستصحبه ويدوم له ويبقى معه.
فتدبر هذا السر الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافيًا، فكيف وفيه من الأسرار والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان، والحمد في ذلك لله وحده. فكما أن المنعم به هو الله وحده. فالمحمود عليه هو الله وحده. وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني وهو مجيء السلام هنا معرفًا ليكون دالًا على اسمه السلام.
وليكن هذا آخر الكلام في مسألة سلام عليكم. فلولا قصد الاختصار لجاءت مجلدًا ضخمًا. هذا ولم نتعرض فيها إلى المسائل المسطورة في الكتب من فروع السلام ومسائله. فإنها مملوءة منها فمن أرادها، فليأخذها من هناك والحمد لله رب العالمين.
(تفسير المعوذتين)
روى مسلم في صحيحه من حديث قيس بن أبى حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس». وفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة: أن رسول الله ﷺ قال له: «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون»، قلت: بلى، قال: «قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس». وفي الترمذي: حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة قال: هذا حديحث غريب. وفي الترمذي والنسائي وسنن أبي داود عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة نطلب النبي ﷺ ليصلي لنا فأدركناه. فقال: قل، فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل، قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا من حديث الجريري عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما. قال: وفي الباب عن أنس، وهذا حديث غريب. وفي الصحيحين عن عائشة: إن النبي ﷺ كان إذا آوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والعوذتين جميعًا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قلت: هكذا رواه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ذكره البخاري. ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها أن النبي ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. وكذلك قال معمر عن الزهري عن عروة عنها: إن النبي ﷺ كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ذكره البخاري أيضا. وهذا هو الصواب أن عائشة كانت تفعل ذلك والنبي ﷺ لم يأمرها ولم يمنعها من ذلك. وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا. ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها على رقيته أن يكون مسترقيًا. فليس أحدهما بمعنى الآخر، ولعل الذي كان بأمرها به إنما هو المسح على نفسه بيده فيكون هو الراقي لنفسه، ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه ويكون هذا غير قراءتها هي عليه ومسحها على يديه، فكانت تفعل هذا وهذا، والذي أمرها به إنما هو تنقل يده لا رقيته. والله أعلم.
والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة، بل الضرورة إليهما وأنه لا يستغني عنهما أحد قط. وأن لهما تأثيرًا خاصًا في دفع السحر والعين وسائر الشرور. وإن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجتهه إلى النفس والطعام والشراب واللباس.
فنقول والله المستعان: قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الاستعاذة: أحدها نفس الاستعاذة، والثانية المستعاذ به، والثالثة المستعاذ منه. فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين. فلنعقد لهما ثلاثة فصول الفصل الأول في الاستعاذة، والثاني في المستعاذ به، والثالث في المستعاذ منه.
الفصل الأول: الاستعاذة وبيان معناها
اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة. وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذًا. كما يسمى ملجأ ووزرًا.
وفي الحديث أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي ﷺ فوضع يده عليها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: «لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك». فمعنى أعوذ التجىء وأعتصم وأتحرز. وفي أصله قولان: أحدهما أنه مأخوذ من الستر. والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. فأما من قال إنه من الستر، قال: العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها عُوَّذًا، بضم العين وتشديد الواو وفتحها، فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها سموه عوذا. فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه، واستجن به منه، ومن قال: هو لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوذ، لأنه اعتصم به واستمسك به. فكذلك العائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه.
والقولان حق، والاستعاذة تنتظمهما معًا. فإن المستعيذ مستتر بمعاذه متمسك به معتصم به. قد استمسك قلبه به ولزمه. كما يلزم الوالد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفًا وقصده به فهرب منه فعرض له أبوه في طريق هربه. فإنه يلقي نفسه عليه، ويستمسك به أعظم استمساك. فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه.
وبعد، فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم وإلا فما يقوم بالقلب حيئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب الافتقار إليه. والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة.
ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته، فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك، ولا تدرك إلا بالانصاف بذلك لا بمجرد الصفة والخبر، كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلًا، فلو قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبهها به لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه، فإذا وصفتها لمن خلقت فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق.
وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكين العين وضم الواو، ثم أعل بنقل حركة الواو إلى العين، وتسكين الواو، فقالوا: أعوذ على أصل هذا الباب، ثم طردوا إعلاله فقالوا في اسم الفاعل عائذ وأصله عاوذ فوقعت الواو بعد ألف فاعل فقلبوها همزة، كما قالوا: قائم وخائف، وقالوا في المصدر: عياذًا بالله. وأصله عواذًا كلواذ، فقلبوا الواو ياء لكسرة ما قبلها، ولم تحصنها حركتها لأنها قد ضعفت بإعلالها في الفعل. وقالوا: مستعيذ، وأصله مستعوذ كمستخرج فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلها، قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب.
فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل. كقوله: فاستعذ بالله ولم تدخل في الماضي والمضارع، بل الأكثر أن يقال: أعوذ بالله وعذت بالله دون أستعيذ واستعذت.
قلت: السين والتاء دالة على الطلب. فقوله: استعيذ بالله أي أطلب العياذ به. كما إذا قلت: أستخير الله أي أطلب خيرته وأستغفره، أي أطلب مغفرته وأستقيله، أي أطلب إقالته. فدخلت في الفعل إيدانًا لطلب هذا المعنى من المعاذ. فإذا قال المأمور: أعوذ بالله. فقد امتثل ما طلب منه، لأنه طلب من الالتجاء والاعتصام وفرق بين نفس الالتجاء الاعتصام وبين طلب ذلك، فلما كان المستعيذ هاربًا ملتجئًا معتصمًا بالله أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك، فتأمله.
وهذا بخلاف ما إذا قيل: استغفر الله، فقال: استغفرِ الله، فإنه طلب منه أن يطلب المغفرة من الله، فإذا قال: أستغفر الله كان ممتثلًا، لأن المعنى أطلب من الله أن يغفر لي. وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين فيقول: أستعيذ بالله، أي أطلب منه أن يعيذني، ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء الهرب إليه. فالأول مخبر عن حاله وعياذه بربه، وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه. والثاني: طالب سائل من ربه أن يعيذه كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني، فحال الأول أكمل.
ولهذا جاء عن النبي ﷺ في امتثال هذا الأمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - وأعوذ بكلمات الله التامات - وأعوذ بعزة الله وقدرته. دون أستعيذ، بل الذي علمه الله إياه أن يقول: { أعوذ برب الفلق }، { قل أعوذ برب الناس }، دون أستعيذ، فتأمل هذه الحكمة البديعة.
فإن قلت: فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به. فقال: { قل أعوذ برب الفلق }، { قل أعوذ برب الناس }، ومعلوم أنه إذا قيل: قل الحمد الله وقل سبحان الله، فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله وسبحان الله، ولا يقول: قل سبحان الله.
قلت: هذا هو السؤال الذي أورده أبي بن كعب على النبي ﷺ بعينه وأجابه عنه رسول الله ﷺ فقال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة ثنا سفيان بن عاصم وعبدة عن زر قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله ﷺ فقال: قيل لي، فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله ﷺ. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش، وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا، فقال: إني سألت رسول الله ﷺ فقال: قيل لي، فقلت: قل، فنحن نقول كما قال رسول الله.
قلت: مفعول القول محذوف وتقديره قيل لي قل، أو قيل لي هذا اللفظ، فقلت كما قيل لي.
وتحت هذا من السر أن النبي ﷺ ليس له في القرآن إلا بلاغه، لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه، بل هو المبلغ له عن الله. وقد قال الله له: { قل أعوذ برب الفلق }، فكان يقتضي البلاغ التام أن يقول: { قل أعوذ برب الفلق }، كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي ﷺ إليه بقوله: «قيل لي فقلت». أي: فلست مبتدئًا، بل أنا مبلغ أقول كما يقال لي، وأبلغ كلام ربي كما أنزله إلي. فصلوات الله وسلامه عليه. لقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وقال كما قيل له، فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول: هذا القرآن العربي، وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به. ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا القول وأنه ﷺ بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه حتى أنه لما قيل له "قل" قال هو: قل، لأنه مبلغ محض. وما على الرسول إلا البلاغ.
الفصل الثاني: المستعاذ به هو الله
في المستعاذ به، وهو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس، الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه. بل هو الذي يعيذ المستعيذين، ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وقد أخبر تعالى في كتابه عن من استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانًا ورهقًا. فقال حكاية عن مؤمني الجن: { وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا }، [260] جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح. أي فزاد الإنسَّ الجنُّ باستعاذتهم بسادتهم رهقًا، أي طغيانًا وإثمًا وشرًا. يقولون: سدنا الإنس والجن. والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم، فزادوهم بهذه الاستعاذة غشيانًا لما كان محظورًا من الكبر والتعاظم، فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن.
واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة بأن النبي ﷺ استعاذ بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامات»، وهو ﷺ لا يستعيذ بمخلوق أبدًا. ونظير ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك». فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته، وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته»، وقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». وما استعاذ به النبي ﷺ غير مخلوق فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو صفة من صفاته. وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس، ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. وقد قررنا في مواضع متعددة. أن الله سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه، وقد قال النبي ﷺ في هاتين السورتين: إنه «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما». فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيًا للمطلوب وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه، وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث وهو الشيء المستعاذ منه. فتتبين المناسبة المذكورة فنقول.
الفصل الثالث: الشرور المستعاذ منها
في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين.
الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالًا بصاحبه. وإما شر واقع به من غيره، وذلك الغير إما مكلف، أو غير مكلف، والمكلف إما نظيره وهو الإنسان، أو ليس نظيره وهو الجني وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمى وغيرها.
فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة. بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما.
فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة. أحدها: شر المخلوقات التي لها شر عمومًا. الثاني: شر الغاسق إذا وقب. الثالث: شر النفاثات في العقد، الرابع: شر الحاسد إذا حسد. فنتكلم على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد والتحرز منها قبل وقوعها وبماذا تدفع بعد وقوعها؟
وقبل الكلام في ذلك. لا بد من بيان الشر ما هو وما حقيقته. فنقول:
الشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه، وليس له مسمى سوى ذلك، فالشرور هي الآلام وأسبابها. فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور. وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة. لكنها شرور، لأنها أسباب الالام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها. فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة، وعلى الذبح والإحراق بالنار والخنق بالحبل وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها، ولا بد ما لم يمنع السببية مانع، أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده، كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان وعظمة الحسنات الماحية وكثرتها فيزيد في كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب فيدفع الأقوى للأضعف. وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة كأسباب الصحة والمرض، وأسباب الضعف والقوة.
والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذة ما هي شر. وإن نالت بها النفس مسرة عاجلة وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي. لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذ لآكله، وطاب له مساغه، وبعد قليل يفعل به ما يفعل. فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده.
وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته. فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه، ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه: { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال }. [261]
ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم. وجد سبب ذلك جميعه، إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله، وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره. وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب كما قيل:
إذا كنت في نعمة فارعها ** فإن المعاصي تزيل النعمْ
فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره، ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه. فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له.
والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا بد. وأما كون مسبباتها شرورًا فلأنها آلام نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم الغموم والأحزان والحسرات. ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب. ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمرًا كان مفعولا. فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العاجل والآجل من الله. وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم والإشراف والإطلاع على عالم البقاء. فحينئذ يقول: { يا ليتني قدمت لحياتي }، [262] { يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله }. [263]
ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات النبي ﷺ جميعها مدارها على هذين الأصلين فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم، وإما سبب يفضي إليه. فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع وأمر بالاستعاذة منهن وهي عذاب القبر وعذاب النار. فهذان أعظم المؤلمات. وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وهذان سبب العذاب المؤلم. فالفتنة سبب العذاب. وذكر الفتنة خصوصًا وعمومًا. وذكر نوعي الفتنة، لأنها إما في الحياة، وإما بعد الموت، ففتنة الحياة قد يتراخى عنها العذاب مدة، وأما فتنة الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابها. وهذا من آكد أدعية الصلاة حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدع به في التشهد الأخير، وأوجبه ابن حزم في كل تشهد، فإن لم يأت به في بطلت صلاته.
ومن ذلك قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال» فاستعاذ من ثمانية أشياء كل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان وهما من آلام الروح ومعذباتها. والفرق بينهما أن الهم توقع الشر في المستقبل والحزن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح. فإن تعلق بالماضي سمي حزنًا، وإن تعلق بالمستقبل سمي همًا.
والعجز والكسل قرينان وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب، فالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عده إرادته. فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل.
والجبن والبخل قرينان، لأنهما عدم النفع بالمال والبدن وهما من أسباب الألم، لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة، والبخل يحول بينه دونها أيضا، فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام.
وضلع الدين وقهر الرجال قرينان وهما مؤلمان للنفس معذبان لها. أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين. والثاني: قهر بباطل وهو غلبة الرجال، وأيضا فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب وغلبة الرجال قهر بغير اختياره.
ومن ذلك تعوذه ﷺ: «من المأثم والمغرم» فإنهما يسببان الألم العاجل. ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» فالسخط سبب الألم والعقوبة هي الألم، فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها.
فصل: الشر المستعاذ منه نوعان
والشر المستعاذ منه نوعان: أحدهما موجود يطلب رفعه، والثاني معدوم يطلب بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. كما أن الخير المطلق نوعان: أحدهما موجود فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه، والثاني معدوم فيطلب وجوده وحصوله.
فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين وعليها مدار طلباتهم. وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم: { ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا }، [264] فهذا الطلب لدفع الشر الموجود. فإذ الذنوب والسيئات شر كما تقدم بيانه.
ثم قال: { وتوفنا مع الأبرار }، فهذا طلب لدوام الخير الموجود وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليه. فهذان قسمان.
ثم قال: { ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك }، فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه. ثم قال: { ولا تخزنا يوم القيامة }، فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر المعدوم وهو خزي يوم القيامة.
فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام مرتبة أحسن ترتيب قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا، وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت، ثم اتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة. وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وأن لا يخزيهم يوم القيامة.
فإذا عرف هذا فقوله ﷺ في في تشهد الخطبة: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»، يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوة فيسأل دفعه وأن لا يوجد.
وأما قوله: «من سيئات أعمالنا» ففيه قولان.
أحدهما: أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت، فيكون الحديث قد تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجد ومن الشر الموجود. فطلب دفع الأول ورفع الثاني.
والقول الثاني: إن سيئات الأعمال هي التي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء صاحبها وعلى هذا يكون من استعاذه الدفع أيضا دفع المسبب. والأول دفع السبب فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه وعلى الأول يكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه. فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منها. وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبب إلى سببه والمعلول إلى علته كأنه قال من عقوبة عملي. والقولان محتملان. فتأمل أيهما أليق بالحديث وأولى به. فإن مع كل واحد منهما نوعًا من الترجيح.
فيترجح الأول بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس، فشر النفس يولد الأعمال السيئة فاستعاذ من صفة النفس ومن الأعمال التي تحدث عن تلك الصفة وهذان جماع الشر وأسباب كل ألم، فمتى عوفي منهما عوفي من الشر بحذافيره.
ويترجح الثاني بأن سيئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء العامل وأسبابها شر النفس، فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها. والقولان في الحقيقة متلازمان والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر.
فصل: الشر ومصدره ومنتهاه
ولما كان الشر له سبب هو مصدره وله مورد ومنتهى. وكان السبب إما من ذات العبد، وإما من خارج ومورده ومنتهاه إما نفسه، وإما غيره؛ كان هنا أربعة أمور: شر مصدره من نفسه ويعود على نفسه تارة وعلى غيره أخرى، وشر مصدره من غيره وهو السبب فيه ويعود على نفسه تارة وعلى غيره أخرى - جمع النبي ﷺ هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله إذا أصبح، وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم». فذكر مصدري الشر وهما النفس والشيطان، وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم، فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه وأبينه.
فصل: الشرور المستعاذ منها في المعوذتين
فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين.
الشر الأول العام في قوله: { من شر ما خلق }، وما ههنا موصولة ليس إلا. والشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه. فإنه لا شر فيه بوجه ما. فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته، ولا في أفعاله. كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى. فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما.
وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلًا، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى. ولعاد إليه منه حكم تعالى وتقدس عن ذلك وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، وإنما يكون شرًا بالنسبة إليهم، فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالى، ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر.
ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال:
أحدهما: أن ما هو شر أو متضمن للشر. فإنه لا يكون إلا مفعولًا منفصلًا لا يكون وصفًا له، ولا فعلًا من أفعاله.
الثاني: أن كونه شرًا هو أمر نسبي إضافي فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان هو من أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقًا وتكوينًا ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها، وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها، وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادىء معرفتها فضلًا عن حقيقتها فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد، وفاعل الشر لا يفعله لحاجته المنافية لغناه، أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده. فيستحيل صدور الشر من الغنى الحميد فعلًا، وإن كان هو الخالق للخير والشر، فقد عرفت أن كونه شرًا هو أمر إضافي وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه.
فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك بابًا عظيمًا من معرفة الرب ومحبته، ويزيل عنك شبهاث حارت فيها عقول أكثر الفضلاء. وقد بسطت هذا في كتاب التحفة المكية، وكتاب الفتح القدسي، وغيرهما.
وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة.
أحدها: أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرًا وحكمًا لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك، وأمره به مشكورعليه يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة.
وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم وجلد من يصول عليهم في أعراضهم. فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم، فكيف عقوبة من يصول على أديانهم ويحول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله، وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به.
أفليس في عقوبة هذا الصائل خير محض، وحكمة وعدل وإحسان إلى العبيد وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي، فالشر ما قام به من تلك العقوبة، وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة، فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم، والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه. وإنه سبحانه. كما إنه البر الرحيم الودود المحسن، فهو الحكيم الملك العدل. فلا تناقض حكمته رحمته. بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه، ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم. فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب، ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته، ولا يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله أن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء، ولا فرق أصلًا، وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة.
وتأمل القرآن من أوله إلى آخره. كيف تجده كفيلًا بالرد على هذه المقالة، وإنكارها أشد الإنكار وتنزيه نفسه عنها كقوله تعالى: { أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون }، [265] وقوله: { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون }، [266] وقوله: { أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار }، [267] فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزه نفسه عنه. فدل على أنه مستقر في الفطر والعقول السليمة. إن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزته وإلاهيته لا إله إلا هو تعالى عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا.
وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان، ومكافأة الصنع الجميل بمثله وزيادة. فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار، واستهجنته أعظم الاستهجان، وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام. كما إذا جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم ودمائهم. فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبى استحسان هذا وتشهد على سفه من فعله.
هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة. وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها، ولم تلق، ولظهرت مناقضة الحكمة، كما قال الشاعر:
نعمة الله لا تعاب ولكن ** ربما استقبحت على أقوام
فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن، ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب، ويغضبون إذا رضي، ويعطلون ما حكم به، ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره فهم مضادون في كل ما يريد. يحبون ما يبغضه ويدعون إليه، ويبغضون ما يحبه، وينفرون عنه ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله. كما قال تعالى: { وكان الكافر على ربه ظهيرًا }، [268] وقال: { وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو }. [269]
فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقابًا وجلالة وتهديدًا. كيف صدره بإخبارنا أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فأبى ذلك فطرده ولعنه وعاداه من أجل إبائه عن السجود لأبينا، ثم أنتم توالونه من دوني. وقد لعنته وطردته إذ لم يسجد لأبيكم، وجعلته عدوًا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني. فليس هذا من أعظم الغبن وأشد الحسرة عليكم ويوم القيامة يقول تعالى: أليس عدلًا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا. فليعلمن أولياء الشيطان كيف حالهم يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد فيتجلى لهم ويقول: ألا تذهبون حيث ذهب الناس. فيقولون: فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم. وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه ونعبده. فيقول: هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم إنه لا مثل له فيتجلى لهم، ويكشف عن ساق فيخرون له سجدًا.
فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة، ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم، وبقوا مع مولاهم الحق. فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا أولياءه؛ إن أولياءه إلا المتقون { ولكن أكثرهم لا يعلمون }.
ولا تستطل هذا البسط، فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ونزولها منها منازلها في الدنيا، لتنزل في جوار ربها في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
فصل: حديث لبيك وسعديك
إذا عرف هذا عرف معنى قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك». وإن معناه أجل وأعظم من قول من قال: والشر لا يتقرب به إليك. وقول من قال: والشر لا يصعد إليك. وإن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه. فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق. فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما لا في صفاته، ولا في أفعاله ولا في أسمائه وأن دخل في مخلوقاته كقوله: { قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق }.
وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به كقوله: { والكافرون هم الظالمون }، [270] وقوله: { والله لا يهدي القوم الفاسقين }، [271] وقوله: { فبظلم من الذين هادوا } وقوله: { ذلك جزيناهم ببغيهم }، [272] وقوله: { وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين }، [273] وهو في القرآن أكثر من أن يذكر ههنا عشر معشاره. وإنما المقصود التمثيل.
وتارة بحذف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: { وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا }، [274] فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد.
ونظيره في الفاتحة: { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين }، فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه والضلال منسوبًا إلى من قام به والغضب محذوفًا فاعله. ومثله قول الخضر في السفينة: { فأردت أن أعيبها }، [275] وفي الغلامين: { فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك }. [276]
ومثله قوله: { ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان }، [277] فنسب هذا التزيين المحبوب إليه، وقال: { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين }، [278] فحذف الفاعل المزين.
ومثله قول الخليل ﷺ: { الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين * والذي يميتني ثم يحيين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين }، [279] فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال. ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة.
وهذا كثير في القرآن ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المكية، وبينا هناك السر في مجيء الذين آتيناهم الكتاب، والذين أوتوا الكتاب والفرق بين الموضعين. وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعًا في سياق المدح. وحيث حذفه كان من أوتيه واقعًا في سياق الذم، أو منقسمًا. وذلك من أسرار القرآن الكريم.
ومثله: { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا }، [280] وقال: { وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب }، [281] وقوله: { فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى }، [282] وبالجملة فالذي يضاف إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل والشر ليس إليه.
فصل: من شر ما خلق
وقد دخل في قوله تعالى: { من شر ما خلق }، الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيًا كان أو جنيًا أو هامة أو دابة أو ريحًا أو صاعقة أي نوع كان من أنواع البلاء.
فإن قلت: فهل في ما ههنا عموم؟
قلت: فيها عموم تقييدي وصفي، لا عموم إطلاقي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر. فعمومها من هذا الوجه. وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر، وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض والخير كله حصل على أيديهم فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر، وكل شر في الدنيا والآخرة وشر شياطين الإنس والجن، وشر السباع والهوام وشر النار والهواء وغير ذلك.
وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من نزل منزلًا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه»، رواه مسلم.
وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر فأقبل الليل قال: «يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد».
وفي الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن». [283]
فصل: شر غاسق إذا وقب
الشر الثاني: { شر غاسق إذا وقب }، فهذا خاص بعد عام، وقد قال المفسرين: إنه الليل. قال ابن عباس: الليل إذا أقبل بظلمته من الشرق، ودخل في كل شيء وأظلم والغسق الظلمة يقال: غسق الليل وأغسق إذا أظلم ومنه قوله تعالى: { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل }. [284]
وكذلك قال الحسن ومجاهد: الغاسق: إذا وقب الليل إذا أقبل ودخل والوقوب الدخول. وهو دخول الليل بغروب الشمس. وقال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار، وفي تسمية الليل غاسقًا قول آخر إنه من البرد والليل أبرد من النهار والغسق البرد. وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى: { هذا فليذوقوه حميم وغساق }، [285] وقوله: { لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا * إلا حميما وغساقا }، [286] قال: هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرها، وكذلك قال مجاهد ومقاتل: هو الذي انتهى برده.
ولا تنافي بين القولين. فإن الليل بارد مظلم فمن ذكر برده فقط، أو ظلمته فقط. اقتصر على أحد وصفيه. والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة، فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور من شر الغاسق الذي هو الظلمة فناسب الوصف المستعاذ به للمعنى المطلوب بالاستعاذة. كما سنزيده تقريرًا عن قريب إن شاء الله.
فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبي ﷺ بيدي فنظر إلى القمر. فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهذا أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه.
قيل: هذا التفسير حق ولا يناقض التفسير الأول. بل يوافقه ويشهد بصحته، فإن الله تعالى قال: { وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة }، [287] فالقمر هو آية الليل وسلطانه فهو أيضا غاسق إذا وقب. كما أن الليل غاسق إذا وقب والنبي ﷺ أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب وهذا خبر صدق وهو أصدق الخبر ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب، وتخصيص النبي ﷺ له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره.
ونظير هذا قوله في المسجد الذي أسس على التقوى وقد سئل عنه فقال: «هو مسجدي»، هذا ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قبا مؤسسًا على التقوى، (بل ثبت أن مسجده أحق بالدخول في هذا الاسم، وأنه أحق بأن يكون مؤسسا على التقوى) من ذاك.
ونظيره أيضا قوله في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت. ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيته.
ونظير هذا قوله ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان التمرة والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئًا ولا يفطن له فيتصدق عليه وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف. بل ينفي اختصاص الاسم به وتناول المسكين لغير السانل أولى من تناوله له.
ونظير هذا قوله: ليس الشديد بالصرعة. ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب فإن لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال. ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يملك نفسه عند الغضب أولى. ونظيره الغسق والوقوب وأمثال ذلك. فكذلك قوله في القمر: هذا هو الغاسق إذا وقب لا ينفي أن يكون الليل غاسقًا بل كلاهما غاسق (والنبي ﷺ أشار إلى آية الليل وسلطانه والمفسرون ذكروا الليل نفسه، والله أعلم).
فإن قيل: فما تقولون في القول الذى ذهب إليه بعضهم أن المراد به القمر إذا خسف واسود، وقوله: وقب أي دخل في الخسوف أو غاب خاسفًا؟
قيل: هذا القول ضعيف ولا نعلم به سلفًا، والنبي ﷺ لما أشار إلى القمر وقال: «هذا الغاسق إذا وقب» لم يكن خاسفًا إذ ذاك، وإنما كان وهو مستنير ولو كان خاسفًا لذكرته عائشة. وإنما قالت: نظر إلى القمر وقال هذا هو الغاسق. ولو كان خاسفًا لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه. فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها لما فيه من التلبيس.
وأيضا فإن اللغة لا تساعد على هذا فلا نعلم أحدًا. قال الفاسق في حال خسوفه. وأيضا فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة أنه الخسوف. وإنما هو الدخول من قولهم وقبت العين إذا غارت وركية وقبار غار ماؤها فدخل في أعماق التراب.
ومنه الوقب للثقب الذي يدخل فيه المحور. وتقول العرب: وقب يقب وقوبًا إذا دخل.
فإن قيل: فلما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن الغاسق هو الثريا إذا سقطت. فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبها وترتفع عند طلوعها.
قيل: إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل. وإن أراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما فهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه، وأما أن يختص اللفظ به فباطل.
فصل: سبب الاستعاذة من شر الليل
والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة وفيه تنتشر الشياطين. وفي الصحيح أن النبي أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين ولهذا قال: فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء. وفي حديث آخر: فإن الله يبث من خلقه ما يشاء. والليل هو محل الظلام وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار؛ فإن النهار نور والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة وعلى أهل الظلمة
وروي أن سائلا سأل مسيلمة كيف يأتيك الذي يأتيك فقال في ظلماء حندس، وسأل النبي كيف يأتيك؟ فقال: في مثل ضوء النهار. فاستدل بهذا على نبوته وأن الذي يأتيه ملك من عند الله وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان. ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير. ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه. وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن.
فصل: سر الاستعاذة برب الفلق
من ههنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع، فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل. فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب. أو كن أو غار، وتأوي الهوام إلى أحجرتها والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها. ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور ويدع الكفار في ظلمات كفرهم. قال تعالى: { الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات }، [288] وقال تعالى: { أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها }، [289] وقال في اعمار الكفار: { أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور }. [290]
وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإيمان ونورهم: { الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء }. [291]
فالإيمان كله نور ومآله إلى نور ومستقره في القلب المضيء المستنير والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة والكفر الشرك كله ظلمة ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة والمقترن بها الأرواح المظلمة.
فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة، ومن شر ما يحدث فيها ونزل هذا المعنى على الواقع يشهد بأن القرآن بل هاتان السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد ﷺ ومضادة لما جاء به الشياطين من كل وجه. وإن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فما فعلوه ولا يليق بهم، ولا يتأتى منهم، ولا يقدرون عليه.
وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي قصر المتكلمون غاية التقصير في دفعها، وما شفوا في جوابها. وإنما الله سبحانه هو الذي شفى وكفى في جوابها فلم يحوجنا إلى متكلم، ولا إلى أصولي، ولا أنظار. فله الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه.
فصل: تفسير الفلق
واعلم أن الخلق كله فلق وذلك أن فلقًا فعل بمعنى مفعول كقبض وسلب وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز وجل فالق الأصباح، وفالق الحب والنوى، وفالق الأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأجنة، والظلام عن الأصباح، ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة فلقًا وفرقًا. يقال: هو أبيض من فرق الصبح وفلقه.
وكما أن في خلقه فلقًا وفرقًا. فكذلك أمره كله فرقان يفرق بين الحق والباطل. فيفرق ظلام الباطل بالحق كما يفرق ظلام الليل بالإصباح، ولهذا سمى كتابه الفرقان ونصره فرقانًا لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه فلقه البحر لموسى وسماه فلقًا وفرقا.
فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع، وظهر بهذا إعجاز القرآن وعظمته وجلالته وأن العباد لا يقدرون قدره، وأنه تنزيل من حكيم حميد.
فصل: شر النفاثات في العقد
الشر الثالث شر النفاثات في العقد. وهذا الشر هو شر السحر، فإن النفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل وهو مرتبة بينهما، والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري، لا الأمر الشرعي.
فإن قيل فالسحر يكون من الذكور والإناث فلم خص الإستعاذة من الإناث دون الذكور؟
قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع وهو أن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي ﷺ. هذا جواب أبي عبيدة وغيره. وليس هذا بسديد فإن الذي سحر النبي ﷺ هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح.
والجواب المحقق إن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات، لا النساء النفاثات، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه إنما يظهر منها. فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله أعلم.
ففي الصحيح عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ طُبَّ حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعه، وأنها دعا ربه، ثم قال: أشعرتِ أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال له: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، بئر في بني زريق، قالت عائشة رضي الله عنها: فأتاها رسول الله ﷺ ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين. قال: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته، قال: أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمر بها فدفنت. قال البخاري: وقال الليث وسفيان بن عيينة عن هشام في مشط ومشاقة، ويقال إن المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة من مشاقة الكتان.
قلت: هكذا في هذه الرواية إنه لم يخرجه اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه. وقد روى البخاري من حديث سفيان بن عيينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشام عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، فقال: يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق حليف ليهود وكان منافقا، قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة، قال: وأين؟ قال: في جف طلع ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان، قال: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رءوس الشياطين، قال: فاستخرج، قالت: فقلت: أفلا؟ أي تنشَّرت، فقال: أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
ففي هذا الحديث أنه استخرجه، وترجم البخاري عليه باب هل يستخرج السحر.
وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب ويؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه.
فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما فإن حديث عيسى عن هشام عن أبيه الأول فيه أنه لم يستخرجه وحديث ابن جريج عن هشام فيه أنه استخرجه، ولا تنافي بينهما فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ثم دفنه بعد أن شفي.
وقول عائشة رضي الله عنها "هلا استخرجته" أي هلا أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوه، فأخبرها بالمانع له من ذلك وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك فيقع الإنكار ويغضب للساحر قومه فيحدث الشر؛ وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر بها فدفنت ولم يستخرجها للناس. فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة، والذي يدل عليه أنه إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه ولم يجيء إليه لينظر إليها ثم ينصرف، إذ لا غرض له في ذلك والله أعلم.
وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته وقد اعتاض على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على هشام وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء قال لأن النبي لا يجوز أن يسحر فإنه يكون تصديقا لقول الكفار: { إن تتبعون إلا رجلا مسحورا }، [292] قالوا وهذا كما قال فرعون لموسى: { إني لأظنك يا موسى مسحورا }. [293] وقال قوم صالح له: { إنما أنت من المسحرين } [294] وقال قوم شعيب له: إنما أنت من المسحرين. قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين.
وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة رضي الله عنها.
وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء؛ وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله ﷺ وأيامه من المتكلمين.
قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد ابن الأرقم قال سحر النبيَّ ﷺ رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال: فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لذلك عقدا، فأرسل رسول الله عليا فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول الله كأنما أنُشِط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط.
وقال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله ﷺ فدنت إليه اليهود فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي وعدة أسنان من مُشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود فنزلت هاتان السورتان فيه.
قال البغوي: وقيل كانت مغروزة بالإبرة، فأنزل الله تعالى هاتين السورتين وهما أحد عشرة آية: سورة الفلق خمس آيات وسورة الناس ست آيات، فكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، فقام النبي كأنما أُنشط من عقال.
قال: وروي أنه لبث فيه ستة أشهر واشتد عليه ثلاثة أيام فنزلت المعوذتان.
قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما، فإن المرض يجوز على الأنبياء وكذلك الإغماء. فقد أغمي عليه في مرضه ووقع حين انفكت قدمه وجُحِش شِقُّه. وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيل كرامته. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس. فليس ببدع أن يبتلى النبي ﷺ من بعض أعدائه بنوع من السحر كما ابتلي بالذي رماه فشجه وابتلي بالذي ألقى على ظهره السَّلى وهو ساجد، وغير ذلك. فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله.
قالوا: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي فقال: يا محمدُ اشتكيتَ؟ فقال: نعم، فقال: باسم الله أَرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفسٍ أو عينِ حاسدٍ اللهُ يشفيك، بسم الله أَرقيك. فعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته ﷺ، وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره.
قالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها لا حجة لكم فيها. أما قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقول قوم صالح له: إنما أنت من المسحرين، فقيل المراد به من له سحر وهي الرئة، أي أنه بشر مثلهم يأكل ويشرب ليس بملك، ليس المراد به السحر. وهذا جواب غير مرض وهو في غاية البعد، فإن الكفار لك يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور ولا يعرف هذا في لغة من اللغات، وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر فقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنؤمن لبشر مثلنا، أبعث الله بشرا رسولا. وأما المسحور فلم يريدوا به ذا السحر وهي الرئة، وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع؟ ثم كيف يقول فرعون لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا أفتراه ما علم أنه له سَحرا وأنه بشر. ثم كيف يجيبه موسى بقوله وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولو أراد بالمسحور أنه بشر لصدقه موسى وقال نعم أنا بشر أرسلني الله إليك كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم: إن أنتم إلا بشرا مثلنا، فقالوا: إن نحن إلا بشرا مثلكم، ولم ينكروا ذلك. فهذا الجواب في غاية الضعف.
وأجابت طائفة منهم ابن جرير وغيره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إياه غيره، فالمسحور عنده بمعنى ساحر أي عالم بالسحر. وهذا جيد إن ساعدت عليه اللغة وهو أن من علم السحر يقال له مسحور، ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال، ولا في اللغة وإنما المسحور من سحره غيره كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. وأما من علِم السحر فإنه يقال له ساحر بمعنى أنه عالم بالسحر وإن لم يسحر غيره، كما قال قوم فرعون لموسى: { إن هذا لساحر عليم }. [295] ففرعون قذفه بكونه مسحورا، وقومه قذفوه بكونه ساحرا.
فالصواب هو الجواب الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغيره: أن المسحور على بابه، وهو من سُحِر حتى جُن فقالوا مسحور مثل مجنون، زائل العقل لا يعقل ما يقول، فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه: { معلم مجنون }. فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم وهو أنهم قد سُحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين. ولهذا قال تعالى: { انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا } [296]: مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى والمجنون مرة والمسحور أخرى، فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه، فإن أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة، فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلا ولا يقدر على سلوكها. فهذا حال أعداء رسول الله ﷺ معه حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها وهو أبعد خلق الله منها، وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان.
وأما قولكم: إن الأنبياء ينافي حماية الله لهم (أن يسحروا؛ فجوابه أن ما يصيبهم من أذى أعدائهم لهم وأذاهم إياهم لا ينافي حماية الله وصيانته لهم)، فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم، ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم، فيعجل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم، وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة، لا إله غيره ولا رب سواه.
فصل: تأثيرات السحر
وقد دل قوله: { ومن شر النفاثات في العقد }، وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر وإن له حقيقة. وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد. قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك. وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء.
والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقلًا وحلًا وعقدًا وحبًا وبغضًا ونزيفًا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس وكثير منهم قد علمه ذوقًا بما أصيب به منه.
وقوله تعالى: { ومن شر النفاثات في العقد }، دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه. ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرًا كما يقوله هؤلاء لم يكر للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه.
وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به مع أن هذا تغير في إحساسهم. فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم. وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن. فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركًا والمتصل منفصلًا والميت حيًا، فما المحيل لأن يغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضًا والبغيض محبوبًا، وغير ذلك من التأثيرات.
وقد قال تعالى عن سحرة فرعون: { سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم }، [297] فبين سبحانه أن أعينهم سحرت، وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي وهو الحبال والعصي مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها وهذا كما إذا جر من لا يراه حصيرًا أو بساطًا، فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له مع أنه هو الذي يجره. فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين فقلبتها كتقلب الحية، فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسها والشياطين هم الذين يقلبونها. وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصي تتحرك وهي ساكنة في أنفسها. ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا، فتارة يتصرف في نفس الرأي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به، وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها.
وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزيبق وغيره، حتى سعت، فهذا باطل من وجوه كثيرة. فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالًا بل حركة حقيقية، ولم يكن ذلك سحرًا لأعين الناس، ولا يسمى ذلك سحرًا بل صناعة من الصناعات المشتركة. وقد قال تعالى: { فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى }، [298] ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء، ومثل هذا لا يخفى. وأيضا لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزئبق وبيان ذلك المحال، ولم يحتج إلى إلقاء العصي لابتلاعها. وأيضا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة، بل يكفي فيها حذاق الصناع ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء. وأيضا فإنه لا يقال في ذلك إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها. وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده فلنرجع إلى المقصود.
فصل: شر الحاسد إذا حسد
الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد، وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود. فنفس حسده شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه، وإن لم يؤذه بيده ولا لسانه، فإن الله تعالى قال: { ومن شر حاسد إذا حسد }، فحقق الشر منه عند صدور الحسد.
والقرآن ليس فيه لفظة مهملة. ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدًا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه. فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه ووجهت إليه سهام الحسد من قبله، فيتأذى المحسود بمجرد ذلك؛ فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والاقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا ناله شر الحاسد ولا بد. فقوله تعالى: { إذا حسد } بيان، لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل.
وقد تقدم في حديث أبي سعيد الصحيح رقية جبريل النبي ﷺ وفيها: بسم الله أَرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فهذا فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد. ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها إذ لو نظر إليه نظر لاه ساه عنه كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئًا، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة واتسمت واحتدت، فصارت نفسًا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيرًا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد، فربما أعطبه وأهلكه بمنزلة من فوّق سهمًا نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلًا وربما صرعه وأمرضه. والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر.
وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة وهي في ذلك بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث فتحدت فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الملسوع، وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة فتطمس البصر وتسقط الحبل، كما ذكره النبي ﷺ في الأبتر وذي الطفيتين منها وقال: «اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل». فإذا كان هذا في الحيات، فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية واتسمت وتوجهت إلى المحسود بكيفيتها. فلله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافى عاد مضنى على فراشه يقول طبيبه لا أعلم داءه ما هو فصدق، ليس هذا الداء من علم الطبائع، هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها.
وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس، والمحجوبون منكرون له، ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه. وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى، وهل الانفعال والتأثر وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح، والأجسام آلتها بمنزلة آلة الصانع. فالصنعة في الحقيقة له، والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع.
ومن له أدنى فطنة، وتأمل أحوال العالم ولطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها، كل ذلك بتقدير العزيز العليم خالق الأسباب والمسببات، رأى عجائب في الكون وآيات دالة على وحدانية الله وعظمته وربوبيته. وإن ثم عالمًا آخر تجري عليه أحكام أخر تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي اتقن ما صنع، وأحسن كل شيء خلقه. ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح، بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبهر وآياته أعجب.
وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم، فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات، كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب، وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويخف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. فرُب رجل عظيم الهيولا كبير الجثة خفيف على قلبك حلو عندك، وآخر لطيف الخلقة صغير الجثة أثقل على قلبك من جبل؛ وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها، وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلق والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلًا والأشباح تبعًا.
فصل: العائن والحاسد
والعائن والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه. فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا. ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد، أو حيوان، أو زرع أو مال، وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه، فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين.
وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى: { وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر }، [299] إنه الإصابة بالعين فأرادوا أن يصيبوا بها رسول الله ﷺ فنظر إليه قوم من العائنين. وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حجته. وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعينها، ثم يقول لخادمه: خذ المكتل والدرهم وأتنا بشيء من لحمها، فما تبرح حتى تقع فتنحر.
وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين، أو ثلاثة لا يأكل، ثم يرفع جانب خبائه، فتمر به الإبل فيقول: لم أر كاليوم إبلًا ولا غنمًا أحسن من هذه؛ فما تذهب إلا قليلًا حتى يسقط منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ﷺ بالعين ويفعل به كفعله في غيره، فعصم الله رسوله وحفظه وأنزل عليه: { وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم }، [300] هذا قول طائفة.
وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتيبة: ليس المراد أنهم يصيبونك بالعين كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك.
قال الزجاج: يعني من شدة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. وهذا مستعمل في الكلام يقول القائل نظر إلي نظرًا كاد يصرعني منها. قال: ويدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة فيحدون إليه النظر بالبغضاء.
قلت: النظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد. فيؤثر نظره فيه كما تؤثر نفسه بالحسد، ويقوى تأثير النفس عند المقابلة، فإن العدو إذا غاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه، فإذا عاينه قبلًا اجتمعت الهمة عليه وتوجهت النفس بكليتها إليه. فيتأثر بنظره حتى إن من الناس من يسقط ومنهم من يحم ومنهم من يحمل إلى بيته، وقد شاهد الناس من ذلك كثيرًا. وقد يكون سببه الإعجاب، وهو الذي يسمونه بإصابة العين، وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين. وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية المعين، فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون منه فيصاب بذلك.
قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن همام بن منبه [301] قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «العين حق»، ونهى عن الوشم. [302] وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين». [303]
فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة فهو نظر يكاد يزلقه لولا حفظ الله وعصمته. فهذا أشد من نظر العائن، بل هو جنس من نظر العائن، فمن قال إنه من الإصابة بالعين أراد هذا المعنى ومن قال ليس به أراد أن نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب، فالقولان حق.
وقد روى الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ كان يتعوذ من عين الإنسان. فلولا أن العين شر لم يتعوذ منها.
وفي الترمذي من حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني حابس بن حبة التميمي حدثني أبي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا شيء في الهام، والعين حق». [304]
وفيه أيضا من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا». قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث صحيح.
والمقصود أن العائن حاسد خاص وهو أضر من الحاسد. ولهذا والله أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم، فكل عائن حاسد ولا بد. وليس كل حاسد عائنًا. فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته.
وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمنى زوالها، فالحاسد عدو النعم، وهذا الشر هو من نفسه وطبعها، ليس هو شيئًا اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها، بخلاف السحر فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا والله أعلم قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن. فالحسد من شياطين الإنس والجن والسحر من النوعين. وبقي قسم ينفرد به شياطين الجن وهو الوسوسة في القلب فذكره في السورة الأخرى، كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه، بل هو أذى من أمر خارج عنه. ففرق بينهما في الذكر في سورة الفلق. والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه، ولهذا يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال والعزم الجازم، لأن ذلك بسعيه وإرادته، بخلاف شر الحاسد والساحر، فإنه لا يعاقب عليه إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته. فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة، وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة، وكثيرًا ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبة.
ولهذا اليهود أسحر الناس وأحسدهم، فإنهم لشدة خبثهم فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم. وقد وصفهم الله في كتابه بهذا وهذا فقال: { واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون }. [305]
وللكلام على أسرار هذه الآية وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية الالتباس، وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما موضع غير هذا؛ إذ المقصود الكلام على أسرار هاتين السورتين وشدة حاجة الخلق إليهما، وأنه لا يقوم غيرهما مقامهما.
وأما وصفهم بالحسد فكثير في القرآن كقوله تعالى: { أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله }، [306] وفي قوله: { ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق }. [307]
والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما، ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان، لأن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسدًا. فالحاسد من جند إبليس، وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه، وربما يعبده من دون الله حتى يقضي له حاجته وربما يسجد له. وفي كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب. ولهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ. ولهذا سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب، وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام، وهم الذين سحروا رسول الله ﷺ. وفي الموطأ عن كعب قال: كلمات أحفظهن من التوراة لولاها لجعلتني يهود حمارًا، أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ.
والمقصود أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ويأمره بموجبه والساحر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشياطين.
فصل: الحاسد من الجن والإنس
وقوله: { ومن شر حاسد إذا حسد }، يعم الحاسد من الجن والإنس، فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله كما حسد إبليس أبانا آدم وهو عدو لذريته كما قال تعالى: { إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا }، [308] ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن والحسد أخص بشياطين الإنس، والوسواس يعمهما كما سيأتي بيانهما. والحسد يعمهما أيضا. فكلا الشيطانين حاسد موسوس. فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جميعًا. فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم. وتضمنت شرورًا أربعة يستعاذ منها: شرًا عامًا وهو شر ما خلق، وشر الغاسق إذا وقب، فهذا نوعان، ثم ذكر شر الساحر والحاسد، وهي نوعان أيضا لأنهما من شر النفس الشريرة، وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر، وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه إما بذبح باسمه أو بذبح يُقصد به هو، فيكون ذبحًا لغير الله، وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. والساحر وإن لم يسم هذا عبادة للشيطان فهو عبادة له وإن سماه بما سماه به. فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه. فمن سجد لمخلوق وقال ليس هذا بسجود له، هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة كما أقبلها بالنعم أو هذا إكرام، لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودًا لغير الله، فليسمه بما شاء. وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب، فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة بل يسميه استخدامًا ما. وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليس خدمة عبادة. فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به. والمقصود أن هذا عبادة منه للشيطان، وإنما سماه استخدامًا. قال تعالى: { ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين }. [309] وقال تعالى: { ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون }. [310] فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة، ولبئس المولى ولبئس العشير. فهذا أحد النوعين. والنوع الثاني: من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به وهو الحاسد، لأنه نائبه وخليفته، لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده.
فصل: تقييد الحاسد بقوله إذا حسد
وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: { إذا حسد } لأن الرجل قد يكون عنده حسد. ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما لا بقلبه، ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئًا من ذلك، ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله.
وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر لها بل يعصيها طاعة لله وخوفًا وحياء منه وإجلالًا له أن يكره نعمه على عباده، فيرى ذلك مخافة لله وبغضًا لما يحب الله ومحبة لما يبغضه، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح؛ فهذا الحسد المذموم وهذا كله حسد تمني الزوال.
وللحسد ثلاث مراتب أحدها هذه. الثانية تمني استصحاب عدم النعمة فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب فهذا حسد على شيء مقدر، والأول حسد على شيء محقق وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدو عباده وممقوت عند الله تعالى وعند الناس ولا يسود أبدًا ولا يرأس. فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم، فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدًا إلا قهرًا يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها، فهم يبغضونه وهو يبغضهم. والحسد الثالث حسد الغبطة وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه. فهذا لا بأس به، ولا يعاب صاحبه. بل هذا قريب من المنافسة. وقد قال تعالى: { وفي ذلك فليتنافس المتنافسون }، [311] وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس». فهذا حسد غبطة الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه وحب خصال الخير والتشبه بأهلها، والدخول في جملتهم وأن يكون من سباقهم وعليتهم ومصليهم، لا من فساكلهم، فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغبطه. وتمنى دوام نعمة الله عليه. فهذا لا يدخل في الآية بوجه ما. فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود فإنها تتضمن التوكل على الله، والإلتجاء إليه، والاستعاذة به من شر حاسد النعمة فهو مستعيذ بولي النعم وموليها كأنه يقول: يا من أولاني نعمته وأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني وهو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فلا تستبطىء نصره ورزقه وعافيته. فإن الله بالغ أمر، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ومن لم يخفه أخافه من كل شيء وما خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله قال تعالى: { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون }، [312] وقال: { إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين }، [313] أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم. فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم.
فصل: دفع شر الحاسد عن المحسود
ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب:
أحدها: التعوذ بالله من شره والتحصن به، واللجأ إليه، وهو المقصود بهذه السورة والله تعالى سميع لاستعاذته عليم بما يستعيذ منه، والسمع هنا المراد به سمع الإجابة لا السمع العام فهو مثل قوله: سمع الله لمن حمده. وقول الخليل ﷺ: { إن ربي لسميع الدعاء }، ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ ذلك، فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه، ويعلم كيده وشره. فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته أي مجيب علم بكيد عدوه يراه ويبصره لينبسط أمل المستعيذ ويقبل بقلبه على الدعاء، وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف وحم السجدة. وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير في سورة حم المؤمن فقال: { إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير }، [314] لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر. وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها، وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية والله أعلم.
السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. قال تعالى: { وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا }، وقال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس: «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك»، فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه. ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر.
السبب الثالث: الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلًا فما نصره على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله، ولا يستطل تأخيره وبغيه. فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندًا وقوة للمبغي عليه المحسود يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله، وقد قال تعالى: { ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله }، [315] فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولًا. فكيف بمن لم يستوفه شيئًا من حقه. بل بغى عليه وهو صابر، وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وقد سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكًا.
السبب الرابع: التوكل على الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدًا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه، قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال: { ومن يتوكل على الله فهو حسبه }، [316] ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر. كما قال في الأعمال. بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجًا من ذلك وكفاه ونصره. وقد ذكرناه حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في كتاب الفتح القدسي. وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وإنه من مقامات العوام، وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة، وبينا أنه من أجل مقامات العارفين وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله. وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر والباغي.
السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه، ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه. بل انعزل عنه لم يقدر عليه. فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر وهكذا الأرواح سواء. فإذا علق روحها وشبثها به، وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومنامًا لا يفتر عنه وهو يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبثا فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما، فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأن لا يخطره بباله، فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به بقى الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضًا. فإن الحسد كالنار، فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضًا. وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية، وبين الكيس الفطن، وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه، وتعلق روحه به، ولا يرى شيئًا ألم لروحه من ذلك، ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة التي رضيت بوكالة الله لها، وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي لنفسها فوثقت بالله، وسكنت إليه، واطمأنت به وعلمت أن ضمانه حق ووعده صدق وإنه لا أوفى بعهده من الله، ولا أصدق منه قيلًا فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها، أو نصر مخلوق مثلها لها، ولا يقوى على هذا إلا:
بالسبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه، وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئًا فشيئًا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب، والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه وذكره. كما يذكر المحب التام المحب لمحبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره ولا روحه انصرافا عن محبته، فإذا صار كذلك. فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت إنكاره وقلبه معمورًا بالفكر في حاسده، والباغي عليه والطريق إلى الانتقام منه. والتدبير عليه هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله وطلب مرضاته. بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه إياك وحمى الملك اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيها ونزل بها مالك، ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك، وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور. قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال: { فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين }، [317] قال تعالى: { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان }، [318] وقال: { إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون }، [319] وقال في حق الصديق يوسف ﷺ: { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين }، [320] فما أعظم سعادة من دخل هذاالحصن وصار داخل اليزك. لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به، ولا ضيعة على من آوى إليه، ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه { ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم }. [321]
السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإن الله تعالى يقول: { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم }، [322] وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه دونه ﷺ: { أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم }، [323] فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه، أو لا يعلمه وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره. وفي الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب. ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه. فقال له: قف حتى أدخل البيت، ثم أخرج إليك فدخل فسجد لله وتضرع إليه، وتاب وأناب إلى ربه، ثم خرج إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها. فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجباتها. فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح، وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منها فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه. ولا بد فما أسعده من عبد وما أبركها من نازلة نزلت به وما أحسن أثرها عليه. ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فما كل أحد يوفق لهذا لا معرفة ولا إرادة له ولا قدرة عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديمًا وحديثًا لكفى به فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق. وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملًا فيه باللطف والمعونة والتأييد. وكانت له فيه العاقبة الحميدة. فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن حصين وبالجملة، فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببًا لزوالها. ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن فإنه لا يفتر ولا يني ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود. فحينئذ يبرد أنينه وتنطفي ناره لا أطفأها الله فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله وهو كفران النعمة وهو باب إلى كفران المنعم. فالمحسن المتصدق يستخدم جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه. فمن لم يكن له جند ولا عسكر ولا عدو، فإنه يوشك أن يظفر به عدوه. وإن تأخرت مدة الظفر والله المستعان.
السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو طفي نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. فكلما ازداد أذى وشرًا وبغيًا وحسدًا ازددت إليه إحسانًا، وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلًا عن أن تتعاطاه فاسمع الآن قوله عز وجل: { ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم }، [324] { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم }، [325] وقال: { أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون }. [326]
وتأمل حال النبي ﷺ الذي حكى عنه نبينا ﷺ أنه ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه. أحدها عفوه عنهم. والثاني استغفاره لهم. والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. الرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه، فقال: «اغفر لقومي»، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به: هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي.
واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به. اعلم أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك. ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله، فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به اساءتك. فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به اساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة. فإن الجزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس في اساءتهم في حقك بفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقًا. فانتقم بعد ذلك أو اعف وأحسن أو اترك فكما تدين تدان. وكما تفعل مع عباده يفعل معك. فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه. هذا مع ما يحصل له بذل من نصر الله ومعيته الخاصة كما قال النبي ﷺ للذي شكى إليه قرابته وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه فقال: «لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك». هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم معه على خصمه فإنه كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسيء وذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرًا لا يعرفهم ولا يعرفونه، ولا يريدون منه إقطاعًا ولا خبزًا. هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، وإما أن يفتتكبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه فإنه يذيقه بإحسانه أضاف ما ينال منه بانتقامه. ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة والله هو الموفق المعين بيده الخير كله لا إله غيره. وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه.
وفي الجملة ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة وآجلة سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه. فهو الذي يحسن عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه قال تعالى: { وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو }، [327] { وإن يردك بخير فلا راد لفضله }. [328] وقال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك». فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه. وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله. بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلًا واشتغالًا به عن غيره. فيرى أن أعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده. وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل. والله يتولى حفظه والدفع عنه. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإن كان مؤمنًا فالله يدافع عنه ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع، وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة كما قال بعض السلف: من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة.
فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء.
فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه وثقته به. وأن لا يخاف معه غيره، بل يكون خوفه منه وحده ولا يرجو سواه. بل يرجوه وحده فلا يعلق قلبه بغيره، ولا يستغيث بسواه، ولا يرجو إلا إياه، ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه، وكل إليه وخذل من جهته فمن خاف شيئًا غير الله سلط عليه، ومن رجا شيئًا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره. هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلًا.
فصل: تأثير نفوس الحاسدين وأعينهم والأرواح الشيطانية
فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التي لا غنى للعبد عنها في دينه ودنياه ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر، والنفث في العقد. وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق:
ففرقة أنكرت تأثير هذا وهذا. وهم فرقتان: فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن وأنكرت تأثيرهما البتة، وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية، وقالت: لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا الهيكل المحسوس وصفاته وأعراضه فقط. ولا وجود للجن والشياطين سوى أعراض قائمة به. وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام. وهو قول شذوذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة.
الفرقة الثانية أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن، وأقرت بوجود الجن والشياطين. وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم.
الفرقة الثالثة بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن وأنكرت وجود الجن والشياطين، وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس وصفاتها. وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم، وهؤلاء يقولون إنما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة. فهي من تأثيرات النفس ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصل وابن سينا وأتباعه على هذا القول. حتى إنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب. ويقولون: إنما هي من تأثيرات النفس في هيولي العالم وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل ليسوا من أتباع الرسل جملة.
الفرقة الرابعة وهم أتباع الرسل. وأهل الحق أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن، وأقروا بوجود الجن والشياطين وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من صفاتهما وشرهما، واستعاذوا بالله منه وعلموا أنه لا يعيذهم منه ولا يجبرهم إلا الله. فهؤلاء أهل الحق ومن عداهم مفرط في الباطل أو معه باطل وحق. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق.
(سورة الناس)
وأما سورة الناس: فقد تضمنمت أيضا استعاذة ومستعاذًا به ومستعاذًا منه.
فالاستعاذة تقدمت. وأما المستعاذ به فهو الله، "رب الناس، ملك الناس، إله الناس" فذكر ربوبيته للناس وملكه إياهم وإلاهيته لهم. ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان كما تقدم. فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث، ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة.
الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه، ودفع الشر عنهم وحفظهم مما يفسدهم، هذا معنى ربوبيته لهم وذلك يتضمن قدرته التامة ورحمته الواسعة وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم.
الإضافة الثانية: إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه. وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء النافذ القدرة فيهم الذي له السلطان التام عليهم فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب. وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم فلا صلاح لهم، ولا قيام إلا به وبتدبيره. فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو، ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم.
الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه، ولا معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد. فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكًا في إلهيته كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه.
وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة، وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره. فلا ينبغي أن يدبر ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه، ولا يذل لغيره، ولا يخضع لسواه، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقًا وكلهم عبيده ومماليكه أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين. بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك. وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه فمن كان ربهم وملكهم وإلههم، فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجأوا إلى غير حماه فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعًا بربوبيته وملكه وإلاهيته لهم، فكيف لا يلتجىء العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه. فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى الأعداء، وأعظمهم عداوة، وأشدهم ضررًا وأبلغهم كيدًا.
ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر ولم يوقع المضمر موقعه فيقول رب الناس وملكهم وإلههم تحقيقًا لهذا المعنى وتقوية له. فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه، ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة.
والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب وأخر الإلهية لخصوصها، لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلهًا. فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه، ولكن ترك إلهه الحق واتخذ إلهًا غيره، ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلًهية، لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره فهو المطاع إذا أمر وملكه لهم تابع لخلقه فملكه من كمال ربوبيته، وكونه إلههم الحق من كمال ملكه فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضي وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها. فهو الرب الحق الملك الحق الإله الحق خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه واستعبدهم بإلآهيته، فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق رب الناس ملك الناس إله الناس. وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه الحسنى.
أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى، فإن الرب هو القادر الخالق البارىء المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء، ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء، ويشقي ويعز من يشاء، ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى.
وأما الملك فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى، كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي المتعالي مالك الملك المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك.
وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى. ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلي، فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى. فكان المستعيذ بها جديرًا بأن يعاذ ويحفظ ويمنع من الوسواس الخناس، ولا يسلط عليه.
وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر. وإنما غاية أولى العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه وأن باديه إلى الخافي يسير.
فصل: الاستعاذة من الشر
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها، وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد وهو شر من خارج، وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخل.
فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه، لأنه ليس من كسبه. والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي. فهذا شر المعائب والأول شر المصائب، والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما. فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات، وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة.
فصل: الوسواس
إذا عرف هذا. فالوسواس فعلال من وسوس. وأصل الوسوسة الحركة، أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه، فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد ومن هذا وسوسة الحلى وهو حركته الخفية في الأذن والظاهر والله أعلم أنها سميت وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الإذن. فقيل: وسوسة الحلى، لأنه صوت مجاور للأذن كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس له.
ولما كانت الوسوسة كلامًا يكرره الموسوس ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها. فقالوا: وسوس وسوسة، فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه، ونظير هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه كالدوران والغليان والنزوان وبابه.
ونظير ذلك زلزل ودكدك وقلقل وكبكب الشيء، لأن الزلزلة حركة متكررة، وكذلك الدكدكة والقلقلة، وكذلك كبكب الشيء إذا كبه في مكان بعيد فهو يكب فيه كبًا بعد كب كقوله تعالى: { فكبكبوا فيها هم والغاوون }، [329] ومثله رضرضه إذا كرر رضه مرة بعد مرة ومثله ذر ذره إذا ذره شيئًا بعد شيء ومثله صرصر الباب إذا تكرر صريره. ومثله مطمط الكلام إذا مططه شيئًا بعد شيء، ومثله كفكف الشيء إذا كرر كفه وهو كثير.
وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي المضاعف لم يصب، لأن الثلاثي لا يدل على تكرار بخلاف الرباعي المكرر. فإذا قلت ذو الشيء وصر الباب وكف الثوب ورض الحب لم يدل على تكرار الفعل بخلاف ذرذر وصرصر ورضرض ونحوه، فتأمله فإنه مطابق للقاعدة العربية في الحذو بالألفاظ حذو المعاني. وقد تقدم التنبيه على ذلك فلا وجه لإعادته.
وكذلك قولهم عَجَّ العِجلُ، إذا صوت، فإن تابع صوته قالوا: عجعج. وكذلك ثج الماء إذا صب، فإن تكرر ذلك قيل ثجثج. والمقصود أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعها قيل وسوس.
فصل: هل الوسواس وصف أو مصدر
إذا عرف هذا فاختلف النحاة في لفظ الوسواس هل هو وصف، أو مصدر. على قولين، ونحن نذكر حجة كل قول، ثم نبين الصحيح من القولين بعون الله وفضله.
فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فعلل، والوصف من فعلل إنما هو مفعلل كمد حرج ومسرهف ومبيطر ومسيطر، وكذلك هو من فعل بوزن مفعل كمقطع ومخرج وبابه، فلو كان الوسواس صفة لقيل موسوس، ألا ترى أن اسم الفاعل من زلزل مزلزل لا زلزال، وكذلك من دكدك مدكوك وهو مطرد. فدل على أن الوسواس مصدر وصف به على وجه المبالغة، أو يكون على حذف مضاف تقديره ذو الوسواس. قالوا: والدليل عليه أيضا قول الشاعر: * تسمع للحلي بها وسواسًا * فهذا مصدر بمعنى الوسوسة سواء.
قال أصحاب القول الآخر: الدليل على أنه وصفًا أن فعلل ضربان أحدهما صحيح لا تكرار فيه كدحرج وسرهف وبيطر وقياس مصدر هذا الفعللة كالدحرجة والسرهفة والبيطرة. والفعلان بكسر الفاء كالسرهاف والدحراج والوصف منهه مفعلل كمدحرج ومبيطر.
والثاني فعلل الثنائي المكرر كزلزل ودكدك ووسوس وهذا فرع على فعلل المجرد عن التكرار، لأن الأصل السلامة من التكرار ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفه فمصدره يأتي على الفعللة كالوسوسة والزلزلة والفعلال كالزلزال، وأقيس المصدرين وأولاهما بنوعي فعلل الفعلال لأمرين:
أحدهما أن فعلل مشاكل لا فعل في عدد الحروف، وفتح الأول والثالث والرابع وسكون الثاني. فجعل أفعال مصدر أفعل وفعلال مصدر فعلل ليتشاكل المصدران كما يتشاكل الفعلان. فكان الفعلال أولى بهذا الوزن من الفعللة.
الثاني أن أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله، ومخالفة فعلال لفعلل أشد من مخالفة فعللة له فكان فعلال أحق بالمصدرية من فعللة، أو تساويًا في الإطراد مع أن فعللة أرجح في الاستعمال، وأكثر هذا هو الأصل.
وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء، فقالوا: وسوس الشيطان وسواسًا ووعوع الكلب وعواعًا إذا عوى وعظعظ السهم عظعاظًا. والجاري على القياس فعلال بكسر الفاء أو فعللة وهذا المفتوح نادر، لأن الرباعي الصحيح أصل للمتكرر، ولم يأت مصدر الصحيح مع كونه أصلًا إلا علىفعللة وفعلال بالكسر فلم يحسن بالرباعي المكرر لفرعيته أن يكون مصدره إلا كذلك، لأن الفرع لا يخالف أصله بل يحتذى فيه حذوه. وهذا يقتضي أن لا يكون مصدره على فعلال بالفتح فإن شذ حفظ ولم يزد عليه.
قالوا: وأيضا فإن فعلالًا المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل المكرر ليكون فيه نظير فعال من الثلاثي، لأنهما متشاركان وزنًا فاقتضى ذلك أن لا يكون لفعلال من المصدرية نصيب كما لم يكن لفعال فيها نصيب. فلذلك استندروا وقوع وسواس ووعواع وعظعاظ مصادر، وإنما حقها أن تكون صفات دالة على المبالغة في مصادر هـذه الأفعال.
قالوا: وإذا ثبت هذا فحق ما وقع منها محتملًا للمصدرية والوصفية أن يحمل على الوصفية حملًا على الأكثر الغالب وتجنبًا للشاذ. فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه ذو تقديرًا. فقوله خارج عن القياس والاستعمال الغالب ويدل على فساد ما ذهب إليه أمران:
أحدهما أن كل مصدر أضيف إليه ذو تقديرًا. فتجرده للمصدرية أكثر من الوصف به كرضى وصوم وفطر وفعلال المفتوح لم يثبت تجرده للمصدرية إلا في ثلاثة ألفاظ فقط وسواس ووعواع وعظعاظ على أن منع المصدرية في هذا ممكن، لأن غاية ما يمكن أن يستدل به على المصدرية قولهم وسوس إليه الشيطان وسواسًا وهذا لا يتعين للمصدرية لاحتمال أن يراد به الوصفية، وينتصب وسواسًا على الحال ويكون حالًا مؤكدة. فإن الحال قد يؤكد بها عاملها الموافق لها لفظًا ومعنى كقوله تعالى: { وأرسلناك للناس رسولًا }، [330] وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره نعم، إنما تتعين مصدرية الوسواس ذا سمع، أعوذ بالله من وسواس الشيطان، ونحو ذلك مما يكون الوسواس فيه إلى مضافًا إلى فاعله كما سمع ذلك في الوسوسة، ولكن أين لكم ذلك. فهاتوا شاهده. فبذلك يتعين أن يكون الوسواس مصدرًا لا بانتصابه بعد الفعل.
الوجه الثاني من دليل فساد من زعم أن وسواسًا مصدر مضاف إليه ذو تقديرًا أن المصدر المضاد إليه ذو تقديرًا لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. بل يلزم طريقة واحدة ليعلم أصالته في المصدرية وإنه عارض الوصفية. فيقال: امرأة صوم وامرأتان صوم ونساء صوم، لأن المعنى ذات صوم وذاتا صوم وذوات صوم وفعلال الموصوف به ليس كذلك. بل يثنى ويجمع ويؤنث فتقول: رجل ثرثار وامرأة ثرثارة ورجال ثرثارون. وفي الحديث: «أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون» وقالوا: ريح رفرافة أي تحرك الأشجار. وريح سفسافة أي تنخل التراب. ودرع فضفاضة أي متسعة. والفعل من ذلك كله فعلل، والمصدر فعللة وفعلال بالكسر، ولم ينقل في شيء من ذلك فعلال بالفتح، وكذلك قالوا تمتام وفأفاء ولضلاض أي ماهر في الدلالة، وفجفاج كثير الكلام وهرهار أي ضحاك وكهكاه ووطواط أي ضعيف وحشحاش وعسعاس أي خفيف وهو كثير ومصدره كله الفعللة والوصف فعلال بالفتح ومثله هفهاف أي خميص ومثله دحداح أي قصير ومثله بجباج أي جسيم وتختاخ أي ألكن وشمشام أي سريع وشيء خشخاش أي مصوت وقعقاع مثله وأسد قضقاض أي كاسر وحية تضناض تحرك لسانها، فقد رأيت فعلال في هذا كله وصفًا لا مصدرًا. فما بال الوسواس أخرج عن نظائره وقياس بابه، فثبت أن وسواسًا وصف لا مصدر كثرثار وتمتام ودحداح وبابه.
ويدل عليه وجه آخر وهو أنه وصفه بما يستحيل أن يكون مصدرًا، بل هو متعين الوصفية وهو الخناس. فالوسواس الخناس وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان وحسن حذف الموصوف ههنا غلبه الوصف حتى صار كالعلم عليه. والموصوف إنما يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركًا يقع اللبس كالطويل والقبيح والحسن ونحوه. فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له لا لغيره. فأما إذا غلب الوصف واختص ولم يعرض فيه اشتراك فإنه يجري مجرى الاسم ويحسن حذف الموصوف كالمسلم والكافر والبر والفاجر والقاضي والداني والشاهد والوالي ونحو ذلك. فحذف الموصوف هنا أحسن من ذكره. وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل.
ومما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر أن الوصفية أغلب على فعلال من المصدرية كما تقدم، فلو أريد المصدر لأتي بـ"ذو" المضافة إليه ليزول اللبس وتتعين المصدرية. فإن اللفظ إذا احتمل الأمرين على السواء، فلا بد من قرينة تدل على تعيين أحدهما، فكيف والوصفية أغلب عليه من المصدرية؟
وهذا بخلاف صوم وفطر وبابهما، فإنها مصادر لا تلتبس بالأوصاف. فإذا جرت أوصافًا، علم أنها على حذف مضاف أو تنزيلًا للمصدر منزلة الوصف مبالغة على الطريقتين في ذلك. فتعين أن الوسواس هو الشيطان نفسه وأنه ذات لا مصدر والله أعلم.
فصل: الخناس وبيان اشتقاقه
وأما الخناس فهو فعال من خنس يخنس إذا توارى واختفى. ومنه قول أبي هريرة: لقيني النبي ﷺ في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه. وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور فليست لمجرد الاختفاء ولهذا وصفت بها الكواكب في قوله تعالى: { فلا أقسم بالخنس }، [331] قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتختفي ولا ترى. وكذلك قال علي رضي الله عنه: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى. وقالت طائفة: الخنس هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق وهي السبعة السيارة. قالوا: وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء. والخناس هو مأخوذ من هذين المعنيين فهو من الاختفاء والرجوع والتأخر. فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان وانبسط عليه وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى، وذلك الانخناس والانقباض هو أيضا تجمع ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج فهو تأخر ورجوع معه اختفاء.
وخنس وانخنس يدل على الأمرين معًا. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان. فإذا ذكر العبد ربه خنس.
ويقال رأسه كرأس الحية وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه فإذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكره عاد ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه.
وجيء من هذا الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس إيذانًا بشدة هروبه ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر الله. وأن ذلك دأبه وديدنه لا أنه يعرض له ذلك عند ذكر الله أحيانًا. بل إذا ذكر الله هرب وانخنس وتأخر. فإن ذكر الله هو مقمعته التي يقمع بها كما يقمع المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه من سياط وحديد وعصي ونحوها.
فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلًا ضئيلًا مضنى مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته.
وفي أثر عن بعض السلف أن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفر، لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة فشيطانه معه في عذاب شديد ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ولهذا يكون قويًا عاتيًا شديدًا.
فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار، فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه.
وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررًا لتكريره الوسوسة الواحدة مرارًا حتى يعزم عليها العبد وجاء بناء الخناس على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل، لأنه كلما ذكر الله انخنس، ثم إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة فجاء بناء اللفظين مطابقًا لمعنييهما.
فصل: الصفة الثالثة للوسواس
وقوله: { الذي يوسوس في صدور الناس }، صفة ثالثة للشيطان. فذكر وسوسته أولًا، ثم ذكر محلها ثانيًا وأنها في صدور الناس. وقد جعل الله للشيطان دخولًا في جوف العبد ونفوذًا إلى قلبه وصدره فهو يجري منه مجرى الدم. وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات.
وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله ﷺ معتكفًا فأتيته أزوره ليلًا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلِبني - وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد - فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا فقال النبي ﷺ: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، فقال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءًا - أو قال - شيئًا».
وفي الصحيح أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول ﷺ: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضيت أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتى لا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، فإذا لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا سجد سجدتي السهو».
ومن وسوسته ما ثبت وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته».
وفي الصحيح أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة».
ومن وسوسته أيضا أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله ولهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه، قال تعالى حكاية عن صاحب موسى إنه قال: { إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره }. [332]
وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته لتعم الاستعاذة شره جميعه. فإن قوله: { من شر الوسواس }، يعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرًا وأقواها تأثيرًا وأعمها فسادًا وهي الوسوسة التي هي مبادي الإرادة، فإن القلب يكون فارغًا من الشر والمعصية. فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه. فيصير شهوة ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه، فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعته فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط وينسى ما وراء ذلك فتصير الإرادة عزيمة جازمة فيشتد الحرص عليها من القلب. فيبعث الجنود في الطلب فيبعث الشيطان معهم مددًا لهم وعونًا. فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم كما قال تعالى: { ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزًا }، [333] أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم وهو الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم فلا بتلك النخوة والكبر ولا يرضاه أن يصير قواد الكل من عصى الله كما قال بعضهم:
عجبت من إبليس في تيهه ** وقبح ما أظهر من نخوته
تاه على آدم في سجدة ** وصار قوادًا لذريته
فأصل كل معصية وبلاء، إنما هو الوسوسة. فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا.
فمن شره إنه لص سارق لأموال الناس فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف، وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. فيدخل سارقًا ويخرج مغيرًا ويدل على عوراتهم فيأمر العبد بالمعصية، ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومنامًا أنه فعل كذا وكذا.
ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه، ثم وسوس إلى الناس بما فعل، وألقاه إليهم فأوقعه في الذنب، ثم فضحه به. فالرب تعالى يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره إلا الله ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته. وقلّ من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة.
ومن شره أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدًا تمنعه من اليقظة كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان».
ومن شره أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح كما ثبت عن النبي ﷺ أنه ذكر عنده رجل نام ليله حتى فأصبح قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه». رواه البخاري.
ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه فإن خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع، فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته.
ويكفي من شره أنه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم، وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة، ثم لم يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض وقصد أن تكون الدعوة له. وأن يعبد من دون، الله فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض.
ويكتفي من شره أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار فرد الله كيده عليه، وجعل النار على خليله بردًا وسلامًا، وتصدى للمسيح ﷺ حتى أراد اليهود قتله وصلبه فرد الله كيده، وصان المسيح ورفعه إليه، وتصدى لزكريا ويحيى حتى قتلا. واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض ودعوى أنه ربهم الأعلى وتصدى للنبي ﷺ وظاهر الكفار على قتله بجهده والله تعالى يكتبه ويرده خاسئًا، وتفلت على النبي ﷺ بشهاب من نار يريد أن يرميه به وهو في الصلاة. فجعل النبي ﷺ يقول: «ألعنك بلعنة الله». وأعان اليهود على سحرهم للنبي ﷺ.
فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته ولا يمكن حصر أجناس شره فضلًا عن آحادها. إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه. ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر:
الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى يناله منه. فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه.
فإن يأس منه من ذلك وكان ممن سبقت له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد وهي ذنب لا يتاب منه وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعا إلى خلاف ما جاؤوا به وهي باب الكفر والشرك فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيًا من دعاته.
فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان الجد ممن سبق له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي الكبائر على اختلاف أنواعها فهو أشد حرصًا على أن يوقعه فيها. ولا سيما إن كان عالمًا متبوعًا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينًا وتقربًا بزعمه إلى الله تعالى وهو نائب إبليس، ولا يشعر فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها. فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم. ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به وذنوب هذا. ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء فإنها ظلم منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته، وبدل سيئاته حسنات، وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم وقصد لفضيحتهم. والله سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس.
فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاجها كما قال النبي ﷺ إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض. وذكر حديثًا معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارًا عظيمة فطبخوا واشتووا، ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالًا منه.
فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها.
فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظًا لوقته شحيحًا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب. نقله إلى المرتبة السادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل. فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له. إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. قل من يتنبه لهذا من الناس فإنه إذا رأى فيه داعيًا قويًا ومحركًا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان، فإن الشيطان لا يأمر بخير، ويرى أن هذا خير فيقول: هذا الداعي من الله، وهو معذور؛ ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت بها خيرًا أعظم من تلك السبعين بابًا وأجل وأفضل.
وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول ﷺ وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم، ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول ﷺ ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض. وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم والله يمن بفضله على من يشاء من عباده.
فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه، وقصد إخماله واطفاءه ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره وليمنع الناس من الانتفاع به فيبقى سعيه في تسليط المبطللين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر ولا يني. فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب، ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها أسر أو أصيب. فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله.
فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانك تزن به الناس، وتزن به الأعمال فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق والله المستعان وعليه التكلان ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعًا لمن تدبره ووعاه.
فصل: الصدور والقلوب
وتأمل السر في قوله تعالى: { يوسوس في صدور الناس }، ولم يقل في قلوبهم والصدر هو ساحة القلب وبيته. فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر، ثم تلج في القلب فهو بمنزلة الدهليز له، ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر، ثم تتفرق على الجنود.
ومن فهم هذا فهم قوله تعالى: { وليبتلي الله ما في صدوركم و ليمحص ما في قلوبكم } [334] فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقى ما يريد إلقاءه إلى القلب فهو موسوس في الصدر ووسوسته واصلة إلى القلب، ولهذا قال تعالى: { فوسوس لهما الشيطان }، [335] ولم يقل فيه. لأن المعنى. أنه ألقى إليه ذلك وأوصله فيه فدخل في قلبه.
فصل: الجار والمجرور من الجنة والناس
وقوله تعالى: { من الجنة والناس }، اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور بم يتعلق.
فقال الفراء وجماعة هو بيان للناس الموسوس في صدورهم والمعنى يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس أي الموسوس في صدورهم قسمان: إنس وجن.
فالوسواس يوسوس للجني كما يوسوس للانسي. وعلى هذا القول فيكون من الجنة والناس نصب على الحال، لأنه مجرور بعد معرفة على قول البصريين، وعلى قول الكوفيين نصب بالخروج من المعرفة هذه عبارتهم ومعناها أنه، لما لم يصلح أن يكون نعتًا للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه نصبًا. والبصريون يقدرونه حالًا أي كائنين من الجنة والناس، وهذا القول ضعيف جدًا لوجوه:
أحدها: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدور الجن ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي، ويجري منه مجراه من الإنسي. فأي دليل يدل على هذا حتى يصح حمل الآية عليه.
الثاني: أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا فإنه قال الذي يوسوس في صدور الناس. فكيف يبين الناس بالناس؟ فإن معنى الكلام على قوله يوسوس في صدور الناس الذين هم، أو كائنين من الجنة والناس. أفيجوز أن يقال في صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم؟ وهذا ما لا يجوز، ولا هو استعمال فصيح.
الثالث: أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين جنة وناس وهذا غير صحيح فإن الشيء لايكون قسيم نفسه. الرابع: أن الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه لا أصلًا ولا اشتقاقًا ولا استعمالًا ولفظهما يابى ذلك، فإن الجن إنما سمو جنًا من الاجتنان وهو الاستتهار، فهم مستترون عن أعين البشر فسموا جنًا لذلك من قولهم جنه الليل، وأجنه إذا ستره وأجن الميت إذا ستره في الأرض قال:
ولا تبك ميتًا بعد ميت أجنه ** عليٌّ وعباسٌ وآلُ أبي بكرِ
يريد النبي ﷺ.
ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه قال تعالى: { وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم }، [336] ومنه المجن لاستتار المحارب به من سلاح خصمه، ومنه الجنة لاستتار داخلها بالأشجار ومنه الجنة بالضم لما يقي الإنسان من السهام والسلاح، ومنه المجنون لاستتار عقله.
وأما الناس فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى وبينهما اشتقاق أوسط وهو عقد تقاليب الكلمة على معنى واحد والإنس والإنسان مشتق من الإيناس وهو الرؤية والإحساس ومنه قوله: { آنس من جانب الطور نارًا }، [337] أي رآها ومنه: { فإن آنستم منهم رشدًا }، [338] أي أحسستموه ورأيتموه. فالإنسان سمي إنسانًا، لأنه يونس أي يرى بالعين.
والناس فيه قولان:
أحدهما أنه مقلوب من أنس وهو بعيد والأصل عدم القلب.
والثاني وهو الصحيح أنه من النوس وهو الحركة المتتابعة، فسمي الناس ناسًا للحركة الظاهرة والباطنة كما سمي الرجل حارث وهمام وهما أصدق الأسماء كما قال النبي ﷺ، لأن كل أحد له هم وإرادة وهي مبدأ وحرث وعمل هو منتهى فكل أحد حارث وهمام. والحرث والهم حركتا الظاهر والباطن وهو حقيقة النوس وأصل ناس نوس تحركت الواو وقبلها فتحة فصارت ألفًا هذان هما القولان المشهوران في اشتقاق الناس.
وأما قول بعضهم أنه من النسيان وسمي الإنسان إنسانًا لنسيانه، وكذلك الناس سموا ناسًا لنسيانهم، فليس هذا القول بشيء وأين النسيان الذي مادته ن س ي إلى الناس، الذي مادته ن و س، وكذلك أين هو من الإنس الذي مادته ا ن س. وأما إنسان فهو فعلان من أ ن س والألف والنون في آخره زائدتان لا يجوز فيه غير هذا البتة، إذ ليس في كلامهم أنسن حتى لا يكون إنسانًا إفعالًا منه. ولا يجوز أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين إذ ليس في كلامهم انفعل. فيتعين أنه فعلان من الإنس، ولو كان مشتقًا من نسي لكان نسيانًا لا إنسانًا.
فإن قلت فهلا جعلته إفعلالًا وأصله إنسيان كليلة إصحيان، ثم حذفت الياء تخفيفًا فصار إنسانًا.
قلت: يأبى ذلك عدم إفعلال في كلامهم وحذف الياء بغير سبب ودعوى ما لا نظير له، وذلك كله فاسد على أن الناس قد قيل إن أصله الأناس فحذفت الهمزة فقيل الناس. واستدل بقول الشاعر:
إن المنايا يطلعـ ** ـن على الأناس الغافلينا
ولا ريب أن أناسا فعال، ولا يجوز فيه غير ذلك البتة. فإن كان أصل ناس أناسًا فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس ويكون الناس كالإنسان سواء في الاشتقاق ويكون وزن ناس على هذا القول عال لأن المحذوف فاؤه وعلى القول الأول يكون وزنه فعل لأنه من النوس. وعلى القول الضعيف يكون وزنه فلع، لأنه من نسي فقلبت لامه إلى موضع العين فصار ناسًا ووزنه فلعًا.
والمقصود أن الناس اسم لبني آدم فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح أن يكون من الجنة والناس بيانًا لقوله: { في صدور الناس }، وهذا واضح لإخفاء فيه.
فإن قيل: لا محذور في ذلك، فقد أطلق على الجن اسم الرجال كما في قوله تعالى: { وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن }، فإذا أطلق عليهم اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم الناس.
قلت: هذا هو الذي غر من قال: إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآية. وجواب ذلك أن اسم الرجال. إنما وقع عليهم وقوعًا مقيدًا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس، ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقًا. وأنت إذا قلت: إنسان من حجارة أو رجل من خشب ونحو ذلك، لم يلزم من ذلك وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب. وأيضا فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس وذلك، لأن الناس والجنة متقابلان، وكذلك الإنس والجن. فالله سبحانه يقابل بين اللفظين كقوله: { يا معشر الجن والإنس }، [339] وهو كثير في القرآن. وكذلك قوله: { من الجنة والناس }، يقتضي أنهما متقابلان فلا يدخل أحدهما في الآخر بخلاف الرجال والجن فإنهما لم يستعملا متقابلين فلا يقال الجن والرجال، كما يقال الجن والإنس. وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس، لأنه قابل بين الجنة والناس فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخرة. فالصواب القول الثاني وهو أن قوله: { من الجنة والناس } بيان للذي يوسوس وأنهم نوعان: إنس وجن، فالجني يوسوس في صدور الإنس، والإنسي أيضا يوسوس إلى الأنسي.
فالموسوس نوعان: إنس وجن. فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب وهذا مشترك بين الجن والإنس وإن كان إلقاء الإنسي ووسوسته، إنما هي بواسطة الأذن والجني لا يحتاج إلى تلك الواسطة، لأنه يدخل في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم.
على أن الجني قد يتمثل له ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي كما في البخاري. عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن.
ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني قال تعالى: { وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا }، [340] فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله فشياطين الإنس والجن يشتركان في الوحي الشيطاني، ويشتركان في الوسوسة. وعلى هذا فتزول تلك الإشكالات والتعسفات التى ارتكبها أصحاب القول الأول.
وتدل الآية على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين شياطين الإنس والجن. وعلى القول الأول إنما تكون الاستعاذة من شر شياطين الجن فقط. فتأمله فإنه بديع جدًا.
فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين وله الحمد والمنة. وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمط فما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين ونختم الكلام على السورتين بذكر:
قاعدة نافعة: اعتصام العبد من الشيطان
فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه.
وذلك عشرة أسباب:
أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى: { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم }، [341] وفي موضع آخر: { إنه سميع عليم }، [342] وقد تقدم أن السمع المراد به ههنا. سمع الإجابة لا مجرد السمع العام.
وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة. هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصها. وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حم لاقتضاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه. فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه. وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، كما قال الله تعالى.
والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا. بل يريه أن هذا ذل وعجز، ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه، وأن لا يسيء إليه ولا يحسن فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله وما عنده على حظه العاجل، فكان المقام مقام تأكيد وتحريض فقال فيه: { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم }. [343]
وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان. بل بالإعراض. وهذا سهل على النفوس غير مستعصي عليها. فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان فقال: { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم }، [344] وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين، وبين قوله في حم المؤمن: { فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير }.
وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسًا مع النبي ﷺ ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد».
الحرز الثاني: قراءة هاتين السورتين فإن لهما تاثيرًا عجيبًا في الاستعاذة بالله من شره ودفعه والتحصن منه. ولهذا قال النبي ﷺ: «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما». وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم، وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. وتقدم قوله ﷺ: «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثًا حين يمسي وثلاثًا حين يصبح كفته من كل شيء».
الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان فأتى آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ. فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي ﷺ: «صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان».
وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله وتأييده.
الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة. ففي الصحيح من حديث سهل عن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا وأن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان».
الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان».
الحرز السادس: أولى سورة حم المؤمن إلى قوله: { إليه المصير } [345] مع آية الكرسي، ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة، عن زرارة بن مصعب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح»، وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه. فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي، وهو محتمل على غرابته.
الحرز السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة، ففي الصحيحين من حديث سمى مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك»، فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه.
الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل. ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي ﷺ قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطىء بها»، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تامرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدِ إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمرَكم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمرَكم أن تذكروا الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعًا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي ﷺ: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع». ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من حثاء جهنم». فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام قال: «وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله». قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، وقال البخاري: الحارث الأشعري له صحبة، وله غير هذا الحديث. [346]
فقد أخبر النبي ﷺ في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل أعوذ برب الناس، فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي وساوس الشر كله فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل.
الحرز التاسع: الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه. ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة. فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رايتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض، وفي أثر آخر إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء»، فأما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة. فإنها نار والوضوء يطفئها. والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه.
الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان، ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به. والفكرة في الظفر به. فمبدأ الفتنة من فضول النظر كما في المسند عن النبي ﷺ أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه، أو كما قال ﷺ. فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر:
كل الحوادث مبداها من النظر ** ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة فتكت في قلبها صاحبها ** فتك السهام بلا قوس ولا وتر
وقال الآخر:
وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا ** لقلبك يومًا أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر ** عليه ولا عن بعضه أنت صابر
وقال المتنبي:
وأنا الذي جلب المنية طرفه ** فمن المطالب والقتيل القاتل
ولي في أبيات:
يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدًا ** أنت القتيل بما ترمي فلا تصب
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له ** توقه إنه يرتد بالعطب
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض ** فهل سمعت ببرء جاء من عطب
ومفنيًا نفسه في أثر أقبحهم ** وصفًا للطخ جمال فيه مستلب
وواهبًا عمره في مثل ذا سفها ** لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب
وبائعًا طيب عيش ماله خطر ** بطيف عيش من الآلام منتهب
غبنت والله غبت فاحشًا فلو اسـ ** ترجعت ذا العقد لم تغبن ولم تخب
وواردًا صفو عيش كله كدر ** أمامك الورد صفوًا ليس بالكذب
وحاطب الليل في الظلماء منتصبًا ** لكل داهية تدن من العطب
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب ** وضاع وقتك بين اللهو واللعب
وشمس عمرك قد حان الغروب لها ** والفيء في الأفق الشرقي لم يغب
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت ** عن أفقه ظلمات الليل والسحب
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ** ورسل ربك قد وافتك في الطلب
ما في الديار وقد سارت ركائب من ** تهواه للصب من سكنى ولا أرب
فافرش الخد ذياك التراب وقل ** ما قاله صاحب الأشواق في الحقب
ما ربع مية محفوفًا يطوف به ** غيلان أشهى له من ربعك الخرب
ولا الخدود وإن أدمين من ضرج ** أشهى إلى ناظري من خدك الترب
منازلًا كان يهواها ويألفها ** أيام كان منال الوصل عن كثب
فكلما جليت تلك الربوع له ** يهوي إليها هوى الماء في صبب
أحيى له الشوق تذكار العهود بها ** فلو دعا القلب للسلوان لم يجب
هذا وكم منزل في الأرض يألفه ** وما له في سواها الدهر من رغب
ما في الخيام أخو وجد يريحك أن ** بثثته بعض شأن الحب فاغترب
وأسر في غمرات الليل مهتديًا ** بنفحة الطيب لا بالنار والحطب
وعاد كل أخي جبن ومعجزة ** وحارب النفس لا تلقيك في الحرب
وخذ لنفسك نورًا تستضيء به ** يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب
فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه ** إلا بنور ينجي العبد في الكرب
والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء.
وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها مداخل للشيطان. فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. وقد قال النبي ﷺ لمعاذ: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم». وفي الترمذي أن رجلًا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة طوبى له، فقال النبي ﷺ: «فما يدريك، فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه».
وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشيطان فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسئمان بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلىء لم يبق فيه إرادة للطعام، وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات. وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان.
وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر. فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرًا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام وكم من طاعة حال دونها. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرًا عظيمًا. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا جاء في بعض الآثار ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم، وقال النبي ﷺ: «ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطن». ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، واذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات. وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت.
وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات. وهي في القلوب لا تزول بفضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر.
أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه في اليوم والليلة. فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر وهم العلماء بالله، وأمره ومكايد عدوه، وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب من مخالطتهم الربح كله.
القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحًا فلا حاجة لك في خلطته وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش، وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للإدواء ونحوها، فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من:
القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا. ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف.
ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربًا عليك فإذا فارقك سكن الألم.
ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها. بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به. فهو يحدث من فيه كلما تحدث، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا يطاق حملها، ولا جرها على الأرض.
ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر.
ورأيت يومًا عند شيخنا قدس الله روحه رجلًا من هذا الضرب والشيخ يحمله، وقد ضعفت القوى عن حمله، فالتفت إلي وقال مجالسة الثقيل: حمى الربع، ثم قال، لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كما قال. وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة.
ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا.
القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم. فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس، لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله ﷺ الداعون إلى خلافها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا. فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله ﷺ قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتّنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينه وبين جيفة الدنيا قالوا: أنت من الملبّسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم، وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم فإنه عينُ كمالِكَ، كما قال:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص ** فهي الشهادة لي بأني فاضل
وقال آخر:
وقد زادني حبًا لنفسي أنني ** بغيض إلى كل امرىء غير طائل
فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم. وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة، واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشيطان. فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على نفسه أبواب جهنم، وفتح عليها أبواب الرحمة وانغمر ظاهره وباطنه. ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء فعند الممات يحمد القوم التقي، وفي الصباح يحمد القوم السري والله الموفق لا رب غيره، ولا إله سواه.
هامش
أحمد والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
بدائع الفوائد
المجلد الأول | المجلد الثاني | المجلد الثالث | المجلد الرابع
تصنيف:
بدائع الفوائد
=========
[التكاثر: 5]
[الواقعة: 95]
[طه: 39]
في النتائج: ولم يعذروا.
صحيح مسلم
[ص: 45]
[ص: 75]
[طه: 39]
[القمر: 14]
[هود: 37]
[طه: 41]
[طه: 39]
[القيامة: 18]
[يوسف: 3]
[آل عمران: 28، 30]
[الزمر: 56]
[العلق: 15 - 16]
[النحل: 73]
[الأحقاف: 30]
[الشورى: 52]
[الأنعام: 87]
[التوبة: 92]
[الفتح: 2]
[الشورى: 52]
[الأنعام: 87]
[الأنعام: 161]
[الشورى: 52]
[التوبة: 33]
[الحديد: 25]
[آل عمران: 1 - 4]
[الأنفال: 41]
[الأنبياء: 84]
[الصافات: 117]
[الصافات: 118]
[الأحقاف: 30]
[الأحقاف: 9]
[الاحقاف: 30]
[البقرة: 274]
[الزمر: 33]
[الأحقاف: 13]
[الأحقاف: 78، 79، 80]
[الجن: 10]
[الكهف: 82]
[البقرة: 187]
[البقرة: 275]
[المائدة: 3]
[الأنعام: 151]
[النساء: 23]
[النساء: 24]
[المائدة: 3]
[البقرة: 152]
[الفتح: 2]
[الشورى: 52]
[الأنعام: 161]
[الأعراف: 43]
[الإسراء: 9]
[الإنسان: 6]
[الحج: 25]
[النساء: 69]
[البقرة: 15]
[إبراهيم: 34]
[البقرة: 122]
[النحل: 81 - 83]
[البقرة: 122]
[آل عمران: 197]
[البقرة: 217]
[العلق: 16]
[البقرة: 90]
[النحل: 88]
[الملك: 3 - 4]
[البقرة: 9]
[المائدة: 60]
[المائدة: 78 - 80]
[المائدة: 77]
[المائدة: 72]
[المؤمنون: 1 - 3]
[الأعلى: 1 - 3]
[طه: 5]
[المؤمنون: 115]
[الأنعام: 38]
[الأنعام: 37]
[فصلت: 17]
[الشورى: 52]
[النحل: 93]
[النحل: 37]
[القصص: 56]
[الشورى: 52]
[يونس: 9]
[الأعراف: 43]
[الصافات: 23]
[البقرة: 201]
[البروج: 5]
[آل عمران: 97]
[البقرة: 183]
[المائدة: 3]
[الأنعام: 151]
[آل عمران: 96 - 97]
[الحج: 26]
[البقرة: 217]
أهل السنن
[الأعراف: 70]
[البقرة: 222]
[الأنعام: 128]
[التغابن: 10]
[البقرة: 184]
[الحج: 37]
[البقرة: 93]
[الأعراف: 155]
[نوح: 4، الأحقاف: 31]
[البقرة: 58]
[آل عمران: 147]
[الصف: 12]
[البقرة: 271]
[نوح: 17]
[الأعراف: 75]
[البقرة: 61]
[البقرة: 146]
[التوبة: 101]
[الأنفال: 60]
[المطففين: 3]
[المطففين: 2]
[البقرة: 286]
[المجادلة: 1]
[آل عمران: 181]
[البقرة: 104]
[المائدة: 41، 42]
[التوبة: 47]
[الأحقاف: 12]
[النساء: 164]
[الأعراف: 144]
[القصص: 7]
[المائدة: 111]
[الأعراف: 143]
[مريم: 52]
[يس: 71]
[الإنسان: 9]
[الفرقان: 62]
تغير حركة الرَّوِي
[الواقعة: 55]
[الشعراء: 155]
[آل عمران: 13]
[الأحزاب: 10]
[البقرة: 185]
[المزمل: 2]
[يوسف: 43]
[الأحقاف: 46]
[المائدة: 48]
[آل عمران: 3]
[الأنعام: 92]
[البقرة: 91]
[فاطر: 31]
[غافر: 67]
[هود: 64، الأعراف: 73]
[مريم: 17]
[الواقعة: 91]
[الفرقان: 63]
[القصص: 55]
[مريم: 33]
[النمل: 59]
[الأحزاب: 56]
[الزمر: 29]
[الأنفال: 61]
[الإسراء: 111]
[الصافات: 180 - 181]
[الصافات: 109]
[الصافات: 79]
[الصافات: 130]
[هود: 48]
[يس: 57 - 58]
[يس: 58]
[الأحزاب: 44]
[الرعد: 23]
تحرفت في الأصول
[الواقعة: 90 - 91]
[الصافات: 109]
[الصافات: 79]
[الرعد: 25]
[الأنبياء: 18]
[الواقعة: 91]
من أمثال العرب
[البقرة: 221]
[محمد: 21]
[البقرة: 88]
[المائدة: 13]
[آل عمران: 159]
[المائدة: 13]
[هود: 48]
[الشرح: 5 - 6]
[الفرقان: 63]
[الفرقان: 63]
[القصص: 55]
[يوسف: 53]
[النازعات: 40]
[الروم: 47]
[الحجر: 92]
[مريم: 68]
[إبراهيم: 13]
[ص: 84 - 85]
[آل عمران: 195]
[الأعراف: 6]
[يس: 1]
[الصافات: 171 - 173]
[هود: 191]
[طه: 129، فصلت: 45، الشورى: 14]
[المائدة: 8]
[التوبة: 72]
[طه: 47 - 48]
[طه: 47]
[النمل: 59]
[الصافات: 79]
[الصافات: 109]
[الصافات: 120]
[الصافات: 130]
[الصافات: 180 - 181]
[الأنبياء: 112]
[المؤمنون: 118]
[الأعراف: 89]
[هود: 73]
[الصافات: 109]
[الصافات: 79]
[الصافات: 130]
[الرعد: 24]
[ص: 78]
[الحجر: 35]
[التوبة: 98]
أبو داود في المراسيل والبيهقي في الكبرى من مرسل عمرو بن شعيب.
[الزمر: 71]
[الزمر: 73]
[آل عمران: 164]
[الحجرات: 17]
[الأنعام: 149]
[إبراهيم: 34]
[البقرة: 201]
[آل عمران: 171]
[هود: 73]
[هود: 9]
[الفرقان: 48]
[غافر: 7]
[الأعراف: 156]
[مريم: 31]
[الأعراف: 54]
[الملك: 1]
[المؤمنون: 14]
[الزخرف: 85]
[الفرقان: 1]
[الفرقان: 10]
[الفرقان: 61]
[الأعراف: 54]
[الزخرف: 85]
[آل عمران: 147]
[الأعراف: 23]
[القصص: 16]
[هود: 47]
[الحشر: 1، الصف: 1]
[الأعراف: 54]
[المؤمنون: 14]
[الفرقان: 1]
[المائدة: 114]
[المائدة: 112]
[الجن: 6]
[الرعد: 11]
[الفجر: 24]
[الزمر: 56]
[آل عمران: 193]
[القلم: 36]
[الجاثية: 21]
[ص: 28]
[الفرقان: 55]
[الكهف: 50]
[البقرة: 254]
[النساء: 160]
[الأنعام: 146]
[الزخرف: 76]
[الجن: 10]
[الكهف: 79]
[الكهف: 82]
[الحجرات: 7]
[آل عمران: 14]
[الشعراء: 78 - 82]
[فاطر: 32]
[الشورى: 14]
[الأعراف: 169]
أحمد وأبو يعلى
[الإسراء: 78]
[ص: 57]
[النبأ: 24 - 25]
[الإسراء: 12]
[البقرة: 257]
[الأنعام: 122]
[النور: 40]
[النور: 35]
[الإسراء: 47]
[الإسراء: 101]
[الشعراء: 153]
[الشعراء: 34]
[الإسراء: 48]
[الأعراف: 116]
[طه: 66]
[القلم: 51]
[القلم: 51]
تحرف في بعض النسخ إلى "هشام بن قتيبة".
مصنف عبد الرزاق وصحيفة همام.
أحمد والترمذي وابن ماجه.
أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
[البقرة: 102]
[النساء: 54]
[البقرة: 109]
[فاطر: 6]
[يس: 60]
[سبأ: 40، 41]
[المطففين: 26]
[النحل: 98 - 100]
[آل عمران: 175]
[غافر: 56]
[الحج: 60]
[الطلاق: 3]
[ص: 82]
[الحجر: 42]
[النحل: 99]
[يوسف: 24]
[الجمعة: 4]
[الشورى: 30]
[آل عمران: 165]
[فصلت: 35]
[الأعراف: 200]
[القصص: 54]
[الأنعام: 17]
[يونس: 107]
[الشعراء: 94]
[النساء: 79]
[التكوير: 15]
[الكهف: 63]
[مريم: 83]
[آل عمران: 154]
[الأعراف: 20]
[النجم: 31]
[القصص: 29]
[النساء: 6]
[الأنعام: 130]
[الأنعام: 112]
[فصلت: 36]
[الأعراف: 200]
[فصلت: 36]
[الأعراف: 200]
[غافر: 3]
======
< بدائع الفوائد
→ الغلاف بدائع الفوائد
المجلد الأول
بدائع الفوائد/المجلد الأول
محتويات
1 فائدة: حقوق المالك والملك
2 فائدة: تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع
3 فائدة: تقديم الحكم على سببه
4 فائدة: الفرق بين الشهادة والرواية
5 فائدة: قول الواحد في هلال رمضان
6 فائدة: الهدية والاستئذان
7 فائدة: الخبر
8 فائدة: تقسيم الخبر
9 فائدة: معاني لفظ شهد
10 فائدة: حد الخبر
11 فائدة: الإنشاءات التي صيغها أخبار
12 فائدة: المجاز والتأويل
13 فائدة: إضافة الموصوف للصفة
14 فائدة: الاسم والمسمى
15 فائدة: اسم الله والاشتقاق
16 فائدة: هل الرحمن في البسملة نعت
17 فائدة: حذف العامل في بسم الله
18 فائدة: عطف الصلاة على البسملة
19 فائدة: بطلان أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة
20 فائدة: اشتقاق الفعل من المصدر
21 فائدة: المصدر عند الكوفيين
22 فائدة: عمل الحروف
23 فائدة: اختصاص الإعراب بالأواخر
24 فائدة: وصف الحرف بالحركة
25 فائدة: تقول نونت الكلمة وسينتها وكوفتها وزويتها
26 فائدة: التنوين في الكلمة
27 فائدة: الحكمة في علامة التصغير
28 فائدة: تنوع الأفعال
29 فائدة: إضافة ظروف الزمان للأحداث
30 (فائدة: قياس الأسماء الخمسة أن تكون مقصورة)
31 فوائد تتعلق بالحروف الروابط بين الجملتين وأحكام الشرط
32 فائدة: الروابط بين جملتين
33 فائدة عظيمة المنفعة: تقديم بعض الألفاظ الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب
34 (مسائل في المثنى والجمع)
35 (الواو والألف في يفعلون وتفعلان)
36 فائدة: أسماء الأيام
37 فائدة: الأمس واليوم والغد
38 فائدة: حذف لام يد ودم وغد
39 فائدة: دخول الزوائد على الحروف
40 فائدة: فعل الحال
41 فائدة: حروف المضارعة
42 فائدة: السين تشبه حروف المضارعة
43 فائدة بديعة: دخول أن على الفعل
44 فائدة: إذا الظرفية الشرطية
45 فائدة بديعة: لام كي ولام الجحود
46 فائدة: نفي الماضي ونفي المستقبل
47 فائدة بديعة: لام الأمر ولا الناهية
48 فائدة بديعة: المفرد والجمع وأسباب اختلاف علامات الجمع
49 فائدة: علامة التثنية والجمع
50 فائدة بديعة: تقدم علامة التثنية والجمع للفعل
51 فائدة بديعة: قولهم ضرب القوم بعضهم بعضا
52 فائدة: إنما للنفي والإثبات
53 فائدة بديعة: الوصلات الخمسة
54 فائدة بديعة: ما الموصولة
55 (سورة الكافرون)
56 فصل: الرد على المعتزلة
57 فائدة: ضمير من يكرمني
58 فائدة: حذف الألف من ما الاستفهامية
59 فائدة بديعة: قوله ثم لننزعن من كل شيعة
60 فائدة: تحقيق معنى أي
61 فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب
62 (في أسماء الله وصفاته)
63 (أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى)
64 فائدة: المعنى المفرد لا يكون نعتا
65 فصل: إقامة النعت مقام المنعوت
66 فائدة بديعة: النعت السببي
67 فائدة: اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه
68 فائدة: تفسير الكلام
69 فائدة بديعة: اسم الإشارة
70 فائدة: العامل في النعت
71 فائدة بديعة: حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة
72 فائدة: النعت
73 فائدة بديعة: الشيء لا يعطف على نفسه
74 تتمة
75 فائدة جليلة: تقدير العامل في المعطوف
76 فصل: حتى
77 تنبيه
78 فائدة: أو للدلالة على أحد الشيئين
79 فصل: لكن
80 (فصل في لا العاطفة)
81 فائدة بديعة: أم على ضربين
82 فصل: أم المنقطعة للإضراب
83 فائدة بديعة: لا يجوز إضمار حرف العطف
84 فائدة بديعة: كل لفظ دال على الإحاطة بالشيء وكأنه من لفظ الإكليل
85 فصل: كل ذلك لم يكن ولم يكن كل ذلك
86 فصل: إضافة كل للمخاطبين
87 فائدة: كلا وكلتا بين الكوفيين والبصريين
88 فائدة: تأكيد المفرد بأجمع
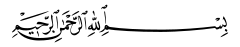
قال الشيخ الإمام العلامة الأوحد البارع أوحد الفضلاء وقدوة العلماء وارث الأنبياء شيخ الإسلام مفتي الأنام المجتهد المفسر ترجمان القرآن ذو الفوائد الحسان أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية تغمده الله برحمته.
الحمد لله ولا قوة إلا بالله، هذه فوائد مختلفة الأنواع.
فائدة: حقوق المالك والملك
حقوق المالك شيء وحقوق الملك شيء آخر، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق وحقوق الملك تتبع الملك ولا يراعى بها المالك، وعلى هذا حق الشفعة للذمي على المسلم من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين.
والنظر الثاني أظهر وأصح، لأن الشارع لم يجعل للذمي حقًا في الطريق المشترك عند المزاحمة. فقال: إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فكيف يجعل له حقًا في انتزاع الملك المختص به عند التزاحم وهذه حجة الإمام أحمد نفسه. وأما حديث لا شفعة لنصراني فاحتج به بعض أصحابه وهو أعلم من أن يحتج به، فإنه من كلام بعض التابعين.
فائدة: تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع
تمليك المنفعة شيء وتمليك الانتفاع شيء آخر، فالأول يملك به والمعاوضة، والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة وعليها إجارة ما استأجره، لأنه ملك المنفعة بخلاف المعارضة على البضع، فإنه لم يملكه، وإنما ملك أن ينتفع به. وكذلك أجاره ما ملك أن ينتفع به من الحقوق، كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس والربط ونحو ذلك لا يملكها، لأنه لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع وعلى هذا الخلاف تخرج إجارة المستعار فمن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما، قال: لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع ومن جوزها كمالك ومن تبعه. قال: هو قد ملك المنفعة، ولهذا يلزم عنده بالتوقيت، ولو أطلقها لزمت في مدة ينتفع بمثلها عرفًا، فليس له الرجوع قبلها.
فائدة: تقديم الحكم على سببه
قولهم: إذا كان للحكم سببان جاز تقديمه على أحدهما. ليس بجيد وفي العبارة تسامح والحكم لا يتقدم سببه، بل الأولى أن يقال: إذا كان للحكم سبب وشرط جاز تقديمه على شرطه دون سببه. وأما تقديمه عليهما أو على سببه فممتنع، ولعل النزاع لفظي فإن شرط الحكم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته، فلو قدمت الظهر مثلًا على الزوال والجلد على الشرب والزنا لم يجز اتفاقًا. وأما إذا كان له سبب وشرط فله ثلاثة أحوال. أحدها: أن يتقدم عليهما فلغو، والثاني: أن يتأخر عنهما فمعتبر صحيح، الثالث: أن يتوسط بينهما فهو مثار الخلاف. وله صور:
إحداها: كفارة اليمين سببها الحلف وشرطها الحنث، فمن جوز توسطها راعى التأخر عن السبب، ومن منعه رأى أن الشرط جزء من السبب.
الثانية: وجوب الزكاة سببه النصاب وشرطه الحول ومأخذ الجواز وعدمه ما ذكرناه.
الثالثة: لو كفر قبل الجرح كان لغوًا وبعد القتل معتبر وبينهما مختلف فيه.
الرابعة: لو عفى عن القصاص قبل الجرح فلغو وبعد الموت عفو الوارث معتبر وبينهما ينفذ أيضا.
الخامسة: إذا أخرج زكاة الحب قبل خروجه لا يجزي، وبعد يبسه يعتبر وبين نضجه ويبسه كذلك.
السادسة: إذا أذن الورثة في التصرف فيما زاد على الثلث قبل المرض فلغو وإجازتهم بعد الموت معتبرة وأذنهم بعد المرض مختلف فيه، فأحمد لا يعتبره لأنه أجازة من غير مالك. ومالك يعتبره وقوله أظهر.
السابعة: إذا أسقطا الخيار قبل التبايع ففيه خلاف فمن منعه نظر إلى تقدمه على السبب، ومن أجازه وهو الصحيح قال: الفرق بينهما أنهما قد عقدا العقد على هذا الوجه فلم يتقدم هنا الحكم على سببه أصلًا. فإنه لم يثبت وسقط بعد ثبوته وقبل سببه، بل تبايعا على عدم ثبوته وكأنه حق لهما رضيا بإسقاطه وعدم انعقاده وتجرد السبب عن اقتضائه. فمن جعل هذه المسألة من هذه القاعدة، فقد فاته الصواب.
ونظيرها سواءً اسقاط الشفعة قبل البيع فمن لم ير سقوطها، قال: هو تقديم للحكم على سببه، وليس بصحيح بل هو إسقاط لحق كان بعرض الثبوت، فلو أن الشفعة ثبتت ثم سقطت قبل البيع لزم ما ذكرتم ولكن صاحبها رضي بإسقاطها وأن لا يكون البيع سببًا لأخذه بها، فالحق له وقد أسقطه. وقد دل النص على سقوط الخيار والشفعة قبل البيع وصار هذا كما لو أذن له في إتلاف ماله وأسقط الضمان عنه قبل الاتلاف، فإنه لا يضمن اتفاقًا فهذا موجب النص والقياس. وأما إذا أسقطت المرأة حقها من النفقة والقسم، فلها الرجوع فيه ولا يسقط، لأن الطباع لا تصبر على ذلك ولا تستمر عليه لتجدد اقتضائها له كل وقت، بخلاف اسقاط الحقوق الثابتة دفعة كالشفعة والخيار ونحوهما، فإنها قد توطن النفس على إسقاطها وأشباهها لا تتجدد فافهمه.
فائدة: الفرق بين الشهادة والرواية
الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الأزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة. فإلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة واللهمة الموجبة للرد، فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبًا على الظن. صدق المخبر وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط. ولما كان النساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها، لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها، وأما اشتراط الحرية ففي غاية البعد ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، وقد حكى أحمد عن أنس بن مالك أنه قال: ما علمت أحدًا رد شهادة العبد والله تعالى يقبل شهادته على الأمم يوم القيامة. فكيف لا يقبل شهادته على نظيره على المكلفين ويقبل شهادته على الرسول ﷺ في الرواية فكيف لا يقبل على رجل في درهم ولا ينتقض هذا بالمرأة؟ لأنها تقبل شهادتها مع مثلها لما ذكرناه، والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد.
وعلى هذه القاعدة مسائل:
أحدها الاخبار عن رؤية هلال رمضان من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه للمكلفين، فهو كالأذان. ومن اشترط فيه العدد ألحقه بالشهادة لأنه لا يعم الأعصار ولا الأمصار، بل يخص تلك السنة وذلك المصر في أحد القولين وهذا ينتقض بالأذان نقضًا لا محيص عنه. وثانيها الاخبار بالنسب بالقافة فمن حيث أنه خبر جزئي عن شخص جزئي يخص ولا يعم جرى مجرى الشهادة، ومن جعله كالرواية غلط فلا مدخل لها هنا، بل الصواب، أن يقال من حيث هو منتصب للناس انتصابًا عامًا يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات جرى مجرى الحاكم. فقوله: حكم لا رواية.
ومن هذا الجرح للمحدث والشاهد هل يكتفى فيه بواحد إجراء له مجرى الحكم أو لا بد من اثنين؟ إجراء له مجرى الشهادة على الخلاف، وأما أن يجري مجرى الرواية فغير صحيح وأما للرواية والجرح. وإنما هو يجرحه باجتهاده لا بما يرويه عن غيره.
ومنها الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها. هل يشترط فيها التعدد؟ مبني على هذا ولكن بناؤه على الرواية والشهادة صحيح، ولا مدخل للحكم هنا.
ومنها التقويم للسلع من اشترط العدد رآه شهادة ومن لم يشترطه أجراه مجرى الحكم لا الرواية.
ومنها القاسم هل يشترط تعدده على هذه القاعدة؟ والصحيح الاكتفاء بالواحد لقصة عبد الله بن رواحة.
ومنها تسبيح المصلي بالإمام هل يشترط أن يكون المسبح اثنين؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة.
ومنها المخبر عن نجاسة الماء هل يشترط تعدده؟ فيه قولان.
ومنها الخارص والصحيح في هذا كله الاكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة، وأما تسبيح المأموم بإمامه ففيه نظر، وفيها المفتي يقبل واحدًا اتفاقًا.
ومنها الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع. والصحيح الاكتفاء فيه بالواحد كالتقويم والقائف. وقالت المالكية: لا بد من اثنين ثم تناقضوا. فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة.
فائدة: قول الواحد في هلال رمضان
إذا كان المؤذن يقبل قوله وحده، مع أن لكل قوم فجرًا وزوالًا وغروبًا يخصهم، فلأن بقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى وأحرى.
فائدة: الهدية والاستئذان
يقبل قول الصبي والكافر والمرأة في الهدية والاستئذان. وعليه عمل الأمة قديمًا وحديثًا، وذلك لما احتف بأخبارهم من القرائن التي تكاد تصل إلى حد القطع؟ في كثير من الصور مع عموم البلوى بذلك، وعموم الحاجة إليه. فلو أن الرجل لا يدخل بيت الرجل ولا يقبل هديته إلا بشاهدين عدلين يشهدان بذلك. حرجت الأمة. وهذا تقرير صحيح، لكن ينبغي طرده وإلا وقع التناقض. كما إذا اختلفا في متاع البيت، فإن القرائن التي تكاد تبلغ القطع تشهد بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنه. والمرأة لما يليق بها ولهذا قبله الأكثرون وعليه تخرج حكومة سليمان بين المرأتين في الولد وهي محض الفقه. وقد حكى ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس، وهو كما ذكر، وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال من اجتماع الأهل والقرابات وندرة التدليس، والغلط في ذلك مع شهرته وعدم المسامحة فيه ودعوى ضرورات الناس إلى ذلك ما أوجب قبول قولها.
فائدة: الخبر
قبول قول القصاب في الذكاة ليس من هذا الباب بشيء، بل هو من قاعدة أخرى. وهي أن الإنسان مؤتمن على ما بيده وعلى ما يخبر به عنه، فإذا قال الكافر: هذه ابنتي جاز للمسلم أن يتزوجها، وكذا إذا قال: هذا مالي جاز شراؤه وأكله فإذا قال هذا ذكيته جاز أكله، فكل أحد مؤتمن على ما يخبر به مما هو في يده فلا يشترط هنا عدالة ولا عدد.
فائدة: تقسيم الخبر
الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة، فإما أن يكون مستنده السماع فهو الرواية، وإن كان مستنده الفهم من المسموع فهو الفتوى. وإن كان خبرًا جزئيًا يتعلق بمعين مستنده المشاهدة، أو العلم فهو الشهادة وإن كان خبرًا عن حق يتعلق بالمخبر عنه، والمخبر به هو مستمعه أو نائبه فهو الدعوى. وإن كان خبرًا عن تصديق هذا الخبر، فهو الإقرار وإن كان خبرًا عن كذبه، فهو الإنكار وإن كان خبرًا نشأ عن دليل فهو النتيجة، وتسمى قبل أن يحصل عليها الدليل مطلوبًا، وإن كان خبرًا عن شيء يقصد منه نتيجته فهو دليل وجزؤه مقدمة.
فائدة: معاني لفظ شهد
شهد في لسانهم لها معان. أحدها الحضور ومنه قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [1] وفيه قولان: أحدهما من شهد المصر في الشهر. والثاني من شهد الشهر في المصر. وهما متلازمان. والثاني الخبر ومنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح. والثالث الاطلاع على الشيء ومنه: { والله على كل شيء شهيد }، [2] وإذا كان كل خبر شهادة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، وعن أحمد فيها ثلاث روايات. إحداهن اشتراط لفظ الشهادة. والثانية الاكتفاء بمجرد الإخبار اختارها شيخنا. والثالثة الفرق بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة وعلى الأفعال، فالشهادة على الأقوال لا يشترط فيها لفظ الشهادة وعلى الأفعال يشترط، لأنه إذا قال: سمعته يقول فهو بمنزلة الشاهد على رسول الله ﷺ فيما يخبر عنه.
فائدة: حد الخبر
اختلف أبو المعالي وابن الباقلاني في قولهم في حد الخبر إنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب. فقال أبو المعالي: يتعين أن يقال يحتمل الصدق أو الكذب، لأنهما ضدان فلا يقبل إلا أحدهما. وقال القاضي: بل يقال يحتمل الصدق والكذب، وقوله أرجح إذ التنافي إنما هو بين المقبولين لا بين القبولين ولا يلزم من تنافي المقبولات تنافي القبولات، ولهذا يقال: الممكن يقبل الوجود والعدم، وهما متناقضان. والقبولان يجب اجتماعهما له لذاته، لأنه لو وجد أحد القبولين دون الآخر لم يكن ممكنًا، فإنه لو لم يقبل الوجود كان مستحيلًا ولو لم يقبل العدم كان واجبًا فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين. وإن تنافى المقبولان، وكذلك نقول: الجسم يقبل الأضداد فقبولاتها مجتمعة والمقبولات متنافية.
فائدة: الإنشاءات التي صيغها أخبار
اختلف في الإنشاءات التي صيغها أخبار كبعت وأعتقت. فقالت الحنفية: هي أخبار، وقالت الحنابلة والشافعية: هي إنشاءات لا أخبار لوجوه، أحدها: لو كانت خبرًا لكانت كذبًا، لأنه لم يتقدم منه مخبره من البيع والعتق، وليست خبرًا عن مستقبل. وفي هذا الدليل شيء، لأن لهم أن يقولوا: إنها إخبارات عن الحال، فخبرها مقارن للتكلم بها. الثاني: لو كانت خبرًا فإما صدقًا وإما كذبًا. وكلاهما ممتنع. أما الثاني فظاهر. وأما الأول فلأن صدقها متوقف على تقدم أحكامها، فأحكامها: إما أن تتوقف عليها فلزم الدور أو لا يتوقف، وذلك محال لأنه لا توجد أحكامها بدونها، ولقائل أن يقول: هو دور معية لا تقدم، فليس بممتنع، وثالثها: أنها لو كانت أخبارات فأما عن الماضي أو الحال، ويمتنع مع ذلك تعليقها بالشرط، لأنه لا يعمل إلا في مستقبل. وإما عن مستقبل وهي محال لأنه يلزم تجردها عن أحكامها في الحال، كما لو صرح بذلك. وقال ستصيرين طالقًا، ولقائل أن يقول: ما المانع أن يكون خبرًا عن الحال. قولكم يمتنع تعليقها بالشرط. قلنا: إذا علقت بالشرط لم تبق أخبارًا عن الحال، بل أخبارًا عن المستقبل. فالخبر عن الحال الإنشاء المطلق، وأما المعلق فلا. ورابعها: أنه لو قال لمطلقة رجعية: أنت طالق. لزمه طلقة أخرى مع أن خبره صدق، فلما لزمه أخرى دل على أنهما إنشاء ولقائل أن يقول: لما قلنا هي خبر عن الحال، بطل هذا الإلزام. وخامسها أن إمتثال قوله تعالى: { فطلقوهن لعدتهن } [3] أن يقول: أنت طالق. وليس هذا تحريمًا، فإن التحريم والتحليل ليس إلى المكلف، وإنما إليه أسبابهما. وليس المراد بالأمر أخبروا عن طلاقهن، وإنما المراد إنشاء أمر يترتب عليه تحريمهن ولا نعني بالإنشاء إلا ذلك. ولقائل أن يقول: المأمور به هو السبب الذي يترتب عليه الطلاق فهنا ثلاثة أمور، الأمر بالتطليق، وفعل المأمور به وهو التطليق. والطلاق وهو التحريم الناشىء عن السبب. فإذا أتى بالخبر عما في نفسه من التطليق فقد وفى الأمر حقه وطلقت. وسادسها أن الإنشاء هو المتبادر إلى الفهم عرفًا وهو دليل الحقيقة. ولهذا لا يحسن أن يقال فيه صدق أو كذب ولو كان خبرًا لحسن فيه أحدهما: وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة أخر. فأجيب عن الأول بأن الشرع قدر تقدم مدلولات هذه الأخبار قبل التكلم بها بالزمن الفرد ضرورة الصدق، والتقدير أولى من النقل. وعن الثاني: أن الدور غير لازم فإن هنا ثلاثة أمور مترتبة فالنطق باللفظ لا يتوقف على شيء. وبعده تقدير تقدم المدلول على اللفظ وهو غير متوقف عليه في التقدير وأن توقف عليه في الوجود وبعده لزوم الحكم ولا يتوقف اللفظ عليه وأن توقف هو على اللفظ. وعن الثالث أما يلزم أنها إخبارات عن الماضي ولا يتعذر التعليق، فإن الماضي نوعان: ماض تقدم مدلوله عليه قبل النطق به من غير تقدير فهذا يتعذر تعليقه. والثاني ماض بالتقدير لا التحقيق. فهذا يصح تعليقه. وبيانه أنه إذا قال: أنت طالق. إن دخلت الدار فقد أخبر عن طلاق امرأته بدخول الدار. فقدرنا هذا الارتباط قبل تطلقها بالزمن الفرد ضرورة الصدق، وإذا قدر الارتباط قبل النطق صار الخبر عن الارتباط ماضيًا، إذ حقيقة الماضي هو الذي تقدم مخبره خبره، إما تحقيقًا وإما تقديرًا. وعلى هذا فقد اجتمع الماضي والتعليق ولم يتنافيا. وعن الرابع أن المطلقة الرجعية أن أراد بقوله لها. أنت طالق. الخبر عن طلقة ماضية لم يلزمه ثانية، وإن أراد الخبر عن طلقة ثانية فهو كذب لعدم وقوع الخبر، فيحتاج إلى التقدير ضرورة التصديق فيقدر تقدم طلقة قبل طلاقه بالزمن الفرد. يصح معها الكلام فيلزمه. وعن الخامس أن الأمر متعلق بإيجاد خبر يقدر الشارع قبله الطلاق فيلزم به لا أنه متعلق بإنشاء الطلاق حتى يكون اللفظ سببًا كما ذكرتموه، بل هو علامة ودليل على الوقوع، وإنما ينتفي الطلاق عند انتفائه كانتفاء المدلول لانتفاء دليله وعلاماته. ولا يقال: لا يلزم من نفي الدليل نفي المدلول، فإن هذا لازم في الشرعيات لأنها إنما تثبت بأدلتها. فأدلتها أسباب ثبوتها. وأما السادس فهو أقواها وقد قيل إنه لا يمكن الجواب عنه إلا بالمكابرة فإنا نعلم بالضرورة أن من قال لأمرأته: أنت طالق. لا يحسن أن يقال له: صدقت ولا كذبت. فهذه نهاية أقدام الطائفتين في هذا المقام.
وفصل الخطاب في ذلك أن لهذه الصيغ نستبين نسبة إلى متعلقاتها الخارجية فهي من هذه الجهات إنشاءات محضة. كما قالت الحنابلة والشافعية ونسبة إلى قصد المتكلم وإرادته: وهي من هذه الجهة خبر عما قصد إنشاءه كما قالت الحنفية: فهي إخبارات بالنظر إلى معانيها الذهنية إنشاءات بالنظر إلى متلقاتها الخارجية. وعلى هذا فإنما لم يحسن أن يقال بالتصديق والتكذيب وإن كانت أخبارًا، لأن متعلق التصديق والتكذيب النفي والإثبات. ومعناهما مطابقة الخبر لمخبره أو عدم مطابقته وهنا المخبر حصل بالخبر حصول المسبب بسببه فلا يتصور فيه تصديق ولا تكذيب، وإنما يتصور التصديق والتكذيب في خبر لم يحصل مخبره ولم يقع به. كقولك: قام زيد فتأمله.
فإن قيل: فما تقولون في قول المظاهر أنت علي كظهر أمي هل هو إنشاء أو إخبار، فإن قلتم إنشاء كان باطلًا من وجوه. أحدها: إن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب والله سبحانه قد كذبهم هنا في ثلاثة مواضع. أحدها في قوله: { ما هن أمهاتهم } [4] فنفى ما أثبتوه وهذا حقيقة التكذيب. ومن طلق امرأته لا يحسن أن يقال: ما هي مطلقة. الثاني قوله تعالى: { وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا } [5] والإنشاء لا يكون منكرًا، وإنما يكون المنكر هو الخبر، والثالث أنه سماه زورًا والزور هو الكذب. وإذا كذبهم الله دل على أن الظهار إخبار لا إنشاء، الثاني: أن الظهار محرم وليس جهة تحريمه إلا كونه كذبًا والدليل على تحريمه خمسة أشياء. أحدها: ما وصفه بالمنكر. والثاني: وصفه بالزور. والثالث: أنه شرع فيه الكفارة ولو كان مباحًا لم يكن فيه كفارة. والرابع: أن الله قال: { ذلكم توعظون به } [6] والوعظ إنما يكون في غير المباحات. والخامس قوله: { وإن الله لعفو غفور } [7] والعفو والمغفرة إنما يكونان عن الذنب.
وإن قلتم: هو إخبار فهو باطل من وجوه. أحدها: أن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فجعله الله في الإسلام تحريمًا تزيله الكفارة وهذا متفق عليه بين أهل العلم. ولو كان خبرًا لم يوجب التحريم فإنه إن كان صدقًا فظاهر. إن كان كذبًا فأبعد له من أن يترتب عليه التحريم. والثاني: أنه لفظ يوجب حكمه الشرعي بنفسه وهو التحريم، وهذا حقيقه الإنشاء بخلاف الخبر فإنه لا يوجب حكمه بنفسه، فسلب كونه إنشاء مع ثبوت حقيقة الإنشاء فيه جمع بين النقيضين. وثالثها: إن أفادة قوله أنت علي كظهر أمي للتحريم كإفادة قوله: أنت حرة. وأنت طالق. وبعتك ووهبتك وتزوجتك ونحوها لأحكامها. فكيف يقولون هذه إنشاءات دون الظهار وما الفرق؟ قيل: أما الفقهاء فيقولون الظهار إنشاء ونازعهم بعض المتأخرين في ذلك وقال: الصواب أنه إخبار. وأجاب عما احتجوا به من كونه إنشاء.
قال: أما قولهم كان طلاقًا في الجاهلية، فهذا لا يقتضي أنهم كانوا يثبتون به الطلاق، بل يقتضي أنهم كانوا يزيلون العصمة عند النطق به. فجاز أن يكون زوالها لكونه إنشاء كما زعمتم، أو لكونه كذبًا وجرت عادتهم أن من أخبر بهذا الكذب زالت عصمة نكاحه، وهذا كما التزموا تحريم الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد ونحو ذلك. قال: وأما قولكم إنه يوجب التحريم المؤقت وهذا حقيقة الإنشاء لا الإخبار فلا نسلم أن ثم تحريمًا البتة، والذي دل عليه القرآن وجوب تقديم الكفارة على الوطء كتقديم الطهارة على الصلاة، فإذا قال الشارع: لا تصل حتى تتطهر لا يدل ذلك على تحريم الصلاة عليه، بل ذلك نوع ترتيب سلمنا أن الظهار ترتب عليه تحريم، لكن التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له ودلالته عليه. وهذا هو الإنشاء، وقد يكون عقوبة محضة كترتيب حرمان الإرث على القتل، وليس القتل إنشاء للتحريم وكترتيب التعزير على الكذب وإسقاط العدالة به، فهذا ترتيب بالوضع الشرعي لا بد لآلة اللفظ. وحقيقة الإنشاء أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك الحكم ويدل عليه كصيغ العقود. فسببية القول أعم من كونه سببًا بالإنشاء أو بغيره. فكل إنشاء سبب وليس كل سبب إنشاء. فالسببية أعم فلا يستدل بمطلقها على الإنشاء، فإن الأعم لا يستلزم الأخص، فظهر الفرق بين ترتب التحريم على الطلاق وترتبه على الظهار. قال: وأما قولكم إنه كالتكلم بالطلاق والعتاق والبيع ونحوها، فقياس في الأسباب فلا نقبله، ولو سلمناه فنص القرآن يدفعه.
وهذه الاعتراضات عليهم باطلة.
أما قوله: إن كونه طلاقًا في الجاهلية لا يقتضي أنهم كانوا يثبتون به الطلاق إلى آخره. فكلام باطل قطعًا فإنهم لم يكونوا يقصدون الأخبار الكذب ليترتب عليه التحريم، بل كانوا إذا أرادوا الطلاق أتوا بلفظ الظهار إرادة للطلاق ولم يكونوا عند أنفسهم كاذبين ولا مخبرين، وإنما كانوا منشئين للطلاق به. ولهذا كان هذا ثابتًا في أول الإسلام حتى نسخه الله بالكفارة في قصة خولة بنت ثعلبة. كانت تحت عبادة بن الصامت، فقال لها: أنت علي ظهر أمي. فأتت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فقال رسول الله ﷺ: «حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر الطلاق، وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي، فقال: «حرمت عليه» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي، فقال رسول الله ﷺ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه ولم أؤمر في شأنك بشيء»، فجعلت تراجع رسول الله ﷺ. وإذا قال لها: حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك وكان هذا أول ظهار في الإسلام. فنزل الوحي على رسول الله ﷺ فلما قضى الوحي قال: «ادعي زوجك» فتلا عليه رسول الله ﷺ: { قد سمع الله }. [8] الآيات فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحريم الحاصل بالطلاق في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بالكفارة، وبهذا يبطل ما نظر به من تحريم الناقة عند ولادها عشرة أبطن ونحوه، فإنه ليس هنا لفظ إنشاء يقتضي التحريم، بل هو شرع منهم لهذا التحريم عند هذا السبب.
وأما قوله إنا لا نسلم أنه يوجب تحريمًا فكلام باطل فإنه لا نزاع بين الفقهاء أن الظهار يقتضي تحريمًا تزيله الكفارة فلو وطئها قبل التكفير أثم بالإجماع المعروف من الدين والتحريم المؤقت هنا، كالتحريم بالإحرام وبالصيام والحيض. وأما تنظيره بالصلاة مع الطهر ففاسد فإن الله أوجب عليه صلاة بطهر، فإذا لم يأت بالطهر ترك ما أوجب الله عليه فاستحق الإثم، وأما المظاهر فإنه حرم على نفسه امرأته وشبهها بمن تحرم عليه، فمنعه الله من قربانها حتى يكفر. فهنا تحريم مستند إلى طهارة وفي الصلاة لا تجزئ منه بغير طهر، لأنها غير مشروعة أصلًا. وقوله التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له وقد يكون عقوبة إلى آخره جوابه أنهما غير متنافيين في الظهار فإنه حرام، وتحرم به تحريمًا مؤقتًا حتى يكفر. وهذا لا يمنع كون اللفظ إنشاء كجمع الثلاث عند من يوقعها، والطلاق في الحيض فإنه يحرم ويتعقبه التحريم، وقد قلتم: إن طلاق السكران يصح عقوبة له. مع أنه لو لم يأت بإنشاء السبب لم تطلق امرأته اتفاقًا فكون التحريم عقوبة لا ينفي أن يستند إلى أسبابها التي تكون إنشاءات لها. قوله السببية أعم من الإنشاء إلى آخره جوابه أن السبب نوعان: فعل وقول فمتى كان قولًا لم يكن إنشاء. فإن أردتم بالعموم أن سببية القول أعم من كونها إنشاء وإخبارًا فممنوع. وإن أردتم أن مطلق السببية أعم من كونها سببية بالفعل والقول فمسلم. ولا يفيدكم شيئًا.
وفصل الخطاب أن قوله: "أنت علي كظهر أمي" يتضمن إنشاء وإخبارًا، فهو إنشاء من حيث قصد التحريم بهذا اللفظ، وإخبار من حيث تشبيهها بظهر أمه. ولهذا جعله الله منكرًا وزورًا. فهو منكر باعتبار الإنشاء، وزور باعتبار الإخبار.
وأما قوله: إن المنكر هو الخبر الكاذب، فالخبر الكاذب من المنكر. والمنكر أعم منه، فالإنكار في الإنشاء والإخبار فإنه ضد المعروف، فما لم يؤذن فيه من الإنشاء فهو منكر، وما لم يكن صدقًا من الإخبار فهو زور.
فائدة: المجاز والتأويل
المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له. وهنا نكتة ينبغي التفطن لها وهي أن كون اللفظ نصًا يعرف بشيئين. أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعًا، كالعشرة. والثاني ما أطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه لا يقبل تأويلًا ولا مجازًا. وإن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده وصار هذا بمنزلة خبر المتواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده، وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير من التأويلات السمعيات التي أطرد استعمالها في ظاهرها وتأويلها. والحالة هذه غلط، فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذًا مخالفًا لغيره، ومن السمعيات فيحتاج إلى تأويله لتوافقها. فإما إذا أطردت كلها على وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى، فتأويلها ممتنع. فتأمل هذا.
فائدة: إضافة الموصوف للصفة
أضافوا الموصوف إلى الصفة وإن اتحدا، لأن الصفة تضمنت معنى ليس في الموصوف فصحت الإضافة للمغايرة. وهنا نكتة لطيفة وهي أن العرب، إنما تفعل ذلك في الوصف المعرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب للأعلام، كما لو قالوا، زيد بطة أي صاحب هذا اللقب. وأما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه. فلا يضاف الموصوف إليه لعدم الفائدة المخصصة التي لأجلها أضيف الاسم إلى اللقب فإنه لما تخصص به كأنك قلت: صاحب هذا اللقب. وهكذا في مسجد الجامع وصلاة الأولى فإنه لما تخصص الجامع بالمسجد ولزمه كأنك قلت: صاحب هذا الوصف، فلو قلت: زيد الضاحك وعمرو القائم لم يجز. وكذا إن كان لازمًا غير معرفة. تقول: مسجد جامع وصلاة أولى.
فائدة: الاسم والمسمى
اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلًا له حقيقة متميزة متحصلة فاستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه، لأنه شيء موجود في اللسان مسموع بالآذان.
فاللفظ المؤلف من همزة الوصل والسين والميم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلًا. واللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان والأذهان، وهو المسمى والمعنى. واللفظ الدال عليه الذي هو الزاي والياء والدال هو الاسم، وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمى من حيث كان لفظ الهمزة والسين والميم عبارة عنه. فقد بان لك أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى. ولهذا تقول: سميت هذا الشخص بهذا الاسم، كما تقول: حليته بهذه الحلية. والحلية غير المحلى. فكذلك الاسم غير المسمى. وقد صرح بذلك سيبويه، وأخطأ من نسب إليه غير هذا وادعى أن مذهبه اتحادهما. والذي غر من ادعى ذلك قوله الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وهذا لا يعارض نصه قبل هذا. فإنه نص على أن الاسم غير المسمى. فقال الكلم: اسم وفعل وحرف، فقد صرح بأن الاسم كلمة. فكيف تكون الكلمة هي المسمى، والمسمى شخص.
ثم قال بعد هذا: تقول سميت زيد بهذا الاسم، كما تقول علمته بهذه العلامة. وفي كتابه قريب من ألف موضع أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمى. ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان وتصغير وتكسير وإعراب وبناء، فذلك كله من عوارض الاسم لا تعلق لشيء من ذلك بالمسمى أصلًا وما قال نحوي قط ولا عربي أن الاسم هو المسمى، ويقولون: أجل مسمى يقولون أجل اسم، ويقولون: مسمى هذا الاسم كذا. ولا يقول أحد: اسم هذا الاسم كذا ويقولون هذا الرجل مسمى بزيد ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيد ويقولون بسم الله ولا يقولون بمسمى الله. وقال رسول الله ﷺ: «لي خمسة أسماء» ولا يصح أن يقال لي خمس مسميات و «تسموا باسمي»، ولا يصح أن يقال تسموا بمسمياتي ولله تسعة وتسعون اسمًا ولا يصح أن يقال تسعة وتسعون مسمى.
وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمى فبقي ها هنا التسمية وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى. والتسمية عبارة عن فعل المسمى، ووضعه الاسم للمسمى. كما أن التحلية عبارة عن فعل المحلى ووضعه الحلية على المحلى. فهنا ثلاث حقائق اسم ومسمى وتسمية، كحلية ومحلى وتحلية وعلامة ومعلم وتعليم ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنى واحد لتباين حقائقها، وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه الحقائق الثلاثة ولا بد.
فإن قيل: فحلوا لنا شبه من قال باتحادهما ليتم الدليل، فإنكم أقمتم الدليل فعليكم الجواب عن المعارض.
فمنها أن الله وحده هو الخالق وما سواه مخلوق. فلو كانت أسماؤه غيره، لكانت مخلوقة وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا صفة لأن أسماءه صفات وهذا هو السؤال الأعظم الذى قاد متكلمي الإثبات إلى أن يقولوا: الاسم هو المسمى، فما عندكم في دفعه؟
الجواب أن منشأ الغلط في هذا الباب من إطلاق ألفاظ مجملة محتملة لمعنيين: صحيح وباطل. فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل تلك المعاني وتنزيل ألفاظها عليها، ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفًا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها فلم يزل بأسمائه وصفاته وهو إله واحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأسماؤه وصفاته داخلة في مسمى اسمه، وإن كان لا يطلق على الصفة إنها إله يخلق ويرزق، فليست وصفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله.
وبلاء القوم من لفظة الغير فإنها يراد بها معنيين: أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقًا. ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها، فإذا قيل علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام. كان المعنى صحيحًا، ولكن الإطلاق باطل، وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلًا لفظًا ومعنى.
وبهذا أجاب أهل السنة المعتزلة القائلين بخلق القرآن وقالوا: كلامه تعالى داخل في مسمى اسمه. فالله تعالى اسم الذات الموصوفة بصفات الكمال، ومن تلك الصفات صفة الكلام، كما أن علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة. وإذا كان القرآن كلامه وهو صفة من صفاته فهو متضمن لأسمائه الحسنى، فإذا كان القرآن غير مخلوق ولا يقال: إنه غير الله، فكيف يقال إن بعض ما تضمنه وهو أسماؤه مخلوقة وهي غيره، فقد حصحص الحق بحمد الله وانحسم الاشكال. وإن أسماءه الحسنى التي في القرآن من كلامه وكلامه غير مخلوق ولا يقال: هو غيره ولا هو هو وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة الذين يقولون: أسماؤه تعالى غيره وهي مخلوقة ولمذهب من رد عليهم ممن يقول: اسمه نفس ذاته لا غيره، وبالتفصيل تزول الشهبه ويتبين الصواب والحمد لله.
حجة ثانية لهم، قالوا: قال تبارك وتعالى تبارك اسم ربك. وإذكر اسم ربك. سبح اسم ربك.
وهذه الحجة عليهم في الحقيقة، لأن النبي ﷺ امتثل هذا الأمر وقال: «سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم»، ولو كان الأمر كما زعموا لقال سبحان اسم ربي العظيم، ثم أن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول: عبدت اسم ربي ولا سجدت لاسم ربي ولا ركعت لاسم ربي ولا باسم ربي ارحمني. وهذا يدل على أن الأشياء متعلقة بالمسمى لا بالاسم. وأما الجواب عن تعلق الذكر والتسبيح المأمور به بالاسم فقد قيل فيه: إن التعظيم والتنزيه إذا وجب للمعظم فقد نعظم ما هو من سببه ومتعلق به كما يقال سلام على الحضرة العالية والباب السامي والمجلس الكريم ونحوه. وهذا جواب غير مرضي لوجهين:
أحدهما: أن رسول الله ﷺ لم يفهم هذا المعنى وإنما قال: «سبحان ربي»، فلم يعرج على ما ذكرتموه.
الثاني: أنه يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل وسائر ما يطلق على المسمى، فيقال: الحمد لاسم الله ولا إله إلا اسم الله ونحوه؛ وهذا مما لم يقله أحد.
بل الجواب الصحيح أن الذكر الحقيقي محله القلب لأنه ضد النسيان، والتسبيح نوع من الذكر فلو أطلق الذكر والتسبيح لما فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسان. والله تعالى أراد من عباده الأمرين جميعًا ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما واجتماعهما فصار معنى الآيتين: سبح ربك بقليل ولسانك واذكر ربك بقلبك ولسانك. فاقحم الاسم تنبيهًا على هذا المعنى حتى لا يخلو الذكر، والتسبيح من اللفظ باللسان لأن ذكر القلب متعلقه المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواه، والذكر باللسان متعلقه اللفظ مع مدلوله، لأن اللفظ لا يراد لنفسه فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو المسبح دون ما يدل عليه من المعنى.
وعبر لي شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة لطيفة وجيزة فقال: المعنى سبح ناطقًا باسم ربك متكلمًا به وكذا: سبح اسم ربك المعنى سبح ربك ذاكرًا اسمه. وهذه الفائدة تساوي رحلة، لكن لمن يعرف قدرها. فالحمد الله المنان بفضله ونسأله تمام نعمته.
حجة ثالثة لهم قالوا: قال تعالى: { ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها } [9] وإنما عبدوا مسمياتها.
والجواب أنه كما قلتم: إنما عبدوا المسميات، ولكن من أجل أنهم نحلوها أسماء باطلة كاللات والعزى وهي مجرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لها في الحقيقة فإنهم سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلهية لها، وليس لها من الإلهية إلا مجرد الأسماء لا حقيقة المسمى فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتها. وهذا كمن سمى قشور البصل لحمًا وأكلها فيقال: ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه، وكمن سمى التراب خبزًا وأكله يقال: ما أكلت من إلا اسم الخبر. بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم فإنه لا حقيقة لإلهيتها بوجه، وما الحكمة ثم إلا مجرد الاسم. فتأمل هذه الفائدة الشريفة في كلامه تعالى.
فإن قيل: فما الفائدة في دخول الباء في قوله: { فسبح باسم ربك العظيم } [10] ولم تدخل في قوله: { سبح اسم ربك الأعلى }؟ [11]
قيل: التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى آخر، ويراد به ذلك مع الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل، ولهذا تسمى الصلاة تسبيحًا. فإذا أريد التسبيح المجرد فلا معنى للباء، لأنه لا يتعدى بحرف جر، لا تقول: سبحت بالله، وإذا أردت المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيهًا على ذلك المراد كأنك قلت: سبح مفتتحًا باسم ربك أو ناطقًا باسم ربك، كما تقول صل مفتتحًا أو ناطقًا باسمه. ولهذا السر والله أعلم دخلت اللام في قوله تعالى: { سبح لله ما في السماوات والأرض } [12] والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة ولم يقل في موضع سبح الله ما في السموات والأرض كما قال: { ولله يسجد من في السموات والأرض }، [13] وتأمل قوله تعالى: { إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون }، [14] فكيف قال: ويسبحونه لما ذكر السجود باسمه الخاص فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه.
شبهة رابعة: قالوا قد قال الشاعر:
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ** ومن يبك حولًا فقد اعتذر
وكذلك قول الأعشى: * داع يناديه باسم الماء مبغوم *
وهذه حجة عليهم لا لهم. أما قوله: ثم اسم السلام عليكما، فالسلام هو الله تعالى والسلام أيضا التحية، فإن أراد الأول فلا إشكال، فكأنه قال: ثم اسم السلام عليكما أي بركة اسمه وإن أراد التحية فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول وباسمه لفظه الدال عليه، والمعنى ثم اسم هذا المسمى عليكما، فيراد بالأول اللفظ، وبالثاني المعنى كما تقول زيد بطة ونحوه مما يراد بأحدهما اللفظ وبالآخر المدلول فيه. وفيه نكتة حسنة كأنه أراد ثم هذا اللفظ باق عليكما جار لا ينقطع مني بل أنا مراعيه دائمًا.
وقد أجاب السهيلي عن البيت بجواب آخر وهذا حكاية لفظه فقال: لبيد لم يرد إيقاع التسليم عليهم لحينه، وإنما أراد بعد الحول ولو قال: السلام عليكما كان مسلمًا لوقته الذي نطق فيه بالبيت، فكذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ أي إنما اللفظ بالتسليم بعد الحول وذلك أن السلام دعاء، فلا يتقيد بالزمان المستقبل، وإنما هو لحينه ألا نرى أنه لا يقال بعد الجمعة اللهم ارحم زيدًا ولا بعد الموت اللهم اغفر لي. إنما يقال: اللهم اغفر لي بعد الموت فيكون بعد ظرفًا للمغفرة والدعاء واقع لحينه، فإن أردت أن تجعل الوقت ظرفًا للدعاء صرحت بلفظ الفعل. فقلت بعد الجمعة: ادعو بكذا أو أسلم أو ألفظ بكذا، لأن الظروف إنما يريد بها الأحداث الواقعة فيها خبرًا أوامرًا أو نهيًا، وأما غيرها من المعاني كالطلاق واليمين والدعاء والتمني والاستفهام وغيرها من المعاني، فإنما هي واقعة لحين النطق بها، وكذلك يقع الطلاق ممن قال بعد يوم الجمعة: أنت طالق وهو مطلق لحينه. ولو قال بعد الحول: والله لأخرجن انعقدت اليمين في الحال ولا ينفعه أن يقول أردت أن لا أوقع اليمين إلا بعد الحول فإنه لو أراد ذلك لقال بعد الحول أحلف أو بعد الجمعة أطلقك. فأما الأمر والنهي والخبر فإنما تقيدت بالظروف، لأن الظروف في الحقيقة إنما يقع فيها الفعل المأمور به والمخبر به دون الأمر والخبر فإنهما واقعان لحين النطق بهما، فإذا قلت: اضرب زيدًا يوم الجمعة، فالضرب هو المقيد بيوم الجمعة، وأما الأمر فأنت في الحال آمر به، وكذلك إذا قلت: سافر زيد يوم الجمعة فالمتقيد باليوم المخبر به لا الخبر، كما أن قوله اضربه يوم الجمعة المقيد بالظرف المأمور به لا أمرك أنت فلا تعلق للظروف إلا بالأحداث، فقد رجع الباب كله بابًا واحدًا فلو أن لبيدًا قال: إلى الحول ثم السلام عليكما، لكان مسلمًا لحينه، ولكنه أراد أن لا يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول، وكذلك ذكر الاسم الذي هو بمعنى اللفظ بالتسليم ليكون ما بعد الحول ظرفًا له.
وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه رحمه الله.
وأما قوله باسم الماء، والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة، ولهذا عرفه تعريف الحقيقة الذهينة والبيت لذي الرمة وصدره: * لا ينعش الطرف إلا ما تحونه * ثم قال داع يناديه باسم الماء، فظن الغالط إنه أراد حكاية صوت الظبية وإنها دعت ولدها بهذا الصوت وهو ماما، وليس هذا مراده، وإنما الشاعر ألغز لما وقع الاشتراك بين لفظ الماء المشروب وصوتها به، فصار صوتها كأنه هو اللفظ المعبر عن الماء المشروب فكأنها تصوت باسم هذا الماء المشروب، وهذا لأن صوتها ماما وهذا في غاية الوضوح.
فائدة: اسم الله والاشتقاق
زعم السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى وإنه مستمد من أصل آخر فهو باطل. ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى، كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير، فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم عن هذه الأسماء؟ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه الله.
ثم الجواب عن الجميع أننا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلًا وفرعًا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. وقول سيبويه إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء هو بهذا الاعتبار لا أن العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال، فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهما. فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مادي، وإنما هو اشتقاق تلازم سمى المتضمن بالكسر مشتقًا، والمتضمن بالفتح مشتقًا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى.
فائدة: هل الرحمن في البسملة نعت
استبعد قوم أن يكون الرحمن نعتًا لله، من قولنا: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الرحمن علم، والأعلام لا ينعت بها. ثم قالوا: هو بدل من اسم الله قالوا: ويدل على هذا أن الرحمن علم مختص بالله لا يشاركه فيه غيره، فليس هي كالصفات التي هي العليم والقدير والسميع والبصير، ولهذا تجري على غيره تعالى. قالوا: ويدل عليه أيضا وروده في القرآن غير تابع لما قبله كقوله: { الرحمن على العرش استوى }، [15] { الرحمن * علم القرآن }، [16] { أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن }، [17] وهذا شأن الأسماء المحضة، لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. قال السهيلي: والبدل عندي فيه ممتنع، وكذلك عطف البيان لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين، فإنه أعرف المعارف كلها وأبينها. ولهذا قالوا: وما الرحمن ولم يقولوا: وما الله ولكنه، وإن جرى مجرى الإعلام فهو وصف يراد به الثناء، وكذلك الرحيم إلا أن الرحمن من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه، وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية. فإن التثنية في الحقيقة تضعيف. وكذلك هذه الصفة فكأن غضبان وسكران كامل لضعفين من الغضب والسكر فكان اللفظ مضارعًا للفظ التثنية لأن التثنية ضعفان في الحقيقة، ألا ترى أنهم أيضا قد شبهوا التثنية بهذا البناء إذا كانت لشيئين متلازمين. فقالوا: الحكمان والعلمان وأعربوا النون كأنه اسم لشيء واحد. فقالوا: اشترك باب فعلان وباب التثنية. ومنه قول فاطمة: يا حسنان يا حسينان برفع النون لابنيها ولمضارعة التثنية امتنع جمعه فلا يقال غضابين، وامنع تأنيثه فلا يقال غضبانة، وامتنع تنوينه كما لا ينون نون المثنى فجرت عليه كثير من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظًا ومعنى. وفائدة الجمع بين الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة. تم كلامه.
قلت: أسماء الرب تعالى هي أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه لا تنافي اسميته وصفيته فمن حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود الاسم العلم. ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعالى حسن مجيئه مفردًا غير تابع كمجيء اسم الله كذلك، وهذا لا ينافي دلالته على صفة الرحمن كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية ولم يجيء قط تابعًا لغيره، بل متبوعًا. وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوها، ولهذا لا تجيء هذه مفردة بل تابعة.
فتأمل هذه النكتة البديعة يظهر لك بها أن الرحمن اسم وصفة لا ينافي أحدهما الآخر. وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا.
وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين اللذين ذكرهما، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف، والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: { وكان بالمؤمنين رحيمًا }، [18] { إنه بهم رؤوف رحيم }. [19] ولم يجىء قط رحمن بهم فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجل لك صورتها.
فائدة: حذف العامل في بسم الله
لحذف العامل في بسم الله فوائد عديدة.
منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر الله، فلو ذكرت الفعل وهو لا يستغني عن فاعله كان ذلك مناقضًا للمقصود. فكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى ليكون المبدؤ به اسم الله كما نقول في الصلاة: الله أكبر، ومعناه من كل شيء، ولكن لا نقول هذا المقدر ليكون اللفظ مطابقًا لمقصود الجنان وهو أن لا يكون في القلب إلا الله وحده، فكما تجرد ذكره في قلب المصلي تجرد ذكره في لسانه.
ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالتسمية في كل عمل وقول وحركة، وليس فعل أولى بها من فعل، فكان الحذف أعم من الذكر فإن أي فعل ذكرته كان المحذوف أعم منه.
ومنها أن الحذف أبلغ، لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل فكأنه لا حاجة إلى النطق به لأن المشاهدة والحال دالة على أن هذا وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى. والحوالة على شاهد الحال أبلغ من الحوالة على شاهد النطق كما قيل:
ومن عجب قول العواذل من به ** وهل غير من أهوى يحب ويعشق
فائدة: عطف الصلاة على البسملة
اسثشكل طائفة قول المصنفين: "بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله"، وقالوا: الفعل بعد الواو دعاء بالصلاة والتسمية قبله خبر، والدعاء لا يحسن عطفه على الخبر. لو قلت: مررت بزيد وغفر الله لك لكان غثًا من الكلام والتسمية في معنى الخبر، لأن المعنى افعل كذا باسم الله.
وحجة من أثبتها الاقتداء بالسلف. والجواب عما قاله هوان الواو لم تعطف دعاء على خبر، وإنما عطفت الجملة على كلام محكي، كأنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد أو أقول هذا وهذا، أو اكتب هذا وهذا.
فائدة: بطلان أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة
قولهم: الصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الله تعالى غاير ينهما في قوله: { عليهم صلوات من ربهم ورحمة }. [20]
الثاني: أن سؤال الرحمة تشرع لكل مسلم والصلاة تختص بالنبي ﷺ وهي حق له ولآله. ولهذا منع كثير من العلماء من الصلاة على معين غيره، ولم يمنع أحد من الترحم على معين.
الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء وصلاته خاصة بخواص عباده.
وقولهم الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل من وجوه:
أحدها: أن الدعاء يكون بالخير والشر والصلاة لا تكون إلا في الخير.
الثاني: أن "دعوت" تعدّى باللام وصليت لا تُعدّى إلا بعلى، ودعاء المعدى بعلى ليس بمعنى صلى، وهذا يدل على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء.
الثالث: أن فعل الدعاء يقتضي مدعوًا أو مدعوًا له، تقول: دعوت الله لك بخير، وفعل الصلاة لا تقتضي ذلك، لا نقول: صليت الله عليك، ولا لك. فدل على أنه ليس بمعناه، فأي تباين أظهر من هذا، ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق فإياك والإخلاد إلى أرضه.
ورأيت لأبي القاسم السهيلي كلامًا حسنًا في اشتقاق الصلاة وهذا لفظه قال: معنى الصلاة اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف، إلا أن الحنو والعطف يكون محسوسًا ومعقولًا فيضاف إلى الله منه ما يليق بجلاله وينفي عنه ما يتقدس عنه، كما أن العلو محسوس ومعقول. فالمحسوس منه صفات الأجسام. والمعقول منه صفة ذي الجلال والإكرام. وهذا المعنى كثير موجود في الصفات، والكثير يكون صفة للمحسوسات، وصفة للمعقولات وهو من أسماء الرب تعالى، وقد تقدس عن مشابهة الأجسام ومضاهاة الأنام. فالمضاف إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة، ثم إذا ثبت هذا فالصلاة كما تسمى عطفًا وحنوًا. تقول: اللهم اعطف علينا أي ارحمنا، قال الشاعر:
وما زلت في ليني له وتعطفي ** عليه كما تحنو على الولد الأم
ورحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانثنى عليه. ورحمة الله للعباد جود وفضل، فإذا صلى عليه فقد أفضل عليه وأنعم. وهذه الأفعال إذا كانت من الله أو من العبد فهي متعدية بعلى مخصوصة بالخير لا تخرج عنه إلى غيره، فقد رجعت كلها إلى معنى واحد إلا أنها في معنى الدعاء. والرحمة صلاة معقولة أي انحناء معقول غير محسوس ثمرته من العبد الدعاء لأنه لا يقدر على أكثر منه، وثمرته من الله الإحسان والإنعام فلم تختلف الصلاة في معناها، إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها. والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس فلم يختلف المعنى فيها إلا من جهة المعقول والمحسوس وليس ذلك باختلاف في الحقيقة، ولذلك تعدت كلها بعلى واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاة ولم يجز صليت على العدو أي دعوت عليه فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة وإن كان راجعًا إليه، إذ ليس كل راحم ينحني على المرحوم ولا ينعطف عليه.
فائدة: اشتقاق الفعل من المصدر
رأيت للسهيلي فصلًا حسنًا في اشتقاق الفعل من المصدر هذا لفظه. قال: فائدة اشتقاق الفعل من المصدر. إن المصدر اسم كسائر الأسماء يخبر عنه، كما يخبر عنها. كقولك: أعجبني خروج زيد، فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو الفاعل له مجرورًا بالإضافة، والمضاف إليه تابع للمضاف، فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدر لم يكن الإخبار عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره، وحق المخبر عنه أن يكون مرفوعًا مبدوءًا به فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفًا يدل على أنه مخبر عنه، كما تدل الحروف على معاني في الأسماء. وهذا لو فعلوه لكان الحرف حاجزًا بينه وبين الحدث في اللفظ. والحدث يستحيل انفصاله عن فاعله كما يستحيل انفصال الحركة عن محلها. فوجب أن يكون اللفظ غير منفصل، لأنه تابع للمعنى فلم يبق إلا أن يشتق من لفظ الحدث لفظ يكون كالحرف في النيابة عنه دالًا على معنى في غيره، ويكون متصلًا اتصال المضاف بالمضاف إليه وهو الفعل المشتق من لفظ الحدث، فإنه يدل على الحدث بالتضمن ويدل على الاسم مخبرًا عنه لا مضافًا إليه، إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى الاسم كاستحالة إضافة الحرف، لأن المضاف هو الشيء بعينه. والفعل ليس هو الشيء بعينه ولا يدل على معنى في نفسه، وإنما يدل على معنى في الفاعل وهو كونه مخبرًا عنه فإن قلت: كيف لا يدل على معنى في نفسه وهو يدل على الحدث. قلنا: إنما يدل على الحدث بالتضمن. والدال عليه بالمطابقة هو الضرب والقتل لا ضرب وقتل، ومن ثم وجب أن لا يضاف ولا يعرف بشيء من آلات التعريف، إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه لا بلفظ يدل على معنى في غيره، ومن ثم وجب أن لا يثنى ولا يجمع كالحرف، ومن ثم وجب أن يبنى كالحرف، ومن ثم وجب أن يكون عاملًا في الاسم كالحرف كما أن الحرف لما دل على معنى في غيره وجب أن يكون له أثر في لفظ ذلك الغير. كما له أثر في معناه، وإنما أعرب المستقبل ذو الزوائد لأنه تضمن معنى الاسم إذ الهمزة تدل على المتكلم والتاء على المخاطب والياء على الغالب. فلما تضمن بها معنى الاسم ضارعه فاعرب. كما أن الاسم إذا تضمن معنى الحرف بني. وأما الماضي والأمر فإنهما وإن تضمنا معنى الحدث وهو اسم فما شار كافيه الحرف من الدلالة على معنى في غيره وهي حقيقة الحرف أوجب بناءهما حتى إذا ضارع الفعل الاسم من وجه آخر غير التضمن للحدث خرج عن مضارعة الحرف وكان أقرب شبهًا بالأسماء كما تقدم. ولما قدمناه من دلالة الفعل على معنى في الاسم وهو كون الاسم مخبرًا عنه وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم مضمرًا أو مظهرًا بخلاف الحدث، فإنك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرًا ولا مظهرًا نحو قوله تعالى: { أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيما ذا مقربة }، [21] وقوله: { وأقام الصلاة }، [22] والفعل لا بد من ذكر الفاعل بعده كما لا بد بعد الحرف من الاسم. فإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدر وهو كونه دالًا على معنى في الاسم، فلا يحتاج من الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة واحدة. وتلك الصيغة هي لفظ الماضى لأنه أخف وأشبه بلفظ الحدث إلا أن تقوم الدلالة على اختلاف أحوال المحدث فتختلف صيغة الفعل. ألا ترى كيف تختلف صيغته بعد ما الظرفية من قولهم: لا أفعله ما لاح برق وما طار طائر لأنهم يريدون الحدث مخبرًا. عنه على الإطلاق من غير تعرض لزمن ولا حال من أحوال الحدث، فاقتصروا على صيغة واحدة وهي أخف أبنية الفعل. وكذلك فعلوا بعد التسوية نحو قوله: { سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم }، [23] وقوله: { أدعوتموهم أم أنتم صامتون }، [24] لأنه أراد التسوية بين الدعاء والصمت على الإطلاق من غير تقييد بوقت ولا حال، فلذلك لم يحتج إلا إلى صيغة واحدة وهي صيغة الماضي كما سبق.
فالحدث إذًا على ثلاثة أضرب. ضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله وإلى اختلاف أحوال الحدث، فيشتق منه الفعل دلالة على كون الفاعل مخبرًا عنه، وتختلف أبنية دلالته على اختلاف أحوال الحدث. وضرب يحتاج إلى الإخبار عن فاعله على الإطلاق من غير تقييد بوقت ولا حال فيشتق منه الفعل ولا تختلف أبنية نحو ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية وبعد ما الظرفية. وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله بل يحتاج إلى ذكره خاصة على الإطلاق مضافًا إلى ما بعده نحو سبحان الله. وسبحان اسم ينبىء عن العظمة والتنزيه فوقع القصد إلى ذكره مجردًا من التقييدات بالزمان أو بالأحوال ولذلك وجب نصبه. كما يجب نصب كل مقصود إليه بالذكر نحو إياك وويله وويحه وهما مصدران لم يشتق منهما فعل حيث لم يحتج إلى الإخبار عن فاعلهما ولا احتيج إلى تخصيصهما بزمن، فحكمها حكم سبحان ونصبهما كنصبه، لأنه مقصود إليه ومما انتصب لأنه مقصود إليه بالذكر زيدًا ضربته في قول شيخنا أبي الحسن وغيره من النحويين، وكذلك زيدًا ضربت بلا ضمير لا نجعله مفعولًا مقدمًا لأن المعمول لا يتقدم على عامله وهو مذهب قوي، ولكن لا يبعد عندي قول النحويين أنه مفعول مقدم وإن كان المعمول لا يتقدم على العامل والفعل كالحرف، لأنه عامل في الاسم ودال على معنى فيه فلا ينبغي للاسم أن يتقدم على الفعل كما لا يتقدم على الحرف، ولكن الفعل في قولك زيدًا ضربت قد أخذ معموله وهو الفاعل فمعتمده عليه ومن أجله صيغ. وأما المفعول فلم يبالوا به إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل، ألا ترى أنه يحذف والفاعل لا يحذف فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد من حذفه. وأما زيدًا ضربته فينتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ.
و هذا الفصل من أعجب كلامه. ولم أعرف أحدًا من النحويين سبقه إليه.
فائدة: المصدر عند الكوفيين
قولهم للضرب ونحوه مصدر؛ إن أريد بحروف مصدر مصدر صدر يصدر مصدرًا فهو يقوي قول الكوفيين إن المصدر صادر عن الفعل مشتق منه والفعل أصله، وأصله على هذا صادر، ولكن توسعوا فيه كصوم وزوز وعلل في صائم وبابه.
قال السهيلي: هو على جهة المكان استعارة كأنه الموضع الذي صدرت عنه الأفعال والأصل الذي نشأت منه.
قلت: وكأنه يعني مصدورًا عنه لا صادر عن غيره.
قال: ولا بد من المجاز على القولين: فالكوفي يحتاج أن يقول الأصل صادر، فإذا قيل: مصدر قدر فيه حذف أي ذو مصدر، كما يقدر في صوم وبابه. ونحن نسميه مصدر استعارة من المصدر الذي هو المكان.
فائدة: عمل الحروف
أصل الحروف أن تكون عاملة، لأنها ليس لها معان في أنفسها، وإنما معانيها في غيرها، وأما الذي معناه في غيره وهو الاسم، فأصله أن لا يعمل في غيره، وإنما وجب أن يعمل الحرف في كل ما دل على معنى فيه، لأن اقتضاءه معنى فتقتضيه عملًا لأن الألفاظ تابعة للمعاني، فكما تشبث الحرف عما دخل عليه معنى وجب أن يتشبث به لفظًا، وذلك هو العمل.
فأصل الحرف أن يكون عاملًا فنسأل عن غير العامل، فنذكر الحروف التي لم تعمل وسبب سلبها العمل.
فمنها هل، فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض وسبق إليها عمل الابتداء أو الفاعلية فدخلت لمعنى في الجملة، لا لمعنى في اسم مفرد، فاكتفي بالعمل السابق قبل هذا الحرف وهو الابتداء ونحوه.
وكذلك الهمزة نحو أعمرو خارج فإن الحرف دخل لمعنى في الجملة ولا يمكن الوقوف عليه ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه، لأنه حرف مفرد لا يوقف عليه ولو توهم ذلك فيه لعمل في الجمله ليؤكدوا بظهور أثره فيها تعلقه بها ودخوله عليها واقتضاؤه لها، كما فعلوا في إن وأخواتها حيث كانت كلمات من ثلاثة أحرف فصاعدًا يجوز الوقف عليها كأنه وليته ولعله فأعملوها في الجملة إظهارًا لارتباطها وشدة تعلقها بالحديث الواقع بعدها، وربما أرادوا توكيد تعلق الحرف بالجملة إذ كان مؤلفًا من حرفين. نحو هل فربما توهم الوقف عليه أو خيف ذهول السامع عنه، فأدخل في الجملة حرف زائد ينبه السامع عليه وقام ذلك الحرف مقام العمل نحو هل زيد بذاهب وما زيد بقائم. فإذا سمع المخاطب الباء وهي لا تدخل في الثبوت تأكد عنده ذكر النفي والاستفهام وأن الجملة غير منفصلة عنده، ولذلك أعمل أهل الحجاز ما النافية لشبهها بالجملة. ومن العرب من اكتفى في ذلك التعلق وتأكيده بإدخال الباء في الخبر ورآها ثابتة في التأثير عن العمل الذي هو النصب. وإنما اختلفوا في ما ولم يختلفوا في هل لمشاركة ما لليس في النفي. فحين أرادوا أن يكون لها أثر في الجملة يؤكد تشبهها بها جعلوا ذلك الأثر كأثر ليس وهو النصب والعمل في باب ليس أقوى، لأنها كلمة كليت ولعل وكأن. والوهم إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى توهم انفصال الجملة عن ما وهل فلم يكن بد من إعمال ليس وإبطال معنى الابتداء السابق، ولذلك إذا قلت: ما زيد إلا قائم لم يعملها أحد منهم، لأنه لا يتوهم انقطاع زيد عن ما، لأن إلا لا تكون إيجابًا إلا بعد نفي فلم يتوهم انفصال الجملة عن ما. ولذلك لم يعملوها عند تقديم الخبر نحو ما قائم زيد إذ ليس من رتبة النكرة أن يكون مبدوءًا بها مخبرًا عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلها، فلم يتوهم المخاطب انقطاع الجملة عما قبلها، لهذا السبب فلم يحتج إلى إعمالها وإظهارها كما كان قبل دخولها مستغنيًا عن تأثيرها فيه.
وأما حرف لا فإن كان عاطفًا فحكمه حكم حروف العطف ولاشيء فها عامل. وإن لم تكن عاطفة نحو لا زيد قائم ولا عمرو، فلا حاجة إلى إعمالها في الجملة، لأنه لا يتوهم انفصال الجملة بقوله: ولا عمرو، لأن الواو مع لا الثانية تشعر بالأولى لا محالة وتربط الكلام بها فلم يحتج إلى إعمالها وبقيت الجملة عاملًا فيها الابتداء كما كانت قبل دخول لا. فإن قلت: فلو لم يعطف وقلت: لا زيد قائم، قلت: هذا لا يجوز لأن لا ينفي بها في أكثر الكلام ما قبلها تقول هل قام زيد؟ فيقال: لا، وقال سبحانه: { لا أقسم بيوم القيامة } [25] وليست نفيًا لما بعدها هنا بخلاف ما لو قيل: ما أقسم فإن ما لا تكون أبدًا إلا نفيًا لما بعدها، فلذلك قالوا: ما زيد قائم، ولم يخشوا توهم انقطاع الجملة عنها. ولو قالوا: لا زيد قائم لخيف أن يتوهم أن الجملة موجبة وأن لا كهي في النكرات نحو: { لا لغو فيها ولا تأثيم }، [26] إلا أنهم في النكرات قد أدخلوها على المبتدأ والخبر تشبيهًا لها بليس، لأن النكرة أبعد في الابتداء من المعرفة، والمعرفة أشد استبدادًا بأول الكلام.
وأما التي للتنزيه فللنحويين فيها اختلاف أهي عاملة أم لا. فإن كانت عاملة فكما اعملوا أن حرصًا على اظهار تشبثها بالحديث. وإن كانت غير عاملة كما ذهب إليه سيبويه والاسم بعدها مركب معها مبني على الفتح فليس الكلام فيه.
وأما حرف النداء فعامل في المنادى عند بعضهم قال: والذي يظهر لي الآن أن النداء تصويت بالمنادى نحوها. وأن المنادى منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره، كما تقدم من قولنا في كل مقصود إلى ذكره مجردًا عن الإخبار عنه أنه منصوب، ويدلك على أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمل في الاسم دونه نحو صاحب زيد أقبل ويوسف أعرض عن هذا، وإن كان مبنيًا عندهم فإنه بناء كالعمل. ألا تراه ينعت على اللفظ كما ينعت المعرب ولو كان حرف النداء عاملًا لما جاز حذفه وإبقاء عمله.
فإن قلت: فلم عملت النواصب والجوازم في المضارع والفعل بعدها جملة قد عمل بعضه في بعض. ثم إن المضارع قبل دخول العامل عليه كان مرفوعًا، ورفعه بعامل وهو وقوعه موقع الاسم. فهلا منع هذا العامل هذه الحروف من العمل كما منع الابتداء الحروفَ الداخلة على الجملة من العمل، إلا أن يُخشى انقطاع الجملة كما خيف في إن وأخواتها.
فالجواب من وجهين:
أحدهما أن العامل في المبتدإ وإن كان معنويا كما أن الرافع للفعل المضارع معنوي، ولكنه أقوى منه، لأن حق كل مخبر عنه أن يكون مرفوعًا لفظًا وحسًا، كما أنه مرفوع معنى وعقلًا، ولذلك استحق الفاعل الرفع دون المفعول لأنه المحدث عنه بالفعل فهو أرفع رتبة في المعنى فوجب أن يكون اللفظ، كذلك لأنه تابع للمعنى. وأما رفع الفعل المضارع فلوقوعه موقع الاسم المخبر عنه والاسم التابع له، فلم يقو قوته في استحقاق الرفع. فلم يمنع شيئًا من الحروف اللفظية عن العمل، إذ اللفظي أقوى من المعنوي وامتنع ذلك في بعض الأسماء المبتدأة لضعف الحروف وقلة العامل السابق للمبتدإ.
الجواب الثاني أن هذه الحروف لم تدخل لمعنى في الجملة إنما دخلت لمعنى في الفعل المتضمن للحدث من نفي أو إنكار أو نهي أو جزاء أو غيره، وذلك كله يتعلق بالفعل خاصة لا بالجملة فوجب عملها فيها كما وجب عمل حروف الجر في الأسماء من حيث دلت على معنى فيها ولم تكن داخلة على جملة، وقد سبق إليها عامل معنوي ولا لفظي.
ومما ينبغي أن يعلم أن النواصب والجوازم لا تدخل على الفعل الواقع موقع الاسم لحصوله في موضع الأسماء، فلا سبيل لنواصب الأفعال وجوازمها أن تدخل على الأسماء ولا ما هو واقع موقعها فهي إذا دخلت على الفعل خلصته للاستقبال ونفت عنه معنى الحال. وهذا معنى يختص بالفعل لا بالجملة.
وأما إلا في الاستثناء فقد زعم بعضهم أنها عاملة ونقض ذلك بقولهم: ما قام أحد إلا زيد وما جاءني إلا عمرو. والصحيح أنها موصلة الفعل إلى العمل في الاسم بعدها كتوصيل واو المفعول معه الفعل إلى العمل فيما بعدها، وليس هذا يكسر الأصل الذي قدمناه، وهو استحقاق جميع الحروف العمل فيما دخلت عليه من الأسماء المفردة والأفعال، لأنها إذا كانت موصلة للفعل. والفعل عامل فكأنها هي العاملة، فإذا قلت: ما قام إلا زيد، فقد اعملت الفعل على معنى الإيجاب. كما لو قلت قام زيد لا عمرو. وقامت لا مقام نفي الفعل عن عمرو، فلذلك قامت إلا مقام إيجاب الفعل لزيد. إذا قلت: ما جاءني إلا زيد، فكأنها هي العاملة فاستغنوا عن أعمالها عملًا آخر.
وكذلك حروف العطف وإن لم تكن عوامل، فإنما جاءت الواو الجامعة منها لتجمع بين الاسمين في الإخبار عنهما بالفعل فقد أوصلت الفعل إلى العمل في الثاني وسائر حروف العطف يتقدر بعدها العامل، فيكون في حكم الحروف الداخلة على الجمل. وإذا قلت: قام زيد وعمرو. فكأنك قلت: قام زيد وقام عمرو فصارت هذه الحروف كالداخلة على الجمل. فقد تقدم في الحروف الداخلة على الجمل أنها لا تستحق من العمل فيها ما تستحق الحروف الداخلة على الأسماء المفردة والأفعال.
ونقيس على ما تقدم لام التوكيد وتركهم أعمالها في الجملة مع أنها لا تدخل لمعنى في الجملة فقط، بل لتربط ما قبلها من القسم بما بعدها. وهذا هو الأصل فيها حتى أنهم ليذكرونها دون القسم فيشعر عند المخاطب بالنهي كقوله:
إني لأمنحك الصدود وإنني ** قسمًا إليك مع الصدود لأميل
لأنه حين قال: لأمنحك علم أنه قد أقسم، فلذلك قال: قسمًا وهذا الأصل محيط بجميع أصول أعمال الحروف وغيرها من العوامل وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في الأسماء، ومنبهة على سر امتناع الأسماء أن تكون عاملة في غيرها، هذا لفظ السهيلي والله أعلم.
فائدة: اختصاص الإعراب بالأواخر
اختص الإعراب بالأواخر، لأنه دليل على المعاني اللاحقة للمعرب، وتلك المعاني لا تلحقه إلا بعد تحصيله وحصول العلم بحقيقته، فوجب أن يترتب الإعراب بعده كما ترتب مدلوله الذي هو الوصف في المعرب.
فائدة: وصف الحرف بالحركة
قولهم حرف متحرك وتحركت الواو ونحو ذلك تساهل منهم، فإن الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حيز إلى حيز، والحرف جزء من المصوت ومحال أن تقوم الحركة بالحرف، لأنه عرض والحركة لا تقوم بالعرض، وإنما المتحرك في الحقيقة هو العضو من الشفتين أو اللسان أو الحنك الذي يخرج منه الحرف.
فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضم عند النطق فيحدث مع ذلك صويت خفي مقارن للحرف إن امتد كان واوًا، وإن قصر كان ضمة، وكذلك الفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف وحدوث الصوت الخفي الذي يسمى فتحة أو نصبة وإن مدت كانت ألفًا وإن قصرت فهي فتحة، وكذلك القول في الكسرة، والسكون عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق بالحرف فلا يحدث بعد الحرف صوت فينجزم عند ذلك أي ينقطع، فلذلك سمي جزمًا اعتبارًا بانجزام المصوت وهو انقطاعه وسكونًا اعتبارًا بالعضو الساكن.
فقولهم: فتح وضم وكسر هو من صفة العضو. وإذا سميت ذلك رفعًا ونصبًا وجزمًا وجرًا في من صفة الصوت، لأنه يرتفع عند ضم الشفتين، وينتصب عند فتحهما، وينخفض عند كسرهما، وينجزم عند سكونهما، ولهذا عبروا عنه بالرفع والنصب والجر عن حركات الإعراب، إذ الإعراب لا يكون إلا بعامل وسبب. كما أن هذه الصفات التي تضاف إلى الصوت من رفع ونصب وخفض، إنما تكون بسبب وهو حركة العضو. واقتضت الحكمة اللفظية أن يعبر بما يكون عن سبب عما يكون عن سبب وهو الإعراب. وأن يعبر بالفتح والضم والكسر والسكون عن أحوال البناء، فإن البناء لا يكون بسبب، وأعني بالسبب العامل فاقتضت الحكمة أن يعبر عن تلك الأحوال بما يكون وجوده تغيرًا له إذ الحركات الموجودة في العضو لا تكون إلا بآلة كما تكون الصفات المضافة إلى الموصوف.
وعندي أن هذا ليس باستدراك على النحاة فإن الحرف وإن كان عرضًا فقد يوصف بالحركة تبعًا لحركة محله. فإن الأعراض وإن لم تتحرك بأنفسها فهي تتحرك بحركة محالها وعلى هذا، فقد اندفع الإشكال جملة.
وأما المناسبة إلى ذكرها في اختصاص الألقاب فحسنة. غير أن كثيرًا من النحاة يطلقون كلًا منها على الآخر. ولهذا يقولون: في قام زيد مرفوع علامة رفعه ضمة آخره ولا يقولون رفعه آخره فدل على إطلاق كل منهما على الآخر.
فائدة: تقول نونت الكلمة وسينتها وكوفتها وزويتها
تقول: نونت الكلمة ألحقت بها نونًا، وسينتها ألحقت بها سينًا، وكوفتها ألحقت بها كافًا. فإن ألحقت بها زايًا. قلت: زويتها لأن ألف الزاي منقلبة عن واو لأن باب طويت أكثر من باب حوة وقوة. وقال بعضهم زييتها وليس بشيء.
فائدة: التنوين في الكلمة
التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلها فلا تدخل في الاسم إلا علامة على انفصاله عما بعده، ولهذا كثر في النكرات لفرط احتياجها إلى التخصيص بالإضافة، فإذا لم تضف احتاجت إلى التنوين تنبيهًا على أنها غير مضافة، ولا تكاد المعارف تحتاج إلى ذلك إلا فيما قل من الكلام لاستغنائها في الأكثر عن زيادة تخصيصها وما لا يتصور فيه الإضافة بحال، كالمضمر والمبهم لا ينون بحال، وكذلك المعرف باللام وهذه علة عدم التنوين وقفًا إذ الموقوف عليه لا يضاف. واختصت النون الساكنة بالدلالة على هذا المعنى لأن الأصل في الدلالة على المعاني الطارئة على الأسماء أن تكون بحروف المد واللين وأبعاضها وهي الحركات الثلاث فمتى قدر عليها فهي الأصل. فإن تعذرت فأقرب شبهًا بها وآخر الأسماء المعربة قد لحقها حركات الإعراب فلم يبق لدخول حركة أخرى عليها سبيل ولا لحروف المد واللين، لأنها مشبعة من تلك الحركات ولأنها عرضة الإعلال والتغير. فأشبه شيء بها النون الساكنة لخفائها وسكونها وإنها من حروف الزيادة وإنها من علامات الإعراب، ولهذه العلة لا ينون الفعل لاتصاله بفاعله واحتياجه إلى ما بعده.
فائدة: الحكمة في علامة التصغير
جعلت علامة التصغير ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالثة.
وحكمة ذلك والله أعلم ما أشار إليه السهيلي فقال: التصغير تقليل أجزاء المصغر والجمع مقابله، وقد زيد في الجمع ألف ثالثة كفعالل فزيد في مقابلته ياء ثالثة ولم يكن آخرًا كعلامة التأنيث، لأن الزيادة في اللفظ على حسب الزيادة في المعنى. والصفة التي هي صغر الجسم لا تختص بجزء منه دون جزء بخلاف صفة التأنيث فإنها مختصة في جميع الحيوانات بطرف يقع به الفرق بين الذكر والأنثى. وكانت العلامة في اللفظ المنبئة عن معنى المناسبة طرفًا في اللفظ بخلاف الياء في التصغير، فإنها منبئة عن صفة واقعة على جملة المصغر. وكانت ياء لا ألفًا لأن الألف قد اختصت بجمع التذكير وكانت به أولى، كما كانت الفتحة التي هي أخفها بذلك أولى، لأن الفتح ينبىء عن الكثرة، ويشار به إلى السعة كما تجد الأخرس والأعجم بطبعه. إذا أخبر عن شيء كثير فتح شفتيه وباعد ما بين يديه، وإذا كان الفتح ينبىء عن السعة والضم الذي هو ضده ينبىء عن القلة والحقارة، كما تجد لم المقلل للشيء يشير إليه بضم يد أو فم. كما فعل رسول الله ﷺ حين ذكر ساعة الجمعة وأشار بيده يقللها فإنه جمع أصابعه وضمها ولم يفتحها.
وأما الواو فلا معنى لها في التصغير لوجهين. أحدهما: دخولها في ضرب من الجموع نحو المفعول فلم يكونوا يجعلونها علامة في التصغير فيلتبس التقليل بالتكثير. والثاني: أنه لا بد من كسر ما بعد علامة التصغير إذا لم يكن حرف إعراب كما كسر ما بعد علامة التكسير في مفاعل ليتقابل اللفظان، وإن تضادا كما قابلوا علم بجهل وروى بعطش، ووضع فهو وضيع بشرف فهو شريف. فلم يمكن إدخال الواو لئلا يخرجوا منها إلى كسرة واستبقيت الألف لأجل أصل الجمع لها بقيت الياء وفتح ما قبلها لأجل ضم أول الكلمة لئلا يخرج من ضم إلى كسر.
فائدة: تنوع الأفعال
الأفعال واجب وممكن ومنتف أو في حكمه. فالرفع للواجب والنصب للممكن، والجزم الذي هو عدم الحركة للمنفي، أو ما في حكمه هذا هو الأصل، وقد يخالف وإن شئت قلت: الأفعال ثلاثة أقسام: واقع موقع الاسم فله الرفع نحو هل تضرب واقع موقع ضارب. وفعل في تأويل الاسم فله النصب نحو أريد أن تقوم أي قيامك. وفعل لا واقع موقع اسم ولا في تأويله فله الجزم نحو لم يقم.
فائدة: إضافة ظروف الزمان للأحداث
إنما أضيفت ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها نحو، يوم يقوم زيد، لأنها أوقات لها وواقعة فيها فهي لاختصاصها بها أضيف إليها وهذا بخلاف ظروف المكان لأنها لا تختص بتلك الأحداث. فإن اختصت غالبًا حسنت الإضافة نحو هذا مكان يجلس القاضي ويكون بمنزلة يوم يجلس القاضي سواء، وربما أضيفت أسماء الزمان إلى أحداث لا تقع فيها لاتصالها بها كقوله تعالى: { ليلة الصيام }. [27] فالليلة من ظروف الزمان وقد أضيفت إلى الصيام، وليس بواقع فيها. فلما جاز في بعض الكلام أن يضاف الظرف إلى الاسم الذي هو الحدث وإن لم يكن واقعًا فيه أضافوه إلى الفعل لفظًا وهو مضاف إلى الحدث معنى. واقحم لفظ الفعل إقرارًا للمعنى وتخصيصًا للغرض ورفعًا لشوائب الاحتمال، حتى إذا سمع المخاطب قولك يوم قام زيد علم أنك تريد اليوم الذي قام فيه زيد، ولو قلت مكان قولك ليلة الصيام ليلة صيام زيد ما كان له معنى إلا وقوع الصيام في الليل، فهو الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل عند إرادتهم. إضافة الظروف إلى الأحداث وقس على ذلك المبتدأ والخبر. وأما ريث فبمنزلة الظرف وقد صارت في معناه، وكذلك حيث وذي تسلم أن المعنى في قول بعضهم اذهب لوقت ذي تسلم، أي سلامتك. فلما حذفت المنعوت وأقمت النعت مقامه أضفته إلى ما كنت تضيف إليه المنعوت وهو الوقت. قال السهيلي: وهو عندي على الحكاية حكوا قول الداعي تسلم كما تعيش وتبقي فقولهم، اذهب بذي تسلم. أي اذهب بهذا القول مني. ولم يقولوا اذهب بتسلم لئلا يكون اقتصارًا على دعوة واحدة، ولكن قالوا: بذي تسلم أي بقول يقال فيه تسلم يريدرن هذا المعنى وحذفوا القول المنعوت بذي اكتفاء بدلالة الحال عليه. وأما قوله * بآية ما يحبون الطعام * فالآية هي العلامة وهي ههنا بمعنى الوقت، لأن الوقت علامة للوقت والذي يجوز إضافته من ظروف الزمان إلى الفعل، ما كان منها مفردًا متمكنًا جاز إضافته إليها، وما كان مثنى كيومين ونحوه لم يضف إليها، لأن الحدث إنما يقع مضافًا لظرفه الذي هو وقت له فلا معنى لذكر وقت آخر. وأيضا فالجملة المضاف إليها نعت للظرف في المعنى. فقولك: يوم قام زيد، كقولك يوم قام زيد فيه في المعنى، والفعل لا يدخله التثنية فلا يصح أن يضاف إليه الاثنان، كما لا يصح أن ينعت الاثنان بالواحد.
وجه ثالث وهو أن قولك: قام زيد يوما قام عمر. ولم يصح إلا أن يكون جوابًا لمتى. واليومان جواب لكم وما هو جواب لكم لا يكون جوابًا لمتى أصلًا فإن أضفت اليومين إلى الفعل صرت مناقضًا لجمعك بين الكمية وبين ما لا يكون إلا لمتى. وأما الأيام فربما جاء إضافتها مجموعة إلى الفعل لأنها قد يراد بها معنى الفرد، كالشهر والأسبوع والحول وغيره، وكذلك غير المتمكن كقبل وبعد لا يضاف إلى الفعل، لأنك لو أضفتها إليه لاقتضت إضافتها إليه ما يقتضيه قولك يوم قام زيد أي اليوم الذي قام فيه، وذلك محال في قبل وبعد لأنه يؤول إلى إبطال معنى القبلية والبعدية. وأما سحر يوم بعينه فيمتنع من إضافته إلى الفعل لما فيه من معنى اللام فقس على هذا.
(فائدة: قياس الأسماء الخمسة أن تكون مقصورة)
وقال السهيلي قياس الأسماء الخمسة أن تكون مقصورة لأن أصلها أبو أخو والواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ألفًا تكون مقصورة كما هو إحدى لغاتها، ولكن هذه الأسماء حذفت أواخرها في حال الإفراد والإنفصال عن الإضافة. وقال لي بعض أشياخنا في بعلبك: إن التنوين لما أوجب حذف الألف المنقلبة لالتقاء الساكنين حذفوها رأسًا كما قيل:
رأى الأمر يفضي إلى آخر ** فصير آخره أولًا
فإذا أضيفت وزالت عند التنوين رجعت الحروف المحذوفة وكان الإعراب فيها مقدرًا كما هو مقدر في الأسماء المقصورة، وقال بهذا بعض النحاة. قال: والأمر فيها عندي أنها علامات إعراب، وليست حروف إعراب والمحذوف منها لا يعود إليها في الإضافة كما لا يعود المحذوف من يد ودم. وبرهان ذلك أنك تقول أخي وأبي إذا أضفت إلى نفسك كما تقول: يدي ودمي، لأن حركات الإعراب لا تجتمع مع ياء المتكلم كما تجتمع معها واو الجمع، فلو كانت الواو في أخوك حرف إعراب لقلت في الإضافة إلى نفسك هذا أخي كما تقول هؤلاء مسلمي فتدغم الواو في الياء لأنها حرف إعراب عند سيبويه. وهي عند غيره علامات إعراب، فإذا كانت واو الجمع تثبت مع ياء المتكلم وهي غير زائدة وهي عند غيره علامة إعراب. فكيف يحذف لام الفعل وهو أحق بالثبات منها؟ فقد وضح لك أنها ليست الحروف المحذوفة هي الأصلية.
فإن قيل: فلم أعربت بالحروف ولم أعلت بالحذف دون القلب خلافًا لنظائرها، مما علته كعلتها. وهي الأسماء المقصورة. قلنا في ذلك جواب لطيف وهو: أن اللفظ جسد والمعنى روح فهو تبع له في صحته واعتلاله، والزيادة فيه والنقصان منه كما أن الجسد مع الروح، كذلك فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة أو حذف، فإنما يكون بحسب ما يكون في المعنى اللهم إلا أن يكثر استعمال كلمة فتحذف منها تخفيفًا على اللسان لكثرة دورها فيه، ولعلم المخاطب بمعناها كقولهم: إيش في أي شيء ولم أبل.
وهذه الأسماء الخمسة مضافة إلى المعنى، فإذا قطعت عن الإضافة وأفردت نقص المعنى فينقص اللفظ تبعًا له، مع أن أواخرها حروف علة فلا بد من تغييرها. إما بقلب وإما بحذف، وكان الحذف فيها أولى كما قدمنا وكان ينبغي على هذا أن يتم لفظها في حال الإضافة كما تم معناها. إلا أنهم كرهوا أن يخلوا الخاء من أخ والباء من أب من الإعراب الحاصل فيها، إذ ليس في الكلام ما يكون حرف إعراب في حال الإفراد دون الإضافة. فجمعوا بين الغرضين ولم يبطلوا أحد القياسين فمكنوا الحركات التي هي علامات الإعراب في الأفراد. فصارت حروف مد ولين في الإضافة، وقد تقدم أن الحركة بعض الحرف، فالضمة التي في قولك أخ هي بعينها علامة الرفع في أخوك إلا أن المصوت بها يمد ليتمموا اللفظ كما تمموا المعنى بالإضافة إلى ما بعد الاسم ولم يحتاجوا مع تطويل حركات الإعراب إلى إعادة ما حذف من الكلمة رأسًا، كما لا يعاد محذوف يد ودم.
وأما التثنية فإنهم صححوا اللفظ فيها بإعادة المحذوف تنبيهًا على الأصل وهو الانقلاب إلى ألف فقالوا: أخوان وأبوان. كما قالوا: عضوان ونضوان، لأن قياسه في الأصل كقياسه بخلاف يد ودم فإن أصلهما يدي ودمي فلم يكن بابها كباب عصى ورحا. فاستمر الحذف فيهما في التثنية والإفراد.
فإن قيل: فلم لا يعود في ابن في تثنية ولا إضافة. قيل: لأنهم عوضوا من المحذوف ألف الوصل في ابن واسم فلم يجمعوا بين العوض والمعوض بخلاف أخ وأب، ومنعهم أن يعوضوا من المحذوف في أخ وأب الهمزة التي في أولها فرارًا من اجتماع همزتين. وأما حم فأصله حمأ بالهمزة فلم يكونوا ليعوضوا من الهمزة همزة أخرى فجعلوه كأخ وأب.
فإن قيل: فلم قالوا في جمعه بنون دون ابنون. قيل: الجمع قد يلحقه التغيير بالكسر وغيره، بخلاف التثنية فإنها لا يتغير فيها لفظ الواحد بحال، مع أنهم رأوا أن جمع السلامة لا بد فيه من واو في الرفع، وياء مكسور ما قبلها في النصب والخفض فأثسبهت حاله حال ما لم يحذف منه شيء. وليست هذه العلة في التثنية، ولم يقولوا: أبنات، كما قالوا: ابنتان. فإنهم حملوا جمع المؤنث على جمع المذكر لئلا يختلف.
وأما أخت وبنت فتاء أخت مبدلة من واو كتاء تراث وتخمة، وإنما حملهم على ذلك ههنا، إنهم رأوا المذكر قد حذفت لامه في الإفراد. فقالوا: أخ وكان القياس أن يقولوا: في المؤنث أخت كسنة، ولو فعلوا ذلك، لكانت تلك التاء حرف إعراب في الإضافة والإفراد ولم يمكنهم أن يعيدوا المحذوف في الإضافة إلى اللفظ، فيخالف لفظه لفظ المذكر، ولا أمكنهم من تطويل الصوت بالحركات ما أمكنهم في التذكير، لأن ما قبل تاء التأنيث ليس بحرف إعراب، ولا أمكنهم نقصان اللفظ في الموطن الذي تم فيه المعنى، فجمعوا بين الأغراض بإبدالها تاء لتكون في حال الإفراد علمًا للتأنيث وفي حال الإضافة من تمام الاسم كالحرف الأصلي إذ هو موطن تتميم كما تقدم، وسكنوا ما قبلها لتكون بمنزلة الحرف الأصلي، وضموا أول الكلمة إشعارًا بالواو وكسروها في بنت إشعارًا بالياء، لأنها من بنيت.
وقالوا في تأنيث ابن: ابنة وبنت ولم يقولوا في تأنيث أخ إلا أخت. والعلة في ذلك مستقراة كما تقدم.
وأما قولهم فوك وفاك وفيك فحروف المد فيها حروف إعراب لانفرادها فلم يلزم فيها ما لزم في الخاء والباء ألا تراهم يقولون: هذا في وجعلته في في كما يقولون: مسلمي فيثبتونها مع ياء المتكلم. وهذا يدلك على أنها حرف إعراب بخلاف أخواتها، ألا تراهم في حال الإفراد كيف أبدلوا من الواو ميمًا لتتعاقب عليها حركات الإعراب ويدخلها التنوين. إذ لو لم يبدلوها ميمًا لأذهبها التنوين في الإفراد، وبقيت الكلمة على حرف واحد. فإذا أضيفت زالت العلة حيث أثبتوا التنوين فلم يحتاجوا إلى قلبها ميمًا.
فإن قلت: أين علامات الإعراب في حال الأصالة؟ قلت: مقدر فيها. وإن شئت قلت: تغير صيغها في الأحوال الثلاثة هو الإعراب والمتغير هو حرف الإعراب فإن قلت: فلم لم تثبت الألف في حال النصب إذا أضيفت إلى ضمير المتكلم. فتقول: فأي كعصاي. قلت: الفرق أن ألف عصا ثابتة في جميع الأحوال، وهذه لا تكون إلا في حال النصب وقد قلبت تلك ياء في لغة طي، فهذه أحرى بالقلب.
وأما ذو مال فكان الأظهر فيه أن يكون حرف العلة حرف إعراب، وأن لا يكون الاسم على حرفين كما هو في بعض الأسماء المبهمة، كذلك يدلك على ذلك قولهم في الجمع: ذوو مال وذوات مال إلا أنه قد جاء في القرآن ذواتا أفنان وذواتي أكل، وهذا ينبىء أن الاسم ثلاثي ولامه ياء انقلبت ألفا في تثنية المؤنث خاصة.
وقولهم في التثنية: ذواتي وفي الجمع ذوات، والجمع كان أحق بالرد في التثنية، لأن التثنية أقرب إلى لفظ واحد ولأنها أقرب إلى معناه، ألا تراهم يقولون: أخت وأختان وأخوات وابنة وابنتان، لا تقول في الجمع: ابنتات، [28] فلذلك كان القياس حين قالوا: ذوات فلم يردوا لام الكلمة. (ألا يردوا في التثنية).
والعلة فيه أن ألف ذو وإن كانت منقلبة عن واو فإن انقلابها ليس بلازم، وإنما هو عارض بدخول التأنيث ولولا التأنيث لكانت واوًا وفي حال الرفع غير منقلبة، وياء في حال الخفض، والتثنية أقرب إلى الواحد لفظًا ومعنى فلذلك حين ثبوتها جعلوها واوًا. كما هي في الواحد إذ كان مرفوعًا ومثنى ومجموعًا وكان حكم الواو أغلب عليها من حكم الياء والألف، ثم ردوا لام الفعل لأنهم لو لم يردوها لقالوا ذواتا مال في حال الرفع، فيلتبس بالفعل نحو رمتا وقضتا إذا أخبرت عن امرأتين وذواتا من الذوي فكان في رد اللام رفع لهذا اللبس.
وفرق بين ما يصح عينه في المذكر نحو ذات وذو وبين ما لا يصح عينه في مذكر ولا جمع نحو شاة فإنك تقول في تثنيته: شاتان كقياس ذات وليس في جمع ذات ما يوجب رد لامها كما في تثنيتها كما تقدم.
وأما سنتان وشفتان فلا يلزم فيهما من الالتباس بالفعل ما لزم في ذواتا لو قيل لأن نون الاثنين لا تحذف منهما حذفًا لازمًا لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام بخلاف ذواتا، فإن النون لا توجد فيها البتة للزومها الإضافة.
فوائد تتعلق بالحروف الروابط بين الجملتين وأحكام الشرط
وفيها مباحث وقواعد عزيزة نافعة تحررت بعد فكر طويل بحمد الله.
فائدة: الروابط بين جملتين
الروابط بين جملتين هي الأدوات التي تجعل بينهما تلازمًا لم يفهم قبل دخولها وهي أربعة أقسام:
أحدها: ما يوجب تلازمًا مطلقًا بين الجملتين. أما بين ثبوت وثبوت، أو بين نفي ونفي، أو بين نفي وثبوت. وعكسه في المستقبل خاصة وهو حرف الشرط البسيط كان فإنها تلازم بين هذه الصور كلها. تقول: إن اتقيت الله أفلحت وإن لم تتق الله لم تفلح. وإن أطعت الله لم تخب، وإن لم تطع الله خسرت. ولهذا كانت أم الباب واعم أدواته تصرفًا.
القسم الثاني: أداة تلازم بين هذه الأقسام الأربعة تكون في الماضي خاصة. وهي لما تقول: لما قام أكرمته. وكثير من النحاة يجعلها ظرف زمان. وتقول: إذا دخلت على الفعل الماضي فهي اسم، وإن دخلت على المستقبل فهي حرف. ونص سيبويه على خلاف ذلك وجعلها من أقسام الحروف التي تربط بين الجملتين ومثال الأقسام الأربعة. لما قام أكرمته ولما لم يقم لم أكرمه ولما لم يقم أكرمته، ولما قام لم أكرمه.
القسم الثالث: أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره، وهي لو نحو لو أسلم الكافر نجا من عذاب الله.
القسم الرابع: أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره وهي لولا نحو: لولا أن هدانا الله لضللنا.
وتفصيل هذا الباب برسم عشرة مسائل.
المسألة الأولى: المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا بالمستقبل، فإن كان ماضي اللفظ كان مستقبل المعنى. كقولك: إن مت على الإسلام دخلت الجنة، ثم للنحاة فيه تقدير إن أحدهما: إن الفعل ذو تغير في اللفظ وكان الأصل إن تمت مسلمًا تدخل الجنة، فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلًا له منزلة المحقق. والثاني أنه ذو تغير في المعنى وإن حرف الشرط لما دخل عليه قلب معناه إلى الاستقبال. وبقي لفظه على حاله. والتقدير الأول أفقه في العربية لموافقته تصرف العرب في إقامتها الماضي مقام المستقبل وتنزيلها المنتظر منزلة الواقع المتيقن نحو: { أتى أمر الله }، [29] { ونفخ في الصور }، [30] ونظائره، فإذا تقرر ذلك في الفعل المجرد فليفهم مثله المقارن لأداة الشرط. وأيضا فإن تغيير الألفاظ أسهل عليهم من تغيير المعاني، لأنهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على المعنى. وأيضا فإنهم إذا أعربوا الشرط أتوا بأداته ثم اتبعوها فعله يتلوه الجزاء، فإذا أتوا بالأداة جاؤوا بعدها بالفعل وكان حقه أن يكون مستقبلًا لفظًا ومعنى، فعدلوا عن لفظ المستقبل إلى الماضي لما ذكرنا فعدلوا عن صيغة إلى صيغة. وعلى التقدير الثاني كأنهم وضعوا فعل الشرط والجزاء أولا ماضيين، ثم أدخلوا عليهما الأداة فانقلبا مستقبلين والترتيب والقصد يأبى ذلك فتأمله.
المسألة الثانية: قال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: { إن كنت قلته فقد علمته }، [31] فهذا شرط دخل على ماضي اللفظ، وهو ماضي المعنى قطعًا، لأن المسيح إما أن يكون صدر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماء أو يكون حكاية ما يقوله يوم القيامة. وعلى التقديرين فإنما تعلق الشرط وجزاؤه بالماضي وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل رفعه. والتقدير إن أكن أقول: هذا فإنك تعلمه. وهذا تحريف للآية، لأن هذا الجواب إنما صدر منه بعد سؤال الله له عن ذلك، والله لم يسأله وهو بين أظهر قومه ولا اتخذوه وأمه إلهين إلا بعد رفعه بمئين من السنين فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارًا لقاعدة نحوية هدم مائة أمثالها أسهل من تحريف معنى الآية. وقال ابن السراج في أصوله: يجب تأويلهما بفعلين مستقبلين تقديرهما إن ثبت في المستقبل. أني قلته في الماضي يثبت أنك علمته. وكل شيء تقرر في الماضي كان ثبوته في المستقبل فيحسن التعليق عليه.
وهذا الجواب أيضا ضعيف جدًا ولا ينبىء عنه اللفظ. وليت شعري ما يصنعون بقول النبي ﷺ: «إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه»، هل يقول عاقل إن الشرط هنا مستقبل. أما التأويل الأول فمنتف هنا قطعًا. وأما الثاني فلا يخفي وجه التعسف فيه، وإنه لم يقصد أنه يثبت في المستقبل إنك أذنبت في الماضي فتوبي ولا قصد هذا المعنى، وإنما المقصود المراد ما دل عليه الكلام إن كان صدر منك ذنب فيما مضى فاستقبليه بالتوبة. لم يرد إلا هذا الكلام.
وإذا ظهر فساد الجوابين فالصواب أن يقال جملة الشرط والجزاء تارة تكون تعليقًا محضًا غير متضمن جوابًا لسائل. هل كان كذا ولا؟ يتضمن لنفي قول من قال: قد كان كذا فهذا يقتضي الاستقبال، وتارة يكون مقصوده ومضمنه جواب سائل، هل وقع كذا؟ أو رد قوله قد وقع كذا، فإذا علق الجواب هنا على شرط لم يلزم أن يكون مستقبلًا لا لفظًا ولا معنى، بل لا يصح فيه الاستقبال بحال كمن يقول لرجل: هل أعتقت عبدك؟ فيقول: إن كنت قد أعتقته فقد أعتقه الله، فما للاستقبال هنا معنى قط، وكذلك إذا قلته: لمن قال صحبت فلانًا. فيقول: إن كنت صحبته فقد أصبت بصحبته خيرًا. وكذلك إذا قلت له: هل أذنبت؟ فيقول: إن كنت قد أذنبت فإني قد تبت إلى الله واستغفرته. وكذلك إذا قال: هل قلت لفلان كذا وهو يعلم أنه علم بقوله له؟ فيقول إن كنت قلته فقد علمته. فقد عرفت أن هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظًا ومعنى ليطابق السؤال الجواب ويصح التعليق الخبري لا الوعدي. فالتعليق الوعدي يستلزم الاستقبال. وأما التعليق الخبري فلا يستلزمه. ومن هذا الباب قوله تعالى: { إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين * وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين }، [32] وتقول: إن كانت البينة شهدت بكذا وكذا فقد صدقت، وهذه دقيقة خلت عنها كتب النحاة والفضلاء وهي كما ترى وضوحًا وبرهانًا ولله الحمد.
المسألة الثالثة: المشهور عند النحاة والأصوليين والفقهاء أن أداة إن لا يعلق عليها إلا محتمل الوجود والعدم. كقولك: إن تأتني أكرمك، ولا يعلق عليها محقق الوجود فلا نقول: إن طلعت الشمس أتيتك، بل تقول: إذا طلعت الشمس أتيتك وإذا يعلق عليها النوعان.
واستشكل هذا بعض الأصوليين فقال: وقد وردت إن في القران في معلوم الوقوع قطعًا كقوله: { وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا }، [33] وهو سبحانه يعلم أن الكفار في ريب منه. وقوله: { فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار }، [34] ومعلوم قطعًا انتفاء فعلهم.
وأجاب عن هذا بأن قال: إن الخصائص الإلهية لا تدخل في الأوضاع العربية، بل الأوضاع العربية مبنية على خصائص الخلق. والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب وعلى منوالهم فكل ما كان في عادة العرب حسنًا أنزل القرآن على ذلك الوجه أو قبحًا لم ينزل في القرآن. فكل ما كان شأنه أن يكون في العادة مشكوكًا فيه بين الناس حسن تعليقه بأن من قبل الله ومن قبل غيره سواء كان معلومًا للمتكلم أو للسامع أم لا. ولذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: إن كان زيد في الدار فأكرمه، مع علمه بأنه في الدار لأن حصول زيد في الدار شأنه أن يكون في العادة مشكوكًا فيه، فهذا هو الضابط لما تعلق على إن فاندفع الإشكال.
قلت: هذا السؤال لا يرد، فإن الذي قاله القوم: إن الواقع ولا بد لا يُعلق بأن. وأما ما يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع، فهو الذي يعلق بها وإن كان بعد وقوعه متعين الوقوع. وإذا عرفت هذا فتدبر قوله تعالى: { وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور }، [35] كيف أتى في تعليق الرحمة المحققة أصابتها من الله تعالى بإذا وأتى في إصابة السيئة بأن فإن ما يعفو الله عنه أكثر، وأتى في الرحمة بالفعل الماضي الدال على تحقيق الوقوع. وفي حصول السيئة بالمستقبل الدال على أنه غير محقق ولا بد، وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل الإذاقة الدال على مباشرة الرحمة لهم وإنها مذوقة لهم. والذوق هو أخص أنواع الملابسة وأشدها وكيف أتى في الرحمة بحرف ابتداء الغاية مضافة إليه؟ فقال: { منا رحمة } وأتى في السيئة بباء السببية مضافة إلى كسب أيديهم. وكيف أكد الجملة الأولى التي تضمنت إذاقة الرحمة بحرف؟ إن دون الجملة الثانية وأسرار القرآن أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر.
وتأمل قوله تعالى: { وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه }، [36] كيف أتى بإذا ههنا؟ لما كان مس الضر لهم في البحر محققًا بخلاف قوله: { لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤوس قنوط }، [37] فإنه لم يقيد مس الشر هنا بل أطلقه ولما قيده بالبحر الذي هو متحقق فيه ذلك أتى بأداة إذا.
وتأمل قوله تعالى: { وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا }، [38] كيف أتى هنا بإذا المشعرة بتحقيق الوقوع المستلزم لليأس؟ فإن اليأس، إنما حصل عند تحقق مس الشر له. فكان الإتيان بإذا ههنا أدل على المعنى المقصود من إن بخلاف قوله: { وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض }، [39] فإنه بقلة صبره وضعف احتماله مني توقع الشر أعرض وأطال في الدعاء، فإذا تحقق وقوعه كان يؤوسًا. ومثل هذه الأسرار في القرآن لا يرقى إليها إلا بموهبة من الله وفهم يؤتيه عبدًا في كتابه.
فإن قلت: فما تصنع بقوله تعالى: { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } [40] والهلاك محقق.
قلت: التعليق ليس على مطلق الهلاك، بل على هلاك مخصوص، وهو هلاك لا عن ولد.
فإن قلت: فما تصنع بقوله: { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون }، [41] وقوله: { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين }، [42] وتقول العرب: إن كنت ابني فأطعني. وفي الحديث في السلام على الموتى: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»، واللحاق محقق. وفي قول الموصي: إن مت فثلث مالي صدقة.
قلت: أما قوله: { إن كنتم إياه تعبدون }، الذي حسن مجيء إن ههنا الاحتجاج والإلزام. فإن المعنى إن عبادتكم لله تستلزم شكركم له، بل هي الشكر نفسه، فإن كنتم ملتزمين لعبادته داخلين في جملتها فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه وهذا كثيرًا ما يورد في الحجاج. كما تقول للرجل: إن كان الله ربك وخالقك فلا تعصه. وإن كان لقاء الله حقًا فتأهب له. وإن كانت الجنة حقًا فتزود إليها، وهذا أحسن من جواب من أجاب بأن إن هنا قامت مقام إذا وكذا قوله: { إن كنتم بآياته مؤمنين }، [43] وكذا قولهم: إن كنت ابني فأطعني ونظائر ذلك.
وأما قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون فالتعليق هنا ليس لمطلق الموت، وإنما هو للحاقهم بالمؤمنين ومصيرهم إلى حيث صاروا.
وأما قول الموصي: إن مت فثلمث مالي صدقة فلأن الموت وإن كان محققًا، لكن لما لم يعرف تعين وقته وطال الأمد وانفردت مسافة أمنية الحياة نزل منزلة المشكوك كما هو الواقع الذي يدل عليه أحوال العباد فإن عاقلًا لا يتيقن الموت ويرضى بإقامته على حال لا يحب الموت عليها أبدًا. كما قال بعض السلف ما رأيت يقينًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت، وعلى هذا حمل بعض أهل المعاني: { ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون } [44] فأكد الموت باللام وأتى فيه باسم الفاعل الدال على الثبوت وأتى في البعث بالفعل ولم يؤكده.
المسألة الرابعة: قد تعلق الشرط بفعل محال ممتنع الوجود فيلزمه محال آخر وتصدق الشرطية دون مفرديها. أما صدقها فلاستلزام المحال المحال، وأما كذب مفرديها فلاستحالتهما وعليه: { قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين } [45] ومنه قوله: { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا }، [46] ومنه: { قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا }، [47] ونظائره كثيرة.
وفائدة الربط بالشرط في مثل هذا أمران. أحدهما: بيان استلزام إحدى القضيتين للأخرى. والثاني: أن اللازم منتف. فالملزوم كذلك فقد تبين من هذا. أن الشرط تعلق به المحقق الثبوت والممتنع الثبوت والممكن الثبوت.
المسألة الخامسة: اختلف سيبويه ويونس في الاستفهام الداخل على الشرط فقال سيبويه: يعتمد على الشرط وجوابه فيتقدم عليهما ويكون بمنزلة القسم نحو قوله: { أفإن مت فهم الخالدون }، [48] وقوله: { أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم }، [49] وقال يونس: يعتمد على الجزاء فتقول: إن مت أفأنت خالد والقرآن مع سيبويه. والقياس أيضا كما يتقدم القسم ليكون جملة الشرط والجزاء مقسمًا عليها ومستفهمًا عنها، ولو كان كما قال يونس لقال: { أفإن مت فهم الخالدون }
المسألة السادسة: اختلف الكوفيون والبصريون فيما إذا تقدم أداة الشرط جملة تصلح أن تكون جزاء، ثم ذكر فعل الشرط ولم يذكر له جزاء نحو أقوم إن قمت فقال ابن السراج: الذي عندي أن الجواب محذوف يغني عنه الفعل المتقدم قال: وإنما يستعمل هذا على وجهين. إما أن يضطر إليه شاعر. وإما أن يكون المتهكلم به محققًا بغير شرط ولا نية فقال: أجيئك ثم يبدو له أن لا يجيئه إلا بسبب فيقول: إن جئتني فيشبه الإستثناء ويغني عن الجواب ما تقدم وهذا قول البصريين وخالفهم أهل الكوفة وقالوا: المتقدم هو الجزاء، والكلام مرتبط به وقولهم في ذلك هو الصواب، وهو اختيار الجرجاني قال: الدليل على أنك إذا قلت؟ آتيك إن اتيتني كان الشرط متصلًا بآتيك وإن الذي يجري في كلامهم لا بد من إضمار الجزاء ليس على ظاهره. وأما إن عملنا على ظاهره وتوقفنا أن الشرط متقدم في النفس على الجزاء، صار من ذلك شيئان ابتداء كلام ثان، ثم اعتقاد ذلك يؤدي إلى ابطال ما اتفق عليه العقلاء في الإيمان من افتراق الحكم بين أن يصل الشرط في نطقه وبين أن يقف ثم يأتي بالشرط وإنه إذا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فوصل لم يعتق ولو وقف. ثم قال: إن شاء الله فإنه يعتق. فإذا سمعت ما قلنا عرفت خلاف المسألة. فالمشهور من مذهب البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط هذا كلامه.
قلت: ولم يكن به حاجة في تقرير الدليل إلى الوقف بين الجملة الأولى وجملة الشرط، فالدلالة قائمة. ولو وصل فانه إذا قال: أنت حر فهذه جملة خبرية ترتب عليها حكمها عند تمامها.
وقوله: إن شاء الله ليس تعليقًا لها عندكم. فإن التعليق، إنما يعمل في الجزاء وهذه ليست بجزاء، وإنما هي خبر محض، والجزاء عندكم محذوف فلما قالوا: إنه لا يعتق، دل على أن المتقدم نفسه جزاء معلق هذا تقرير الدلالة ولكن، ليس هذا باتفاق فقد ذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أن الشرط، إنما يعمل في تعليق الحكم إذا تقدم على الطلاق فتقول: إن شاء الله فأنت طالق. فأما إن تقدم الطلاق ثم عقبه بالتعليق فقال، أنت طالق إن شاء الله طلقت ولا ينفع التعليق، وعلى هذا فلا يبقى فيما ذكر حجة، ولكن هذا المذهب شاذ والأكثرون على خلافه وهو الصواب لأنه إما جزاء لفظًا ومعنى قد اقتضاه التعليق على قول الكوفيين، وأما أن يكون جزاء في المعنى وهو نائب الجزاء المحذوف ودال عليه، فالحكم تعلق به على التقديرين والمتكلم إنما بنى كلامه عليه.
وأما قول ابن السراج إنه قصد الخبر جزمًا، ثم عقبه بالجزاء فليس كذلك، بل بنى كلامه على الشرط كما لو قال له: علي عشرة إلا درهمًا فإنه لم يقر بالعشرة ثم أنكر درهمًا، ولو كان كذلك لم ينفعه الاستثناء، ومن هنا قال بعض الفقهاء: إن الاستثناء لا ينفع في الطلاق، لأنه إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة فقد أوقع الثلاثة ثم رفع منها واحدة وهذا مذهب باطل. فإن الكلام مبني على آخره مرتبط أجزاوه بعضها ببعض، كارتباط التوابع من الصفات وغيرها بمتبوعاتها والاستثناء لا يستقل بنفسه فلا يقبل إلا بارتباطه بما قبله فجرى مجرى الصفة والعطف. ويلزم أصحاب هذا المذهب أن لا ينفع الاستثناء في الإقرار، لأن المقربة لا يرفع ثبوته وفي إجماعهم على صحته، دليل على إبطال هذا المذهب، وإنما احتاج الجرجاني إلى ذكر الفرق بين أن يقف أو يصل، لأنه إذا وقف عتق العبد ولم ينفعه الاستثناء، وإذا وصل لم يعتق فدل على أن الفرق بين وقوع العتق وعدمه هو السكوت. والوصل هو المؤثر في الحكم لا تقدم الجزاء وتأخره فانه لا تأثير له بحال كما ذكره ابن السراج أنه إنما يأتي في الضرورة، ليس كما قال فقد جاء في أفصح الكلام وهو كثير جدًا. كقوله تعالى: { واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون }، [50] وقوله: { فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين }، [51] وقوله: { قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون }، [52] وهو كثير.
فالصواب المذهب الكوفي، والتقدير إنما يصار إليه عند الضرورة بحيث لا يتم الكلام إلا به، فإذا كان الكلام تامًا بدونه فأي حاجة بنا إلى التقدير، وأيضا فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم الخبر والمفعول والحال ونظائرها.
فإن قيل: الشرط له التصدير وصفًا فتقديم الجزاء عليه يخل بتصديره.
قلنا: هذه هي الشبهة التي منعت القائلين بعدم تقديمه وجوابها: أنكم إن عنيتم بالتصدير أنه لا يتقدم معموله عليه، والجزاء معمول له فيمتنع تقديمه فهو نفس المتنازع فيه. فلا يجوز إثبات الشيء بنفسه وإن عنيتم به أمرًا آخر لم يلزم منه امتناع التقديم، ثم نقول: الشرط والجزاء جملتان قد صارتا بأداة الشرط جملة واحدة وصارت الجملتان بالأداة كأنهما مفردان. فأشبها الفردين في باب الابتداء والخبر فكما لا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ، فكذلك تقديم الجزاء، وأيضا فالجزاء هو المقصود والشرط قيد فيه وتابع له فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعًا. ولهذا كثيرًا ما يجيء الشرط متأخرًا عن المشروط، لأن المشروط هو المقصود وهو الغاية والشرط وسيلة فتقديم المشروط هو تقديم الغايات على وسائلها ورتبتها التقديم ذهنًا، وإن تقدمت الوسيلة وجودًا فكل منهما له التقدم بوجه وتقدم الغاية أقوى، فإذا وقعت في مرتبتها فأي حاجة إلى أن نقدرها متأخرة وإذا انكشف الصواب فالصواب أن تدور معه حيثما دار.
المسألة السابعة: لو يؤتى بها للربط لتعلق ماض بماض. كقولك: لو زرتني لأكرمتك. ولهذا لم تجزم إذا دخلت على مضارع لأن الوضع للماضي لفظًا ومعنى كقولك لو يزورني زيد لأكرمته. فهي في الشرط نظير إن في الربط بين الجملتين لا في العمل ولا في الاستقبال. وكان بعض فضلاء المتأخرين وهو تاج الدين الكندي ينكر أن تكون لو حرف شرط، وغلط الزمخشري في عدها في أدوات الشرط قال الأندلسي: في شرح المفصل فحكيت ذلك لشيخنا أبي البقاء. فقال: غلط تاج الدين في هذا التغليط، فإن لو تربط شيئًا بشيء كما تفعل إن قلت: ولعل النزاع لفظي فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي. فالصواب ما قاله أبو البقاء والزمخشري وإن أريد بالشرط ما يعمل في الجزأين فليست من أدوات الشرط.
المسألة الثامنة: المشهور أن لو إذا دخلت على ثبوتين نفتهما أو نفيين أثبتتهما أو نفي وثبوت أثبتت المنفي ونفت المثبت، وذلك لأنها تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، لم إذا امتنع النفي صار اثباتًا فجاءت الأقسام الأربعة وأورد على هذا أمور.
أحدها قوله تعالى: { ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله }، [53] ومقتضى ما ذكرتم. أن تكون كلمات الله تعالى قد نفدت وهو محال، لأن الأول ثبوت وهو كون أشجار الأرض أقلامًا، والبحار مدادًا لكلماته وهذا منتف. والثاني: وهو قوله ما نفدت كلمات الله فيلزم أن يكون ثبوتًا.
الثاني: قول عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فعلى ما ذكرتم يكون الخوف ثابتًا، لأنه منفي والمعصية كذلك، لأنها منفية أيضا. وقد اختلف أجوبة الناس عن ذلك.
فقال أبو الحسن بن عصفور: لو في الحديث بمعنى إن لمطلق الربط فلا يكون نفيها إثباتًا ولا إثباتها نفيًا. فاندفع الإشكال. وفي هذا الجواب ضعف بين فإنه لم يقصد في الحديث مطلق الربط كما قال، وإنما قصد ارتباط متضمن لنفي الجزاء ولو سيق الكلام إلا لهذا ففي الجواب إبطال خاصية لو التي فارقت بها سائر أدوات الشرط.
وقال غيره: لو في اللغة لمطلق الربط، وإنما اشتهرت في العرف في انقلاب ثبوتها نفيًا وبالعكس. والحديث إنما ورد بمعنى اللفظ في اللغة. حكى هذا الجواب القرافي عن الخسروشاهي، وهو أفسد من الذي قبله بكثير، فإن اقتضاء لو لنفي الثابت بعدها وإثبات المنفي متلقى من أصل وضعها لا من العرف الحادث، كما أن معاني سائر الحروف من نفي أو تأكيد أو تخصيص أو بيان أو ابتداء أو انتهار، إنما هو متلقى من الوضع لا من العرف فما قاله ظاهر البطلان.
الجواب الثالث: جواب الشيخ أبي محمد بن عبد السلام وغيره وهو أن الشيء الواحد قد يكون له سبب واحد فينتفي عند انتفائه وقد يكون له سببان فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه، لأن السبب الثاني يخلف السبب الأول كقولنا في زوج هو ابن عم لو لم يكن زوجًا لورث أي بالتعصيب فإنهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخر، وكذلك الناس ههنا في الغالب، إنما لم يعصوا لأجل الخوف فإذا ذهب الخوف عنهم عصوا لاتحاد السبب في حقهم فأخبر عمر أن صهيبًا اجتمع له سببان يمنعانه المعصية الخوف والإجلال فلو انتفى الخوف في حقه لانتفى العصيان للسبب الآخر وهو الإجلال. وهذا مدح عظيم له.
قلت وبهذا الجواب بعينه يجاب عن قوله ﷺ في ابنة حمزة: «إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة»، أي فيها سببان يقتضيان التحريم فلو قدر انتفاء أحدهما لم ينتف التحريم للسبب الثاني. وهذا جواب حسن جيد.
الجواب الرابع: ذكره بعضهم بأن قال: جواب لو محذوف وتقديره لو لم يخف الله لعصمه فلم يعصه بإجلاله ومحبته إياه، فإن الله يعصم عبده بالخوف تارة، والمحبة والإجلال تارة. وعصمة الإجلال والمحبة أعظم من عصمة الخوف، لأن الخوف يتعلق بعقابه، والمحبة والإجلال يتعلقان بذاته وما يستحقه تبارك وتعالى، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان دين الحب أثبت وأرسخ من دين الخوف وأمكن وأعظم تأثيرًا. وشاهد ما نراه من طاعة المحب لمحبوبه وطاعة الخائف لمن يخافه. كما قال بعض الصحابة: أنه ليستخرج حبه مني من الطاعة ما لا يستخرجه الخوف، وليس هذا موضع بسط هذا الشأن العظيم القدر، وقد بسطته في كتاب الفتوحات القدسية. [54]
الجواب الخامس: أن لو أصلها أن تستعمل للربط بين شيئين كما تقدم، ثم أنها قد تستعمل لقطع الربط فتكون جوابًا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط. كما لو قال القائل: إن لم يكن زيد زوجًا لم يرث، ققول أنت: لو لم يكن زوجًا لورث زيد. إن ما ذكره من الربط بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس بحق، فمقصودك قطع ربط كلامه لا ربطه. وتقول: لو لم يكن زيد عالمًا لأكرم أي لشجاعته جوابًا لسؤال سائل يتوهم أنه لو لم يكن عالمًا لما أكرم. فتربط بين عدم العلم والإكرام فتقطع أنت ذلك الربط، وليس مقصودك أن تربط بين عدم العلم والإكرام، لأن ذلك ليس بمناسب ولا من أغراض العقلاء ولا يتجه كلامك إلا على عدم الربط.
كذلك الحديث، لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصيانهم بعدم خوفهم، وأن ذلك في الأوهام، قطع عمر هذا الربط وقال: لو لم يخف الله لم يعصه.
وكذلك لما كان الغالب على الأوهام أن الشجر كلها إذا صارت أقلامًا والبحار المذكورة كلها تكتب به الكلمات الإلهية، فلعل الوهم يقول: ما يكتب بهذا شيء إلا نفد كائنًا ما كان، فقطع الله تعالى هذا الربط ونفى هذا الوهم وقال: { ما نفدت.
قلت: ونظير هذا في الحدي. أن زوجته لما توهمت أن ابنة عمه حمزة تحل له لكونها بنت عمه، فقطع هذا الربط بقوله: إنها لا تحل وذكر للتحريم سببين الرضاعة وكونها ربيبة له، وهذا جواب القرافي، قال: وهو أصلح من الأجوبة المتقدمة من وجهين أحدهما: شموله للحديث والآية وبعض الأجوبة لا تنطبق على الآية، والثاني: أن ورود لو بمعنى إن خلاف الظاهر وما ذكره لا يتضمن خلاف الظاهر.
قلت: وهذا الجواب فيه ما فيه فإنه إن ادعى أن لو وضعت أو جيء بها لقطع الربط فغلط فإنها حرف من حروف الشرط التي مضمونها ربط السبب بمسببه والملزوم بلازمه. ولم يؤت بها لقطع هذا الارتباط ولا وضعت له أصلًا فلا يفسر الحرف بضد موضوعه. ونظير هذا قول من يقول: إن إلا قد تكون بمعنى الواو، وهذا فاسد، فإن الواو للتشريك والجمع وإلا للإخراج وقطع التشريك ونظائر ذلك. وإن أراد أن قطع الربط المتوهم مقصود للمتكلم من أدلة. فهذا حق، ولكن لم ينشأ هذا من حرف لو، وإنما جاء من خصوصية ما صحبها من الكلام المتضمن لنفي ما توهمه القائل أو ادعاه ولم يأت من قبل لو.
فهذا كلام هؤلاء الفضلاء في هذه المسألة، وإنما جاء الإشكال سؤالًا وجوابًا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته. وأنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون الله.
فاعلم أن لو حرف وضع للملازمة بين أمرين، يدل على أن الحرف الأول منهما ملزوم والثاني لازم، هذا وضع هذا الحرف وطبيعته، وموارده في هذه الملازمة فإنه إما أن يلازم بين نفيين أو ثبوتين أو بين ملزوم مثبت ولازم منفي أو عكسه. ونعني بالثبوت والنفي هنا الصوري اللفظي لا المعنوي.
فمثال الأول: { قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذًا لأمسكتم خشية الإنفاق }، [55] { ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما }، [56] { ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد تثبيتًا }، [57] ونظائره.
ومثال الثاني لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي ولو لم يخف الله لم يعصه.
ومثال الثالث: { ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله }. [58]
ومثال الرابع: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فهذه صورة وردوها على النفي والإثبات.
وأما حكم ذلك فأمران:
أحدهما: نفي الأول لنفي الثاني، لأن الأول ملزوم والثاني لازم، والملزوم عدم عند عدم لازمه.
والثاني تحقق الثاني لتحقق الأول، لأن تحقق الملزوم يستلزم تحقق لازمه.
فإذا عرفت هذا، فليس في طبيعة لو ولا وضعها ما يؤذن بنفي واحد من الجزأين ولا إثباته، وإنما طبعها وحقيقتها الدلالة على التلازم المذكور، لكن إنما يؤتى به للتلازم المتضمن نفي اللازم أو الملزوم أو تحققها. ومن هنا نشأت الشبهة فلم يؤت بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزأين أو نفيهما، فإذا دخلت على جزأين متلازمين قد انتفى اللازم منهما. استفيد نفي الملزوم من قضية اللزوم لا من نفس الحرف. وبيان ذلك أن قوله تعالى: { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا }، [59] لم يستفد نفي الفساد من حرف لو، بل الحرف دخل على أمرين قد علم انتفاء أحدهما حسًا فلازمت بينه وبين من يريد نفيه من تعدد الآلهة، وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، فإذا كان اللازم منتف قطعًا وحسًا انتفى ملزومه لانتفائه لا من حيث الحرف.
فهنا أمران؛ أحدهما: الملازمة التي فهمت من الحرف. والثاني انتفاء اللازم المعلوم بالحس. فعلى هذا الوجه ينبغي أن يفهم انتفاء اللازم والملزوم بلو. فمن هنا قالوا: إن دخلت على مثبتين صارا منتفيين بمعنى أن الثاني منهما قد علم انتفاؤه من خارج فينتفي الأول لانتفائه. وإذا دخلت على منفيين أثبتتهما لذلك، أيضا لأنها تدخل على ملزوم محقق الثبوت من خارج فيتحقق ثبوت ملزومه كما في قوله: لو لم تذنبوا فهذا الملزوم وهو صدور الذنب متحقق في الخارج من البشر فتحقق لازمه وهو بقاء النوع الإنساني وعدم الذهاب به، لأن الملازمة وقعت بين عدم الذنب وعدم البقاء، لكن عدم الذنب منتف قطعًا، فانتفى لازمه وهو عدم الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء، وكذلك نفيه الأقسام الأربعة يفهم على هذا الوجه.
وإذا عرف هذا؛ فاللازم الواحد قد يلزم ملزرمات متعددة، كالحيوانية اللازمة للإنسان والفرس وغيرهما، فيقصد المتكلم إثبات الملازمة بين بعض تلك الملزومات، واللازم على تقدير انتفاء البعض الآخر فيكون مقصوده أن الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك الملزوم الآخر، فلا يتوهم المتوهم انتفاء اللازم عند نفي ملزوم معين. فإن الملازمة حاصلة بدونه وعلى هذا يخرجه لو لم يخف الله لم يعصه. ولو لم تكن ربيبتي لما حلت لي فإن عدم المعصية له ملزومات فهي الخشية والمحبة والإجلال، فلو انتفى بعضها وهو الخوف مثلًا لم يبطل اللازم، لأن له ملزومات أخر غيره، وكذلك لو انتفى كون البنت ربيبة لما انتفى التحريم لحصوا الملازمة بينه وبين وصف آخر وهو الرضاع، وذلك الوصف ثابت وهذا القسم، إنما يأتي في لازم له ملزومات متعددة فيقصد المتكلم تحقق الملازمة على تقدير نفي ما نفاه منها.
وأما قوله تعالى: { ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام } [60] فإن الآية سيقت لبيان أن أشجار الأرض. لو كانت أقلامًا والبحار مدادًا فكتبت بها كلمات الله لنفدت البحار والأقلام، ولم تنفد كلمات الله. فالآية سيقت لبيان الملازمة بين عدم نفاد كلماته، وبين كون الأشجار أقلامًا والبحار مدادًا يكتب بها، فإذا كانت الملازمة ثابتة على هذا التقدير الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المكتوب، فثبوتها على غيره من التقادير أولى.
ونوضح هذا بضرب مثل يرتقى منه إلى فهم مقصود الآية. إذا قلت لرجل: لا يعطي أحدًا شيئًا لو أن لك الدنيا بأسرها ما أعطيت أحدًا منها شيئًا. فإنك إذا قصدت أن عدم إعطانه ثابت على أعظم التقادير التي تقتضي الإعطاء، فلازمت بين عدم إعطائه وبين أعظم أسباب الإعطاء، وهو كثرة ما يملكه. فدل هذا على أن عدم إعطائه ثابت على ما هو دون هذا التقدير، وإن عدم الإعطاء لازم لكل تقدير فافهم نظير هذا المعنى في الآية، وهو عدم نفاد كلمات الله تعالى على تقدير أن الأشجار أقلام والبحار مداد يكتب بها. فإذا لم تنفد على هذا التقدير كان عدم نفادها لازمًا له. فكيف بما دونه من التقديرات!
فافهم هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقت ولا تكاد تجدها في الكتب، وإنما هي من فتح الله وفضاله فله الحمد والمنة، ونسأله المزيد من فضله. فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية، وجاءت النصوص بمقتضاهما معًا من غير خروج عن موجب عقل ولا لغة ولا تحريف لنص، ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذه الفائدة لساوت رحلة. فكيف وقد تضمن من غرر الفوائد ما لا ينفق إلا على تُجاره. وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة، والزجاجة المستديرة المثقوبة جوهرة ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق بينهما والله المعين.
المسألة التاسعة: في دخول الشرط على الشرط. ونذكر فيه ضابطًا مزيلًا للأشكال إن شاء الله، فنقول: الشرط الثاني تارة يكون معطوفًا على الأول، وتارة لا يكون، والمعطوف تارة يكون معطوفًا على فعل الشرط وحده، وتارة يعطف على الفعل مع الأداة، فمثال غير المعطوف. إن قمت إن قعدت فأنت طالق. ومثال المعطوف على فعل الشرط وحده إن قمت وقعدت. ومثال المعطوف على الفعل مع الأداة إن قمت وإن قعدت. فهذه الأقسام الثلاثة أصول الباب وهي عشر صور:
أحدها: إن خرجت ولبست فلا يقع المشروط إلا بهما كيفما اجتمعا.
الثانية: إن لبست فخرجت لم يقع المشروط إلا بالخروج بعد اللبس فلو خرجت ثم لبست لم يحنث.
الثالثة: إن لبست ثم خرجت، فهذا مثل الأول وإن كان ثم للتراخي فإنه لا يعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده.
الرابعة: إن خرجت لا إن لبست فيحتمل هذا التعليق أمرين: أحدهما: جعل الخروج شرطًا ونفي اللبس أن يكون شرطًا. الثاني: أن يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن اللبس، والمعنى إن خرجت لا لابسة أي غير لابسة أي غير لابسة، ويكون المعنى إن كان منك خروج لا مع اللبس، فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحدة. وعلى الثاني لا يحنث إلا بخروج لا لبس معه.
الخامسة: إن خرجت، بل إن لبست ويحتمل هذا التعليق أمرين أحدهما: أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به لأجل الإضراب. والثاني: أن يكون كل منهما شرطًا فيحنث بأيهما وجد ويكون الإضراب عن الاقتصار، فيكون اضراب اقتصار لا اضراب إلغاء. كما تقول: أعطه درهمًا بل درهمًا آخر.
السادسة: إن خرجت أو إن لبست فالشرط أحدهما أيهما كان.
السابعة: إن لبست، لكن إن خرجت، فالشرط الثاني وقع لغا الأول لأجل الإستدراك بلكن.
الثامنة: أن يدخل الشرط على الشرط ويكون الثاني معطوفًا بالواو. نحو إن لبست وإن خرجت فهذا يحنث بأحدهما فإن قيل: فكيف لم تحنثوه في صورة العطف على الفعل وحده إلا بهما وحنثتموه ههنا بأيهما كان؟ قيل: لأن هناك جعل الشرط مجموعهما. وهنا جعل كل واحد منهما شرطًا برأسه. وجعل لهما جوابًا واحدًا وفيه رأيان. أحدهما: أن الجواب لهما جميعًا وهو الصحيح. والثاني: أن جواب أحدهما حذف لدلالة المذكور عليه وهي أخت مسألة الخبر عن المبتدإ بجزأين.
التاسعة: أن يعطف الشرط الثاني بالفاء نحو قوله تعالى: { فإما يأتينكم مني هدى }، [61] فالجواب المذكور جواب الشرط الثاني، وهو وجوابه جواب الأول. فإذا قال: إن خرجت فإن كلمت أحدًا فأنت طالق. لم تطلق حتى تخرج وتكلم أحدًا.
العاشرة: وهي أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط على الشرط بلا عطف. نحو إن خرجت، إن لبست واختلف أقوالهم فيها فمن قائل إن المؤخر في اللفظ مقدم في المعنى وإنه لا يحنث حتى يتقدم اللبس على الخروج ومن قائل بل المقدم لفظًا هو المقدم معنى. وذكر كل منهم حججًا لقوله.
وممن نص على المسألة الموفق الأندلسي في شرحه، فقال: إذا دخل الشرط على الشرط وعيد حرف الشرط توقف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول. كقولك: إن أكلت، إن شربت فأنت طالق، فلا تطلق حتى يوجد الشرب منها قبل الأكل، لأنه تعلق على أكل معلق على شرب. وهذا الذي ذكره أبو إسحق في المهذب وحكى ابن شاس في الجواهر عن أصحاب مالك عكسه والوجهان لأصحاب الشافعي.
ولا بد في المسألة من تفصيل وهو أن الشرط الثاني إن كان متأخرًا في الوجود عن الأول كان مقدرًا بالفاء. وتكون الفاء جواب الأول والجواب المذكور جواب الثاني مثاله: إن دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجر تقديره، فإن صليت فيه وحذفت الفاء لدلالة الكلام عليها. وإن كان الثاني متقدمًا في الوجود على الأول فهو في نية التقدم وما قبله جوابه والفاء مقدرة فيه ومثله قوله عز وجل: { ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم }، [62] أي فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. وتقول: إن دخلت المسجد إن توضأت فصل ركعتين. تقديره إن توضأت فإن دخلت المسجد فصل ركعتين. فالشرط الثاني هنا متقدم وإن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود على الآخر، بل كان محتملًا للتقدم والتأخر لم يحكم على أحدهما بتقدم ولا تأخر، بل يكون الحكم راجعًا إلى تقدير المتكلم ونيته فأيهما قدره شرطًا كان الآخر جوابًا له وكان مقدرًا بالفاء. تقدم في اللفظ أو تأخر وإن لم يظهر نيته ولا تقديره احتمل الأمرين فمما ظهر فيه تقديم المتأخر قول الشاعر:
إن تستغيثوا بنا أن تذعروا تجدوا ** منا معاقل عز زانها الكرم
لأن الاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر، ومنه قول ابن دريد:
فإن عثرت بعدها إن وألت ** نفسي من هاتا فقولا لا لعا
ومعلوم أن العثور مرة ثانية إنما يكون بعد الذعر. ومن المحتمل قوله تعالى: { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين }، [63] يحتمل أن تكون الهبة شرطًا، ويكون فعل الإرادة جوابًا له ويكون التقدير إن وهبت نفسها للنبي. فإن أراد النبي أن يستنكحها فخالصة له ويحتمل أن تكون الإرادة شرطًا والهبة جوابًا له، والتقدير إن أراد النبي أن يستنكحها فإن وهبت نفسها فهي خالصة له يحتمل الأمرين. فهذا ما ظهر لي من التفصيل في هذه المسألة وتحقيقها. والله أعلم.
فائدة عظيمة المنفعة: تقديم بعض الألفاظ الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب
قال سيبويه: الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب تقول: صمت رمضان وشعبان وإن شئت شعبان ورمضان بخلاف الفاء، وثم إلا أنهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم، وهم ببيانه أعني وإن كانا جميعًا يهمانهم ويغنيانهم هذا لفظه.
قال السهيلي: وهو كلام مجمل يحتاج إلى بسط وتبيين فيقال: متى يكون أحد الشيئين أحق بالتقدم ويكون المتكلم ببيانه أعنى.
قال: والجواب أن هذا الأصل يجب الاعتناء به لعظم منفعته في كتاب الله وحديث رسوله، إذ لا بد من الوقوف على الحكمة في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر نحو السميع والبصير والظلمات والنور والليل والنهار والجن والإنس في الأكثر، وفي بعضها الإنس والجن وتقديم السماء على الأرض في الذكر، وتقديم الأرض عليها في بعض الآي ونحو سميع عليم ولم يجيء علهيم سميع، وكذلك عزيز حكيم وغفور رحيم. وفي موضع واحد الرحيم الغفور إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر، وليس شيء من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة، لأنه كلام الحكيم الخبير وسنقدم بين يدي الخوض في هذا الغرض أصلًا يقف بك على الطريق الأوضح.
فنقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدم المعاني في الجنان، والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان، وإما بالطبع، وإما بالرتبة، وإما بالسبب، وإما بالفضل والكمال، فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخفة والثقل بأحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرها. سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق وكان ترتب الألفاظ بحسب ذلك نعم، وربما كان ترتب الألفاظ بحسب الخفة والثقل، لا بحسب المعنى كقولهم: ربيعة ومضر وكان تقديم مضر أولى من جهة الفضل، ولكن آثروا الخفة لأنك لو قدمت مضر في اللفظ كثرت الحركات وتوالت، فلما أخرت وقف عليها بالسكون.
قلت: ومن هذا النحو الجن والإنس، فإن لفظ الإنس أخف لمكان النون الخفيفة والسين المهموسة. فكان الأثقل أولى بأول الكلام من الأخف لنشاط المتكلم وجمامه. وأما في القرآن فلحكمة أخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الأكثر والأغلب وسنشير إليها في آخر الفصل إن شاء الله.
أما ما تقدم بتقدم الزمان فكعاد وثمود والظلمات والنور، فإن الظلمة سابقة للنور في المحسوس والمعقول وتقدمها في المحسوس معلوم بالخبر المنقول، وتقدم الظلمة المعقولة معلوم بضرورة العقل قال سبحانه: { والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة }، [64] فالجهل ظلمة معقولة وهي متقدمة بالزمان على نور العلم ولذلك قال تعالى: { في ظلمات ثلاث }. [65] فهذه ثلاث محسوسات ظلمة الرحم وظلمة البطن وظلمة المشيمة. وثلاث معقولات وهي عدم الادراكات الثلاثة المذكورة في الآية المتقدمة إذ لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع، وفي الحديث: «إن الله خلق عباده في ظلمة، ئم ألقى عليهم من نوره». [66]
ومن المتقدم بالطبع نحو مثنى وثلاث ورباع ونحو: { ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم }، [67] الآية.
وما يتقدم من الأعداد بعضها على بعض إنما يتقدم بالطبع كتقدم الحيوان على الإنسان والجسم على الحيوان. ومن هذا الباب تقدم العزيز على الحكيم، لأنه عز فلما عز حكم. وربما كان هذا من تقدم السبب على المسبب ومثله كثير في القرآن نحو: { يحب التوابين ويحب المتطهرين }، [68] لأن التوبة سبب الطهارة. وكذلك: { كل أفاك أثيم }، [69] لأن الإفك سبب الإثم، وكذلك: { كل معتد أثيم }. [70]
وأما تقدم هماز على مشاء بنميم، فبالرتبة لأن المشي مرتب على القعود في المكان. والهماز هو العياب، وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه بخلاف النميمة.
وأما تقدم مناع للخير على معتد، فبالرتبة أيضا، لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره ونفسه قبل غيره.
ومن المقدم بالرتبة: { يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر } [71] لأن الذي يأتي راجلًا يأتي من المكان القريب، والذي يأتي على الضامر يأتي من المكان البعيد. على أنه قد روى عن ابن عباس أنه قال: وددت أني حججت راجلًا لأن الله قدم الرجالة على الركبان، في القرآن فجعله ابن عباس من باب تقدم الفاضل على المفضول، والمعنيان موجودان، وربما قدم الشيء لثلاثة معان وأربعة وخمسة، وربما قدم لمعنى واحد من الخمسة.
ومما قدم للفضل والشرف: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم }، [72] وقوله: النبيين والصديقين ومنه تقديم السميع على البصير وسميع على بصير، ومنه تقديم الجن على الإنس في أكثر المواضع، لأن الجن تشتمل على الملائكة وغيرهم، مما اجتن عن الإبصار قال تعالى: { وجعلوا بينه وبين الجنة نسبًا } [73] وقال الأعشى:
وسخر من جن الملائك سبعة ** قيامًا لديه يعملون بلا أجر
وأما قوله تعالى: { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان }، [74] وقوله: { لا يُسئل عن ذنبه إنس ولا جان }، [75] وقوله: { ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبًا }، [76] فإن لفظ الجن ههنا لا يتناول الملائكة بحال لنزاهتهم عن العيوب، وأنهم لا يتوهم عليهم الكذب ولا سائر الذنوب، فلما لم يتناولهم عموم لفظ لهذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم.
وأما تقديم السماء على الأرض فبالرتبة أيضا، وبالفضل والشرف.
وأما تقديم الأرض في قوله: { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء }، [77] فبالرتبة أيضا، لأنها منتظمة بذكر ما هي أقرب إليه وهم المخاطبون بقوله: { ولا تعملون من عمل } [78] فاقتضى حسن النظم تقديمها مرتبة في الذكر مع المخاطبين الذين هم أهلها بخلاف الآية التي في سبأ، فإنها منتظمة بقوله عالم الغيب.
وأما تقديمه المال على الولد في كثير من الآي فلأن الولد بعد وجود المال نعمة ومسرة، وعند الفقر وسوء الحال هم ومضرة، فهذا من باب تقديم السبب على المسبب، لأن المال سبب تمام النعمة بالولد.
وأما قوله: حب الشهوات من النساء والبنين. فتقديم النساء على البنين بالسبب، وتقدم الأموال على البنين بالرتبة.
ومما تقدم بالرتبة ذكر السمع والعلم حيث وقع، فإنه خبر يتضمن التخويف والتهديد، فبدأ بالسمع لتعلقه بما قرب كالأصوات وهمس الحركات، فإن من سمع حِسَّك وخَفيَّ صوتِك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك إنه يعلم، وإن كان علمه تعالى متعلقًا بما ظهر وبطن وواقعًا على ما قرُب وشَطَن، ولكن ذكر السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم، فهو أولى بالتقديم.
وأما تقديم الغفور على الرحيم فهو أولى بالطبع، لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة تطلب قبل الغنيمة. وفي الحديث أن النبي ﷺ قال لعمرو بن العاص: «ابعثك وجهًا يسلمك الله فيه ويغنمك وارغب لك رغبة من المال»، فهذا من الترتيب البديع بدأ بالسلامة قبل الغنيمة وبالغنيمة قبل الكسب.
وأما قوله: وهو الرحيم الغفور في سبأ فالرحمة هناك متقدمة على المغفرة، فإما بالفضل والكمال، وإما بالطبع، لأنها منتظمة بذكر أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان. فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصهم والعموم بالطبع قبل الخصوص كقوله: { فاكهة ونخل ورمان }، [79] وكقوله: { وملائكته ورسله وجبريل وميكال }. [80]
ومما قدم بالفضل قوله: { واسجدي واركعي مع الراكعين }، [81] لأن السجود أفضل وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة، لأنه انتقال من علو إلى انخفاض، والعلو بالطبع قبل الانخفاض، فهلا قدم الركوع؟ فالجواب أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: { اركعي مع الراكعين }، ولم يقل اسجدي مع الساجدين، فإنما عبر بالسجود عن الصلاة وأراد صلاتها في بيتها، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع قومها. ثم قال لها: اركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين في بيت المقدس، ولم يرد أيضا الركوع وحده دون أجزاء الصلاة، ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة، كما تقول: ركعت ركعتين وأربع ركعات، يريد الصلاة لا الركوع بمجرده؛ فصارت الآية متضمنة لصلاتين: صلاتها وحدها، عبر عنها بالسجود لأن السجود أفضل حالات العبد، وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، ثم صلاتها في المسجد عبر عنها بالركوع، لأنه في الفضل دون السجود، وكذلك صلاتها مع المصلين دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابها. وهذا نظم بديع وفقه دقيق وهذه نبذ تشير لك إلى ما وراء أو تنبذك وأنت صحيح بالعراء.
قالوا: ومما يليق ذكره بهذا الباب قوله: { وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود }. [82] بدأ بالطائفين للرتبة والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافين، وجمعهم جمع السلامة، لأن جمع السلامة أدل على لفظ الفعل الذي هو علة تعلق بها حكم التطهير، ولو كان مكان الطائفين الطواف لم يكن في هذا اللفظ من بيان قصد الفعل ما في قوله للطائفين ألا ترى أنك تقول: تطوفون، كما تقول: طائفون، فاللفظان متشابهان.
فإن قيل: فهلا أتى بلفظ الفعل بعينه فيكون أبين، فيقول: وطهر بيتي للذين يطوفون.
قيل: إن الحكم يعلل بالفعل لا بذوات الأشخاص، ولفظ الذين ينبىء عن الشخص والذات، ولفظ الطواف يخفي معنى الفعل ولا يبينه فكان لفظ الطائفين أولى بهذا الموطن.
ثم يليه في الترتيب والقائمين، لأنه في معنى العاكفين وهو في معنى قوله: { إلا ما دمت عليه قائمًا } [83] أي مثابرًا ملازمًا، وهو كالطائفين في تعلق حكم التطهر به. ثم يليه بالرتبة لفظ الراكع، لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يختصمون بما قرب منه كالطائفين والعاكفين، ولذلك لم يتعلق حكم التطهير بهذا الفعل الذي هو الركوع وإنه لا يلزم أن يكون في البيت ولا عنده، فلذلك لم يجىء بلفظ جمع السلامة لأنه لا يحتاج فيه إلى بيان لفظ الفعل، كما احتيج فيما قبله.
ثم وصف الركع بالسجود ولم يعطف بالواو كما عطف ما قبله لأن الركع هم السجود. والشيء لا يعطف بالواو على نفسه ولفائدة أخرى وهو أن السجود أغلب ما يجيء عبارة عن المصدر، والمراد به ههنا الجمع، فلو عطف بالواو لتوهم أنه يريد السجود الذي هو المصدر دون الاسم الذي هو النعت. وفائدة ثالثة أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حكم الشريعة، فلو عطفت ههنا بالواو لتوهم أن الركوع حكم يجري على حياله.
فإن قيل: فلم قال السجود على وزن فعول ولم يقل السجد كالركع، وفي آية أخرى ركعًا سجدًا ولم جمع ساجد على السجود ولم يجمع راكع على ركوع.
فالجواب أن السجود في الأصل مصدر كالخشوع والخضوع، وهو يتناول السجود الظاهر والباطن. ولو قال: السجد في جمع ساجد لم يتناول إلا المعنى الظاهر، وكذلك الركع ألا تراه يقول: تراهم ركعًا سجدًا وهذه رؤية العين وهي لا تتعلق إلا بالظاهر. والمقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على ما قبله مما يراد به قصد البيت والبيت لا يتوجه إليه إلا بالعمل الظاهر. وأما الخشوع والخضوع الذي يتناوله لفظ الركوع دون لفظ الركع، فليس مشروطًا بالتوجه إلى البيت، وأما السجود فمن حيث أنبأ عن المعنى الباطن جعل وصفًا للركع ومتممًا لمعناه، إذ لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود الباطن ومن حيث تناول لفظه. أيضا السجود الظاهر الذي يشترط فيه التوجه إلى البيت حسن انتظامه أيضا مع ما قبله مما هو معطوف على الطائفين الذين ذكرهم بذكر البيت، فمن لحظ هذه المعاني بقلبه وتدبر هذا النظم البديع بلبه ارتفع في معرفة الإعجاز عن التقليد، وأبصر بعين اليقين أنه تنزيل من حكيم حميد تم كلامه.
قلت: وقد تولج رحمة الله مضائق تضايق عنها أن تولجها الإبر وأتى بأشياء حسنة وبأشياء غيرها أحسن منها.
فأما تعليله تقديم ربيعة على مضر ففي غاية الحسن وهذان الاسمان لتلازمهما في الغالب صارا كاسم واحد فحسن فيهما ما ذكره.
وأما ما ذكره في تقديم الجن على الإنس من شرف الجن فمستدرك عليه، فإن الإنس أشرف من الجن من وجوه عديدة قد ذكرناها في غير هذا الموضع.
وأما قوله: إن الملائكة منهم أو هم أشرف، فالمقدمتان ممنوعتان. أما الأول فلأن أصل الملائكة ومادتهم التي خلقوا منها هي النور، كما ثبت ذلك مرفوعًا عن النبي ﷺ في صحيح مسلم. وأما الجان فمادتهم النار بنص القرآن ولا يصح التفريق بين الجن والجان لغة ولا شرعًا ولا عقلًا. وأما المقدمة الثانية وهي كون الملائكة خيرًا وأشرف من الإنس فهي المسألة المشهورة وهي تفضيل الملائكة أو البشر والجمهور على تفضيل البشر. والذين فضلوا الملائكة هم المعتزلة والفلاسفة وطائفة ممن عداهم، بل الذي ينبغي أن يقال في التقديم هنا إنه تقديم بالزمان لقوله تعالى: { ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون * والجان خلقناه من قبل من نار السموم }. [84]
وأما تقديم الإنس على الجن في قوله: { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان }، [85] فلحكمة أخرى سوى ما ذكره، وهو أن النفي تابع لما تعقله القلوب من الاثبات فيرد النفي عليه، وعلم النفوس بطمث الإنس ونفرتها ممن طمثها الرجال هو المعروف. فجاء النفي على مقتضى ذلك. وكان تقديم الإنس في هذا النفي أهم.
وأما قوله: { وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا فهذا يعرف سره من السياق، فإن هذا حكاية كلام مؤمني الجن حين سماع القرآن كما قال تعالى: { قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عجبًا } [86] الآيات. وكان القرآن أول ما خوطب به الإنس ونزل على نبيهم وهم أول من بدأ بالتصديق والتكذيب قبل الجن فجاء قول مؤمني الجن: { وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا } [87] بتقديم الإنس لتقدمهم في الخطاب بالقرآن، وتقديمهم في التصديق والتكذيب.
وفائدة ثالثة وهي أن هذا حكاية كلام مؤمني الجن لقولهم بعد أن رجعوا إليهم بأنهم لم يكونوا يظنون أن الإنس والجن يقولون على الله كذبًا، فذكرهم الإنس هنا في التقديم أحسن في الدعوة وأبلغ في عدم التهمة، فإنهم خالفوا ما كانوا يسمعونه من الإنس والجن لما تبين لهم كذبهم فبدأتهم بذكر الإنس أبلغ في نفي الغرض والتهمة وأن لا يظن بهم قومهم أنهم ظاهروا الإنس عليهم، فإنهم أول ما أقروا بتقولهم الكذب على الله، وهذا من ألطف المعاني وأدقها، ومن تأمل مواقعه في الخطاب عرف صحته.
وأما تقديم عاد على ثمود حيث وقع في القرآن فما ذكره من تقدمهم بالزمان فصحيح. وكذلك الظلمات والنور. وكذلك مثنى وبابه.
وأما تقديم العزيز على الحكيم فإن كان من الحكم وهو الفصل والأمر، فما ذكره من المعنى صحيح، وإن كان من الحكمة وهي كمال العلم والإرادة المتضمنين اتساق صنعه وجريانه على أحسن الوجوه وأكملها. ووضعه الأشياء مواضعها وهو الظاهر من هذا الاسم، فيكون وجه التقديم أن العزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وهو سبحانه الموصوف من كل صفة كمال بأكملها وأعظمها وغايتها، فتقدم وصف القدرة لأن متعلقه أقرب إلى مشاهدة الخلق وهو مفعولاته تعالى وآياته. وأما الحكمة فمتعلقها بالنظر والفكر والاعتبار غالبًا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. ووجه ثان أن النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم به، فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه من الحكم والمعاني. ووجه ثالث أن الحكمة غاية الفعل، فهي متأخرة عنه تأخر الغايات عن وسائلها، فالقدرة تتعلق بإيجاده. والحكمة تتعلق بغايته فقدم الوسيلة على الغاية، لأنها أسبق في الترتيب الخارجي.
وأما قوله تعالى: { يحب التوابين ويحب المتطهرين }، [88] ففيه معنى آخر سوى ما ذكره. وهو أن الطهر طهران طهر بالماء من الأحداث والنجاسات وطهر بالتوبة من الشرك والمعاصي، وهذا الطهور أصل لطهور الماء وطهور الماء لا ينفع بدونه، بل هو مكمل له معد مهيىء بحصوله فكان أولى بالتقديم، لأن العبد أول ما يدخل في الإسلام فقد تطهر بالتوبة من الشرك ثم يتطهر بالماء من الحدث.
وأما قوله: { كل أفاك أثيم }، [89] فالإفك هو الكذب وهو في القول والإثم هو الفجور وهو في الفعل. والكذب يدعو إلى الفجور كما في الحديث الصحيح أن الكذب يدعو إلى الفجور، وأن الفجور يدعو إلى النار، فالذي قاله صحيح.
وأما كل معتد أثيم ففيه معنى ثاني غير ما ذكره وهو أن العدوان مجاوزة الحد الذي حد للعبد فهو ظلم في القدر والوصف. وأما الإثم فهو محرم الجنس ومن تعاطى تعدى الحدود تخطى إلى الجنس الآخر وهو الإثم. ومعنى ثالث وهو أن المعتدي الظالم لعباد الله عدوانًا عليهم، والأثيم الظالم لنفسه بالفجور فكان تقديمه هنا على الأثيم أولى، لأنه في سياق ذمه والنهي عن طاعته. فمن كان معتديًا على العباد ظالمًا لهم فهو أحرى بأن لا تطيعه وتوافقه. وفيه معنى رابع وهو أنه قدمه على الأثيم ليقترن بما قبله وهو وصف المنع للخير، فوصفه بأنه لا خير فيه للناس وأنه مع ذلك معتد عليهم، فهو متأخر عن المناع لأنه يمنع خيره أولًا، ثم يعتدي عليهم ثانيًا، ولهذا يحمد الناس من يوجد لهم الراحة ويكف عنهم الأذى وهذا هو حقيقة التصوف وهذا لا راحة يوجدها ولا أذى يكفه.
وأما تقديم هماز على مشاء بنميم ففيه معنى آخر غير ما ذكره، وهو أن همزه عيب للمهموز وإزراء به وإظهار لفساد حاله في نفسه فإن قاله يختص بالمهموز لا يتعداه إلى غيره. والمشي بالنميمة يتعداه إلى من ينم عنده فهو ضرر متعد والهمز ضرره لازم للمهموز. إذا شعر به ما ينقل من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدي المنتشر.
وأما تقديم الرجال على الركبان ففيه فائدة جليلة وهي أن الله شرط في الحج الاستطاعة، ولا بد من السفر إليه لغالب الناس، فذكر نوعي الحجاج لقطع توهم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب. وقدم الرجال اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدًا. ومن الناس من يقول: قدمهم جبرًا لهم، لأن نفوس الركبان تزدريهم وتوبخهم. وتقول: إن الله لم يكتبه عليكم ولم يرده منكم، وربما توهموا أنه غير نافع لهم، فبدأ بهم جبرًا لهم ورحمة.
وأما تقديم غسل الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم الرجلين في الوضوء، فمن يقول إن هذا الترتيب واجب هو الشافعي وأحمد ومن وافقهما. فالآية عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقرائن عديدة.
أحدها: أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره، ولو أريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات متسقة في النظم والممسوح بعدها، فلما عدل إلى ذلك دل على وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله.
الثاني: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء، فدخلت الواو عاطفة لإجزائه بعضها إلى بعض. والفعل الواحد يحصل من ارتباط أجزائه بعضها ببعض. فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت الترتيب إذ هو الربط المذكور في الآية، ولا يلزمه من كونها لا تفيد الترتيب بين أفعال لا ارتباط بينهما، نحو: { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة }، [90] أن لا تفيده بين أجزاء فعل مرتبطة بعضها ببعض. فتأمل هذا الموضع ولطفه. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في إفادة الواو للترتيب وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه. وهو قول ابن أبي موسى من أصحاب أحمد ولعله أرجح الأقوال.
الثالث: أن لبداءة الرب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء خاصة فيجب مراعاتها، وأن لا تلغى وتهدر فيهدر ما اعتبره الله ويؤخر ما قدمه الله. وقد أشار النبي ﷺ إلى أن ما قدمه الله. فإنه ينبغي تقديمه ولا يؤخر، بل يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله. فلما طاف بين الصفا والمروة. بدأ بالصفا وقال: «نبدأ بما بدأ الله به»، وفي رواية للنسائي: «ابدؤا بما بدأ الله به» على الأمر، فتأمل بداءته بالصفا معللًا ذلك، يكون الله بدأ به. فلا ينبغي تأخيره، وهكذا يقول المرتبون للوضوء: سواء نحن نبدأ بما بدأ الله به ولا يجوز تأخير ما قدمه الله. ويتعين البداءة بما بدأ الله به، وهذا هو الصواب لمواظبة المبين عن الله مراده ﷺ على الوضوء المرتب، فاتفق جميع من نقل عنه وضوءه كلهم على إيقاعه مرتبًا ولم ينقل عنه أحد قط. أنه أخل بالترتيب مرة واحدة فلو كان الوضوء المنكوس مشروعًا لفعله، ولو في عمره مرة واحدة لتبين جوازه لأمته وهذا بحمد الله أوضح.
وأما تقديم النبيين على الصديقين فلما ذكره، ولكون الصديق تابعًا للنبي فإنما استحق اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي فهو تابع محض. وتأمل تقديم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم، وتقديم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم.
وأما تقديم السمع على البصر فهو متقدم عليه حيث وقع في القرآن مصدرًا أو فعلًا أو اسمًا. فالأول كقوله تعالى: { إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا }، [91] الثاني كقوله تعالى: { إنني معكما أسمع وأرى }، [92] والثالث كقوله تعالى: { سميع بصير }، [93] { إنه هو السميع البصير }، [94] { وكان الله سميعًا بصير } [95] فاحتج بهذا من يقول إن السمع أشرف من البصر وهذا قول الاكثرين، وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي، وحكوا هم وغيرهم عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل ونصبوا معهم الخلاف وذكروا الحجاج من الطرفين. ولا أدري ما يترتب على هذه المسألة من الأحكام حتى تذكر في كتب الفقه! وكذلك القولان للمتكلمين والمفسرين وحكى أبو المعالي عن ابن قتيبة: تفضيل البصر ورد عليه. واحتج مفضلو السمع بأن الله تعالى يقدمه في القرآن حيث وقع وبأن بالسمع تنال سعادة الدنيا والآخرة. فإن السعادة بأجمعها في طاعة الرسل والإيمان بما جاءوا به، وهذا إنما يدرك بالسمع. ولهذا في الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث الأسود بن سريع: ثلاثة كلهم يدلي على الله بحجته يوم القيامة فذكر منهم رجلًا أصم يقول: يا رب لقد جاء الإسلام وأنا لا أسمع شيئًا واحتجوا بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم الحاصلة من البصر. فإن البصر لا يدرك إلا بعض الموجودات المشاهدة بالبصر القريبة، والسمع يدرك الموجودات والمعدومات والحاضر والغائب والقريب والبعيد والواجب والممكن والممتنع، فلا نسبة لإدراك البصر إلى إدراكه. واحتجوا بأن فقد السمع يوجب ثلم القلب واللسان، ولهذا كان الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب. وأما فقد البصر فربما كان معينًا على قوة إدراك البصيرة وشدة ذكائها. فإن نور البصر ينعكس إلى البصيرة باطنًا فيقوى إدراكها ويعظم، ولهذا تجد كثيرًا من العميان أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقاد والفطنة، وضياء الحس الباطن، ما لا تكاد تجده عند البصير. ولا ريب أن سفر البصر في الجهات والأقطار ومباشرته للمبصرات على اختلافها يوجب تفرق القلب وتشتيته. ولهذا كان الليل أجمع للقلب والخلوة أعون على إصابة الفكرة. قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصر، ولهذا كثير في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى ولم يعرف فيهم واحد أطرش بل لا يعرف في الصحابة أطرش. فهذا ونحوه من احتجاجهم على تفضيل البصر.
قال منازعوهم: يفصل بيننا وبينكم أمران.
أحداهما: أن مدرك البصر النظر إلى وجه الله تعالى في الدار الآخرة، وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم. ولا شيء أكمل من المنظور إليه سبحانه فلا حاسة في العبد أكمل من حاسة تراه بها.
الثاني: أن هذا النعيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة السمع فكان السمع كالوسلية لهذا المطلوب الأعظم. فتفضليه عليه كفضيلة الغايات على وسائلها.
وأما ما ذكرتم من سعة إدراكاته وعمومها فيعارضه كثرة الخيانة فيها ووقوع الغلط. فإن الصواب فيما يدركه السمع بالإضافة إلى كثرة المسموعات قليل في كثير ويقابل كثير مدركاته صحة مدركات البصر وعدم الخيانة. وإنما يراه ويشاهده لا يعرض فيه من الكذب ما يعرض فيه فيما يسمعه، وإذا تقابلت المرتبتان بقي الترجيح بما ذكرناه.
قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه: وفصل الخطاب أن إدراك السمع أعم وأشمل وإدراك البصر أتم وأكمل فهذا له التمام والكمال. وذاك له العموم والشمول، فقد ترجح كل منهما على الآخر بما اختص به. تم كلامه.
وقد ورد في الحديث المشهور أن النبي ﷺ قال لأبي بكر وعمر: «هذان السمع والبصر» وهذا يحتمل أربعة أوجه.
أحدها: أن يكون المراد أنهما مني بمنزلة السمع والبصر.
والثاني أن يريد أنهما من دين الاسلام بمنزلة السمع والبصر من الإنسان، فيكون الرسول ﷺ بمنزلة القلب والروح. وهما بمنزلة السمع والبصر من الدين. وعلى هذا فيحتمل وجهين.
أحدهما: التوزيع فيكون أحدهما بمنزلة السمع والآخر بمنزلة البصر.
والثاني: الشركة فيكون هذا التنزيل والتشبيه بالحاستين ثابتًا لكل واحد منهما، فكل منهما بمنزلة السمع والبصر فعلى احتمال التوزيع والتقسيم تكلم الناس. أيهما هو السمع وأيهما هو البصر؟ وبنوا ذلك على أي الصفتين أفضل. فهي صفة الصديق.
والتحقيق أن صفة البصر للصديق وصفة السمع للفاروق. ويظهر لك هذا من كون عمر محدثًا كما قال النبي ﷺ: «قد كان في الإمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة أحد فعمر»، والتحديث المذكور هو ما يلقى في القلب من الصواب والحق وهذا طريقة السمع الباطن وهو بمنزلة التحديث والإخبار في الأذن. وأما الصديق فهو الذي كمل مقام الصديقية لكمال بصيرته، حتى كأنه قد باشر بصره مما أخبر به الرسول ما باشر قلبه فلم يبق بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب، فهو كأنه ينظر إلى ما أخبر به من الغيب من وراء ستوره، وهذا لكمال البصيرة وهذا أفضل مواهب العبد وأعظم كراماته التي يكرم بها، وليس بعد درجة النبوة إلا هي ولهذا جعلها سبحانه بعدها فقال: { ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين } [96] وهذا هو الذي سبق به الصديق لا بكثرة صوم ولا بكثرة صلاة. وصاحب هذا يمشي رويدًا ويجيء في الأول. ولقد تعنى من لم يكن سيره على هذا الطريق وتشميره إلى هذا العلم، وقد سبق من شمر إليه وإن كان يزحف زحفًا ويحبو حبوًا، ولا تستطل هذا الفصل فإنه أهم مما قصد بالكلام فليعد إليه.
فقيل: تقديم السمع على البصر له سببان:
أحدهما: أن يكون السياق يقتضيه بحيث يكون ذكرها بين الصفتين متضمنًا للتهديد والوعيد كما جرت عادة القرآن بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التي تقتضي الحذر والاستقامة كقوله: { فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم }، [97] وقوله: { من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعًا بصيرًا }، [98] والقرآن مملوء من هذا وعلى هذا، فيكون في ضمن ذلك أني أسمع ما يردون به عليك وما يقابلون به رسالاتي وأبصر ما يفعلون.
ولا ريب أن المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان.
أحدهما: قابلوها بقولهم صدقت ثم عملوا بموجبها.
والثاني: قابلوها بالتكذيب ثم عملوا بخلافها، فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة البصر. فقدم ما يتعلق به على ما يتعلق بالمبصر. وتأمل هذا المعنى في قوله تعالى لموسى: { إنني معكما أسمع وأرى } [99] هو يسمع ما يجيبهم به، ويرى ما يصنعه. وهذا لا يعم سائر المواضع، بل يختص منها بما هذا شأنه.
والسبب الثاني أن إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام مع غاية البعد بين السامع والمسموع أشد من إنكارها لرؤيته مع بعده.
وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول. فقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. ولم يقولوا: أترون الله يرانا، فكان تقديم السمع أهم والحاجة إلى العلم به أمس.
وسبب ثالث وهو أن حركة اللسان بالكلام أعظم حركات الجوارح وأشدها تأثيرًا في الخير والشر والصلاح والفساد، بل عامة ما يترتب في الوجود من الأفعال إنما ينشأ بعد حركة اللسان. فكان تقديم الصفة المتعلقة به أهم وأولى وبهذا يعلم تقديمه على العليم حيث وقع.
وأما تقديم السماء على الأرض ففيه معنى آخر غير ما ذكره، وهو أن غالبًا تذكر السمرات والأرض في سياق آيات الرب الدالة على وحدانيته وربوبيته، ومعلوم أن الآيات في السموات أعظم منها في الأرض لسعتها وعظمها وما فيها من كواكبها وشمسها وقمرها وبروجها وعلومها واستغنائها عن عمد تقلها، أو علاقة ترفعها إلى غير ذلك من عجائبها التي الأرض وما فيها كقطرة في سعتها، ولهذا أمر سبحانه بأن يرجع الناظر البصر فيها كرة بعد كرة، ويتأمل استواءها واتساقها وبراءتها من الخلل والفطور. فالآية فيها أعظم من الأرض، وفي كل شيء له آية سبحانه وبحمده.
وأما تقديم الأرض عليها في قوله: { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء }، [100] وتأخيرها عنها في سبأ فتأمل. كيف وقع هذا الترتيب في سبأ في ضمن قول الكفار: { لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض } [101] كيف قدم السموات هنا، لأن الساعة إنما تأتي من قبلها وهي غيب فيها ومن جهتها تبتدىء وتنشأ، ولهذا قدم صعق أهل السموات على أهل الأرض عندها فقال تعالى: { ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض }. [102]
وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يونس فإنه لما كان السياق سياق تحذير وتهديد للبشر وإعلامهم أنه سبحانه عالم بأعمالهم دقيقها وجليلها، وإنه لا يغيب عنه منها شيء. اقتضى ذلك ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء فتبارك من أودغ كلامه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه كلام الله وإن مخلوقًا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا.
وأما تقديم المال على الولد فلم يطرد في القرآن، بل قد جاء مقدمًا كذلك في قوله: { وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم }، [103] وقوله: { إنما أموالكم وأولادكم فتنة }، [104] وقوله: { لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله }، [105] وجاء ذكر البنين مقدمًا كما في قوله: { قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها }، [106] وقوله: { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة }. [107] فأما تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة فلأنها ينتظمها معنى واحد وهو التحذير من الاشتغال بها، والحرص على تحصيلها حتى يفوته حظه من الله والدار الآخرة. فهي في موضع الالتهاب بها وأخبر في موضع أنها فتنة وأخبر في موضع آخر أن الذي يقرب عباده إليه إيمانهم وعملهم الصالح لا أموالهم ولا أولادهم ففي ضمن هذا النهي عن الاشتغال بها عما يقرب إليه. ومعلوم أن اشتغال الناس بأموالهم والتلاهي بها، أعظم من اشتغالهم بأولادهم، وهذا هو الواقع حتى أن الرجل ليستغرقه اشتغاله بما له عن مصلحة ولده وعن معاشرته وقربه. وأما تقديمهم على الأموال في تينك الآيتين فلحكمة باهرة وهي أن براءة متضمنة لوعيد من كانت تلك الأشياء المذكورة فيها أحب إليه من الجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن تصور المجاهد فراق أهله وأولاده وآبائه وإخوانه وعشيرته تمنعه من الخروج عنهم أكثر مما يمنعه مفارقته ماله، فإن تصور مع هذا أن يقتل فيفارقهم فراق الدهر، نفرت نفسه عن هذه أكثر وأكثر، ولايكاد عند هذا التصور يخطر له مفارقة ماله بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة المال، فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم المال.
وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدم وتأخير ما أخر يطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته. فبدأ أولا بذكر أصول العبد وهم آباؤه المتقدمون طبعًا وشرفًا ورتبة، وكان فخرًا لقوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم عن أنفسهم وأموالهم، وحتى عن أبنائهم. ولهذا حملتهم محاماتهم عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسبي الذرية ولايشهدون على آبائهم بالكفر والنقيصة ويرغبون عن دينهم لما في ذلك من ازرائهم بهم، ثم ذكر الفروع وهم الأبناء لأنهم يتلونهم في الرتبة وهم أقرب أقاربهم إليهم وأعلق بقلوبهم وألصق بأكبادهم من الإخوان والعشيرة، ثم ذكر الإخوان وهم الكلالة وحواشي النسب، فذكر الأصول أولًا، ثم الفروع ثانيًا، ثم النظراء ثالثًا، ثم الأزواج رابعًا. لأن الزوجة أجنبية عنده ويمكن أن يتعوض عنها بغيرها، وهي إنما تراد للشهوة، وأما الأقارب من الآباء والأبناء والإخوان فلا عوض عنهم ويرادون للنصرة والدفاع. وذلك مقدم على مجرد الشهوة، ثم ذكر القرابة البعيدة. خامسًا: وهي العشيرة وبنو العم، فإن عشائرهم كانوا بني عمتهم غالبًا. وإن كانوا أجانب فأولى بالتأخير، ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسًا: ووصفها بكونها مقترفة أي مكتسبة، لأن القلوب إلى ما اكتسبته من المال أميل، وله أحب وبقدره أعرف لما حصل له فيه من التعب والمشقة، بخلاف مال جاء عفوًا بلا كسب من ميراث أو هبة أو وصية، فإن حفظه للأول ومراعاته له وحرصه على بقائه أعظم من الثاني والحس شاهد بهذا، وحسبك به، ثم ذكر التجارة سابعًا لأن محبة العبد للمال أعظم من محبته للتجارة التي يحصله بها، فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقترف. فقدم المال على التجارة تقديم الغايات على وسائلها، ثم وصف التجارة بكونها مما يخشى كسادها، وهذا يدل على شرفها وخطرها وإنه قد بلغ قدرها إلى أنها مخوفة الكساد، ثم ذكر الأوطان ثامنًا آخر المراتب، لأن تعلق القلب بها دون تعلقه بسائر ما تقدم، فإن الأوطان تتشابه. وقد يقوم الوطن الثاني مقام الأول من كل وجه ويكون خيرًا منه فمنها عوض. وأما الآباء والأبناء والأقارب والعشائر فلا يتعوض منها بغيرها. فالقلب وإن كان يحن إلى وطنه الأول فحنينه إلى آبائه وأبنائه وزوجاته أعظم. فمحبة الوطن آخر المراتب وهذا هو الواقع. إلا لعارض يترجح عنده إيثار البعيد على القريب، فذلك جزئي لا كلي فلا تناقض به. وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع.
وأما آية آل عمران فإنها لما كانت في سياق الإخبار بما زين للناس من الشهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بها قدم ما تعلق الشهوة به أقوى والنفس إليه أشد سعرًا، وهو النساء التي فتنتهن أعظم فتن الدنيا. وهي القيود التي حالت بين العباد وبين سيرهم إلى الله، ثم ذكر البنين المتولدين منهم فالإنسان يشتهي المرأة للذة والولد، وكلاهما مقصود له لذاته، ثم ذكر شهوة الأموال لأنها تقصد لغيرها، فشهوتها شهوة الوسائل. وقدم أشرف أنواعها وهو الذهب، ثم الفضة بعده، ثم ذكر الشهوة المتعلقة بالحيوان الذي لا يعاشر عشرة النساء والأولاد. فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بها. وقدم أشرف هذا النوع وهو الخيل، فإنها حصون القوم ومعاقلهم وعزهم وشرفهم. فقدمها على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ثم ذكر الأنعام وقدمها على الحرث، لأن الجمال بها والانتفاع أظهر وأكثر من الحرث كما قال تعالى: { ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون }، [108] والانتفاع بها أكثر من الحرث فإنها ينتفع بها ركوبًا وأكلًا وشربًا ولباسًا وأمتعة وأسلحة ودواء وقنية إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع، وأيضا فصاحبها أعز من صاحب الحرث وأشرف، وهذا هو الواقع فإن صاحب الحرث لا بد له من نوع مذلة، ولهذا قال بعض السلف وقد رأى سكة ما دخل: هذا دار قوم إلا دخلهم الذل. فجعل الحرث في آخر المراتب وضعًا له في موضعه.
ويتعلق بهذا نوع آخر من التقديم لم يذكره وهو تقديم الأموال على الأنفس في الجهاد، حيث ما وقع في القرآن إلا في موضع واحد. وهو قوله: { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله }. [109]
وأما سائر المواضع فقدم فيها المال نحو قوله: { وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم }، [110] وقوله: { وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم }، [111] وهو كثير فما الحكمة في تقديم المال على النفس؟ وما الحكمة في تأخيره في هذا الموضع وحده؟
وهذا لم يتعرض له السهيلي رحمه الله، فيقال:
أولًا: هذا دليل على وجوب الجهاد بالمال، كما يجب بالنفس. فإذا دهم العدو وجب على القادر الخروج بنفسه، فإن كان عاجزًا وجب عليه أن يكتري بماله وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والأدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا.
ومن تأمل أحوال النبي ﷺ وسيرته في أصحابه وأمرهم بإخراج أموالهم في الجهاد، قطع بصحة هذا القول.
والمقصود تقديم المال في الذكر وإن ذلك مشعر بإنكار وهم من يتوهم أن العاجز بنفسه إذا كان قادرًا على أن يغزى بماله لا يجب عليه شيء، فحيث ذكر الجهاد قدم ذكر المال. فكيف يقال: لا يجب به. ولو قيل: إن وجوبه بالمال أعظم وأقوى وجوبه بالنفس، لكان هذا القول أصح من قول من قال: لا يجب بالمال وهذا بين وعلى هذا فتظهر الفائدة في تقديمه في الذكر. وفائدة ثانية على تقدير عدم الوجوب وهي أن المال محبوب النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله وترتكب الأخطار وتتعرض للموت في طلبه. وهذا يدل على أنه هو محبوبها ومعشوقها فندب الله تعالى محبيه المجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم ومحبوبهم في مرضاته. فإن المقصود أن يكون الله هو أحب شيء إليهم، ولا يكون في الوجود شيء أحب إليهم منه، فإذا بذلوا محبوبهم في حبه، نقلهم إلى مرتبة أخرى أكمل منها. وهي بذل نفوسهم له، فهذا غاية الحب. فإن الإنسان لا شيء أحب إليه من نفسه، فإذا أحب شيئًا بذل له محبوبه من نفعه وماله، فإذا آل الأمر إلى بذل نفسه ضن بنفسه وآثرها على محبوبه. هذا هو الغالب وهو مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية، ولهذا يدافع الرجل عن ماله وأهله وولده، فإذا أحس بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه فر وتركهم، فلم يرض الله من محبيه بهذا، بل أمرهم أن يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها، وأيضا فبذل النفس آخر المراتب فإن العبد ييذل ماله أو لا يقي به نفسه، فإذا لم يبق له مال بذل نفسه، فكان تقديم المال على النفس في الجهاد مطابقًا للواقع.
وأما قوله: { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم }. [112] فكان تقديم الأنفس هو الأولى، لأنها هي المشتراة في الحقيقة وهي مورد العقد وهي السلعة التي استامها ربها وطلب شراءها لنفسه وجعل ثمن هذا العقد رضاه وجنته. فكانت هي المقصود بعقد الشراء والأموال تبع لها، فإذا ملكها مشتريها ملك مالها. فإن العبد وما يملكه لسيده ليس له فيه شيء. فالمالك الحق إذا ملك النفس ملك أموالها ومتعلقاتها، فحصن تقديم النفس على المال في هذه الآية حسنًا لا مزيد عليه.
فلنرجع إلى كلام السهيلي رحمه الله وأما ما ذكره من تقديم الغفور على الرحيم فحسن جدًا. وأما تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأ ففيه معنى غير ما ذكره يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلي وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى قوله وهو الرحيم الغفور. فإنه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم، وهو متضمن لجميع صفات كماله، ونعوت جلاله مستلزم لها. كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره. فهو المحمود على كل حال وعلى كل ما خلقه وشرعه، ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد فقال: { الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض }، [113] ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدًا، فإنه حمد يستحقه لذاته وكمال أوصافه. وما يستحقه لذاته دائم بدوامه لا يزول أبدًا. وقرن بين الملك والحمد على عادته تعالى في كلامه. فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهما. فله كمال من ملكه وكمال من حمده وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. فإن الملك بلا حمد يستلزم نقصًا، والحمد بلا ملك يستلزم عجزًا، والحمد مع الملك غاية الكمال. ونظير هذه العزة والرحمة والعفو والقدرة والغنى والكرم فوسط الملك بين الجملتين فجعله محفوفًا بحمد قبله وحمد بعده، ثم عقب هذا الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدالين على كمال الإرادة، وإنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة وعلى كمال العلم. وإنه كما يتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق ببواطنها التي لا تدرك إلا بخبره. فنسبة الحكمة إلى الإرادة، كنسبة الخبرة إلى العلم. فالمراد ظاهر والحكمة باطنة والعلم ظاهر والخبرة باطنة، فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة، وكمال العلم أن يكون كاشفًا عن الخبرة. فالخبرة باطن العلم وكماله، والحكمة باطن الإرادة وكمالها فتضمنت الآية إثبات حمده وملكه وحكمته وعلمه على أكمل الوجوه.
ثم ذكر تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم العلوي والسفلي فقال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها.
ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه وهما الرحمة والمغفرة فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته، ويعفو عن زلتهم ويهب لهم ذنوبهم ولا يؤاخذهم بها بمغفرته. فقال: { وهو الرحيم الغفور }، [114] فتضمنت هذه الآية سعة علمه ورحمته وحكمه ومغفرته.
وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة. كما يقرن بين العلم والحلم. فمن الأول قوله: { ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا }، [115] ومن الثاني: { والله عليم حليم }، [116] فما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علم، ومن رحمة إلى علم.
وحملة العرش أربعة؛ اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم، لأن العفو إنما يحسن عند القدرة، وكذلك الحلم والرحمة، إنما يحسنان مع العلم. وقدم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم. فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله: { ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا }. [117]
ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضمنها دفع الشر وتضمن ما قبلها جلب الخير، ولما كان دفع الشر مقدمًا على جلب الخير قدم اسم الغفور على الرحيم حيث وقع. ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقديم اسمه الرحيم لأجل ما قبله قدم على الغفور.
وأما قوله تعالى: { يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين }، [118] فقد أبعد النجعة فيما تعسفه من فائدة التقديم وأتى بما ينبو اللفظ عنه. وقال غيره: السجود كان في دينهم قبل الركوع. وهذا قائل ما لا علم له به. والذي يظهر في الآية والله أعلم بمراده من كلامه أنها اشتملت على مطلق العبادة وتفصيلها، فذكر الأعم، ثم ما هو أخص منه، ثم ما هو أخص من الأخص. فذكر القنوت أولا وهو الطاعة الدائمة فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة، ثم ذكر ما هو أخص منه وهو السجود الذي يشرع وحده، كسجود الشكر والتلاوة ويشرع في الصلاة فهو أخص من مطلق القنوت، ثم ذكر الركوع الذي لا يشرع إلا في الصلاة فلا يسن الإتيان به منفردًا فهو أخص مما قبله.
ففائدة الترتيب النزول من الأعم إلى الأخص إلى أخص منه. وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى الأخص وعكسها وهو الترقي من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم.
ونظيرها: { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير }، [119] فذكر أربعة أشياء أخصها الركوع، ثم السجود أعم منه، ثم العبادة أعم من السجود، ثم فعل الخير العام المتضمن لذلك كله.
والذي يزيد هذا وضوحًا الكلام على ما ذكره بعد هذه الآية من قوله: { أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } [120] فإنه ذكر أخص هذه الثلاثة وهو الطواف الذي لا يشرع إلا بالبيت خاصة، ثم انتقل منه إلى الاعتكاف وهو القيام المذكور في الحج وهو أعم من الطواف، لأنه يكون في كل مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداها، ثم ذكر الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما منع منه مانع أو استثني شرعًا.
وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت، ثم الاعتكاف الذي يكون في سائر المساجد، ثم الصلاة التي تكون في البلد كله، بل في كل بقعة، فهذا تمام الكلام على ما ذكره من الأمثلة وله رحمه الله مزيد السبق وفضل التقدم.
وابن اللبون إذا ما لز في قرن ** لم يستطع صولة البزل القنا عيسى
(مسائل في المثنى والجمع)
(الواو والألف في يفعلون وتفعلان)
الواو والألف في يفعلون وتفعلان أصل للواو والألف في الزيدون والزيدان، فإنما جعلنا ما هو من الأفعال أصلًا لما هو في الأسماء، لأنها إذا كانت في الأفعال كانت أسماء وعلامة جمع. وإذا كانت في الأسماء كانت علامة محضة لا أسماء، وما يكون اسمًا وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفًا في موضع آخر. إذا كان اللفظ واحدًا نحو كاف الضمير وكاف المخاطبة في ذلك، وهذا أولى بنا من أن نجعل الحرف أصلًا والاسم فرعًا له، يدلك على هذا أنهم لم يجمعوا بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى الفعل، كالمسلمون والصالحون دون رجلون وخيلون.
فإن قيل: فالإعلام ليس فيها معنى الفعل وقد جمعوها كذلك.
قيل: الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف واللام. فلا يقال: جاءني زيدون وعمرون. فدل على أنهم أرادوا معنى الفعل أي الملقبون بهذا الاسم والمعرفون بهذه العلامة. فعاد الأمر إلى ما ذكرنا.
وأما التثنية فمن حيث قالوا: في الفعل فعلًا وصنعًا لمن يعقل وغيره، ولم يقولوا صنعوا إلا لمن يعقل. لم يجعلوا الواو علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل، إذ كان فيه معنى الفعل، ومن حيث اتفق معنى التثنية ولم يختلف. اتفق لفظها كذلك في جميع أحوالها ولم يختلف. واستوى فيها العاقل وغيره.
ومن حيث اختلفت معاني الجموع بالكثرة والقلة، اختلف ألفاظها. ولما كان الإخبار عن جمع ما لا يعقل يجري مجرى الجمّة والأمة والبلد، لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان المجتمعة على التخصيص لا كل منهما على التعيين. كان الإخبار عنها بالفعل كالإخبار عن الأسماء المؤنثة، إذ الجمة والأمة وما هو في ذلك المعنى أسماء مؤنثة، ولذلك قالوا: الجمال ذهبت والثياب بيعت. إذ لا يتعين في قصد الضمير كل واحد منهما في غالب الكلام والتفاهم بين الأنام. ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل بخلاف ذلك، وكان كل واحد من الجمع يتعين غالبًا في القصد إليه والإشارة، وكان اجتماعهم في الغالب عن ملازمتهم وتدبير وأغراض عقلية، جعلت لهم علامة تختص بهم تنبىء عن الجمع المعنوي كما هي في ذاتها جمع لفظي وهي الواو، لأنها ضامة بين الشفتين وجامعة لهما. وكل محسوس يعبر عن معقول فينبغي أن يكون مشاكلًا له. فما خلق الله الأجساد في صفاتها المحسوسة إلا مطابقة للأرواح في صفاتها المعقولة، ولا وضع الألفاظ في لسان آدم وذريته إلا موازنة للمعاني التي هي أرواحها. وعلى نحو ذلك خصت الواو بالعطف لأنه جمع في معناه وبالقسم، لأن واوه في معنى واو العطف.
وأما اختصاص الألف بالتثنية فلقرب التثنية من الواحد في المعنى فوجب أن يقرب لفظها من لفظه. وكذلك لا يتغير بناء الواحد فهما كما لا يتغير في أكثر الجموع وفعل الواحد مبني على الفتح فوجب أن يكون فعل الاثنين كذلك وذلك لا يمكن مع غير الألف، فلما ثبت أن الألف بهذه العلة ضمير الاثنين كانت علامة للاثنين في الأسماء، كما فعلوا في الواو حين كانت ضمير الجماعة في الفعل جعلت علامة للجمع في الأسماء.
وأما إلحاق النون بعد حرف المد في هذه الأفعال الخمسة فحملت على الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السلامة والمثناة نحو مسلمون ومسلمات وهي في تثنية الأسماء وجمعها عوض عن التنوين. كما ذكروا، ثم شبهوا بها هذه الأمثلة الخمسة وألحقوا النون فيها في حال الرفع، لأنها إذا كانت مرفوعة كانت واقعة موقع الاسم فاجتمع فيها وقوعها موقع الاسم ومضارعتها له في اللفظ، لأن آخرها حرف مد ولين، ومشاركتها له في المعنى، فالحق فيها النون عوضًا عن حركة الأعراب حملًا على الأسماء كما حملت الأسماء عليها فجمعت بالواو والياء.
فالنون في تثنية الأسماء وجمعها أصل للنون في تثنية الأفعال وجمعها، أعني علامات الأعراب هي أصل الحروف والمد في تثنية الأسماء، وجمعها التي هي علامات إعراب وحروف إعراب كما تقدم.
فإن قيل: فهلا أثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم من الأمثلة الخمسة؟
قلنا: لعدم العلة المتقدمة وهي وقوعها موقع الإسم. وأنت إذا أدخلت النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء، لأن الأسماء لا تكون بعد عوامل الأفعال فبعدت عن الأسماء ولم يبق فيها إلا مضارعتها لها في اتصال حروف المد بها مع الاشتراك في معنى الفعل.
فإن قيل: فأين الإعراب فيها في حال النصب والجزم؟
قلنا: مقدر، كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مد ولين سواء. وسواء كان حرف المد زائدًا أو أصليًا ضميرًا أو حرفًا كيرمي والقاضي وعصى ورمى وسكري وغلامي، إلا أنه مع هذه الياء مقدر قبلها أعني الإعراب وهو في يرمي ويخشى، ونحوه مقدر في نفس الحرف لا قبله، لأنه لا يتقدر إعراب اسم في غيره.
إذا ثبت ذلك، فقولك: لن تفعلوا ولن تفعلي إعرابه مقدر قبل الضمير في لام الفعل. كما هو كذلك في غلامي. وليس زوال النون وحذفها هو الإعراب، لأنه يستحيل أن يحول بين حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعل أو غير فاعل. مع أن العدم ليس بشيء فيكون إعرابًا وعلامة لشيء في أصل الكلام ومفعوله.
وأما فعل جماعة النساء، فكذلك أيضا إعرابه مقدر قبل علامة الإضمار كما هو مقدر قبل الياء من غلامي فعلامة الإضمار منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل، وإنها لبعض حروفه فلا يمكن تعاقب الحركات على لام الفعل معها، كما لم يمكن ذلك مع ضمائر الفاعلين المذكورين ولا مع الياء في غلامي، ولا يمكن أيضا أن يكون الإعراب في نفس النون، لأنها ضمير الفاعل فهي غير الفعل ولا يكون إعراب شيء في غيره.
ولا يمكن أيضا أن يكون بعدها فإنه مستحيل في الحركات وبعيد كل البعد في غير الحركات أن يكون إعرابًا وبينه وبين حرف الإعراب اسم أو فعل فثبت أنه مقدر كما هو في جميع الأسماء والأفعال المعربة التي لا يقدر على ظهور الإعراب فيها لمانع كما تقدم.
فإن قيل: فقد أثبتم أن فعل جماعة المؤنث معرب وهذا خلاف لسيبويه ومن وافقه من النحويين. فإنهم زعموا أنه مبني وإن اختلفوا في علة بنائه.
قلنا: بل هو وفاق لهم لأنهم علمونا وأصلوا لنا أصلًا صحيحًا. فلا ينبغي لنا أن ننقضه ونكسره عليهم وهو وجود المضارعة الموجبة للإعراب وهي موجودة في يفعلن وتفعلن. فمتى وجدت الزوائد الأربع وجدت المضارعة وإذا وجدت المضارعة وجد الإعراب.
فإن قيل: فهلا عوضوا من حركة الإعراب في حال رفعه كما فعلوا في يفعلون، لأنه أيضا واقع موقع الاسم؟
قلنا: قد تقدم ما في يفعلون ويفعلان من وجوه الشبه بينه وبين جمع السلامة في الأسماء فمنها الوقوع موقع الاسم، ومنها المضارعة في اللفظ من جهة حروف المد واللين. وهذا الشبه معدوم في يفعلن من جهة اللفظ، لأنه ليس مثل لفظ فاعلين ولا فاعلات وإن كان واقعًا موقعه في حال الرفع.
فائدة: أسماء الأيام
لما كانت الأيام متماثلة لا يتميز يوم من بوم بصفة نفسية ولا معنوية. لم يبق تمييزها إلا بالأعداد، ولذلك جعلوا أسماء أيام الأسبوع مأخوذة من العدد، نحو الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أو بالأحداث الواقعة فيها كيوم بعاث ويوم بدر ويوم الفتح، ومنه يوم الجمعة. وفيه قولان: أحدهما لاجتماع الناس فيه للصلاة. والثاني، وهو الصحيح، لأنه اليوم الذي جمع فيه الخلق وكمل. وهو اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء. وأما يوم السبت فمن القطع كما تشعر به هذه المادة، ومن السبات لانقطاع الحيوان فيه عن التحرك والمعاش. والنعال السبتية التي قطع عنها الشعر، وعلة السبات التي تقطع العليل عن الحركة والنطق، ولم يكن يومًا من أيام تخليق العالم بل ابتداء أيام التخليق الأحد وخاتمتها الجمعة. هذا أصح القولين، وعليه يدل القرآن وإجماع الأمة. على أن أيام تخليق العالم ستة، فلو كان أولها السبت لكانت سبعة.
وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه خلق الله التربة يوم السبت فقد ذكر البخاري في تاريخه أنه حديث معلول وأن الصحيح إنه قول كعب وهو كما ذكر، لأنه يتضمن أن أيام التخليق سبعة والقرآن يرده.
واعلم: أن معرفة أيام الأسبوع لا يعرف بحس ولا عقل ولا وضع يتميز به الأسبوع عن غيره، وإنما يعلم بالشرع. ولهذا لا يعرف أيام الأسبوع إلا أهل الشرائع ومن تلقى ذلك عنهم وجاورهم. وأما الأمم الذين لا يدينون بشريعة ولا كتاب، فلا يتميز الأسبوع عندهم من غيره، ولا أيامه بعضها من بعض. وهذا بخلاف معرفة الشهر والعام فإنه أمر محسوس.
فائدة: الأمس واليوم والغد
في اليوم وأمس وغد وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه
اعلم أن أقرب الأيام إليك يومك الذي أنت فيه، فيقال: فعلت اليوم فذكر الاسم العام، ثم عرف بأداة العهد ولا شيء أعرف من يومك الحاضر. فانصرف إليه ونظيره الآن من آن والساعة من ساعة. وأما أمس وغد فلما كان كل واحد منهما متصلًا بيومك اشتق له اسم من أقرب ساعة إليه، فاشتق لليوم الماضي أمس الملاقي للمساء، وهو أقرب إلى يومك من صاحبه، أعني صباح غد، فقالوا: أمس. وكذلك غد، اشتق الاسم من الغدو وهو أقرب إلى يومك من مسائه أعني مساء غد.
وتأمل كيف بنوا أمس وأعربوا غدًا لأن أمس صيغ من فعل ماض وهو أمسى، وذلك مبني فوضعوا أمس على وزن الأمر من أمسى يمسي. وأما الغد فإنه لم يؤخذ من مبني. إذ لا يمكن أن يقال: هو مأخوذ من غدًا.
كما يمكن أن يقال أمس من أمسى، بل أقصى ما يمكن فيه أن يكون من الغدو والغدوه وليستا بمبنيين. وهذه العلة أحسن من علة النحاة أن أمس بني لتضمنه معنى اللام وأصله الأمس. قالوا: لأنهم يقولون أمسِ الدابر فيصفونه بذي اللام، فدل على أنه معرفة، ولا يمكن أن يكون معرفة إلا بتقدير اللام وهذا أولا منقوض بقولهم غد الآتي فيلزم على طرد علتهم أن يبنوا غدًا.
وأيضا فإن أمس جرى مجرى الأعلام وهو والله أعلم بمنزلة "اصمت" و"أطرقا" مما جاء منها بلفظ الأمر اسم علم لمكان. يقول الرجل لصاحبه: فقد اصمت إذا جاوره، فاصمت في المكان كأمس في الزمان، ولعله أخذ من قولهم أمس بخير وأمس معنا ونحوه. ولا يقال: كيف يدعي فيه العلمية مع شياعه، لأنا نقول: علميته ليست كعلمية زيد وعمرو، بل كعلمية أسامة وذؤالة وبرة وفجار، وبابه مما جعل الجنس فيه بمنزلة الشخص في العلم الشخصي.
فإن قيل: فما الفرق بينه وهو اسم الجنس إذًا؟
قيل: هذا مما أعضل على كثير من النحاة حتى جعلوا الفرق بينهما لفظيًا فقط، وقالوا يظهر تأثيره في منع الصرف ووصفه بالمعرفة وانتصاب الحال عنه ونحو ذلك، ولم يهتدوا لسر الفرق بين أن موضع اللفظ لواحد منهم منكر شائع في الجنس ولمسمى الجنس المطلق. فهنا ثلاثة أمور تتبعها ثلاثة أوضاع:
أحدها معرف معين من الجنس له العلم الشخصي كزيد.
والثاني واحد منهم شائع في الجنس غير معرف فله الاسم النكرة كأسد من الأسد.
الثالث الجنس المتصور في الذهن المنطبق على كل فرد من أفراده وله علم الجنس كأسامة، فنظير هذا أمس في الزمان، ولهذا وصف بالمعرفة فاعلق بهذه الفائدة التي لا تجدها في شيء من كتب القوم. والحمد الله الوهاب المان بفضله.
فائدة: حذف لام يد ودم وغد
المشهور عند النحاة أن حذف لام يد ودم وغد وبابه حذف اعتباطي لا سبب له، لأنهم لم يروه جاريًا على قياس الحذف، وقد يظهر فيه معنى لطيف وهو أن الألفاظ أصلها المصادر الدالة على الأحداث فأصل غد مصدر غدًا يغدو غدوًا بوزن رمى وأصل دم دمي بوزن فرح مصدر دمي يدمى كبقي يبقى. وأصل يد كذلك يدي من يديت إليه يديا، ثم حذفوا: فقالوا: يدًا وكذلك سم أصله سمو من سما يسمو سموًا كعلم يعلم علمًا. فلما زحزحت على أصل موضوعاتها وبقي فيها من المعنى الأول ما يعلم أنها مشتقة منه. حذفت منها لاماتها بإزاء ما نقص من معانيها ليكون النقص في اللفظ موازيًا للنقص في المعنى، فلا يستوفي حروف الكلمة بأسرها إلا عند حصول المعنى بأسره.
فائدة: دخول الزوائد على الحروف
دخول الزوائد على الحروف الأصلية منبئة معان زائدة على معنى الكلمة التي وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه. فإن كان المعنى الزائد آخرًا كانت الزيادة آخرًا كنحو التاء في فعلت، لأنها تنبىء عما رتبته بعد الفعل، وإن كان المعنى الزائد أولًا، كانت الزيادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة كالزوائد الأربع، فإنها تنبىء أن الفعل لم يحصل بعد لفاعله، وإن بينه وبين تحصيله جزءًا من الزمان. وكان الحرف الزائد السابق للفظ مشيرًا في اللسان إلى الجزء من الزمان مرتبًا في البيان على حسب ترتب المعنى في الجنان. وكذلك حكم جميع ما يرد عليك في كلامهم.
فإن قيل: فهلا كانت الياء مكان التاء، والهمزة.
قيل: أصل هذه الزوائد الياء بدليل كونها في الوضع الذي لا يحتاج فيه إلى الفرق بين مذكر ومؤنث وهو فعل جماعة النساء، فإنك إذا قلت: النسوة يقمن، فالفرق حاصل بالنون. وأيضا فأصل الزيادة لحروف المد واللين والواو لا تزاد أولا لئلا يشتبه بواو العطف والألف يتعذر أولا لسكونها فلم يبق إلا الياء فهي الأصل، فلما أريد الفرق كانت الهمزة للمتكلم أولى لإشعارها بالضمير المستتر في الفعل، إذ هي أول حروف ذلك الضمير إذا برز فلتكن مشيرة إليه إذا خفي، وكانت النون لفعل المتكلم أولى لوجودها في أول لفظ الضمير الكامن في الفعل إذا ظهر فلتكن دالة عليه إذا خفي واستتر وكانت التاء من تفعل للمخاطب لكونها في الضمير المستتر فيه، وإن لم تكن في أول اللفظ أعني أتت، ولكنها في آخره. ولم يخصوا بالدلالة عليه ما هو في أول لفظه، أعني الهمزة لمشاركته للمتكلم فيها وفي النون. فلم يبق من لفظ الضمير إلا التاء فجعلوها في أول الفعل علمًا عليه وإيماء إليه.
فإن قيل: فكان يلزم على هذا أن تكون الزيادة في فعل الغائب هاء لوجودها في لفظ ضمير الغائب إذا برز.
قيل: لا ضمير في الغائب في أصل الكلام وأكثر مواضعه، لأن الاسم الظاهر يغني عنه ولا يستتر ضمير الغائب حتى يتقدمه مذكور يعود عليه. وليس كذلك فعل المتكلم والمخاطب والمخبرين عن أنفسهم. فإنه لا يخلو أبدًا عن ضمير ولا يجيء بعده اسم ظاهر يكون علامة ولا مضمرًا أيضا. إلا أن يكون توكيدًا للمضمر المنطوي عليه الفعل.
ومن ههنا ضارعت الأسماء حتى أعربت وجرت مجراها في دخول لام التوكيد وغير ذلك، لأنها ضمنت معنى الأسماء بالحروف التي في أوائلها. فهي من حيث دلت على الحدث والزمان فعل محض، ومن حيث دلت بأوائلها على المتكلم والمخاطب وغير ذلك متضمنة معنى الاسم. فاستحقت الإعراب الذي هو من خواص الاسم، كما استحق الاسم المتضمن معنى الحرف البناء.
فائدة: فعل الحال
فعل الحال لا يكون مستقبلًا وإن حسن فيه عد. كما لا يكون المستقبل حالًا أبدًا ولا الحال ماضيًا. وأما جاءني زيد يسافر غدًا، فعلى تقدير الحكاية له إذا وقع وهي حال مقدرة. ومنه قوله تعالى: { ولو ترى إذ وقفوا }، [121] والوقوف مستقبل لا محالة، ولكن جاء بلفظ الماضي حكاية لحال يوم الحساب فيه لا يترتب على وقوف، قد ثبت وكذلك: { قال الذين حق عليهم القول }، [122] { وقال الذين في النار }، [123] وهو كثير والوقت مستقبل والفعل بلفظ الماضي ونحوه: { فوجد فيها رجلين يقتتلان }، [124] حكاية للحال، فكذلك يقوم زيد غدًا هو على التقرير والتصوير لهيئته إذا وقع، وهذا لأن الأصل أنه لا يحكم للفظين متغايرين بمعنى واحد إلا بدليل، ولا للفظ واحد بمعنيين إلا بدليل.
فائدة: حروف المضارعة
حروف المضارعة وإن كانت زوائد فقد صارت كأنها من أنفس الكلم، وليست كذلك السين وسوف وإن كانوا قد شبهوهما بحروف المضارعة والحروف الملحقة بالأصول، ولذلك تقول غدًا يقوم زيد فتقدم الظرف على الفعل، كما تفعل ذلك في الماضي الذي لا زيادة فيه، نحو أمس قام زيد ولا يستقيم هذا في المقرون بالسين وسوف لا تقول غدًا سيقوم زيد لوجوه.
منها: أن السين تنبىء عن معنى الاستئناف والاستقبال للفعل، وإنما يكون مستقبلًا بالإضافة إلى ما قبله. فإن كان قبله ظرف أخرجته السين عن الوقوع في الظرف فبقي الظرف لا عامل فيه فبطل الكلام. فإذا قلت: سيقوم غدًا، دلت السين على أن الفعل مستقبل بالإضافة إلى ما قبله، وليس قبله إلا حالة التكلم، ودل لفظ غدًا على استقبال اليوم فتطابقا وصارا ظرفًا له.
الثاني: أن السين وسوف من حروف المعاني الداخلة على الجمل ومعناها في نفس المتكلم، وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر عنه. فوجب أن يكون له صدر الكلام كحروف الاستفهام والنفي والنهي وغير ذلك، ولذلك قبح زيد سأضرب وزيد سيقوم. مع أن الخبر عن زيد، إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه السين. فإن ذلك المعنى مستند إلى المتكلم لا إلى زيد. فلا يجوز أن يخلط بالخبر عن زيد. فتقول: زيد سيفعل.
فإن أدخلت إن على الاسم المبتدأ، جاز دخول السين في الخبر لاعتماد الاسم على أن ومضارعتها للفعل، فصارت في اللفظ مع اسمها كالجملة التامة فصلح دخول السين فيم بعدها. وأما مع عدم أن فيقبح ذلك، وهذا مذهب أبي الحسن شيخ السهيلي. قال السهيلي: فقلت له: أليس قد قال الله تعالى: { والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات }، [125] فقال لي: اقرأ ما قبل الآية فقرأت: { إن الذين كفروا } [126] الآية. فضحك وقال: قد كنت أفزعتني أليست هذه إن في الجملة المتقدمة وهذه الأخرى معطوفة بالواو عليها، والواو تنوب مناب تكرار العامل فسلمت له وسكت.
قال: ونظير هذه المسألة مسألة اللام في إن تقول: إن زيدًا لقائم، ولا تقول زيد لقائم، والمصحح لتقديم الظرف على الفعل الماضي. أن معنى المضي مستفاد من لفظه لا من حرف زائد على الجملة منفصل عن الفعل كالسين وقد. وأما فعل الحال فزوانده ملحقة بالأصل، فإن أدخلت على الماضي قد التي للتوقع كانت بمنزلة السين التي للاستئناف، وقبح حينئذ أمس قد قام زيد، كما قبح غدًا يقوم زيد والعلة حذو النعل بالنعل.
فائدة: السين تشبه حروف المضارعة
السين تشبه حروف المضارعة، ونقرر قبل ذلك مقدمة وهي لم لم تعمل في الفعل وقد اختصت به؟
والجواب أنها فاصلة لهذا الفعل من فعل الحال، كما فصلت الزوائد الأربع فعل الحال عن الماضي فأشبهتها. وإن لم تكن مثلها في اتصالها ولحوقها بالأصل، كما أشبهت لام التعريف العلمية في اتصالها وتعرف الاسم بها. وإن لم تكن ملحقة بحروف الأصل. فلما لم تعمل تلك اللام في الأسماء مع اختصاصها بها، لم تعمل هذه في الأفعال مع استبدادها بها. هذا تعليل الفارسي في بعض كتبه وابن السراج والسهيلي وهو يحتاج إلى بيان وإيضاح.
وتقريره أن الحرف إذا نزل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل فيها، لأن أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض، ولام التعريف مع المعرف بمنزلة اسم علم، فنزلت منزلته جزئه.
و"قد" مع الماضي بمنزلة فعل الحال فنزلت منزلة جزئه. وأما الزوائد الأربع فهي فاصلة لفعل الحال عن الماضي فصارت مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الحال. وكذلك السين مع الفعل فاصلة للمستقبل عن الحال، فصارت مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الاستقبال. وهذا المعنى موجود في سوف أيضا. فاختصاص الحرف شرط عمله ونزوله منزلة الجزء مانع من العمل.
فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن المصدرية فإنها منزلة منزلة الجزء من الكلمة، ولهذا يصير الفعل بها في تأويل كلمة مفردة، ومع هذا فهي عاملة.
قيل: هذا لا ينقض ما أصلناه، لأن هذا الحرف لم ينزل منزلة الجزء من الفعل، وإنما صار به الفعل في تأويل الاسم فلم ينتقض ما ذكرناه.
وعلل السهيلي بطلان عمل سوف بعلة أخرى فقال: وأما سوف فحرف، ولكنه على لفظ السوف الذي هو الشم لرائحة ما ليس بحاضر، وقد وجدت رائحته. كما أن سوف هذه تدل على أن ما بعدها ليس بحاضر. وقد علم وقوعه وانتظر إيابه ولا غرو أن يتقارب معنى الحرف من معنى الاسم المشتق المتمكن في الكلام.
فهذه "ثم" حرف عطف ولفظها كلفظ الثم وهو زم الشيء بعضه إلى بعض. كما قال: كنا أهل ثمة وزمة، وأصله من ثممت البيت إذا كانت فيه فرج فسدد بالثمام، والمعنى الذي في ثم العاطفة قريب من هذا، لأنه ضم شيء إلى شيء بينهما مهلة. كما أن ثم البيت ضم بين شئين بينهما فرجة. ومن تأمل هذا المعنى في الحروف والأسماء المضارعة لها الفاه كثيرًا.
فائدة بديعة: دخول أن على الفعل
في دخول أن على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر ثلاث فوائد:
أحدها: أن المصدر فد يكون فيما مضى وفيما هو آت وليس في صيغته ما يدل عليه. فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع أن ليجتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان.
الثانية: أن أن تدل على إمكان الفعل دون الوجوب والاستحالة.
الثالثة: أنها تدل على مجرد معنى الحدث دون احتمال معنى زائد عليه نفيها تحصين للمعنى من الإشكال وتخليص له من شوائب الاحتمال.
بيانه أنك إذا قلت: كرهت خروجك وأعجبني قدومك، احتمل الكلام معاني.
منها أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك دون صفة من صفاته وهيئاته وإن كان لا يوصف في الحقيقة بصفات، ولكنها عبارة عن الكيفيات.
واحتمل أيضا أنك تريد أنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة من حالاته. فإذا قلت: أعجبني أن قدمت كانت أن على الفعل بمنزلة الطبايع. والصواب من عوارض الاجمالات المتصورة في الأذهان، وكذلك زادوا أن بعد لما في قولهم لما أن جاء زيد أكرمتك، ولم يزيدوها بغير ظرف سوى لما وذلك أن لما ليست في الحقيقة ظرف زمان، ولكنه حرف يدل على ارتباط الفعل الثاني بالأول، وأن أحدهما كالعلة للآخر بخلاف الظرف. إذا قلت: حين قام زيد قام عمرو فجعلت أحدهما وقتًا للآخر على اتفاق لا على ارتباط. فلذلك زادوا أن بعدها صيانة لهذا المعنى وتخليصًا له من الاحتمال العارض في الظرف، إذ ليس الظرف من الزمان بحرف فيكون قد جاء لمعنى كما جاءت لما.
وقد زعم الفارسي أنها مركبة من لم وما. قال السهيلي: ولا أدري ما وجه قوله، وهي عندي من الحروف التي في لفظها شبه من الاشتقاق وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منها نحو ما تقدم في سوف وثم لأنك تقول: لممت الشيء لما إذا ضممت بعضه إلى بعض. وهذا نحو من هذا المعنى الذي سيقت إليه، لأنه ربط فعل بفعل على جهة التسبيب أو التعقيب فإذا كان التسبيب حسن إدخال إن بعدها زائدة إشعارًا بمعنى المفعول من أجله. وإن لم يكن مفعولًا من أجله نحو قوله: { ولما جاءت رسلنا لوطًا }، [127] و { فلما أن جاء البشير }، [128] ونحوه وإذا كان التعقيب مجردًا من التسبيب لم يحسن زيادة إن بعدها وتأمله في القرآن. وأما أن التي للتفسير فليست مع ما بعدها بتأويل المصدر، ولكنها تشارك أن التي تقدم ذكرها في بعض معانيها لأنها تحصين لما بعدها من الاحتمالات وتفسير لما قبلها من المصادر المجملات التي في معنى المقالات والإشارات. فلا يكون تفسيرًا إلا لفعل في معنى التراجم الخمس الكاشفة عن كلام النفس، لأن الكلام القائم في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة يكشفه للمخاطبين خمسة أشياء: اللفظ والخط والإشارة والعقد والنصب وهي لسان الحال وهي أصدق من لسان المقال، فلا تكون أن المفسرة إلا تفسيرًا لما أجمل من هذه الأشياء. كقولك: كتبت إليه أن اخرج، وأشرت إليه أن اذهب، { نودي أن بورك من في النار }، [129] وأوصيته أن أشكر. وعقدت في يدي أن قد أخذت بخمسين. وزربت على حائطي أن لا يدخلوه. ومنه قول الله عز وجل: { ووضع الميزان * أن لا تطغوا في الميزان }، [130] هي ههنا لتفسير النصبة التي هي لسان الحال.
وإذا كان الأمر فيها كذلك، فهي بعينها التي تقدم ذكرها، لأنها إذا كانت تفسيرًا فإنما تفسر الكلام. والكلام مصدر فهي إذًا في تأويل مصدر إلا أنك أوقعت بعدها الفعل بلفظ الأمر والنهي وذلك مزيد فائدة ومزيد الفائدة لا تخرج الفعل عن كونه فعلًا. فلذلك لا تخرج عن كونها مصدرية كما لا يخرجها عن ذلك صيغة المضي والاستقبال بعدها. إذا قلت: يعجبني أن تقوم وإن قمت فكأنهم، إنما قصدوا إلى ماهية الحدث مخبرًا عن الفاعل لا الحدث مطلقًا، ولذلك لا تكون مبتدأة وخبرها في ظرف أو مجرور، لأن المجرور لا يتعلق بالمعنى الذي يدل عليه أن ولا الذي من أجله صيغ الفعل واشتق من المصدر، وإنما يتعلق المجرور بالمصدر نفسه مجردًا من هذا المعنى كما تقدم. فلا يكون خبرًا عن أن المتقدمة وإن كانت في تأويل اسم، وكذلك أيضا لا يخبر عنها بشيء مما هو من صفة للمصدر. كقولك: قيام سريع أو بطيء ونحوه. لا يكون مثل هذا خبرًا عن المصدر.
فإن قلت: حسن أن تقوم وقبح أن تفعل جاز ذلك، لأنك تريد بها معنى المفعول كأنك تقول: استحسن هذا، أو استقبحه، وكذلك إذا قلت: لأن تقوم خير من أن تقعد جاز لأنه ترجيح وتفصيل فكأنك تأمره بأن يفعل. ولست بمخبر عن الحدث بدليل امتناع ذلك في المضي، فإنك لا تقول: إن قمت خير من أن قعد، ولا إن قام زيد خير من أن قعد، وامتناع هذا دليل على ما قدمناه من أن الحدث هو الذي يخبر عنه.
وأما "أن" وما بعدها فإنها وإن كانت في تأويل المصدر فإن لها معنى زائدًا لا يجوز الإخبار عنه، ولكنه يراد ويلزم ويؤمر به. فإن وجدتها مبتدأة ولها خبر فليس الكلام على ظاهره كما تقدم.
وأما لن فهي عند الخليل مركبة من لا وأن، ولا يلزم ما اعترض عليه سيبويه من تقديم المفعول عليها، لأنه يجوز في المركبات ما لا يجوز في البسائط. واحتج الخليل بقول جابر الأنصاري وهو من شعراء الجاهلية:
فإن أمسك فإن العيش حلو ** إلي كأنه عسل مشوبُ
يرجى المرء ما لا أن يُلاقي ** وتعرضُ دون أبعده خطوبُ [131]
فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان بأن كما تقدم.
وكان ينبغي أن تكون جازمة كلم، لأنها حرف نفي مختص بالفعل فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى. وقد فعل ذلك بعض العرب فجزم بها حين لحظ هذا الأسلوب، ولكن أكثرهم ينصب بها مراعاة، لأن المركبة فيها مع لا. إذ هي من جهة الفعل وأقرب إلى لفظه فهي أحق بالمراعاة من معنى النفي. فرب نفي لا يجزم الأفعال، وذلك إذا لم يختص بها دون الأسماء والنفي في هذا الحرف، إنما جاءه من قبل لا وهي غير عاملة لعدم اختصاصها. فلذلك كان النصب بها أولى من الجزم على أنها قد ضارعت لم لتقارب المعنى واللفظ. حتى قدم عليها معمول فعلها فقالوا: زيدًا لن أضرب، كما قالوا: زيدًا لم أضرب.
ومن خواصها تخليصها الفعل للاستقبال بعد أن كان محتملًا للحال فأغنت عن السين وسوف. وجل هذه النواصب تخلص الفعل للاستقبال.
ومن خواصها أنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد معنى النفي في حرف لا. إذا قلت: لا يقوم زيد أبدًا، وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني التي أرواحها يتفرس الفطن فيها حقيقة المعنى بطبعه وحسه كما يتعرف الصادق الفراسة صفات الأرواح في الأجساد من قوالبها بفطنته.
وقلت يومًا لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه: قال ابن جني: مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه من نفس حروفه وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه، ثم أكشفه، فإذا هو كما ظننته أو قريبًا منه، فقال لي رحمه الله: وهذا كثيرًا ما يقع لي.
وتأمل حرف لا كيف تجدها لامًا بعدها ألف يمتد بها الصوت ما لم يقطعه ضيق النفس. فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها ولن يعكس ذلك. فتأمله فإنه معنى بديع.
وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله: { ولا يتمنونه أبدًا } [132] بحرف لا في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل فصار من صيغ العموم فانسحب على جميع الأزمنة. وهو قوله عز وجل: { إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت } [133] كأنه يقول: متى زعموا ذلك لوقت من الأوقات، أو زمن من الأزمان. وقيل لهم: تمنوا الموت فلا يتمنونه أبدًا. وحرف الشرط دل على هذا المعنى وحرف لا في الجواب بإزاء صيغة العموم لاتساع معنى النفي فيها.
وقال في سورة البقرة: { ولن يتمنوه } [134] فقصر من سعة النفي وقرب لأن قبله: { قل إن كانت لكم الدار الآخرة } [135] لأن إن وكان هنا ليست من صيغ العموم، لأن كان ليست بدالة على حدث وإنما هي داخلة على المبتدأ والخبر عبارة عن مضي الزمان الذي كان فيه ذلك الحدث فكأنه يقول عز وجل: إن كان قد وجبت لكم الدار الآخرة وثبتت لكم في علم الله فتمنوا الموت الآن. ثم قال في الجواب: ولن يتمنوه فانتظم معنى الجواب بمعنى الخطاب في الآيتين جميعًا.
وليس في قوله أبدًا ما يناقض ما قلناه. فقد يكون أبدًا بعد فعل الحال تقول: زيد يقوم أبدًا.
ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في لن وطوله في لا يعلم الموفق قصور المعتزلة في فهم كلام الله حيث جعلوا لن تدل على النفي على الدوام واحتجوا بقوله: { لن تراني }، [136] وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي. وهكذا كل صاحب بدعة تجده محجوبًا عن فهم القرآن.
وتأمل قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار }، [137] كيف نفى الإدراك بلا الدالة على طول النفي ودوامه في أنه لا يدرك أبدًا وإن رآه المؤمنون فأبصارهم لا تدركه تعالى عن أن يحيط به مخلوق وكيف نفى الرؤية بلن فقال: { لن تراني } [138] لأن النفي بها لا يتأيد وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي بلن صريحًا بقوله وقالوا: { يا مالك ليقض علينا ربك }، [139] فهذا تمن للموت فلو اقتضت لن دوام النفي تناقض الكلام كيف وهي مقرونة بالتأبيد بقوله: { ولن يتمنوه أبدًا }، [140] ولكن ذلك لا ينافي تننيه في النار، لأن التأبيد قد يراد به التأبيد المقيد والتأبيد المطلق. فالمقيد كالتأبيد بمدة الحياة مقيد كقولك: والله لا أكلمه أبدًا والمطلق كقولك: والله لا أكفر بربي أبدًا. وإذا كان كذلك فالآية إنما اقتضت نفي تمني الموت أبد الحياة الدنيا، ولم يتعرض للآخرة أصلًا. وذلك لأنهم لحبهم الحياة وكراهتهم للجزاء لا يتمنون. وهذا منتف في الآخرة.
فهكذا ينبغي أن يفهم كلام الله لا كفهم المحرفين له عن مواضعه.
قال أبو القاسم السهيلي: على أني أقول إن العرب، إنما تنفي بلن ما كان ممكنًا عند المخاطب مظنونًا أن سيكون، فتقول له: لن يكون، لما ظًن أن يكون، لأن لن فيها معنى أن؛ وإذا كان الأمر عندهم على الشك لا على الظن كأنه يقول أيكون أم لا، قلت في النفي: لا [141] يكون، وهذا كله مقو لتركيبها من لا، وإن وتبين لك وجه اختصاصها في القرآن بالمواضع التي وقعت فيها دون لا.
فائدة: إذا الظرفية الشرطية
قولهم: إذن أُكرمك، قال السهيلي: هي عندي إذا الظرفية الشرطية خلع منها معنى الاسمية، كما فعلوا ذلك بإذا وبكاف الخطاب وبالضمائر المنفصلة، وكذلك فعلوا بإذا إلا أنهم زادوا فيها التنوين فذهبت الألف والقياس إذا وقفت عليها أن يرجع الألف لزوال العلة، وإنما نونوها لما فصلوها عن الإضافة إذ التنوين علامة الانفصال. كما فصلوها عن الإضافة إلى الجملة فيه فصار التنوين معاقبًا للجملة إلا أن إذ في ذلك الموضع لم تخرج عن الاسمية في نحو قوله: { ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون } [142] جعلها سيبويه ههنا حرفًا بمنزلة أن.
فإن قيل: ليس شيء من هذه الأشياء التي صيرت حروفًا بعد أن كانت اسمًا إلا وقد بقي فيها معنى من معانيها، كما بقي في كاف الخطاب معنى الخطاب وفي على معنى الاستعلاء. فما بقي في إذا إذًا من معانيها في حال الاسمية؟
فالجواب أنك إذا قلت: سأفعل كذا إذا خرج زيد. ففعلك مرتبط بالخروج مشروط به، وكذلك إذا قال لك القائل: قد أكرمتك. فقلت: إذا أحسن إليك ربطت إحسانك بإكرامه وجعلته جزاء له، فقد بقي فيها طرف من معنى الجزاء وهي حرف كما كان فيها معنى الجزاء وهو اسم.
وأما "إذ" من قوله: { إذ ظلمتم } [143] ففيها معنى الاقتران بين الفعلين. كما كان فيها ذلك في حال الظرفية تقول: لأضربن زيدًا إذ شتمني فهي وإن لم تكن ظرفًا ففيها معنى الظرف. كأنك تنبهه على أنك تجازيه على ما كان منه وقت الشتم، فإن لم يكن الضرب واقعًا في حال الشتم فله رد إليه وتنبيه عليه، فقد لاح لك قرب ما بينها وبين أن التي هي للمفعول من أجله، ولذلك شبهها سيبويه بها في سواد كتابه.
وعجبًا للفارسي حيث غاب ذلك عنه وجعلها ظرفًا، ثم تحيل في إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها وسوقه إليها.
وأما "إذ" فإذا كانت منونة فإنها لا تكون إلا مضافًا إليها ما قبلها ليعتمد على الظرف المضاف إليها فلا يزول عنها معنى الظرفية. كما زال عن أختها حين نونوها وفصلوها عن الفعل الذي كانت تضاف إليه، والأصل في هذا أن إذ وإذا في غاية من الإبهام والبعد عن شبه الأسماء والقرب من الحروف لعدم الاشتقاق وقلة حروف اللفظ وعدم التمكن وغير ذلك، فلولا إضافتها إلى الفعل الذي يبنى للزمان ويفتقر إلى الظروف لما عرف فيها معنى الاسم أبدًا إذ لا تدل واحدة منهما على معنى في نفسها إنما جاءت لمعنى في غيرها. فإذا قطعت عن ذلك المعنى تمحض معنى الحرف فيها إلا أن إذ لما ذكرنا من إضافة ما قبلها من الظرف إليها لم يفارقها معنى الاسم. وليست الإضافة إليها في الحقيقة، ولكن إلى الجملة التي عاقبها التنوين.
وأما إذن فلما لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما يعضد معنى الاسمية فيها صارت حرفًا لقربها من حروف الشرط في المعنى. ولما صارت حرفًا مختصًا بالفعل مخلصًا له للاستقبال لسائر النواصب للأفعال نصبوا الفعل بعده، إذ ليس واقعًا موقع الاسم فيستحق الرفع ولا غير واجب فيستحق الجزم فلم يبق إلا النصب. ولما لم يكن العمل فيها أصليًا لم تقو قوة أخوتها فألغيت تارة، وأعملت أخرى، وضعفت عن عوامل الأفعال.
فإن قيل: فهلا فعلوا بها ما فعلوا بإذ حين نونوها وحذفوا الجملة بعدها فيضيفوا إليها ظروف الزمان، كما يضيفونها إلى إذ في نحو يومئذ، لأن الإضافة في المعنى إلى الجملة التي عاقبها التنوين.
فالجواب أن إذ قد استعملت مضافة إلى الفعل في المعنى على وجه الحكاية للحال. كما قال تعالى: { ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب } [144] ولم يستعملوا إذا مضافة إلى الماضي بوجه ولا على الحال، فلذلك استغنوا بإضافة الظروف إلى إذ، وهم يريدون الجملة بعدها عن إضافتها إلى إذا، مع أن إذ في الأصل حرفان وإذا ثلاثة أحرف فكان ما هو أقل حروفًا في اللفظ أولى بالزيادة فيه، وإظافة الأوقات إليه زيادة فيه، لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد. وأقوى من هذا أن إذا فيها معنى الجزاء وليس في إذ منه رائحته فامتنع إضافة ظرف الزمان إلى إذا، لأن ذلك يبطل ما فيها من معنى الجزاء، لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد، فلو أضيف إليه والحين إليهما لغلب عليهما حكمه لضعفهما عن درجة حرف الجزاء فتأمله.
فائدة بديعة: لام كي ولام الجحود
لام كي والجحود حرفان ماضيان بإضمار أن إلا أن لام كي هي لام العلة فلا يقع فيها إلا فعل يكون علة لما بعدها. فإن كان ذلك الفعل منفيًا لم يخرجها عن أن تكون لام كي. كما ذهب إليه الصيمري، لأن معنى العلة فيها باق، وإنما الفرق بين لام الجحود ولام كي وذلك من ستة أوجه:
أحدها أن لام الجحود يكون قبلها كون منفي بشرط المضي. إما ما كان أو لم يكن لا مستقبلًا فلا تقول: ما أكون لأزورك، وتكون زمانية ناقصة لا تامة ولا يقع بعد اسمها ظرف ولا مجرور. لا تقول: ما كان زيد عندك ليذهب ولا أمس ليخرج فهذه أربعة فروق.
والذي يكشف لك قناع المعنى ويهجم بك على الغرض إن كان الزمانية عبارة عن زمان ماض فلا يكون علة لحادث، ولا يتعدى إلى المفعول من أجله، ولا إلى الحال وظروف المكان وفي تعديها إلى ظرف الزمان نظر. وهذا الذي منعها أن تقع قبلها لام العلة أو يقع بعدها المجرور أو الظرف.
وأما الفرق الخامس بين اللامين فهو أن الفعل بعد لام الجحود لا يكون فاعله إلا عائدًا على اسم كان، لأن الفعل بعدها في موضع الخبر فلا تقول: ما كان زيد ليذهب عمرو كما تقول: يا زيد ليذهب عمرو، أو لتذهب أنت، ولكن تقول: ما كان ليذهب وما كنت لأفعل.
والفرق السادس جواز إظهار أن بعد لام كي ولا يجوز إظهارها بعد لام الجحود، لأنها جرت في كلامهم نفيًا للفعل المستقبل بالسين أو سوف فصارت لام الجحود بإزائها فلم يظهر بعدها ما لا يكون بعدها.
وفي هذه النكتة مطلع على فوائد من كتاب الله ومرقاة إلى تدبره كقوله: { وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم } [145] فجاء بلام الجحد حيث كان نفيًا لأمر متوقع وسبب مخوف في المستقبل، ثم قال: { وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون } [146] فجاء باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب بالمستغفرين على العموم في الأقوال لا يخص مضيًا من استقبال. ومثله: { ما كان ربك ليهلك القرى }، [147] ثم قال: { وما كنا مهلكي القرى }، [148] فالحظ هذه الآية من مطلع الأخرى تجدها كذلك.
وأما لام العاقبة ويسمونها لام الصيرورة في نحو: { ليكون لهم عدوًا } [149] فهي في الحقيقة لام كي، ولكنها لم تتعلق بالخبر لقصد المخبر عنه وإرادته، ولكنها تعلقت بإرادة فاعل الفعل على الحقيقة وهو الله سبحانه أي فعل الله ليكون كذا وكذا. وكذلك قولهم: أعتق ليموت لم يعتق لقصد الموت، ولم بتعلق اللام بالفعل، وإنما المعنى قدر الله أنه يعتق ليموت فهي متعلقة بالمقدور وفعل الله. ونظيره إني أنسى لاسن ومن رواه أنسى بالتشديد فقد كشف قناع المعنى.
وسمعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول: يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله، فإنها حيث وردت في الكلام فهي لجهل الفاعل لعاقبة فعله، كالتقاط آل فرعون لموسى فإنهم لم يعلموا عاقبته، أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة نحو "لدوا للموت وابنوا للخراب". فأما في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة. ومن هو على كل شيء قدير، فلا يكون قط إلا لام كي وهي لام التعليل.
ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء.
فائدة: نفي الماضي ونفي المستقبل
كما أن لن لنفي المستقبل كان الأصل أن يكون لا لنفي الماضي وقد استعملت فيه نحو: { فلا اقتحم العقبة } [150] ونحوه: * وأي عبد لك لا ألمّا * ولكن عدلوا في الأكثر إلى نفي الماضي بلم لوجوه:
منها أنهم خصوا المستقبل بلن. فأرادوا أن يخصوا الماضي بحرف، ولا لا تخص ماضيًا من مستقبل، ولا فعلًا من اسم. فخصوا نفي الماضي بلم.
ومنها أن "لا" يتوهم انفصالها مما بعدها، إذ قد تكون نافية لما قبلها ويكون ما بعدها في حكم الوجوب، مثل لا أقسم. حتى لقد قيل في قول عمر: "لا نقضي ما تجانفنا لإثم" إن لا رد لما قبلها ونقضي واجب لا منفي. وقال بعض الناس في قوله ﷺ: «لا ترآى ناراهما». أن لا رد وما بعدها واجب، وهذا خطأ في الأثرين وتلبيس لا يجوز حمل النصوص عليه. وكذلك: { لا أقسم بيوم القيامة } [151] أيضا، بل القول فيها أحد قولين، إما أن يقال هي للقسم وهو ضعيف. وإما أن يقال أقحمت أول القسم إيذانًا بنفي القسم عليه وتوكيدًا لنفيه كقول الصديق لاها الله لا تعمد إلى أسد من أسد الله الحديث.
ومما يدل على حرصهم على إيصال حرف النفي بما بعده قطعًا لهذا التوهم، إنما قلبوا لفظ الفعل الماضي بعد لم إلى لفظ المضارع حرصًا على الاتصال وصرفًا للوهم عن ملاحظة الانفصال.
فإن قيل: وأي شيء في لفظ المضارع مما يؤكد هذا المعنى، أو ليسا سواء هو والماضي؟
قلنا: لا سواء، فاعلم أن الأفعال مضارعة للحروف من حيث كانت عوامل في الأسماء كهي ومن هناك استحقت البناء، وحق العامل أن لا يكون مهيئًا لدخول عامل آخر عليه قطعًا للتسلسل الباطن. والفعل الماضي بهذه الصورة وهو على أصله من البناء ومضارعة الحروف العوامل في الأسماء فليس يذهب الوهم عند النطق به إلا إلى انقطاعه عما قبله إلا بدليل يربطه وقرينة تجمعه إليه. ولا يكون في موضع الحال البتة إلا مصاحبًا لقيد ليجعل هذا الفعل في موضع الحال.
فإن قلت: فقد يكون في موضع الصفتين النكرة، نحو مررت برجل ذهب.
قيل: افتقار النكرة إلى الوصف وفرط احتياجها إلى التخصيص تكملة لفائدة الخبر هو الرابط بين الفعل وبينها بخلاف الحال فإنها تجيء بعد استغناء الكلام وتمامه.
وأما كونه خبرًا للمبتدإ فلشدة احتياج المبتدأ إلى خبره جاز ذلك حتى أنك إذا أدخلت أن على المبتدأ بطل أن يكون الماضي في موضع الخبر إذ قد كان في خبرها اللام لما في الكلام من معنى الابتداء والاستئناف لما بعدها، فاجتمع ذلك مع صيغة الماضي وتعاونا على منع الفعل الماضي من أن يكون خبرًا لما قبلها، وليس ذلك في المضارع.
وليس المضارع كالماضي، لأن مضارعته للاسم هيأته لدخول العوامل عليه والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم وأخرجته عن شبه العوامل التي لها صدر الكلام وصيرته كالأسماء المعمول فيها، فوقع موقع الحال والوصف وموقع خبر المبتدأ وإن لم يقطعه دخول اللام عن أن يكون خبرًا في باب أن. كما قطع الماضي من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الكلام كما تقدم.
فإن قيل: فما وجه مضارعة الفعل المستقبل والحال؟
قيل: دخول الزوائد ملحقة بالحروف الأصلية متضمنة لمعاني الأسماء كالمتكلم والمخاطب فما تضمن معنى الاسم أعرب كما بني من الأسماء ما تضمن معنى الحرف. ومع هذا فإن الأصل في دخول الزوائد شبه الأسماء وصلح فيها من الوجوه ما لا يصلح في الماضي.
فائدة بديعة: لام الأمر ولا الناهية
لام الأمر ولا في النهي وحروف المجازاة داخلة على المستقبل فحقها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي، ثم لم يوجد ذلك إلا لحكمة. أما حرف النهي فلا يكون فيه ذلك كي لا يلتبس بالنفي لعدم الجزم، ولكن إذا كانت لا في معنى الدعاء. جاز وقوع الفعل بعدها بلفظ الماضي، ثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه:
منها أنهم أرادوا أن يجمعوا التفاؤل مع الدعاء في لفظ واحد فجاءوا بلفظ الفعل الحاصل في معرض الدعاء تفاؤلًا بالإجابة، فقالوا: لا خيبك الله.
وأيضا: فالداعي قد تضمن دعاؤه القصد إلى إعلام السامع وإخبار المخاطب بأنه داع فجاءوا بلفظ الخبر إشعارًا بما تضمنه من معنى الاخبار نحو أعزك الله وأكرمك ولا رحم فلانًا. جمعت بين الدعاء والإخبار فإنك داع.
ويوضح ذلك أنك لا تقول هذا في حال مناجاتك الله ودعائك لنفسك لا تقول: رحمتني رب ورزقتني وغفرت لي كما تقول للمخاطب: رحمك الله ورزقك وغفر لك. إذ لا أحد في حال مناجاتك يقصد إخباره وإعلامه وإنما أنت داع وسائل محض.
فإن قيل: وكيف لم يخافوا اللبس كما خافوه في النهي.
قلنا: للدعاء هيبة ترفع الالتباس وذكر الله مع الفعل، ليس بمنزلة ذكر الناس فتأمله، فإنه بديع في النظر والقياس فقد جاءت أشياء بلفظ الخبر وهي في معنى الأمر والنهي. منها قول عمر: صلى رجل في كذا وكذا من اللباس. وقولهم: أنجز حر ما وعد. وقولهم: اتقى الله امرء. وهو كثير فجاء بلفظ الخبر الحاصل تحقيقًا لثبوته وإنه مما ينبغي أن يكون واقعًا ولا بد فلا يطلب من المخاطب إيجاده، بل يخبر عنه به ليحققه خبرًا صرفًا كالإخبار عن سائر الموجودات.
وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معنى من هذه وهو أن هذا إخبار محض عن وجوب ذلك واستقرار حسنه في العقل والشريعة والفطرة وكأنهم يريدون بقولهم أنجز حر ما وعد، أي ثبت ذلك في المروءة واستقر في الفطرة. وقول عمر صلى رجل في إزار ورداء الحديث أي هذا مما وجب في الديانة وظهر وتحقق من الشريعة، فالإشارة إلى هذه المعاني حسنت صرفه إلى صورة الخبر وإن كان أمرًا زائدًا لا يكاد يجيء الاسم بعده إلا نكرة لعموم هذا الحكم وشيوع النكرة في جنسها، فلو جعلت مكان النكرة في هذه الأفعال أسماء معرفة تمحض فيها معنى الخبر وزال معنى الأمر، فقلت: اتق الله زيد وأنجز عمر وما وعد فصار خبرًا لا أمرًا.
وهذا موضع المسألة المشهورة وهي مجيء الخبر بمعنى الأمر في القرآن في نحو قوله: { والوالدات يرضعن }، [152] { والمطلقات يتربصن }، [153] ونظائره. فمن سلك المسلك الأول جعله خبرًا بمعنى الأمر ومن سلك المسلك الثاني قال: بل هو خبر حقيقة غير مصروف من جهة الخبرية، ولكن هو خبر عن حكم الله وشرعه ودينه ليس خبرًا عن الواقع ليلزم ما ذكروه من الأشكال، وهو احتمال عدم وقوع مخبره، فإن هذا، إنما يلزم من الخبر عن الواقع، وأما الخبر عن الحكم والشرع فهو حق مطابق لمخبره لا يقع خلافه أصلًا.
وضد هذا مجيء الأمر بمعنى الخبر نحو قوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت»، فإن هذا صورته صورة الأمر ومعناه معنى الخبر المحض، أي من كان لا يستحي فإنه يصنع ما يشتهي، ولكنه صرف عن جهة الخبرية إلى صورة الأمر لفائدة بديعة. وهي أن العبد له من حيائه آمر يأمره بالحسن وزاجر يزجره عن القبيح، ومن لم يكن من نفسه هذا الأمر لم تنفعه الأوامر، وهذا هو واعظ الله في قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي ﷺ ولا تنفع المواعظ الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن، فمن لم يكن له من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ، فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحياء فهو مطيع لا محالة لداعي الغي، والشهوة طاعة لا انفكاك له منها. فنزل منزلة المأمور، وكأنه يقول: إذا لم تأتمر لأمر الحياء فأنت مؤتمر لأمر الغي والسفه وأنت مطيعه لا محالة. وصانع ما شئت لا محالة فأتي بصيغة الامر تنبيهًا على هذا المعنى ولو أنه عدل عنها إلى صيغة الخبر المحض. فقيل: إذا لم تستح صنعت ما شئت لم يفهم منها هذا المعنى اللطيف فتأمله. وإياك والوقوف مع كثافة الذهن وغلظ الطباع فإنها تدعوك إلى إنكار هذه اللطائف وأمثالها فلا تأتمر لها.
وأما وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط نحو: قم أكرمك أي أن تقم أكرمك. فقيل: حكمته أن صيغة الأمر تدل على الاستقبال فعدلوا إليها إيثارًا للخفة، وليست هذه العلة مطردة، فإن الأفعال المختصة بالمستقبل لا يحسن إقامة لفظ الأمر مقام أكثرها. نحوة سيقوم وسوف يقوم ولن تقوم وأريد أن يقوم، ولكن أحسن ما ذكروه أن يقال في قوله: قم اكرمك فائدتان ومطلوبان. أحدهما جعل القيام سببًا للإكرام ومقتضيًا له اقتضاء الأسباب لمسبباتها. والثاني كونه مطلوبًا للآمر مرادًا له. وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل فعدل عنه إلى لفظ الأمر تحقيقًا له، وهذا واضح جدًا.
وأما وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي مع أن الموضع للمستقبل، فقد علل بنحو هذه العلة. وإن الإرادة لا تدل على الاستقبال فعدلوا إلى الماضي، لأنه أخف وهي أيضا غير مطردة ولا مستقلة، ولو لم ينقض عليهم إلا بسائر الأدوات التي لا يكون الفعل بعدها إلا مستقبلًا. ومع ذلك لا يقع بلفظ الماضي.
وأحسن مما ذكروه أن يقال: عدل عن المستقبل هنا إلى صيغة الماضي إشارة إلى نكتة بديعة. وهي تنزيل الشرط بالنسبة إلى الجزاء منزلة الفعل الماضي، فإن الشرط لا يكون سابقًا للجزاء متقدمًا عليه فهو ماض بالإضافة إليه. ألا ترى أنك إذا قلت: إن اتقيت الله أدخلك جنته. فلا يكون إلا سابقًا على دخول الجنة فهو ماض بالإضافة إلى الجزاء فأتوا بلفظ الماضي تأكيدًا للجزاء وتحقيقًا، لأن الثاني لا يقع إلا بعد تحقق الأول ودخوله في الوجود، وأنه لا يكتفي فيه بمجرد العزم وتوطين النفس عليه الذي في المستقبل، بل لا سبيل إلى نيل الجزاء إلا بتقدم الشرط عليه وسبقه له. فأتي بالماضي لهده النكتة البديعة مع أمنهم اللبس بتحصين أداة الشرط لمعنى الاستقبال فيهما.
يبقى أن يقال فهذا تقرير حسن في فعل الشرط فما الذي حسن وقوع الجزاء المستقبل من كل وجه بلفظ الماضي إذا قلت: إن قمتَ قمتُ.
قيل: هذا سؤال حسن، وجوابه: أنهم أبرموا تلك الفائدة في فعل الشرط، قصدوا معها تحسين اللفظ ومشاكلة أوله لآخره وازدواجه واعتدال أجزائه، فأتوا بالجزاء ماضيًا لهذه الحكمة، فإن لفظتي الشرط والجزاء كالأخوين الشقيقين، وأنت تراهم يغيرون اللفظ عن جهته وما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة، فيقولون: أتيته بالغدايا والعشايا، ومأزورات غير مأجورات ونظائره. ألا ترى كيف حسن أن تزرني أزرك. وأن زرتني زرتك وقبح أن تزرني زرتك، وتوسط أن زرتني أزرك. فحسن إلا ولأن للمشاكلة، وقبح الثالث للمنافرة حتى منع منه أكثر النحاة وأجازه جماعة منهم أبو عبد الله بن مالك وغيره، وهو الصواب لكثرة شواهده وصحة قياسه على الصورة الواقعة، وادعى أنه أولى منها. قال: لأن المستقبل في هذا الباب هو الأصل، والماضي فرع عليه. فإذا أجزتم أن يكون الماضي أولا والمستقبل بعده. فجواز الإتيان بالمستقبل الذي هو الأصل أولا والماضي بعده أولى.
والتقرير الذي قدمناه من كون الشرط سابقًا على الجزاء فهو ماضي بالنسبة إليه يدل على ترجيح قولهم: وإن زرتني أزرك أولى بالجواز من أن تزرني زرتك، والتقرير الذي قرره من جواز المستقبل هو الأصل في هذا الباب والماضي دخيل عليه، فإذا قدم الأصل كان أولى بالجواز، ترجح ما ذكره، فالترجيحان حق ولا فرق بين الصورتين، وكلاهما جائز هذا هو الإنصاف في المسألة والله أعلم.
ولكن هنا دقيقة تشير إلى ترجيح قول الجماعة وهي أن الفعل الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه والاعتماد عليه، فيكون هو مطلوب المعلق، وجعل الجزاء باعثًا ووسيلة إلى تحصيله وفي هذا الموضع يتأكد أو يتعين الإيتان فيه بلفظ المضارع الدال على أن المقصود منه أن يأتي به فيوقعه. وظهور القصد المعنوي إليه أوجب تأثير العمل اللفظي فيه ليطابق المعنى للفظ فيجتمع التأثيران اللفظي والمعنوي. والذي يدل على هذا أنهم قلبوا لفظ الفعل الماضي إلى المستقبل في الشرط لهذا المعنى حتى يظهر تأثير الشرط فيه واقتضاؤه له.
وإذا كان الكلام معتمدًا على الجزاء والقصد إليه والشرط جعل تابعًا ووسيلة إليه كان الإتيان فيه بلفظ الماضي حسنًا أو أحسن من المستقبل، فزن بهذه القاعدة ما يرد عليك من هذا الباب.
فمنه قوله تعالى: { لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين }، [154] فانظر كيف جعل فعل الشرط ماضيًا والجزاء مستقبلًا، لأن القصد كان إلى دخولهم المسجد الحرام، وعنايتهم كلها مصروفة، وهمهم معلقة به دون وقوع الأفعال بمشيئة الله تعالى. فإنهم لم يكونوا يشكون في ذلك ولا يرتابون.
وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرط. وهو إما نفس الجزاء على أصح القولين دليلًا كما تقدم تقريره، وإما دال على الجزاء وهو محذوف مقدر تأخيره وعلى القولين فتقدم الجزاء، أو تقديم ما يدل عليه اعتناء بأمره وتجريدًا للقصد إليه.
ويدل عليه أيضا تأكيده باللام المؤذنة بالقسم المضمر كأنه قيل: والله لتدخلن المسجد الحرام، فهذا كله يدلك على أنه هو المقصود المعنى به ومثل هذا قوله تعالى: { لئن شكرتم لأزيدنكم }، [155] ونحوه: { ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك } [156] ومثله: { لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله } [157] وهذا أصل غير منخرم، وفيه نكتة حسنة. وهي اعتماد الكلام في هذا النوع على القسم كما رأيت. فحسن الإتيان بلفظ الماضي إذ القسم أولى به لتحققه ولا يكون الإلغاء مستشنعًا فيه، لأنه مبني. ولما كان الفعل بعد حرف الجزاء يقع بلفظ الماضي لما ذكرناه من الفائدة حسن وقوع المستقبل المنفي بلم بعدها نحو، وان لم تنتهوا وهما جازمتان ولا يجتمع جازمان كما لا يجتمع في شيء من الكلام عاملان من جنس واحد، ولكن لما كان الفعل بعدها ماضيًا في المعنى وكانت متصلة به حتى كأن صيغته صيغة الماضي لقوة الدلالة عليه بلم جاز وقوعه بعد إن، وكان العمل والجزم لحرف لم، لأنها أقرب إلى الفعل وألصق به، وكان المعنى في الاستقبال لحرف إن، لأنها أولى وأسبق لكان اعتبارها في المعنى واعتبار لم في الجزم. ولا ينكر إلغاء إن هنا، لأن ما بعدها في حكم صيغة الفعل الماضي. كما لا ينكر إلغاؤها قبله.
وقد أجازوا في إن النافية من وقوع المستقبل بعدها بلفظ الماضي ما أجازوا في إن التي للشرط كما قال تعالى: { ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد } [158] ولو جعلت مكان إن ههنا غيرها من حروف النفي لم يحسن فيه مثل هذا، لأن الشرطية أصل للنافية كأن المجتهد في النفي، إذا أراد توكيده يقول: إن كان كذا وكذا فعلى كذا أو فأنا كذا، ثم كثر هذا في كلامهم حتى حذف الجواب وفهم القصد. فدخلت أن في باب النفي والأصل ما ذكرناه والله أعلم.
فائدة بديعة: المفرد والجمع وأسباب اختلاف علامات الجمع
في ذكر المفرد والجمع وأسباب اختلاف العلامات الدالة على الجمع واختصاص كل محل بعلامته ووقوع المفرد موقع الجملة وعكسه، وأين يحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه. وهذا فصل نافع جدا يطلعك على سر هذه اللغة العظيمة القدر، المفضلة على سائر لغات الأمم.
اعلم أن الأصل هو المعنى المفرد، وأن يكون اللفظ الدال عليه مفردًا؛ لأن اللفظ قالب المعنى، ولباسه يحتذى حذوه، والمناسبة الحقيقية معتبرة بين اللفظ والمعنى طولًا وقصرًا وخفة وثقلًا وكثرة وقلة وحركة وسكونًا وشدة ولينًا، فإن كان المعنى مفردًا أفردوا لفظه، وإن كان مركبًا ركبوا اللفظ، وإن كان طويلًا طولوه كالقطنط والعشنق للطويل، فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول معناه، وانظر إلى لفظ بحتر وما فيه من الضم والاجتماع لما كان مسماه القصير المجتمع الخلق، وكذلك لفظة الحديد والحجر والشدة والقوة ونحوها. تجد في ألفاظها ما يناسب مسمياتها، وكذلك لفظا الحركة والسكون مناسبتهما لمسمياتهما معلوم بالحس، وكذلك لفظ الدوران والنزوان والغليان، وبابه في لفظها من تتابع الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماها، وكذلك الدجال والجراح والضراب والأفاك في تكرر الحرف المضاعف، منها ما يدل على تكرر المعنى. وكذلك الغضبان والظمآن والحيران، وبابه صيغ على هذا البناء الذي يتسع النطق به ويمتلىء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني، فكان الغضبان هو الممتلىء غضبًا الذي قد اتسع غضبه حتى ملأ قلبه وجوارحه، وكذلك بقيتها.
ولا يتسع المقام لبسط هذا، فإنه يطول ويدق جدًا حتى تسكع عنه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته، فإنه ينشأ من جوهر الحرف تارة، وتارة من صفته. ومن اقترانه بما يناسبه ومن تكرره ومن حركته وسكونه. ومن تقديمه وتأخيره. ومن إثباته وحذفه. ومن قلبه وإعلاله إلى غير ذلك من الموازنة بين الحركات وتعديل الحروف وتوخي المشاكلة والمخالفة والخفة والثقل والفصل والوصل، وهذا باب يقوم من تتبعه سفر ضخم، وعسى الله أن يساعد على إبرازه بحوله وقوته.
ورأيت لشيخنا أبي العباس بن تيمية فيه فهمًا عجيبًا كان إذا انبعث فيه أتى بكل غريبة، ولكن كان حاله فيه كما كان كثيرًا يتمثل:
تألق البرق نجديًا فقلت له ** يا أيها البرق إني عنك مشغول
ولنذكر من هذا الباب مسألة واحدة وهي حال اللفظ في إفراده وتغييره عند زيادة معناها بالتثنية والجمع دون سائر مغيراته، فنقول: لما كان المفرد هو الأصل والتثنية والجمع تابعان له جعل لهما في الاسم علامة تدل عليهما، وجعلت آخره قضاء لحق الأصالة فيه، والتبعية فيهما والفرعية. فالتزموا هذا في التثنية ولم ينخرم عليهم.
وأما الجمع فإنهم ذهبوا به كل مذهب وصرفوه كل مصرف فمرة جعلوه على حد التثنية وهو قياس الباب، كالتثنية والنسب والتأنيث وغيرها، وتارة اجتلبوا له علامة في وسطه كالألف في جعافر والياء في عبيد والواو في فلوس. وتارة جعلوا اختصار بعض حروفه وإسقاطها علامة عليه نحو عنكبوت وعناكب، فإنه لما ثقل عليهم المفرد وطالت حروفه وازداد ثقلًا بالجمع خففوه بحذف بعض حروفه لئلا يجمعوا بين ثقلين، ولا يناقض هذا ما أصلوه من طول اللفظ لطول المعنى وقصره لقصره. فإن هذا باب آخر من المعادلة والموازنة. عارض ذلك الأصل ومنع من طرده.
ومنهم جمعهم فعيل وفعول وفعال على فعل، كرغيف وعمود وقذال على رغف وعمد وقذل لثقل المفرد بالمدة، فإن كان في واحده ياء التأنيث فإنها تحذف في الجمع. فكرهوا أن يحذفوا المدة فيجمعوا عليه بين نقيضين فقلبوا المدة ولم يحذفوها كرسالة ورسائل وصحيفة وصحائف، فجبروا النقص بالفرق لا أنهم تناقضوا.
وتارة يقتصرون على تغيير بعض حركاته فيجعلونها علامة لجمعه، كفلك وفلك وعبد وعبد. وتارة يجتلبون له لفظًا مستقلًا من غير لفظ واحدة كخيل وأيم وقوم ورهط ونحوه. وتارة يجعلون العلامة في التقدير والنية لا في اللفظ كفلك للواحد والجمع، فإن ضمة الواحد في النية كضمة قفل، وضمة الجمع كضمة رسل، وكذلك هجان ودلاص وأسمال وأعشار. مع أن غالب هذا الباب، إنما يأتي في الباب لحصول التمييز والعلامة بموصوفاتها، فلا يقع لبس ولا يكاد يجيء في غير الصفات إلا نادرًا جدًا. ومع هذا، فلا بد أن يكون لمفرده لفظ يغاير جمعه ويكون فيه لغتان، لأنهم علموا أنه يثقل عليهم. أما في الجر والنصب فلتوالي الكسرات. وأما في الرفع فيثقل الخروج من الكسرة إلى الضمة فعدلوا إلى جمع تكسيره ولا يرد هذا عليهم في راحمين وراحمون لفصل الألف الساكنة ومنعها من توالي الحركات فهو كمسلمين وقائمين، وكذلك عدلوا عن جمع فعل المضاعف من صفات العقلاء كفظ وبر، فلم يجمعوه جمع سلامة، ويقولون برون وفظون لئلا بشتبه بكلوب وسفود، لأنه برائبن فكسروه. وقالوا: أبرار، فلما جاءوا إلى غير المضاعف كصعب جمعوه جمع تصحيح، ولم يخافوا التباسًا، إذ ليس في الكلام فعلول، وصعفوق نادر. فتأمل هذا التفريق وهذا التصور الدال، على أن أذهانهم قد فاقت أذهان الأمم، كما فاقت لغتهم لغاتهم.
وتأمل كيف لم يجمعوا شاعرًا جمع سلامة مع استيفائه وشروطه. بل كسروه فقالوا: شعراء إيذانًا منهم بأن واحده على زنة فعيل فجمعوه جمعه كرحيم ورحماء لما كان مقصودهم المبالغة في وصفهم بالشعور.
ثم انظر كيف لم ينطقوا بهذا الوجه المقدر كراهية منهم لمجيئه بلفظ شعير وهو الحب المعروف. فأتوا بفاعل ولما لم يكن هذا المانع في الجمع قالوا شعراء.
فأما التثنية فإنهم ألزموها حالًا واحدًا، فالتزموا فيها لفظ المفرد، ثم زادوا عليه علامة التثنية، وقد قدمنا أن ألف التثنية في الأسماء أصلها ألف الاثنين في فعلا، وذكرنا الدليل على ذلك، فجاءت الألف في التثنية في الأسماء، كما كانت في فعلا علامة الاثنين، وكذلك الواو في جمع المذكر السالم علامة الجمع، نظير واو فعلوا، وتقدم أنك لا تجد الواو علامة للرفع في جميع الأسماء إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال أو ما هو في حكمها. ولما كانت الألف علامة الاثنين في ضمير من يعقل وغيره، كانت علامة التثنية في العاقل وغيره، كانت الألف أولى بضمير الاثنين لقرب التثنية من الواحد. وأرادوا أن لا يغيروا الفعل عن البناء على الفتح في الاثنين، كما كان ذلك في الواحد للقرب المذكور.
ولما كانت الواو ضمير العاقلين خاصة في فعلوا خصوها بجمع العقلاء في نحوهم مسلمون وقائمون، ولما كان في الواو من الضم والجمع ما ليس في غيرها خصوها بالدلالة على الجمع دون الألف.
وسر المسألة أنك إذا جمعت وكان القصد الى تعيين آحاد الجموع، وأنت معتمد الاخبار عن كل واحد منهم وسلم لفظ بناء الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه، فقلت: فعلوا وهم فاعلون وأكثر ما يكون هذا فيمن يعقل، لأن جميع ما لا يعقل من الأجناس يجري مجرى الأسماء المؤنثة المفردة كالثلة والأمة والجملة. فلذلك تقول: الثياب بيعت وذهبت. ولا تقول: بيعوا وذهبوا، لأنك تشير إلى الجملة من غير تعيين آحادها. هذا هو الغالب فيما لا يعقل إلا ما أجرى مجرى العاقل.
وجاءت جموع التكسير معتبرًا فيها بناء الواحد جارية في الإعراب مجراه حيث ضعف الاعتماد على كل واحد بعينه وصار الخبر كأنه عن الجنس الكبير الجاري في لفظه مجرى الواحد، وكذلك جمعوا ما قل عدده من المؤنث جمع السلامة، وإن كان ما لا يعقل نحو الثمرات والسمرات. إلا أنهم لم يجمعوا المذكر منه، وإن قل عدده إلا جمع تكسير، لأنهم في المؤنث لا يزيدوا غير ألف فرقًا بينه وبين الواحد. وأما التاء فقد كانت موجودة في الواحدة، وفي وصفها، وإن كثر جمعوه جمع تكسير، كالمذكر، فإذا كانوا في الجمع القليل فيسلمون لفظ الواحد من أجل الاعتماد في إسناد الخبر على أفراده. فما ظنك به في الاثنين إذا ساغ لهم ذلك في الجمع الذي هو على حدها لقربه منها، فلهذا لا تجد التثنية في العاقل وغيره، إلا على حد واحد، وكذلك ضمير الاثنين في الفعل.
وإذا علم هذا، فحق العلامة في تثنية الأسماء أن يكون على حدها في علامة الإضمار، وأن تكون ألفًا في كل الأحوال.
وكذلك فعلت طوائف من العرب وهم خثعم وطي وبنو الحرث بن كعب وعليه جاءت في قول محققي النحاة: إن هذان لساحران. وأما أكثر العرب فإنهم كرهوا أن يجعلوه كالاسم المبني والمقصور من حيث كان الإعراب قد ثبت في الواحد، والتثنية طارئة على الإفراد، وكرهوا زوال الألف لاستحقاق التثنية لها، فتمسكوا بالأمرين فجعلوا الياء علامة الجر وشركوا النصب معه لما علمت من تعليل النحاة. فكان الرفع أجدر بالألف لا سيما وهي في الأصل، علامة إضمار الفاعل وهي في تثنية الأسماء علامة رفع الفاعل أو ما ضارعه وقام مقامه.
وأما الواو فقد فهمت اختصاصها بالجمع واستحقاق الرفع لها بما قررناه في الألف، ولكنهم حولوا إلى الياء في الجر لما ذكرنا في ألف التثنية. ومتى انقلبت الواو ياء فكأنها، إذ لم يفارقها المد واللين فكأنهما حرف واحد، والانقلاب فيهما يعتبر حال لا تبديل، ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى بالقلب لا بالإبدال. ويقولون في تاء تراث وتخمة وتجاه: إنها بدل من الواو.
فإن قيل: فإذا كان بعض العرب قد جعل التثنية بالألف في كل حال فهلا جعلوا الجمع بالواو في جمع أحواله.
قيل: إن الألف منفردة في كثير من أحكامها عن الواو والياء، والياء والواو أختان فكأنهم لما قلبوها ياء في النصب لم يبعدوا عن الواو، بخلاف الألف فإنهم إذا قلبوها ياء بعدوا عنها.
فإن قيل: فما بال سنين ومئين وبابهما جمع على حد التثنية، وليس من صفات العاقلين ولا أسمائهم.
قيل: إن هذا الجمع لا يوجد إلا فيما كملت فيه أربعة شروط.
أحدها: أن يكون معتل اللام.
الثاني: أن لا يكون المحذوف منه غير حرف مد ولين.
الثالث: أن يكون مؤنثًا.
الرابع: أن لا يكون له مذكر.
فخرج من هذا الضابط شفة، لأن محذوفها هاء. وكذا شاه وعضه وخرج منه أمة، لأن لها مذكرًا وإن لم يكن على لفظها، فقالوا في جمعها أموات ولم يجمعوه جمع سنين كيلا يظن أنه جمع المذكر، إذ كان له مذكر فجمعوا هذا الباب جمع سلامة من أجل أنه مؤنث. والمؤنث يجمع جمع سلامة وأن لم يكن على هذا اللفظ، فلما حصل فيه جمع السلامة بالقياس الصحيح وكانت عادتها رد اللام المحذوفة في الجموع، وكانت اللام المحذوفة واوًا أو ياء أظهر في الجمع السالم لها ياء أو واو ولم يكن في الواحد، وساق القياس إليها سوقًا لطيفًا حتى حصلت له بعد أخذها منه. فما أشبه حال هذا الاسم بحال من أخذ الله منه شيئًا، وعوضه خيرًا منه. وأين الواو والياء الدالة على جمع أولى العلم من ياء أو واو لا تدل على معنى البتة.
فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه في الكتب والألسنة.
ثم انظر كيف كسروا السين من سنين لئلا يلتبس بما هو على وزن فعول من أوزان المبالغة. فلو قالوا: سنون بفتح السين لالتبس بفعول من سن يسن. فكان كسر السين تحقيقًا للجمع، إذ ليس في الكلام اسم مفرد على وزن فعيل وفعول بكسر الفاء.
فإن قيل: فما أنت صانع في الأرضين.
قيل: ليست الأرض في الأصل كأسماء الأجناس مثل ماء وحجر وتمر، ولكنها لفظة جارية مجرى المصدر فهي بمنزلة السفل والتحت وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعلو، ولكنها وصف بها هذا المكان المحسوس فجرت مجرى امرأة زور وضيف، ويدل على هذا قول الراجز: * ولم يقلب أرضها البيطار * يصف قوائم فرس، فأفرد اللفظ وإن كان يريد ما هو جمع في المعنى.
فإذا كانت بهذه المنزلة فلا معنى لجمعها، كما لا يجمع الفوق والتحت والعلو والسفل. فإن قصد المخبر إلى جزء من هذه الأرض الموطوءة وعين قطعة محدودة منها خرجت عن معنى السفل الذي هو في مقابلة العلو، حيث عين جزءًا محسوسًا منها. فجاز على هذا أن يثنى إذا ضممت إليه جزءًا آخر، فتقول: رأيت أرضين. ولا تقول للواحدة: أرضة، كما تقول في واحد التمرة: تمرة، لأن الأرض ليس باسم جنس كما تقدم.
ولا يقال أيضا: أرضة من حيث قلت: ضربة وجرحة، لأنها في الأصل تجري مجرى السفل والتحت، ولا يتصور في العقول أن يقال: سفله وتحته كما يتصور ذلك في بعض المصادر، فلما لم يمكنهم أن يجمعوا أرضًا على أرضات من حيث رفضوا أرضه، ولا أمكنهم أن يقولوا آرض ولا آراض من حيث لم يكن مثل أسماء الأجناس كصخر وكلب وكانوا قد عينوا مجزوءًا محدودًا، فقالوا فيه: أرض وفي تثنيته أرضان لم يستكثروا إذا أضافوا إلى الجزأين بالياء، ورابعًا أن يجمعوه على حد التثنية فقد تقدم السر في الجمع الذي على حد التثنية وأنه مقصود إلى آحاده على التعيين، فإن أرادوا الكثرة والجمع الذي لا يتعين آحاده كأسماء الأجناس لم يحتاجوا إلى الجمع، فإن لفظ أرض يأتي على ذلك كله، لأنها كلها بالإضافة إلى السماء تحت وسفل فعبر عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظًا ومعنى، وكأنه وصف لذاتها لا عبارة عن عينها وحقيقتها إذ يصلح أن يعبر به عن كل ماله فوق وهو بالإضافة إلى ما يقابله سفل كما تقدم فسماء كل شيء أعلاه وأرضه أسفله، وتأمل كيف جاءت مجموعة في قول النبي ﷺ: «طوقه من سبع أرضين» لما اعتمد الكلام على ذات الأرضين وأنفسها على التفصيل والتعيين لآحادها دون الوصف لها بتحت، أو سفل في مقابلة فوق وعلو فتأمله.
فإن قلت: فلم جمعوا السماء فقالوا: سموات وهلا راعوا فيها ما راعوا في الأرض فإنها مقابلة فما الفرق بينهما؟
قيل: بينهما فرقان فرق لفظي وفرق معنوي.
أما اللفظي فإن الأرض على وزن ألفاظ المصادر الثلاثة وهو فعل كضرب، وأما السموات كان نظيرها في المصادر التلاء والجلاء فهي بأبنية الأسماء أشبه، وإنما الذي يماثل الأرض في معناها ووزنها السفل والتحت وهما لا يثنيان ولا يجمعان، وفي مقابلتهما الفوق والعلو، وهما كذلك لا يجمعان على أنه قد قيل: إن السموات ليس جمع سماء، وإنما هي جمع سماوة، وسماوة كل شيء أعلاه. وأما جمع سماء فقياسه اسمية كأكسية وأغطية أو (سماءات [159] في المسلَّم).
وليس هذا بشيء، فإن السماوة هي أعلا الشيء خاصة ليست باسم لشيء عال، وإنما هي اسم لجزئه العالي. وأما السماء فاسم لهذا السقف الرفيع بجملته، فالسموات جمعه لا جمع أجزاء عالية منه على أنه كل عال.
وأحسن من هذا الفرق أن يقال: لو جمعوا أرضًا على قياس جموع التكسير، لقالوا: آرض كأفلس أو آراض كأجمال أو آروض كفلوس فاستثقلوا هذا اللفظ. إذ ليس فيه من الفصاحة والحسن والعذوبة ما في لفظ السموات وأنت تجد السمع ينبو عنه بقدر ما يستحسن لفظ السموات، ولفظ السموات يلج في السمع بغير استئذان لنصاعته وعذوبته. ولفظ الأراضي لا يأذن له السمع إلا على كره، ولهذا تفادوا من جمعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ تدل على التعدد كما قال تعالى: { خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن }، [160] كل هذا تفاديًا من أن يقال أراض وآرض.
وأما الفرق المعنوي فإن الكلام متى اعتمد به على السماء المحسوسة التي هي السقف وقصد به إلى ذاتها دون معنى الوصف صح جمعها جمع السلامة، لأن العدد قليل، وجمع السلامة بالقليل أولى لما تقدم من قربه من التثنية القريبة من الواحد. ومتى اعتمد الكلام على الوصف ومعنى العلا والرفعة جرى اللفظ مجرى المصدر الموصوف به في قولك: قوم عَدل وزور.
وأما الأرض فأكثر ما تجيء مقصودًا بها معنى التحت والسفل دون أن يقصد ذواتها وأعدادها. وحيث جاءت مقصودًا بها الذات والعدد أتى بلفظ يدل على البعد كقوله: { ومن الأرض مثلهن }.
وفرق ثان وهو أن الأرض لا نسبة لها إلى السموات وسعتها، بل هي بالنسبة إليها كحصاة في صحراء فهي وإن تعددت وتكبرت فهي بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل فاختير لها اسم الجنس.
وفرق ثالث أن الأرض هي دار الدنيا التي بالإضافة إلى الآخرة، كما يدخل الإنسان أصبعه في اليم فما تعلق بها هو مثال الدنيا من الآخرة، والله سبحانه لم يذكر الدنيا إلا مقللًا لها محقرًا لشأنها.
وأما السموات فليست من الدنيا هذا على أحد القولين في الدنيا فإنه اسم للمكان فإن السموات مقر ملائكة الرب تعالى ومحل دار جزائه ومهبط ملائكته ووحيه، فإذا اعتمد التعبير عنها عبر عنها بلفظ الجمع. إذ المقصود ذواتها لا مجرد العلو والفوق، وأما إذا أريد الوصف الشامل للسموات وهو معنى العلو والفوق أفردوا ذلك بحسب ما يتصل به من الكلام والسباق فتأمل. قوله: { أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور }، [161] { أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبًا }، [162] كيف أفردت هنا، لما كان المراد الوصف الشامل والفوق المطلق ولم يرد سماء معينة مخصوصة، ولما لم تفهم الجهمية هذا المعنى أخذوا في تحريف الآية عن مواضعها.
وكذا قوله تعالى: { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء } [163] بخلاف قوله في سبأ: { عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض }، [164] فإن قبلها ذكر سبحانه سعة ملكه ومحله، وهو السموات كلها والأرض، ولما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي أفردها إرادة للجنس.
وتأمل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى: { وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم }، [165] فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة وهي تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى الإلهية. فالمعنى وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السموات ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود، فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد.
ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بها، [166] فقال: الوقف التام على السموات ثم يبتدىء بقوله: { وفي الأرض يعلم }، [167] وغلط في فهم الآية. وإن معناها ما أخبرتك به، وهو قول محققي أهل التفسير. [168]
وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: { فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون }، [169] إرادة لهذين الجنسين أي رب كل ما علا وكل ما سفل، فلما كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم الشامل لكل ما يسمى سماء وكل ما يسمى أرضًا، وهو أمر حقيقي لا يتبدل ولا يتغير. وإن تبدلت عين السماء والأرض. فانظر كيف جاءت مجموعة في قوله: { يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض } [170] في جميع الصور. لما كان المراد الإخبار عن تسبيح سكانها على كثرتهم وتباين مراتبهم لم يكن بد من جمع محلهم.
ونظير هذا جمعها في قوله: { وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون }، [171] وكذلك جاءت في قوله: { تسبح له السموات السبع }، [172] مجموعة إخبارًا بأنهاى تسبح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددها، وأكد هذا المعنى بوصفها بالعدد ولم يقتصر على السموات فقط، بل قال: السبع.
وانظر كيف جاءت مفردة في قوله: { وفي السماء رزقكم وما توعدون } [173] فالرزق المطر وما وعدنا به الجنة وكلاهما في هذه الجهة لا أنهما في كل واحدة واحدة من السموات فكان لفظ الأفراد أليق بها.
ثم تأمل كيف جاءت مجموعة في قوله: { قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله }، [174] لما كان المراد نفي علم الغيب عن كل من هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها مجموعة.
وتأمل كيف لم يجىء في سياق الإخبار بنزول الماء منها إلا مفردة حيث وقعت. لما لم يكن المراد نزوله من ذات السماء بنفسها، بل المراد الوصف.
وهذا باب قد فتحه الله لي ولك، فلجه وانظر إلى أسرار الكتاب وعجائبه وموارد ألفاظه جمعًا له إفرادًا وتقديمًا وتأخيرًا إلى غير ذلك من أسراره فلله الحمد والمنة لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه.
فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس: { قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار } [175] وبين قوله في سورة سبأ: { قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله }؟ [176]
قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فرقًا فتدبر السياق تجده نقيضًا لما وقع، فإن الآيات التي في يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقروا به، ولم يمكنهم إنكاره من كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ومدبر أمورهم وغيرها، ومخرج الحي من الميت، والميت من الحي. فلما كانوا مقرين بهذا كله، حسن الاحتجاج به عليهم. إن فاعل هذا هو الله الذي لا إله غيره، فكيف يعبدون معه غيره ويجعلون له شركاء لا يملكون شيئًا من هذا ولا يستطيعون فعل شيء منه. ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك من شأنه تعالى: { فسيقولون الله } [177] أي لا بد أنهم يقرون بذلك، ولا يجحدونه، فلا بد أن يكون المذكور مما يقرون به.
والمخاطبون المحتج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس ولم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء حتى تنتهي إليهم ولم يصل علمهم إلى هذا. فأفردت لفظ السماء هنا فإنهم لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منها، لا سيما والرزق ههنا إن كان هو المطر فمجيئه من السماء التي هي السحاب، فإنه يسمى سماء لعلوه.
وقد أخبر سبحانه أنه بسط السحاب في السماء بقوله: { الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء } [178] والسحاب إنما هو مبسوط في جهة العلو لا في نفس الفلك، وهذا معلوم بالحس فلا يلتفت إلى غيره. فلما انتظم هذا بذكر الاحتجاج عليهم، لم يصلح فيه إلا إفراد السماء لأنهم لا يقرون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح ولا بد من الوحي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية، وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة الفانية المنقضية. فما ينزل من فوق ذلك من الوحي والرحمة والألطاف والموارد الربانية والتنزلات الإلهية، وما به قوام العالم العلوي والسفلي من أعظم أنواع الرزق، ولكن القوم لم يكونوا مقرين به فخوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم، بحيث لا يمكنهم إنكاره.
وأما الآية التي في سبأ فلم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل من السموات ولهذا أمر رسوله بأن يتولى الجواب فيها ولم يذكر عنهم أنهم المجيبون المقرون فقال: { قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله } [179] ولم يقل: سيقولون الله فأمر تعالى نبيه ﷺ أن يجيب بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه، ومنافعه من السموات السبع. وأما الأرض فلم يدع السياق إلى جمعها في واحدة من الاثنين إذ يقربه كل أحد مؤمن وكافر وبر وفاجر.
ومن هذا الباب ذكر الرياح في القرآن جمعًا ومفردة فحيث كانت في سياق الرحمة أتت مجموعة وحيث وقعت في سياق العذاب أتت مفردة، وسر ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهاب والمنافع، وإذا هاجت منها ريح أنشأ لها ما يقابلها ما يكسر سورتها ويصدم حدتها، فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات، فكل ريح منها في مقابلها ما يعد لها ويرد سورتها فكانت في الرحمة ريحًا، وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد وحمام واحد لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غيرها، حتى تنتهي إلى حيث أمرت لا يرد سورتها ولا يكسر شرتها، فتمتثل ما أمرت به، وتصيب ما أرسلت إليه. ولهذا وصف سبحانه الريح التي أرسلها على عاد بأنها عقيم فقال: { أرسلنا عليهم الريح العقيم }، [180] وهي التي لا تلقح ولا خير فيها، والتي تعقم ما مرت عليه.
ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله في سورة يونس: { هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف }، [181] فذكر ريح الرحمة الطيبة بلفظ الأفراد، لأن تمام الرحمة هناك، إنما تحصل بوحدة الريح لا باختلافها، فإن السفينة لا تسير إلا بريح واحدة من وجه واحد سيرها. فإذا اختلف عليها الرياح وتصادمت وتقابلت فهو سبب الهلاك. فالمطلوب هناك ريح واحدة لا رياح، وأكد هذا المعنى بوصفها بالطيب دفعًا لتوهم أن تكون ريحًا عاصفة، بل هي مما يفرح بها لطيبها فلينزه الفطن بصيرته في هذه الرياض المونقة المعجبة التي ترقص القلوب لها فرحًا، ويتغذى بها عن الطعام والشراب والحمد لله الفتاح العليم. فمثل هذا الفصل يعض عليه بالنواجذ، وتثنى عليه الخناصر فإنه يشرف بك على أسرار عجائب تجتنيها من كلام الله. والله الموفق للصواب.
ومما يدخل في هذا الباب جمع الظلمات وإفراد النور وجمع سبل الباطل، وإفراد سبل الحق وجمع الشمائل وإفراد اليمين.
أما الأول فكقوله: { الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور }. [182]
وأما الثاني فكقوله: { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله }. [183]
وأما الثالث فكقوله: { يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل }. [184]
والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة، وسر ذلك والله أعلم أن طريق الحق واحد وهو على الواحد للأحد، كما قال تعالى: { هذا صراط علي مستقيم }، [185] قال مجاهد: الحق طريقه على الله ويرجع إليه كما يقال: طريقك علي، ونظيره قوله: { وعلى الله قصد السبيل } [186] في أصح القولين أي السبيل القصد الذي يوصل إلى الله وهي طريق عليه. قال الشاعر:
فهن المنايا أي واد سلكنه ** عليها طريقي أو علي طريقها
وقد قررت هذا المعنى وبينت شواهده من القرآن، وسر كون الصراط المستقيم على الله، وكونه تعالى على الصراط المستقيم كما في قول هود: { إن ربي على صراط مستقيم في كتاب التحفة المكية. [187]
والمقصود أن طريق الحق واحد إذ مرده إلى الله الملك الحق، وطرق الباطل متشعبة متعددة فإنها لا ترجع إلى شيء موجود ولا غاية لها يوصل إليها، بل هي بمنزلة بنيات الطريق. وطريق الحق بمنزلة الطريق الموصل إلى المقصود، فهي وإن تنوعت فأصلها طريق واحد.
ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل والنور بمنزلة طريق الحق، بل هما هما أفرد النور وجمعت الظلمات وعلى هذا جاء قوله: { الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات }، [188] فوحد ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد، وجمع الذين كفروا لتعددهم وكثرتهم، وجمع الظلمات وهي طرق الضلال، وألغي لكثرتها واختلافها، ووحد النور وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه.
ولما كانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون أفردت. ولما كانت الشمال جهة أهل الباطل وهم أصحاب الشمال جمعت في قوله: { عن اليمين والشمائل }. [189]
فإن قيل: فهلا كذلك في قوله: { وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال }، [190] وما بالها جاءت مفردة؟
قيل: جاءت مفردة لأن المراد أهل هذه الجهة ومصيرهم ومآلهم إلى جهة واحدة وهي جهة الشمال مستقر أهل النار، والنار من جهة الشمال فلا يحسن مجيئها مجموعة، لأن الطرق الباطلة وإن تعددت، فغايتها المرد إلى طريق الجحيم وهي جهة الشمال، وكذلك مجيئها مفردة في قوله: { عن اليمين وعن الشمال قعيد } [191] لما كان المراد أن لكل عبد قعيدين: قعيدًا عن يمينه، وقعيدًا عن شماله، يحصيان عليه الخير والشر، فلكل عبد من يختص بيمينه وشماله من الحفظة، فلا معنى للجمع ههنا، وهذا بخلاف قوله تعالى حكاية عن إبليس: { ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم }، [192] فإن الجمع هنا في مقابلة كثرة من يريد إغواءهم، فكأنه أقسم أن يأتي كل واحد واحد من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله ولا يحسن هنا عن يمينهم وعن شمالهم. بل الجمع ههنا من مقابلة الجملة بالجملة المقتضي توزيع الأفراد ونظيره: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق }. [193]
وقد قال بعض الناس: إن الشمائل، إنما جمعت في الظلال وأفرد اليمين، لأن الظل حين ينشأ أول النهار يكون في غاية الطول، يبدو كذلك ظلأً واحدًا من جهة اليمين، ثم يأخذ في النقصان. وأما إذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد شيئًا فشيئًا. والثاني منه غير الأول، فلما زاد منه شيئًا فهو غير ما كان قبله، فصار كل جزء منه كأنه ظل، فحسن جمع الشمائل في مقابلة تعدد الظلال، وهذا معنى حسن.
ومن هذا المعنى مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة مجموعين، وتارة مثنيين، وتارة مفردين لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك. فالأول كقوله: { فلا أقسم برب المشارق والمغارب }، [194] والثاني كقوله: { رب المشرقين ورب المغربين * فبأي آلاء ربكما تكذبان }، [195] والثالث كقوله: { رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا }، [196] فتأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية بحسب موادها. يطلعك على عظمة القرآن وجلالته، وأنه تنزيل من حكيم حميد.
فحيث جمعت كان المراد بها مشارق الأرض ومغاربها في أيام السنة وهي متعددة، وحيث أفردا كان المراد أفقي المشرق والمغرب، وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهما. فإنها تبتدىء صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعها، فهذا مشرق صعودها، وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء. فجعل مشرق صعدوها بجملته مشرقًا واحدًا، ومشرق هبوطها بجملته مشرقًا واحدًا، ويقابلها مغرباها. فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع.
وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه فلم أر أحدًا تعرض له ولا فتح بابه وهو بحمد الله بين من السياق، فتأمل وروده مثنى في سورة الرحمن، لما كان مساق السورة مساق المثاني المزدوجات، فذكر أولا نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعظيم، ثم ذكر سراجي العالم ومظهري نوره: وهما الشمس والقمر، ثم ذكر نوعي النبات ما قام منه على ساق، وما انبسط منه على وجه الأرض: وهما النجم والشجر، ثم ذكر نوعي السماء المرفوعة، والأرض الموضوعة وأخبر أنه رفع هذه، ووضع هذه، ووسط بينما ذكر الميزان، ثم ذكر العدل والظلم في الميزان فأمر بالعدل ونهى عن الظلم، ثم ذكر نوعي الخارج من الأرض وهما الحبوب والثمار، ثم ذكر خلق نوعي المكلفين وهما: نوع الإنسان ونوع الجان، ثم ذكر نوعي المشرقين ونوعي المغربين، ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب.
فتأمل حسن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة ورودهما لذلك، وقدر موضعهما اللفظ مفردًا ومجموعًا، تجد السمع ينبو عنه ويشهد العقل بمنافرته للنظم.
ثم تأمل ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر الليل والنهار فأمر رسوله بقيام الليل، ثم أخبره أن له في النهار سبحًا طويلًا. فلما تقدم ذكر الليل وما أمر به فيه وذكر النهار وما يكون منه فيه عقب ذلك بذكر المشرق والمغرب الذين هما مظهر الليل والنهار. فكان ورودهما مفردين في هذا السياق أحسن من التثنية والجمع، لأن ظهور الليل والنهار هما واحد فالنهار أبدًا يظهر من المشرق والليل أبدًا يظهر من المغرب، ثم تأمل مجيئهما مجموعين في سورة المعارج في قوله: { فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون * على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين }، [197] لما كان هذا القسم في سياق سعة ربوبيته وإحاطة قدرته والمقسم عليه أرباب هؤلاء، والإتيان بخير منهم ذكر المشارق والمغارب لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته العظيمة الكبيرة، ونقله سبحانه لها، وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب. فمن فعل هذا، كيف يعجزه أن يبدل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم؟
وأيضا فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهور، وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا لتبدل أجسام النبات، وأحوال الحيوانات وانتقالها من حال إلى غيره، ويبدل الحر بالبرد. والبرد بالحر. والصيف بالشتاء، والشتاء بالصيف إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والثلوج، وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم. بسبب اختلاف مشارق الشمس ومغاربها. كان ذلك تقدير العزيز العليم. فكيف لا يقدر مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خيرًا منهم؟ وأكد هذا المعنى بقوله: { وما نحن بمسبوقين } فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظة الجمع.
ثم تأمل كيف جاءت أيضا في سورة الصافات مجموعة في قوله: { رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق } [198] لما جاءت مع جملة المربوبات المتعددة وهي السموات والأرض وما بينهما. كان الأحسن مجيئها مجموعة لينتظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد، ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب لاقتضاء الحال، لذلك فإن المشارق مظهر الأنوار وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصرفه ومعاشه وانبساطه فهو إنشاء مشهود، فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث، ثم ذكر تعجب بنيه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت، ثم قدر الموت وحالهم فيه وكان الاقتصار على ذكر المشارق ههنا في غاية المناسبة للغرض المطلوب والله أعلم.
فائدة: علامة التثنية والجمع
إنما ظهرت علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد، لأن الفعل يدل على فاعل مطلق ولا يدل على تثنية ولا جمع، لأنهما طارئان على الأفراد وهو الأصل. ففعل الواحد مستغن عن علامة الإضمار لعلم السامع أن له فاعلًا، ولا كذلك في التثنية والجمع لأن السامع لا يعلم أن الفاعل مثنى ولا مجموع.
فإن قيل: فما معنى استتار الضمير في الفعل وهو حروف مركبة من حركات اللسان، فكيف يستتر فيها شيء أو يظهر؟
قيل: أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح، إذ مقصودهم التقريب على المتعلمين.
والتحقيق أن الفاعل مضمر في نفس المتكلم، ولفظ الفعل متضمن له دال عليه، واستغني عن إظهاره لتقدم ذكره، وعبر عنه بلفظ مضمر ولم يعبر عنه بمحذوف، لأن المضمر هو المستتر فهو مضمر في النية مخفي في الخلد، والإضمار هو الإخفاء.
فإن قيل: فهلا سموا ما حذفوه لفظًا وأرادوا نيته مضمرًا مثل الغاية في قولك، الذي رأيت زيد، وما الفرق بينهما وبين زيد قام؟
قيل: الضمير في زيد قام. لم ينطق به، ثم حذف، ولكنه مضمر في الإرادة، ولا كذلك الضمير المحذوف للعلم به، لأنه قد لفظ به في النطق، ثم حذف تخفيفًا. فلما كان قد لفظ به، ثم قطع من اللفظ تخفيفًا. عبر عنه بالحذف، والحذف هو القطع من الشيء فهذا هو الفرق بينهما.
فائدة بديعة: تقدم علامة التثنية والجمع للفعل
لحاق علامة التثنية والجمع للفعل مقدمًا، جاء في لغة قوم من العرب حرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى، إذ كانوا يسمون بالتثنية والجمع نحو فلسطين وقنسرين وحمدان وسلمان مما يشبه لفظه لفظ المثنى والجمع، فهذا ونحوه دعاهم إلى تقديم العلامة في قولهم: أكلوني البارغيث، وقد ورد في الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة» وكما أن هذه العلامة ليست للفعل، إنما هي للفاعلين، وكذلك التاء في قامت هند ليست للفعل إذ هو حيث يذكر لا يلحقه تأنيث إلا في نحو ضربه وقتله. والفعل لم يشتق من المصدر محدودًا، وإنما يدل عليه مطلقًا. فالتاء إذًا بمنزلة علامة التثنية والجمع، إلا أنها ألزم للفعل منها.
وقد ذكر النحاة في ذلك فروقًا وعللًا مشهورة فراجعها، ولكن ينبغي أن تتنبه لأمور تجب مراعاتها.
منها: أنهم قالوا إن الاسم المؤنث لو كان تأنيثه حقيقيًا فلا بد من لحوق تاء التأنيث في الفعل، وإن كان مجازيًا لكنت بالخيار. وزعموا أن التاء في قالت الأعراب ونحوه لتأنيث الجماعة وهو غير حقيقي، وقد كان على لحوق التاء في. وقال نسوة أولى: لأن تأنيثهن حقيقي، واتفقوا أن الفعل إذا تأخر عن فاعله المؤنث فلا بد من إثبات التاء، وإن لم يكن التأنيث حقيقيًا ولم يذكروا فرقًا بين تقدم الفعل وتأخره.
ومما يقال لهم إذ لحقت التاء لتأنيث الجماعة فلم لا يجوز في جمع السلامة المذكر كما جازت في جمع التكسير.
ومما يقال لهم أيضا: إذا كان لفظ الجماعة مؤنثًا فلفظ الجمع مذكر فلم روعي لفظ التأنيث دون لفظ التذكير.
فإن قلتم: أنت مخير، فإن راعيت لفظ التأنيث أنثت، وإن راعيت لفظ التذكير ذكرت.
قيل لهم: هذا باطل. فإن أحدًا من العرب لم يقل الهنداتُ ذهب، ولا الجمال انطلق، ولا الأعراب تكلم، مراعاة للفظ الجمع فبطلت العلة.
فهذه عللهم قد انتقضت كما ترى. فاسمع الآن سر المسألة وكشف قناعها: الأصل في هذا الباب أن الفعل متى اتصل بفاعله، ولم يحجز بينهما حاجز، لحقت العلامة ولا نبالي أكان التأنيث حقيقيًا أم مجازيًا. فتقول: طابت الثمرة وجاءت هند، إلا أن يكون الاسم المؤنث في معنى اسم آخر مذكر كالحوادث والحدثان والأرض والمكان. فلذلك جاء: * فإن الحوادث أودى بها * فإن الحوادث في معنى الحدثان. وجاء: * ولا أرض أبقل إبقالها * فإنه في معنى ولا مكان أبقل إبقالها. وإذا فصلت الفعل عن فاعله فكلما بعد عنه قوي حذف العلامة، وكلما قرب قوي إثباتها وإن توسط توسط فحضر القاضي اليوم امرأة أحسن من حضرت، وفي القرآن: { وأخذ الذين ظلموا الصيحة }. [199]
ومن هنا كان إذا تأخر الفعل عن الفاعل وجب ثبوت التاء طال الكلام أم قصر، لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصلًا به اتصال الجزء بالكل. فلم يكن بد من ثبوت التاء لفرط الاتصال. وإذا تقدم الفعل متصلًا بفاعله الظاهر فليس مؤخر الاتصال كهو مع المضمر، لأن الفاعل الظاهر كلمة، والفعل كلمة أخرى، كان حذف التاء في تأنيث هند وطابت الثمرة أقرب إلى الجواز منه، في قولك الثمرة طابت.
فإن حجز بين الفعل وفاعله حاجز كان حذف التاء حسنًا، وكلما كثرت الحواجز كان حذفها أحسن.
فإن كان الفاعل جمعًا مكسرًا دخلت التاء للتأنيث وحذفت لتذكير اللفظ، لأنه بمنزلة الواحد في أن اعرابه كإعرابه، ومجراه في كثير من الكلام مجرى اسم الجنس.
فإن كان الجمع مسلمًا فلا بد من التذكير لسلامة لفظ الواحد. فلا تقول: قالت الكافرون، كما لا تقول: قالت الكافر، لأن اللفظ بحاله لم يتغير بطر والجمع عليه.
فإن قيل: فلم لا تقول الأعراب. قال: كما تقوله مقدمًا.
قيل: ثبوت التاء إنما كان مراعاة لمعنى الجماعة، فإذا أردت ذلك المعنى أثبت التاء، وإن تأخر الفعل لم يجز حذفه لاتصال الضمير. وإن لم ترد معنى الجماعة حذفت التاء إذا تقدم الفعل ولم يحتج إليها، إذا تأخر لأن ضمير الفاعلين لجماعة في المعنى وليسوا جمعًا، لأن الجمع مصدر جمعت أجمع. فمن قال إن التذكير في ذهب الرجال، وقام الهندات مراعاة لمعنى الجمع فقد أخطأ.
وأما حذف التاء من { وقال نسوة }، فلانة اسم جمع كرهط وقوم، ولولا أن فيه تاء التأنيث لقبحت التاء في فعله. ولكنه قد يجوز أن تقول: قالت نسوة، كما تقول: قالت فِتية وصِبية.
فإن قلت: إذا كانت النسوة باللام كان دخول التاء في الفعل أحسن كما كان ذلك في قالت الأعراب لأن اللام للعهد وكان الاسم قد تقدم ذكره فأشبهت حال الفعل حاله. إذا كان فيه ضمير يعود إلى مذكور من أجل الألف واللام فإنها ترد على معهود.
فإن قلت: فإذا استوى ذكر التاء وتركها في الفعل المتقدم وفاعله مؤنث غير حقيقي فما الحكمة في اختصاصها في قصة شعيب بالفعل وحذفها في قصة صالح: { وأخذ الذين ظلموا الصيحة }.
قلت: الصيحة في قصة صالح في معنى العذاب والخزي إذ كانت منتظمة بقوله سبحانه: { ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز }، [200] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي، وعن العذاب المذكور في الآية. فقوي التذكير بخلاف قصة شعيب فإنه لم يذكر فيها ذلك، وهذا جواب السهيلي.
وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله، وهو أن الصيحة يراد بها المصدر بمعنى الصياح فيحسن فيها التذكير ويراد بها الواحدة من المصدر فيكون التأنيث أحسن.
وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة أمور كلها مؤنثة اللفظ.
أحدها: الرجفة في قوله في الأعراف: { فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين }. [201]
الثاني: الظلة بقوله: { فأخذهم عذاب يوم الظلة }. [202]
الثالث: الصيحة: { وأخذت الذين ظلموا الصيحة }، [203] وجمع لهم بين الثلاثة. فإن الرجفة بدأت بهم فأصحروا إلى الفضاء خوفًا من سقوط الأبنية عليهم فصهرتهم الشمس بحرها، ورفعت لهم الظلة فأهرعوا إليها يستظلون بها من الشمس فنزل عليهم منها العذاب وفيه الصيحة، فكان ذكر الصيحة مع الرجفة، والظلة أحسن من ذكر الصياح وكان ذكر التاء والله أعلم.
فإن قيل: فإن قلتم إن التاء حرف ولم يجعلوها بمنزلة الواو والألف في قاما وقاموا؟
قيل: لإجماع العرب على قولهم: الهندان قامتا بالتاء والضمير، ولا يجوز أن يكون للفعل ضميران فاعلان.
فإن قيل: فما الفرق بين قوله: { فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة } [204] وبين قوله: { فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة }. [205]
قيل: الفرق من وجهين: لفظي ومعنوي. أما اللفظي فهو أن الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله: { حق عليهم الضلالة }، أكثر منها في قوله: { حقت عليه }، وقد تقدم أن الحذف مع كثرة الحواجز أحسن.
وأما المعنوي فإن من في قوله: { ومنهم من حقت عليه الضلالة } واقعة على الأمة والجماعة وهي مؤنثة لفظًا، ألا تراه يقول: { ولقد بعثنا في كل أمة رسولا }، [206] ثم قال: { ومنهم من حقت عليه الضلالة } أي من تلك الأمم أمم حقت عليه بم الضلالة. ولو قال بدل ذلك: ضلت. لتعينت التاء ومعنى الكلامين واحد، وإذا كان معنى الكلامين واحدًا كان إثبات التاء أحسن من تركها، لأنها ثابتة فيما هو في معنى الكلام الآخر.
وأما: { فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة } فالفريق مذكر. ولو قال: فريقا ضلوا لكان بغير تاء. وقوله تعالى: { حق عليهم الضلالة } في معناه فجاء بغير تاء، وهذا أسلوب لطيف من أساليب العربية تدغ العرب حكم اللفظ الواجب له في قياس لغتها إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكم تراهم يقولون: هو أحسن الفتيان وأجمله، لأنه في معنى هو أحسن فتى وأجمله.
ونظيره تصحيحهم حول وعور، لأنه في معنى أحول وأعور. ونظائره كثيرة جدًا فإذا حسن الحمل على المعنى فيما كان القياس لا يجوزه. فما ظنك به حيث يجوزه القياس والاستعمال.
وأحسن من هذا أن يقول: إنهم أرادوا أحسن شيء وأجمله. فجعلوا مكان شيء قولهم الفتيان تنبيهًا على أنه أحسن شيء من هذا الجنس، فلو اقتصروا على ذكر شيء لم يدل على الجنس المفضل عليه ومن هذا قوله ﷺ: «أحناه على ولد في صغره، وأرعاه في ذات يده» فهذا يدل على أن التقدير هذا أحسن شيء وأجمله. لأنه أحسن فتى إذ لو كان التقدير أحسن فتى لكان نظيره هنا أحنى امرأة على ولد. وكان يقال: أحناها وأرعاها. فلما عدل إلى التذكير دل على أنهم أرادوا أحسن شيء من هذا الجنس وأرعاه.
فائدة بديعة: قولهم ضرب القوم بعضهم بعضا
قولك: ضرب القوم بعضهم بعضًا، هذه المسألة مما لم يدخل تحت ضبط النحاة ما يجب تقديمه من الفاعلين فإن كلاهما ظاهر إعرابه وتقديم الفاعل متعين. وسر ذلك وهو الضمير المحذوف فإن الأصل أن يقال: ضرب القوم بعضهم بعضهم، لأن حق البعض أن يضاف إلى الكل ظاهرًا، أو مقدرًا، فلما حذفوه من المفعول استغناء بذكره في الفاعل لم يجوروا تأخير الفاعل، فيقولوا: ضرب بعضًا بعضهم، لأن اهتمامهم بالفاعل قد قوي وتضاعف لاتصاله بالضمير الذي لا بد منه، فبعد أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرة صارت الحاجة إليه مرتين.
فإن قلت: فما المانع من إضافة بعض المفعول إلى الضمير، فتقول: ضرب القوم بعضهم بعض، أو ضرب القوم بعض بعضهم.
قلت: الأصل أن يذكر الضميران منهما جميعًا. فلما أرادوا حذفه من أحدهما تخفيفًا كان حذفه مع، المفعول الذي هو كالفضلة في الكلام. أولى من حذفه مع الفاعل الذي لا بد منه، ولا غناء عنه كقولك: خلطت القوم بعضهم ببعض، لأن رتبة المفعول ههنا التقدم على المجرور، كما كانت رتبة الفاعل التقديم على المفعول. فحق الضمير العائد على الكل أن يتصل بما هو أهم بالتقديم.
فائدة: إنما للنفي والإثبات
إذا قلت: إنما يأكل زيد الخبز، فحققت ما يتصل، ومحقت ما ينفصل هذه عبارة بعض النحاة وهي عبارة أهل سمرقند يقولون: في إنما وضعت لتحقيق المتصل، وتمحيق المنفصل. وتلخيص هذا الكلام أنها لنفي وإثبات. فأثبتت لزيد أكل الخبز المتصل به في الذكر، ونفت ما عداه فمعناه ما يأكل زيدًا إلا الخبز، فإن قدمت المفعول. فقلت: إنما يأكل الخبز زيد انعكس المعنى والقصد.
فائدة بديعة: الوصلات الخمسة
الوصلات في كلامهم التي وضعوها للتوصل بها إلى غيرها خمسة أقسام:
أحدها حروف الجر التي وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور بها، ولولاها لما نفذ الفعل إليها، ولا باشرها.
الثاني: حرف ها التي للتنبيه وضعت ليتوصل بها إلى نداء ذي الألف واللام.
الثالث: ذو وضعوه وصلة إلى وصف النكرات بأسماء الأجناس غير المشتقة كرجل ذي مال.
الرابع: الذي وضوه وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ولولاها لما جرت صفاتها عليها.
الخامس: الضمير الذي جعل وصلة إلى ارتباط الجمل بالمفردات خبرًا وصفة وصلة وحالًا. فأتوا بالضمير وصلة إلى جريان الجمل على هذه المفردات أحوالًا وأخبارًا وصفات وصلات، ولم يصفرا المعرفة بالجملة مع وجود هذه الوصلة المصححة كما وصفوا بها النكرة لوجهين:
أحدهما: أن النكرة مفتقرة إلى الوصف والتبيين. فعلم أن الجملة بعدها مبينة لها ومكملة لفائدتها.
الوجه الثاني: أن الجملة تتنزل منزلة النكرة، لأنها خبر ولا يخبر المخاطب إلا بما يجهله، لا بما يعرفه. فصلح أن يوصف بها النكرة بخلاف المعرفة. فإنك لو قلت: جاءني زيد قائم أبوه على وجه الوصف لما ارتبط الكلام بعضه ببعض لاستقلال كل واحد منهما بنفسه، فجاؤوا بالوصلة التي توصلوا بها إلى وصف النكرة باسم الجنس وهي ذو. فقالوا: جاءني زيد ذو قام أبوه وهذه لغة طيىء وهي الأصل.
ثم إن أكثر العرب لما رآها اسمًا قد وصف بها المعرفة أرادوا تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف. فأدخلوا الألف واللام عليه، ثم ضاعفوا اللام كيلا يذهب لفظها بالإدغام، وتذهب ألف الوصل في الدرج. فلا يظهر التعريف. فجاء منه هذا اللفظ تقديرًا لذو فلما رأوا الاسم قد انفصل عن الإضافة حيث صار معرفة قلبوا الواو منه ياء. إذ ليس في كلامهم واو متطرفة مضموم ما قبلها ألا وتنقلب ياء، كأدل وأحق. فصار الذي.
وإنما صحب الواو في قولهم: ذو لأنها كانت في حكم التوسط؛ إذ المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد.
وفي معنى "ذو" بمعنى الذي طرف من معنى ذا التي للإشارة، لأن كلًا منهما يبين بأسماء الأجناس. كقولك: هذا الغلام، وهذا الرجل فيتصل بها على وجه البيان، كما يتصل بها ذو على جهة الإضافة، وكذلك قالوا: في المؤنث من الذي التي بالتاء، كما قالوا في المؤنث، من هذا هاتا وهاتين.
فإن قيل: فلم أعرب الذي في حال التثنية.
قيل: لأن الألف التي فيه بعضها علامة الرفع في الأسماء المعربة فدار الأمر بين ثلاثة أمور:
أحدها: أن يبنوه وفيه علامة الإعراب وهو مستشنع وصار بمنزلة من تعطل عن التصرف وفيه آلته.
الثاني: أن يسقطوها منه ليعطوه حظه من البناء فيبطل معنى التثنية.
فرأوا الثالث أسهل شيء عليهم وهو إعرابه فكان ترك مراعاة علة البناء أهون عليهم من إبطال معنى التثنية ولهذه بعينها أعربوا اثنى عشر وهذين. وطرد هذا أن يكون هذان معربًا وهو الصحيح. وممن نص عليه السهيلي وأحسن ما بينا فإن الألف لا يكون علامة بناء بخلاف الضمير فانها تكون للبناء كحيث ومنذ، فتأمل هذا الموضع.
فإن قلت: ينتقض عليك بالجمع فإنهم بنوه أعني الذين وهو على حد التثنية وفيه علامة الإعراب؟
قلت: الفرق بين الجمع والتثنية من وجهين:
أحدهما: أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات نعم، وقد يكون الجمع اسمًا واحدًا في اللفظ كقوم ورهط.
الثاني: أن الجمع نصبه وخفضه يضارع لفظه لفظ الواحد من حيث كان آخره باء مكسورًا ما قبلها. فجعلوا الرفع الذي هو أقل حالاته على النصب والخفض، وغلبوا عليه البناء حيث كان لفظه في الإعراب في أغلب أحواله كلفظه في البناء، وليس كذلك التثنية فإن ياءها مفتوح ما قبلها فلا يضارع لفظها في شيء من أحوالها لفظ الواحد.
وأما النون في الذين فلا اعتبار بها، لأنها ليست في الجمع ركنًا من أركان صيغته لسقوطها في الإضافة من الشعر كما قال: * وإن الذي حانت بفلج دماؤهم [207] * هذا تعليل السهيلي.
وعندي فيه علة ثانية وهي أن التثنية في الذين خاصة من خواص الاسم قاومت شبه الحرف فتقابل المقتضيان، فرجع إلى أصله، فأعرب بخلاف الذين فإن الجمع وإن كان من خواص الأسماء، لكن هذه الخاصة ضعيفة في هذا الاسم لنقصان دلالته مجموعًا عما يدل عليه مفردًا فإن الذي يصلح للعاقل وغيره، والذي لا يستعمل إلا للعقلاء خاصة فنقصت دلالته فضعفت خاصية الجمع فيه، فبقي موجب بنائه على قوته وهذا بخلاف المثنى، فإنه يقال على العاقلين وغيرهما فإنك تقول: الرجلان اللذان لقيتهما، والثوبان اللذان لبستهما، ولا تقول: الثياب الذين لبستهم. وعلى هذا التعليل فلا حاجة بنا إلى ركوب ما تعسفه رحمه الله من مضارعة الجمع للواحد وشبهه به وتكلف الجواب عن تلك الإشكالات. والله أعلم.
فائدة بديعة: ما الموصولة
قول النحاة إن "ما" الموصولة بمعنى الذي، إن أرادرا به أنها بمعناها من كل وجه فليس بحق، وإن أرادوا أنها بمعناها من بعض الوجوه فحق. والفرق بينهما أن ما اسم مبهم في غاية الإبهام حتى أنها تقع على كل شيء، وتقع على ما ليس بشيء، ألا تراك تقول: إن الله يعلم ما كان وما لم يكن، ولفرط أبهامها لم يجز الإخبار عنها حتى توصل بما يوضحها، وكل ما وصلت به يجوز أن يكون صلة للذي فهو يوافق الذي في هذا الحكم، ويخالفها في إبهامها. فلا تكون نعتًا لما قبلها ولا منعوتة لأن صلتها بعينها غير النعت. وأيضا فلو نعتت بنعت زائد على الصلة لارتفع إبهامها وفي ارتفاع الأبهام منها جملة بطلان حقيقتها وإخراجها عن أصل موضوعها.
وتفارق الذي أيضا في امتناعها من التثنية والجمع، وذلك أيضا لفرط إبهامها فإذا ثبت الفرق بينهما. فاعلم أنه لا يجوز أن توجد إلا موصولة لإبهامها وموصوفة، ولا يجوز أن توجد إلا واقعة على جنس تتنوع منه أنواع، لأنها لا تخلو من الإبهام أبدًا. ولذلك كان في لفظها ألف آخرة لما في الألف من المد والإتساع في هواء الفم مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس. فإذا أوقعوها أعلى نوع بعينه وخصوا به من يعقل وقصروها عليه، أبدلوا الألف نونًا ساكنة. فذهب امتداد الصوت فصار قصر اللفظ موازنًا لقصر المعنى.
وإذا كان أمرها كذلك (ووقعت على جنس من الأجناس) وجب أن يكون ضميرها العائد عليها من الصلة التي لا بد للصلة منه، ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة له فيجب أن يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب والمعنى، فإذا وقعت على ما هو فاعل في المعنى كان ضميرها فاعلًا في المعنى واللفظ، نحو كرهت ما أصابك. فما مفعولة لكرهت في اللفظ وهي فاعلة لأصاب في المعنى، فالضمير الذي في أصاب فاعل في اللفظ والمعنى.
وإذا وقعت على مفعول كان ضميرها مفعولا لفظًا ومعنى نحو: سرني ما أكلته، وأعجبني ما لبسته، فهي في المعنى مفعولة لأنها عبارة عن الملبوس، فضميرها مفعول في اللفظ والمعنى، وكذلك إذا وقعت على اللفظ كان ضميرها مجرورًا بفي، لأن الظرف كذلك في المعنى إلا أنها لا تقع على المصادر إلا على ما تختلف أنواعه للإبهام الذي فيها.
فإن قيل: فكيف وقعت على من يعقل كقوله: { لما خلقت بيدي }، [208] { والسماء وما بناها }، [209] { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، وأمثال ذلك؟
قيل: هي في هذا كله على أصلها من الأبهام والوقوع على الجنس العام لما يراد بما ما يراد بمن من التعيين لما يعقل، والاختصاص دون الشياع، ومن فهم حقيقة الكلام وكان له ذوق عرف هذا واستبان له.
أما قوله تعالى: { ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي }، [210] فهذا كلام ورد في معرض التوبيخ والتبكيت للعين على امتناعه من السجود، ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ حيث كان السجود لمن يعقل، ولكن للمعصية والتكبر على ما لم يخلقه. إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على مثله، إنما التكبر للخالق وحده فكأنه يقول: سبحانه لم عصيتني وتكبرت على ما لم تخلقه وخلقته أنا وشرفته وأمرتك بالسجود له. فهذا موضع ما، لأن معناها أبلغ ولفظها أعم وهو في الحجة أوقع وللعذر والشبهة أقطع.
فلو قال: ما منعك أن تسجد لمن خلقت لكان استفهامًا مجردًا من توبيخ وتبكيت ولتوهم أنه وجب السجود له من حيث كان يعقل.
ولعله موجود في ذاته وعينه. وليس المراد كذلك، وإنما المراد توبيخه وتبكيته على ترك سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له، ولهذا عدل عن اسم آدم العلم مع كونه أخص وأتى بالاسم الموصول الدال على جهة التشريف المقتضية لإسجاده له كونه خلقه بيديه، وأنت لو وضعت مكان ما لفظة من، لما رأيت هذا المعنى المذكور في الصلة وإن ما جيء بها وصلة إلى ذكر الصلة. فتأمل ذلك فلا معنى إذًا للتعيين بالذكر. إذ لو أريد التعيين لكان بالاسم العلم أولى وأحرى.
وكذلك قوله: { والسماء وما بناها } [211] لأن القسم تعظيم للمقسم به واستحقاقه للتعظيم من حيث ما. وأظهر هذا الخلق العظيم الذي هو السماء ومن حيث سواها، وزينها بحكمته فاستحق التعظيم، وثبتت قدرته. فلو قال: ومن بناها لم يكن في اللفظ دليل على استحقاقه للقسم من حيث اقتدر على بنائها، ولكان المعنى مقصورًا على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى أفعاله الدالة على عظمته المنبئة عن حكمته المفصحة باستحقاقه للتعظيم من خليقته.
وكذلك قولهم: "سبحان ما يسبح الرعد بحمده"، لأن الرعد صوت عظيم من جرم عظيم، والمسبَّح به لا محالة أعظم، فاستحقاقه للتسبيح من حيث سبَّحته [212] العظيمات من خلقه لا من حيث كان يعلم، ولا تقل: يعقل في هذا الموضع.
فإذا تأملت ما ذكرناه استبان لك قصور من قال: إن ما مع الفعل في هذا كله سوى الأول في تأويل المصدر، وإنه لم يصدر المعنى حق قدره فلا لصناعة النحو وفق، ولا لفهم التفسير رزق وإنه تابع الحز وأخطا المفصل وحام، ولكن ما ورد المنهل.
(سورة الكافرون)
وأما قوله عز وجل: { لا أعبد ما تعبدون * ولا أنتم عابدون ما أعبد }، فما على بابها، لأنها واقعة على معبوده ﷺ على الإطلاق، لأن امتناعهم من عبادة الله ليس لذاته، بل كانوا يظنون أنهم يعبدون الله، ولكنهم كانوا جاهلين به فقوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، أي لا أنتم تعبدون معبودي، ومعبوده هو ﷺ كان عارفًا به دونهم وهم جاهلون به. هذا جواب بعضهم.
وقال آخرون: إنها هنا مصدرية لا موصولة أي لا تعبدون عبادتي ويلزم من تنزيههم عن عبادته تنزيههم عن المعبود، لأن العبادة متعلقة به وليس هذا بشىء إذ المقصود براءته من معبوديهم، وإعلامه أنهم بريئون من معبوده تعالى. فالمقصود المعبود لا العبادة.
وقيل: إنهم كانوا يقصدون مخالفته ﷺ حسدًا له، وأنفة من أتباعه، فهم لا يعبدون معبوده لا كراهية لذات المعبود، ولكن كراهية لأتباعه ﷺ وحرصًا على مخالفته في العبادة. وعلى هذا فلا يصح في النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ ما لإبهامها ومطابقتها الغرض الذي تضمنته الآية.
وقيل في ذلك وجه رابع. وهو قصد ازدواج الكلام في البلاغة والفصاحة مثل قوله: { نسوا الله فنسيهم }، [213] { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه }، [214] فكذلك: { لا أعبد ما تعبدون } ومعبودهم لا يعقل، ثم ازدوج مع هذا الكلام قوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد } فاستوى اللفظان وإن اختلف المعنيان، ولهذا لا يجيء في الإفراد مثل هذا، بل لا يجيء إلا من كقوله: { قل من ينجيكم قل من يرزقكم }، [215] { أمن يملك السمع }، [216] { أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر }، [217] { أمن يجيب المضطر إذا دعاه }، [218] { أمن يبدأ الخلق }، [219] إلى أمثال ذلك.
وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا كله، وهو أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقًا لها، فأتى بما الدالة على هذا المعنى كأنه قيل: ولا أنتم عابدون معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق، ولو أتى بلفظة من لكانت إنما تدل على الذات فقط، ويكون ذكر الصلة تعريفًا لا أنه هو جهة العبادة ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلًا، لأن يعبد تعريف محض أو وصف مقتضي لعبادته. فتأمله فإنه بديع جدًا.
وهذا معنى قول محققي النحاة أن "ما" تأتي لصفات من يعلم، ونظيره: { فانكحوا ما طاب لكم من النساء } [220] لما كان المراد الوصف وإن هو السبب الله الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده وهو الطيب فتنكح المرأة الموصوفة به أتى بما دون من وهذا باب لا ينخرم وهو من ألطف مسالك العربية.
وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هنا. فلنذكر فائدة ثانية على ذلك وهي تكرير الأفعال في هذه السورة.
ثم فائدة ثالثة وهي كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ المستقبل في الموضعين، وأتى في حقهم بالماضي.
ثم فائدة رابعة: وهي أنه جاء في نفي عبادة معبودهم عنه بلفظ الفعل المستقبل، وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل.
ثم فائدة خامسة وهي كون إيراده النفي هنا "لا" دون لن.
ثم فائدة سادسة: وهي أن طريقة القرآن في مثل هذا. أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته. وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد. وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفي والإثبات وهذا حقيقة لا إله إلا الله. فلم جاءت هذه السورة بالنفي المحض وما سر ذلك؟
وفائدة سابعة: وهي ما حكمة تقديم نفي عبادته عن معبودهم، ثم نفي عبادتهم عن معبوده.
وفائدة ثامنة: وهي أن طريقة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخاطبهم بالذين كفروا والذين هادوا كقوله: { يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم }، [221] { قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله }، [222] و { يا أيها الكافرون } في هذا الموضع فما وجه هذا الاختصاص؟
وفائدة تاسعة: وهي هل في قوله: { لكم دينكم ولي دين }، معنى زائد على النفي المتقدم فإنه يدل على اختصاص كل بدينه ومعبوده وقد فهم هذا من النفي فما أفاد التقسيم المذكور؟ وفائدة عاشرة: وهي تقديم ذكرهم ومعبودهم في هذا التقسيم والاختصاص. وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة.
وفائدة حادية عشرة وهي أن هذه السورة قد اشتملت على جنسين من الإخبار.
أحدهما: براءته من معبودهم وبراءتهم من معبوده وهذا لازم أبدًا.
الثاني: إخباره بأن له دينه ولهم دينهم، فهل هذا متاركة وسكوت عنهم فيدخله النسخ بالسيف، أو التخصيص ببعض الكفار، أم الآية باقية على عمومها وحكمها غير منسوخة ولا مخصوصة.
فهذه عشر مسائل في هذه السورة فقد ذكرنا منها مسألة واحدة وهي وقوع ما فيها بدل من. فنذكر المسائل التسع مستمدين من فضل الله مستعينين بحوله وقوته متبرئين إليه من الخطأ. فما كان من صواب فمنه وحده لا شريك له وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه.
فأما المسألة الثانية: وهي فائدة تكرار الأفعال فقيل فيه وجوه أحدها إن قوله: { لا أعبد ما تعبدون }، نفي للحال والمستقبل وقوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، مقابله أي لا تفعلون ذلك. وقوله: { ولا أنا عابد ما عبدتم }، أي لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي. ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي فقال: ما عبدتم فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم. وقوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، مقابله أي لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائمًا. وعلى هذا فلا تكرار أصلًا، وقد استوفت الآيات أقسام النفي ماضيًا وحالًا ومستقبلًا عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأخصره وأبينه. وهذا إن شاء الله أحسن ما قيل فيها فلنقتصر عليه، ولا نتعداه إلى غيره، فإن الوجوه التي قيلت في مواضعها فعليك بها.
وأما المسألة الثالثة: وهي تكريره الأفعال بلفظ المستقبل حين أخبر عن نفسه وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم. ففي ذلك سر وهو الإشارة والإيماء إلى عصمة الله له عن الزيغ والإنحراف عن عبادة معبوده، والاستبدال به غيره. وأن معبوده واحد في الحال والمآل على الدوام لا يرضى به بدلًا ولا يبغي عنه حولًا بخلاف الكافرين فإنهم يعبدون أهواءهم، ويتبعون شهواتهم في الدين وأغراضهم. فهم يصددان يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيره فقال: { لا أعبد ما تعبدون } يعني الآن: { ولا أنتم عابدون ما أعبد }، أنا الآن أيضا، ثم قال: { ولا أنا عابد ما عبدتم } يعني ولا أنا فيما يستقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. وأشبهت ما هنا رائحة الشرط، فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي وهو مستقبل في المعنى. كما يجيء ذلك بعد حرف الشرط، كأنه يقول: مهما عبدتم من شيء فلا أعبده أنا.
فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط وقد عمل فيها الفعل ولا جواب لها وهي موصولة. فما أبعد الشرط منها؟
قلنا: لم نقل أنها شرط نفسها، ولكن فيها رائحة منه وطرف من معناه لوقوعها على غير معين، وإبهامها في المعبودات وعمومها. وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديًا على صفحاته. فإذا قلت لرجل: ما تخالفه في كل ما يفعل أنا لا أفعل ما تفعل. ألست ترى معنى الشرط قائمًا في كلامك وقصدك. وإن روح هذا الكلام مهما فعلت من شيء فإني لا أفعله. وتأمل ذلك من مثل قوله تعالى: { قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيًا }، [223] كيف تجد معنى الشرطية فيه حتى وقع الفعل بعد من بلفظ الماضي، والمراد به المستقبل. وإن المعنى من كان في المهد صبيًا فكيف نكلمه؟ وهذا هو المعنى الذي حام حوله من قال من المفسرين والمعربين: أنه كان نبيًا بمعنى يكون، لكنهم لم يأتوا إليه من بابه، بل ألقوه عطلًا من تقدير وتنزيل وعزب فهم غيرهم عن هذا للطفه ودقته. فقالوا: كان زائدة والوجه ما أخبرتك فخذه عفوًا لك عزمه، وعلى سواك غرمه. هل على من في الآية قد عمل فيها الفعل. وليس لها جواب. ومعنى الشرطية قائم فيها، فكذلك في قوله: { ولا أنا عابد ما عبدتم }، وهذا كله مفهوم من كلام فحول النحاة كالزجاج وغيره.
فإذا ثبت هذا، فقد صحت الحكمة التي من أجلها جاء الفعل بلفظ الماضي من قوله: { ولا أنا عابد ما عبدتم } بخلاف قوله: { ولا أنتم عابدون ما أعبد } لبعد ما فيها عن معنى الشرط. تنبيهًا من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه، وأن ينتقل في المعبودات تنقل الكافرين.
وأما المسألة الرابعة: وهي أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة، وباسم الفاعل أخرى، فذلك والله أعلم لحكمة بديعة وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه وفي كل وقت، فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد، ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت. فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع مني، وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلًا لي، ولا وصفًا، فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي. وأما في حقهم، فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوب دون الفعل. أي إن الوصف الثابت اللازم العائد لله ملتف عنكم. فليس هذا الوصف ثابتًا لكم، وإنما ثبت لمن خص الله وحده بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدًا، وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه وإن عبدوه في بعض الأحيان فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، كما قال أهل الكهف: { وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله } [224] أي اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه، وكذا قال المشركون عن معبودهم: { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى } [225] فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه منهم ونفي الوصف، لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتًا على عبادة الله موصوفًا بها.
فتأمل هذه النكتة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد الله، وعبده المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته، وتبتل إليه تبتيلًا لم يلتفت إلى غيره، ولم يشرك به أحدًا في عبادته وإنه وإن عبده وأشرك به غيره، فليس عابدًا لله ولا عبدًا له. وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي إحدى سورتي الإخلاص التي تعدل ربع القرآن كما جاء في بعض السنن. وهذا لا يفهمه كل أحد، ولا يدركه إلا من منحه الله فهمًا من عنده فله الحمد والمنة.
وأما المسألة الخامسة: وهي أن النفي في هذه السورة أتى بأداة لا دون لن فلما تقدم تحقيقه عن قرب إن النفي بلا أبلغ منه بلن، وإنها أدل على دوام النفي وطوله من لن وإنها للطول والمد الذي في نفيها طال النفي بها واشتد وإن هذا ضد ما فهمته الجهمية والمعتزلة من أن لن إنما تنفي المستقبل، ولا تنفي الحال المستمر النفي في الاستقبال. وقد تقدم تقرير ذلك بما لا تكاد تجده في غير هذا التعليق. فالإتيان بلا متعين هنا والله أعلم.
وأما المسألة السادسة: وهي اشتمال هذه السورة على النفي المحض فهذا هو خاصة هذه السورة العظيمة فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها أنها براءة من الشرك. [226] فمقصودها الأعظم هو البراءة المطلوبة بين الموحدين والمشركين، ولهذا أتي بالنفي في الجانبين تحقيقًا للبراءة المطلوبة مع أنها متضمنة للإثبات صريحًا فقوله: { لا أعبد ما تعبدون براءة محضة ولا أنتم عابدون ما أعبد إثبات أن له معبودًا يعبده وأنتم بريئون من عبادته فتضمنت النفي والإثبات، وطابقت قول إمام الحنفاء: { إنني براء مما تعبدون * إلا الذي فطرني }، [227] وطابقت قول الفئة الموحدين: { وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله } [228] فانتظمت حقيقة لا إله إلا الله ولهذا كان النبي ﷺ يقرنها بسورة { قل هو الله أحد } في سنة الفجر وسنة المغرب، فإن هاتين السورتين سورتا الإخلاص، وقد اشتملتا على نوعي التوحيد الذي لا نجاة للعبد، ولا فلاح إلا بهما. وهما توحيد العلم والاعتقاد المتضمن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالد. وأنه إله أحد صمد لم يلد فيكون له فرع ولم يولد فيكون له أصل، ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظير، ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت له صفات الكمال كلها؛ فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال ونفي ما لا يليق به من الشريك أصلًا وفرعًا ونظيرًا، فهذا توحيد العلم والاعتقاد. والثاني: توحيد القصد والإرادة وهو أن لا يعبد إلا إياه فلا يشرك به في عبادته سواه بل يكون وحده هو المعبود وسورة { قل يا أيها الكافرون } مشتملة على هذا التوحيد، فانتظمت السورتان نوعي التوحيد، وأخلصتا له فكان ﷺ يفتتح بهما النهار في سنة الفجر ويختم بهما في سنة المغرب، وفي السنن أنه كان يوتر بهما فيكونا خاتمة عمل الليل، كما كانا خاتمة عمل النهار.
ومن هنا تخريج جواب المسألة السابعة وهي تقديم براءته من معبودهم، ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده. فتأمله.
وأما المسألة الثامنة: وهي إثباته هنا بلفظ يا أيها الكافرون. دون يا أيها الذين كفروا. فسره والله أعلم إرادة الدلالة على أن من كان الكفر وصفًا ثابتًا له لازمًا لا يفارقه، فهو حقيق أن يتبرأ الله منه، ويكون هو أيضا بريئًا من الله. فحقيق بالموحد البراءة منه، فكان في معرض البراءة التي هي غاية البعد، والمجانبة بحققة حاله التي هي غاية الكفر. وهو الكفر الثابت اللازم في غاية المناسبة فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابت لا تنتقلون عنه فمجانبتكم والبراءة منكم ثابتة دائمًا أبدًا. ولهذا أتى فيها بالنفي الدال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر وهذا واضح.
وأما المسألة التاسعة: وهي ما هي الفائدة في قوله: { لكم دينكم ولي دين }، وهل أفاد هذا معنى زائدًا على ما تقدم؟ فيقال في ذلك من الحكمة والله أعلم أن النفي الأول أفاد البراءة وأنه لا يتصور منه، ولا ينبغي له أن يعبد معبوديهم وهم أيضا لا يكونون عابدين لمعبوده، وأفاد آخر السورة إثبات ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك، والكفر الذي هو حظهم، وقسمهم ونصيبهم فجرى ذلك مجرى من اقتسم هو وغيره أرضًا. فقال له: لا تدخل في حدي، ولا أدخل في حدك، لك أرضك ولي أرضي. فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت إنا اقتسمنا خطتنا بيننا فأصابنا التوحيد والإيمان فهو نصيبنا، وقسمنا الذي نختص به لا تشركونا فيه، وأصابكم الشرك بالله والكفر به، فهو نصيبكم وقسمكم الذي تختصون به لا نشرككم به.
فتبارك من أحيا قلوب من شاء من عباده بفهم كلامه. وهذه المعاني ونحوها، إذا تجلت للقلوب رافلة في حللها فإنها تسبي القلوب وتأخذ بمجامعها، ومن لم يصادف من قلبه حياة فهي: * خود تزف إلى ضرير مقعد * فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لها ونسأله إتمام نعمته.
وأما المسألة العاشرة: وهي تقديم قسمهم ونصيبهم على قسمه ونصيبه وفي أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهم. فهذا من أسرار الكلام، وبديع الخطاب الذي لا يدركه إلا فحول البلاغة وفرسانها. فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد والشرك بينه وبينهم ورضي كل بقسمه وكان المحق هو صاحب القسمة، وقد برز النصيبين وميزا القسمين، وعلم أنهم راضون بقسمهم الدون الذي لا أردى منه وإنه هو قد استولى على القسم الأشرف. والحظ الأعظم بمنزلة من اقتسم هو وغيره سمًا وشفاء فرضي مقاسمه بالسم. فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي، ولا أشاركك في قسمك، لك قسمك ولي قسمي. فتقديم ذكر قسمه ههنا أحسن وأبلغ. كأنه يقول: هذا هو قسمك الذي آثرته بالتقديم، وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما بالتقديم. فكان في تقديم ذكر قسمه من اللهم به، والنداء على سوء اختياره، وقبح ما رضيه لنفسه من الحسن والبيان ما لا يوجد في ذكر تقديم قسم نفسه، والحاكم في هذا هو الذوق والفطن يكتفي بأدنى إشارة، وأما غليظ الفهم فلا ينجع فيه كثرة البيان.
ووجه ثان وهو أن مقصود السورة براءته ﷺ من دينهم ومعبودهم، هذا هو لبها ومغزاها. وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد الثاني مكملًا لبراءته، ومحققًا لها فلما كان المقصود براءته من دينهم، بدأ به في أول السورة ثم جاء قوله: { لكم دينكم } مطابقًا لهذا المعنى أي لا أشارككم في دينكم، ولا أوافقكم عليه، بل هو دين تختصون أنتم به لا أشرككم فيه أبدًا. فطابق آخر السورة أولها فتأمله.
وأما المسألة الحادية عشرة: وهي أن هذا الإخبار بأن لهم دينهم وله دينه، هل هو إقرار فيكون منسوخًا أو مخصوصًا، أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟
فهذه مسألة شريفة ومن أهم المسائل المذكورة، وقد غلط في السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب. وكلا القولين غلط محض فلا نسخ في السورة ولا تخصيص، بل هي محكمة عمومها نص محفوظ. وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها، فإن أحكام التوحيد التى اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه. وهذه السورة أخلصت التوحيد. ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم، ومنشأ الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم، ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف فقالوا: منسوخ. وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم، فقالوا: هذا مخصوص. ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا لهم أو إقرارا على دينهم أبدًا. بل لم يزل رسول الله ﷺ في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد على الإنكار عليهم، وعيب دينهم وتقبيحه، والنهي عنه والتهديد والوعيد كل وقت وفي كل ناد. وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه فأبى إلا مضيًا على الإنكار عليهم وعيب دينهم. فكيف يقال: إن الآية اقتضت تقريره لهم. معاذ الله من هذا الزعم الباطل. وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة كما تقدم، وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدًا فإنه دين باطل فهو مختص بكم لا نشرككم فيه، ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق. فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم. فأين الإقرار حتى يدعي النسخ أو التخصيص. أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال لهم: لكم دينكم ولي دين. بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين، إلى أن يطهر الله منهم عباده وبلاده.
وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول ﷺ أهل سنته، وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته. إذا قال لهم خلفاء الرسول وورثته: لكم دينكم ولنا ديننا. لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم، بل يقولون لهم: هذه براءة منها، وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان.
فهذا ما فتح الله العظيم به من هذه الكلمات اليسيرة، والنبذة المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها، وبديع نظمها من غير استعانة بتفسير، ولا تتبع لهذه الكلمات من مظان توجد فيه. بل هي استملاء مما علمه الله وألهمه بفضله وكرمه. والله يعلم أني لو وجدتها في كتاب لأضفتها إلى قائلها، ولبالغت في استحسانها وعسى الله المان بفضله الواسع العطاء الذي عطاؤه على غير قياس المخلوقين أن يعين على تعليق تفسير هذا النمط، وهذا الأسلوب، وقد كتبت على مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما يسنح من هذا الغمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدس. والله المرجو إتمام نعمته.
ولنذكر تمام الكلام على أقسام ما ومواقعها فقد ذكرنا منها الموصولة. ومن أقسامها المصدرية، ومعنى وقوعها عليه أنها إذا دخلت على الفعل كان معها في تأويل المصدر. هكذا أطلق النحاة. وهنا أمور يجب التنبيه عليها والتنبه لها:
أحدها: الفرق بين المصدر الصريح والمصدر المقدر مع ما. والفرق بينههما. أنك إذا قلت: يعجبني صنعك. فالإعجاب هنا واقع على نفس الحدث بقطع النظر عن زمانه ومكانه، وإذا قلت: يعجبني ما صنعك فالإعجاب واقع على صنع ماض، وكذلك ما تصنع واقع على مستقبل فلم تتحد دلالة ما والفعل والمصدر.
الثاني: أنها لا تقع مع كل فعل في تأويل المصدر وإن وقع المصدر في ذلك الموضع. فإنك إذا قلت: يعجبني قيامك كان حسنًا. فلو قلت: يعجبني ما تقوم، لم يكن كلامًا حسنًا، وكذلك يعجبني ما تقوم وما تجلس، أي قيامك وجلوسك. ولو أتيت بالمصدر كان حسنًا، وكذلك إذا قلت: يعجبني ما تذهب لم يكن في الجوازة والاستعمال مثل يعجبني ذهابك.
فقال أبو القاسم السهيلي: الأصل في هذا أن ما. لما كانت اسمًا مبهمًا لم يصح وقوعها إلا على جنس تختلف أنواعه. فإن كان المصدر مختلف الأنواع جاز أن تقع عيه ويعبر بها عنه، كقولك: يعجبني ما صنعت، وما عملت، وما حكمت لاختلاف الصنعة والعلم والحكم. فإن قلت: يعجبني ما جلست، وما قعدت وما نطلق زيد كان غثًا من الكلام لخروج ما عن الإبهام ووقوعها على ما لا يتنوع من المعاني، لأنه يكون التقدير يعجبني الجلوس الذي جلست، والقعود الذي قعدت فيكون آخر الكلام مفسرًا لأوله رافعًا للأبهام. فلا معنى حينئذ لما فأما قوله تعالى: { ذلك بما عصوا } [229] فلأن المعصية تختلف أنواعها. وقوله: { بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون }، [230] فهو كقولك: لأعاقبنك بما ضربت زيدًا، وبما شتمت عمرًا أوقعتها على الذنب والذنب مختلف الأنواع ودل ذكر المعاقبة والمجازاة على ذلك وكأنك قلت: لأجزينك بالذنب الذي هو ضرب زيد، أو شتم عمرو فما على بابها غير خارجة عن إبهامها.
هذا كلامه، وليس كما زعم رحمه الله فإنه لا يشترط في كونها مصدرية ما ذكر من الإبهام، بل تقع على المصدر الذي لا تختلف أنواعه، بل هو نوع واحد فإن إخلافهم ما وعد الله كان نوعًا واحدًا مستمرًا معلومًا. وكذلك كذبهم.
وأصرح من هذا كله قوله تعالى: { كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون } [231] فهذا مصدر معين خاص لا إبهام فيه بوجه وهو علم الكتاب ودرسه، وهو فرد من أفراد العمل والصنع، فهو كما منعه من الجلوس والقعود والانطلاق. ولا فرق بينهما في إبهام، ولا تعيبن إذ كلاهما معين متميز غير مبهم ونظيره: { بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون }، [232] فاستكبارهم وقولهم على الله غير الحق مصدر أن معيان غير مبهمين، واختلاف أفرادهما كاختلاف أفراد الجلوس والانطلاق، ولو أنك قلت: في الموضع الذي منعه هذا بما جلست، وهذا بما نطقت، كان حسنًا غير غث، ولا مستكره وهو المصدر بعينه فلم يكن الكلام غثًا بخصوص المصدر، وإنما هو لخصوص التركيب. فإن كان ما يقدر امتناعه واستكراهه إذا صغته في تركيب آخر زالت الكراهية والغثاثة عنه كما رأيت.
والتحقيق أن قوله: يعجبني ما تجلس، وما ينطلق زيد. إنما استكره وكان غثًا، لأن ما المصدرية والموصولة يتعاقبان غالبًا، ويصلح أحدهما في الموضع الذي يصلح فيه الآخر، وربما احتملها كلام واحد ولا يميز بينهما فيه إلا بنظر وتأمل. فإذا قلت: يعجبني ما صنعت فهي صالحة، لأن تكون مصدرية أو موصولة، وكذلك: { والله عليم بما يفعلون }، [233] { والله بصير بما يعملون }، [234] فتأمله تجده كذلك.
ولدخول إحداهما على الأخرى. ظن كثير من الناس أن قوله تعالى: { والله خلقكم وما تعملون }، [235] إنها مصدرية واحتجوا بها على خلق الأعمال، وليست مصدرية، وإنما هي موصولة، والمعنى والله خلقكم، وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من الأصنام، فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله، ولو كانت مصدرية لكان الكلام إلى أن يكون حجة لهم أقرب من أن يكون حجة عليهم. إذ يكون المعنى: { أتعبدون ما تنحتون } [236] والله خلق عبادتكم لها فأي معنى في هذا وأي حجة عليهم.
والمقصود أنه كثيرًا ما تدخل إحداهما على الأخرى ويحتملها الكلام سواء.
وأنت لو قلت: تعجبني الذي يجلس. لكان غثًا من المقال إلا تأتي بموصوف يجري هذا صفة له فتقول: يعجبني الجلوس الذي تجلس، وكذلك إذا قلت: يعجبني الذي ينطلق زيد كان عثًا. فإذا قلت: يعجبني الانطلاق الذي ينطلق زيد كان حسنًا. فمن هنا استغث يعجبني ما ينطلق وما تجلس إذا أردت به المصدر.
وأنت لو قلت: آكل ما يأكل كانت موصولة وكان الكلام حسنًا. فلو أردت بها المصدرية، والمعنى آكل أكلك كان غثًا حتى تأتي بضميمة تدل على المصدر. فتقول: آكل كما يأكل فعرفت أنه لم يكن الاستكراه الذي أشار إليه من جهة الإبهام والتعيين، فتأمله.
وأما طالما يقوم زيد، وقل ما يأتي عمرو فما هنا واقعة على الزمان. والفعل بعدها متعد إلى ضميره بحرف الجر. والتقدير طال زمان يقوم فيه زيد وقل زمان يأتينا فيه عمر، وثم حذف الضمير فسقط الحرف هذا تقدير طائفة من النحاة منهم السهيلي وغيره.
ويحتمل عندي تقديرين آخرين هما أحسن من هذا.
أحدهما: أن تكون مصدرية وقتية والتقدير طال قيام زيد وقل إتيان عمرو. وإنما كان هذا أحسن، لأن حذف العائد من الصفة قبيح بخلاف حذفه إذا لم يكن عائدًا على شيء فإنه أسهل. وإذا جعلت مصدرية كان حذف الضمير حذف فضلة غير عائد على موصوف.
والتقدير الثالث وهو أحسنها: إن ما ههنا مهيئة لدخول الفعل على الفعل ليست مصدرية ولا نكرة، إنما أتى بها لتكون مهيئة لدخول طال على الفعل. فإنك لو قلت: طال يقوم زيد وقل يجنىء عمرو لم يجز. فإذا أدخلت ما استقام الكلام وهذا كما دخلت على رب مهيئة لدخولها على الفعل نحو قوله: { ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين }، [237] وكما دخلت على إن مهيئة لدخولها على الفعل نحو: { إنما يخشى الله من عباده العلماء }. [238] فإذا عرفت هذا فقول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، هو من هذا الباب ودخلت ما بين كاف التشبيه وبين الفعل مهيئة لدخولها عليه فهي كافة للخافض ومهيئة له أن تقع بعد الفعل، وهذا قد خفي على أكثر النحاة حتى ظن كثير منهم أن ما ههنا مصدرية. وليس كما ظن فإنه لم يقع التشبيه بالرؤية. وأنت لو صرحت بالمصدر هنا، لم يكن كلامًا صحيحًا فإنه لو قيل: صلوا كرؤيتكم صلاتي لم يكن مطابقًا للمعنى المقصود فلو قيل: إنها موصولة والعائد محذوف، والتقدير صلوا كالتي رأيتموني أصلي أي كالصلوات التي رأيتموني أصليها كان أقرب من المصدرية على كراهته. فالصواب ما ذكرته لك.
ونظير هذه المسألة قوله ﷺ للصديق: «كما أنت»، فأنت مبتدأ والخبر محذوف فلا مصدر هنا إذ لا فعل، فمن قال إنها مصدرية فقد غلظ، وإنما هي مهيئة لدخول الكاف على ضمير الرفع، والمعنى كما أنت صانع أو كما أنت مصل فدم على حالتك.
ونظير ذلك أيضا وقوعها بين بعد والفعل نحو قوله تعالى: { من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم }، [239] ليست مصدرية كما زعم أكثر النحاة، بل هي مهيئة لدخول بعد على فعل كاد إذ لا يصاغ من كاد وما مصدر إلا أن يتشجم له فعل بمعناه يسبك منها. ومن ذلك الفعل مصدر، وعلى ما قررناه لا يحتاج إلى ذلك ويؤيد هذا قول الشاعر:
أعلَاقَةٌ أمَّ الوليد بعدما ** أفنانُ رأسك كالثَّغام المُخلِس
أفلا تراها ههنا حيث لا فعل ولا مصدر أصلًا، فهي كقوله "كما أنت" مهيئة لدخول "بعد" على الجملة الإبتدائية، ولكن الخبر في البيت مذكور، وهو في قوله "كما أنت" محذوف.
فإن قلت: فما بالهم لم يدخلوها في قبل كافة لها مهيئة لدخولها على الفعل والجملة قبلما يقوم زيد وقبل ما زيد قائم.
قلت: لا تكون ما كافة لأسماء الإضافة، وإنما تكون كافة للحروف وبعد أشد مضارعة للحروف من قبل، لأن قبل كالمصدر في لفظها ومعناها تقول: جئت قبل الجمعة تريد الوقت الذي تستقبل في الجمعة. فالجمعة بالإضافة إلى ذلك الوقت قابله كما قال الشاعر: * نحج معًا، قالت أعامًا وقابله * فإذا كان العام الذي بعد عامك يسمى قابلًا فعامك الذي أنت فيه قبل، ولفظه من لفظ قابل. فقد بان لك من جهة اللفظ والمعنى أن "قبل" مصدر في الأصل، والمصدر كسائر الأسماء لا يكف به ولا يهيأ لدخول الجمل بعد، وإنما ذلك في بعض العوامل لا في شيء من الأسماء، وأما "بعد" فهي أبعد عن شبه المصدر، وإن كانت تقرب من لفظ بعد ومن معناه. فليس قربها من لفظ المصدر كقرب قبل؛ ألا ترى أنهم لم يستعملوا من لفظها اسم فاعل فيقولون للعام الماضي الباعد، كما قالوا للمستقبل القابل.
فإن قلت: فما تقول في قوله: { كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم }، [240] وقوله: { واذكروه كما هداكم }، [241] وقوله: { وأحسن كما أحسن الله إليك }، [242] فإنها لا يمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلها فهل هي كافة مهيئة أو مصدرية؟
قلت: التحقيق أنها كافة لحرف التشبيه عن عمله مهيئة لدخوله على الفعل. ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وإن لم تكن مصدرية محضة، ويدل على أن ما لا تقع مصدرية على حد أن إنك تجدها لا تصلح في موضع تصلح فيه أن. فإذا قلت: أريد أن تقوم كان مستقيمًا، فلو قلت: أريد ما تقوم لم يستقم، وكذلك أحب أن تأتيني. لا تقول موضعه أحب تأتيني.
وسر المسألة أن المصدرية ملحوظ فيها معنى الذي كما تقدم بخلاف أن.
فإن قلت: فما تقول في كلما قمت أكرمتك أمصدرية هنا أم كافة أم نكرة؟
قلت: هي ههنا نكرة وهي ظرف زمان في المعنى. والتقدير كل وقت تقوم فيه أكرمك.
فإن قلت: فهلا جعلتها كافة لإضافة كل إلى الفعل مهيئة لدخولها عليه.
قلت: ما أحراها بذلك لولا ظهور الظرف، والوقت، وقصده من الكلام فلا يمكن إلغاؤه مع كونه هو المقصود. ألا ترى أنك تقول: كل وقت يفعل كذا أفعل كذا. فإذا قلت: كلما فعلت فعلت. وجدت معنى الكلامين واحدًا، وهذا قول أئمة العربية وهو الحق.
فصل: الرد على المعتزلة
قال أبو القاسم السهيلي: اعلم أن ما إذا كانت موصولة بالفعل الذي لفظه عمل أو صنع أو فعل وذلك الفعل مضاف إلى فاعل غير الباري سبحانه فلا يصح وقوعها إلا على مصدر، لإجماع العقلاء من الأنام في الجاهلية والإسلام على أن أفعال الآدميين لا تتعلق بالجواهر والأجسام، لا تقول: عملت جملًا، ولا صنعت جبلًا ولا حديدًا ولا حجرًا ولا ترابًا. فاذا قلت: أعجبني ما عملت وما فعل زيد، فإنما يعني الحدث. فعلى هذا لا يصح في تأويل قوله تعالى: { والله خلقكم وما تعملون } [243] إلا قول أهل السنة أن المعنى والله خلقكم وأعمالكم، ولا يصح قول المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول لأنهم زعموا أن ما واقعة على الحجارة التي كانوا ينحتونها أصنامًا. وقالوا: تقدير الكلام خلقكم والأصنام التي تعلمون إنكارًا منهم أن تكون أعمالنا مخلوقة لله سبحانه، واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالوا لأنه تقدم قوله: { أتعبدون ما تنحتون } فما واقعة على الحجارة المنحوتة، ولا يصح غير هذا من جهة النحو، ولا من جهة المعنى. أما النحو فقد تقدم أن ما لا تكون مع الفعل الخاص مصدرًا. وأما المعنى فإنهم لم يكونوا يعبدون النحت، وإنما كانوا يعبدون المنحوتات، فلما ثبت هذا وجب أن تكون الآية التي هي رد عليهم وتقييد لهم واقعة على الحجارة المنحونة والأصنام المعبودة. ويكون التقدير تعبدون حجارة منحوتة والله خلقكم وتلك الحجارة التي تعملون!
هذا كله معنى قول المعتزلة وشرح ما شبهوا به، والنظم على تأويل أهل الحق أبدع والحجة أقطع. والذي ذهبوا إليه فاسد محال، لأنهم أجمعوا معنا على أن أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام.
فإن قيل: فقد تقول عملت الصحيفة وصنعت الجفنة، وكذلك الأجسام معمولة على هذا.
قلنا: لا يتعلق الفعل فيما ذكرتم إلا بالصورة التي هي التأليف والتركيب، وهي نفس العمل. وأما الجوهر المؤلف المركب فليس بمعمول لنا. فقد رجع العمل والفعل إلى الأحداث دون الجواهر. هذا إجماع منا ومنهم، فلا يصلح حملهم على غير ذلك.
وأما ما زعموا من حسن النظم وإعجاز الكلام فهو ظاهر، وتأويلنا معدوم في تأويلهم، لأن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده بالخلق، وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم يخلقون فقال: { أتعبدون ما تنحتون }، [244] أي من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون، وتدعون عبادة من خلقكم وأعمالكم التي تعملون، ولو لم يضف خلق الأعمال إليه في الآية وقد نسبها إليهم بالمجاز ما قامت له حجة من نفس الكلام، لأنه كان يجعلهم خالقين لأعمالهم وهو خالق لأجناس أخر فيشركهم معه في الخلق تعالى الله عن قول الزائغين ولا لعا لعثرات المبطلين، فما أدحض حجتهم، وما أوهى قواعد مذهبهم، وما أبين الحق لمن اتبعه، جعلنا الله من أتباعه وحزبه.
وهذا الذي ذكرناه قاله أبو عبيد في قول حذيفة: إن الله يخلق صانع الخَزَم وصنعته واستشهد بالآية. وخالفه القتيبي في إصلاح الغلط فغلط أشد الغلط ووافق المعتزلة في تأويلها، وإن لم يقل بقيلها. هذا آخر كلام أبي القاسم.
ولقد بالغ في رد ما لا تحتمل الآية سواه أو ما هو أولى بحملها وأليق بها، ونحن وكلُّ محق مساعدوه على أن الله خالق العباد وأعمالهم، وأن كل حركة في الكون فالله خالقها. وعلى صحة هذا المذهب أكثر من ألف دليل من القرآن والسنة والمعقول والفطر. ولكن لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بها حرصًا على جعلها عليهم حجة. ففي سائر الأدلة غنية عن ذلك على أنها حجة عليهم من وجه آخر مع كون ما بمعنى الذي سنبينه إن شاء الله تعالى.
والكلام إن شاء الله في الآية قي مقامين:
أحدهما في سلب دلالتها على مذهب القدرية. والثاني في إثبات دلالتها على مذهب أهل الحق خلاف قولهم. فههنا مقامان: مقام إثبات ومقام سلب.
فأما مقام السلب فزعمت القدرية أن الآية حجة لهم في كونهم خالقين أعمالهم. قالوا: لأن الله سبحانه أضاف الأعمال إليهم. وهذا يدل على أنهم هم المحدثون لها، وليس المراد ههنا نفس الأعمال، بل الأصنام المعمولة فأخبر سبحانه أنه خالقهم، وخالق تلك الأصنام التي عملوها. والمراد مادتها وهي التي وقع الخلق عليها.
وأما صورتها وهي التي صارت بها أصنامًا فإنها بأعمالهم وقد أضافها إليهم فتكون بأحداثهم وخلقهم فهذا وجه احتجاجهم بالآية.
وقابلهم بعض المثبتين للقدر، وأن الله هو خالق أفعال العباد. فقالوا: الآية صريحة في كون أعمالهم مخلوقة الله فإن ما ههنا مصدرية والمعنى والله خلقهم وخلق أعمالهم. وقرروه بما ذكره السهيلي وغيره، ولما أورد عليهم القدرية كيف تكون ما مصدرية هنا وأي وجه يبقى للاحتجاج عليهم إذا كان المعنى والله خلقكم وخلق عبادتكم وهل هذا إلا تلقين لهم الاحتجاج بأن يقولوا: فإذا كان الله قد خلق عبادتنا للأصنام فهي مرادة له، فكيف ينهانا عنها؟ وإذا كانت مخلوقة مرادة فكيف يمكننا تركها؟ فهل يسوغ أن يحتج على إنكار عبادتهم؟ أجابهم المثبتون بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية. ومقصودها لعرفتم صحة الاحتجاج، فإن الله سبحانه أنكر عليهم عبادة من لا يخلق شيئًا أصلًا، وترك عبادة من هو خالق لذواتهم وأعمالهم. فإذا كان الله خالقكم وخالق أعمالكم. فكيف تدعون عبادته وتعبدون من لا يخلق شيئًا لا ذواتكم ولا أعمالكم؟ وهذا من أحسن الاحتجاج.
وقد تكرر في القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا ما لا يخلق شيئًا وسوى بينه وبين الخالق لقوله: { أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون }، [245] وقوله: { والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون }، [246] وقوله: { هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه }، [247] إلى أمثال ذلك فصح الاحتجاج وقامت الحجة بخلق الأعمال مع خلق الذوات، فهذا منتهى اقدام الطائفتين في الآية كما ترى.
والصواب أنها موصولة، وأنها لا تدل على صحة مذهب القدرية. بل هي حجة عليهم مع كونها موصولة، وهذا يتبين بمقدمة نذكرها قبل الخوض في التقرير. وهي أن طريقة الحجاج والخطاب أن يجرد القصد والعناية بحال ما يحتج له وعليه، فإذا كان المستدل محتجًا على بطلان ما قد ادعى في شيء وهو يخالف ذلك، فإنه يجرد العناية إلى بيان بطلان تلك الدعوى، وأن ما ادُّعي له ذلك الوصف هو متصف بضده لا متصف به. فأما أن يمسك عنه ويذكر وصف غيره فلا.
وإذا تقرر هذا فالله سبحانه أنكر عليهم عبادتهم الأصنام، وبين أنها لا تستحق العبادة. ولم يكن سياق الكلام في معرض الإنكار عليهم ترك عبادته وأن ما هو في معرض الإنكار عبادة من لا يستحق العبادة، فلو أنه قال: لا تعبدون الله وقد خلقكم وما تعملون لتعينت المصدرية قطعًا، ولم يحسن أن يكون بمعنى الذي إذ يكون المعنى كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وأوجد أعمالكم فهو المنعم عليكم بنوعي الإيجاد والخلق، فهذا وزان ما قرروه من كونها مصدرية، فأما سياق الآية فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة من لا يستحق العبادة فلا بد أن يبين فيه معنى ينافي كونه معبودًا. فبين هذا المعنى بكونه مخلوقًا له، ومن كان مخلوقًا في بعض مخلوقاته فإنه لا ينبغي أن يعبد ولا تليق به العبادة.
وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله: { والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون }، [248] كيف أنكر عليهم عبادة الهة مخلوقة له سبحانه وهي غير خالقة. فهذا يبين المراد من قوله: { والله خلقكم وما تعملون }، [249] ونظيره قوله في سورة الأعراف: { إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم }، [250] أي هم عباد مخلوقون كما أنتم كذلك. فكيف تعبدون المخلوق.
وتأمل طريقة القرآن لو أراد المعنى الذي ذكروه من حسن صفاته وانفراده بالخلق كقول صاحب يس: { وما لي لا أعبد الذي فطرني }، [251] فهنا لما كان المقصود إخبارهم بحسن عبادته واستحقاقه لها. ذكر الموجب لذلك وهي كونه خالقًا لعابده فاطرًا له، وهذا إنعام منه عليه. فكيف يترك عبادته. ولو كان هذا هو المراد من قوله: { والله خلقكم وما تعملون }، [252] كان يقتضي أن يقال ألا يعبدون الله وهو خالقهم وخالق أعمالهم. فتأمله فإنه واضح.
وقول أبي القاسم رحمه الله في تقرير حجة المعتزلة من الآية، إنه لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل. من جهة النحو ليس كذلك.
أما قوله: أن ما لا تكون مع الفعل الخاص مصدرًا، فقد تقدم بطلانه إذ مصدريتها تقع مع الفعل الخاص المبهم لقوله تعالى: { بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون }، [253] وقوله: { بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون } [254] إلى أضعاف ذلك، فإن هذه كلها أفعال خاصة وهي أخص من مطلق العمل فإذا جاءت مصدرية مع هذه الأفعال فمجيئها مصدرية مع العمل أولى.
قولهم إنهم لم يكونوا يعبدون النحت وإنما عبدوا المنحوت حجة فاسدة فإن الكلام في ما المصاحبة للفعل دون المصاحبة لفعل النحت فإنها لا تحتمل غير الموصولة ولا يلزم من كون الثانية مصدرية كون الأولى كذلك فهذا تقرير فاسد * وأما تقريره كونها مصدرية أيضا بما ذكره فلا حجة له فيه.
أما قوله أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام، فيقال ما معنى عدم وقوعها على الجواهر والأجسام؟ أتعني به أن أفعالهم لا تتعلق بإيجادها، أم تعني به أنها لا تتعلق بتغييرها وتصويرها، أم تعني به أعم من ذلك وهو المشترك بين القسمين؟
فإن عنيت الأول فمسلم لكن لا يفيدك شيئا، فإن كونها موصولة لا يستلزم ذلك، فإن كون الأصنام معمولة لهم يقتضي أن تكون مادتها معمولة لهم، بل هو على حد قولهم "عملت بيتا، وعملت بابا، وعملت حائطا، وعملت ثوبا" وهذا إطلاق حقيقي ثابت عقلا ولغة وشرعا وعرفا لا يتطرق إليه رد، فهذا ككون الأصنام معمولة سواء.
وإن عنيت أن أفعالهم لا تتعلق بتصويرها فباطل قطعا. وإن عنيت القدر المشترك فباطل أيضا، فإنه مشتمل على نفي حق وباطل فنفي الباطل صحيح ونفي الحق باطل.
ثم يقال إيقاع العمل منهم على الجواهر والأجسام يجوز أن يطلق فيه العمل الخاص وشاهده في الآية: { أتعبدون ما تنحتون } [255] فما ههنا موصولة فقد أوقع فعلهم وهو النحت على الجسم وحينئذ فأي فرق بين إيقاع أفعالهم الخاصة على الجوهر والجسم وبين إيقاع أفعالهم العامة عليه لا بمعنى أن ذاته مفعولة له، بل بمعنى أن فعلهم هو الذي صار به صنما واستحق أن يطلق عليه اسمه كما أنه بعملهم صار منحوتا واستحق هذا الاسم وهذا بين.
وأما قوله بجواب النقض بعملت الصحيفة وصنعت الجفنة أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التأليف والتركيب وهي نفس العمل، فكذلك هو أيضا متعلق بالتصوير الذي صار الحجر به صنما منحوتا سواء.
وأما قوله الآية في بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده بالخلق فقد تقدم جوابه وأن الآية وردت لبيان عدم استحقاق معبوديهم للعبادة لأنها مخلوقة لله وذكرنا شواهده من القرآن.
فإن قيل كان يكفي في هذا أن يقال أتعبدون ما تنحتون والله خالقه فلما عدل إلى قوله: { والله خلقكم وما تعملون } [256] علم أنه أراد الاحتجاج عليهم في ترك عبادته سبحانه وهو خالقهم وخالق أفعالهم.
قيل: في ذكر خلقه سبحانه لآلهتهم ولعابديها من بيان تقبيح حالهم وفساد رأيهم وعقولهم في عبادتها دونه تعالى ما ليس في الاقتصار على ذكر خلق الآلهة فقط فإنه إذا كان الله تعالى هو الذي خلقكم وخلق معبوديكم فهي مخلوقة أمثالكم، فكيف يعبد العاقل من هو مثله ويتألهه ويفرده بغاية التعظيم والإجلال والمحبة؟ وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسكم وفي حق ربكم!
وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله: { إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم }، [257] ومن حق المعبود أن لا يكون مثل العابد، فإنه إذا كان مثله كان عبدا مخلوقا، والمعبود ينبغي أن يكون ربا خالقا. فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه. فقد أسفر لك من المعنى المقصود بالسياق صبحه ووضح لك شرحه وانجلى بحمد الله الإشكال وزال عن المعنى غطاء الإجمال وبان أن ابن قتبية في تفسير الآية وفق للسداد كما وفق لموافقة أهل السنة في خلق أعمال العباد. ولا تستطل هذا الفصل فإنه يحقق لك فصولا لا تكاد تسمعها في خلال المذاكرات ويحصل لك قواعد وأصولا لا تجدها في عامة المصنفات.
فإن قيل فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد على تقدير كون ما موصولة؟
قيل: نعم قد سبق الوعد بذلك وقد حان انجازه وآن ابرازه. ووجه الاستدلال بها على هذا التقدير أن الله سبحانه أخبر أنه خالقهم وخالق الأصنام التي عملوها وهي إنما صارت أصناما بأعمالهم فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم فإذا كان سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها بجملتها أعني مادتها وصورتها، فإذا كانت صورتها مخلوقة لله كما أن مادتها كذلك، لزم أن يكون خالقا لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة لأنه متولد عن نفس حركاتهم. فإذا كان الله خالقها كانت أعمالهم التي تولد عنها ما هو مخلوق الله مخلوقة له، وهذا أحسن استدلالا وألطف من جعل ما مصدرية.
ونظيره من الاستدلال سواء قوله: { وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون * وخلقنا لهم من مثله ما يركبون }. [258] والأصح أن المثل المخلوق هنا هو السفن وقد أخبر أنها مخلوقة وهي إنما صارت سفنا بأعمال العباد. وأبعد من قال إن المثل ههنا هو سفن البر وهي الإبل لوجهين:
أحدهما أنها لا تسمي مثلا للسفن لا لغة ولا حقيقة، فإن المثلين ما سد أحدهما مسد الآخر، وحقيقة المماثلة أن يكون بين فلك وفلك لا بين جمل وفلك.
الثاني أن قوله: { إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم }، [259] عقب ذلك دليل على أن المراد الفلك التي إذا ركبوها قدرنا على إغراقهم فذكرهم بنعمه عليهم من وجهين: أحدهما ركوبهم إياها، والثاني أن يسلمهم عند ركوبها من الغرق.
ونظير هذا الاستدلال أيضا قوله تعالى: { والله جعل لكم مما خلق ظلالًا وجعل لكم من الجبال أكنانًا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم } [260] والسرابيل التي يلبسونها وهي مصنوعة لهم، وقد أخبر بأنه سبحانه هو جاعلها، وإنما صارت سرابيل بعملهم. ونظيره: { والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتًا } [261] والبيوت التي من جلود الأنعام هي الخيام، وإنما صارت بيوتًا بعملهم.
فإن قلت: المراد من هذا كله المادة لا الصورة.
قلت: المادة لا تستحق هذه الأسماء التي أطلق الخلق عليها، وإنما تستحق هذه الأسماء بعد عملها وقيام صورها بها، وقد أخبر أنها مخلوقة له في هذه الحال. والله أعلم.
فائدة: ضمير من يكرمني
الذي يدل على أن الضمير من يكرمني ونحوه الياء دون ما معها وجوه:
أحدها: القياس على ضمير المخاطب، والغائب في أكرمك وأكرمه.
الثاني: أن الضمير في قولك أني وأخواته هو الياء وحدها لسقوط النون اختيارًا في بعضها، وجوازًا في أكثرها، وسماعًا في بعضها، ولو كان الضمير هو الحرفين لم يسقطوا أحدهما.
الثالث: إدخالهم هذه النون في بعض حروف الجر وهي من وعن. ولو كانت جزءًا من الضمير لأطردت في إلي وفي وسائر حروف الجر. فإن قلت: فما وجه اختصاصها ببعض الحروف والأسماء، والجواب: أنهم أرادوا فصل الفعل والحروف المضارعة له من توهم الإضافة إلى الياء، فألحقوها علامة للانفصال. وهي في أكثر الكلام نون ساكنة وهو التنوين. فإنه لا يوجد في الكلام إلا علامة لانفصال الاسم. ولذلك ألحقوها في القوافي المعرفة باللام أبدًا بإتمام البيت وانفصاله مما بعده نحو العتابا والزرافا، ولذلك زادوها قبل علامة الإنكار حين أرادوا فصل الاسم من العلامة كي لا يتوهم أنها تمام الاسم، أو علامة جمع. ففصل بين الاسم وبينها بنون زائدة، وأدخل عليها ألف الوصل لسكونها، ثم حركتها بالكسر لالتقاء الساكنين. فلما كان من أصلهم تخصيص النون بعلامة الانفصال واجبًا وأرادوا فصل الفعل وما ضارعه عن الإضافة إلى الياء، جاؤوا بهذه النون الساكنة ولولا سكون الياء لكانت ساكنة كالتنوين، ولكنهم كسروها لالتقاء الساكنين.
فائدة: حذف الألف من ما الاستفهامية
السر في حذف الألف من ما الاستفهامية عند حرف الجر أنهم أرادوا مشاكلة اللفظ للمعنى فحذفوا الألف، لأن معنى قولهم فيم ترغب في أي شيء وإلى م تذهب إلى أي شيء، وحتام لا ترجع حتى أي غاية تستمر ونحوه، فحذفوا الألف مع الجار ولم يحذفوها في حال النصب والرفع كيلا تبقى الكلمة على حرف واحد. فإذا اتصل بها حرف الجر، أو اسم مضاف اعتمدت عليه، لأن الخافض والمخفوض بمنزلة كلمة واحدة.
وربما حذفوا الألف في غير موضع الخفض، ولكن إذا حذفوا الخبر. فيقولون: مه يا زيد؟ أي ما الخبر وما الأمر؟ فلما كثر الحذف في المعنى كثر في اللفظ، ولكن لا بد من هاء السكت لتقف عليها.
ومنه قولهم: مهيم كان الأصل ما هذا يا امرؤ؟ فاقتصروا من كل كلمة على حرف. وهذا غاية الاختصار والحذف. والذي شجعهم على ذلك أمنهم من اللبس لدلالة حال المسؤول والمسؤول عنه على المحذوف، فيهم المخاطب من قوله مهيم ما يفهم من تلك الكلمات الأربع. ونظير هذا قولهم "أيش" في "أي شيء"، و"م الله" في و"أيمين الله".
فائدة بديعة: قوله ثم لننزعن من كل شيعة
قوله عز وجل: { ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيًا }، [262] الشيعة الفرقة التي شايع بعضها بعضًا أي تابعه. ومنه الأشياع أي الأتباع. فالفرق بين الشيعة والأشياع: أن الأشياع هم التبع. والشيعة القوم الذين شايعوا أي تبع بعضهم بعضًا، وغالب ما يستعمل في الذم، ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك كهذه الآية وكقوله: { إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا }، [263] وقوله: { وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل }، [264] وذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتماع، ولهذا لا يطلق لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. والمعنى لننزعن من كل فرقة أشدهم عتوًا على الله وأعظمهم فسادًا، فنلقيهم في النار. وفيه إشارة إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات أولا ثم تكون الأتباع تبعًا لهم فيه، كما كانوا تبعًا لهم في الدنيا.
و { أيهم أشد } للنحاة فيه أقوال:
أحدها: قول الخليل أنه مبتدأ وأشد خبره، ولم يعمل لننزعن فيه، لأنه محكي، والتقدير الذي يقال فيه: { أيهم أشد على الرحمن عتيًا وعلى هذا فأي استفهامية.
الثاني: قول يونس أنه رفع على جهة التعليق للفعل السابق. كما لو قلت علمت أنه أخوك فعلق الفعل عن الفعل كما تعلق أفعال القلوب.
الثالث: قول سيبويه إن أي هنا موصولة مبنية على الضم والمسوغ لبنائها حذف صدر صلتها وعنده أصل الكلام أيهم هو أشد. فلما حذف صدر الصلة بنيت على الضم تشبيهًا لها بالغايات، التي قد حذفت مضافاتها كقبل وبعد. وعلى كل واحد من الأقوال إشكالات نذكرها، ثم نبين الصحيح إن شاء الله.
فأما قول الخليل: فقيل يلزمه ستة أمور:
أحدها: حذف الموصول.
الثاني: حذف الصلة.
الثالث: حذف العائد، لأن تقديره الذي يقال لهم: إنهم أشد، وهذا لا عهد لنا فيه باللغة. وأما ما يحذف من القول فإنه إنما يكون قولًا مجردًا عن كونه صلة لموصول نحو قوله: { والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم }، [265] أي: يقولون أو قائلين. ومثله: { والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى }. [266]
الرابع: أنه إذا قدر المحذوف هكذا لم يستقم الكلام فإنه يصير { لننزعن من كل شيعة } الذي يقال فيهم: { أيهم أشد } وهذا فاسد فإن ذلك المنزوع لا يقال فيه أيهم أشد بل هو نفسه أشد، أو من أشد الشيعة على الرحمن فلا يقع عليه الاستفهام بعد نزعه، فتأمله.
الخامس: أن الاستفهام لا يقع إلا بعد أفعال العلم والقول على الحكاية، ولا يقع بعد غيره من الأفعال. تقول: علمت أزيد عندك، أم عمرو، ولو قلت: ضربت أزيد أم عمرو ولم يجز وننزعن ليس من أفعال العلم. فإذا قلت: ضربت أيهم قام لم تكن إلا موصولة ولا يصح أن يقال ضربت الذي يقال فيه أيهم قال، وإنما توهم مثل ذلك لكون اللفظ صالحًا لجهة أخرى مستقيمة فيتوهم متوهم أن حمله على الجهة الأخرى يسقيم. والذي يدل عليه أنه لو قدرت موضعه استفهامًا صريحًا ليس له جهة أخرى لم يجز. فلو قلت: ضرب أزيد عندك أم عمرو لم يجز بخلاف ضرب أيهم عندك. فلو كان أيهم استفهامًا لجاز الكلام مع الاستفهام الذي بمعناهما، وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم والقول. أما القول فلأنه يحكي به كل جملة خبرية كانت أو إنشائية. وأما أفعال العلم فإنما وقع بعدها الاستفهام لكون الاستفهام مستعلمًا به. فكأنك إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو كان معناه اعلمني. وإذا قلت: علمت أزيد عندك أم عمرو؟ كان معناه علمت ما يطلب استعلامه فلهذا صح وقوع الاستفهام بعد العلم. لأنه استعلام، ثم حمل الحسبان والظن عليهما لكونهما من بابه. ووجه آخر وهو كثرة استعمال أفعال العلم فجعل لها شأن ليس لغيرها.
السادس: أن هذا الحذف الذي قدره في الآية حذف لا يدل عليه سياق فهو مجهول الوضع. وكل حذف كان بهذا المنزلة كان تقديره من باب علم الغيب.
وأما قول يونس فإشكاله ظاهر فإن التعليق، إنما يكون في أفعال القلوب نحو العلم والظن والحسبان دون غيرها. ولا يجوز أن تقول: ضربت أيهم. قام على أن تكون أيهم استفهامًا وقد علق الفعل عن العمل فيه.
وأما قول سيبويه فإشكاله أنه بناء خارج عن النظائر ولم يوجد في اللغة شاهد له.
قال السهيلي: ما ذكره سيبويه لو استشهد عليه بشاهد من نظم أو نثر أو وجدنا بعده في كلام فصيح شاهدًا له لم نعدل به قولًا ولا رأينا لغيره عنه طولًا، ولكنا لم نجز ما بين لمخالفته غيره، لا سيما مثل هذه المخالفة فإنا لا نسلم أنه حذف من الكلام شيء. وإن قال: إنه حذف ولا بد والتقدير أيهم هو أخوك؛ فيقال: لم لم يبنوا في النكرة فيقولون: مررت برجل أخوك، أو رأيت رجلًا أبوك أي هو أخوك وأبوك. ولم خصوا أيًا هذا دون سائر الأسماء أن يحذف من صلته، ثم يبنى للحذف. ومتى وجدنا شيئًا من الجملة يحذف، ثم يبنى الموصوف بالجملة من أجل ذلك الحذف. وذلك الحذف لا نجعله متضمنًا لمعنى الحرف، ولا مضارعًا له. وهذه علة البناء وقد عدمت في أي.
قال: والمختار قول الخليل لكنه يحتاج إلى شرح، وذلك أنه لم يرد بالحكاية ما يسبق إلى الفهم من تقدير معنى القول، ولكنه أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو أصل في أي كما يحكيه بعد العلم. إذا قلت: قد علمت من أخوك وأقام زيد أم قعد فقد تركت الكلام على حاله قبل دخول الفعل لبقاء معنى الاختصاص والتعيين في أي الذي كان موجودًا فيها وهي استفهام، لأن ذلك المعنى هو الذي وضعت له استفهامًا كانت، أو خبرًا كما حكوا لفظ النداء في قولهم اللهم اغفر لي أيها الرجل، وارحمنا أيتها العصابة. فنحكي لفظ هذا إشعارًا بالتعيين والاختصاص الموجود في حال النداء لوجود معنى الاختصاص والتعيين فيه.
قال: وقول يونس: إن الفعل ملغى حق وإن لم تكن من أفعال القلب وعلة إلغائه ما قدمناه من حكاية لفظ الاستفهام للاختصاص.
فإذا أتممت لفظة الصلة وقلت: ضربت أيهم أخوك، زالت مضارعة الاستفهام وغلب فيه معنى الخبر لوجود الصلة التامة بعده.
قال وأما قوله تعالى: { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون }، [267] وإجماعهم على أنها منصوبة بينقلبون لا بسيعلم. وقد كان يتصور فيها أن تكون منصوبة بسيعلم على جهة الاستفهام، ولكن تكون موصولة والجملة صلتها والعائد محذوف. ولكن منع من هذا أصل أصلناه ودليل أقمناه على أن الاسم الموصول إذا عني به المصدر ووصل بفعل مشتق من ذلك المصدر لم يجز لعدم الفائدة المطلوبة من الصلة وهي إيضاح الموصول وتبيينه. والمصدر لا يوضح فعله المشتق من لفظه، لأنه كأنه هو لفظًا ومعنى إلا في المختلف الأنواع كما تقدم.
قال: ووجه آخر أقوى من هذا وهو أن أيًا لا تكون بمعنى الذي حتى تضاف إلى معرفة. فتقول: لقيت أيهم في الدار إذ من المحال أن يكون بمعنى الذي وهو نكرة. والذي لا ينكر وهذا أصل يبنى عليه في "أي".
فائدة: تحقيق معنى أي
فصل في تحقيق معنى أي
وهو أن لفظ الألف والياء المكررة راجع في جميع الكلام إلى معنى التعيين والتمييز للشيء من غيره، فمنه أياة الشمس لضوءها لأنه يبينها ويميزها من غيره، ومنه الآية العلامة، ومنه خرج القوم بآيهم أي بجماعتهم التي يتميزون بها عن غيرهم، ومنه تأييت بالمكان أي تثبت لتبيين شيء، أو تمييزه ومنه قول امرىء القيس:
قف بالديار وقوف حابسْ ** وتأيَّ إنك غير يائسْ
وقال الكميت: * وتأيَّ إنك غير صاغر *
ومنه إياك في المضمرات، لأنه في أكثر الكلام مفعول مقدم، والمفعول إنما يتقدم على فعله قصدًا إلى تعيينه وحرصًا على تمييزه من غيره وصرفًا للذهن عن الذهاب إلى غيره، ولذلك تقدم في ( إياك نعبد ) إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقيق الوحدانية ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره، ولهذا اختصت أي بنداء ما فيه الألف واللام تمييزًا له وتعيينًا، وكذلك أي زيد، ومنه إياك المراء والأسد أي ميز نفسك وأخلصها عنه. ومنه وقوع أي تفسيرًا كقولك: عندي عهن أي صوف.
وأما وقوعها نفيًا لما قبلها نحو مررت برجل أي رجل. فأي تدرجت إلى الصفة من الاستفهام كان الأصل أي رجل هو على الاستفهام الذي يراد به التفخيم والتهويل، وإنما دخله التفخيم لأنهم يريدون إظهار العجز والإحاطة لوصفه فكأنه مما يستفهم عنه بجهل كنهه. فأدخلوه في باب الاستفهام الذي هو موضوع لما يجهل. وكذلك جاء: { القارعة * ما القارعة } [268] و { الحاقة * ما الحاقة } [269] أي أنها لا يحاط بوصفها. فلما ثبت هذا اللفظ في باب التفخيم والتعظيم للشيء قرب من الوصف حتى أدخلوه في باب النعت، وأخروه في الإعراب عن ما قبله ومنه: * جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط * أي كأنه في لون الذئب إن كنت رأيت الذئب. ومنه "مررت بفارس هل رأيت الأسد"، وهذا التقدير أحسن من قول بعض النحويين أنه معمول وصف مقدر، وهو قول محذوف أي مقول فيه هل رأيت كذا، وما ذكرته لك أحسن وأبلغ فتأمله.
فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب
ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام.
أحدها: ما يرجع إلى نفس الذات كقولك: ذات وموجود وشيء.
الثاني: ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع.
الثالث: ما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرزاق.
الرابع: ما يرجع إلى التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتًا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام.
الخامس: ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه لا على معنى مفرد نحو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والغفار وأمجد الناقة علفًا. ومنه { ذو العرش المجيد } [270] صفة للعرض لسعته وعظمه وشرفه.
وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه ﷺ لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء، وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم تقتضيه كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا يحسن أنك أنت السميع البصير فهو راجع إلى المتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه.
ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام». ومنه: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام». فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده وإنه الذي لا إله إلا هو المنان. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا عند المسؤول. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارة، وقد فتح لمن بصره الله.
ولنرجع إلى المقصود وهو وصفه تعالى بالاسم المتضمن لصفات عديدة. فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. وكذلك الصمد قال ابن عباس: هو السيد الذي كمل في سؤدده. وقال ابن وائل: هو السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة: الذي ليس فوقه أحد، وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السؤدد فقد صمد له كل شيء. وقال ابن الأنباري: "لا خلاف بين أهل اللغة أن الصمد السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم". واشتقاقه يدل على هذا، فإنه في الجمع والقصد الذي اجتمع القصد نحوه، واجتمعت فيه صفات السؤدد وهذا أصله في اللغة كما قال:
ألا بكر الناعي بخير بني أسد ** بعمرو بن يربوع وبالسيد الصمد
والعرب تسمى أشرافها بالصمد لاجتماع قصد القاصدين إليه واجتماع صفات السيادة فيه.
السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو: الغني الحميد، العفو القدير، الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر. فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما، وكذلك العفو القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
وأما صفات السلب المحض فلا تدخل في أوصافه تعالى إلا أن تكون متضمنة لثبوت كالأحد المتضمن لانفراده بالربوبية والإلهية. والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله، وكذلك الإخبار عنه بالسلوب هو لتضمنها ثبوتًا كقوله تعالى: { لا تأخذه سنة ولا نوم }، [271] فإنه متضمن لكمال حياته وقيوميته وكذلك قوله تعالى: { وما مسنا من لغوب } [272] متضمن لكمال قدرته. وكذلك قوله: { وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة }، [273] متضمن لكمال علمه. وكذلك قوله: { لم يلد ولم يولد } متضمن لكمال صمديته وغناه وكذلك قوله: { ولم يكن له كفوًا أحد } متضمن لتفرده بكماله وأنه لا نظير له، وكذلك قوله تعالى: { لا تدركه الأبصار } [274] متضمن لعظمته. وأنه جل عن أن يدرك بحيث يحاط به. وهذا مطرد في كل ما وصف به نفسه من السلوب.
(في أسماء الله وصفاته)
ويجب أن يعلم هنا أمور:
أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى، أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه، ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا.
الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه منها كمالها وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق. بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلًا وخبرًا.
الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله، فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة والله أعلم.
الرابع: أن أسماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف. والوصف بها لا ينافي العلمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي علميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى.
الخامس: أن الاسم من أسمائه له دلالات. دلالة على الذات والصفة بالمطابقة. ودلالة على أحدهما بالتضمن. ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم.
السادس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة، وبالاعتبار الثاني متباينة.
السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية، أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع.
الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل، فيخبر به عنه فعلًا ومصدرًا نحو السميع البصير القدير، يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو: { قد سمع الله }، [275] { فقدرنا فنعم القادرون }. [276] هذا إن كان الفعل متعديًا. فإن كان لازمًا لم يخبر عنه به نحو الحي. بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حيي.
التاسع: أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته. وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله. والمخلوق كماله عن فعاله فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملًا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته فأفعاله صادرة عن كماله كمل ففعل والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به.
العاشر: احصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه، إما أن تكون خلقًا له تعالى أو أمرًا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه. فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به، ونهاهم عنه. فأمره كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان إذ مصدره أسماؤه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة إذ مصدره أسماؤه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث ولم يخلق خلقه باطلًا ولا سدى ولا عبثًا. وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده. فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم. فمن أحصى أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى ولهذا لا تجد فيها خللًا ولا تفاوتًا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله. إما أن يكون لجهله به، أو لعدم حكمته، وأما الرب تعالى فهو الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض.
الحادي عشر: إن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلًا، وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم. ولم تكن أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل. فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلًا ولا وصفًا، وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول. فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح.
المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها.
المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها.
المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها } [277] وهو مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها فلا يقال: يا موجود أو يا شيء أو يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك المطلوب فيكون السائل متوسلًا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسل، ولا سيما خاتمهم وإمامهم، وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجان وهي التعبد، وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال التخلق. وأحسن منها عبارة من قال التعبد. وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن.
الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. فقالت طائفة من المتكلمين. هي حقيقة في العبد مجاز في الرب. وهذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادًا. الثاني: مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد وهذا قول أبي العباس الناشي. الثالث: أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها. فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر.
الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات. اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. الاعتبار الثاني: اعتباره مضافًا إلى الرب مختصًا به. الثالث: اعتباره مضافًا إلى العبد مقيدًا به فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتًا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات، والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات والعليم والقدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه، ولا يشابههم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله. ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برىء من فرث التشبيه ودم التعطيل. وهذا طريق أهل السنة، وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولًا به مفتقرًا إليه محاطًا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى، وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها. فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته وسائر صفاته، فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فاذا أحطت بهذه القاعدة خبرًا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتن هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل، وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت الله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة فخلصت من التعطيل، ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم فخلصت من التشبيه، فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب والله الموفق للصواب.
الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: أمران لفظيان وأمران معنويان. فاللفظيان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره، والمعنويان ثبوتي وسلبي، فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره، ولا يكون خبرًا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات. فلنذكر من ذلك مثالًا واحدًا وهو صفة الكلام، فإنه إذا قامت بمحل كانت هو التكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بها، وعاد حكمها إليه دون غيره. فيقال: قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب وتكلم وكلم ونحو ذلك. وامتنعت هذه الأحكام لغيره، فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به. وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردًا وعكسًا.
السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه. وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمه، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي ﷺ في حديث الشفاعة: «فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن» وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته. ومنه قوله ﷺ: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». وأما قوله ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة». فالكلام جملة واحدة. وقوله: «من أحصاها دخل الجنة»، صفة لا خبر مستقبل. والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.
السابع عشر: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره، وهو غالب الأسماء. فالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم وهذا يسوغ أن يدعا به مفردًا ومقترنًا بغيره، فتقول: يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم. وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، بل مقرونًا بمقابله كالمانع والضار والمنتقم فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفو. فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعًا ونفعًا وضرًا وعفوًا وانتقامًا. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ. فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. ولذلك لم تجىء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت: يا مذل، يا ضار، يا مانع، وأخبرت بذلك لم تكن مثنيًا عليه، ولا حامدًا له حتى تذكر مقابلها.
الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال. وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالًا، ولا نقصًا، وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا رابعًا وهو ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها كمال محض فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا بمرادف محض، بل هو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب، أو نقص، فله من صفة الإدراكات العلم الخبير دون العاقل الفقيه، والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان البر، الرحيم، الودود، دون الرفيق والشفوق ونحوهما، وكذلك العلي العظيم دون الرفيع الشريف. وكذلك الكريم دون السخي، والخالق البارىء المصؤر دون الفاعل الصانع المشكل، والغفور العفو دون الصفوح الساتر. وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها وما لا يقوم غيره مقامه، فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء، كما أن صفاته أكمل الصفات، فلا نعدل عما سمي به نفسه إلى غيره، كما لا تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون والمعطلون.
التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنى ما يكون دالًا على عدة صفات ويكون ذلك الاسم متناولًا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها كما. تقدم بيانه، كاسمه العظيم والمجيد والصمد كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره: الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. والحليم الذي قد كمل في حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه. والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفوًا أحد وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار هذا لفظه.
وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء الحسنى. ففسر الاسم بدون معناه، ونقصه من حيث لا يعلم، فمن لم يحط بهذا علمًا بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه فتدبره.
العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون } [278] والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته ل ح د. فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. ومنه الملتحد: وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: { ولن تجد من دونه ملتحدًا } [279] أي من تعدل إليه، وتهرب إليه، وتلتجىء إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه.
(أنواع الإلحاد في أسمائه تعالى)
إذا عرف هذا. فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:
أحدها: أن يسمي الأصنام بها كتسمتيهم اللات من الإلهية والعزى من العزيز وتسميتهم الصنم إلهًا، وهذا إلحاد حقيقة فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة.
الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبًا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك.
وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه، ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود أنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه.
وقولهم: { يد الله مغلولة }، [280] وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته.
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: أنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات، ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به، وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلًا وشرعًا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين. فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في أسمائه.
ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب. وكل من جحد شيئًا عما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقل أو ليستكثر.
وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوًا كبيرًا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة. فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه فجمعهم الإلحاد، وتفرقت بهم طرقه، وبرأ الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه، ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنى. بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. فكان إثباتهم بريًا من التشبيه، وتنزيههم خليًا من التعطيل لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنمًا أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا.
وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل، توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعته رسوله إنه قريب مجيب.
فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به تبارك وتعالى فعليك بمعرفتها ومراعاتها ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبًا عاقلًا ولسانًا قائلًا ومحلًا قابلًا وإلا فالسكوت أولى بك فجناب الربوبية أجل وأعز مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال: { وفوق كل ذي علم عليم } [281] حتى ينتهى العلم إلى من أحاط بكل شيء علمًا. وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى مراعيًا فيه أحكام هذه القواعد بريئًا من الإلحاد في أسمائه، وتعطيل صفاته فهو المان بفضله والله ذو الفضل العظيم.
فائدة: المعنى المفرد لا يكون نعتا
المعنى المفرد لا يكون نعتًا ونعني بالمفرد ما دل لفظه على معنى واحد نحو: علم وقدرة، لأنه لأ رابط بينه وبين المنعوت، لأنه اسم جنس على حياله. فإذا قلت: ذو علم وذو قدرة. كان الرابط ذو. فإذا قلت: عالم وقادر. كان الرابط الضمير فكل نعت وإن كان مفردًا في لفظه فهو دال على معلومين: حامل ومحمول. فالحامل هو الاسم المضمر، والمحمول هو الصفة، وإنما أضمر في الصفة، ولم يضمر في المصدر وهو الصفة في الحقيقة لأن هذا الوصف مشتق من الفعل، والفعل هو الذي يضمر فيه دون المصدر، لأنه إنما صيغ من المصدر ليخبر به عن فاعل. فلا بد له مما صيغ لأجله، إما ظاهرًا وإما مضمرًا. ولا كذلك المصدر لأنه اسم جنس فحكمه حكم سائر الأجناس، ولذلك ينعت الاسم بالفعل لتحمله الضمير.
فإن قلت: فأيهما هو الأصل في باب النعت؟
قلت: الاسم أصل للفعل في باب النعت، والفعل أصل لذلك الاسم لي غير باب النعت، وإنما قلنا: ذلك لأن حكم النعت أن يكون جاريًا على المنعوت في إعرابه، لأنه هو مع زيادة معنى ولأن الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام لعمله في الاسم. وحق العامل التقدم لا سيما إن قلنا إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. وعلى هذا لا يتصور أن يكون الفعل أصلًا في باب النعت، لأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال فعلى هذا لا ينبغي أن ينعت النعت. فتقول: مررت برجل عاقل كريم على أن يكون كريمًا صفة للعاقل، بل للرجل لأن النعت ينبىء عن الاسم المضمر وعن الصفة والمضمر لا ينعت، ولأنه قد صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل والجملة لا تنعت ولأنه يجري مجرى الفعل في رفع الأسماء، والفعل لا ينعت قاله ابن جني. وبعد فلا يمتنع أن ينعت النعت، إذا جرى النعت الأول مجرى الاسم الجامد ولم يرد به ما هو جار على الفعل.
فصل: إقامة النعت مقام المنعوت
ولما علم من افتقاره إلى الضمير لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين:
أحدهما: احتماله الضمير فإذا حذفت المنعوت لم يبق للضمير ما يعود عليه.
الثاني: عموم الصفة فلا بد من بيان الموصوف بها ما هو.
فإن أجريت الصفة مجرى الاسم مثل: جاءني الفقيه وجالست العالم، خرج عن الأصل الممتنع وصار كسائر الأسماء، وإن جئت بفعل يختص بنوع من الأسماء وأعملته في نوع يختص بذلك النوع، كان حذف المنعوت حسنًا، كقولك: أكلت طيبًا ولبست لينًا وركبت فارها ونحوه. أقمت طويلًا وسرت سريعًا، لأن الفعل يدل على المصدر والزمان فجاز حذف المنعوت ههنا لدلالة الفعل عليه.
وقريب منه قوله تعالى: { ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين } [282] لدلالة الذرية عليه الموصوف بالصفة.
وإن كان في كلامك حكم منوط بصفة اعتمد [283] الكلام على تلك واستغنى عن ذكر الموصوف كقولك: مؤمن خير من كافر، وغني أحظى من فقير، والمؤمن لا يفعل كذا، ولعنة الله على الظالمين، والمؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وقولهم وأبيض كالمخراق.. البيت، وقول الآخر وأسمر خطي.. لأن الفخر والمدح إنما يتعلق بالصفة دون الموصوف. فمضمون هذا الفصل ينقسم خمسة أقسام:
نعت لا يجوز حذف منعوته كقولك لقيت سريعًا وركبت خفيفًا.
ونعت يجوز حذف منعوته على قبح نحو لقيت ضاحكًا ورأيت جاهلًا فجوازه لاختصاص الصفة بنوع واحد من الأسماء.
وقسم يستوي فيه الأمران: نحو أكلت طيبًا وركبت فارهًا ولبست لينًا وشربت عذبًا لاختصاص الفعل بنوع من المفعولات.
وقسم يقبح فيه ذكر الموصوف لكونه حشوًا في الكلام. نحو أكرم الشيخ ووقر العالم وارفق بالضعيف وارحم المسكين وأعط الفقير وأكرم البر وجانب الفاجر. ونظائره لتعليق الأحكام بالصفات واعتمادها عليها بالذكر.
وقسم لا يجوز فيه البتة ذكر الموصوف كقوله: دابة أبطح وأجرع. وأبرق للمكان وأسود للحية وأدهم للقيد وأخيل للطائر. فهذه في الأصول نعوت ولكنهم لا يجرونها نعتًا على منعوت فنقف عند ما وقفوا، ونترك القياس إذا تركوا.
فائدة بديعة: النعت السببي
إذا نعت الاسم بصفة هي لسببه ففيه ثلاثة أوجه.
أحدها: وهو الأصل أن تقول مررت برجل حسن أبوه بالرفع، لأن الحسن ليس صفة له فتجري عليه، وإنما ذكرت الجملة ليميز بها بين الرجل، وبين من ليس عنده أب كأبيه. فلما تميز بالجملة من غيره صارت في موضع النعت وتدرجوا من ذلك إلى أن قالوا: حسن أبوه بالجر وأجروه نعتًا على الأول وإن كان الأب من حيث تميز وتخصص كما يتخصص بصفة نفسه.
والوجه الثالث مررت برجل حسن الأب فيصير نعتًا للأول ويضمر فيه ما يعود عليه حتى كان الحسن له، وإنما فعلوا ذلك مبالغة وتقريبًا للنسب وحذفًا للمضاف وهو الأب وإقامة المضاف إليه مقامه وهو الهاء. فلما قام الضمير مقام الاسم المرفرع صار ضميرًا مرفوعًا فاستتر في الفعل فقلت برجل حسن، ثم أضفته إلى النسب الذي من أجله كان حسنًا وهو الأب ودخول الألف واللام على النسب، إنما هي لبيان الحسن. وهذا الوجه لا يجوز إلا في الموضع الذي يجوز فيه حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وذلك غير مطرد الجواز وإنما يجوز حيث يقصدون المبالغة تفخيم الأمر وإن بعد النسب كان الجواز أبعد كقولك: نابح الكلب وصاهل فرس العبد. وما امتنع في هذا الفصل فإنه يجوز في الفصل الذي قبله من حيث لم يقيموا فيه مضافًا مقام المضاف إليه.
وإنما حكمنا باختلاف المعاني في هذه الوجوه الثلاثة. من حيث اختلف اللفظ فيها، لأن الأصل أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف المعنى، ولا يحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. فمعنى الوجه الأول تمييز الاسم من غيره بالجملة التي بعده. ومعنى الوجه الثاني تمييز الاسم من غيره مع انجرار الوصف إليه بمدح أو ذم. ومعنى الوجه الثالث نقل الصفة كلها إلى الأول على حذف المضاف مع تبيين السبب الذي صيره، كذلك وأكثر ما يكون هذا الوجه فيما قرب سببه جدًا. نحو عظيم القدر وشريف الأب، لأن شرف الأب شرف له، وكذلك القدر والوجه، وههنا يحسن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
فائدة: اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه
إن قيل: لم اكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه، ولم يكتسب المضاف إليه التنكير من المضاف وهو مقدم عليه في اللفظ، لا سيما والتنكير أصل في الأسماء والتعريف فرع عليه؟
قيل: الجواب من وجهين:
أحدهما: أنهم قد حكم غلبوا المعرفة على النكرة في غير هذا الموضع نحو هذا زيد ورجل ضاحكين على الحال، ولا يجوز ضاحكان على النعت تغليبًا لحكم المعرفة، لأنهم رأوا الاسم المعرفة يدل على معنيين الرجل وتعيينه، والشيء وتخصيصه من غيره، والنكرة لا تدل إلا على معنى مفرد فكان ما يدل على معنيين أقوى مما يدل على معنى واحد وهذا أصل نافع فحصله.
الثاني: أن المضاف إليه بمنزلة آلة التعريف فصار كالألف واللام. ألا ترى أنك إذا قلت: غلام زيد فهو بمنزلة قولك الغلام لمن تعرفه بذلك. وكذلك إذا قلت: كتاب سيبويه فهو بمنزلة قولك الكتاب، وكذلك إذا قلت: سلطان المسلمين فهو بمنزلة قولك السلطان فتعريفه باللام في أوله وتعريفه بالإضافة من آخره.
فإن قيل: فإذا اكتسب التعريف من المضاف إليه فكان ينبغي أن يعطي حكمه.
قيل: وإن استفاد منه التعريف لم يستفد منه خصوصية تعريفه، وإنما اكتسب منه تعريفًا آخر كما اكتسبه من لام التعريف. ألا ترى أنه إذا أضيف إلى المضمر لم يكتسب منه الإضمار، وإذا أضيف إلى المبهم لم يكتسب منه الإبهام، فلا الأول اقتبس من الثاني خصوصية تعريفه، ولا الثاني اقتبس من الأول تنكيره والمضاف إليه في ذلك كالآلة الداخلة على الاسم.
فائدة: تفسير الكلام
من كلام السهيلي: الكلام هو تعبير عما في نفس المتكلم من المعاني. فإذا أضمر ذلك المعنى في نفسه أي أخفاه، ودل المخاطب عليه بلفظ خاص، سمي ذلك اللفظ ضميرًا تسمية له باسم مدلوله. ولا يقال فكان ينبغي أن يسمي كل لفظ ضميرًا على ما ذكرتم، لأن هنا مراتب ثلاثة:
أحدها المعنى المضمر وهو حقيقة الرجل مثلا.
والثاني اللفظ المميز له عن غيره وهو زيد وعمرو.
والثالث: اللفظ المعبر عن هذا الاسم الذي إذا أطلق كان المراد به ذلك الاسم بخلاف قولك زيد وعمرو. فإنه ليس ثم إلا لفظ ومعنى فخصوا اسم الضمير بما ذكرناه. والمضمرات في كلامهم ستين ضميرًا وأحوالها معلومة، لكن ننبه على أسرارها من أحكام المضمرات.
اعلم أن المتكلم لما استغنى عن اسم الظاهر في حال الأخبار لدلالة المشاهدة عليه جعل مكانه لفظًا يومىء به إليه وذلك اللفظ مؤلف من همزة ونون. أما الهمزة فلأن مخرجها من الصدر وهو أقرب مواضع الصوت إلى المتكلم إذ المتكلم في الحقيقة محله وراء حبل الوريد. قال الله تعالى: { ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد }، [284] ألا تراه يقول: { ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد }، [285] يعني ما يلفظ المتكلم، فدل على أن المتكلم أقرب شيء إلى حبل الوريد، فإذا كان المتكلم على الحقيقة. محله هناك وأردت من الحروف ما يكون عبارة عنه. فأولاها بذلك ما كان مخرجه من جهته، وأقرب المواضع إلى محله وليس إلا الهمزة أو الهاء، والهمزة أحق بالمتكلم لقوتها بالجهر والشدة وضعف الهاء بالخفاء فكان ما هو أجهر أقوى وأولى بالتعبير عن اسم المتكلم الذي الكلام صفة له وهو أحق بالاتصاف به.
وأما تآلفها مع النون؛ فلما كانت الهمزة بانفرادها لا تكون اسمًا منفصلًا كان أولى ما وصلت به النون أو بحرف المد واللين إذ هي أمهات الزوائد. ولم يمكن حروف المد مع الهمزة لذهابها عند التقاء الساكنين نحو أنا الرجل فلو حذف الحرف الثاني لبقيت الهمزة في أكثر الكلام منفردة مع لام التعريف فتلتبس بالألف التي هي أخت اللام، فيختل أكثر الكلام، فكان أولى ما قرن به النون لقربها من حرف المد واللين ثم ثبتوا النون لخفائها بالألف في حال السكت، أو بهاء في لغة من قال: إنه.
ثم لما كان المخاطب مشاركًا للمتكلم في حال معنى الكلام، إذ الكلام مبدأه من المتكلم، ومنتهاه عند المخاطب، ولولا المخاطب ما كان كلام المتكلم لفظًا مسموعًا، ولا احتاج إلى التعبير عنه، فلما اشتركا في المقصود بالكلام وفائدته اشتركا في اللفظ الدال على الاسم الظاهر وهو الألف والنون، وفرق بينهما بالتاء خاصة، وخصت التاء بالمخاطب لثبوتها علامة الضمير في قمت، إلا أنها اسم، وفي أنت حرف.
فإن قلت: فهي علامة لضمير المتكلم في قمت فلم كان المخاطب أولى بها.
قلت: الأصل في التاء للمخاطب، وإنما المتكلم دخيل عليه، ولما كان دخيلًا عليه خصوه بالضم، لأن فيه من الجمع والإشارة إلى نفسه ما ليس في الفتحة، وخصوا المخاطب بالفتح، لأن في الفتحة من الإشارة إليه ما ليس في الضمة. وهذا معلوم في الحس.
وأما ضمير المتكلم المخفوض فإنما كان ياء، لأن الاسم الظاهر لما ترك لفظه استغناء ولم يكن بد من علامة دالة عليه كان أولى الحروف بذلك حرف من حروف الاسم المضمر وذلك لا يمكن لاختلاف أسماء المتكلمين، وإنما أرادوا علامة تختص بكل متكلم في حال الخفض والأسماء مختلفة الألفاظ متفقة في حال الإضافة إلى الياء في الكسرة التي هي علامة الخفض إلا أن الكسرة لا تستقل بنفسها حتى تمكن فتكون ياء، فجعلوا الياء علامة لكل متكلم مخفوض، ثم شركوا النصب مع الحفظ في علامة الإضمار لاستوائها في المعنى إلا أنهم زادوا نونًا في ضمير المنصوب وقاية للفعل من الكسر.
وأما ضمير المتكلم المتصل فعلامته التاء المضمومة. وأما المتكلمون فعلامتهم نافي الأحوال كلها.
وسره أنهم لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف ما يكون علامة عليه أخذوا من الاسم الظاهر ما يشترك جميع المتكلمين فيه في حال الجمع والتثنية وهي النون التي في آخر اللفظ وهي موجودة في التثنية والجمع رفعًا ونصبًا وجرًا، فجعلوها علامة للمتكلمين جمعًا كانوا أو تثنية وزادوا بعدها ألفًا كيلا تشبه التنوين، أو النون الخفيفة. ولحكمة أخرى وهي القرب من لفظ أنا، لأنها من ضمير المتكلمين فإنها ضمير متكلم فلم يسقط من لفظة أنا إلا الهمزة التي هي أصل في المتكلم الواحد. وأما جمع المتكلم وتثنيته ففرع طار عن الأصل فلم تمكن فيه الهمزة التي تقدم اختصاصها بالمتكلم حتى خصت به في أفعل وخص المخاطب لتاء في تفعل لما ذكرناه.
وأما ضمير المرفوع المتصل فإنما خص بالتاء، لأنهم حين أرادوا حرفًا يكون علامة على الاسم الظاهر المستغنى عن ذكره كان أولى الحروف بذلك حرفًا من الاسم وهو مختلف كما تقدم، فأخذوا من الاسم ما لا تختلف الأسماء فيه في حال الرفع وهي الضمة. وهي لا تستقل بنفسها ما لم تكن واوًا، ثم رأوا الواو لا يمكن تعاقب الحركات عليها لثقلها وهم يحتاجون إلى الحركات في هذا الضمير فرقًا بين المتكلم والمخاطب المؤنث، والمخاطب المذكر فجعلوا التاء مكان الواو لقربها من مخرجها، ولأنها قد تبدل منها في كثير من الكلام كتراث وتجاه. فاشترك ضمير المتكلم والمخاطب في التاء، كما اشتركا في الألف والنون من أنا وأنت، لأنهما شريكان في الكلام لأن الكلام من حيث كان للمخاطب كان لفظًا، ومن حيث كان للمتكلم كان معنى، ثم وقع الفرق بين ضميريهما بالحركة دون الحروف لما تقدم.
وأما ضمير المخاطب نصبًا وجرًا فكان كافًا دون الياء، لأن الياء قد اختص بها المتكلم نصبًا وخفضًا فلو أمكنت فيه الحركات، أو وجد ما يقوم مقامها في البدل كما كانت التاء مع الواو اشترك المخاطب مع المتكلم في حال الخفض، كما اشترك معه في الباقي حال الرفع. فلما لم يمكن ذلك، ولم يكن بد من حروف تكون علامة إضمار كان الكاف أحق بهذا الموطن، لأن المخاطبين وإن اختلف أسماؤهم الظاهرة فكل واحد منهم متكلم ومقصود في الكلام الذي هواللفظ ومن أجله احتيج إلى التعبير بالألفاظ عما في النفس فجعل الكلام المبدوء بها في لفظ الكلام علامة إضمار المخاطب. ألا تراه لا يقع علامة إضمار له إلا بعد كلام كالفعل والفاعل نحو أكرمتك، لأنهما كلام والفعل وحده ليس كلامًا فلذلك لم تكن علامة الضمير كافًا إلا بعد كلام من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر.
فإن قيل: فالمتكلم أيضا هو صاحب الكلام فهو أحق بأن تكون الكاف المأخوذة من لفظ الكلام علامة للاسم.
قيل: الكاف لفظ فهي أحق بالمخاطب، لأن الكلام إنما لفظ به من أجله.
وأما ضمير الغائب المنفصل فهاء بعدها واو، لأن الغائب لما كان مذكورًا بالقلب واستغني عن اسمه الظاهر بتقدمه، كانت الهاء التي مخرجها من الصدر قريبًا من محل الذكر أولى بأن تكون عبارة على مذكور بالقلب، ولم تكن الهمزة لأنها مجهورة شديدة فكانت أولى بالمتكلم الذي هو أظهر، والهاء لخفائها أولى بالغائب الذي هو أخفى وأبطن، ثم وصلت بالواو لأنه لفظ يرمز به إلى المخاطب ليعلم ما في النفس من المذكور والرمز بالشفتين، والواو مخرجها من هناك فخصت بذلك.
ثم طردوا أصلهم في ضمير الغائب المنفرد فجعلوه في جميع أحواله هاء إلا في الرفع، وإنما فعلوا ذلك لأنهم رأوا الفرق بين الحالات واقعًا باختلاف حال الضمير، لأنه إذا دخل عليها حرف الجر كسرت الهاء وانقلبت واوه ياء، وإذا لم يدخل عليه بقي مضمومًا على أصله. وإذا كان في حال الرفع لم يكن له علامة في اللفظ، لأن الاسم الظاهر قبل الفعل علم ظاهر يغني المخاطب عن علامة إضمار في الفعل بخلاف المتكلم. والمخاطب لأنك تقول في الغائب: زيد قائم فتجد الاسم الذي يعود عليه الضمير موجودًا ظاهرًا في اللفظ. ولا تقول في المتكلم: زيد قمت، ولا في المخاطب زيد قمت. فلما اختلف أحوال الضمير الغائب لسقوط علامته في الرفع وتغير الهاء بدخول حروف الخفض قام ذلك عندهم مقام علامات الإعراب في الظاهر وما هو بمنزلتها في المضمر، كالتاء المبدلة من الواو والياء المثبتة والكسرة والكاف المختصة بالمفعول والمجرور الواقعين بعد الكلام التام، ولا يقع بعد الكلام إلا منصوب أو مجرور. فكانت الكاف المأخوذة من لفظ الكلام علامة على المنصوب والمجرور إذا كان مخاطبًا.
وأما نحن فضمير منفصل للمتكلمين تثنية وجمعًا وخصت بذلك لما لم يمكنهم التثنية والجمع في المتكلم المضمر، لأن حقيقة التثنية ضم شيء إلى مثله في اللفظ. والجمع ضم شيء إلى أكثر منه مما يماثله في اللفظ، فإذا قلت: زيدان فمعناه زيد وزيد. وأنتم معناه أنت وأنت وأنت، والمتكلم لا يمكنه أن يأتي باسم مثنى، أو مجموعًا في معناه لأنه لا يمكنه أن يقول: أنا فيضم إلى نفسه مثله في اللفظ. فلما عدم ذلك ولم يكن بد من لفظ يشير إلى ذلك المعنى وإن لم يكنه في الحقيقة جاءوا بكلمة تقع على الاثنين والجمع في هذا الموطن، ثم كانت الكلمة آخرها نون. وفي أولها إشارة إلى الأصل المتقدم الذي لم يمكنهم الإتيان به وهو تثنية أنا التي هي بمنزلة عطف اللفظ على مثله، فإذا لم يمكنهم ذلك في اللفظ مثنى كانت النون المكررة تنبيهًا عليه وتلويحًا عليه. وخصت النون بذلك دون الهمزة لما تقدم من اختصاص ضمير الجمع بالنون وضمير المتكلم بالهمزة، ثم جعلوا بين النون حاء ساكنة لقربها من مخرج الألف الموجودة في ضمير المتكلم قبل النون وبعدها، ثم بنوها على الضم دون الفتح والكسر، إشارة إلى أنه ضمير مرفوع وشاهده ما قلناه في الباب من دلالة الحروف المقطعة على المعاني والرمز بها إليها وقوع ذلك في منثور كلامهم ومنظومه. فمنه: * قلت لها قفي، قالت قاف * ومنه: ألاتا، فيقول الآخر: ألافا؛ يعني ألا ترتحل، فيقول: ألا فارحل. ومنه:
بالخير خيرات وإن شرا فا ** ولا أريد الشر إلا أن تا
وكقولهم مهيم في ما هذا يا امرؤ. وأيش في أي شيء. وم الله في أيمن الله.
ومن هذا الباب حروف التهجي في أوائل السور.
وقد رأيت لابن فورك نحو من هذا في اسم الله. قال: الحكمة في وجود الألف في أوله أنها من أقصى مخارج الصوت قريبًا من القلب الذي هو محل المعرفة إليه، ثم الهاء في آخره مخرجها من هناك أيضا، لأن المبتدأ منه والمعاد إليه، والإعادة أهون من الابتداء. وكذلك لفظ الهاء أهون من لفظ الهمزة هذا معنى كلامه. فلم يقل ما قلناه في المضمرات إلا اقتضابًا من أصول أئمة النحاة واستنباطًا من قواعد اللغة.
فتأمل هذه الأسرار ولا يزهدنك فيها نبو طباغ أكثر الناس عنها، واستغناؤهم بظاهر من الحياة الدنيا عن الفكر فيها، والتنبيه عليها. فإني لم أفحص عن هذه الأسرار وخفي التعليل في الظواهر والإضمار إلا قصد التفكر، والاعتبار في حكمة من خلق الإنسان وعلمه البيان، فمتى لاح لك من هذه الأسرار سر، وكشف لك عن مكنونها فكر فاشكر الواهب للنعمى وقل: رب زدني علمًا.
فائدة بديعة: اسم الإشارة
الاسم من هذا الذال وحدها دون الألف على أصح القولين، بدليل سقوط الألف في التثنية والمؤنث. وخصت الذال بهذا الاسم، لأنها الخارج من طرف اللسان والمبهم مشار إليه، فالمتكلم يشير نحوه بلفظه أو بيده، ويشير مع ذلك بلسانه، فإن الجوارح خدم القلب فإذا ذهب القلب إلى شيء ذهابًا معقولًا. ذهبت الجوارح نحوه ذهابًا محسوسًا.
والعمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان، ولا يمكن إشارته إلا بحرف يكون مخرجه من عذبة اللسان التي هي آلة الإشارة دون سائر أجزائه. فأما الذال أو التاء فالتاء مهموسة رخوة، فالمجهور أو الشديد من الحروف أولى منها للبيان والذال مجهورة فخصت بالإشارة إلى المذكر، وخصت التاء بالإشارة إلى المؤنث لأجل الفرق. وكانت التاء به أولى لهمسها وضعف المؤنث، ولأنها قد ثبتت علامة التأنيث في غير هذا الباب، ثم بينوا حركة الذال بالألف كما فعلوا في النون من أنا، وربما شركوا المؤنث مع المذكر في الذال فاكتفوا بالكسرة فرقًا بينهما، وربما اكتفوا بمجرد لفظ التاء في الفرق بينهما، وربما جمعوا بين لفظ التاء والكسرة حرصًا على البيان.
وأما في المؤنث الغائب فلا بد من التاء مع الكسرة، لأنه أحوج إلى البيان لدلالة المشاهدة على الخاطر ققول: تيك، وربما زادوا اللام توكيدًا كما زادوها في المذكر الغائب إلا أنهم سكنوها في المؤنث لئلا تتوالى الكسرات مع التاء وذلك ثقيل عليهم. وكانت اللام أولى بهذا الموطن حين أرادوا الإشارة إلى البعيد فكثرت الحروف حين كثرت مسافة هذه الإشارة. وقللوها حين قلت لأن اللام قد وجدت في كلامهم توكيدًا. وهذا الموطن موطن توكيد وقد وجدت بمعنى الإضافة للشيء، وهذا الموطن شبيه بها، لأنك إذا أومأت إلى الغائب بالاسم المبهم فأنت مشير إلى من يخاطب ويقبل عليه لينظر إلى من تشير، إما بالعين وإما بالقلب. وكذلك جئت بكاف الخطاب فكأنك تقول له: لك أقول ولك أرمز بهذا الاسم ففي اللام طرف من هذا المعنى كما كان ذلك في الكاف، وكما لم يكن الكاف ههنا اسمًا مضمرًا لم يكن اللام حرف جر، وإنما كل منهما طرف من المعنى دون جميعه فلذلك خلعوا من المكان معنى الاسمية، وأبقوا فيها معنى الخطاب واللام كذلك، إنما اجتلبت لطرف من معناها الذي وضعت له في باب الإضافة.
وأما دخول هاء التنبيه، فلأن المخاطب يحتاج إلى تنبيه على الاسم الذي يشير به إليه، لأن للإشارة قرائن حال يحتاج إلى أن ينظر إليها. فالمتكلم كأنه آمر له بالإلتفات إلى المشار إليه، أو منبه له. فلذلك اختص هذا الموطن بالتنبيه وقلما يتكلمون به في المبهم الغائب، لأن كاف الخطاب يغني عنها مع أن المخاطب مأمور بالإلتفات بلحظه إلى المبهم الحاضر. فكان التنبيه في أول الكلام أولى بهذا الموطن، لأنه بمنزلة الأمر الذي له صدر الكلام.
وعندي أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء. وسائر حروف المعاني لا يجوز أن تعمل معانيها في الأحوال، ولا في الظروف كما لا يعمل معنى الاستفهام والنفي في هل وما في ذلك. ولا نعلم حرفًا يعمل معناه في الحال والظرف إلا كان وحدها على أنها فعل، فدع عنك ما شعبوا به في مسائل الحال في هذا الباب من قولهم: هذا قائمًا زيد وقائمًا. هذا زيد فإنه لا يصلح من ذلك إلا تأخير الحال عن الاسم الذي هو ذا، لأن العامل فيها معنى الإشارة دون معنى التنبيه وكلاهما معنوي.
فإن قيل: لم جاز أن يعمل فيه معنى الإشارة دون معنى التنبيه وكلاهما معنوي.
قيل: معنى الإشارة يدل عليه قرائن الأحوال من الإيماء باللحظ واللفظ من طرف اللسان، وهيئة المتكلم. فقامت تلك الدلالة مقام التصريح بلفظ الإشارة، لأن الدال على المعنى إما لفظ، وإما إشارة وإما لحظ فقد جرت الإشارة مجرى اللفظ فلتعمل فيما عمل فيه اللفظ، وإن لم تقو قوته في جميع أحكام العمل.
وأصح من هذا أن يقال معنى الإشارة ليس هو العامل إذ الاسم الذي هو هذا ليس بمشتق من أشار يشير. ولو جاز أن تعمل أسماء الإشارة لجاز أن تعمل علامات الإضمار، لأنها أيضا إيماء وإشارة إلى مذكور. وإنما العامل فعل مضمر تقديره انظر، وأضمر لدلالة الحال عليه من التوجه واللفظ. وقد قالوا لمن الدار مفتوحًا بابها، فأعملوا في الحال معنى انظر وابصر، ودل عليه التوجه من المتكلم بوجهه نحوها وكذلك هذا بعلي شيخًا وهو قوي في الدلالة لاجتماع اللفظ مع التوجه. وإذا ثبت هذا فلا سبيل إلى تقديم الحال، لأن العامل المعنوي (لا يعمل) حتى يدل عليه الدليل اللفظي أو التوجه، أو ما شاكله.
فائدة: العامل في النعت
العامل في النعت هو العامل في المنعوت. وكان سيبوبه إلى هذا ذهب حين منع أن يجمع بين نعتين للاسمين إذا اتفق إعرابهما، واختلف عاملاهما نحو جاء زيد وهذا عمرو العاقلان.
وذهب قوم إلى أن العامل في النعت معنوي وهو كونه في معنى الاسم المنعوت، فإنما ارتفع أو انتصب من حيث كان هو الأول في المعنى. لا من حيث كان الفعل عاملًا فيه. وكيف يعمل فيه وهو لا يدل عليه. إنما يدل على فاعل، أو مفعول، أو مصدر دلالة واحدة من جهة اللفظ.
وأما الظروف فمن دليل آخر. قال السهيلي: وإلى هذا أذهب. وليس فيه نقض لما منعه سيبويه من النجاح بين نعتي الاسمين المتفقين في الإعراب. إذا اختلف العامل فيهما، لأن العامل في النعت وإن كان هو المنعوت فلولا العامل في المنعوت لما صح رفع النعت، ولا نصبه فكان الفعل هو العامل في النعت فامتنع اشتراك عاملين في معمول واحد. وإن لم يكونا عاملين فيه في الحقيقة، ولكنهما عاملان فيما هو في المعنى.
وإنما قوي عندنا هذا القول الثاني لوجوه. منها امتناع تقديم النعت على المنعوت ولو كان الفعل عاملًا فيه لما امتنع أن يليه معموله كما يليه المعمول تارة، والفاعل أخرى، وكما يليه الحال والظرف. ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيره، لو قلت: قام زيدًا ضارب، تريد ضارب زيدًا أو ضربت عمرًا رجلًا ضاربًا. تريد ضربت رجلًا ضاربًا عمر. لم يجز فلا يلي العامل إلا ما عمل فيه، فكذلك لا يلي كان إلا ما عملت فيه، ولذلك تقول خبر: إن المرفوع ليس بمعمول، لأن وإنما هو على أصله في باب المبتدإ والخبر ولولا ذلك لجاز أن يليها، وإنما وليها إذا كان مجرورًا، لأنها ممنوعة من العمل فيه بدخول حرف الجر، مع أن المجرور رتبته التأخير فلم يبالوا بتقديمه في اللفظ إذ كان موضه التأخير، ولأن المجرور ليس هو بخبر على الحقيقة، وإنما هو متعلق بالخبر والخبر منوي في موضعه أعني بعد الاسم المنصوب بإن.
فإن قيل: ولعل امتناع النعت من التقديم على المنعوت إنما هو من أجل الضمير الذي فيه، والمضمر حقه أن يترتب بعد الاسم الظاهر.
قلنا: هذا ليس بمانع، لأن خبر المبتدأ حامل للضمير ويجوز تقديمه ورب مضمر يجوز تقديمه على الظاهر إذا كان موضعه التأخير.
فإن قيل: ولعل امتناع تقديم النعت، إنما وجب من أجل أنه تبيين للمنعوت وتكملة لفائدته فصار كالصلة مع الموصول.
قلنا: هذا باطل، لأن الاسم المنعوت يستقل به الكلام ولا يفتقر إلى النعت افتقار الموصول إلى الصلة.
ومما يبين لك أن الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته إذ النعت صفة للمنعوت لازمة له قبل وجود الفعل وبعده فلا تأثير للفعل فيه ولا تسلط له عليه، وإنما التأثير فيه للاسم المنعوت إذ بسببه يرفع وينصب. وإن لم يجز أن تكون الأسماء عوامل في الحقيقة. وهذا بخلاف الحال، لأنها وإن كانت صفة كالنعت وفيها ضمير يعود إلى الاسم فإنها ليست بصفة لازمة للاسم كالنعت، وإنما هي صفة للاسم في حيز وجود الفعل خاصة. فالفعل بها أولى من الاسم فعمل فيه دونه. فلما عمل فيها جاز تقديمها عليه نحو ضاحكًا جاء زيد وجاء ضاحكًا زيد. وتأخيرها بعد الفاعل، لأنها كالمفعول يعمل الفعل فيها والنعت بخلاف هذا كله.
وسنبين بعد هذا إن شاء الله فصلًا عجيبًا في أن الفعل لا يعمل بنفسه إلا بثلاثة أشياء الفاعل، والمفعول به، والمصدر، أو ما هو صفة لأجل هذه الثلاثة في حيز وقوع الفعل ويخرج من هذا الفصل ظرفًا المكان والزمان والنعوت والإبدال والتوكيدات وجميع الأسماء المعمول فيها، ونقيم هنالك البراهين القاطعة على صحة هذه الدعوى.
فائدة بديعة: حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة
حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة أن تكون جارية عليها ليتفق اللفظ، وأما نصب الصفة على الحال فيضعف عندهم لاختلاف اللفظ من غير ضرورة. ورد بعض محققي النحاة هذا القول بالقياس والسماع. قال: أما القياس، فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة والحال، كما إذا قلت: جاء زيد الكاتب وكاتبًا بينهما من الفرق ما تراه فما المانع من الاختلاف؟ كذلك في النكرة. إذا قلت: مررت برجل كاتب أو كاتبًا، لأن الحاجة قد تدعو إلى الحال من النكرة، كما تدعو إلى الحال من المعرفة ولا فرق. وأما السماع فأكثر من أن يحصر فمنه وصلى خلفه رجال قيامًا. وأما نحو وقع أمر فجأة فحال من مصدر وقع لا من أمر، وكذلك أقبل رجل مشيًا. حال من الإقبال.
وهذا صحيح، ولكن الأكثر ما قاله النحاة إيثارًا لاتفاق اللفظ ولتقارب ما بين المعنيين في النكرة، ولتباعد ما بينهما في المعرفة، لأن الصفة في النكرة مجهولة عند المخاطب حالًا كانت أو نعتًا وهي في المعرفة بخلاف ذلك، ولو كانت الحال من النكرة ممتنعة لأجل تنكيرها لما اتفقت العرب على صحتها حالًا إذا تقدمت عليها كما أنشده سيبويه: * لمية موحشًا طلل * وقوله:
وتحت العوالي والقنا مستكنة ** ظباء أعارتها العيون الجآذر
قإن قيل: حمل سيبويه وغيره على أن جعلوا موحشًا حالًا من طلل، وقائمًا حالًا من قولك فيها قائمًا رجل وهو لا يقول بقول الأخفش: إن رجلًا وطللًا فاعل بالإستقرار الذي تعلق به الجار. فلو قال بهذا القول كان عذرًا له في جعلها حالًا منه، ولكن الاسم النكرة عنده مبتدأ وخبره في المجرور قبله، ولا بد في خبر المبتدأ من ضمير يعود على المبتدأ تقدم الخبر، أو تأخر فلم لا تكون هذه الحال من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة. وما الذي دعاهم إلى هذا؟
قيل: هذا سؤال حسن جدًا يجب التقصي عنه والاعتناء به. فقد كع عند أكثر الشارحين للكتاب والمؤلفين في هذا الباب، وما رأيت أحدًا منهم أشار فيه إلى جواب مقنع وأكثرهم لم ينتبه للسؤال ولا تعرض له.
والذي أقوله وبان التوفيق: أن هذه المسألة في النحو بمنزلة مسائل الدور في الفقه، ونضرب فيه مثالًا فنقول: رجل شهد مع آخر في عبد أنه حر فعتق العبد وقبلت شهادته، ثم شهد ذلك الرجل مرة أخرى فأريد تجريحه فشهد العبد المعتق فيه بالجرحة، فإن قبلت شهادته ثبت جرح الشاهد وبطل العتق، وإذا بطل العتق سقطت الشهادة. وإن سقطت شهادته لم يصح جرح الشاهد، ودارت المسألة هكذا، وكل فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن يسقط في نفسه، وكذلك مسألة هذا الفصل. فإنك إن جعلت الحال من قولك فيها قائمًا رجل من الضمير لم يصح تقدير المضمر إلا مع تقدير فعل يتضمنه، ولا يصح تقدير فعل بعده مبتدأ، لأن معنى الابتداء يبطل ويصير المبتدأ فاعلًا، وإذا صار فاعلًا بطل أن يكون في الفعل ضمير لتقدم الفعل على الفاعل، وإذا بطل وجود الضمير بطل وجود الحال منه وهذا بديع في النظر.
فإن قيل: إن المجرور ينوي به التأخير، لأن خبر المبتدأ حقه أن يكون مؤخرًا.
قيل: وإذا نويت به التأخير لم يصح وجود الحال مقدمة على المبتدأ لأنها لا تتقدم على عاملها إذا كان معنويًا فبطل كون الحال من شيء غير الاسم النكرة الذي هو مبتدأ عند سيبويه، وفاعل عند الأخفش، وهذا السؤال لا يلزم الأخفش على مذهبه، وإنما يلزم سيبويه ومن قال بقوله، ولولا الوحشة من مخالفة الإمام أبي بشر لنصرت قول الأخفش نصرًا مؤزرًا وجلوت مذهبه في منصب التحقيق مفسرًا، ولكن النفس إلى مذهب سيبويه أميل. هذا كلام الفاضل وهو كما ترى كأنه سيل ينحط من صبب.
قلت: والكلام معه في ثلاث مقامات: أحدها: ثحقيق مذهب الأخفش في أن قولك في الدار رجل ارتفاع رجل بالظرف لا بالابتداء. والمقام الثاني أن الحال من النكرة يمتنع أن يكون. حالًا من الضمير في الظرف: والمقام الثالث: الكلام فيما ذكره من الدور في المسألة النحوية وإنه ليس مطابقًا للدور في المسألة الفقهية.
فأما المقام الأول: فاعلم أن الأخفش مذهبه إذا تقدم الظر ف على الاسم المرفوع نحو قي الدار زيد. كان مرفوعًا ارتفاع الفاعل بفعله ومذهبه أيضا، أن المبتدأ إذا كان نكرة لا يسو غ الابتداء به إلا بتقديم الخبر عليه وجب تقديمه عليه نحو: في الدار رجل. تقديم الظرف عنده واجب وجوب تقديم الخبر على المبتدأ به وعلى هذا فلا ضمير في الظرف بحال لو كان مذهبه أن المسألتين سواء في أن الاسم مرفوع بالظرف لم يلزم سببويه أن يقول بقوله حتى يجعل الحال من النكرة، وذلك أن قولك: في الدار رجل ليس في الظرف ضمير فإنه ليس بمشتق، ولا يتحمل ضميرًا بوجه أقصى ما يقال: إن عامله وهو الاستقرار يتضمن الضمير وهذا لا يقتضي رجوع حكم الضمير إلى الظرف حتى ينصب عنه الحال، فإنه ليس واقعًا موقعه، ولا بدل من اللفظ به،. ألا ترى أنك لو صرحت بالعامل لم نستغن عن الظرف، فلو قلت: زيد مستقر، لم تستغن عن قولك في الدار. فعلم أنه إنما حذف حذفًا مستقرًا لمكان العلم به، وليس الظرف نائبًا عنه ولا واقعًا موقعه ليصح تحمله الضمير فتأمله فإنه من بديع النحو، وإذا كان كذلك فلا ضمير في الظرف فينصب عنه الحال بوجه فلم يبق معك ما يصح أن يكون صاحب الحال إلا تلك النكرة الموجودة فلهذا جعل الإمام أبو بشر وأئمة أصحابه الحال منها لا من غيرها.
وأما المقام الثاني: فاعلم أن الظرف إذا تقدم وقدرت فيه الضمير صار بمنزلة الفعل العامل. فإنه لا يتحمل الضمير إلا وهو بمنزلة الفعل أو ما أشبهه، وإذا صار بمنزلة الفعل وهو مقدم وجب أن يتجرد عن الضمير قضاء لحق التشبيه بالفعل وقيامه مقامه. فتعدي الضمير فيه ينافي تقديره.
فإن قيل: إنما قدرنا فيه الضمير الذي كان يستحقه وهو خبر فلما قدم وفيه ما يستحقه من الضمير، بخلاف ما إذا كان عاملا محضًا.
قيل: فهلا قدرت مثل هذا في زيد قام. إنه يجوز أن يقدم قام وتقول قام زيد ويكون مبتدأ وخبرًا فلما أجمع النحاة على امتناع ذلك وقالوا لا يجوز تقديم الخبر هنا لأنه لا يعرف هل المسألة من باب الابتداء والخبر أو من باب الفعل والفاعل. وكذلك ينبغي في نائب الفعل من الظرف سواء فتأمله.
وأما المقام الثالث وهو ما ذكره من الدور، فالدور أربعة أقسام دور حكمي. ودور علمي. ودور معي. ودور سبقي تقدمي.
فالحكمي توقف ثبوت حكمين كل منهما على الآخر من الجهة التي توقف الآخر منها. وأخص من هذه العبارة توقف كل من الحكمين على الآخر من جهة واحدة.
والدور العلمي توقف العلم بكل من المعلومين على العلم بالآخر.
والإضافي المعي تلازم شيئين في الوجود لا يكون أحدهما إلا مع الآخر.
والدور السبقي التقدمي توقف وجود كل واحد منهما على سبق الآخر له وهذا المحال.
والإضافي واقع. والدوران الآخران فيهما كلام ليس هذا موضعه.
وإذا عرف هذا فما ذكره في الصورتين الفقهية والنحوية ليس بدور إذ ليس فيه توقف كل من الشيئين في ثبوته على الآخر فإن قبول شهادة العبد موقوفة على قبول شهادة شاهد عتقه، وليس شهادة شاهد العتق موقوفة على شهادته، ولذلك تحمل الظرف للضمير موقوف على تقدير فعل يتضمنه، وتقدير الفعل غير موقوف على تحمل الظرف للضمير فتأمله.
وإنما هذا من باب ما يقتضي إثباته إلى إسقاطه فهو من باب الفروع التي لا تعود على أصولها بالإبطال. وإذا بطلت أصولها بطلت هي فهي موقوفة على صحة أصولها، وصحة أصولها لا تتوقف عليها، ولكن وجه الدور في هذا أنها لو أبطلت أصولها لتوقف صحة أصولها على عدم إفسادها لها وهي متوقفة على اقتضاء أصولها لها. فجاء الدور من هذا الوجه. وكذلك نظائره.
فائدة: النعت
النعت إذا كان تمييزًا للمنعوت مثبتًا له لم يقطع برفع ولا نصب، لأنه من تمامه وإن كان غير تمييز له، بل هي من أداة المدح له، أو الذم المحض شاع قطعه تكررت النعوت، أو لم تتكرر. وإنما يشترط تكرر النعوت إذا كانت للتمييز والتبيين فيحصل الاتباع ببعضها ويسوغ قطع الباقي فتفطن لهذه النكتة، والذي يدلك على ذاك قول سيبويه سمعت العرب يقولون: ( الحمد لله رب العالمين ) فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية.
وفائدة القطع من الأول أنهم إذا أرادوا تجديد مدح، أو ذم جددوا الكلام، لأن تجديد غير اللفظ الأول دليل على تجدد المعنى، وكلما كثرت المعاني وتجدد المدح كان أبلغ.
فائدة بديعة: الشيء لا يعطف على نفسه
القاعدة أن الشيء لا يعطف على نفسه، لأن حروف العطف بمنزلة تكرار العامل لأنك إذا قلت: قام زيد وعمرو فهي بمعنى قام زيد وقام عمرو. والثاني غير الأول فإذا وجدت مثل قولهم كذبًا ومينًا فهو لمعنى زائد في اللفظ الثاني، وإن خفي عنك.
ولهذا يبعد جدًا أن يجيء في كلامهم جاءني عمر وأبو حفص ورضي الله عن أبي بكر وعتيقه، فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين لا بين الشيء الواحد. فإذا كان في الاسم الثاني فائدة زائدة على معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العطف وتركه. فإن عطفت فمن حيث قصدت تعداد الصفات وهب متغايرة، وإن لم تعطف فمن حيث كان في كل منهما ضمير هو الأول فعلى الوجه الأول تقول: زيد فقيه شاعر كاتب. وعلى الثاني فقيه وشاعر وكاتب كأنك عطفت بالواو الكتابة على الشعر وحيث لم تعطف أتبعت الثاني الأول، لأنه هو هو من حيث اتحد الحامل للصفات.
وأما في أسماء الرب تبارك وتعالى فأكثر ما يجيء في القرآن بغير عطف نحو السميع العليم، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، الملك القدوس، السلام إلى آخرها وجاءت معطوفة في موضعين:
أحدهما في أربعة أسماء: وهي { الأول والآخر والظاهر والباطن }.
والثاني: في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله: { الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى }، [286] ونظيره: { الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون * والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون * والذي خلق الأزواج }، [287] فأما ترك العطف في الغالب فلتناسب معاني تلك الأسماء وقرب بعضها من بعض وشعور الذهن بالثاني منها شعوره بالأول. ألا ترى أنك إذا شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمة، وكذلك إذا شعرت بصفة السمع انتقل الذهن إلى البصر وكذلك: { الخالق البارئ المصور }. [288]
وأما تلك الأسماء الأربعة فهي ألفاظ متباينة المعاني متضادة الحقائق في أصل موضوعها وهي متفقة المعاني متطابقة في حق الرب تعالى لا يبقى منها معنى بغيره. بل هو أول كما أنه آخر وظاهر كما أنه باطن. ولا يناقض بعضها بعضًا في حقه فكان دخول الواو صرفًا لوهم المخاطب قبل التفكر والنظر عن توهم المحال واحتمال الأضداد، لأن الشيء لا يكون ظاهرًا باطنًا من وجه واحد، وإنما يكون ذلك باعتبارين فكان العطف ههنا أحسن من تركه لهذه الحكمة هذا جواب السهيلي.
وأحسن منه أن يقال: لما كانت هذه الألفاظ دالة على معاني متباينة، وأن الكمال في الاتصاف بها على تباينها أتى بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات إيذانًا بأن هذه المعاني مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بها.
ووجه آخر وهو أحسن منهما، وهو أن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم. وتقريره يكون في الكلام متضمنًا لنوع من التأكيد من مزيد التقرير. وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه، إذا كان لرجل مثلًا أربع صفات هو: عالم وجواد وشجاع وغني وكان المخاطب لا يعلم ذلك، أو لا يقربه ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجل، فإذا قلت: زيد عالم وكان ذهنه استبعد ذلك. فتقول: وجواد أي وهو مع ذلك جواد. فإذا قدرت استبعاده لذلك قلت: وشجاع أي وهو مع ذلك شجاع وغني فيكون في العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الإنكار.
وإذا عرفت هذا فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في موصوف واحد. فإذا قيل: هو الأول ربما سرى الوهم إلى أن كونه أولا يقتضي أن يكون الآخر غيره، لأن الأولية والآخرية من المتضايفات. وكذلك الظاهر والباطن إذا قيل: هو ظاهر ربما سرى الوهم إلى أن الباطن مقابله. فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية فكأنه قيل: هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه، فتأمل ذلك فإنه من لطيف العربية ودقيقها.
والذي يوضح لك ذلك أنه إذا كان للبلد مثلًا قاض وخطيب وأمير فاجتمعت في رجل حسن أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضي والأمير وكان للعطف هنا مزية ليست للنعت المجرد. فعطف الصفات ههنا أحسن قطعًا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وأن الأمير غيره.
وأما قوله تعالى: { غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو } [289] فعطف في الاسمين الأولين دون الآخرين. فقال السهيلي: إنما حسن العطف بين الاسمين الأولين لكونهما من صفات الأفعال وفعله سبحانه في غيره، لا في نفسه. فدخل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين ولتنزلهما منزلة الجملتين، لأنه يريد تنبيه العياد على أنه يفعل هذا، ويفعل هذا ليرجوه ويؤملوه، ثم قال: { شديد العقاب } بغير واو، لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة والقدرة وهو معنى خارج عن صفات الأفعال فصار بمنزلة قوله: { العزيز العليم }، [290] وكذلك قوله: { ذي الطول } لأن لفظ ذي عبارة عن ذاته.
هذا جوابه، وهو كما ترى غير شاف، ولا كاف. فإن شدة عقابه من صفات الأفعال. وطوله من صفات الأفعال، ولفظه ذي فيه لا تخرجه عن كونه صفة فعل كقوله: { عزيز ذو انتقام }، [291] بل لفظ الوصف بغافر وقابل أدل على الذات من الوصف بذي، لأنها بمعنى صاحب كذا. فالوصف المشتق أدل على الذات من الوصف بها فلم يشف جوابه، بل زاد السؤال سؤالًا.
فاعلم أن هذه الجملة مشثملة على ستة أسماء كل اثنين منها قسم. فابتدأها بالعزيز العليم وهما اسمان مطلقان، وصفتان من صفات ذاته، وهما مجردان على العاطف.
ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أفعاله، فأدخل بينهما العاطف، ثم ذكر اسمين آخرين بعدهما وجردهما من العاطف، فاما الأولان فتجردهما من العاطف لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم الله وهما متلازمان. فتجريدهما عن العطف هو الأصل وهو موافق لبيان ما في الكتاب العزيز من ذلك، كالعزيز العليم، والسميع والبصير والغفور الرحيم.
وأما: { غافر الذنب وقابل التوب } فدخل العاطف بينهما، لأنهما في معنى الجملتين وإن كانا مفردين لفظًا فهما يعطيان معنى يغفر الذنب ويقبل التوب أي هذا شأنه ووصفه في كل وقت فأتى بالاسم الدال على أن وصفه ونعته المتضمن لمعنى الفعل الدال على أنه لا يزال يفعل ذلك فعطف أحدهما على الآخر على نحو عطف الجمل بعضها على بعض، ولا كذلك الاسمان الأولان، ولما لم يكن الفعل ملحوظًا في قوله: { شديد العقاب ذي الطول إذ لا يحسن وقوع الفعل فيهما وليس في لفظ ( ذي ) ما يصاغ منه فعل جرى مجرى المفردين من كل وجه، ولم يعطف أحدهما على الآخر كما لم يعطف في العزيز العليم، فتأمله فإنه واضح.
وأما العطف في قوله: { الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى } [292] فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملة دخلت الواو عاطفة جملة على جملة وإن كانت الجملة مع الموصول في تقدير المفرد. فالفعل مراد مقصود، والعطف يصير كلًا منها جملة مستقلة مقصودة بالذكر بخلاف ما لو أتى بها في خبر موصول واحد فقيل: { الذي جعل لكم الأرض مهدا } و { نزل من السماء ماء } و { خلق الأزواج كلها } [293] كانت كلها في حكم جملة واحدة. فلما غاير بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كل جملة دل على أن المقصود وصفه بكل من هذه الجمل على حدتها وهذا قريب من باب قطع النعوت، والفائدة هنا كالفائدة ثم وقد تقدمت الإشارة إليها فراجعها، بل قطع النعوت. إنما كان لأجل هذه الفائدة فذلك المقدر في النعوت المقطوعة لهذا المحقق به وأنعم، فإنه ذو الطول والإحسان.
تتمة
تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفتي رحمة قبله وصفة رحمة بعده. فقبله: { غافر الذنب وقابل التوب } وبعده: { ذي الطول }، [294] ففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له وهو قوله ﷺ: «إن الله كتب كتابًا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي»، وفي لفظ: «سبقت غضبي»، وقد سبقت صفتا الرحمة هنا وغلبت.
وتأمل كيف افتتح الآية بقوله: { تنزيل الكتاب } [295] والتنزيل يستلزم علو المنزل من عنده لا تعقل العرب من لغتها. بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك. وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين: أحدهما: علوه تعالى على خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره. فإنه أخبر أنه منه. وهذا يقتضي أن يكون منه قولًا كما أنه منه تنزيلًا فإن غيره. لو كان هو ا لمتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير فإن الكلام، إنما يضاف إلى المتكلم به.
ومثل هذا: { ولكن حق القول مني }، [296] ومثله: { قل نزله روح القدس من ربك }، [297] ومثله: { تنزيل من حكيم حميد } [298] فاستمسك بحرف من في هذه المواضع فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية.
وتأمل كيف قال تعالى: { تنزيل من ولم يقل تنزيله فتضمنت الآية إثبات علوه وكلامه وثبوت الرسالة ثم قال: { العزيز العليم } [299] فتضمن هذان الإسمان صفتي القدرة والعلم وخلق أعمال العباد وحدوث كل ما سوى الله لأن القدرة هي قدرة الله كما قال أحمد بن حنبل فتضمنمت إثبات القدر، ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه، أو أن يشاء ما لا يكون فكان عزته تبطل ذلك. وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء. وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه، لأن كمال قدرته وعزته يبطل ذلك.
ثم قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب، والذنب مخالفة شرعه وأمره، فتضمن هذان الإسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله، ثم قال: شديد العقاب، وهذا جزاؤه للمذنبين وذو الطول جزاؤه للمحسنين فتضمنت الثواب والعقاب.
ثم قال تعالى: { لا إله إلا هو إليه المصير }، [300] فتضمن ذلك التوحيد والمعاد.
فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلو والكلام والقدرة والعلم والقدر وحدوث العالم والثواب والعقاب والتوحيد والمعاد. وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة، فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان تجلي على سمعك في هذه الآية العظيمة، ولكن * خود تزف إلى ضرير مقعد *
فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها، وسماعك إياها. وهكذا سائر آيات القرآن، فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم، ثم يخرج من الدنيا، وما فهم حقائق القرآن، ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه. فالله المستعان.
فائدة جليلة: تقدير العامل في المعطوف
العامل في المعطوف مقدر في معنى المعطوف عليه، وحرف العطف أغنى عن إعادته وناب منابه، وإنما قلنا ذلك للقياس والسماع.
أما القياس فإن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله، ولا يتعلق به إلا في باب المفعول معه، لأنه قد أخذ معموله ولا يقتضي ما بعد حرف العطف، ولا يصح تسليطه عليه بوجه فلا تقول: ضربت وعمرًا. فكيف يقال: إن عاملًا يعمل في شيء فلا يصح مباشرته إياه، وأيضا فالنعت هو المنعوت في المعنى ولا واسطة بينه، وبين المنعوت، ومع ذلك فلا يعمل فيه ما يعمل في المنعوت على القول الذي نصرناه سالفًا وهو الصحيح، فكيف بالمعطوف الذي هو غير المعطوف عليه من كل وجه.
وأما السماع فإظهار العامل قبل المعطوف في مثل قوله:
بل بنو النجار إن لنا ** فيهم قتلى وإن تره
يريد: لنا فيهم قتلى وترة، وهذا مطرد في سائر حروف العطف ما لم يمنع مانع كما منع في المعطوف على اسم لا يصح انفراده عنه نحو: اختصم زيد وعمرو، وجلست بين زيد وعمرو. فإن الواو هنا تجمع بين الاسمين في العالم. فكأنك قلت: اختصم هذان واجتمع الرجلان في قولك: اجتمع زيد وعمرو. ومعرفة هذه الواو أصل يبنى عليه فروع كثيرة فمنها. أنك تقول: رأيت الذي قام زيد وأخوه، على أن تكون الواو جامعة وإن كانت عاطفة لم يجز، لأن التقدير يصير قام زيد وقام أخوه فخلت الصلة من العائد. ومنها قوله سبحانه: { وجمع الشمس والقمر } [301] غلب المذكر على المؤنث لاجتماعهما، ولو قلت طلع الشمر والقمر لقبح ذلك، كما يقبح قام هند وزيد إلا أن تريد الواو الجامعة لا العاطفة، وأما في الآية فلا بد أن تكون الواو جامعة، ولفظ الفعل يقتضي ذلك.
وأما الفاء فهي موضوعة للتعقيب وقد تكون للتسبيب والترتيب وهما راجعان إلى معنى التعقيب، لأن الثاني بعدهما أبدًا. إنما يجيء في عقب الأول، فالسبب نحو ضربته فبكى. والترتيب: { أهلكناها فجاءها بأسنا } [302] دخلت الفاء لترتيب اللفظ، لأن الهلاك يجب تقديمه في الذكر لأن الاهتمام به أولى وإن كان مجيء البأس قبله في الوجود. ومن هذا:
إن من ساد، ثم ساد أبوه ** ثم قد ساد بعد ذلك جده
دخلت "ثم" لترتيب الكلام لا لترتيب المعنى في الوجود، وهذا معنى قول بعض النحاة: إنها تأتي للترتيب في الخبر لا في المخبر.
وعندي في الآية تقديران آخران أحسن من هذا:
أحدهما: أن يكون المراد بالإهلاك إرادة الهلاك. وعبر بالفعل عن الإرادة وهو كثير فترتب مجيء البأس على الإرادة ترتب المراد على الإرادة.
والثاني: وهو ألطف أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على جملة. فذكر الإهلاك ثم فصله بنوعين أحدهما مجيء البأس بياتًا أي ليلًا. والثاني: مجيئه وقت القائلة، وخص هذين الوقتين، لأنهما وقت راحتهم وطمأنيتهم، فجاءهم بأس الله أسكن ما كانوا وأروحه في وقت طمأنينتهم وسكونهم على عادته سبحانه في أخذ الظالم في وقت بلوغ آماله وكرمه وفرحه وركونه إلى ما هو فيه. وكذلك قوله تعالى: { حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا }. [303] والمقصود أن الترتيب هنا، ترتيب التفصيل على الجمل وهو ترتيب علمي لا خارجي، فإن الذهن يشعر بالشيء جملة أولًا، ثم يطلب تفصيله بعد ذلك. وأما في الخارج فلم يقع إلا مفصلًا، فتأمل هذا الموضع الذي خفي على كثير من الناس حتي ظن أن الترتيب في الآية كترتيب الأخبار. أي: إنا أخبرناكم بهذا قبل هذا.
وأما قوله تعالى: { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } [304] فعلى ما ذكرنا من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور.
وفيه وجه ألطف من هذا، وهو أن العرب تعبر بالفعل عن ابتداء الشروع فيه تارة، وتعبر عن انتهائه تارة، فيقولون: فعلت عند الشروع، وفعلت عند الفراغ وهذا استعمال حقيقي وعلى هذا فيكون معنى قرأت في الآية ابتداء الفعل أي إذا شرعت وأخذت في القراءة فاستعذ فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادىء الفعل ومقدمته وطليعته. ومنه قوله: فصلى الصبح حتى طلع الفجر أي أخذ في الصلاة عند طلوعه.
وأما قوله: ثم صلاها من الغد بعد أن أسفر. فالصحيح أن المراد به الابتداء وقالت طالفة: المراد الانتهاء منهم السهيلي وغلطوا في ذلك، والحديث صريح في أنه قدمها في اليوم الأول، وأخرها في اليوم الثاني ليبين أول الوقت وآخره.
وقوله في حديث جبريل: صلى الظهر حين زالت الشمس هذا ابتداؤها ليس إلا.
وقوله: صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، فذلك مراد به الابتداء.
وأما قوله: وصلى الظهر من الغد حين صار ظل الرجل مثله، فقيل: المراد به الفراغ منها أي فرغ منها في هذا الوقت، وقيل: المراد به الابتداء أي أخرها إلى هذا الوقت بيانًا لا آخر الوقت وعلى هذا. فتمسك به أصحاب مالك في مسألة الوقت المشترك والكلام في هذه المسائل ليس هذا موضعه.
فصل: حتى
وأما حتى فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها، وغاية كل شيء حده. وذلك كان لفظها كلفظ الحد فإنها حاء قبل تاءين. كما أن الحد حاء قبل دالين والدال كالتاء في المخرج والصفة إلا في الجهر فكانت لجهرها أولى بالاسم لقوته. والتاء لهمسها أولى بالحرف لضفه ومن حيث كانت حتى كانت للغاية خفضوا بها كما يخفضون بإلى التي للغاية والفرق بينهما أن حتى غاية لما قبلها وهو منه وما بعد إلى ليس مما قبلها بل عنده انتهى من قبل الحرف، ولذلك فارقتها في أكثر أحكامها ولم تكن إلى عاطفة لانقطاع ما بعدها عما قبلها بخلاف حتى. ومن ثم دخلت حتى في حروف. العطف ولم يجز دخولها على المضمر المخفوض. إذا كانت خافضة لا تقول قام القوم حتاك، كما لا تقول قاموا وك، ومن حيث كانت ما بعدها غاية لما قبلها لم يجز في العطف قام زيد حتى عمرو، ولا أكلت خبزًا حتى تمرًا، لأن الثاني ليس بحد للأول ولا ظرف.
تنبيه
ليس المراد من كون حتى لانتهاء الغاية وإن ما بعدها ظرفًا. أن يكون متأخرًا في الفعل عما قبلها، فإذا قلت: مات الناس حتى الأنبياء، وقدم الحاج حتى المشاه لم يلزم تأخر موت الأنبياء عن الناس، وتأخر قدوم المشاة عن الحاج.
ولهذا قال بعض الناس: إن حتى مثل الواو لا تخالفها إلا في شيئين. أحدهما: أن يكون المعطوف من قبيل المعطوف عليه فلا تقول: قدم الناس حتى الخيل بخلاف الواو. الثاني: أن تخالفه بقوة أو ضعف أو كثرة أو قلة، وأما أن يفهم منها الغاية والحد فلا والذي حمله على ذلك ما تقدم من المثالين، ولكن فاته أن يعلم المراد بكون ما بعدها غاية وظرفًا. فاعلم أن المراد به أن يكون غاية في المعطوف عليه لا في الفعل. فإنه يجب أن يخالفه في الأشد والأضعف والقلة والكثرة. وإذا فهمت هذا، فالأنبياء غاية للناس في الشرف والفضل، والمشاة غاية للحجاج في الضعف والعجز وأنت إذا قلت: أكلت السمكة حتى رأسها. فالرأس غاية لانتهاء السمكة، وليس المراد أن غاية أكلك كان الرأس فلا يجوز أن يتقدم أكلك للرأس.. وهذا مما أغفله كثير من النحويين لم ينبهوا عليه.
فائدة: أو للدلالة على أحد الشيئين
"أو" وضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين معها ولذلك وقعت في الخبر المشكوك فيه من حيث كان الشك ترددًا بين أمرين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر لا أنها وضعت للشك. فقد تكون في الخبر الذي لا شك فيه. إذا أبهمت على المخاطب ولم تقصد أن تبين له كقوله سبحانه: { إلى مائة ألف أو يزيدون }. [305] أي أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم: هم مائة ألف أو يزيدون. فأو على بابها دالة على أحد الشيئين. إما مائة ألف بمجردها وإما مائة ألف مع زيادة. والمخبر في كل هذا لا يشك.
وقوله: { فهي كالحجارة أو أشد قسوة }، [306] ذهب في هذه الزجاج كالتي في قوله: { أو كصيب من السماء }، [307] إلى أنها أو التي للإباحة أي أبيح للمخاطبين أن يشبهوا بهذا أو هذا، وهذا فاسد، فإن أو لم توضع للإباحة في شيء من الكلام، ولكنها على بابها. أما قوله: { أو كصيب من السماء } فإنه تعالى ذكر مثلين مضروبين للمنافقين في حالتين مختلفتين. فهم لا يخلون من أحد الحالتين فأو على بابها من الدلالة على أحد المعنيين. وهذا كما تقول: زيد لا يخلو أن يكون في المسجد، أو الدار ذكرت، أو لأنك أردت أحد الشيئين. وتأمل الآية بما قبلها وافهم المراد منها تجد الأمر كما ذكرت لك، وليس المعنى ابحت لكم أن تشبهوهم بهذا وهذا.
وأما قوله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة فإنه ذكر قلوبًا ولم يذكر قلبًا واحدًا. فهي على الجملة قاسية أو على التعيين لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون كالحجارة. وإما أن تكون أشد قسوة. ومنها ما هو كالحجارة ومنها ما هو أشد قسوة منها، ومن هذا قول الشاعر:
فقلت لهم ثنتان لا بد منهما ** صدور رماح أشرعت أو سلاسل
أي لا بد منهما في الجملة، ثم فصل الاثنين بالرماح والسلاسل فبعضهم له الرماح قتلًا، وبعضهم له السلاسل أسرًا. فهذا على التفصيل والتعيين. والأول على الجملة فالأمران واقعان جملة، وتفصيلهما بما بعد أو. وقد يجوز في قوله تعالى: أو أشد قسوة مثل أن يكون مائة ألف، أو يزيدون.
وأما أو التي للتخيير فالأمر فيها ظاهر.
وأما "أو" التي زعموا أنها للإباحة نحو جالس مر الذي هو للإباحة ويدل على هذا أن القائلين بأنها للإباحة يلزمهم أن يقولوا إنها للوجوب إذا دخلت بين شيئين لا بد من أحدهما نحو قولك للمكفر أطعم عشرة مساكين، أو اكسهم، فالوجوب هنا لم يوجد من "أو" وإنما اخذ من الأمر. فكذا جالس الحسن أو ابن سيرين.
فصل: لكن
وأما لكن فقال السهيلي: أصح القولين فيها أنها مركبة من لا وإن وكاف الخطاب في قول الكوفيين. قال السهيلي: وما أراها إلا كاف التشبيه، لأن المعنى يدل عليها. إذا قلت: ذهب زيد، لكن عمرو مقيم تريد لا ينتقل عمرو فلا لتوكيد النفي عن الأول. وإن لإيجاب الفعل الثاني وهو النفي عن الأول، لأنك ذكرت الذاهب الذي هو ضده فدل على انتفائه به.
قلت: وفي هذا من التعسف والبعد عن اللغة والمعنى ما لا يخفى وأي حاجة إلى هذا، بل هي حرف شرط موضوع للمعنى المفهوم منها، ولا تقع إلا بين كلامين متنافيين.
ومن هنا قال: إنها ركبت من لا والكاف وإن، إلا أنهم لما حذفوا الهمزة المذكورة كسروا الكاف إشعارًا بها، ولا بد بعدها من جملة، إذا كان الكلام قبلها موجبًا شددت نونها، أو خففت فإن كان ما قبلها منفيًا اكتفيت بالاسم المفرد بعدها، إذا خففت النون منها لعلم المخاطب أنه لا يضاد النفي إلا الإيجاب فلما اكتفيت باسم مفرد وكانت إذا خففت نونها لا تعمل مطيرت كحروف العطف فألحقوها بها، لأنهم حين استغنوا عن خبرها بما تقدم من الدلالة كان إجراء ما بعدها على ما قبلها أولى وأحرى ليتفق اللفظ كما اتفق المعنى.
فإن قيل: أليس مضادة النفي للوجوب بمثابة مضادة الوجوب للنفي. وهي في كل حال لا تقع إلا بين كلامين متضادين. فلم قالوا: ما قام زيد، لكن قام عمرو، اكتفاء بدلالة النفي على نقيضه وهو الوجوب، ولم يقولوا: قام زيد لكن قام عمرو، اكتفاء بدلالة الوجوب على نقيضه من النفي.
قيل: إن الفعل الموجب قد تكون له معان تضاده وتناقض وجوده، كالعلم. فإنه يناقض وجود الشك والظن والغفلة والموت، وأخص أضداده به الجهل. فلو قلت: قد علمت الخبر، لكن زيد لم يدر ما أضفت إلى زيدًا ظن أو شك أم غفلة أم جهل؟ فلم يكن بد من جملة قائمة بنفسها لعلم ما تريد، فإذا تقدم النفي نحو قولك ما علمت الخبر لكن زيد اكتفى باسم واحد لعلم المخاطب أنه لا يضاد نفي العلم إلا وجوده، لأن النفي مشتمل على جمبع أضداده المنافية للعلم.
فإن قيل: فام إذا خففت وجب الغاؤها بخلاف أن وإن وكأن فإنه يجوز فيها الوجهان مع التخفيف، كما قال: * كأن ظبية تَعطُو إلى وارِق السَّلَم *
قيل: زعم الفارسي أن القياس فيهن كلهن الإلغاء إذا خففن. فلذلك ألزموا لكن إذا خففت الإلغاء تنبيهًا على أن ذلك هو الأصل في جميع الباب. وهذا القول مع ما يلزم عليه من الضعف والوهن ينكسر عليه بأخواتها. فيقال له: فلم خصت، لكن بذلك دون إن وإن ولا جواب له عن هذا.
قال السهيلي: وإنما الجواب عن ذلك أنها لما ركبت من لا وإن، ثم حذفت الهمزة اكتفاء بكسر الكاف بقي عمل أن لبقاء العلة الموجبة للعمل وهي فتح آخرها، وبذلك ضارعت الفعل. فلما حذفت النون المفتوحة وقد ذهبت الهمزة للتركيب ولم يبق إلا النون الساكنة وجب إبطال حكم العمل بذهاب طرفها وارتفاع علة المضارعة للفعل بخلاف أخواتها إذا خففن فإن معظم لفظها باق فجاز أن يبقى حكمها على أن الأستاذ أبا القاسم الرمان قد حكى رواية عن يونس أنه حكى الأعمال في لكن مع تخفيفها. وكان يستغرب هذه الرواية.
واعلم أن لكن لا تكون حرف عطف مع دخول الواو عليها، لأنه لا يجتمع حرفان من حروف العطف. فمتى رأيت حرفًا من حروف العطف مع الواو قالوا هي العاطفة دونه فمن ذلك. أما إذا قلت: إما زيد، وإما عمرو، وكذلك لا. إذا قلت: ما قام زيد ولا عمرو. ودخلت لا لتوكيد النفي. ولئلا يتوهم أن الواو جامعة، وإنك نفيت قيامهما في وقت واحد.
(فصل في لا العاطفة)
ولا تكون "لا" عاطفة إلا بعد إيجاب. وشرط آخر وهو أن يكون الكلام قبلها يتضمن بمفهوم الخطاب نفي الفعل عما بعدها. كقولك: جاءني رجل لا امرأة ورجل عالم لا رجل جاهل، ولو قلت: مررت برجل لا زيد لم يجز، وكذلك مررت برجل لا عاقل، لأنه ليس في مفهوم الكلام ما ينفي الفعل عن الثاني وهي لا تدخل إلا لتوكيد نفي. فإن أردت ذلك المعنى جئت بلفظ غير فتقول: مررت برجل غير زيد ورجل غير عالم، ولا تقول برجل غير امرأة ولا بطويل غير قصير، لأن في مفهوم الخطاب ما يغنيك عن مفهوم النفي الذي في غير وذلك المعنى الذي دل عليه المفهوم حتى قلت بطويل لا قصير.
وأما إذا كانا اسمين معرفين نحو مررت بزيد لا عمرو فجائز هنا. دخول غير لجمود الاسم العلم. فإنه ليس له مفهوم خطاب عند الأصوليين بخلاف الأسماء المشتقة، وما جرى مجراها كرجل. فإنه بمنزلة قولك ذكر ولذلك دل بمفهومه على انتقال الخبر عن المرأة ويجوز أيضا مررت بزيد لا عمرو لأنه اسم مخصوص بشخص وكأنه حين خصصته بالذكر نفيت المرور عن عمرو، ثم أكدت ذلك النفي بلا.
وأما الكلام المنفي فلا يعطف عليه بلا، لأن نفيك الفعل عن زيد إذا قلت ما قام زيد لا يفهم منه نفيه عن عمرو فيؤكد بلا.
فإن قلت: أكد بها النفي المتقدم.
قيل لك: وأي شيء يكون حينئذ إعراب عمرو وهو اسم مفرد ولم يدخل عليه عاطف يعطف على ما قبله. فهذا لا يجوز إلا أن تجعله مبتدأ وتأتي بخبر. فتقول: ما قام زيد لا عمرو هو القائم. وإما إن أردت تشريكهما في النفي فلا بد من الواو إما وحدها. وإما مع لا فلا تكون الواو عاطفة ومعها لا.
وأما قوله: { غير المغضوب عليهم ولا الضالين }، فإن معنى النفي موجود في غير.
فإن قيل: فهلا قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين.
قيل: في ذكر غير بيان للفضيلة للذين أنعم عليهم وتخصيص لنفي صفة الضلال والغضب عنهم، وأنهم الذين أنعم عليهم بالنبوة والهدى دون غيرهم، ولو قال لا المغضوب عليهم ولا الضالين، لم يكن في ذلك إلا تأكيد نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم. كما تقول: هذا غلام زيد لا عمرو. أكدت نفي الإضافة عن عمرو بخلاف قولك، هذا غلام الفقيه غير الفاسق، ولا الخبيث. وكأنك جمعت بين إضافة الغلام إلى الفقيه دون غيره. وهي نفي الصفة المذمومة عن الفقيه فافهمه.
فإن قيل: وأي شيء أكدت لا حتى أدخلت عليها الواو وقد قلت إنها لا تؤكد المنفي المتقدم، وإنما تؤكد نصبًا يدل عليه اختصاص الفعل الواجب بوصف ما كقولك: جاءني رجل عالم لا جاهل.
فالجواب أنك حين قلت: ما جاءني زيد، لم يدل الكلام على نفي المجيء عن عمرو كما تقدم. فلما عطفت بالواو دل الكلام على انتفاء الفعل عن عمرو كما انتفى عن الأول لقيام الواو مقام تكرار حرف النفي، فدخلت لا لتوكيد النفي عن الثاني.
فائدة بديعة: أم على ضربين
"أمْ" تكون على ضربين؛ متصلة وهي المعادلة لهمزة الاستفهام وإنما جعلوها معادلة للهمزة دون هل ومتى وكيف، لأن الهمزة هي أم الباب والسؤال بها استفهام بسيط مطلق غير مقيد بوقت ولا حال، والسؤال بغيرها استفهام مركب مقيد، إما بوقت كمتى، وإما بمكان كأين، وإما بحال نحو كيف، وإما بنسبة نحو هل زيد عندك. ولهذا لا يقال "كيف زيد أم عمرو"، ولا "أين زيد أم عمرو"، ولا "من زيد أم عمرو".
وأيضا فلأن الهمزة وأم يصطحبان كثيرًا كقوله تعالى: { سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم }، [308] ونحو قوله تعالى: { أأنتم أشد خلقًا أم السماء }. [309]
وأيضا فلأن اقتران أم بسائر أدوات النفي غير الهمزة يفسد معناها فإنك إذا قلت كيف زيد فأنت سائل عن حاله. فإذا قلت: أم عمرو كان خلفًا من الكلام، وكذلك إذا قلت: من عندك فأنت سائل عن تعيينه، فإذا قلت: أم عمرو فسد الكلام، وكذلك الباقي.
وأيضا فإنما عادلت الهمزة دون غيرها، لأن الهمزة من بين حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات نحو ألم أحسن إليك. فإذا قلت: أعندك زيد أم عمرو فأنت مقر بأن أحدهما عنده، ومثبت لذلك، وطالب تعيينه فأتوا بالهمزة التي تكون للتقرير دون هل التي لا تكون لذلك، إنما يستقبل بها الاستفهام استقبالًا.
وسر المسألة أن أم هذه مشربة معنى أي. فإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو كأنك قلت: أي هذين عندك. ولذلك تعين الجواب بأحدهما أو بنفيهما أو بإثباتهما، ولو قلت: نعم، أو لا. كان خلفًا من الكلام وهذا بخلاف أو فإنك إذا قلت أزيد عندك أو عمرو كنت سائلًا عن كون أحدهما عنده بخبر معين فكأنك قلت: أعندك أحدهما. فيتعين الجواب بنعم أو لا.
وتفصيل ذلك أن السؤال على أربع مراتب في هذا الباب الأول السؤال بالهمزة منفردة نحو أعندك شيء مما يحتاج إليه فتقول: نعم. فينتقل إلى المرتبة الثانية. فتقول: ما هو؟ فتقول: متاع، فينتقل إلى المرتبة الثالثة بأي فتقول: أي متاع؟ فتقول: ثياب فتنتقل إلى المرتبة الرابعة. فتقول: أكتان هي أم قطن أم صوف؟ وهذه أخص المراتب وأشدها طلبًا للتعيين فلا يحسن الجواب إلا بالتعيين وأشدها إبهامًا السؤال الأول لأنه لم يدع فيه أن عنده شيئًا، ثم الثاني أقل إبهامًا منه، لأن فيه ادعاء شيء عنده وطلب ماهيته، ثم الثالث أقل إبهامًا وهو السؤال بأي، لأن فيه طلب تعيين ما عرف حقيقته، ثم السؤال الرابع بأم أخص من ذلك كله، لأن فيه طلب تعيين فرد من أفراد قد عرفها وميزها. والثالث: إنما فيه تعيين جنس عن غيره.
ولا بد في أم هذه من ثلاثة أمور تكون بها متصلة:
أحدها: أن تعادل بهمزة الاستفهام.
الثاني: أن يكون السائل عنده علم أحدها دون تعيينه.
الثالث: أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر نحو قولك: أزيد عندك، أم عندك عمرو فقولك أم عندك عمرو. يقتضي أن تكون منفصلة بخلاف ما، إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو فإذا وقعت الجملة بعدها فعلية لم تخرجها عن الاتصال نحو أعطيت زيدًا أم حرمته.
وسر ذلك كله أن السؤال قام عن تعيين أحد الأمرين أو للأمر. فإذا قلت: أزيد عندك أم عمرو كأنك قلت: أيهما عندك وإذا قلت: أزيد عندك؟ أم عندك عمر؟ وكان كل واحد منهما جملة مستقلة بنفسها، وإن سائل هل عنده زيد أو لا، ثم استأنفت سؤالا آخر هل عندك عمرو أم لا. فتأمله فإنه من دقيق النحو وفقهه، ولذلك سميت متصلة لاتصال ما بعدها بما قبلها وكونه كلامًا واحد.
وفي السؤال بها معادلة وتسوية، فأما المعادلة فهي بين الاسمين أو الفعلين، لأنك جعلت الثاني عديل الأول في وقوع الألف على الأول، وأم على الثاني. وأما التسوية فإن الشيئين المسؤول عن تعيين أحدهما مستويان في علم السائل وعلى هذا فقوله تعالى: { أأنتم أشد خلقًا أم السماء بناها }، هو على التقرير والتوبيخ والمعنى أي المخلوقين أشد خلقًا وأعظم. ومثله: { أهم خير أم قوم تبع }. [310]
فإن قيل: هذا ينقض ما أصلتموه فإنكم ادعيتم أنها إنما يسأل بها عن تعيين ما علم وقوعه، وهنا لا خير فيهم ولا في قوم تبع.
قيل: هذا لا ينقض ما ذكرناه، بل يشده ويقويه، فإن مثل هذا الكلام يخرج خطابًا على تقرير دعوى المخاطب وظنه أن هناك خيرًا، ثم يدعي أنه هو ذلك المفصل فيخرج الكلام معه والتقريع والتوبيخ على زعمه وظنه. أي ليس الأمر كما زعمتم، وهذا كما تعاقب شخصًا على ذنب لم يفعله مثله وتدعي أنك لا تعاقبه.
فتقول: أنت خير أم فلان؟ وقد عاقبته بهذا الذنب ولست خيرًا منه.
فصل: أم المنقطعة للإضراب
وأما أم التي للإضراب وهي المنقطعة فإنها قد تكون أم إضرابًا، ولكن ليس بمنزلة بل كما زعم بعضهم، ولكن إذا مضي كلامك على اليقين، ثم أدركك الشك مثل قولهم إنها لا بل أم شاء كأنك أضربت عن اليقين ورجعت إلى الاستفهام حين أدركك الشك.
ونظيره قول الزباء: * عسى الغوير أبؤسا * فتكلمت بعسى الغوير، ثم أدركها اليقين فختمت كلامها بحكم ما غلب على ظنها لا بحكم عسى، لأن عسى لا يكون خبرها اسمًا عن حدث فكأنها لما قالت: عسى الغوير قالته متوقعة شرًا تريد الإخبار بفعل مستقبل متوقع كما تقتضيه عسى، ثم هجم عليها اليقين فعدلت إلى الإخبار باسم حدث يقتضي جملة ثبوتية محققة. فكأنها قالت: أصار الغوير؟ أبؤسا؟ فابتدأت كلامها على الشك، ثم ختمته بما يقتضي اليقين والتحقيق.
فكذا أم إذا قلت: إنها لأبل ابتدأت كلامك باليقين والجزم، ثم أدركك الشك في أثنائه فاتيت بام الدالة على الشك فهو عكس طريقة عسى الغوير أبؤسا، ولذلك قدرت ببل لدلالتها على الاضراب، فإنك أضربت عن الخبر الأول إلى الاستفهام والشك. فإنك أخبرت أولا عما توهمت، ثم أدركك الشك فأضربت عن ذلك الإخبار. وإذا وقع بعد أم هذا الاسم المفرد فلا بد من تقدير مبتدأ محذوف وهمزة استفهام. فإذا قلت: إنها لا بل أم شاء كان تقديره لا بل أهي شاء وليس الثاني خبرًا ثبوتيًا كما توهمه بعضهم وهو من أقبح الغلط. والدليل عليه قوله تعالى: { أم له البنات ولكم البنون }. [311]، وقوله تعالى: { أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين }، [312] وقوله تعالى: { أم لهم إله غير الله أم لهم سلم يستمعون فيه }، [313] { أم لكم سلطان مبين } [314] { أم خلقوا من غير شيء }، [315] فهذا ونحوه يدلك على أن الكلام بعدها استفهام محض وأنه لا يقدر ببل وحدها، ولا يقدر أيضا بالهمزة وحدها. إذ لو قدر بالهمزة وحدها لم يكن بينه وبين الأول علقة، لأن الأول خبر، وأم المقدرة بالهمزة وحدها لا تكون إلا بعد استفهام، فتأمله.
هذا شرح كلام التحاة وتقريره في هذا الحرف. والحق أن يقال: إنها على بابها، وأصلها الأول من المعادلة والاستفهام حيث وقعت وإن لم يكن قبلها أداة استفهام في اللفظ وتقديرها ببل. والهمزة خارج عن أصول اللغة والعربية فإن أم للاستفهام وبل للإضراب ويا بعد ما بينهما والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض على أصح الطريقتين. وهي طريقة إمام الصناعة والمحققين من أتباعه. ولو قدر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معناهما كمعنى على وفي ومعنى إلى ومع. ونظائر ذلك، وأما في ما لا جامع بينهما فلا. ومن هنا كان زعم من زعم أن لا قد تأتي بمعنى الواو باطلًا لبعد ما بين معنيهما، وكذلك أو بمعنى الواو فأين معنى الجمع بين الشيئين إلى معنى الإثبات لأحدهما؟ وكذلك مسألتنا أين معنى أم من معنى بل، فاسمع الآن فقه المسألة وسرها:
اعلم أن ورود أم هذه على قسمين. أحدهما ما تقدمه استفهام صريح بالهمزة وحكمها ما تقدم وهو الأصل فيها والأخية التي يرجع إليها ما خرج عن ذلك كله. والثاني ورودها مبتدأة مجردة من استفهام لفظي سابق عليها نحو قوله تعالى: { أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا }، [316] وقوله تعالى: { أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون }، [317] وقوله: { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة }، [318] { أم لم يعرفوا رسولهم }، [319] { أم اتخذ مما يخلق بنات }، [320] { أم له البنات }، [321] { أم أنا خير من هذا الذي هو مهين } [322] { أم أنزلنا عليهم سلطانًا }، [323] وهو كثير جدًا تجد فيه أم مبتدأ بها ليس قبلها استفهام في اللفظ، وليس هذا استفهام استعلام بل تقريع وتوبيخ وإنكار. وليس بإخبار فهو إذًا متضمن لاستفهام سابق مدلول عليه بقوة الكلام وسياقه ودلت أم عليه لأنها لا تكون إلا بعد تقدم استفهام كأنه يقول: أيقولون صادق أم يقولون شاعر، وكذلك أم يقولون تقوله أي أتصدقونه أم تقولون تقوله. وكذلك: { أم حسبت أن أصحاب الكهف }، [324] أي أبلغك خبرهم أم حسبت أنهم كانوا من آياتنا عجبًا. وتأمل كيف تجد هذا المعنى باديًا على صفحات قوله تعالى: { ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين }، [325] كيف تجد المعنى: أحضَرَ أم كان من الغائبين. وهذا بظهر كل الظهور فيما إذا كان الذي دخلت عليه أم له ضد وقد حصل التردد بينهما، فإذا ذكر أحدهما استغنى به عن ذكر الآخر، لأن الضد يخطر بالقلب وهو عند شعوره بضده.
فإذا قلت: ما لي لا أرى زيدًا أم هو في الأموات كان المعنى الذي لا معنى للكلام سواه، أحي هو أم في الأموات؟ وكذلك قوله تعالى: { أم أنا خير من هذا الذي هو مهين } [326] معناه أهو خير مني أم أنا خير منه. وكذلك قوله تعالى: { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم }، [327] هو استفهام إنكار معادل لاستفهام مقدر في قوة الكلام، فإذا قلت: لم فعلت هذا أم حسبت أن لا أعاقبك؟ كان معناه أحسبت أن أعاقبك فأقدمت على العقوبة، أم حسبت أني لا أعاقبك فجهلتها.
وكذلك قوله: { أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم }، [328] أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير جهاد فتكونوا جاهلين أم لم تحسبوا ذلك فتكونوا مفرطين. وكذلك إذا قلت: أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهاد معناه أحسبت أن تناله بالبطالة والهوينا؟ فأنت جاهل، أم لم تحسب ذلك؟ فأنت مفرط.
وكذلك: { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات }، [329] أي أحسبوا هذا فهم مغترون أم لم يحسبوه فما لهم مقيمون على السيئات، وعلى هذا سائر ما يرد عليك من هذا الباب.
وتأمل كيف يذكر سبحانه القسم الذي يظنونه ويزعمونه فينكره عليهم وإنه مما لا ينبغي أن يكون ويترك ذكر القسم الآخر الذي لا يذهبون إليه. فتردد الكلام بين قسمين فيصرح بإنكار أحدهما وهو الذي سيق لإنكاره، ويكتفي منه بذكر الآخر. وهذه طريقة بديعة عجيبة في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرها، وهي من باب الاكتفاء عن غير الأهم بذكر الأهم لدلالته عليه. فأحدهما مذكور صريحًا والآخر ضمنًا. ولذلك أمثلة في القرآن يحذف منها الشيء للعلم بموضعه.
فمنها قوله تعالى: { وإذ قلنا }، [330] { وإذ نجيناكم }، [331] { وإذ فرقنا }، [332] وإذ فعلنا وهو كثير جدًا بواو العطف من غير ذكر عامل يعمل في إذ، لأن الكلام في سياق تعداد النعم وتكرار الأقاصيص فيشير بالواو العاطفة إليها كانها مذكورة في اللفظ لعلم المخاطب بالمراد. ولما خفي هذا على بعض ظاهرية النحاة قال: إن أو زائدة هنا، وليس كذلك.
ومن هذا الباب الواو المتضمنة معنى رب. فإنك تجدها في أول الكلام كثيرًا إشارة منهم إلى تعداد المذكور بعدها من فخر، أو مدح، أو غير ذلك. فهذه كلها معان مضمرة في النفس وهذه الحروف عاطفة عليها، وربما صرحوا بذلك المضمر كقول ابن مسعود: دع ما في نفسك وإن أفتوك عنه وأفتوك.
ومن هذا الباب حذف كثير من الجوابات في القرآن لدلالة الواو عليها لعلم المخاطب أن الواو عاطفة ولا يعطف بها إلا على شيء كقوله تعالى: { فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب }، [333] وكقوله تعالى: { حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها } [334] وهذا الباب واسع في اللغة.
فهذا ما في هذه المسألة، وكان قد وقع لي هذا بعينه أمام المقام بمكة وكان يجول في نفسي فأضرب عنه صفحًا، لأني لم أره في مباحث القوم، ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة. أحدهما حام حوله وما ورد ولا أعرف اسمه. والثاني أبو القاسم السهيلي رحمه الله فإنه كشفه وصرح به. وإذا لاحت الحقائق فكن أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار. والله الموفق للصواب.
فائدة بديعة: لا يجوز إضمار حرف العطف
لا يجوز إضمار حرف العطف خلافًا للفارسي ومن تبعه لأن الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم فلو أضمرت لاحتاج المخاطب إلى وحي يسفر له عما في نفس مكلمه. وحكم حروف العطف في هذا حكم حروف النفي والتوكيد والترجي والتمني وغيرهم اللهم إلا أن حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض المواطن لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر وهذا على قلته.
فإن قيل: فكيف تصنعون بقول الشاعر:
كيف أصبحت كيف أمسيت مما يثبت الود في فؤاد الكريم
أليس على إضمار حرف العطف وأصله كيف أصبحت وكيف أمسيت؟
قيل: ليس كذلك، وليس حرف العطف مرادًا هنا البتة. ولو كان مرادًا لانتقض الغرض الذي أراده الشاعر، لأنه لم يرد انحصار الود في هاتين الكلمتين من غير مواظبة عليهما. بل أراد أن تكرار هاتين الكلمتين دائمًا يثبت المودة، ولولا حذف الواو لانحصر إثبات الود في هاتين الكلمتين من غير مواظبة ولا استمرار عليها، ولم يرد الشاعر ذلك، وإنما أراد أن يجعل أول الكلام ترجمة على سائر الباب يريد الاستمرار على هذا الكلام والمواظبة عليه. كما تقول: قرأت ألفًا بابا جمعت هذه الحروف ترجمة لسائر الباب وعنوانًا للغرض المقصود. ولو قلت قرأت ألفًا وباء لأشعرت بانقضاء المقروء حيث عطفت الباء على الألف دون ما بعدها، فكان مفهوم الخطاب أنك لم تقرأ غير هذين الحرفين.
وأحسن من هذا أن يقال: دخول الواو هنا يفسد المعنى، لأن المراد أن هذا اللفظ وحده يثبت الود وهذا وحده يثبته بحسب اللقاء فأيهما وجد مقتضيه وواظب عليه أثبت الود ولو أدخل الواو لكان لا يثبت الود إلا باللفظين معًا. ونظير هذا أن تقول: أطعم فلانًا شيئًا فيقول: ما أطعمه؟ فيقول: أطعمه تمرًا أقطا زبيبًا لحمًا، لم ترد جمع ذلك، بل أردت أطعمه واحدًا من هذه أيهما تسير. ومنه الحديث الصحيح المرفوع: «تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره»، ومنه قول عمر: صلى رجل في إزار ورداء في سراويل ورداء في تبان ورداء.. الحديث. يتعين ترك العطف في هذا كله لا المراد الجمع.
فإن قيل: فما تقولون: في قولهم أضرب زيدًا عمرًا خالدًا أليس على حذف الواو؟
قيل: ليس كذلك إذ لو كان على تقدير الواو لاختص الأمر بالمذكورين ولم يعدهم إلى سواهم، وإنما المراد الإشارة بهم إلى غيرهم. ومنه قولهم: بوبت الكتاب بابًا بابًا وقسمت المال درهمًا درهمًا وليس على إضمار حرف العطف ولو كان كذلك، لانحصر الأمر في درهمين وبابين.
وأما ما احتجوا به من قوله تعالى: { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه }، [335] والذي دعاهم إلى ذلك أن جواب إذا هو قوله تعالى: { تولوا وأعينهم تفيض من الدمع } والمعنى، إذا أتوك ولم يكن عندك ما تحملهم عليه تولوا يبكون فيكون الواو في قلت مقدرة، لأنها معطوفة على فعل الشرط وهو أتوك هذا تقرير احتجاجهم ولا حجة فيه لأنه جواب إذا في قوله قلت لا أجد. والمعنى إذا أتوك لتحملهم لم يكن عندك ما تحملهم عليه فعبر عن هذا بقوله قلت: لا أجد ما أحملكم عليه لنكتة بديعة وهي الإشارة إلى تصديقهم له، وأنهم اكتفوا من علمهم بعدم الإمكان بمجرد إخباره لهم بقوله: { لا أجد ما أحملكم عليه } بخلاف ما لو قيل: لم يجدوا عندك ما تحهلهم عليه فإنه يكون تبيين حزنهم خارجًا عن إخباره. وكذلك لو قيل: لم تجد ما تحملهم عليه لم يؤد هذا المعنى فتأمله فإنه بديع.
فإن قيل: فبأي شيء يرتبط قوله: { تولوا وأعينهم تفيض }، وهذا عطف على ما قبله فإنه ليس بمستأنف.
فالجواب أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما قبله ووقوعه منه موقع التفسير حتى كأنه هو وتأمل مثل هذا في قوله تعالى: { أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين }، [336] كيف لم يعطف فعل القول بأداة عطف لأنه كالتفسير لتعجبهم والبدل من قوله تعالى: { أكان للناس عجبًا }، فجرى مجرى قوله: { ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا }، [337] فلما كان مضاعفة العذاب بدلًا وتفسيرًا لأثامًا لم يحسن عطفه عليه.
وزعم بعض الناس أن من هذا الباب قول عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح: لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله ﷺ لها فقال: المعنى أعجبها حسنها وحب رسول الله ﷺ وليس الأمر كذلك، ولكن قوله: حب رسول الله ﷺ، بدل من قوله: هذه وهو من بدل الاشتمال والمعنى: لا يغرنك حب رسول الله ﷺ لهذه التي قد أعجبها حسنها. ولا عطف هناك، ولا حذف، وهذا واضح بحمد الله.
فائدة بديعة: كل لفظ دال على الإحاطة بالشيء وكأنه من لفظ الإكليل
"كل" لفظ دال على الإحاطة بالشيء وكأنه من لفظ الإكليل والكلالة والكلة مما هو في معنى الإحاطة بالشيء وسر اسم واحد في لفظه جمع في معناه ولو لم يكن معناه معنى الجمع لما جاز أن يؤكد به الجمع، لأن التوكيد تكرار للمؤكد فلا يكون إلا مثله إن كان جمعًا فجمع، وإن كان واحدًا فواحد.
وحقه أن يكون مضافًا إلى اسم منكر شائع في الجنس من حيث اقتضى الإحاطة، فإن أضفته إلى معرفة كقولك كل إخوتك ذاهب قبح إلا في الابتداء، لأنه إذا كان مبتدأ في هذا الموطن كان خبره بلفظ الإفراد تنبيهًا على أن أصله أن يضاف إلى نكرة، لأن النكرة شائعة في الجنس، وهو أيضا يطلب جنسًا يحيط به فأما أن تقول: كل واحد من إخوتك ذاهب فيدل إفراد الخبر على المعنى الذي هو الأصل وهو إضافته إلى اسم مفرد نكرة.
فإن لم تجعله مبتدأ وأضفته إلى جملة معرفة كقولك: رأيت كل إخوتك وضربت كل القوم لم يكن في الحسن بمنزلة ما قبله لأنك لم تضفه إلى جنس ولا معك في الكلام خبر مفرد يدل على معنى إضافته إلى جنس كما كان في قولهم كلهم ذاهب وكل القوم عاقل فإن أضفته إلى جنس معرف باللام نحو قوله تعالى: { فأخرجنا به من كل الثمرات } [338] حسن ذلك، لأن اللام للجنس لا للعهد، ولو كانت للعهد لقبح. كما إذا قلت: خذ من كل الثمرات التي عندك، لأنها إذا كانت جملة معرفة معهودة وأردت معنى الإحاطة فيها فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصله فتؤكد المعرفة بكل فتقول: خذ من الثمرات التي عندك كلها، لأنك لم تضطر عن إخراجها عن التوكيد كما اضطررت في النكرة حين قلت: لقيت كل رجل، لأن النكرة لا تؤكد، وهي أيضا شائعة في الجنس كما تقدم.
فإن قيل: فإذا استوى الأمران كقولك كل من كل الثمرات وكل من الثمرات كلها. فلم اختص أحد النظمين بالقرآن في موضع دون موضع؟
قيل: هذا لا يلزم، لأن كل واحد منه فصيح، ولكن لا بد من فائدة في الاختصاص.
أما قوله تعالى: { فأخرجنا به من كل الثمرات }، [339] فمن ههنا لبيان الجنس لاللتبعيض والمجرور في موضع المفعول لا في موضع الظرف، وإنما تريد الثمرات نفسها إلا أنه أخرج منها شيئًا وأدخل من لبيان الجنس كله. ولو قال: أخرجنا به من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أن المجرور في موضع ظرف وأن مفعول أخرجنا فيما بعد، ولم يتوهم ذلك مع تقديم كل لعلم المخاطبين. أن كلًا إذا تقدمت تقتضي الإحاطة بالجنس. وإذا تأخرت وكانت توكيدًا اقتضت الإحاطة بالمؤكد خاصة جنسًا شائعًا كان أو معهودًا معروفًا.
وأما قوله تعالى: { كلي من كل الثمرات } [340] ولم يقل من الثمرات كلها ففيها الحكمة التي في الآية قبلها ومزيد فائدة. وهو أنه تقدمها في النظم قوله تعالى: { ومن ثمرات النخيل والأعناب }، [341] فلو قال بعدها: كلي من الثمرات كلها لذهب الوهم إلى أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذا. أعني ثمرات النخيل والأغاب، لأن اللام إنما تنصرف إلى المعهود. فكان الابتداء بكل أحصن للمعنى، وأجمع للجنس، وأرفع للبس، وأبدع في النظم فتأمله.
وإذا قطعت عن الإضافة وأخبر عنها فحقها أن تكون ابتداء ويكون خبرها جمعًا، ولا بد من مذكورين قبلها، لأنها إن لم تذكر قبلها جملة ولا أضيفت إلى جملة بطل معنى الإحاطة فيها ولم يعقل لها معنى، وإنما وجب أن يكون خبرها جمعًا لأنها اسم في معنى الجمع فتقول: كل ذاهبون إذا تقدم ذكر قوم، لأنك معتمد في المعنى عليهم. وإن كنت مخبرًا عن كل فصارت بمنزلة قولك الرهط ذاهبون والنفر منطلقون، لأن الرهط والنفر اسمان مفردان، ولكنهما في معنى الجمع. والشاهد لما بيناه قوله سبحانه: { كل في فلك يسبحون }، [342] { كل إلينا راجعون }، [343] { وكل كانوا ظالمين }، [344] وإن كانت مضافة إلى ما بعدها في اللفظ لم تجد خبرها إلا مفردًا للحكمة التي قدمتها قبل. وهي أن الأصل إضافتها إلى النكرة المفردة. فتقول: كل إخوتك ذاهب أي كل واحد منهم ذاهب ولم يلزم ذلك حين قطعتها عن الإضافة فقلت: كل ذاهبون، لأن اعتمادها إذا أفردت على المذكورين قبلها وعلى ما في معناها من معنى الجمع واعتمادها إذا أضفتها على الاسم المفرد إما لفظًا وإما تقديرًا كقوله ﷺ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، ولم يقل راعون ومسؤولون. ومنه: «كلكم سيروي». ومنه قول عمر أوكلكم يجد ثوبين ولم يقل تجدون. ومثله قوله تعالى: { كل من عليها فان }، [345] وقال تعالى: { كل له قانتون }، [346] فجمع وقال تعالى: { إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا }. [347]
فإن قيل: فقد ورد في القرآن: { كل يعمل على شاكلته }، [348] { كل كذب الرسل } [349] وهذا يناقض ما أصلتم.
قيل: إن في هاتين الآيتين قرينة تقتضي تخصيص المعنى بهذا اللفظ دون غيره، أما قوله تعالى: { قل كل يعمل على شاكلته } فلأن قبلها ذكر فريقين مختلفين، ذكر مؤمنين وظالمين. فلو قال: يعملون وجميعهم في الإخبار عنهم لبطل معنى الاختلاف فكان لفظة الأفراد أدل على المعنى المراد. كأنه يقول: كل فهو يعمل على شاكلته.
وأما قوله: { كل كذب الرسل }، فلأنه ذكر قرونًا وأمما وختم ذكرهم بذكر قوم تبع. فلو قال: كل كذبوا. وكل إذا أفردت، إنما تعتمد على أقرب المذكورين إليها فكان يذهب الوهم إلى أن الإخبار عن قوم تبع خاصة بأنهم كذبوا الرسل فلما قال: { كل كذب } علم أنه يريد كل فريق منهم، لأن إفراد الخبر عن كل حيث وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم. ومثل: { كل آمن بالله }، [350].
وأما قولنا في كل إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون مبتدأة، فإنما يريد أنها مبتدأة يخبر عنها، أو مبتدأة باللفظ منصوبة بفعل بعدها لا قبلها، أو مجرورة يتعلق خافضها بما بعد نحو: { وكلًا وعد الله الحسنى }، [351] وقول الشاعر: بكل تداوينا..
ويقبح تقديم الفعل العامل فيها إذا كانت مفردة كقولك: ضربت كلا ومررت بكل وإن لم يقبح كلا ضربت وبكل مررت من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها في اللفظ، لأن العامل اللفظي له صدر الكلام. وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ لم يكن لها شيء تعتمد عليه قبلها، ولا بعدها فقبح ذلك.
وأما إذا كان العامل معنويًا نحو كل ذاهبون، فليس بقاطع لها عما قبلها من المذكورين، لأنه لا وجود له في اللفظ. فإذا قلت: ضربت زيدًا وعمرًا وخالدًا وشتمت كلًا وضربت كلًا. لم يجز ولم يعد يخبر لما قدمناه.
إذا عرفت هذا فقولك كل إخوتك ضربت سواء رفعت، أو نصبت يقتضي وقوع الضرب بكل واحد منهم وإذا قلت: كل إخوتك ضربني يقتضي أيضا أن كل واحد واحد منهم ضربك. فلو قلت: كل إخوتي ضربوني وكل القوم جاؤوني احتمل ذلك، واحتمل أن يكونوا اجتمعوا في الضرب والمجيء، لأنك أخبرت عن جملتهم يخبر واقع عن الجملة بخلاف قولك، كل إخوانك جاءني فإنما هو إخبار عن كل واحد منهم وإن الإخبار بالمجيء عم جميعهم. فتأمل على هذا قوله تعالى: { قل كل يعمل على شاكلته } كيف أفرد الخبر، لأنه لم يرد اجتماعهم فيه. وقال تعالى: { كل إلينا راجعون }، [352] فجمع لما أريد الاجتماع في المجيء وهذا أحسن مما تقدم من الفرق فتأمله.
ولا يرد على هذا قوله تعالى: { وله من في السموات والأرض كل له قانتون } [353] بل هو تحقيق له وشاهد، لأن القنوت هنا هو العبودية العامة التي تشترك فيها أهل السموات والأرض لا يختص بها بعضهم عن بعض، ولا يختص بزمان دون زمان وهي عبودية القهر. فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحبة، وهذا بخلاف قوله تعالى: { كل من عليها فان }، [354] فإنه أفرد لما لم يهجتمعوا في الفناء. ونظيره قوله ﷺ: «وكلكم مسؤول عن رعيته»، فإن الله يسأل كل راع راع بمفرده.
ومما جاء مجموعًا لاجتماع الخبر قوله تعالى: { كل في فلك يسبحون }، [355] وما أفرد لعدم اجتماع الخبر قوله تعالى: { كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد * وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب * إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب }، [356] فأفرد ما لم يجتمعوا في التكذيب.
ونظيره في سورة ق: { كل كذب الرسل فحق وعيد }، [357] وتأمل كيف كشف قناع هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله تعالى: { وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا }. [358] كيف أفرد آتيه لما كان المقصود الإشارة إلى أنهم وإن أتوه جميعًا فكل واحد منهم منفرد عن كل فريق من صاحب أو قريب أو رفيق. بل هو وحده منفرد فكأنه، إنما أتاه وحده وإن أتاه مع غيره لانقطاع تبعيته للغير وانفراده بشأن نفسه، فهذا عندي أحسن من الفرق بالإضافة وقطعها. والفرق بذلك فرقه السهيلي رحمه الله تعالى. فتأمل الفرقين واستقر الأمثلة والشواهد.
فصل: كل ذلك لم يكن ولم يكن كل ذلك
وأما مسألة كل ذلك لم يكن ولم يكن كل ذلك، ولم أصنع كله وكله لم أصنعه فقد أطالوا فيها القول وفرقوا بين دلالتي الجملة الفعلية والاسمية. وقالوا: إذا قلت كل ذلك لم يكن وكله لم أصنعه فهو نفي للكل بنفي كل فرد من أفراده فينا قض الإيجاب الجزئي. وإذا قلت لم أصنع الكل ولم يكن كل ذلك فهو نفي للكلية دون التعرض لنفي الأفراد فلا يناقضه الإيجاب الجزئي ولا بد من تقرير مقدمة تبنى عليها هذه المسألة وأمثالها وهي أن الخبر لا يجوز أن يكون أخص من المبتدإ بل يجوز أن يكون أعم منه أو مساويًا له إذ لو كان أخص منه لكان ثابتًا لبعض افراده ولم يكن خبرًا عن جملته فإن الأخص، إنما يثبت لبعض أفراد الأعم.
وأما إذا كان أعم منه فإنه لا يمتنع، لأنه يكون ثابتًا لجملة افراد المبتدأ وغيرها، وهذا غير ممتنع، فإذا عرف ذلك، فإذا كان المبتدأ لفظة كل الدال على الإحاطة والشمول. وجب أن يكون الخبر المثبت حاصلًا لكل فرد من أفراد كل والخبر المنفي مثبتًا لكل فرد من أفراده سواء أضفت كلا، أو قطعتها عن الإضافة، فإن الإضافة فيها منوية معنى وإن سقطت لفظًا، فإذا قلت: كلهم ذهب، وكلكم سيروي، أو كل ذهب وكل سيروي عم الحكم افراد المبتدأ فإذا كان الحكم سلبًا نحو كلهم لم يأت وكل لم يقم فكذلك، ولهذا يصح مقابلته بالإيجاب الجزئي نحو قوله ﷺ: وقد سأل أقصرت الصلاة أم نسيت. فقال: كل ذلك لم يكن فقال: ذو اليدين بلى قد كان بعض ذلك.
ومن هذا ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى:
قد أصبحت أم الخيار تدعي ** علي ذنبًا كله لم أصنع
أنشده برفع كل، واستقبحه لحذف الضمير العائد من الخبر، وغير سيبويه يمنعه مطلقًا وينشد البيت منصوبًا فيقول: كلَّه لم أصنع. والصواب إنشاده بالرفع محافظة على النفي العام الذي أراده الشاعر وتمدح به عند أم الخيار، ولو كان منصوبًا لم يحصل له مقصوده من التمدح فإنه لم يفعل ذلك الذنب، ولا شيئًا منه، بل يكون المعنى لم أفعل كل الذنب بل بعضه، وهذا ينافي غرضه. ويشهد لصحة قول سيبويه قراءة ابن عامر في سورة الحديد: { أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلٌّ وعد الله الحسنى }، [359] فهذا يدل على أن حذف العائد جائز، وأنه غير قبيح.
ومن هذا على أحد القولين: { قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون }، [360] أجاز الزجاج أن تكون الجملة ابتدائية وقد حذف العائد من يستعجل وتقديره يستعجله منه المجرمون، كما يحذف من الصلة والصفة والحال. إذا دل عليه دليل ودعوى قبح حذفه من الخبر مما لا دليل عليها. وللكلام في تقرير هذه المسألة موضع آخر.
والمقصود أن إنشاد البيت بالنصب محافظة على عدم الحذف اخلال شديد المعنى. وأما إذا تقدم النفي. وقلت: لم أصنع كله ولم أضرب كلهم، كأنك لم تتعرض للنفي عن كل فرد فرد. وإنما نفيت فعل الجميع، ولم تنف فعل البعض ألا ترى أن قولك لم أصنع الكل مناقض لقولك صنعت الكل. والإيجاب الكلي يناقضه السلب الجزئي. ألا ترى إلى قولهم لم أرد كل هذا فيما إذا فعل ما يريده وغيره، فتقول: لم أرد كل هذا، ولا يصح أن تقول: كل هذا لم أرده، فتأمله فهذا تقرير هذه المسألة وقد أغناك عن ذلك التطويل المتعب القليل الفائدة.
فصل: إضافة كل للمخاطبين
واعلم أن كلًا من ألفاظ الغيبة فإذا أضفته إلى المخاطبين جاز لك أن تعيد المضمر عليه بلفظ الغيبة مراعاة للفظه وأن تعيده بلفظ الخطاب مراعاة لمعناه، فتقول: كلكم فعلتم، وكلكم فعلوا. فإن قلت: أنتم كلكم فعلتم وأنتم كلكم بينكم درهم، فإن جعلت أنتم مبتدأ وكلكم تأكيد. قلت: أنتم كلكم فعلتم وبينكم درهم لتطابق المبتدأ، وإن جعلت كلكم مبتدأ ثانيًا جاز لك وجهان. أحدهما: أن تقول فعلوا وببنهم درهم مراعاة للفظ كل. وإن تقول فعلتم وبينكم درهم عملًا على المعنى، لأن كلًا في المعنى للمخاطبين.
فائدة: كلا وكلتا بين الكوفيين والبصريين
اختلف الكوفيون والبصريون في كلا وكلتا فذهب البصريون إلى أنها اسم مفرد دال على الاثنين. فيجوز عود الضمير إليه باعتبار لفظه وهو الأكثر، ويجوز عوده باعتبار معناه وهو الأقل وألفها لام الفعل ليست ألف تثنية عندهم.
ولهم حجج؛ منها أنها في الأحوال الثلاثة مع الظاهر على صورة واحدة، والمثنى ليس كذلك، وأما انقلابها ياء مع الضمير فلا يدل على أنها ألف تثنية، كألف على وإلى ولدي هذا قول الخليل وسيبويه، واحتجوا أيضا بقولهم كلاهما ذاهب دون ذاهبان. وسيبويه لم يحتج بهذه الجملة لما تقدم من إنك إذا أضفت لفظ كل أفردت خبره مع كونه دالًا على الجمع حملًا على المعنى، لأن قولك: كلكم راع بمنزلة كل واحد منكم راع. فكذا قولك: كلا كما قائم أي كل واحد منكما قائم.
فإن قيل: بل أفرد الخبر عن كل وكلا، لأنهما اسمان مفردان.
قيل: هذا يبطل بتوكيد الجمع والتثنية بهما، وكما لا ينعت الجمع والمثنى بالواحد، فكذلك لا يؤكد به بطريق الأولى، لأن التوكيد تكرار للمؤكد بعينه بخلاف النعت فإنه عينه بوجه.
والمعول عليه لمن نصر مذهب سيبويه على الحجة الأولى على ما فيها وعلى معارضتها بتوكيد الاثنين. وكلا والمثنى لا يؤكد بالمفرد كما قررناه.
فإن قيل: الجواب عن هذا أن كلا اسم للمثنى فحسن التوكيد به، وحصلت المطابقة باعتبار مدلوله وهو المقصود من الكلام، فلا يضر إفراد اللفظ.
قيل: هذا يمكن في الجمع أن يكون لفظه واحدًا ومعناه جمعًا نحو كل وأسماء الجموع كرهط وقوم، لأن الجموع قد اختلفت صورها أشد اختلاف فمذكر ومؤنث مسلم ومكسر على اختلاف ضروبه، وما لفظه على لفظ واحده كما تقدم بيانه، فليس ببدع أن يكون صورة اللفظ مفردًا ومعناه جمعًا. وأما التثنية فلم تختلف قط. بل لزمت طريقة واحدة أي وقعت فبعيد جدًا. بل ممتنع أن يكون منها اسم مفرد معناه مثنى، وليس معكم إلا القياس على الجمع. وقد وضح الفرق بينهما، فتعين أن تكون كلا لفظًا مثنى ينقلب ألفه ياء مع المضمر دون المظهر، لأنك إذا أضفته إلى ظاهر استغنيت عن قلب ألفه ياء بانقلابها في المضاف إليه لتنزله منزلة الجزئية لدلالة اللفظ على مدلول واحد، لأن كلًا هو نفس ما يضاف إليه، بخلاف قولك: ثوبا الرجلين وفرسا الزيدين. فلو قلت: مررت بكلى الرجلين، جمعت بين علامتي تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنهما لا ينفصلان أبدًا، ولا تنفك كلا هذه عن الإضافة بحال. ألا ترى كيف رفضوا ضربت رأسي الزيدين. وقالوا: رؤوسهما لما رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم واحد هذا مع أن الرؤوس تنفصل عن الإضافة كثيرًا. وكذلك القلوب من قوله: { صغت قلوبكما } [361] فإذا كانوا قد رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة عارضة فما ظنك بهذا الموضع الذي لا تفارقه الإضافة، ولا تنفك عنه. فهذا الذي حملهم على أن ألزموها الألف على كل حال وكان هذا أحسن من إلزام طيء وخثعم وبني الحرث وغيرهم المثنى للألف في كل حال نحو الزيدان والعمران. فإذا أضافوه إلى الضمير قلبوا ألفه في النصب والجر، لأن المضاف إليه ليس فيه علامة إعراب، ولا يثنى بالباء، ولكنه أبدًا بالألف. فقد زالت العلة التي رفضوها في الظاهر وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله كما ترى. وإن كان سيبويه المعظم المقدم في الصناعة، فمأخوذ من قوله ومتروك.
ومما يدل على صحة هذا القول أن كلًا يفهم من لفظه ما يفهم من لفظ كل، وهو موافق له في فاء الفعل وعينه. وأما اللام فمحذوفة كما حذفت في كثير من الأسماء. فمن ادعى أن لام الفعل واو وإنه من غير لفظ كل، فليس دلبل يعضده، ولا اشتقاق يشهد له.
فإن قيل: فلم رجع الضمير إليها بلفظ الافراد إذا كانت مثناة؟
قيل: لما تقدم من رجوع الضمير على كل، لذلك إيذانًا بأن الخبر عن كل واحد واحد. فكأنك قلت: كل واحد من الرجلين قام وفيه نكتة بديعة. وهي أن عود الضمير بلفظ الافراد أحسن، لأنه يتضمن صدور الفعل عن كل واحد منفردًا به ومشاركًا للآخر.
فإن قيل: فلم كسرت الكاف من كلا وهي من كل مضمومة؟
قيل: هذا لا يلزمهم، لأنهم لم يقولوا إنها لفظة كل بعينها ولهم أن يقولوا: كسرت تنبيهًا على معنى الاثنين كما يبتدأ لفظ الاثنين بالكسر، ولهذا كسروا العين من عشرين إشعارًا بتثنية عشر.
ومما يدل على صحة هذا القول أيضا أن كلتا بمنزلة قولك ثنتا، ولا خلاف أن ألف ثنتا ألف تثنية، فكذلك ألف كلتا. ومن ادعى أن الأصل فيها كلواهما فقد ادعى ما تستبعده العقول ولا يقوم عليه برهان.
ومما يدل أيضا على صحته أنك تقول في التوكيد مررت بإخوتك ثلاثتهم وأربعتهم فتؤكد بالعدد فاقتضى القياس أن تقول أيضا في التثنية كذلك مررت بأخويك اثنيهما. فاستغنوا عنه بكليهما لأنه في معناه. وإذا كان كذلك فهو مثنى مثله.
فإن قيل فإنك تقول كلا أخويك جاء، ولا تقول: اثنا أخويك جاء فدل على أنه ليس في معناه.
قيل العدد الذي يؤكد به، إنما يكون تأكيدًا مؤخرًا تابعًا لما قبله، فأما إذا قدم لم يجز ذلك لأنه في معنى الوصف. والوصف لا يقدم على الموصوف، فلا تقول ثلاثة أخوتك جاؤوني وهذا بخلاف كل وكلا وكلتا، لأن فيهما معنى الإحاطة فصارت كالحرف الداخل لمعنى فيما بعذه فحسن تقديمهما في حال الإخبار عنها، وتأخيرهما في حال التوكيد فهذا في هذا المذهب كما ترى.
فائدة: تأكيد المفرد بأجمع
لا يؤكد بأجمع المفرد مما يعقل ولا ما حقيقته لا تتبعض. وهذا إنما يؤكد به ما يتبعض كجماعة من يعقل فجرى مجرى كل.
فإن قيل: فقد تقول: رأيت زيدًا أجمع إذا رأيته بارزًا من طاقة ونحوه.
قيل: ليس هذا توكيدًا في الحقيقة لزيد، لأنك لا تريد حقيقته وذاته، وإنما تريد به ما تدرك العين منه.
وأجمع هذه اسم معرفة بالإضافة، وإن لم يكن مضافًا في اللفظ، لأن معنى قبضت المال أجمع أي كله، فلما كان مضافًا في المعنى تعرف وأكد به المعرفة، وإنما استغنوا عن التصريح بلفظ المضاف إليه معه ولم يستغن عن لفظ المضاف مع كل إذا قلت: قبضت المال كله لأن كلًا تكون توكيد وغير توكيد، وتتقدم في أول الكلام. نحو كلكم ذاهب فصار بمنزلة نفسه وعينه، لأن كل واحد منهما يكون توكيدًا وغير توكيد. فإذا أكدته لم يكن بد من إضافته إلى ضمير المؤكد حتى يعلم أنه توكيد. وليس كذلك أجمع لأنه لا يجيء إلا تابعًا لما قبله. فاكتفى بالاسم الظاهر المؤكد واستغنى به عن التصريح بضميره، كما فعل بسحر حين أردته ليوم بعينه فإنه عرف بمعنى الإضافة واستغني عن التصريح بالمضاف إليه اتكالًا عن ذكر اليوم قبله.
فإن قيل: ولم لم تقدم أجمع كما قدم كل؟
قيل الجواب: إن فيه معنى الصفة، لأنه مشتق من جمعت فلم يكن يقع تابعًا بخلاف كل.
ومن أحكامه أنه لا يثنى ولا يجمع على لفظه. أما امتناع تثنيته، فلأنه وضع لتأكيد جملة تتبعض فلو ثنيته لم يكن في قولك أجمعا توكيد لمعنى التثنية كما في كليهما، لأن التوكيد تكرار المعنى المذكور، إذا قلت درهمان أفدت أنهما اثنان فإذا قلت: كلاهما كأنك قلت: اثناهما ولا يستقيم ذلك في أجمعان لأنه بمنزلة من يقول: أجمع وأجمع كالزيدان بمنزلة زيد وزيد فلم يفدك أجمعان تكرار معنى التثنية، وإنما أفادك تثنية واحدة بخلاف كلاهما فإنه ليس بمنزلة قولك: كل وكل، وكذلك أثناهما المستغنى عنه بكليهما لا يقال فيها اثن واثن. فإنما هي تثنية لا تنحل ولا تنفرد فلم يصلح لتأكيد معنى التثنية غيرها. فلا ينبغي أن يؤكد معنى التثنية والجمع إلا بما لا واحد له من لفظه كيلا يكون بمنزلة الأسماء المفردة المعطوف بعضها على بعض بالواو وهذه علة امتناع الجمع فيه لأنك لو جمعته كان جمعًا لواحد من لفظه ولا يؤكد معنى الجمع إلا بجمع لا ينحل إلى الواحد.
فإن قيل: هذا ينتقض بأجمعين وأكتعين فإن واحده أجمع وأكتع؟
قيل: سيأتي جوابه وإن شئت قلت إن أجمع في معنى كل وكل لا يثنى ولا يجمع إنما يثنى ويجمع الضمير الذي يضاف إليه كل.
وأما قولهم في تأنيثه جمعاء فلأنه أقرب إلى باب أحمر، وحمراء من باب أفضل وفضلى. فلذلك لم يقولوا: في تأنيثه جمعى ككبرى. ودليل ذلك أنه ل يدخله الألف واللام، ولا يضاف صريحًا فكان أقرب إلى باب أفعل وفعلي. وإن خالفه في غير هذا.
وأما أجمعون أكتعون فليس بجمع لأجمع وأكتع ولا واحد له من لفظه، وإنما هو لفظ وضع لتأكيد الجمع بوزن الاسمين بمنزلة اثينون تصغير الاثنان فإنه جمع مسلم، ولا واحد له من لفظه، والدليل على ذلك أنه لو كان واحد أجمعين أجمع لما قالوا في المؤنث: جمعاء، لأن فعل بفتح العين لا يكون واحده فعلًا. وجمعاء التي هي مؤنث أجمع، لو جمعت لقيل: جمعاوات، أو جمع بوزن حمر. وأما فعل بوزن كبر فجمع لفعلى، وإنما جاء أجمعون على وزن أكرمون وأرذلون، لأن فيه طرفًا من معنى التفضيل كما في الأكرمين والأرذلين، وذلك أن الجموع تختلف مقاديرها، فإذا كثر العدد احتيج إلى كثرة التوكيد حرصًا على التحقيق ورفعًا للمجاز. فإذا قلت: جاء القوم كلهم وكان العدد كثيرًا توهم إنه قد شذ منهم البعض فاحتيج إلى توكيد أبلغ من الأول. فقالوا: أجمعون، أكتعون فمن حيث كان أبلغ من التوكيد الذي قبله دخله معنى التفضيل، ومن حيث دخله معنى التفضيل جمع جمع السلامة كما يجمع أفعل الذي فيه ذلك المعنى جمع السلامة كأفضلون ويجمع مؤنثه على فعل كما يجمع مؤنث ما فيه من التفضيل.
وأما أجمع الذي هو توكيد الاسم الواحد فليس فيه من معنى التفضيل شيء وكان كباب أحمر، ولذلك استغنى أن يقال: كلاهما أجمعان كما يقال كلهم أجمعون، لأن التثنية أدنى من أن يحتاج إلى توكيدها إلى هذا المعنى. فثبت أن أجمعون لا واحد له من لفظه لأنه توكيد لجمع من يعقل، وأنت لا تقول فيمن يعقل جاءني زيد أجمع. فكيف يكون جاءني الزيدون أجمعون جمعًا له وهو غير مستعمل في الإفراد.
وسر هذا ما تقدم وهو أنهم لا يؤكدون مع الجمع والتثنية إلا بلفظ لا واحد له ليكون توكيدًا على الحقيقة، لأن كل جمع ينحل لفظه إلى الواحد فهو عارض في معنى الجمع فكيف يؤكد به معنى الجمع والتوكيد تحقيق وتثبيت ورفع للبس والإبهام فوجب أن يكون مما يثبت لفظًا ومعنى.
وأما حذف التنوين من جمع فكحذفه من سحر، لأنه مضاف في المعنى.
فإن قيل: ونون الجمع محذوفة في الإضافة أيضا فهلا حذفت من أجمعين، لأنه مضاف في المعنى.
قيل: الإضافة المعنوية لا تقوى على حذف النون المتحركة التي هي كالعرض من الحركة والتنوين. ألا ترى أن نون الجمع تثبت مع الألف واللام وفي الوقف والتنوين بخلاف ذلك. فقويت الإضافة المعنوية على حذفه، ولم تقو على حذف النون إلا الإضافة اللفظية.
فإن قيل: ولم كانت الإضافة اللفظية أقوى من المعنوية، والعامل اللفظي أقوى من المعنوي.
قيل: اللفظي لا يكون إلا متضمنًا لمعناه، فإذا اجتمعا معًا كان أقوى من المعخى المفرد عن اللفظ فوجب أن تكون أضعف. وهذا ظاهر لمن عدل وأنصف.
هامش
[التحريم: 4]
بدائع الفوائد
المجلد الأول | المجلد الثاني | المجلد الثالث | المجلد الرابع
==============
[البقرة: 185]
[البروج: 9]
[الطلاق: 1]
[المجادلة: 2]
[المجادلة: 2]
[المجادلة: 3]
[المجادلة: 2]
[المجادلة: 1]
[يوسف: 4]
[الواقعة: 74]
[الأعلى: 1]
[الحديد؛ الحشر؛ الصف: 1]
[النحل: 49]
[الأعراف: 206]
[طه: 5]
[الرحمن: 2]
[الملك: 20]
[الأحزاب: 43]
[التوبة: 117]
[البقرة: 157]
[البلد: 14]
[البقرة: 177، التوبة: 18]
[البقرة: 6]
[الأعراف: 193]
[القيامة: 1]
[الطور: 23]
[البقرة: 187]
في النتائج: ابنات.
[النحل: 1]
[ق: 2]
[المائدة: 116]
[يوسف: 26 - 27]
[البقرة: 23]
[البقرة: 24]
[الشورى: 48]
[الإسراء: 67]
[فصلت: 51]
[الإسراء: 83]
[فصلت: 51]
[النساء: 176]
[الأعراف: 160]
[الأنعام: 118]
[الأنعام: 118]
[المؤمنون: 16]
[الزخرف: 81]
[الأنبياء: 22]
[الإسراء: 42]
[الأنبياء: 34]
[آل عمران: 144]
[الأعراف: 160]
[الأنعام: 118]
[آل عمران: 118]
[لقمان: 27]
مفقود
[الإسراء: 100]
[النساء: 64]
[النساء: 66]
[لقمان: 27]
[الأنبياء: 22]
[لقمان: 27]
[البقرة: 38]
[هود: 34]
[الأحزاب: 50]
[النحل: 78]
[الزمر: 6]
الصحيحة 1076
[المجادلة: 7]
[البقرة: 222]
[الجاثية: 7]
[المطففين: 12]
[الحج: 27]
[المائدة: 6]
[الصافات: 158]
[الرحمن: 56]
[الرحمن: 39]
[الجن: 5]
[يونس: 61]
[يونس: 61]
[الرحمن: 68]
[البقرة: 98]
[آل عمران: 43]
[الحج: 26]
[آل عمران: 75]
[الحجر: 26]
[الرحمن: 56]
[الجن: 1]
[الجن: 5]
[البقرة: 222]
[الجاثية: 7]
[المزمل: 20، المجادلة: 13]
[الإسراء: 36]
[طه: 46]
[الإسراء: 36]
[غافر: 56]
[النساء: 134]
[النساء: 69]
[البقرة: 209]
[النساء: 134]
[طه: 46]
[يونس: 61]
[سبأ: 3]
[الزمر: 68]
[سبأ: 37]
[الأنفال: 28]
[المنافقون: 9]
[التوبة: 24]
[آل عمران: 14]
[النحل: 6]
[التوبة: 111]
[الصف: 11]
[التوبة: 25]
[التوبة: 111]
[سبأ: 1]
[سبأ: 2]
[غافر: 7]
[النساء: 12]
[غافر: 7]
[آل عمران: 43]
[الحج: 77]
[الحج: 126]
[الأنعام: 27، 30]
[القصص: 63]
[غافر: 49]
[القصص: 15]
[النساء: 57، 122]
[النساء: 56]
[هود: 77]
[يوسف: 96]
[النمل: 8]
[الرحمن: 7 - 8]
التصويب من المصادر.
[الجمعة: 7]
[الجمعة: 6]
[البقرة: 95]
[البقرة: 94]
[الأعراف: 143]
[الزخرف: 77]
[الأعراف: 143]
[الزخرف: 77]
[البقرة: 95]
الأصل: لن، والتصويب من نتائج الفكر.
[الزخرف: 39]
[الزخرف: 39]
[البقرة: 165]
[الأنفال: 33]
[الأنفال: 33]
[هود: 117]
[القصص: 59]
[القصص: 8]
[البلد: 11]
[القيامة: 1]
[البقرة: 233]
[البقرة: 238]
[الفتح: 27]
[إبراهيم: 7]
[الإسراء: 86]
[الإسراء: 88]
[فاطر: 41]
من النتائح؛ فالأصل: سماوات.
[الطلاق: 12]
[الملك: 16]
[الملك: 17]
[يونس: 61]
[سبأ: 3]
[الأنعام: 3]
الطبري
[الأنعام: 3]
تفسير القرطبي ومجموع الفتاوى.
[الذاريات: 23]
[التغابن: 1، الجمعة: 1]
[الأنبياء: 19]
[الإسراء: 44]
[الذاريات: 22]
[النمل: 65]
[يونس: 31]
[سبأ: 24]
[يونس: 41]
[الروم: 48]
[سبأ: 24]
[الذاريات: 41]
[يونس: 22]
[الأنعام: 1]
[الأنعام: 153]
[النحل: 48]
[الحجر: 41]
[النحل: 9]
مفقود
[البقرة: 257]
[النحل: 48]
[الواقعة: 41]
[ق: 17]
[الأعراف: 17]
[المائدة: 6]
[المعارج: 40]
[الرحمن: 13]
[المزمل: 9]
[المعارج: 41]
[الصافات: 5]
[هود: 67]
[هود: 66]
[الأعراف: 78]
[الشعراء: 189]
[هود: 94]
[النحل: 36]
[الأعراف: 30]
[النحل: 36]
عجزه: (هم القوم كل القوم يا أم خالد)
[ص: 75]
[الشمس: 5]
[ص: 75]
[الشمس: 5]
الأصل: يستحقه، والمثبت من النتائج.
[التوبة: 67]
[البقرة: 194]
[يونس: 31]
[يونس: 31]
[النمل: 63]
[النمل: 62]
[النمل: 64]
[النساء: 3]
[التحريم: 7]
[الجمعة: 6]
[مريم: 29]
[الكهف: 16]
[الزمر: 3]
أبو داود والترمذي.
[الزخرف: 26]
[الكهف: 16]
[البقرة: 61]
[التوبة: 77]
[آل عمران: 79]
[الأنعام: 93]
[النور: 41]
[آل عمران: 163]
[الصافات: 96]
[الصافات: 95]
[الحجر: 2]
[فاطر: 28]
[التوبة: 117]
[البقرة: 151]
[البقرة: 198]
[القصص: 77]
[الصافات: 96]
[الصافات: 95]
[النحل: 17]
[النحل: 20]
[لقمان: 11]
[النحل: 20]
[الصافات: 96]
[الأعراف: 194]
[يس: 22]
[الصافات: 96]
[التوبة: 77]
[غافر 75]
[الصافات 95]
[الصافات 96]
[الأعراف 194]
[يس 41 - 42]
[يس 43]
[النحل 81]
[النحل: 80]
[مريم: 69]
[الأنعام: 159]
[سبأ: 54]
[الأنعام: 93]
[الزمر: 3]
[الشعراء: 227]
[القارعة: 1، 2]
[الحاقة: 1، 2]
[البروج: 15]
[البقرة: 155]
[ق: 38]
[يونس: 62]
[الأنعام: 103]
[المجادلة: 1]
[المرسلات: 23]
[الأعراف: 180]
[الاعراف: 180]
[الكهف: 27]
[المائدة: 64]
[يوسف: 76]
[الصافات: 113]
الأصل: احتمل، والمثبت من النتائج.
[ق: 16]
[ق: 18]
[الأعلى: 2 - 4]
[الزخرف: 10 - 12]
[الحشر: 24]
[غافر: 3]
[النمل: 78]
[آل عمران: 4]
[الأعلى: 2، 3]
[الزخرف: 10، 11، 12]
[غافر: 3]
[غافر: 2]
[السجدة: 13]
[النحل: 102]
[فصلت: 42]
[فصلت: 12]
[غافر: 3]
[القيامة: 9]
[الأعراف: 4]
[يونس: 24]
[النحل: 98]
[الصافات: 47]
[البقرة: 74]
[البقرة: 19]
[البقرة: 6]
[النازعات: 27]
[الدخان: 37]
[الطور: 39]
[الزخرف: 16]
[الطور: 38]
[الصافات: 156]
[الطور: 35]
[الكهف: 9]
[الطور: 30]
[البقرة: 214، آل عمران: 142]
[الزخرف: 52]
[المؤمنون: 69]
[الطور: 39]
[الزخرف: 52]
[الروم: 35]
[الكهف: 9]
[النمل: 20]
[الزخرف: 52]
[البقرة: 214]
[آل عمران: 142]
[الجاثية: 21]
[البقرة: 34]
[البقرة: 49]
[البقرة: 50]
[يوسف: 15]
[الزمر: 73]
[التوبة: 92]
[يونس: 2]
[الفرقان: 69]
[الأعراف: 57]
[الأعراف: 57]
[النحل: 69]
[النحل: 67]
[الأنبياء: 33]
[الأنبياء: 93]
[الأنفال: 54]
[الرحمن: 26]
[البقرة: 116]
[مريم: 93]
[الإسراء: 84]
[ق: 14]
[البقرة: 285]
[النساء: 95]
[الأنبياء: 93]
[البقرة: 116]
[الرحمن: 26]
[الأنبباء: 33]
[ص: 12]
[ق: 14]
[مريم: 95]
[الحديد: 10]
[يونس: 50]
===========
[أغلق]
* اقرأ * * نزّل * استشهد * شارك في ويكي مصدر *
بدائع الفوائد/المجلد الثاني
< بدائع الفوائد اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
→ المجلد الأول بدائع الفوائد
المجلد الثاني
ابن القيم المجلد الثالث ←
محتويات
1 فائدة بديعة: دلالات العين
2 فائدة: إبدال النكرة من المعرفة
3 فائدة بديعة: تفسير اهدنا الصراط المستقيم
3.1 فصل: تعريف الصراط باللام
3.2 فصل: اشتقاق الصراط
3.3 فصل: إضافة الصراط إلى الموصول المبهم
3.4 فصل: قال أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم
3.5 فصل: تعدية الفعل بنفسه
3.6 فصل: تخصيص أهل السعادة بالهداية
3.7 فصل: قال غير المغضوب ولم يقل لا المغضوب عليهم
3.8 فصل: جريان غير صفة على المعرفة
3.9 فصل: إخراج صراط مخرج البدل
3.10 فصل: تفسير المغضوب عليهم والضالين
3.11 فصل: تقديم المغضوب عليهم على الضالين
3.12 فصل: اسم المفعول في المغضوب واسم الفاعل في الضال
3.13 فصل: زيادة لا بين المعطوف والمعطوف عليه
3.14 فصل: معنى الهداية
3.15 فصل: الإتيان بالضمير في قوله اهدنا
3.16 فصل: ما هو الصراط المستقيم
4 فائدة: بدل البعض وبدل المصدر
5 فائدة بديعة: ولله على الناس حج البيت
6 فائدة بديعة: يسألونك عن الشهر الحرام
7 فائدة: مجيء الحال من المضاف إليه
8 فائدة بديعة: إضمار الناصب
9 فائدة: مصدر الفعل اللازم
10 فائدة: فعل المطاوعة
11 فائدة: المتعدي إلى مفعولين
12 فائدة: اخترت يتعدى بحرف الجر
13 فائدة: تقديم المجرور وتأخير المفعول
14 فائدة بديعة: استغفر زيد ربه ذنبه
15 فائدة: ألبست زيدا الثوب
16 فائدة: حذف الباء من أمرتك الخير
17 فائدة بديعة: أصل وضع عرفت كذا
18 تنبيه
19 فصل: حروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيه ما بعدها
20 فصل: العامل في قولك لو أنك ذاهب فعلت
21 فائدة: الاقتصار على المفعول الأول من باب أعلمت
22 فائدة: الفعل الذي يطلب مفعولا ولا يصل إليه بنفسه
23 فصل: سمع الله لمن حمده
24 فصل: قولهم قرأت الكتاب واللوح
25 فصل: كفى بالله شهيدا
26 فائدة: تعدي الفعل إلى المصدر
27 فصل فيما يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكد
28 فصل: توكيد الفعل وتوكيد النكرة
29 فصل: فيما يحدد من المصادر بالهاء
30 فصل: تثنية المصادر وجمعها
31 فائدة: لفظ سحر وتقسيمه
32 فصل: ضحوة وعشية ومساء
33 فصل: غدوة وبكرة
34 فصل: عمل الفعل وشروطه
35 فصل: تعدي الفعل واشتقاقه
36 فصل: جلست خلفك وأمامك
37 فصل: تعدي الفعل إلى الحال بنفسه
38 فصل: إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم
39 فائدة: قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا
40 فصل: صاحب الحال
41 فصل: تقديم معمول أفعل التفضيل عليه
42 فصل: عمل العامل الواحد في حالين
43 فصل: التقديم والتأخير في الحالين
44 فصل: تصور الحال في غير المشتق
45 فصل: مدلول الإشارة بقولك هذا
46 فصل: هل النصب على أنه خبر كان
47 فصل: اتحاد المفضل والمفضل عليه
48 (مسألة سلام عليكم ورحمة الله)
48.1 فصل: إطلاق السلام على الله تعالى
48.2 فصل: هل السلام مصدر أو اسم مصدر
48.3 فصل: هل السلام عليكم إنشاء أم خبر
48.4 فصل: معنى السلام المطلوب عند التحية
48.5 فصل: الحكمة في السلام عند اللقاء
48.6 فصل: تعدية السلام بعلى
48.7 فصل: الابتداء بالنكرة في السلام
48.8 فصل: تقديم السلام في جانب المسلم
48.9 فصل: ابتداء السلام بالنكرة والجواب بالمعرفة
48.10 فصل: السلام في المكاتبة
48.11 فصل: نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة
48.12 فصل: نصب السلام ورفعه
48.13 فصل: تسليم الله أنبيائه ورسله
48.14 فصل: التسليم بلفظ النكرة أو المعرفة
48.15 فصل: التسليم على يحيى والمسيح
48.16 فصل: تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح
48.17 فصل: تسليم نبينا وتسليم موسى
48.18 فصل: قل الحمد لله وسلام على عباده
48.19 فصل: عليك السلام تحية الموتى
48.20 فصل: إذا سلم أهل الكتاب فقولوا وعليكم
48.21 فصل: اقتران الرحمة والبركة بالسلام
48.22 فصل: لماذا نهاية السلام عند قوله وبركاته
48.23 فصل: إضافة الرحمة لله وتجريد السلام عن الإضافة
48.24 فصل: الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة
48.25 فصل: الرحمة المضافة إلى الله
48.26 فصل: البركة المضافة لله
48.27 فصل: تأكيد السلام على النبي دون الصلاة عليه
48.28 فصل: تقديم السلام على النبي في الصلاة قبل الصلاة عليه
48.29 فصل: السلام بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة
48.30 فصل: الثناء على الله في التشهد
48.31 فصل: السلام في آخر الصلاة وتعريفه
49 (تفسير المعوذتين)
49.1 الفصل الأول: الاستعاذة وبيان معناها
49.2 الفصل الثاني: المستعاذ به هو الله
49.3 الفصل الثالث: الشرور المستعاذ منها
49.4 فصل: الشر المستعاذ منه نوعان
49.5 فصل: الشر ومصدره ومنتهاه
49.6 فصل: الشرور المستعاذ منها في المعوذتين
49.7 فصل: حديث لبيك وسعديك
49.8 فصل: من شر ما خلق
49.9 فصل: شر غاسق إذا وقب
49.10 فصل: سبب الاستعاذة من شر الليل
49.11 فصل: سر الاستعاذة برب الفلق
49.12 فصل: تفسير الفلق
49.13 فصل: شر النفاثات في العقد
49.14 فصل: تأثيرات السحر
49.15 فصل: شر الحاسد إذا حسد
49.16 فصل: العائن والحاسد
49.17 فصل: الحاسد من الجن والإنس
49.18 فصل: تقييد الحاسد بقوله إذا حسد
49.19 فصل: دفع شر الحاسد عن المحسود
49.20 فصل: تأثير نفوس الحاسدين وأعينهم والأرواح الشيطانية
49.21 (سورة الناس)
49.22 فصل: الاستعاذة من الشر
49.23 فصل: الوسواس
49.24 فصل: هل الوسواس وصف أو مصدر
49.25 فصل: الخناس وبيان اشتقاقه
49.26 فصل: الصفة الثالثة للوسواس
49.27 فصل: الصدور والقلوب
49.28 فصل: الجار والمجرور من الجنة والناس
50 قاعدة نافعة: اعتصام العبد من الشيطان
فائدة بديعة: دلالات العين
العين: يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان، وليست اللفظة على أصل موضوعها، لأن أصلها أن يكون مصدرًا وصفة لمن قامت به، ثم عبر عن حقيقة الشيء بالعين، كما عبر عن الوحش بالصيد، وإنما الصيد في أصل موضوعه مصدر من صاد يصيد ومن ههنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري سبحانه وتعالى، لأن نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم. وأما عين القبلة وعين الذهب وعين الميزان فراجعة إلى هذا المعنى. وأما العين الجارية فمشبهة بعين الإنسان لموافقتها لها في كثير من صفاتها. وأما عين الإنسان فمسماة بما أصله أن يكون صفة ومصدرًا، لأن العين في أصل الوضع مصدر كالدين والزين والبين والأين وما جاء على بنائه. ألا تراهم يقولون: رجل عيون وعاين، ويقولون: عنته أصبته بالعين وعاينته رأيته بالعين، وفرقوا بين المعنيين وكأن عاينته من الرؤية أولى من عنته، لأنه بمنزلة المفاعلة والمقابلة فقد تقابلتما وتعاينتما بخلاف عنته. فإنك تفرد إصابته العين من حيث لا يشعر.
ومما يدلك على أنها مصدر في الأصل قوله تعالى: { عين اليقين كما قال: { علم اليقين }، [1] و { حق اليقين }، [2] فالعلم والحق مصدران مضافان إلى اليقين، فكذلك العين. هكذا قال السهيلي رحمه الله تعالى. وفيه نظر، لأن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم نفس الشيء وذاته. فعين اليقين نفس اليقين، والعين التي هي عضو سميت عينًا، لأنها آلة ومحل لهذه الصفة التي هي العين. وهذا من باب قولهم امرأة ضيف وعدل تسمية للفاعل باسم المصدر والعين التي هي حقيقة الشيء ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدر كصيد.
قال السهيلي: إذا علمت هذا، فاعلم أن العين أضيفت إلى الباري تعالى كقوله: { ولتصنع على عيني }، [3] حقيقة لا مجازًا كما توهم أكثر الناس، لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك، وإنما المجاز في تسمية العضو بها وكل شيء يوهم الكفر والتجسيم فلا يضاف إلى الباري تعالى لا حقيقة ولا مجازًا. ألا ترى كيف كفر الرومية من النصارى حيث قالوا في عيسى إنه ولد، على المجاز لا على الحقيقة، فكفروا ولم يدروا. [4] ألا ترى كيف لم يضف سبحانه إلى نفسه ما هو في معنى عين الإنسان كالمقلة والحدقة حقيقة، ولا مجازًا نعم ولا لفظ الإبصار، لأنه لا يعطي معنى البصر والرؤية مجردًا، ولكنه يقتضي مع معنى البصر معنى التحديق والملاحظة ونحوهما.
قلت: كأنه رحمه الله غفل عن وصفه بالسميع البصير وغفل عن قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه»، [5] وأما إلزامه التحديق والملاحظة ونحوها فهو كإلزام المعتزلة نظيره في الرؤية فهو منقول من هناك حرفًا بحرف. وجوابه من وجوه.
أحدها: ما تعني بالتحديق والملاحظة. أمعنى البصر والإدراك أو قدرًا زائدًا عليهما غير ممتنع وصف الرب به. أو معنى زائدًا يمتنع وصفه به. فإن عنيت الأولين منعنا انتفاء اللازم، وإن عنيت الثالث منعنا الملازمة، ولا سبيل إلى إثباتها بحال.
الثاني: إن هذا التحديق والملاحظة، إنما تلزم الصفة من جهة إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة إلى الرب تعالى. وهذا كسائر خصائص المخلوقين التي تطرقت الجهمية بها إلى نفي صفات الرب وهذا من جهلهم وتلبيسهم. فإن خصانص صفات المخلوقين لا تلزم الصفة مضافة إلى الرب تعالى، كما لا يلزم خصائص وجودهم وذاتهم وهذا مقرر في موضعه. وهذا الأصل الذي فارق به أهل السنة طائفتي الضلال من المشبهة والمعطلة فعليك بمراعاته.
الثالث: قوله لا يعطي الأبصار معنى البصر والرؤية مجردًا كلام لا حاصل تحته ولا تحقيق فإنه قد تقرر عقلًا ونقلًا أن لله تعالى صفة البصر ثابتة كصفة السمع. فإن كان لفظ الإبصار لا يعطي الرؤية مجردة. فكذلك لفظ السمع وإن أعطى السمع إدراك المسموعات مجردًا. فكذلك البصر. فالتفريق بينهما تحكم محض.
ثم نعود إلى كلامه، قال: وكذلك لا يضاف إليه سبحانه وتعالى من آلات الإدراك الأذن ونحوها، لأنها في أصل الوضع عبارة عن الجارحة لا عن الصفة التي هي محلها فلم ينقل لفظها إلى الصفة أعني السمع مجازًا ولا حقيقة إلا أشياء وردت على جهة المثل بما يعرف بأدنى نظر أنها أمثال مضروبة نحو الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن مما عرفت العرب المراد به بأول وهلة.
قال: وأما اليد فهي عندي في أصل الوضع كالمصدر عبارة عن صفة لموصوف قال:
يديتُ على ابن حَصحاصِ بن عمرو ** بأسفل ذي الجذاة يدَ الكريم
فيديت فعل مأخوذ من مصدر لا محالة والمصدر صفة موصوف. ولذلك مدح سبحانه بالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله: { أولي الأيدي والأبصار }، [6] ولم يمدحهم بالجوارح، لأن المدح لا يتعلق إلا بالصفات لا بالجواهر.
قلت: المراد بالأيدي والأبصار هنا القوة في أمر الله والبصر بدينه فأراد أنهم من أهل القوى في أمره، والبصائر في دينه، فليست من يديت إليه يدًا فتأمله.
قال: وإذا ثبت هذا فصح قول أبي الحسن الأشعري إن اليد من قوله: خلق آدم بيده، وقوله تعالى: { لما خلقت بيدي }، [7] صفة ورد بها الشرع؛ ولم يقل إنها في معنى القدرة كما قال المتأخرون من أصحابه، ولا في معنى النعم، ولا قط بشيء من التأويلات تحرزًا منه عن مخالفة السلف. وقطع بأنها صفة تحرزًا عن مذهب المشبهة. فإن قيل: وكيف خوطبوا بما لا يفهمون ولا يستعملون، إذ اليد بمعنى الصفة لا يفهم معناه؟ قلنا: ليس الأمر كذلك. بل كان معناها مفهومًا عند القوم الذين نزل القرآن بلغتهم، ولذلك لم يستفت واحد من المؤمنين عن معناها، ولا خاف على نفسه توهم التشبيه، ولا احتاج إلى شرح وتنبيه. وكذلك الكفار لو كانت (اليد) عندهم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض واحتجوا بها على الرسول ﷺ ولقالوا له زعمت أن الله تعالى ليس كمثله شيء ثم تخبر أن له يدًا كأيدينا وعينًا كأعيننا؛ ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر، علم أن الأمر كان فيهم عندهم جليًا ولا خفيًا، وأنها صفة سميت الجارحة بها مجازًا، ثم استمر المجاز فيها حتى نسيت الحقيقة. ورب مجاز كثر واستعمل حتى نسي أصله وتركت حقيقته. والذي يلوح في معنى هذه الصفة أنها قريب من معنى القدرة، إلا أنها أخص منها معنى والقدرة أعم كالمحبة مع الإرادة والمشيئة. وكل شيء أحبه الله فقد أراده، وليس كل شيء أراده أحبه، وكذلك كل شيء حادث فهو واقع بالقدرة، وليس كل واقع بالقدرة واقعًا باليد. فاليد أخص من معنى القدرة، ولذلك كان فيها تشريف لآدم.
قلت: أما قوله: ليس كل شيء أراده فقد أحبه. فهذا صحيح. وهوأحد قولي الأشعري وقول المحققين من أصحابه، وهذا الذي يدل عليه الكتاب والسنة والمعقول كما هو مقرر في موضعه.
وأما قوله: كل شيء أحبه فقد أراده، فإن كان المراد أنه أراده بمعنى رضيه وأراده دينا فحق. وإن كان المراد أنه أراده كونًا فغير لازم. فإنه سبحانه يحب طاعة عباده كلهم ولم يردها ويحب التوبة من كل عاص ولم يرد ذلك كله تكوينًا إذ لو أراده لوقع فالمحبة والإرادة غير متلازمين فإنه يريد كون ما لا يحبه ويحب ويرضى بأشياء لا يريد تكوينها، ولو أرادها لوقعت وهذا مقرر في غير هذا الموضع.
قال: ومن فوائد هذه المسألة أن يسأل عن المعنى الذي لأجله قال تعالى: { ولتصنع على عيني }، [8] بحرف على، وقال تعالى: { تجري بأعيننا } [9] بالباء، { واصنع الفلك بأعيننا }، [10] وما الفرق؟ فالفرق أن الآية الأولى وردت في إظهار أمر كان خفيًا وإبداء ما كان مكتومًا، فإن الأطفال إذ ذاك كانوا يغذون ويصنعون سرًا. فلما أراد أن يصنع موسى ويغذى ويربى على حال أمن وظهور لا تحت خوف واستسرار، دخلت على في اللفظ تنبيهًا على المعنى، لأنها تعطي الاستعلاء والاستعلاء ظهور وإبداء فكأنه يقول سبحانه وتعالى: ولتصنع على أمن لا تحت خوف وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. وأما قوله تعالى: { تجري بأعيننا }، { واصنع الفلك بأعيننا } فإنه إنما يريد برعاية منا حفظ، ولا يريد إبداء شيء، ولا إظهاره بعد كتم، فلم يحتج في الكلام إلى معنى على بخلاف ما تقدم.
هذا كلامه، ولم يتعرض رحمه الله لوجه الإفراد هناك والجمع هنا، وهو من ألطف معاني الآية. والفرق بينهما يظهر من الاختصاص الذي خص به موسى في قوله تعالى: { واصطنعتك لنفسي }، [11] فاقتضى هذا الاختصاص الاختصاص الآخر في قوله: { ولتصنع على عيني } [12] فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص.
وأما قول تعالى: { تجري بأعيننًا }، { واصنع الفلك بأعيننا }، فليس فيه من الاختصاص ما في صنع موسى على عينه سبحانه واصطناعه إياه لنفسه، وما يسنده سبحانه إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع قد يريد به ملائكته كقوله تعالى: { فإذا قرأناه فاتبع قرآنه }، [13] وقوله: { نحن نقص عليك }، [14] ونظائره فتأمله.
قال: وأما النفس فعلى أصل موضوعها، إنما هي عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد، وقد استعمل أيضا من لفظها النفاسة والشيء النفيس، فصلحت للتعبيرعنه سبحانه وتعالى بخلاف ما تقدم من الألفاظ المجازية. وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس، ولا سيما المتكلمين القول فيها أنها في معنى النفس والحقيقة. ويقولون: ذات الباري هي نفسه، ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله ﷺ: «في قصة إبراهيم ثلاث كذبات كلهن في ذات الله»، وقول خبيب: * وذلك في ذات الإله.. *
قال: وليست هذه اللفظة إذا ستقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا. ولو كان كذلك لجاز أن يقال عند ذات الله واحذر ذات الله كما قال تعالى: { ويحذركم الله نفسه }، [15] وذلك غير مسموع ولا يقال إلا بحرف ( في ) الجارة وحرف ( في ) للوعاء وهو معنى مستحيل على نفس الباري تعالى. إذا قلت: جاهدت في الله تعالى وأحببتك في الله تعالى محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، وإنما هو على حذف المضاف أي في مرضاة الله وطاعته فيكون الحرف على بابه. كأنك قلت: هذا محسوب في الأعمال التي فيها مرضاة الله وطاعته. وإما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال.
وإذا ثبت هذا فقوله: في ذات الله، أو في ذات الإله، إما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات الإله فذات وصف للديانة، وكذلك هي في الأصل موضوعها نعت لمؤنث. ألا ترى أن فيها تاء التأنيث، وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله تعالى عز وجل لا عن نفسه سبحانه. وهذا هو المفهوم من كلام العرب. ألا ترى إلى قول النابعة: * بجلتهم ذات الإله ودينهم * فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيف إليه.
وهذا من كلامه من المرقِّصات، فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل هذه اللفظة هو تأنيث ذو بمعنى صاحب. فذات صاحبة كذا في الأصل، ولهذا لا يقال ذات الشيء إلا لما له صفات ونعوت تضاف إليه. فكأنه يقول: صاحبة هذه الصفات والنعوت. ولهذا أنكر جماعة من النحاة منهم ابن هان وغيره على الأصوليين قولهم "الذات" وقالوا: لا مدخل للألف واللام هنا، كما لا يقال: "الذو" في ذو. وهذا إنكار صحيح، والاعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه، فلما استعملوها استعمال النفس والحقيقة عرفوها باللام وجردوها، ومن هنا غلطهم السهيلي فإن هذا الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي، فإن العرب لا تكاد تقول: رأيت الشيء لعينه ونفسه، وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه ومن جهته، وهذا كجنب الشيء. إذا قالوا هذا في جنب الله، لا يريدون إلا فيما ينسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته - لا يريدون غير هذا البتة. فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله: «ثلاث كذبات في ذات الله»، وقوله: * وذلك في ذات الإله * فغلط واستحق التغليط، بل الذات هنا كالجنب في قوله تعالى: { يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله }، [16] ألا ترى أنه لا يحسن أن يقال ههنا: فرطت في نفس الله وحقيقته، ويحسن أن يقال: فرط في ذات الله، كما يقال: فعل كذا في ذات الله، وقتل في ذات الله، وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك فإنه من المباحث العزيزة الغريبة التي يثنى على مثلها الخناصر، والله الموفق المعين.
فائدة: إبدال النكرة من المعرفة
ما الفائدة في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بها، فإن كانت الفائدة في النكرة فلم ذكرت المعرفة، وإن كانت في المعرفة فما بال ذكر النكرة.
قيل: هذا فيه نكتة بديعة. وهي أن الحكم قد يعلق بالنكرة السابقة فتذكر. ويكون الكلام في معرض أمر معين من الجنس مدحًا، أو ذمًا، فلو اقتصر على ذكر المعرفة لاختص الحكم به، ولو ذكرت النكرة وحدها لخرج الكلام عن التعرض لذلك المعين. فلما أريد الجنس أتى بالنكرة ووصفت إشعارًا بتعليق الحكم بالوصف. ولما أتى بالمعرفة كان تنبيهًا على دخول ذلك المعين قطعًا. ومثال ذلك قوله تعالى: { لنسفعا بالناصية * ناصية كاذبة خاطئة }، [17] فإن الآية كما قيل: نزلت في أبي جهل، ثم تعلق حكمها بكل من اتصف به فقال: { لنسفعا بالناصية } تعيينًا { ناصية كاذبة } لعدمه وتنبيهًا، ولذلك اشترط في النكرة في هذا الباب أن تكون منعوتة لتحصل الفائدة المذكورة وليتبين المراد.
وأما قوله تعالى: { ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا }، [18] ففيها قولان:
أحدهما: أن شيئًا بدل من رزقه ورزقًا أبين من شيئًا، لأنه أخص منه، والأخص أبين من الأعم، وجاز هذا من أجل تقدم النفي، لأن النكرة إنما تفيد بالإخبار عنها بعد النفي، فلما اقتضى النفي العام ذكر الاسم العام الذي هو أنكر النكرات ووقعت الفائدة به من أجل النفي صلح أن يكون بدلًا من رزق. ألا ترى أنك لو طرحت الاسم الأول واقتصرت على الثاني لم يكن إخلالًا بالكلام.
والقول الثاني: أن شيئًا هنا مفعول المصدر الذي هو الرزق وتقديره لا يملكون أن يرزقوا شيئًا وهذا قول الأكثرين إلا أنه يرد عليهم. أن الرزق هنا اسم لا مصدر، لأنه بوزن الذبح والطحن للمذبوح والمطحون. ولو أريد المصدر لجاء بالفتح نحو قول الشاعر: يخاطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعفا عنه:
واقصد إلى الخير ولا توقه ** وارزق عيال المسلمين رزقه
وقد يجاب عن هذا بأن الرزق من المصادر التي جاءت على فعل بكسر أوائلها كالفسق، ويطلق على المصدر والاسم بلفظ واحد، كالنسخ للمصدر والمنسوخ وبابه وهذا أحسن. والبيت لا نسلم أن راءه مفتوحة، وإنما هي مكسورة. وهذا اللائق بحال عمر بن عبد العزيز والشاعر فإنه طلب منه أن يرزق عيال المسلمين رزق الله الذي هو المال المرزوق لا أنه يرزقهم كرزق الله الذي هو المصدر، هذا مما لا يخاطب به أحد، ولا يقصده عاقل والله أعلم.
فائدة بديعة: تفسير اهدنا الصراط المستقيم
قوله تعالى: { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم } فيها عشرون مسألة.
أحدها: ما فائدة البدل في الدعاء، والداعي مخاطب لمن لا يحتاج إلى البيان والبدل القصد به بيان الاسم الأول.
الثانية: ما فائدة تعريف { الصراط المستقيم }، باللام، وهلا أخبرعنه بمجرد اللفظ دونها كما قال: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }.
الثالثة: ما معنى الصراط ومن أي شيء اشتقاقه ولم جاء على وزن فعال ولم ذكر في أكثر المواضع في القران بهذا اللفظ. وفي سورة الأحقاف ذكر بلفظ الطريق فقال: { يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم }. [19]
الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: { الذين أنعمت عليهم } بهذا اللفظ ولم يذكرهم بخصوصهم فيقول صراط النبيين والصديقين فلم عدل إلى لفظ المبهم دون المفسر.
الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ الذي مع صلتها دون أن يقال المنعم عليهم وهو أخصر كما قال: { المغضوب عليهم }، وما الفرق.
السادسة: لم فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم. فقال في أهل النعمة، الذين أنعمت وفي أهل الغضب المغضوب بحذف الفاعل.
السابعة لم قال: { اهدنا الصراط المستقيم }، فعدى الفعل بنفسه، ولم يعده بإلى كما قال تعالى: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }، [20] وقال تعالى: { واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم } [21]
الثامنة: أن قوله تعالى: { الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم } يقتضي أن نعمته مختصة بالأولين دون المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا حجة لمن ذهب إلى أنه لا نعمة له على كافر. فهل هذا استدلال صحيح أم لا.
التاسعة: أن يقال لم وصفهم بلفظ غير وهلا قال تعالى: لا المغضوب عليهم كما قال والضالين. وهذا كما تقول: مررت بزيد لا عمرو وبالعاقل لا الأحمق.
العاشرة: كيف جرت غير صفة على الموصول وهي لا تتعرف بالإضافة، وليس المحل محل عطف بيان إذ بابه الإعلام ولا محل لذلك. إذ المقصود في باب البدل هو الثاني والأول توطئة وفي باب الصفات المقصود الأول. والثاني بيان وهذا شأن هذا الموضع. فإن المقصود ذكر المنعم عليهم ووصفهم بمغايرتهم معنى الغضب والضلال.
الحادية عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل، فالصراط المستقيم مقصود الإخبار عنه بذلك، وليس في نية الطرح، فكيف جاء صراط الذين أنعمت عليهم بدلًا منه؟ وما فائدة البدل هنا.
الثانية عشرة: إنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وأبو حاتم تفسير المغضوب عليهم بأنهم اليهود، والنصارى بأنهم الضالون، فما وجه هذا التقسيم والاختصاص؟ وكل من الطائفتين ضال مغضوب عليه.
الثالثة عشرة: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالين؟
الرابعة عشرة: لم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة من فعل؟ ولم يأت في أهل الضلال بذلك. فيقال المضلين. بل أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من فعل.
الخامسة عشرة: ما فائدة العطف بلا هنا. ولو قيل المغضوب عليهم والضالين لم يختل الكلام وكان أوجز.
السادسة عشرة: إذ قد عطف بها فيأتي العطف بها مع الواو للمنفي. نحو ما قام زيد ولا عمرو وكقوله تعالى: { ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج } إلى قوله تعالى: { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم }، [22] وأما بدون الواو فبابها الإيجاب. نحو مررت بزيد لا عمرو. فهذه ستة عشرة مسألة في ذلك.
السابعة عشرة: هل الهداية هنا هداية التعريف والبيان، أو هداية التوفيق والإلهام.
الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرًا لازمًا لا يقوم غيره مقامه، ولا بد منه. وهذا إنما نسأله في الصلاة بعد هدايته. فما وجه السؤال لأمر حاصل؟ وكيف يطلب تحصيل الحاصل؟
التاسعة عشرة: ما فائدة الإتيان بضمير الجمع في اهدنا؟ والداعي يسأل ربه لنفسه في الصلاة وخارجها ولا يليق به ضمير الجمع ولهذا يقول: رب اغفر لي وارحمني وتب علي.
العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد وقت سؤاله؟ فهذه أربع مسائل حقها أن تقدم أولًا، ولكن جر الكلام إليها بعد ترتيب المسائل الستة عشر.
فالجواب بعون الله وتعليمه فإنه لا علم لأحد من عباده إلا ما علمه، ولا قوة له إلا بإعانته.
أما المسألة الأولى وهي فائدة البدل من الدعاء، أن االآية وردت في معرض التعليم للعباد والدعاء وحق الداعي أن يستشعر عند دعائها ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمان إلا به. إذ الدعاء مخ العبادة والمخ لا يكون إلا في عظم، والعظم لا يكون إلا في لحم ودم. فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء وجب أن يكون الطلب ممزوجًا بالثناء. فمن ثم جاء لفظ الطلب للهداية والرغبة فيها مثوبًا بالخير تصريحًا من الداعي بمعتقده وتوسلًا منه بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربه. فكأنه متوسل! ليه بإيمانه واعتقاده. إن صراط الحق هو الصراط المستقيم وإنه صراط الذين اختصهم بنعمته وحباهم بكرامته. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضا، والداعي يجب عليهم اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه. فلذلك أبدل وبين لهم ليمرن اللسان على ما اعتقده الجنان. ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبار بفائدتين جليلتين إحداهما فائدة الخبر، والثانية فائدة لازم الخبر.
فأما فائدة الخبر فهي الإخبار عنه بالاستقامة وإنه الصراط المستقيم الذي نصبه لأهل نعمته وكرامته. وأما فائدة لازم الخبر فإقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقرار إلى ربه، فهذه أربع فوائد الدعاء بالهداية إليه. والخبر عنه بذلك. والإقرار والتصديق لشأنه. والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق. وفيه فائدة خامسة وهي أن الداعي، إنما أمر بذلك لحاجته إليه وإن سعادته وفلاحه لا تتم إلا به فهو مأمور بتدبر ما يطلب وتصور معناه. فذكر له من أوصافه ما إذا تصور في خلده وقام بقلبه كان أشد طلبًا له وأعظم رغبة فيه، وأحرص على دوام الطلب والسؤال له، فتأمل هذه النكت البديعة.
فصل: تعريف الصراط باللام
وأما المسألة الثانية وهي تعريف الصراط باللام هنا. فاعلم أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره. ألا ترى أن قولك جالس فقيهًا، أو عالمًا، ليس كقولك جالس الفقيه أو العالم. ولا قولك أكلت طيبًا كقولك الطيب. ألا ترى إلى قوله ﷺ: «أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق»، ثم قال: «ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق»، فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المحدثة وأدخلها على اسم الرب تعالى ووعده وكلامه.
فإذا عرفت هذا، فلو قال: اهدنا صراطًا مستقيمًا لكان الداعي إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق. وليس المراد ذلك بل المراد الهداية إلى الصراط المعين الذي نصبه الله تعالى لأهل نعمته وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته، وهو دينه الذي لا دين له سواه. فالمطلوب أمر معين في الخارج والذهن لا شيء مطلق منكر واللام هنا للعهد العلمي الذهني وهو أنه طلب الهداية إلى سر معهود قد قام في القلوب معرفته والتصديق به وتميزه عن سائر طرق الضلال فلم يكن بد من التعريف.
فإن قيل: لم جاء منكرًا في قوله لنبيه ﷺ: { ويهديك صراطا مستقيمًا }، [23] وقوله تعالى: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }، [24] وقوله تعالى: { واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم }، [25] وقوله تعالى: { قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم }. [26]
فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو أنها ليست في مقام الدعاء والطلب، وإنما هي في مقام الإخبار من الله تعالى عن هدايته إلى صراط مستقيم وهداية رسوله إليه. ولم يكن للمخاطبين عهد به، ولم يكن معروفًا لهم فلم يجىء معرفًا بلام العهد المشيرة إلى معروف في ذهن المخاطب قائم في خلده، ولا تقدمه في اللفظ معهود تكون اللام معروفة إليه، وإنما تأتي لام العهد ني أحد هذين الموضعين أعني أن يكون لها معهود ذهني أو ذكري لفظي. وإذ لا واحد منهما في هذه المواضع. فالتنكير هو الأصل وهذا بخلاف قوله: { اهدنا الصراط المستقيم }، فإنه لما تقررعندالمخاطبين. إن لله صراطًا مستقيمًا هدى إليه أنبياءه ورسله. وكان المخاطب سبحانه المسؤول من هدايته عالمًا به دخلت اللام عليه فقال: { اهدنا الصراط المستقيم }.
وقال أبو القاسم السهيلي: إن قوله تعالى: { ويهديك صراطًا مستقيمًا } نزلت في صلح الحديبية وكان المسلمون قد كرهوا ذلك الصلح ورأوا أن الرأي خلافه. وكان الله تعالى عما يقولون ورسوله ﷺ أعلم فأنزل على رسوله ﷺ هذه الآية. فلم يرد صراطًا مستقيمًا في الدين، وإنما أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة. وقوله تبارك وتعالى: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }، [27] أي تهدي من الكفر والضلال إلى صراط مستقيم. ولو قال في هذا الموطن إلى الصراط المستقيم لجعل للكفر وللضلال حظًا من الاستقامة إذ الألف واللام تنبىء أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصلة أحق بذلك المعنى مما تلاه في الذكر، أو ما قرب به في الوهم، ولا يكون أحق به إلا والآخر فيه طرف منه.
وغير خاف ما في هذين الجوابين من الضعف والوهن، أما قوله إن المراد بقوله: ويهديك صراطًا مستقيمًا في الحرب والمكيدة. فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتن الله به على رسوله وأخبر النبي ﷺ أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا وما فيها ومتى سمى الله الحرب والمكيدة صراطًا مستقيمًا، وهل فسر هذه الآية أحد من السلف أو الخلف بذلك؟ بل الصراط المستقيم ما جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر بأن الله تعالى هداه إليه في قوله: { قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم } ثم فسره بقوله تعالى: { دينًا قيمًا ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين } ونصب دينًا هنا على البدل من الجار والمجرور. أي هداني دينًا قيمًا. أفتراه يمكنه ههنا أن يقول: إنه الحرب والمكيدة؟ فهذا جواب فاسد جدًا.
وتأمل ما جمع الله سبحانه لرسوله في آية الفتح من أنواع العطايا وذلك خمسة أشياء أحدها الفتح المبين. والثاني مغفرة ماتقدم من ذنبه وما تأخر. والثالث هدايته الصراط المستقيم. والرابع إتمام نعمته عليه. والخامس إعطاء النصر العزيز وجمع سبحانه له بين الهدى والنصر، لأن هذين الأصلين بهما كمال السعادة والفلاح. فإن الهدى هو العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته وطاعته. فهو العلم النافع والعمل الصالح والنصر والقدرة التامة على تنفيذ دينه. فالحجة والبيان والسيف والسنان فهو النصر بالحجة واليد، وقهر قلوب المخالفين له بالحجة، وقهر أبدانهم باليد.
وهو سبحانه كثيرًا ما يجمع بين هذين الأصلين إذ بهما تمام الدعوة وظهور دينه على الدين كله كقوله تعالى: { هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله } [28] في موضعين في سورة براءة وفي سورة الصف. وقال تعالى: { لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط }، فهذا الهدى ثم قال: { وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد }، [29] فهذا النصر فذكر الكتاب الهادي والحديد الناصر. وقال تعالى: { الم * الله لا إله إلا هو الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل * من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان }، [30] فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان وهو النصر الذي يفرق بين الحق والباطل.
وسر اقتران النصر بالهدى. إن كلًا منهما يحصل به الفرقان بين الحق والباطل. ولهذا سمي تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانًا. كما قال تعالى: { إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان }، [31] فذكر الأصلين ما أنزله على رسوله يوم الفرقان وهو يوم بدر. وهو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهم ومن هذا قوله تعالى: { ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين }، [32] فالفرقان نصرة له على فرعون وقومه والضياء والذكر والتوراة هذا هو معنى الآية. ولم يصب من قال: إن الواو زائدة، وإن ضياء منصوب على الحال كما بينا فساده في الأمالي المكية. فبين أن آية الفتح تضمنت الأصلين الهدى والنصر، وإنه لا يصح فيها غير ذلك البتة.
وأما جوابه الثاني عن قوله: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بأنه لوعرف لجعل للكفر والضلال حظًا من الاستقامة. فما أدري من أين جاء له هذا الفهم مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع رحمه الله تعالى؟ وما هي إلا كبوة جواد ونبوة صارم افترى قوله تعالى: { وآتيناهما الكتاب المستبين }، [33] { وهديناهما الصراط المستقيم } [34] يفهم منه أن لغيره حظًا من الاستقامة، وما ثم غيره إلا طرق الضلال. وإنما الصراط المستقيم واحد وهو ما هدى الله إليه أنبيائه ورسله أجمعين وهو الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وكذلك تعريفه في سورة الفاتحة هل يقال: إنه يفهم منه إن لغيره حظًا من الاستقامة. بل يقال تعريفه ينبىء أن لا يكون لغيره حظ من الاستقامة. فإن التعريف في قوة الحصر فكانه قيل الذي لا صراط مستقيم سواه، وفهم هذا الاختصاص من اللفظ أقوى من فهم المشاركة، فتأمله هنا وفي نظائره.
فصل: اشتقاق الصراط
وأما المسألة الثالثة وهي اشتقاق الصراط. فالمشهور أنه من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته بلعًا سهلًا فسمي الطريق صراطًا، لأنه يشترط المارة فيه. والصراط ما جمع خمسة أوصاف أن يكون طريقًا مستقيمًا سهلًا مسلوكًا واسعًا موصلًا إلى المقصود. فلا تسمي العرب الطريق المعوج صراطًا، ولا الصعب المشق، ولا المسدود غير الموصل. ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم تبين له ذلك. قال جرير:
أمير المؤمنين على صراط ** إذا اعوج الموارد مستقيم
وبنوا الصراط على زنة فعال لأنه مشتمل على سالكه اشتمال الحلق على الشيء المشروط وهذا الوزن كثير في المشتملات على الأشياء، كاللحاف والخمار والرداء والغطاء والفراش والكتاب إلى سائر الباب يأتي لثلاثة معان. أحدها: المصدر كالقتال والضراب، والثاني المفعول نحو الكتاب والبناء والغرا س، والثالث إنه يقصد به قصد الآلة التي يحصل بها الفعل ويقع بها كالخمار والغطاء والسداد لما يخمر به ويغطي ويسد به، فهذا الة محضة والمفعول هو الشيء المخمر والمغطى والمسدود. ومن هذا القسم الثالث إله بمعنى مألوه.
وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة، فهذا حكاية الله تعالى لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: { إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى مصدقًا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم }، [35] وتعبيرهم عنه ههنا بالطريق فيه نكتة بديعة، وهي أنهم قدموا قبله ذكر موسى وإن الكتاب الذي سمعوه مصدقًا لما بين بديه من كتاب موسى وغيره، فكان فيه كالنبأ عن رسول الله ﷺ في قوله لقومه: { ما كنت بدعًا من الرسل } [36] أي لم أكن أول رسول بعث إلى أهل الأرض بل قد تقدمت رسل من الله إلى الأمم، وإنما بعثت مصدقًا لهم بمثل ما بعثوا به من التوحيد والإيمان فقال مؤمنو الجن: { إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم }. [37] أي إلى سبيل مطروق قد مرت عليه الرسل قبله، وإنه ليس ببدع كما قال في أول السورة نفسها فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ الطريق، لأنه فعيل بمعنى مفعول أي مطروق مشت عليه الرسل والأنبياء قبل. فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن يؤمن به ويصدقه. فذكر الطريق ههنا إذًا أولى، لأنه أدخل في باب الدعوة. والتنبيه على تعين أتباعه والله أعلم. ثم رأيت هذا المعنى بعينه قد ذكره السهيلي فوافق فيه الخاطر الخاطر.
فصل: إضافة الصراط إلى الموصول المبهم
وأما المسألة الرابعة وهي إضافته إلى الموصول المبهم دون أن يقول: صراط النبيين والمرسلين ففيه ثلاث فوائد:
إحداها: إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذا، فإن استحقاق كونهم من المنعم عليهم هو بهدايتهم إلى الصراط فيه صاروا من أهل النعمة وهذا كما يعلق الحكم بالصلة دون الاسم الجامد لما فيه من الإنعام باستحقاق ما علق عليها من الحكم بها. وهذا كقوله تعالى: { الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم }، [38] { والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون }، [39] { إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم }، [40] وهذا الباب مطرد فالإتيان بالاسم موصولًا على هذا المعنى من ذكر الاسم الخاص.
الفائدة الثانية: فيه إشارة إلى أن نفي التقليد عن القلب واستشعار العلم بأن من هدى إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه. فالسائل مستشعر سؤال الهداية وطلب الإنعام من الله عليه. والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل الهداية إليه. والثاني يتضمن الطلب والإرادة وأن تكون منه.
الفائدة الثالثة: إن الآية عامة في جميع طبقات المنعم عليهم، ولو أتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى صراط جميع المنعم عليهم. فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة. إن المسؤول الهدي إلى جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا أجل مطلوب وأعظم مسؤول. ولو عرف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هجيراه وقرنه بأنفاسه. فإنه لم يدع شيئًا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمنه. ولما كان بهذه المثابة فرضه الله على جميع، عباده فرضا متكررًا في اليوم والليلة لا يقوم غيره مقامه، ومن ثم يعلم تعين الفاتحة في، الصلاة وإنها ليس منها عوض يقوم مقامها.
فصل: قال أنعمت عليهم ولم يقل المنعم عليهم
وأما المسألة الخامسة وهي أنه قال: { الذين أنعمت عليهم } ولم يقل المنعم عليهم. كما قال: { المغضوب عليهم } فجوابها وجواب المسألة السادسة واحد وفيه فوائد عديدة.
أحدها: إن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القران. وهي أن أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فيذكر فاعلها منسوبة إليه، ولا يبني الفعل معها للمفعول، فإذا جيء بأفعال العدل والجزاء والعقوبة. حذف الفاعل وبنى الفعل معها للمفعول أدبًا في الخطاب، وإضافته إلى الله أشرف فسمى أفعاله، فمنه هذه الآية فإنه ذكر النعمة فأضافها إليه، ولم يحذف فاعلها. ولما ذكر الغضب حذف الفاعل، وبنى الفعل للمفعول. فقال: المغضوب عليهم وقال في الإحسان: الذين أنعمت عليهم. ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: { الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين } [41] فنسب الخلق والهداية والإحسان بالطعام. والسقي إلى الله تعالى. ولما جاء إلى ذكر المرض قال: وإذا مرضت. ولم يقل أمرضني. وقال: فهو يشفين ومنه قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: { وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا }، [42] فنسبوا إرادة الرشد إلى الرب وحذفوا فاعل إرادة الشر وبنوا الفعل للمفعول. ومنه قول الخضر عليه الصلاة والسلام في السفينة فأردت أن أعيبها. فأضاف العيب إلى نفسه. وقال في الغلامين: { فأراد ربك أن يبلغا أشدهما }، [43] ومنه قوله تعالى: { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }، [44] فحذف الفاعل وبناه للمفعول وقال: { وأحل الله البيع وحرم الربا }، [45] لأن في ذكر الرفث ما يحسن منه أن لا يقترن بالتصريح بالفاعل ومنه: { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير }، [46] وقوله: { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا } [47] إلى آخرها. ومنه وهو ألطف من هذا وأدق معنى قوله: { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم } [48] إلى آخرها، ثم قال: { وأحل لكم ما وراء ذلكم }، [49] وتأمل قوله: { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كيف صرح بفاعل التحريم في هذا الموضع. وقال في حق المؤمنين: { حرمت عليكم الميتة والدم }. [50]
الفائدة الثانية: أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المنعم بها وأصل الشكر ذكر النعم والعمل بطاعته. وكان من شكره إبراز الضمير المتضمن لذكره تعالى الذي هو أساس الشكر وكان في قوله: { أنعمت عليهم } من ذكر وإضافته النعمة إليه ما ليس في ذكر المنعم عليهم لو قاله. فضمن هذا اللفظ الأصلين وهما الشكر والذكر المذكوران في قوله: { فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون }. [51]
الفائدة الثالثة: أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده وهو المنعم بالهداية دون أن يشركه أحد في نعمته، فاقتضى اختصاصه بها أن يضاف إليه بوصف الإفراد فيقال: أنعمت عليهم أي أنت وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة، وأما الغضب فإن الله سبحانه غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراط وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم، وذلك يستلزم غضبهم عليهم موافقة لغضب ربهم عليهم فموافقته تعالى تقتضي أن يغضب على من غضب عليه ويرضى عمن رضي عنه فيغضب لغضبه ويرضى لرضاه. وهذا حقيقة العبودية واليهود قد غضب الله عليهم، فحقيق بالمؤمنين الغضب عليهم. فحذف فاعل الغضب وقال: المغضوب عليهم لما كان للمؤمنين نصيب من غضبهم على من غضب الله عليه بخلاف الإنعام فإنه لله وحده. فتأمل هذه النكتة البديعة.
الفائدة الرابعة: أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم وترك الإلتفات إليهم والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار عليها. وأما أهل النعمة فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم والإشارة بذكرهم وإذا ثبت هذا فالألف واللام في المغضوب وإن كانتا بمعنى الذين. فليست مثل الذين في التصريح والإشارة إلى تعيين ذات المسمى. فإن قولك الذين فعلوا معناه القوم الذين فعلوا وقولك الضاربون والمضروبون ليس فيه ما في قولك الذين ضربوا أو ضربوا فتأمل ذلك. فالذين أنعمت عليهم إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقصد ذواتهم بخلاف المغضوب عليهم. فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عنهم وعدم الإلتفات إليهم والمعول عليه من الأجوبة ما تقدم.
فصل: تعدية الفعل بنفسه
وأما المسألة السابعة وهي تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف إلى، فجوابها أن فعل الهداية يتعدى بنفسه تارة، وبحرف إلى تارة وباللام تارة. والثلاثة في القرآن. فمن المعدى بنفسه هذه الآية. وقوله: { ويهديك صراطًا مستقيمًا }، [52] ومن المعدى بإلى قوله: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }، [53] وقوله تعالى: { قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم }، [54] ومن المعدى باللام قوله قول أهل الجنة: { الحمد لله الذي هدانا لهذا }، [55] وقوله تعالى: { إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم }. [56]
والفرق بين هذه المواضع تدق جدًا عن أفهام العلماء، ولكن نذكر قاعدة تشير إلى الفرق، وهي أن الفعل المعدي بالحروف المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد على معنى الحرف الآخر وهذا بحسب اختلاف معاني الحروف. فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحو رغبت عنه ورغبت فيه، وعدلت إليه وعدلت عنه، وملت إليه وعنه وسعيت إليه وبه، وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق نحو قصدت إليه وقصدت له، وهديته إلى كذا وهديته لكذا، وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر. وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة، بل يجعلون للفعل معنى مع الحرف، ومعنى مع غيره. فينظرون إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال، فيشربون الفعل المتعدي به معناه، هذه طريقة أمام الصناعة سيبويه رحمه الله تعالى، وطريقة حذاق أصحابه يضمنون الفعل معنى الفعل لا يقيمون الحرف مقام الحرف. وهذه قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن. وهذا نحو قوله تعالى: { عينًا يشرب بها عباد الله }، [57] فإنهم يضمنون بشرب معنى يروي فيعدونه بالباء التي تطلبها. فيكون في ذلك دليل على الفعلين أحدهما بالتصريح به، والثاني بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. ومنه قوله في السحاب: شربن بماء البحر حتى روين، ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن من أن يقال يشرب منها. فإنه لا دلالة فيه على الري وإن يقال: يروي بها لأنه لا يدل على الشرب بصريحه، بل باللزوم، فإذا قال: يشرب بها. دل على الشرب بصريحه وعلى الري بخلاف الباء فتأمله. ومن هذا قوله تعالى: { ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه }، [58] وفعل الإرادة لا يتعدى بالباء، ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذا وهو أبلغ من الإرادة. فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب عند الإرادة وإن لم تكن جازمة، وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه ويكفي المثالان المذكوران. فإذا عرفت هذا ففعل الهداية متى عدي بإلى تضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة فأتى بحرف الغاية ومتى عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعيين. فإذا قلت: هديته لكذا. فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهيأته ونحو هذا، وإذا تعدى بنفسه تضمن المعنى، الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم. هو طالب من الله أن يعرفه إياه ويبينه له ويلهمه إياه ويقدره عليه، فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه. فجرد الفعل من الحرف وأتى به مجردًا معدى بنفسه ليتضمن هذه المراتب كلها. ولو عدى بحرف تعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف. فتأمله فإنه من دقائق اللغة وأسرارها.
فصل: تخصيص أهل السعادة بالهداية
وأما المسألة الثامنة وهي أنه خص أهل السعادة بالهداية دون غيرهم. فهذه مسألة اختلف الناس فيها وطال الحجاج من الطرفين وهي أنه هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ فمن ناف محتج بهذه وبقوله: { ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا }، [59] فخص هؤلاء بالإنعام فدل على أن غيرهم غير منعم عليه، ولقوله لعباده المؤمنين: { ولأتم نعمتي عليكم } [60] وبأن الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة فأي نعمة على من خلق للعذاب الأبدي. ومن مثبت محتج بقوله: { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها }، [61] وقوله لليهود: { يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم }، [62] وهذا خطاب لهم في حال كفرهم وبقوله في سورة النحل التي عدد فيها نعمه المشتركة على عباده من أولها إلى قوله: { كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون * فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين * يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون }، [63] وهذا نص صريح لا يحتمل صرفًا. واحتجوا بأن البر والفاجر والمؤمن والكافر كلهم يعيش في نعمة الله وكل أحد مقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته. وهذا معلوم بالاضطرار عند جميع أصناف بني آدم إلا من كابر وجحد حق الله تعالى وكفر بنعمته.
وفصل الخطاب في المسألة أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمان لا يشركهم فيها سواهم. ومطلق النعمة عام للخليفة كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم. فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم، فهذه غير مشتركة ومطلق النعمة عام مشترك. فإذا أراد النافي سلب النعمة المطلقة أصاب، وإن أراد سلب مطلق النعمة أخطأ. وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر أخطأ. وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب، وبهذا تتفق الأدلة ويزول النزاع ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ وصواب، والله الموفق.
وأما قوله تعالى: { يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم }، [64] فإنما يذكرهم بنعمته على آبائهم ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة بأن أنجاهم من آل فرعون وإن فرق بهم البحر وإن وعد موسى أربعين ليلة. فضلوا بعده ثم تاب عليهم، وعفا عنهم، وبأن ظلل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المن والسلوى إلى غير ذلك من نعمه التي يعددها عليهم، وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم فأمرهم أن يذكروها ليدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته، والإيمان برسله، والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه وطاعته، وكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم تستدعي منهم شكرًا فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي وتكذيبكم له ومعاداتكم إياه؟ وهذا لا يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال كفرهم والله أعلم.
فصل: قال غير المغضوب ولم يقل لا المغضوب عليهم
وأما المسألة التاسعة وهي أنه قال غير المغضوب، ولم يقل لا المغضوب عليهم. فيقال: لا ريب أن لا يعطف بها بعد الإيجاب، كما تقول: جاءني زيد لا عمرو وجاءني العالم لا الجاهل. وأما غير فهي تابع لما قبلها وهي صفة ليس إلا كما سيأتي. وإخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف وهذا إنما يعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع والوصف. فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف، وقيل: صراط الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم. لم يكن في العطف بها أكثر من نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم. كما هو مقتضي العطف. فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا الجاهل لم يكن في العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم. وأما الإتيان بلفظ غير فهي صفة لما قبلها فأفاد الكلام معها. وصفهم بشيئين أحدهما أنهم منعم عليهم. والثاني أنهم غير مغضوب عليهم. فأفاد ما يفيد العطف مع زيادة الثناء عليهم، ومدحهم فإنه يتضمن صفتين صفة ثبوتية وهي كونهم منعمًا عليهم وصفة سلبية وهي كونهم غير مستحقين لوصف الغضب وإنهم مغايرون لأهله. ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المنعم عليهم، ولم تكن صفة منصوبة على الاستثناء لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود.
وفيه فائدة أخرى وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعوا أنهم هم المنعم عليهم دون أهل الإسلام. فكأنه قيل لهم: المنعم عليهم غيركم لا أنتم. وقيل للمسلمين المغضوب عليهم غيركم لا أنتم. فالإتيان بلفظة غير في هذا السياق أحسن وأدل على إثبات المغايرة المطلوبة. فتأمله وتأمل كيف قال المغضوب عليهم ولا الضالين. ولم يقل: اليهود والنصارى مع أنهم هم الموصوفون بذلك تجريدًا لوصفهم بالغضب والضلال الذي به غايروا المنعم عليهم ولم يكونوا منهم بسبيل، لأن الإنعام المطلق ينافي الغضب والضلال فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضال. فتبارك من أودع كلامه من الأسرار ما يشهد بأنه تنزيل من حكيم حميد.
فصل: جريان غير صفة على المعرفة
وأما المسألة العاشرة وهي جريان غير صفة على المعرفة. وهي لا تتعرف بالإضافة ففيه ثلاثة أجوبة:
أحدها: أن غير هنا بدل لا صفة وبدل النكرة من المعرفة جائز، وهذا فاسد من وجوه ثلاثة.
أحدها: أن باب البدل المقصود فيه الثاني والأول توطئة له ومهاد أمامه وهو المقصود بالذكر فقوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }، [65] المقصود هو أهل الاستطاعة خاصة وذكر الناس قبلهم توطئة، وقولك: أعجبني زيد علمه، إنما وقع الإعجاب على علمه وذكرت صاحبه توطئة لذكره وكذا قوله: { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه }، [66] المقصود إنما هو السؤال عن القتال في الشهر الحرام لا عن نفس الشهر. وهذا ظاهر جدًا في بدل البعض وبدل الاشتمال، ويراعى في بدل الكل من الكل. ولهذا سمي بدلًا إيذانًا بأنه المقصود فقوله: { لنسفعا بالناصية * ناصية كاذبة خاطئة }، [67] المقصود لنسفعن بالناصية الكاذبة الخاطئة وذكر المبدل منه توطئة لها، وإذا عرف هذا، فالمقصود هنا ذكر المنعم عليهم وإضافة الصراط إليهم ومن تمام هذا المقصود وتكميله الإخبار بمغايرتهم للمغضوب عليهم. فجاء ذكر غير المغضوب مكملًا لهذا المعنى ومتممًا، لأن أصحاب الصراط المسؤول هدايته هم أهل النعمة فكونهم غير مغضوب عليهم وصف محقق وفائدته فائدة الوصف المبين للموصوف المكمل له وهذا واضح.
الوجه الثاني: أن البدل يجري مجرى توكيد المبدل وتكريره وتثنيته ولهذا كان في تقدير تكرار العامل وهو المقصود بالذكر كما تقدم فهو الأول بعينه ذاتًا ووصفًا، وإنما ذكر بوصف آخر مقصود بالذكر كقوله: { اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم }، ولهذا يحسن الاقتصار عليه دون الأول ولا يكون مخلًا بالكلام، ألا ترى أنك لو قلت: في غير القرآن لله حج البيت على من استطاع إليه السبيل لكان كاملًا مستقيمًا لا خلل فيه. ولو قلت في دعائك: رب اهدني صراط من أنعمت عليه من عبادك لكان مستقيمًا. وإذا كان كذلك فلو قدر الاقتصار على غير، وما في حيزها لاختل الكلام وذهب معظم المقصود منه. إذ المقصود إضافة الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم لا إضافته إلى غير المغضوب عليهم. بل أتى بلفظ غير زيادة في وصفهم والثناء عليه فتأمله.
الوجه الثالث: أن غير لا يعقل ورودها بدلًا، وإنما ترد استثناء أو صفة أو حالًا. وسر ذلك أنها لم توضع مستقلة بنفسها بل لا تكون إلا تابعة لغيرها ولهذا قلما يقال: جاءني غير زيد ومررت بغير عمرو. والبدل لا بد أن يكون مستقلًا بنفسه كما تبين أنه المقصود ونكتة الفرق أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه إليه قد جعلت الأول سلمًا ومرقاة إليه. فهو موضع قصدك ومحط إرادتك وفي باب الصفة بخلاف ذلك، إنما أنت قاصد الموصوف موضح له بصفته. فاجعل هذه النكتة معيارًا على باب البدل والوصف، ثم زن بها غير المغضوب عليهم. هل يصح أن يكون بدلًا أو وصفًا؟
الجواب الثاني: أن غير ههنا صح جريانه صفة على المعرفة لأنها موصولة والموصول مبهم غير معين. ففيه رائحة من النكرة لإبهامه فإنه غير دال على معين فصلح وصفه بغير لقربه من النكرة وهذا جواب صاحب الكشاف قال: فإن قلت: كيف صح أن يقع غير صفة للمعرفة وهو لا يتعرف وان أضيف إلى المعارف قلت: الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه فهو كقوله:
ولقد أمر على اللئيم يسبني ** فمضيت ثمت قلت لا يعنيني
ومعنى قوله: لا توقيت فيه، أي لا تعيين لواحد من واحد كما تعين المعرفة. بل هو مطلق في الجنس فجرى مجرى النكرة واستشهاده بالبيت. معناه أن الفعل نكرة وهو يسبني وقد أوقعه صفة للئيم المعرفة باللام لكونه غير معين فهو في قوة النكرة، فجاز أن ينعت بالنكرة وكأنه قال على لئيم: يسبني وهذا استدلال ضعيف فإن قوله يسبني حال منه لا وصف والعامل فيه فعل المرور المعنى أمر على اللئيم سابًا لي أي أمر عليه في هذه الحال فأتجاوزه ولا أحتفل بسبه.
الجواب الثالث: وهو الصحيح أن غير هنها قد تعرفت بالإضافة. فإن المانع لها من تعريفها شدة إبهامها أو عمومها في كل مغاير للمذكور فلا يحصل بها تعيين. ولهذا تجري صفة على النكرة فتقول: رجل غيرك يقول كذا، ويفعل كذا، فتجرى صفة للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة. ومعلوم أن هذا الإبهام يزول لوقوعها بين متضادين يذكر أحدهما، ثم تضيفها إلى الثاني. فيتعين بالإضافة ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال:
نحن بنو عمرو الهجان الأزهر ** النسب المعروف غير المنكر
أفلا تراه أجرى غير المنكر صفة على النسب، كما أجرى عليه المعروف صفتان معينتان فلا إبهام في غير لأن مقابلها المعروف وهو معرفة وضده المنكر متميز متعين، كتعين المعروف أعني تعين الجنس.
وهكذا قوله: { صراط الذين أنعمت عليهم }، فالمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم. فإذا كان الأول معرفة كانت غير معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير مبهم. فاكتسبت منه التعريف.
وينبغي أن تتفطن هنها لنكتة لطيفة في غير تكشف لك حقيقة أمرها. فأين تكون معرفة وأين تكون نكرة؟ وهي أن "غيرًا" هي نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه. فإن المعروف هو تفسير غير المنكر والمنعم عليهم هم غير المغضوب عليهم هذا حقيقة اللفظة. فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة، وإن أضيفت. كما إذا قلت: رجل غيرك فعل كذا وكذا، وإذا كان متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة، كما إذا قيل المحسن غير المسيء محبوب معظم عند الناس والبر غير الفاجر مهيب والعادل غير الظالم مجاب الدعوة. فهذا لا تكون فيه غير إلا معرفة، ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط وقال: ما لا دليل عليه إذ لا إبهام فيها بحال فتأمله.
فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخر. وهي أنها بمعنى مغاير اسم فاعل عن غاير كمثل بمعنى مماثل وشبه بمعنى مشابه وأسماء الفاعلين لا تعرف بالإضافة، وكذا ما ناب عنها.
قلت: اسم الفاعل، إنما لا يتعرف بالإضافة إذا أضيف إلى معموله، لأن الإضافة في تقدير الانفصال نحو هذا ضارب زيد غدًا. وليست غير بعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول حتى يقال الإضافة في تقدير الانفصال، بل إضافتها إضافة محضة كإضافة غيرها من النكرات. ألا ترى أن قولك غيرك بمنزلة قولك سواك ولا فرق بينهما والله أعلم.
فصل: إخراج صراط مخرج البدل
وأما المسألة الحادية عشرة: وهي ما فائدة إخراج الكلام في قوله: { اهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم }، مخرج البدل مع أن الأول في نية الطرح.
فالجواب أن قولهم الأول في البدل في نية الطرح كلام لا يصح أن يؤخذ على إطلاقه. بل البدل نوعان: نوع يكون الأول فيه في نية الطرح وهو بدل، البعض من الكل، وبدل الاشتمال لأن المقصود هو الثاني لا الأول، وقد تقدم، ونوع لا ينوي فيه طرح الأول وهو بدل الكل من الكل، بل يكون الثاني بمنزلة التذكير واالتوكيد وتقوية النسبة مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة المتجددة الزائدة على الأول. فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار بحصول وصف المبدل للمبدل منه إنه لما قال: { اهدنا الصراط المستقيم }، فكأن الذهن طلب معرفة ما إذا كان الصراط مختص بنا أم سلكه غيرنا ممن هداه الله. فقال: { صراط الذين أنعمت عليهم } وهذا كما إذا دللت رجلًا على طريق لا يعرفها، وأردت توكيد الدلالة وتحريضه على لزومها وأن لا يفارقها. فأنت تقول: هذه الطريق الموصلة إلى مقصودك، ثم تزيد ذلك عنده توكيدًا وتقوية، فتقول: وهي الطريق التي سلكها الناس والمسافرون وأهل النجاة. أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين الناجين قدرًا زائدًا على وصفك لها بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة مستقيمة. فإن النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة. فإذا ذكر لها من تتأسى به في سلوكها أنست واقتحمتها فتأمله.
فصل: تفسير المغضوب عليهم والضالين
وأما المسألة الثانية عشرة: وهي ما وجه تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى مع تلازم وصفي الغضب والضلال.
فالجواب أن يقال هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن أصحاب الصفة الأخرى، فإن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه، لكن ذكر كل طائفة بأشهر وصفيها وأحقها به وألصقه بها، وأن ذلك هو الوصف الغالب عليهما وهذا مطابق، لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن والنصارى بالضلال. فهو تفسير للآية بالصفة التي وصفهم بها في ذلك الموضع.
أما اليهود فقال تعالى في حقهم: { بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين }، [68] وفي تكرار هذا الغضب هنا أقوال.
أحدها: أنه غضب متكرر في مقابلة تكرر كفرهم برسول الله ﷺ والبغي عليه ومحاربته. فاستحقوا بكفرهم غضبًا، وبالبغي والحرب والصد عنه غضبًا آخر. ونظيره قوله تعالى: { الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا فوق العذاب } [69] فالعذاب الأول بكفرهم، والعذاب الذي زادهم إياه بصدهم الناس عن سبيله.
القول الثاني أن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم الأنبياء، والغضب الثاني بكفرهم بالمسيح.
والقول الثالث أن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح والغضب الثاني بمحمد ﷺ.
والصحيح في الآية أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تشفع الواحد، بل المراد غضب بعد غضب بحسب تكرر كفرهم وإفسادهم وقتلهم الأنبياء وكفرهم بالمسيح وبمحمد ﷺ، ومعاداتهم لرسل الله، إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبًا على حدته. وهذا كما في قوله: { فارجع البصر هل ترى من فطور * ثم ارجع البصر كرتين }، [70] أي كرة بعد كرة لا مرتين فقط.
وقصد التعدد في قوله: { فباءوا بغضب على غضب }، [71] أظهر ولا ريب أن تعطيلهم ما عطلوه من شرائع التوراة وتحريفهم وتبديلهم يستدعي غضبًا، وتكذيبهم الأنبياء يستدعي غضبًا آخر وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا آخر، وتكذيبهم المسيح وطلبهم قتله ورميهم أمه بالبهتان العظيم يستدعي غضبًا، وتكذيبهم النبي ﷺ يستدعي غضبًا، ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي غضبًا، وصدهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبًا. فهم الأمة الغضبية أعاذنا الله من غضبه فهي الأمة التي باءت بالغضب المضاعف المتكرر وكانوا أحق بهذا الاسم والوصف من النصارى. وقال تعالى في شأنهم: { قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت }، [72] فهذا غضب مشفوع باللعنة والمسخ وهو أشد ما يكون من الغضب. وقال تعالى: { لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون * ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون }. [73]
وأما وصف النصارى بالضلال ففي قوله تعالى: { قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل }، [74] فهذا خطاب للنصارى، لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: { لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم } وقال المسيح: { يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم } [75] إلى قوله: { وضلوا عن سواء السبيل }، فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولًا، ثم أضلوا كثيرًا وهم أتباعهم. فهذا قبل مبعث النبي في ﷺ حيث ضلوا في أمر المسيح وأضلوا أتباعهم، فلما بعث النبي ﷺ ازدادوا ضلالًا آخر بتكذيبهم له وكفرهم به فتضاعف الضلال في حقهم. هذا قول طائفة منهم الزمخشري وغيره، وهو ضعيف. فإن هذا كله وصف لأسلافهم الذين هم لهم تبع فوصفهم بثلاث صفات. أحدها أنهم قد ضلوا من قبلهم. والثاني أنهم أضلوا أتباعهم، والثالث أنهم ضلوا عن سواء السبيل فهذه صفات لأسلافهم الذين نهى هؤلاء عن اتباع أهوائهم فلا يصح أن يكون وصفًا للموجودين في زمن النبي ﷺ، لأنهم هم المنهيون أنفسهم لا المنهي عنهم. فتأمله.
وإنما سر الآية أنها اقتضت تكرار الضلال في النصارى ضلالًا بعد ضلال لفرط جهلهم بالحق. وهي نظير الآية التي تقدمت في تكرار الغضب في حق اليهود ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من اليهود، ووجه تكرار هذا الضلال. إن الضلال قد أخطأ نفس مقصوده فيكون ضالًا فيه فيقصد ما لا ينبغي أن يقصده، ويعبد من لا ينبغي أن يعبده وقد يصيب مقصودًا حقًا، لكن يضل في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليه، فالأول ضلال في الغاية. والثاني ضلال في الوسيلة، ثم إذا دعى غيره إلى ذلك فقد أضله.
وأسلاف النصارى اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة:
فضلوا عن مقصودهم، حيث لم يصيبوه وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي وأنه قتل وصلب وصفع؛ فهذا ضلال في نفس المقصود حيث لم يظفروا به.
وضلوا عن السبيل الموصلة إليه، فلا اهتدوا إلى المطلوب، ولا إلى الطريق الموصل إليه.
ودعوا أتباعهم إلى ذلك، فضلوا عن الحق وعن طريقه، وأضلوا كثيرًا، فكانوا أدخل في الضلال من اليهود. فوصفوا بأخص الوصفين.
والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد وإيثار ما كان لهم على قومهم من السحت والرياسة، فخافوا أن يذهب بالإسلام فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق. فإنهم كانوا يعرفون أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبر والحسد وإيثار السحت والبغي وقتل الأنبياء؛ ووبخ النصارى بالضلال، والجهل الذي هو عدم العلم بالحق. فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة، ومن عدم إرادته والعمل بها أخرى يتركب منها، فكفر اليهود ينشأ من عدم إرادة الحق والعمل به، وإيثار غيره عليه بعد معرفته، فلم يكن ضلالًا محضًا. وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه، فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين.
ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة الحق وإيثاره على غيره، وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق. والبغي يمنعه من إرادته كان العبد أحوج شيء إلى أن يسأل الله تعالى كل وقت أن يهديه الصراط المستقيم تعريفًا وبيانًا وإرشادًا وإلهامًا وتوفيقًا وإعانة، فيعلمه ويعرفه، ثم يجعله مريدًا له قاصدًا لأتباعه، فيخرج بذلك عن طريق المغضوب عليهم الذين عدلوا عنه على عمد وعلم، والضالين الذين عدلوا عنه عن جهل وضلال.
وكان السلف يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهذا كما قالوا: فإن من فسد من العلماء فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف، الكلم عن مواضعه، وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضه، وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتله وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم إلى غير ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكفر واللي والكتمان والتحريف والتحيل على المحارم، وتلبيس الحق بالباطل. فهذا شبهه باليهود ظاهر. وأما من فسد من العباد فعبد الله بمقتضى هواه لا بما بعث به رسوله ﷺ وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية وجاوز ذلك إلى نوع من الحلول أو الاتحاد فشبهه بالنصارى ظاهر.
فعلى المسلم أن يبعد من هذين الشبهين غاية البعد ومن تصور الشبهين والوصفين وعلم أحوال الخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا الدعاء الذي ليس للعبد دعاء أنفع منه، ولا أوجب منه عليه. وأن حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنفس، لأن غاية ما يقدر بفوتهما موته وهذا يحصل له بفوته شقاوة الأبد فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنه قريب مجيب.
فصل: تقديم المغضوب عليهم على الضالين
وأما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم المغضوب عليهم على الضالين فلوجوه عديدة:
أحدها: أنهم متقدمون عليهم بالزمان.
الثاني: أنهم كانوا هم الذين يلون النبي ﷺ من أهل الكتابين فإنهم كانوا جيرانه في المدينة، والنصارى كانت ديارهم نائية عنه. ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب النصارى، كما في سورة البقرة والمائدة وآل عمران وغيرهما من السور.
الثالث: أن اليهود أغلظ من النصارى ولهذا كان الغضب أخص بهم واللعنة والعقوبة. فإن كفرهم عن عناد وبغي كما تقدم. فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أحق وأهم بالتقديم، وليس عقوبة من جهل كعقوبة من علم وعاند.
الرابع: وهو أحسنها أنه تقدم ذكر المنعم عليهم، والغضب ضد الإنعام والسورة هي السبع المثاني التي يذكر فيها الشيء ومقابله، فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليه فيه من الإزدواج والمقابلة ما ليس في تقديم الضالين. فقولك: الناس منعم عليه ومغضوب عليه فكن من المنعم عليهم أحسن من قولك منعم عليه وضال.
فصل: اسم المفعول في المغضوب واسم الفاعل في الضال
وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم المفعول وفي الضالين باسم الفاعل فجوابهما ظاهر، فإن أهل الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم، وأما أهل الضلال. فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه. ولهذا استحقوا العقوبة عليه، ولا يليق أن يقال ولا المضلين مبنيًا للمفعول لما في رائحته من إقامة عذرهم، وإنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم. بل فعل فيهم، ولا حجة في هذا للقدرية. فإنا نقول: إنهم هم الذين ضلوا وإن كان الله أضلهم بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلًا إلا على جهة المجاز لا الحقيقة فتضمنت الآية الرد عليهم، كما تضمن قوله: اهدنا الصراط المستقيم الرد على القدرية. ففي الآية إبطال قول الطائفتين والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون وهم المثبتون للقدر توحيدًا وخلقًا والقدرة لإضافة أفعال العباد إليهم عملًا وكسبًا وهو متعلق الأمر والعمل، كما أن الأول متعلق الخلق والقدرة. فاقتضت الآية إثبات الشرع والقدر والمعاد والنبوة فإن النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه، فالمنعم عليهم رسله واتباعهم ليس إلا وهدى اتباعهم، إنما يكون على أيديهم. فاقتضت إثبات النبوة بأقرب طريق وأبينها وأدلها على عموم الحاجة وشدة الضرورة إليها، وإنه لا سبيل للعبد أن يكون من المنعم عليهم إلا بهداية الله له، ولا تنال هذه الهداية إلا على أيدي الرسل، وإن هذه الهداية لها ثمرة وهي النعمة التامة المطلقة في دار النعيم، ولخلافها ثمرة وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبدي، فتأمل كيف اشتملت هذه الآية مع وجازتها واختصارها على أهم مطالب الدين وأجلها. والله الهادي إلى سواء السبيل وهو أعلم.
فصل: زيادة لا بين المعطوف والمعطوف عليه
وأما المسألة الخامسة عشرة: وهي ما فائدة زيادة لا بين المعطوف والمعطوف عليه ففي ذلك أربع فوائد:
أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفي الذي تضمنه غير فلولا ما فيها من معنى النفي لما عطف عليها بلا مع الواو، فهو في قوة لا المغضوب عليهم ولا الضالين، أو غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفائدة الثانية: إن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل نوع بمفرده، فلو لم يذكر لا وقيل: غير المغضوب عليهم والضالين. أوهم أن المراد ما غاير المجموع المركب من النوعين لا ما غاير كل نوع بمفرده. فإذا قيل: ولا الضالين كان صريحًا أو أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمر فإنما نفيت القيام عنهما، ولا يلزم من ذلك نفيه عن كل واحد منهما بمفرده.
الفائدة الثالثة: رفع توهم أن الضالين وصف للمغضوب عليهم وإنهما صنف واحد وصفوا بالغضب والضلال ودخل العطف بينهما، كما يدخل في عطف الصفات بعضها على بعض نحو قوله تعالى: { قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون }، [76] إلى آخرها فإن هذه صفات للمؤمنين. ومثل قوله: { سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى }، [77] ونظائره فلما دخلت لا علم أنهما صنفان متغايران مقصودان بالذكر وكانت لا أولى بهذا المعنى من غير لوجوه. أحدها: أنها أقل حروفًا. الثاني: التفادي من تكرار اللفظ. الثالث: الثقل الحاصل بالنطق بغير مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة، ولا ريب أنه ثقيل على اللسان الرافع أن لا، إنما يعطف بها بعد النفي، فالإتيان بها مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم كما نفى عنهم الضلال وغيره. وإن أفهمت هذا فلا أدخل في النفي منها، وقد عرف بهذا جواب المسألة السادسة عشرة وهي أن لا إنما يعطف بها في النفي.
فصل: معنى الهداية
وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ فاعلم أن أنواع الهداية أربعة:
أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى: { الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى }، [78] أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال وهذب هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره وهداية الجماد المسخر لما خلق له فله هداية تليق به. كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها، وكذلك كل عضو له هداية تليق به. فهدى الرجلين للمشي واليدين للبطش والعمل واللسان للكلام والأذن للاستماع والعين لكشف المرئيات، وكل عضو لما خلق له وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد، وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه ومراتب هدايته سبحانه لا يحصيها إلا هو، فتبارك الله رب العالمين.
وهدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومن الأبنية، ثم تسلك سبل ربها مذللة لها لا تستعصي عليها، ثم تأوي إلى بيوتها وهداها إلى طاعة يعسوبها وأتباعه والائتمام به أين توجه بها، ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة البناء.
ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر وأول وهلة، وأحسن طريق وأخصرها وأبعدها من كل شبهة، فإن من لم يهمل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة، بل هداها إلى هذه التي تعجز عقول العقلاء عنها كيف يليق به أن يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من خلقه مهملًا، وسدى معطلًا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته. بل يتركه معطلًا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه، وهل هذا إلا مناف لحكمته ونسبته له. مما لا يليق بجلاله. ولهذا أنكر ذلك على من زعمه، ونزه نفسه عنه، وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه، وأنه يتعالى عنه فقال تعالى: { أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق }، [79] فنزه نفسه عن هذا الحسبان فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة والعقول المستقيمة وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل، وإنه مما تظاهر عليه العقل والشرع. كما هو أصح الطريقين في ذلك ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى: { وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون }، [80] بقوله: { وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون }، [81] وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة، وإن من لم يهمل أمر كل دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه. بل جعلها أممًا وهداها إلى غاياتها ومصالحها، كيف لا يهديكم إلى كمالكم ومصالحكم. فهذه أحد أنواع الهداية وأعمها.
النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر، وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا ينبغي الهدى معها كقوله تعالى: { وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى }، [82] أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }. [83]
النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للإهتداء. فلا يتخلف عنها وهي المذكورة في قوله: { يضل من يشاء ويهدي من يشاء }، [84] وفي قوله: { إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل }، [85] وفي قول النبي ﷺ: «من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له»، وفي قوله تعالى: { إنك لا تهدي من أحببت }، [86] فنفى عنه هذه الهداية وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم }. [87]
النوع الرابع: غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما قال تعالى: { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم }، [88] وقال أهل الجنة فيها: { الحمد لله الذي هدانا }، [89] لهذا. وقال تعالى عن أهل النار: { احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون * من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم }. [90]
إذا عرف هذا فالهداية المسؤولة في قوله الصراط المستقيم، إنما تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام.
فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان وهو حاصل له، وكذلك الإلهام والتوفيق؟
قيل هذه هي المسألة الثامنة عشرة. وقد أجاب عنها من أجاب بأن المراد التثبت ودوام الهداية. ولقد أجاب وما أجاب! وذكر فرعًا لا قوام له بدون أصله، وثمرة لا وجود لها بدون حاملها. ونحن نبين بحمد الله أن الأمر فوق ما أجاب به، وأعظم من ذلك بحول الله.
فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة أمور وهو محتاج إليها حاجة لا غنى له عنها:
الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبًا للرب تعالى مرضيًا له، فيؤثره، وكونه مغضوبًا له مسخوطًا عليه فيجتنبه، فإن نقص من هذا العلم والمعرفة شيء نقص من الهداية التامة بحسبه.
الأمر الثاني: أن يكون مريد الجميع ما يحب الله منه أن يفعله عازمًا عليه ومريدًا لترك جميع ما نهى الله. عازمًا على تركه بعد خطوره بالبال مفصلًا، وعازمًا على تركه من حيث الجملة مجملًا. فإن نقص من إرادته لذلك شيء نقص من الهدى التام بحسب ما نقص من الإرادة.
الأمر الثالث: أن يكون قائمًا به فعلًا وتركًا. فإن نقص من فعله شيء نقص من هداه بحسبه.
فهذه ثلاثة هي أصول في الهداية ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها:
أحدها: أمور هدي إليها جملة، ولم يهتد إلى تفاصيلها فهو محتاج إلى هداية التفصيل فيها.
الثاني: أمور هدي إليها من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها لتكمل له هدايتها.
الثالث: الأمور التي هدى إليها تفصيلًا من جميع وجوهها فهو محتاج إلى الاستمرار إلى الهداية والدوام عليها.
فهذه ستة أصول تتعلق بما يعزم على فعله وتركه ويتعلق بالماضي أمر سابع وهو أمور وقعت منه على غير جهة الاستقامة فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها، وتبديلها بغيرها، وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسأل الهداية وهي موجودة له، ثم يجاب عن ذلك، بأن المراد التثبييت والدوام عليها، إذا كانت هذه المراتب الست حاصلة له بالفعل فحينئذ يكون سؤاله الهداية سؤال تثبيت ودوام، فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمه وما لا يريده من رشده أكثر مما يريده، ولا سبيل له إلى فعله إلا بأن يخلق الله فاعلية فيه، فالمسؤول هو أصل الهداية على الدوام تعليمًا وتوفيقًا وخلقًا للإرادة فيه وإقدارًا له وخلقًا للفاعلية وتثبيتًا له على ذلك، فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية أصلها وتفصيلها علمًا وعملًا والتثبيت عليها والدوام إلى الممات.
وسر ذلك أن العبد مفتقر إلى الهداية في كل نفس في جميع ما يأتيه ويذره أصلًا وتفصيلًا وتثبيتًا، ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى على الدوام، فليس له أنفع ولا هو إلى شيء أحوج من سؤال الهداية. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يثبت قلوبنا على دينه.
فصل: الإتيان بالضمير في قوله اهدنا
وأما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير في قوله: { اهدنا الصراط } ضمير جمع. فقد قال بعض الناس في جوابه: أن كل عضو من أعضاء العبد، وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به. فأتى بصيغة الجمع تنزيلًا، لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه. وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فاستركه واستضعفه جدًا، وهو كما قال: فإن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه، وعضو من أعضائه، والقائل إذا قال: اغفر لي وارحمني واجبرني واصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه فلا يحتاج أن يستشعرلكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظة.
فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم. فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته فأتى به بصيغة ضمير الجمع، أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك. فيكون هذا أحسن وأعظم موقعًا عند الملك من أن يقول: أنا عبدك ومملوكك ولهذا، لو قال: أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدًا، وأنا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك الاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. فتأمله، وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } [91] ونحو دعاء آخر البقرة. وآخر آل عمران وأولها وهو أكثر أدعية القرآن.
فصل: ما هو الصراط المستقيم
وأما المسألة العشرون، وهي ما هو الصراط المستقيم؟
فتذكر فيه قولًا وجيزًا. فإن الناس قد تنوعت عباراتهم فيه وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلًا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه. بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا وهو إفراده بالعبودية، وإفراد رسوله بالطاعة. فلا يشرك به أحدًا في عبوديته، ولا يشرك برسوله أحدًا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول.
وهذا معنى قول بعض العارفين إن السعادة والفلاح كله مجموع في شيئين صدق محبته وحسن معاملته. وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فأي شيء فسر به الصراط فهو داخل في هذين الأصلين. ونكتة ذلك وعقده أن تحبه بقلبك كله وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور بحبه، ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. والأول يحصل بالتحقيق بشهادة أن لا إله إلا الله. والثاني يحصل بالتحقيق بشهادة أن محمدًا رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق. والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به.
فقل ما شئت من العبارات التي هذا أحسنها وقطب رحاها. وهي معنى قول من قال: علوم وأعمال ظاهرة وباطنة مستفادة من مشكاة النبوة، ومعنى قول من قال متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا وعملًا ومعنى قول من قال: الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على أمره. وأما ما عدا هذا من الأقوال كقول من قال: الصلوات الخمس. وقول من قال: حب أبي بكر وعمر، وقول من قال: هو أركان الإسلام الخمس التي بني عليها فكل هذه الأقوال تمثيل وتنويع لا تفسير مطابق له. بل هي جزء من أجزائه وحقيقته الجامعة ما تقدم. والله أعلم.
فائدة: بدل البعض وبدل المصدر
في بدل البعض من الكل وبدل المصدر من الاسم وهما جميعًا يرجعان في المعنى والتحصيل إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة، إلا أن البدل في هذين الموضعين لا بد من إضافته إلى ضمير المبدل منه بخلاف بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة.
أما اتفاقهما في المعنى فإنك إذا قلت: رأيت القوم أكثرهم أو نصفهم، فإنما تكلمت بالعموم وأنت تريد الخصوص وهو كثير شائع فأردت بعض القوم وجعلت أكثرهم أو نصفهم تبيينًا لذلك البعض وأضفته إلى ضمير القوم، كما كان الاسم المبدل مضافًا إلى القوم فقد آل الكلام إلى أنك أبدلت شيئًا من شيء وهما لعين واحدة. وكذلك بدل المصدر من الاسم لأن الاسم من حيث كان جوهرًا لا يتعلق به المدح والذم والإعجاب والحب والبغض، إنما متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة به. فإذا قلت: نفعني عبد الله علمه دل أن الذي نفعك منه صفة وفعل من أفعاله، ثم بينت ذلك الوصف فقلت علمه أو إرشاده أو رويته. فأضفت ذلك إلى ضمير الاسم كما كان الاسم المبدل منه مضافًا إليه في المعنى. فصار التقدير نفعني صفة زيد أو خصلة من خصاله، ثم بينتها بقولك علمه أو إحسانه أو لقاؤه فآل المعنى إلى بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة.
وإذا تقرر هذا فلا يصح في بدل الاشتمال أن يكون الثاني جوهرًا، لأنه لا يبدل جوهر من عرض، ولا بد من إضافته إلى ضمير الاسم، لأنه بيان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم في التقدير والعجب من الفارسي يقول في قوله تعالى: { النار ذات الوقود } [92] إنها بدل من الأخدود بدل اشتمال والنار جوهر قائم بنفسه، ثم ليست مضافة إلى ضمير الأخدود وليس فيها شرط من شرانط الاشتمال، وذهل أبو علي عن هذا وترك ما هو أصح في المعنى وأليق بصناعة النحو، وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فكأنه قيل: أصحاب الأخدود أخدود النار ذات الوقود فيكون من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة كما قال الشاعر: * رضيعَي لِبان ثديِ أُمٍّ تحالفا * على رواية الجر في ثدي أم، أراد لبان ثدي فحذف المضاف.
فائدة بديعة: ولله على الناس حج البيت
قوله تعالى: { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا }. [93] حج البيت مبتدأ وخبره في أحد المجرورين قبله والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله عى الناس، لأنه وجوب، والوجوب يقتضي على ويجوز أن يكون في قوله ولله، لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق، ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير وكان الأحق أن يكون ولله ويرجع الوجه الأول بأن يقال قوله: { على الناس حج البيت أكثر استعمالًا في باب الوجوب من أن يقال: حج البيت لله أي حق واجب لله، فتأمله.
وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول، وليس بخبر، فائدتان:
إحداهما: أنه اسم للموجب للحج فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب. فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع. أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدىء بذكره. والثاني: مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس. والثالث: النسبة والحق المتعلق به إيجابًا وبهم وجوبًا وأداء وهو الحج.
والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان لله اسمًا سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي أوجبه وتخويفًا من تضييعه. إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة ما أوجبه غيره.
وأما قوله من فهي بدل. وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل المصدر كأنه قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلًا. وهذا القول يضعف من وجوه:
منها أن الحج فرض عين ولو كان معنى الآية ما ذكروه لأفهم فرض الكفاية، لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم، لأن المعنى يؤول إلي ولله على الناس أن يحج البيت مستطيعهم. فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبًا على غير المستطيعين، وليس الأمر كذلك، بل الحج فرض عين على كل أحد حج المستطيعون أو قعدوا، ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه عن أداء الواجب فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه. فإذا حج أسقط الفرض عن نفسه، وليس حج المستطيعين بمسقط للفرض عن العاجزين.
وإن أردت زيادة إيضاح فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعة للجهاد. فإذا جاهدت تلك الطائفة انقطع تعلق الوجوب عن غيرهم.
وإذا قلت: واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم المستطيع كان الوجوب متعلقًا بالجميع، وعذر العاجز بعجزه. ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين. هذه النكتة البديعة فتأملها.
الوجه الثاني أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إصافته إلى المفعول ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول، فلو كان من هو الفاعل لأضيف المصدر إليه، وكان يقال: ولله على الناس حج من استطاع. وحمله على باب يعجبني ضرب زيدًا عمرو. مما يفصل به بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول، والظرف حمل على المكثور المرجوح وهي قراءة ابن عامر قتل أولادهم بفتح الدال شركائهم فلا يصار إليه.
وإذا ثبت أن من بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى الناس، كأنه قيل: من استطاع منهم وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن وحسنه ههنا أمور:
منها أن من واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منه فارتبطت به.
ومنها أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد. ومثال ذلك. إذا قلت رأيت اخوتك من ذهب إلى السوق، تريد من ذهب منهم لكان قبيحًا، لأن الذاهب إلى السوق أعم من الاخوة، وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل، تريد منها ولم تذكر الضمير لكان أبعد في الجواز، لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب وباب بدل البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه. فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول ارتفع العموم وبقي الخصوص.
ومما حسن حذف الضمير في هذه الآية أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول.
وأما المجرور من قوله إليه فيحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون في موضع حال من سبيل كأنه نعت نكرة قدم عليها، لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل.
والثاني: أن يكون متعلقًا بسبيل.
فإن قيل: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟
قيل: السبيل كان ههنا عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهما كان فيه رائحة الفعل ولم يقصد به السبيل الذي هو الطريق فصلح تعلق المجرور به، واقتضى حسن النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور، وإن كان موضعه التأخير، لأنه ضمير يعود على البيت. والبيت هو المقصود به الاعتناء. وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم وببيانه أعنى.
هذا تعبير السهيلي وهو بعيد جدًا. بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وجه آخر أحسن من هذين ولا يليق بالآية سواه وهو الوجوب المفهوم من قوله على الناس، أي يجب على الناس الحج، فهو حق واجب، وأما تعليقه بالسبيل أو جعله حالًا منها ففي غاية البعد فتأمله، ولا يكاد يخطر بالبال من الآية. وهذا كما يقول لله: عليك الحج ولله عليك الصلاة والزكاة.
ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويجرمه، يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثر أو بلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو: { كتب عليكم الصيام }، [94] { حرمت عليكم الميتة }، [95] { قل تعالوا أتل ما حرم ربكم }، [96] وفي الحج أتى بهذا النظم الدال على تأكد الوجوب من عشرة أوجه:
أحدها: أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والاختصاص، ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على، ثم أبدل منه أهل الاستطاعة، ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانا بأنه يجب الحج على أي سبيل تيسرت من قوت أو مال، فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلًا، ثم اتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: ومن كفر أي بعدم التزام هذا الواجب وتركه، ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره باستغنائه عنه والله تعالى هو الغني الحميد، ولا حاجة به إلى حج أحد، وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو من أعظم التهديد وأبلغه، ثم أكد ذلك بذكر اسم العالمين عمومًا ولم يقل فإن الله غني عنه، لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين كلهم فله الغنى الكامل التام من كل وجه عن كل أحد بكل اعتبار، وكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. ثم أكد هذا المعنى بأداة إن الدالة على التوكيد.
فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين. مرة بإسناده إلى عموم الناس. ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين. وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرار الإسناد. ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته.
ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال، وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناءً به وتأكيدًا لشأنه. ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجه وإن لم يطلب ذلك منها فقال: { إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدىً للعالمين * فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا }. [97] فوصفه بخمس صفات:
أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض.
الثاني: أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرًا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق.
الثالث: أنه هدى ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو نفس الهدى.
الرابع: ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية.
الخامس: الأمن الحاصل لداخله.
وفي وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار، ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات، وهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم، والتنويه بذكره، والتعظيم لشأنه والرفعة من قدره. ولو لم يكن له شرف إلا ضافته إياه إلى نفسه بقوله: { وطهر بيتي للطائفين } [98] لكفى بهذه الإضافة فضلًا وشرفًا. وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه، وسلبت نفوسهم حبًا له وشوقًا إلى رؤيته فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه، ولا يقضون منه وطرًا أبدًا كلما ازدادوا له زيادة، ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقًا، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، كما قيل:
أطوف به والنفس بعد مشوقة ** إليه وهل بعد الطواف تداني
وألثم منه الركن أطلب برد ما ** بقلبي من شوق ومن هيمان
فوالله ما أزداد إلا صَبابة ** ولا القلب إلا كثرة الخفقان
فيا جنة المأوى وياغاية المنى ** ويا مُنيتي من دون كل أمان
أبَتْ غلبات الشوق إلا تقربًا ** إليك فما لي بالبعاد يدان
وما كل صَدّي عنك صد ملالة ** ولي شاهد من مقلتي ولساني
دعوتُ اصطباري عنك بعدك والبُكا ** فلبى البكا والصبر عنك عصاني
وقد زعموا أن المحب إذا نأى ** سيَبلى هواه بعد طول زمان
ولو كان هذا الزعم حقًا لكان ذا ** دواء الهوى في الناس كل أوان
بل إنه يبلى التصبر والهوى ** على حاله لم يُبله المَلَوان
وهذا محب قاده الشوق والهوى ** بغير زمامٍ قائدٍ وعنان
أتاك على بُعد المزار ولو وَنَت ** مطيته جاءت به القدمان
فائدة بديعة: يسألونك عن الشهر الحرام
قوله تعالى: { يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه } [99] من باب بدل الاشتمال، والسؤال إنما وقع عن القتال فيه فلم قدم الشهر وقد قلتم إنهم يقدمون ما هم ببيانه أهمّ وهم به أعنى؟
قيل السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر، وتشنيع أعدائهم عليهم، وانتهاك حرمته، فكان اعتناؤهم واهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال. فالسؤال إنما وقع من أجل حرمة الشهر. فلذلك قدم في الذكر وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من القاعدة.
فإن قيل: فما الفائدة في إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر وهلا اكتفى بضميره، فقال: قل هو كبير، وأنت إذا قلت: سألته عن زيد أهو في الدار كان، أوجز من أن تقول أزيد في الدار؟
قيل: في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة وهي تعلق الحكم الخبري باسم القتال فيه عمومًا. ولو أتى بالمضمر. وقال: هو كبير لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه. وليس الأمر كذلك، وإنما هو عام في كل قتال وقع في شهر حرام.
ونظير هذه الفائدة قوله ﷺ: وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». [100] فأعاد لفظ الماء ولم يقتصر على قوله نعم توضؤوا به، لئلا يتوهم اختصاص الحكم بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص. فعدل عن قوله نعم توضؤوا إلى جواب عام يقتضي تعلق الحكم والطهورية بنفس مائه من حيث هو، فأفاد استمرار الحكم على الدوام وتعلقه بعموم الآية، وبطل توهم قصره على السبب. فتأمله فإنه بديع.
فكذلك في الآية لما قال قتال فيه كبير فجعل الخبر بكبير واقعًا على قتال فيه فيطلق الحكم به على العموم، ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك.
وقريب من هذا قوله تعالى: { والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين }، [101] ولم يقل: أجرهم تعليقًا لهذا الحكم بالوصف وهو كونهم مصلحين، وليس في الضمير ما يدل على الوصف المذكور.
وقريب منه وهو ألطف معنى قوله تعالى: { يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض }، [102] ولم يقل فيه تعليقًا لحكم الاعتزال بنفس الحيض وأنه هو سبب الاعتزال. وقال تعالى: { قل هو أذى }، ولم يقل الحيض، لأن الآية جارية على الأصل، ولأنه لو كرره لثقل اللفظ لتكرره ثلاث مرات وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالإعتزال أحسن من ذكره مضمرًا ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضًا بخلاف قوله: { قل هو أذى } فإنه إخبار بالواقع، والمخاطبون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضًا بخلاف تعليق الحكم به. فإنه إنما يعلم بالشرع فتأمله.
فائدة: مجيء الحال من المضاف إليه
إنما امتنع مجيء الحال من المضاف إليه، لأن الحال شبه الظرف والمفعول. فلا بد لها من عامل ومعنى الإضافة أضعف من لامها. ولامها لا تعمل في ظرف ولو مفعول. فمعناها أولى بعدم العمل.
فإن قلت: فاجعل العامل فيها هو العامل في المضاف.
قلت: هو محال لا يجب اتحاد العامل في الحال وصاحبها، فلو كان العامل فيها هو العامل في المضاف لكانت حالًا منه دون المضاف إليه فتستحيل المسألة. فإما إذا كان المضاف فيه معنى الفعل نحو قولك: هذا ضارب هند قائمة، وأعجبني خروجها راكبة، جاز انتصاب الحال من المضاف إليه، لأن ما في المضاف من معنى الفعل واقع على المضاف إليه وعامل فيما هو حال منه وعلى هذا جاء قوله تعالى: { قال النار مثواكم خالدين فيها }، [103] وقوله: { أولئك أصحاب النار خالدين فيها } [104] فإن ما في مثوى وأصحاب من معنى الفعل يصحح عمله في الحال بخلاف قولك: رأيت غلام هند راكبة فإنه ليس في الغلام شيء من رائحة الفعل. وقد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه، إذا كان المضاف جزءه أو منزلًا منزلة جزءه نحو رأيت وجه هند قائمة، لأن البعض يجري عليه حكم الكل في اقتضاء العامل له. فجاز أن يعمل في الحال ما يعمل في بعض صاحبها لتنزله منزلته. وسريان حكم البعض إلى الكل لا ينكر لا لغة ولا شرعًا ولا عقلًا. فاللغة نحو هذا ونحو قوله: ذهبت بعض أصابعه وسرقت صدر القناة وتواصفت سور المدينة وهو كثير. وأما الشرع فكسريان العتق في الشقص المشترك. وأما العقل فإن الارتباط الذي بين الجزء والكل يقتضي أن يثبت لأحدهما ما يثبت للآخر وعلى هذا جاء قول الشاعر: * كان حواء منه مدبرًا * وقول حبيب: * والعلم في شهب الأرماح لامعة *
فائدة بديعة: إضمار الناصب
إن قيل كيف يضمرون الناصب في مثل: * للبسُ عباءة وتقرَّ عيني * وبابه، ولا يجوزون إضمار الخافض ولا الجازم، ولا إضمار نواصب الأسماء، وعواملُ الأسماء عندكم أقوى من عوامل الأفعال؟
قيل: نحن لا نجيز إضمار أن الناصبة إلا بإحدى شرائط إما مع الواو العاطفة على مصدر نحو: * تقضي لُبانات ويسأم سائمُ * و * لبس عباءة وتقر عيني * ألا ترى أنك لو جعلت مكان اللبس والتقضي اسمًا غير مصدر فقلت: يعجبني زيد ويذهب عمرو لم يجز، وإنما جاز هذا مع المصدر لأن الفعل المنصوب بأنه مشتق من المصدر ودال عليه بلفظه فكأنك عطفت مصدرًا على مصدر.
فإن قيل: فكان ينبغي أن يستغني بمجرد لفظ الفعل عن ذكر المصدر وإضمار أن فقال: ألبس عباءة وتقر عيني وأقضي لبانات ويسأم سائم؟
قيل: هذا سؤال حسن يستدعي جوابًا قويًا، وقد أجيب عنه بأن الأول لو جعل فعلًا مضارعًا لكان مرفوعًا. فإذا عطفت عليه الثاني شاركه في إعرابه وعامله. ورافع المضارع ضعيف لا يقوى على العمل في الفعلين. فإن العامل في المعطوف والمعطوف عليه واحد ولا يخفى فساد هذا الجواب فإنه منتقض بالطم والرم مما يعطف فيه المضارع على مثله كقوله: زيد يذهب ويركب، وإنما يذهب ويخرج زيد وأمثال ذلك.
فالجواب الصحيح أن يقال: المراد ما في المصدر من الدلالة على ثبوت نفس الحدث، وتعليق الحكم به دون تقييده بزمان دون زمان فلو أتى بالفعل المقيد بالزمان لفات الغرض. ألا ترى أن قولها بولبس عباءة وتقر عيني. المراد به حصول نفس اللبس مع كونها تقر عينها كل وقت شيئًا بعد شيء. فقرة العين مطلوب تجددها بحسب تجدد الأوقات وليس هذا مرادًا في لبس العباءة. وكذا قولك: آكل الشعير وأكف وجهي عن الناس أحب إلي من أكل البر وأبذل وجهي لهم. أفلا ترى تفضيل أكل الشعير على أكل البر ويدوم له كف وجهه عن الناس، كما أن تلك فضلت لبس العباءة على لبس الشفوف وتدوم لها قرة العين. فعلمت أن المقصود ماهية المصدر وحقيقته لا تقييده بزمان دون زمان. ولما كانت أن والفعل تقع موقع المصدر ويؤولان به في الإخبار عنهما كما يخبر عن الاسم نحو قوله: { وأن تصوموا خير لكم }، [105] أي صيامكم أول المصدر بأن والفعل في صحة عطف الفعل عليه وهذا من باب المقابلة والموازنة وقد جاء عطف الفعل على الاسم إذا كان فيه معنى الفعل نحو صافات ويقبضن. وإن المصدقين والمصدقات واقرضوا الله. ومنه وجيهًا ومن المقربين ويكلم الناس في المهد، لأن الاسم المعطوف عليه لما كان حاملًا للضمير صار بمنزلة الفعل ولو كان مصدرًا لم يجز عطف الفعل عليه إلا بإضمار أن، لأن المصادر لا تتحمل الضمائر.
فإن قيل: فلم جاز عطف الفعل على الاسم الحامل للضمير، ولم يعطف الاسم على الفعل. فتقول: مررت برجل يقعد وقائم، كما تقول: قائم ويقعد.
قيل: هذا سؤال قوي ولما رأى بعض النحاة أنه لا فرق بينهما أجاز ذلك وهو الزجاج فإنه أجازه في معاني القرآن والصحيح أنه قبيح. والفرق بينهما أنك إذا عطفت الفعل على الاسم المشتق منه رددت الفرع إلى الأصل، لأن الاسم أصل الفعل، والفعل متفرع عنه فجاز عطف الفعل عليه، لأنه ثان والثواني فروع على الأوائل. وإذا عطفت الاسم على الفعل كنت قد رددت الأصل فرعًا وجعلته ثانيًا وهو أحق بأن يكون مقدما لأصالته.
وسر المسألة: أن عطف الفعل على الاسم في مثل قوله: { صافات ويقبضن } ومررت برجل قائم، وبقعد أن الاسم معتمد على ما قبله. وإذا كان اسم الفاعل معتمدًا عمل عمل الفعل وجرى مجراه والاعتماد أن يكون نعتًا أو خبرًا، أو حالًا، والذي بعد الواو ليس بمعتمد بل هو اسم محض فيجري مجرى الفعل.
فائدة: مصدر الفعل اللازم
لما كان الفعل اللازم هو الذي لزم فاعله ولم يجاوزه إلى غيره، جاء مصدره مثقلًا بالحركات. إذ المثقل من صفة ما لزم محله، ولم ينتقل عنه إلى غيره. والخفة من صفة المنتقل من محله إلى غيره، فكان خفة اللفظ في هذا الباب وثقله موازنًا للمعنى فما لزم مكانه ومحله فهو الثقيل لفظًا ومعنى، وما جاوزه وتعداه فهو الخفيف لفظًا ومعنى.
ومن ههنا يرجح قول سيبويه: إن دخلت الدار غير متعد، لأن مصدره دخول فهو كالخروج والقعود وبابه، إلا أن الفعل منه لم يجىء على فعل، لأنه ليس بطبع في الفاعل ولا خصلة ثابتة فيه، فإن كان الفعل عبارة عما هو طبع وخصلة ثابتة نقلوه بضم العين كظرف وكرم، فهذا الباب ألزم للفاعل من باب قعد ودخل فكان أثقل منه لفظًا وباب قعد وخرج ألزم للفاعل من الفعل المتعدي كضرب. فكان أثقل منه مصدرًا، وإن اتفقا في لفظ الفعل.
ولزم مصدر فعل الذي هو طبع وخصلة وزن الفعال، كالجمال والكمال والبهاء والسناء والجلال والعلاء، هذا إذا كان المعنى عاملًا مشتملًا على خصال لا تختص بخصلة واحدة، فإن اختص المعنى بخصلة واحدة صار كالمحدود ولزمته تاء التأنيث، لأنها تدل على نهاية ما دخلت عليه كالضربة من الضرب، وحذفها في هذا الباب وفي أكثر الأبواب. يدل على انتفاء النهاية. ألا ترى أن الضرب يقع على القليل والكثير إلى غير نهاية، وإنما استحقت التاء ذلك لأن مخرجها منتهى الصوت وغايته فصلحت للغايات، ولذلك قالوا: علامة ونسابة أي غاية في هذا الوصف، فإذا عرفت هذا. فالجمال والكمال كالجنس العام من حيث لم تكن فيه التاء المخصوصة بالتحديد والنهاية، وقولك: ملح ملاحة وفصح فصاحة هو على وزنه إلا في التاء، لأن الفصاحة خصلة من خصال الكمال، وكذلك الملاحة فحددت بالتاء، لأنها ليست بجنس عام كالكمال والجمال فصارت كباب الضربة والثمرة من الضرب والثمر، ألا ترى إلى قول خالد بن صفوان، وقد قالت له امرأته: إنك لجميل، فقال: أتقولين ذلك وليس عندي عمود الجمال ولا رداؤه ولا برنسه: ولكن قولي إنك لمليح ظريف، فجعل الملاحة خصلة من خصال الجمال، فبان صحة ما قلناه.
وعلى هذا قالوا: الحلاوة والأصالة والرجاحة والرزانة والمهابة، وفي ضد ذلك السفاهة والوضاعة والحماقة والرذالة، لأنها كلها خصال محدودة بالإضافة إلى السفال الذي هو في مقابلة العلاء والكمال، لأنه جنس يجمع الأنواع التي تحته، وهذا هو الأصل في هذا الباب، فمتى شذ عنه منه شيء. فلمانع وحكمة أخرى كقولهم: شرف الرجل شرفًا، ولم يقولوا: شرافًا لأن الشرف رفعة في آبائه وهو شيء خارج عنه بخلاف كمل كمالًا، وجمل جمالًا، فإن جماله وكماله وصف قائم به وهذا، لأن شرف مستعار من شرف الأرض وهو ما ارتفع منها فاستعير للرجل الرفيع في قومه كأن آباءه الذين ذكر بهم وارتفع بسببهم شرف له.
وكذلك قولهم في هذا الباب الحسب، لأنه من باب القبص والنقص والقنص لا من باب المصادر لأن الحسب ما يحسبه الإنسان ويعده لنفسه من الخصال الحميدة والأخلاق الشريفة. واستحق الاسم الشامل في هذا الباب اسم الفعال بفتح الفاء والعين وبعدهما ألف وهي فتح ليكون اللفظ الذي يتوالى فيه الفتح موازنًا لانفتاح المعنى واتساعه، ولذلك اطرد في الجمع الكثير نحو مفاعل وفعايل وبابه واطرد في باب تفاعل نحو تقاتل وتخاصم وتمارض وتغافل وتناوم، لأنه إظهار الأمر ونشر له.
ومن هذا الباب حلم فإنه يوافقه في وجه ويخالفه في وجه، لأنه يدل على إثبات الصفة، فوافق شرف وكرم في الضم وخالفه في المصدر لمخالفته له في المعنى، لأنه صفة تقتضي كف النفس وجمعها عن الانتقام والمعاقبة، ولا يقتضي انفتاحًا ولا انتشًارا فقالوا: حلم لأنه من بناء الخصال والطبائع. وقالوا: حلماء، لأن الصفة صفة جمع النفس وضمها وعدم إرسالها في الانتقام فتأمله. ومن هذا الباب كبر وصغر موافق لما قبله في الفعل مخالف له في المصدر، لأن الكبر والصغر عبارة عن اجتماع أجزاء الحمم في قلة أو كثرة، وليس من الصفات والأحداث المنتشرة. وهذا تنبيه لطيف على ما هو أضعاف ذلك.
فائدة: فعل المطاوعة
فعل المطاوعة هو الواقع مسببًا عن سبب اقتضاه نحو كسرته فانكسر. فزيدت النون في أوله قبل الحروف الأصلية ساكنة كيلا يتوالى الحركات، ثم وصل إليها بهمزة الوصل. وقد تقدم أن الزوائد في الأفعال والأسماء موازنة للمعاني الزائدة على معنى الكلمة. فإن كان المعنى الزائد مترتبًا قبل المعنى الأصلي كانت الحروف الزائدة قبل الحروف الأصلية كالنون في الفعل، وكحروف المضارعة في بابها، وإن كان المعنى الزائد في الكلمة آخرًا كان الحرف الزائد على الحروف الأصلية آخرًا، كعلامة التأنيث وعلامة التثنية الجمع.
ومن هذا الباب تفعلل وتفاعل. وأما تفعل فلا يتعدى البتة، لأن التاء فيه بمثابة النون في الفعل إلا أنهم خصوا الرباعي بالتاء وخصوا الثلاثي بالنون فرقًا بينهما ولم تكن التاء هنا ساكنة كالنون لسكون عين الفعل. فلم يلزم منها من توالي الحركات ما لزم هناك.
وأما تفاعل فقد توجد متعدية لأنها لا يراد بها المطاوعة كما أريد بتفعلل، وإنما هو فعل دخلته التاء زيادة على فاعل المتعدي فصار حكمه إن كان متعديًا إلى مفعولين قبل دخول التاء، أن يتعدى بعد دخول التاء إلى مفعول نحو نازعت زيدًا الحديث، ثم تقول، وتنازعنا الحديث، وإن كان متعديًا إلى مفعول لم يتعد بعد دخول التاء إلى شيء نحو خاصمت زيدًا وتخاصمنا.
وهذا عكس دخول همزة التعدية على الفعل فإنها تزيده واحدًا أبدًا، وإن كان لازمًا صيرته متعديًا إلى مفعول، وإن كان متعديًا إلى واحد صيرته متعديًا إلى اثنين، وأما أحمر واحمار ففعل مشتق من الاسم كانتعل من النعل، وتمسكن من المسكن، وتمدرع وتمندل وتمنطق.
وزعم الخطابي أن معنى أحمر مخالف لمعنى احمار وبابه، وذهب إلى أن أفعل يقال فيما لم يخالطه لون آخر وأفعال. يقال لما خالطه لون آخر وهو ثقة في نقله والقياس يقتضي ما ذكر، لأن الألف لم يزد في إضاف حروف الكلمة إلا لدخول معنى زائد بين إضعاف معناها، والذي قاله غيره أحسن من هذا وهو أن أحمر يقال لما أحمر وهلة نحو أحمر الثوب ونحوه.
وأما احمارَّ فيقال لما يبدو فيه اللون شيئًا بعد شيء على التدريح نحو احمار البسر واصفار، ويدخل أفعل في هذا على أفعال. فيقال: احمر البسر، إذا تكامل لون الحمرة فيه واحمار، إذا ابتدأ صاعدًا إلى كماله.
فائدة: المتعدي إلى مفعولين
اختلفوا في المتعدي إلى مفعولين من باب كسى هل هو قياسي بالهمزة أم سماعي؟ والثاني قول سيبويه وهو الصحيح، فإنك لا تقول: آكلت زيدًا الخبز، ولا آخذته الدراهم، ولا أطلقت زيدًا امرأته وأعتقته عبده، ولكن ينبغي التفطن لضابط حسن وهو أنه ينظر إلى كل فعل منه في الفاعل صفة ما، فهو الذي يجوز فيه النقل، لأنك إذا قلت: أفعلته فإنما تعني جعلته على هذه الصفة، وقلما ينكسر هذا الأصل في غير المتعدي إذا كان ثلاثيًا. نحو قعد وأقعدته، وطال وأطلته.
وأما المتعدي فمنه ما يحصل للفاعل منه صفة في نفسه، ولا يكون اعتماده في الثاني على المفعول فيجوز نقله مثل طعم زيد الخبز وأطعمته، وكذلك جرع الماء وأجرعته، وكذلك بلع وشم وسمع وذلك، لأنها كلها تجعل في الفاعل منها صفة في نفسه غير خارجة عنه، ولذلك جاءت أو أكثرها على فعل بكسر العين مشابهة لباب فزع وحذر وحزن ومرض إلى غير ذلك مما له أثر في باطن الفاعل وغموض معنى. ولذلك كانت حركة العين كسرة، لأن الكسرة خفض للصوت وإخفاء له فشاكل اللفظ المعنى. ومن هذا الباب لبس الثوب وألبسته إياه، لأن الفعل وإن كان متعديًا فحاصل معناه في نفس الفاعل كأنه لم يفعل بالثوب شيئًا، وإنما فعل بلابسه. ولذلك جاء على فعل مقابلة عرى وقالوا: كسوته الثوب ولم يقولوا: أكسيته إياه وإن كان اللازم منه كسى. ومنه: * واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي * فهذا من كسى يكسي لا من كسا يكسو. وسر ذلك أن الكسوة ستر للعورة فجاء على وزن سترته وحجبته، فعدوه بتغيير الحركة لا بزيادة الهمزة.
وأما أكل وأخذ وضرب فلا ينقل، لأن الفعل واقع بالمفعول ظاهر أثره فيه غير حاصل في الفاعل منه صفة، فلا تقول: أضربت زيدًا عمرًا وأقتلته خالدًا، لأنك لم تجعله على صفة في نفسك كما تقدم.
وأما أعطيته فمنقول من عطا يعطو إذا أشار للتناول وليس معناه الأخذ والتناول. ألا تراهم يقولون: عاط بغير أنواط، أي يشير إلى التناول من غير شيء فنفوا أن يكون وقع هذا الفعل لشيء. فلذلك نقل كما نقل المتعدي لقربه منه فقالوا: أعطيته أي جعلته عاطيًا.
وأما أنلت من نال المتعدية وهي بمنزلة عطا يعطو لا تنبىء إلا عن وصول إلى المفعول دون تأثير فيه ولا وقوع ظاهر به، ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى: { لن ينال الله لحومها }، [106] ولو كان فعلًا مؤثرًا في مفعوله لم يجز هذا، إنما هو شيء منبىء عن الوصول فقط، أو ما أتيت المال زيدًا، فمنقول من أتى، لأنها غير مؤثرة في المفعول وقد حصل منها في الفاعل صفة.
فإن قيل: يلزمك أن تجيز أتيت زيدًا عمرًا أو المدينة أي جعلته يأتيها؟
قلت: بينهما فرق وهو أن ايتاء المال كسب وتمليك فلما اقترن به هذا المعنى صار كقوله أكسبته مالًا أو ملكته إياه وليس كقولك: آتي عمرًا.
وأما شرب زيد الماء فلم يقولوا فيه: أشربته الماء، لأنه بمثابة الأكل والأخذ ومعظم أثره في المفعول، وإن كان قد جاء على فعل كبلع، ولكنه ليس مثله إلا أن يريد أن الماء خالط أجزاء الشارب له وحصل من الشرب صفة من الشارب. فيجوز حينئذ نحو قوله تعالى: { وأشربوا في قلوبهم العجل }، [107] وعلى هذا يقال: أشربت الدهن الخبز، لأن شرب الخبز الدهن ليس كشرب زيد الماء فتأمله.
وأما ذكر زيد عمرًا فإن كان في ذكر اللسان لم ينقل، لأنه بمنزلة شتم ولطم وإن كان من ذكر القلب نقل فقلت أذكرته الحديث بمنزلة أفهته وأعلمته أي جعلته على هذه الصفة.
فائدة: اخترت يتعدى بحرف الجر
اخترت: أصله أن يتعدى بحرف الجر وهو من، لأنه يتضمن إخراج شيء من شيء. وجاء محذوفًا في قوله تعالى: { واختار موسى قومه }، [108] لتضمن الفعل معـنا فعل غير متعد كأنه نخل قومه وميزهم وسبرهم ونحو ذلك. فمن ههنا والله أعلم أسقط حرف الجر كما سقط من أمرتك الخير أي ألزمتك وكلفتك، لأن الأمر إلزام وتكليف. ومنه تمرون الديار أي تعدونها وتجاوزونها. ومنه رحبتك الديار أي وسعتك.
فائدة: تقديم المجرور وتأخير المفعول
الاختيار تقديم المجرور في باب اخترت وتأخير المفعول المجرد عن حرف الجر. فتقول: اخترت من الرجال زيدًا ويجوز فيه التأخير. فإذا أسقطت الحرف لم يحسن تأخير ما كان مجرورًا به في الأصل فيقبح أن تقول: اخترت زيدًا الرجال، واخترت عشرة الرجال أي من الرجال لما يوهم من كون المجرور في موضع النعت للعشرة، وإنه ليس في موضع المفعول الثاني، وأيضا فإن الرجال معرفة فهو أحق بالتقديم للاهتمام به كما لزم في تقديم المجرور الذي هو خبر عن النكرة من قولك: في الدار رجل لكون المجرور معرفة وكأنه المخبر عنه. فإذا حذفت حرف الجر لم يكن بد من التقديم للاسم الذي كان مجرورًا نحو اخترت الرجال عشرة.
والحكمة في ذلك أن المعنى الداعي الذي من أجله حذف حرف الجر هو معنى غير لفظ فم يقو على حذف حرف الجر إلا مع اتصاله به وقربه منه.
ووجه ثان وهو أن القليل الذي اختير من الكثير إذا كان مما يتبعض، ثم ولي الفعل الذي هو اخترت توهم أنه مختار منه أيضا لأن كل ما يتبعض يجوز فيه أن يختار منه وأن يختار، فألزموه التأخير وقدموا الاسم المختار منه وكان أولى بذلك لما سبق من القول. فإن كان مما لا يتبعض نحو زيد وعمرو، فربما جاز على قلة في الكلام نحو قوله: * ومنا الذي اختير الرجال سماحة * وليس هذا كقولك: اخترت فرسًا الخيل، لأن الفرس اسم جنس فقد يتبعض مثله ويختار منه وزيد من حيث كان جسمًا يتبعض، ومن حيث كان علمًا على شيء بعينه لا يتبعض فتأمل هذا الموضع.
فائدة بديعة: استغفر زيد ربه ذنبه
قولهم: استغفر زيد ربه ذنبه، فيه ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. والثاني: استغفره من ذنبه. والثالث: استغفره لذنبه وهذا موضع يحتاج إلى تدقيق نظر وأنه هل الأصل حرف الجر وسقوطه داخل عليه؟ أو الأصل سقوطه وتعديه بنفسه وتعديته بالحرف مضمن هذا مما ينبغي تحقيقه. فقال السهيلي: الأصل فيه سقوط حرف الجر. وأن يكون الذنب نفسه مفعولًا بأستغفر غير متعد بحرف الجر، لأنه من غفرت الشيء إذا غطيته وسترته مع أن الاسم الأول هو فاعل بالحقيقة وهو الغافر.
ثم أورد على نفسه سؤالًا فقال: فإن قيل: فإن كان سقوط حرف الجر هو الأصل فيلزمكم أن تكون من زائدة كما قال الكسائي. وقد قال سيبويه والزجاجي: أن الأصل حرف الجر، ثم حذف فنصب الفعل. وأجاب بأن سقوط حرف الجر أصل في الفعل المشتق منه نحو غفر. وأم استغفر ففي ضمن الكلام ما لا بد منه من حرف الجر، لأنك لا تطلب غفرًا مجردًا من معنى التوبة والخروج من الذنب، وإنما تريد بالاستغفار خروجًا من الذنب وتطهيرًا منه. فلزمت من في هذا الكلام لهذا المعنى فهي متعلقة بالمعنى لا بنفس اللفظ، فإن حذفتها تعدى الفعل فنصب وكان بمنزلة أمرتك الخير.
فإن قيل: فما قولكم في نحو قوله تعالى: { يغفر لكم من ذنوبكم } [109] و { نغفر لكم خطاياكم }؟ [110]
قلنا هي متعلقة بمعنى الإنقاذ والإخراج من الذنوب فدخلت منه لتؤذن بهذا المعنى، ولكن لا يكون ذلك في القرآن إلا حيث يذكر الفاعل والمفعول الذي هو الذنب نحو قوله: ( لكم ) لأنه المنقذ المخرج من الذنوب بالإيمان. ولو قلت: يغفر من ذنوبكم دون أن يذكر الاسم المجرور. لم يحسن إلا على معنى التبعيض، لأن الفعل الذي كان في ضمن الكلام وهو الإنقاذ قد ذهب بذهاب الاسم الذي هو واقع عليه.
فإن قلت: فقد قال تعالى: { وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا }، [111] وفي سورة الصف: { يغفر لكم ذنوبكم }، [112] فما الحكمة في سقوطها هنا وما الفرق؟
قلت: هذا إخبار عن المؤمنين الذين قد سبق لهم الإنقاذ من ذنوب الكفر بأيمانهم، ثم وعدوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في الإسلام من الذنوب وهي غير محبطة كإحباط الكفر المهلك للكافر فلم يتضمن الغفران معنى الاستنقاذ إذ ليس، ثم إحاطة من الذنب بالمذنب، وإنما يتضمن معنى الإذهاب والإبطال للذنوب، لأن الحسنات يذهبن السيئات بخلاف الآيتين المتقدمتين فإنهما خطاب للمشركين وأمر لهم بما ينقذهم ويخلصهم مما أحاط بهم من الذنوب وهو الكفر. ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة بأنهم واقعون في مهلكة قد أحاطت بهم. وأن لا ينقذهم منها إلا المغفرة المتضمنة للإنقاذ الذي هو أخص من الإبطال والإذهاب. وأما المؤمنون فقد أنقذوا.
وأما قوله تعالى: { يكفر عنكم من سيئاتكم }، فهي في موضع من التي للتبعيض، لأن الآية في سياق ثواب الصدقة فإنه قال: { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم }، [113] والصدقة لا تذهب جميع الذنوب.
ومن هذا النحو قوله ﷺ: «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». فأدخل عن في الكلام إيذانًا بمعنى الخروج عن اليمين لما ذكر الفاعل وهو الخارج فكأنه قال: فليخرج بالكفارة عن يمينه ولما لم يذكر الفاعل المكفر في قوله: { ذلك كفارة أيمانكم } لم يذكر من وأضاف الكفارة إلا الأيمان وذلك من إضافة المصدر إلى المفعول وإن كانت الأيمان لا تكفر، وإنما يكفر الحنث والإثم، ولكن الكفارة حل لعقد اليمين. فمن هنالك أضيفت إلى اليمين، كما يضاف الحل إلى العقد إذ اليمين عقد والكفارة حل له. والله أعلم.
فائدة: ألبست زيدا الثوب
قولك: ألبست زيدًا الثوب ليس الثوب منتصبًا بألبست كما هو السابق إلى الأوهام لما تقدم. من أنك لا تنقل الفعل عن الفاعل ويصير الفاعل مفعولًا حتى يكون الفعل حاصلًا في الفاعل، ولكن المفعول الثاني منتصب بما تضمنه ألبست من معنى، لبس فهو منتصب بما كان منتصبًا به قبل دخول الهمزة والنقل. وذلك أنهم اعتقدوا طرحها حين كانت زائدة، كما فعلوا في تصغير حميد وزهير. ومنه قولهم: أحببت حبيبًا فجاؤوا بحبيب على اعتقاد طرح الهمزة وهي لغية. ومنه أدرست البيت فهو دارس على تقدير درسته. ومنه: { والله أنبتكم من الأرض نباتًا }، [114] فجاء المصدر على نبت.
ومما يوضح هذا أنهم أعلوا الفعل. فقالوا: أطال الصلاة وأقامها مراعاة لإعلاله قبل دخول الهمزة. ولهذا حيث نقلوه في التعجب. فاعتقدوا إثبات الهمزة لم يعدوه إلى مفعول ثان. بل قالوا: ما أضرب زيدًا لعمرو باللام، لأن التعجب تعظيم لصفة المتعجب منه. وإذا كان الفعل صفة في الفاعل لم ينقل، ومن ثم صححوه في التعجب فقالوا: ما أقومه وأطوله، حيث لم يعتقدوا سقوط الهمزة، كما صححوا الفعل من استحوذ واستنوق الجمل حيث كانت الهمزة والزوائد لازمة غير عارضة. والله أعلم.
فائدة: حذف الباء من أمرتك الخير
حذف الباء من أمرتك الخير ونحوه إنما يكون بشرطين:
أحدهما: اتصال الفعل بالمجرور. فإن تباعد منه لم يكن بد من الباء نحو أمرت الرجل يوم الجمعة بالخير، لأن المعنى الذي من أجله حذفت الباء معنى وليس بلفظ وهو تضمنها معنى كلفتك. فلم يقو على الحذف إلا مع القرب من الاسم كما كان ذلك في اخترت. ألا ترى إلى قوله تعالى: { قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم }، [115] كيف أعاد حرف الجر في البدل لما طال بالصلة وكذلك: { يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها }، [116] على أحد القولين أي يخرج لنا من بقل الأرض وقثائها. وقوله: { مما تنبت } توطئة وتمهيد. والقول الثاني أنها متعلقة بقوله: { تنبت } أي ما تنبت من هذا الجنس. فمن الأولى لابتداء الغاية، والثانية لبيان الجنس، وهذا الثاني أظهر فإذا أعيد حرف الجر مع البدل لطول الاسم الأول فإثبات الحرف من نحو أمرتك الخير إذا طال الاسم أجدر.
الشرط الثاني: أن يكون المأمور به حدثًا. فإن قلت: أمرتك بزيد لم يحذف، لأن الأمر في الحقيقة ليس به، وإنما هو على غيره. كأنك قلت، أمرتك بضربه أو إكرامه. وأما نهيتك عن الشر فلا يحذف الحرف منه، لأنه ليس في الكلام ما يتضمن الفعل الناصب، لأن النهي عنه كف وزجر وإبعاد وهذه المعاني التي يتضمنها نهي تطلب من الحرف ما يطلبه نهي بخلاف أمر فإنه كلف وألزم لا تطلب الباء.
فائدة بديعة: أصل وضع عرفت كذا
قولهم: عرفت، كذا أصل وضعها لتمييز الشيء وتعيينه حتى يظهر للذهن منفردًا عن غيره. وهذه المادة تقتضي العلو والظهور كعرف الشيء لأعلاه ومنه الأعراف ومنه عرف الديك.
وأما علمت فموضوعة للمركبات لا لتمييز المعاني المفردة. ومعنى التركيب فيها إضافة الصفة إلى المحل وذلك أنك تعرف زيدًا على حدته. وتعرف معنى القيام على حدته، ثم تضيف القيام إلى زيد. فإضافة القيام إلى زيد هو التركيب وهو متعلق العلم.
فإذا قلت: علمت فمطلوبها ثلاثة معان محل وصفة وإضافة الصفة إلى المحل، وهن ثلاث معلومات. إذا عرف هذا فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله سبحانه إلا العلم لا المعرفة، لأن علمه متعلق بالأشياء كلها مركبها ومفردها تعلقًا واحدًا بخلاف علم المحدثين. فإن معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير علمهم ومعرفتهم بشيء آخر.
وهذا بناء منه على أن الله تعالى يعلم المعلومات كلها بعلم واحد، وأن علمه بصدق في رسول الله ﷺ هو عين علمه بكذب مسيلمة. والذي عليه محققو النظار خلاف هذا القول وأن العلوم متكثرة متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرها، فلكل معلوم علم يخصه. ولإبطال قول أولئك وذكر الأدلة الراجحة على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به. وعلى هذا فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم، وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناها فإنها في مجاري استعمالها، إنما تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب. فإذا تصور وحصل في الذهن قيل: عرفه، أو وصف له صفته ولم يره. فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل: عرفه ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد زمان فتبينت أنه هو قلت: عرفته، وكذلك عرفت اللفظة وعرفت الديار وعرفت المنزل وعرفت الطريق.
وسر المسألة: أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره. فاشتبه، فالمعرفة تمييز له وتعيين ومن هذا قوله تعالى: { يعرفونه كما يعرفون أبناءهم }، [117] فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته، وجاء كما يعرفون أبناءهم من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر فتأمله. وقد بسطنا هذا في كتاب التحفة المكية وذكرنا فيها من الأسرار والفوائد ما لا يكاد يشتمل عليه مصنف.
وأما ما زعموا من قولهم إن علمت قد يكون بمعنى عرفت واستشهادهم بنحو قوله تعالى: { لا تعلمهم نحن نعلمهم }، [118] وبقوله: { وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم }، فالذي دعاهم إلى ذلك، أنهم رأوا علمت قد تعدت إلى مفعول واحد. وهذا هو حقيقة العرفان. فاستشهاد ظاهر على أنه قد قال بعض الناس: إن تعدي فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى مفعول واحد لا يخرجها عن كونها علمًا على الحقيقة. فإنها لا تتعدى إلى مفعول واحد على نحو تعدى عرفت، ولكن على جهة الحذف والاختصار فقوله: لا تعلمهم نحو نعلمهم لا تنفي عنه معرفة أعيانهم وأسمائهم، وإنما تنفي عنه العلم بعدوانهم ونفاقهم، وما تقدم من الكلام يدلك على ذلك، وكذلك قوله: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم، فربما كانوا يعرفونهم ولا يعلمونهم أعداء لهم، فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف لا بعينه وذاته. قال: هذا وإنما مثل من يقول: إن علمت بمعنى عرفت من أجل أنها متعدية إلى مفعول واحد في اللفظ كمثل من يقول: إن سألت يتعدى إلى غير العقلاء بقولهم: سألت الحائط وسألت الدار ويحتج بقوله: واسأل القرية، قال: وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف، وكذلك ما تقدم.
وليس ما قاله هؤلاء بقوي. فإن الله سبحانه نفى عن رسوله معرفة أعيان أولئك المنافقين، هذا صريح اللفظ، وإنما جاء نفي معرفة نفاقهم من جهة اللزوم، فهو ﷺ كان يعلم وجود النفاق في أشخاص معينين وهو موجود في غيرهم، ولا يعرف أعيانهم. وليس المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا على النفاق وهو لا يعلم ذلك فيهم، فإن اللفظ لم يدل على ذلك بوجه.
والظاهر بل المتعين أنه ﷺ لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسيماهم وفي لحن القول: ولم يكن يخفى عليه نفاق من يظهر له الإسلام ويبطن عداوته وعداوة الله عز وجل. والذي يزيد هذا وضوحًا الآية الأخرى فإن قوله: { ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم }، [119] فيهم قولان:
أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على محاربة الله ورسوله وعلى هذا. فالآية نص في أن العلم فيها بمعنى المعرفة، ولا يمكن أن يقال: إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولئك جاهلين عداوتهم كما أمكن مثله في الإنس.
والقول الثاني أنهم المنافقون وعلى هذا فقوله: لا تعلمونهم إنما ينبغي حمله على معرفة أشخاصهم لا على معرفة نفاقهم، لأنهم كانوا عالمين بنفاق كثير من المنافقين يعلمون نفاقهم ولا يشكون فيه. فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم عالمون به. وإنما ينفي عنهم معرفة أشخاص من هذا الضرب. فيكون كقوله تعالى: { لا تعلمهم نحن نعلمهم } فتأمله.
ويزيده وضوحًا أن هذه الأفعال لا يجوز فيها الاقتصار على أحد المفعولين بخلاف باب أعطى وكسى للعلة المذكورة هناك وهي تعلق هذه الأفعال بالنسبة. فلا بد من ذكر المنتسبين بخلاف باب أعطى فإنه لم يتعلق بنسبة، فيصح الاقتصار فيه على أحد مفعولين وهذا واضح كما تراه والله أعلم.
وأما تنظيرهم بـ"سألتُ الحائط والدار" فيا بعد ما بينهما، فإن هذا سؤال بلسان الحال وهو كثير في كلامهم جدًا على أنه لا يمتنع أن يكون سؤالًا بلسان المقال صريحًا. كما يقول الرجل للدار الخربة. ليت شعري ما فعل أهلك. وليت شعري ما صيرك إلى هذه الحال! وليس هذا سؤال استعلام بل سؤال تعجب وتفجع وتحزن.
وأما قوله: { واسأل القرية } فالقرية إن كانت هنا اسمًا للسكان كما هو المراد بها في أكثر القرآن والكلام، فلا مجاز ولا حذف وإن كان المراد بها المسكن. فعلى حذف المضاف فأين التسوية والتنظير.
تنبيه
قولهم: علمت وظننت يتعدى إلى مفعولين ليس هنا مفعولان في الحقيقة. وإنما هو المبتدأ والخبر وهو حديث إما معلوم. وإما مظنون فكان حق الاسم الأول أن يرتفع بالابتداء والثاني بالخبر ويلغي الفعل لأنه لا تأثير له في الاسم، إنما التأثير لعرفت الواقعة على الاسم المفرد تعيينًا وتمييزًا ولكن أرادوا تثبيت علمت بالجملة التي هي الحديث كيلا يتوهم الانقطاع بين المبتدأ وبين ما قبله، لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع له مما قبله. وهم إنما يريدون إعلام المخاطب بأن هذا الحديث معلوم، فكان أعمال علمت فيه ونصبه له إظهارًا لتشبثها ولم يكن عملهما في أحد الاسمين أولى من الآخر. فعملت فيهما جميعًا.
وكذلك ظننت لأنه لا يتحدث بحديث حتى يكون عند المتكلم إما مظنونًا، وإما معلومًا، فإن كان مشكوكًا فيه أو مجهولًا عنده لم يسعه التحدث به، فمن ثم لم يعملوا شككت ولا جهلت فيما عملت فيه ظننت، لأن الشك تردد بين أمرين من غير اعتماد على أحدهما بخلاف الظن فإنه معتمد على أحد الأمرين. وأما العلم فأنت فيه قاطع بأحدهما، ومن ثم تعدى الشك بحرف في، لأنه مستعار من شككت الحائط بالمسمار وشك الحائط إيلاج فيه من غير ميل إلى أحد الجانبين، كما أن الشك في الحديث تردد فيه من غير ترجيح لأحد الجانبين.
ونظير أعماله علمت وأخواتها في المبتدإ والخبر اللذين هما بمعنى الحديث أعمالهم كان وأخواتها في الجملة. وإنما كان أصلها أن ترفع فاعلًا واحدًا نحو كان الأمر أي حدث، فلما خلعوا منها معنى الحدث ولم يبق فيها إلا معنى الزمان، ثم أرادوا أن يخبروا بها عن الحدث الذي هو زيد قائم أي زمان هذا الحدث ماض أو مستقبل أعملوها في الجملة ليظهر تشبثها بها ولئلا يتوهم انقطاعها عنها، لأن الجملة قائمة بنفسها وكان كلمة يوقف عليها، أو يكون خبرًا عما قبلها. فكان عملها في الجملة دليلًا على تشبثها بها وإنها خبر عن هذا الحدث، ولم تكن لتنصب الاسمين لأن أصلها أن ترفع ما بعدها، ولم تكن لترفعهما معًا فلا يظهر عملها، ولذلك رفعت أحدهما ونصبت الآخر.
نعم، ومنهم من يقول: كان زيد قائم فيجعل الحديث هو الفاعل لكان فيكون معمولها معنويًا لا لفظيًا كأنك قلت: كان هذا الحديث، و(إن) أضمرت الشأن والحديث، ودلت عليه قرينة الحال والمسألة على حالها، لأن الجملة حينئذ بدل من ذلك الضمير، لأنها في معنى الحديث. وذلك الحديث هو الأمر المضمر. فهذا بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة.
ونظير هذا المعمول المعنوي الذي هو الحديث معمول علمت وظننت إذا الغيت نحو زيد ظننت قائم كأنك قلت: ظننت هذا الحديث فلم تعملها لفظًا، إنما أعملتها معنى.
ومن هذا الباب إعمالهم إن وأخواتها، وإنما دخلت لمعان في الجملة والحديث: ألا ترى أن كلمة أن وأخواتها كلمات يصح الوقف عليها، لأن حروفها ثلاثة فصاعدًا كما قال: *.. فقلت: إنه * وقال آخر: * ليت شعري وأين مِني ليتُ * وقال حبيب: * عسى وطن يدنو بهم ولعلما *
وإذا كان هذا حكمها، فلو رفع ما بعدها على الأصل بالابتداء لم يظهر تشبثها بالحديث الذي دخلت لمعنى فيه. فكان إعمالها في الاسم المبتدإ إظهارًا لتشبثها بالجملة كي لا يتوهم انقطاعها عنها وكان عملها نصبًا، لأن المعاني التي تضمنتها لو لفظ بها لنصبت نحو أؤكد وأترجى وأتمنى. وليست هذه المعاني مضافة إلى الاسم المخبر عنه، ولكن الحديث هو المؤكدة والمتمني والمترجي فكان عملها نصبًا بها وبقي الاسم الآخر مرفوعًا لم تعمل فيه حيث لم تكن أفعالًا كعلمت وظننت فتعمل في الجملة كلها.
وأيضا أرادوا إظهار تشبثها بالجملة، فاكتفوا بتأثيرها في الاسم الأول يدلك على أنها لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا يليها لأنه لا يلي العامل ما عمل فيه غيره. فلو عملت فيه لوليها كما يلي كان خبرها ويلي الفعل مفعوله.
نعم، ومن العرب من أعملها في الاسمين جميعًا وهو أقوى في القياس، لأنها دخلت لمعان في الجملة، فليس أحد الاسمين أولى بأن تعمل فيه من الآخر قال:
إن العجوزَ خَبّةً جَروزًا ** تأكل كل ليلة قَفيزا
وقال:
كان أُذنيه إذا تشوَّفا ** قادمةً أو قلما محرفا
وقال:
وليس هذا من باب حذف فعل التشبيه كما قال بعضهم: فإن هذا لغة قائمة بنفسها.
واعلم أن معاني هذه الحروف لا تعمل في حال ولا ظرف، ولا يتعلق بها مجرور لأنها معان في نفس المتكلم كالاستفهام والنفي وسائر المعاني التي جعلت الحروف إمارات لها وليس لها وجود في اللفظ فإذا قلت: هل زيد قائم؟ فمعناه استفهم عن هذا الحديث، وكذلك لا معناها النفي، وكذلك ليس، ولذلك لما أرادوا تشبثها بالجملة لم ينصبوا بها الاسم الأول كما نصبوا بأن حيث لم يكن معناها يقتضي نصبًا إذا لفظ به كما يقتضي معنى أن لعل إذا لفظ به.
وأما كأن للتشبيه فمفارقة لأخواتها من جهة أنها تدل على التشبيه وهو معنى في نفس المتكلم واقع على الاسم الذي بعدها فكأنك تخبر عن الاسم أنه يشبه غيره فصار معنى التشبيه مسندًا إلى الاسم بعدها كما أن معاني الأفعال مسندة إلى الأسماء بعدها. فمن ثم عملت في الحال والظرف تقول: كأن زيدًا يوم الجمعة أمير فيعمل التشبيه في الظرف. ومن ذلك قوله:
كأنه خارجًا من جنب صفحته ** سفودُ شربٍ نَسُوه عند مُفتأدِ
ومن ثم وقعت في موضع الحال والنعت كما تقع الأفعال المخبر بها عن الأسماء تقول: مررت برجل كأنه أسد وجاءني رجل كأنه أمير. وليس ذلك في أخواتها، لأنها لا تكون في موضع نعت، ولا في موضع حال. بل لها صدر الكلام كما لحروف الشرط والاستفهام، لأنها داخلة لمعان في الجمل فانقطعت عما قبلها، وإنما كانت كأن مخالفة لأخواتها من وجه وموافقة من وجه من حيث كانت مركبة من كاف التشبيه وأن التي للتوكيد. وكان أصلها أن زيدًا الأسد أي مثل الأسد، ثم أرادوا أن يبينوا أنه ليس هو بعينه فأدخلوا الكاف على الحديث المؤكد بأن لتؤذن أن الحديث مشبه به. وحكم أن إذا أدخل عليها عامل أن تفتح الهمزة منها فصار اللفظ بها كأن زيدًا الأسد.
فلما في الكلمة من التشبيه المخبر به عن زيد صار زيد بمنزلة من أخبر عنه بالفعل فوقع موقع النعت والحال وعمل ذلك المعنى وتعلقت به المجرورات، ومن حيث كان في الكلمة معنى أن دخلت في هذا الباب ووقع في خبرها الفعل نحو قولك: كأن زيدًا يقوم. والجملة نحو كأن زيدًا أبوه أمير. ولو لم يكن إلا مجرد التشبيه لم يجز هذا، لأن الاسم لا يشبه بفعل ولا بجملة. ولكنه حديث مؤكد بأن والكاف تدل على أن خبرًا أشبه من خبر وذلك الخبر المشبه هو الذي عليه زيد فكان المعنى زيد قائم وكأنه قاعد وزيد أبوه وضيع وكأنه أبوه أمير فشبهت حديثًا بحديث. والذي يؤكد الحديث أن والذي يدل على التشبيه الكاف فلم يكن بد من اجتماعهما.
فصل: حروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيه ما بعدها
وكل هذه الحروف تمنع ما قبلها أن بعمل فيه ما بعدها لفظًا أو معنى. أما اللفظ. فلأنه لا يجتمع عاملان في اسم واحد وهذه الحروف عوامل. وأما المعنى فلا تقول: سرني زيد قائم أي سرني هذا الحديث ولا كرهت زيد قائم أي كرهت هذا الحديث كما يكون ذلك في كان وليس، لأنها ليست بفعل محض فجاز أن تقول: كان زيد قائم أي كان هذا الحديث. ولم يجز في سرني ولا بلغني. فإن أدخلت ليت، أو لعل، أو إن المكسورة لم يجز أيضا، لأن هذه المعاني ينبغي أن يكون لها صدر الكلام فلا يقع بعدها فعل يعمل ولا يلغى فإن جئت بأن المفتوحة قلت: بلغني أن زيدًا منطلق فأعملت الفعل في معمول معنوي وهو الحديث، لأن الجملة الملفوظ بها حديث في المعنى، وإنما جاز هذا لامتناع الفعل أن يعمل فيما عملت فيه أن. ولا بد له من معمول فتسلط على المعمول المعنوي وهو الحديث حيث لم يمكن أن يعمل في اللفظي الذي عملت فيه أن. وكذلك كرهت أن زيدًا منطلق المفعول هو الحديث وهو معنى لا لفظ.
فإن قيل: ولم لا جعلوا لأن المفتوحة صدر الكلام كما جعلوا لليت ولعل ولجميع الحروف الداخلة على الجمل؟
قيل: ليس في أن معنى زائد على الجملة أكثر من التوكيد. وتوكيد الشيء بمثابة تكراره لا بمثابة معنى زائد فيه، فصح أن يكون الحديث المؤكد بها معمولًا لما قبلها حيث منعت هي من عمل ما قبلها في اللفظ الذي بعدها فتسلط العامل الذي قبلها على الحديث ولم يكن له مانع في صدر الكلام يقطعه عنه كما كان ذلك في غيرها، فإن كسرت همزتها كان الكسر فيها إشعارًا بتجريد المعنى الذي هو التوكيد عن توطئة الجملة للعمل في معناها، فليس بين المكسورة والمفتوحة فرق في المعنى إلا أنهم أرادوا توطئة الجملة، لأن يعمل الفعل الذي قبلها في معناها وإن صيروها في معنى الحديث فتحوا الهمزة، وإذا أرادوا قطع الجملة مما قبلها وأن يعتمدوا على التوكيد اعتمادهم على الترجي والتمني كسروا الهمزة لتؤذن بالابتداء والانقطاع عما قبل. وأنهم قد جعلوا التوكيد صدر الكلام، لأنه معنى كسائر المعاني وإن لم يكن في الفائدة مثل غيره، وكان الكسر في هذا الموطن أولى، لأنه أثقل من الفتح والثقل أولى أن يعتمد عليه ويصدر الكلام به، والفتح أولى بما جاء بعد كلام لخفته وأن المتكلم ليس في عنفوان نشاطه وجمامه، مع أن المفتوحة قد يليها الضم والكسر كقولك لأنك وعلمت أنك فلو كسرت لتوالي الثقل.
فإن قيل: فما المانع أن تكون هي وما بعدها في موضع الابتداء كما كانت في موضع الفاعل والمفعول والمجرور. أليس قد صيرت الجملة في معنى الحديث فهلا تقول: إنك منطلق يعجبني وما الفرق بينها وبين أن التي هي وما بعدها في تأويل الاسم. نحو أن تقوم خير من أن تجلس فلم تكون تلك في موضع المبتدأ ولا تكون هذه كذلك؟
قيل: إن المبتدأ يعمل فيه عامل معنوي. والعامل المعنوي لولا أثره في المعمول اللفظي لما عقل. وهذه الجملة المؤكدة بأن إنما يصح أن تكون معمولًا لعامل لفظي، لأن المعمول معنى أيضا. فهذا لا يفهمه المخاطب ولا يصل إلى علمه إلا بوحي. فامتنع أن تكون هذه الجملة المؤكدة في موضع المبتدأ، لأنه لا ظهور للعامل ولا للمعمول، ومن ثم لم تدخل عليه عوامل الابتداء من كان وأخواتها وإن وأخواتها، لأنها قد استغنت بظهور عملها في الجملة عن حرف يصير الجملة في معنى الحديث المعمول فيه، فلا تقول كان إنك منطلق لا حاجة إلى أن مع عمل هذه الحروف في الجملة.
وجواب آخر وهو أنهم لو جعلوها في موضع الابتداء لم يسبق إلى الذهن إلا الاعتمادعلى مجرد التوكيد دون توطئة الجملة للإخبار عنها فكانت تكسر همزتها. وقد تقدم أن الكسر إشعار بالانقطاع عما قبل، واعتماد على المعنى الذي هو التوكيد. فلم يتصور فتحها في الابتداء إلا بتقديم عامل لفظي يدل على المراد بفتحها، لأن العامل اللفظي يطلب معموله فإن وجده لفظًا غير ممنوع منه وإلا تسلط على المعنى والابتداء بخلاف هذا.
فإن قيل: فلم قالوا: علمت أن زيدًا منطلق وظننت أنه ذاهب هلا اكتفوا بعمل هذه الأفعال في الأسماء عن تصيير الجملة في معنى الحديث كما اكتفوا في باب كان، وإن فقالوا: كان زيدًا قائمًا. قيل: يقولوا: كان إن زيدًا قائمًا.
قيل: الفرق بينهما أن هذه الأفعال تدل على الحدث والزمان وليست بمنزلة كان وليس ولا بمنزلة إن وليت فجرت مجرى كرهت وأحببت، فلذلك قالوا: علمت أنك منطلق كما قالوا: أحببت أنك منطلق إلا أنها تخالف كرهت وسائر الأفعال لأنها لا تطلب إلا الحديث خاصة ولا تتعلق إلا به فمن، ثم قالوا: علمت زيدًا منطلقًا وزيد، علمت منطلق ولم يقولوا كرهت زيدًا أخاك لأنه لا متعلق لكرهت وسائر الأفعال بالحديث، إنما متعلقها الأسماء إلا أن يمنعها من العمل من الأسماء مانع فتصير متعلقة بالحديث فافهمه.
فصل: العامل في قولك لو أنك ذاهب فعلت
فإن قيل: فما العامل في هذا الحديث المؤكد بأن من قولك: لو أنك ذاهب فعلت لا سيما ولو لا يقع بعدها إلا الفعل. ولا فعل ههنا فما موضع إن وما بعدها؟
فالجواب: أن إن في معنى التأكيد وهو تحقيق وتثبيت، فذلك المعنى الذي هو التحقيق اكتفت به لو حتى كأنه فعل وليها، ثم عمل ذلك المعنى في الحديث، كأنك قلت: لو ثبت أنك منطلق فصارت إن كأنها من جهة اللفظ عاملة في الاسم الذي هو لفظ. ومن جهة المعنى عاملة في المعنى الذي هو الحديث.
فإن قيل: ألم يتقدم أنه لا يعمل عامل معنوي في معمول معنوي؟
قيل: هذا في الابتداء حيث لا لفظ يسد مسد العامل اللفظي. فأما ههنا فلو لشدة مقارنتها للفعل وطلبها له تقوم مقام اللفظ، فالعامل الذي هو التحقيق والتثبيت اللتي دلت عليه إن بمعناها، ومن ثم عمل حرف النفي المركب مع لو من قولك: لولا زيد عمل المصدر فصار زيد فاعلًا بذلك المعنى حتى كأنك قلت: لو عدم زيد وفقد وغاب لكان كذا وكذا، ولولا مقارنة لو لهذا الحرف لما جاز هذا، لأن الحروف لا تعمل معانيها في الأسماء أصلًا. فالعامل في هذا الاسم الذي بعد لو كالعامل في هذا الاسم الذي هو الحديث من قولك: لو أنك ذاهب لفعلت كذا.
وأما اختصاص لا بالتركيب معها في باب لولا زيد لزرتك، فلأن لا قد تكون منفردة معنى عن الفعل إذا قيل لك: هل قام زيد؟ فتقول لا، فقد أخبرت عنه بالقعود. وإذا قيل هل قعد؟ قلت: لا فكأنك مخبر بالقيام وليس شيء من حروف النفي يكتفي به في الجواب حتى يكون بمنزلة الإخبار إلا هذا الحرف. فمن ثم صلح للاعتماد عليه في هذا الباب وساغ تركيبه مع حرف لا يطلب إلا الفعل فصارت الكلمة بأسرها بمنزلة حرف وفعل. وصار زيد بعدها بمنزلة الفاعل، ولذلك قال سيبويه: إنه مبني على لولا وهذا هو الحق، لأن ما يهذون به من أنه مبتدأ وخبره محذوف لا يظهر وخامل لا يذكر هذا الفصل كله كلام السهيلي إلى آخره.
فائدة: الاقتصار على المفعول الأول من باب أعلمت
قول سيبويه: لا يجوز الاقتصار على المفعول الأول من باب أعلمت تأوله أصحابه بمعنى لا يحسن الاقتصار عليه. قالوا: لأنه هو الفاعل في المعنى فإنه هو علم ما أعلمته به من كون زيد قائمًا قالوا: والفاعل يجوز الاقتصار عليه لتمام الكلام به. فهكذا ما في معناه بخلاف المفعول الأول من باب علمت فإنه ليس فاعلًا لفظلًا ولا معنى. هذا تقرير قولهم. وقول إمام النحو هو الصواب؛ ولا حاجة إلى تأويله هذا التأويل البارد.
وممن أنكر هذا التأويل السهيلي وقال: عندي أن قول سيبويه محمول على الظاهر، لأنك لا تريد بقولك أعلمت زيدًا. أي جعلته عالمًا على الإطلاق هذا محال، إنما تريد أعلمته بهذا الحديث. فلا بد إذًا من ذكر الحديث الذي أعلمته به.
فإن قيل: فهل يجوز أظننت زيدًا عمرًا قائمًا؟
قيل: الصحيح امتناعه، لأن الظن إن كان بعد علم ضروري فمحال أن ينقلب ظنًا. وإن كان بعد علم نظري لم يرجع العالم إلى الظن إلا بعد النسيان والذهول عن ركن من أركان النظر. وهذا ليس من فعلك أنت به فلا تقول: أظننته بعد إن كان عالمًا. وإن كان قبل الظن شاكًا، أو جاهلًا، أو عاقلًا لم يتصور أيضا أن تقول أظننته، لأن الظن لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خبر صادق يخبره به كما يكون العلم، لأن الدليل لا يقتضي ظنًا، ولا يقتضي أيضا شبهة. كما بينه الأصوليون فثبت أن الظن لا تفعله أنت به، ولا تفعل شيئًا من أسبابه، فلم يجز أظننته أي جعلته ظانًا، وكذلك يمتنع أشككته أي جعلته شكًا، ولكنهم يقولون: شككته إذا جذبته بحديث يصرفه عن حال الظن إلى حال الشك.
هذا كلام السهيلي. وليس الأمر كما قال ولا فرق بين أعلمته وأظننته إلا من جهة السماع.
وأما الجواب عما ذكرناه فيقال: ما المانع أن يكون أظننته أي جعلته ظانًا بعد أن كان جاهلًا أو شاكًا مما ذكرته له من الأمارات والأدلة الظنية. وقولك: إن الظن لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خبر صادق يخبر به دعوى مجردة بل ظاهرة البطلان. فإن الظن هو الرجحان. فإذا ذكرت له أمارة ظاهرة لا توجب اليقين أفادته الرجحان وهو الظن، وهذا كما إذا أخبرك من يثير خبره لك ظنًا راجحًا ولا ينتهي إلى قطع، كالشاهد وغيره، فدعوى أن الظن لا يكون عن دليل دعوى باطلة. وإن أردت أنه لا يكون عن دليل قاطع لم يفدك شيئًا فإنه يكون عن إمارة تحصل له. ولا يلزم من كون الدليل لا يقتضي الظن إلا تقتضيه الإمارة.
وقوله: فثبت أن الظن لا تفعله أنت، ولا تفعل شيئًا من أسبابه - يقال: وكذلك العلم لم تفعله أنت به، ولا شيئًا من أسبابه إن أردت أنك لم تحدثه فيه، وإن أردت أنك لم تتسبب إلى حصوله فيه فباطل، فإن ذكر الأمارات والأدلة الظنية سبب إلى حصول الظن له. وهذا أظهر من أن يحتاج إلى تقريره ويدل عليه. قولهم شككته. فإن معناه أحدثت له شكًا بما ذكرته له من الأمور التي تستلزم شكه.
فائدة: الفعل الذي يطلب مفعولا ولا يصل إليه بنفسه
كل فعل يقتضي مفعولًا ويطلبه ولا يصل إليه بنفسه. توصلوا إليه بأداة وهي حرف الجر، ثم أنهم قد يحذفون الحرف لتضمن الفعل معنى فعل متعد بنفسه كما تقدم.
لكن هنا دقيقة ينبغي التفطن لها وهي أنه قد يتعدى الفعل بنفسه إلى مفعول وإلى آخر بحرف الجر، ثم يحذف المفعول الذي وصل إليه بنفسه لعلم السامع به، ويبقى الذي وصل إليه بحرف الجر كما قالوا: نصحت لزيد وكلت له ووزنت له وشكرت له. المفعول في هذا كله محذوف والفعل واصل إلى الآخر بحرف الجر ولا يسمع قولهم أربعة أفعال تتعدى بنفسها تارة، وبحرف الجر أخرى، ويذكرون هذه فإنه كلام مجرد عن تحقيق بل المفعول في الحقيقة محذوف. فإن قولك: نصحت له مأخوذ من نصح الخياط الثوب إذا أصلحه وضم بعضه إلى بعض. ثم استعير في الرأي فقالوا: نصحت له أي نصحت له رأيه أي أخلصته له وأصلحته.
والتوبة النصوح إنما هي من هذا، فإن الذنب يمزق الدين، فالتوبة النصوح بمنزلة نصح الخياط الثوب إذا أصلحه وضم أجزاءه ويقولون: نصحت زيدًا فيسقطون الحرف، لأن النصيحة إرشاد فكأنك قلت: أرشدته وكذلك شكرت، إنما هو تفخيم للفعل وتعظيم له من شكر بطنه إذا امتلأ. فالأصل شكرت لزيد إحسانه وفعله، ثم تحذف المفعول فتقول: شكرت لزيد ثم تحذف الحرف، لأن شكرت متضمنة لحمدت أو مدحت.
وأما كلت لزيد ووزنت له فمفعولهما غير زيد، لأن مطلوبهما ما يكال أو يوزن فالأصل دخول اللام، ثم قد يحذف لزيادة فائدة، لأن كيل الطعام ووزنه يتضمن معنى المبايعة والمقاوضة إلا مع حرف اللام، فإن قلت: كلت لزيد اخبرت بكيل الطعام خاصة. وإذا قلت: كلت زيدًا فقد أخبرت بمعاملته ومبايعته مع الكيل كأنك قلت: بايعته بالكيل والوزن. قال تعالى: { وإذا كالوهم أو وزنوهم } [120] أي بايعوهم كيلًا أو وزنًا.
وأما قوله: { اكتالوا على الناس } [121] فإنما دخلت على لتؤذن أن الكيل على البائع للمشتري ودخلت التاء في اكتالوا، لأن افتعل في هذا الباب كله للأخذ، لأنها زيادة على الحروف الأصلية تؤذن بمعنى زائد على معنى الكلمة، لأن الآخذ للشيء كالمبتاع والمكتال والمشتري. ونحو ذلك يدخل فعله من التناول والاجترار إلى نفسه والاحتمال إلى رحله ما لا يدخل فعل المعطي والمبايع. ولهذا قال سبحانه: { لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت }، [122] يعني من السيئات، لأن الذنوب يوصل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوى والحسنة تنال بهبة الله من غير واسطة شهوة، ولا إغراء عدو، فهذا الفرق بينهما على ما قاله السهيلي.
وفيه فرق أحسن من هذا، وهو أن الاكتساب يستدعي التعمل والمحاولة والمعاناة فلم يجعل على العبد إلا ما كان من هذا القبيل الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمله. وأما الكسب فيحصل بأدنى ملابسة حتى بالهم بالحسنة ونحو ذلك فخص الشر بالاكتساب والخير بأعم منه. ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح: «إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها وإن هم بسيئة فلا تكتبوها». وأما حديث الواسطة وعدمها فضعيف، لأن الخير أيضا بواسطة الرسول والملك والإلهام والتوفيق. فهذا في مقابلة وسائط الشر فالفرق ما ذكرناه. والله أعلم.
فصل: سمع الله لمن حمده
وأما سمع الله لمن حمده، فقال السهيلي: مفعول سمع محذوف، لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام على بابها إلا أنها تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهي الاستجابة لمن حمده وهذا مثل قوله: عسى أن يكون ردف لكم ليست اللام لام المفعول كما زعموا، ولا هي زائدة، ولكن ردف فعل متعد ومعموله غير هذا الاسم كما كان مفعول سمع غير المجرور، ومعنى ردف تبع وجاء على الأثر فلو حملته على الاسم المجرور لكان المعنى غير صحيح إذا تأملته، ولكن المعنى ردف لكم استعجالكم وقولكم لأنهم قالوا: متى هذا الوعد، ثم حذف المفعول الذي هو القول والاستعجال اتكال على فهم السامع ودلت اللام على الحذف لمنعها الاسم الذي دخلت عليه أن يكون مفعولًا، وآذنت أيضا بفائدة أخرى وهي معنى عجل لكم. فهي متعلقة بهذا المعنى فصار معنى الكلام. قل: عسى أن يكون عجل لكم بعض الذي تستعجلون فردف قولكم واستعجل لكم. فدلت ردف على أنهم قالوا: واستعجلوا ودلت اللام على المعنى الآخر فانتظم الكلام أحسن انتظام واجتمع الإيجاز مع التمام.
قلت: فعل السمع يراد به أربعة معان:
أحدها: سمع إدراك ومتعلقه الأصوات.
الثاني: سمع فهم وعقل ومتعلقه المعاني.
الثالث: سمع إجابة وإعطاء ما سأل.
الرابع: سمع قبول وانقياد.
فمن الأول: { سمع الله قول التي تجادلك في زوجها }، [123] { قد سمع الله قول الذين قالوا }، [124] ومن الثاني قوله: { لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا }، [125] ليس المراد سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل. ومنه سمعنا وأطعنا، ومن الثالث سمع الله لمن حمده، وفي الدعاء المأثور اللهم اسمع أي أجب واعط ما سألتك. ومن الرابع قوله تعالى: { سماعون للكذب } [126] أي قابلون له ومنقادون غير منكرين له. ومنه على أصح القولين { وفيكم سماعون لهم }، [127] أي قابلون ومنقادون وقيل: عيون وجواسيس وليس بشيء فإن العيون والجواسيس، إنما تكون بين الفئتين غير المختلطتين فيحتاج إلى الجواسيس والعيون وهذه الآية، إنما هي في حق المنافقين وهم كانوا مختلطين بالصحابة بينهم فلم يكونوا محتاجين إلى عيون وجواسيس. وإذا عرف هذا فسمع الإدراك يتعدى بنفسه، وسمع القبول يتعدى باللازم تارة، وبمن أخرى، وهذا بحسب المعنى. فإذا كان السياق يقتضي القبول عدى بمن، وإذا كان يقتضي الانقياد عدى باللام. وأما سمع الإجابة فيتعدى باللام نحو سمع الله لمن حمده لتضمنه معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن. وأما سمع الفهم فيتعدى بنفسه، لأن مضمونه يتعدى بنفسه.
فصل: قولهم قرأت الكتاب واللوح
ومما يتعلق بهذا قولهم: قرأت الكتاب واللوح ونحوهما مما يتعدى بنفسه. وأما قرأت بأم القرآن وقرأت بسورة كذا كقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، ففيه نكتة بديعة قل من يتفطن لها وهي أن الفعل إذا عدى بنفسه فقلت: قرأت سورة كذا، اقتضى اقتصارك عليها لتخصيصها بالذكر وأما إذا عدى بالباء فمعناه لا صلاة لمن لم يأت بهذا السورة في قراءته، أو في صلاته أي في جملة ما يقرأ به. وهذا لا يعطي الاقتصار عليها بل يشعر بقراءة غيرها معها. وتأمل قوله: في الحديث كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة كيف تجد المعنى أن يقرأ فيما يقرأ به بعد الفاتحة بهذا العدد، وكذلك قوله: قرأ بالأعراف، إنما هي بعد الفاتحة، وكذلك قرأ بسورة ق ونحو هذا. وتأمل كيف لم يأت بالباقي قوله: قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون فقال: قرأ سورة النجم ولم يقل بها لأنه لم يكن في صلاة فقرأها وحدها، وكذلك قوله: قرأ على الجن سورة الرحمن، ولم يقل بسورة الرحمن، وكذلك قرأ على أبي سورة لم يكن ولم يقل بسورة ولم تألت الباء إلا في قراءة في الصلاة كما ذكرت لك. وإن شئت قلت: هو مضمن معنى صلى بسورة كذا وقام بسورة كذا، وعلى هذا فيصح على الإطلاق وإن أتى بها وحدها وهذا أحسن من الأول وعلى هذا فلا يقال: قرأ بسورة كذا. إذا قرأها خارج الصلاة وألفاظ الحديث تتنزل على هذا فتدبرها.
فصل: كفى بالله شهيدا
وأما كفى بالله شهيدًا. فالباء متعلقة بما تضمنه الخبر عن معنى الأمر بالاكتفاء، لأنك إذا قلت: كفى بالله أو كفاك الله زيدًا، فإنما تريد أن يكتفي هو به. فصار اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى الأمر فدخلت الباء لهذا السبب. فليست زائدة في الحقيقة، وإنما هي كقولك حسبك بزيد، ألا ترى أن حسبك مبتدأ وله خبر. ومع هذا فقد يجزم الفعل في جوابه فتقول: حسبك يتم الناس فيتم جزم على جواب الأمر الذي في ضمن الكلام. حكى هذا سيبويه عن العرب.
فائدة: تعدي الفعل إلى المصدر
تعدي الفعل إلى المصدر على ثلاثة أنحاء: أحدها: أن يكون مفعولًا مطلقًا لبيان النوع؛ الثاني: أن يكون توكيدًا؛ الثالث: أن يكون حالًا.
قال سيبويه: وإنما تذكره لتبين أي فعل فعلت أو توكيدًا. وأما الحال فنحو جاء زيد مشيًا وسعيًا تريد ماشيًا وساعيًا وفيه قولان: أحدهما هذا. والثاني: أن الحال محذوف ومشيًا معمولها أي يمشي مشيًا، وقد تقول: مشيت ماشيًا وقعدت قاعدًا تجعلها حالًا مؤكدة. وقد تقول: مشيت مشيًا بطيئًا ومسرعًا فلك فيها وجهان: أحدهما: أن يكون المصدر حالًا فيكون من باب قوله تعالى: { لسانًا عربيًا }، [128] وهي الحال الموطئة، لأن الصفة وطأت الاسم الجامد أن يكون حالًا. فإن حذفت الاسم وبقيت الصفة وحدها لم يكن في الحال إشكال. نحو سرت شديدًا.
ويبين ما قلناه إن قولك سرت شديدًا هي حال من المصدر الذي دل عليه الفعل. فإذا أردت بالمصدر هذا المعنى كان بمنزلة الحال. ويجوز تقديمه وتأخيره. إذا كان مفعولًا مطلقًا، أو حالًا، ولا يجوز تقديمه على الفعل إذا كان توكيدًا له، لأن التوكيد لا يتقدم على المؤكد. والعامل فيه، إذا أردت معنى الحال الفعل نفسه. والعامل فيه إذا كان مفعولًا مطلقًا ليس هو لفظ الفعل بنفسه، وإنما هو ما يتضمنه من معنى فعل الذي هو فاء وعين ولام، لأنك إذا قلت: ضربًا فالضرب ليس بمضروب ولكنك حين قلت: ضربت تضمن ضربت معنى فعلت، لأن كل ضرب فعل وليس كل فعل ضربًا فصار هذا بمنزلة تضمن الإنسان الحيوان. وإذا كان كذلك فضربًا منصوب بفعلت المدلول عليها بضربت حتى كأنك قلت: فعلت ضربًا. ولا يكون المصدر مفعولًا مطلقًا بل يكون منعوتًا أو في حكم المنعوت، وإنما يكون توكيدًا للفعل، لأن الفعل يدل عليه دلالة مطلقة ولا يدل عليه محدودًا ولا منعوتًا، وقد يكون مفعولًا مطلقا وليس، ثم نعت في اللفظ إذا كان في حكم المنعوت كأنك تريد ضربًا تامًا فلا يكون حينئذ توكيدًا إذ لا يؤكد الشيء بما فيه معنى زائد على معناه، لأن التوكيد تكرار محض.
وقد احتج بعض أهل السنة على القائلين من المعتزلة بأن تكليم الله لموسى مجاز بقوله: { وكلم الله موسى تكليما } [129] فأكد الفعل بالمصدر ولا يصح المجاز مع التوكيد. قال السهيلي: فذاكرت بها شيخنا أبا الحسن فقال: هذا حسن لولا أن سيبويه أجاز في مثل هذا أن يكون مفعولًا مطلقًا وإن لم يكن منعوتًا في اللفظ. فيحتمل على هذا أن يريد تكليمًا ما فلا يكون في الآية حجة قاطعة والحجاج عليهم كثيرة.
قلت: وهذا ليس بشيء والآية صريحة في أن المراد بها تكليم أخص من الإيحاء، فإنه ذكر أنه أوحى إلى نوح والنبيين من بعده وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك، ثم خص موسى باسم خاص وفعل خاص وهو كلم تكليمًا، ورفع توهم إرادة التكليم العام عن الفعل بتأكيده بالمصدر، وهذا يدل على اختصاص موسى بهذا التكليم. ولو كان المراد تكليمًا ما لكان مساويًا لما تقدم من الوحي أو دونه وهو باطل. وأيضا فإن التأكيد في مثل هذا السياق صريح في التعظيم وتثبيت حقيقة الكلام والتكليم فعلًا ومصدرًا ووصفه بما يشعر بالتقليل مضاد للسياق فتأمله. وأيضا فإن الله سبحانه قال لموسى: { إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي } [130] فلو كان التكليم الذي حصل له تكليمًا ما كان مشاركًا لسائر الأنبياء فيه فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى. وأيضا فإن وصف المصدر ههنا مؤذن بقلته وإن نوعًا من أنواع التكليم حصل له وهذا محال ههنا فإن الإلهام تكليم ما ولهذا سماه الله تعالى وحيًا والوحي تكليم ما فقال: { وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه }، [131] { وإذ أوحيت إلى الحواريين }، [132] ونظائره. وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه. هذه الأنواع تسمى تكليمًا ما. وقد خص الله سبحانه موسى واصطفاه على البشر بكلامه له. وأيضا فإن الله سبحانه حيث ذكر موسى ذكر تكليمه له باسم التكليم الخاص دون الاسم العام كقوله: { ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني }، [133] ذكر تكليمه له بأخص من ذلك وهو تكليم خاص كقوله: { وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيًا }، [134] فناداه وناجاه، والنداء والنجاء أخص من التكليم، لأنه تكليم خاص، فالنداء تكليم من البعد يسمعه المنادى والنجاء تكليم من القرب. وأيضا فإنه اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملها على ما ذكره وهو أنه ذكر الوحي المشترك، ثم ذكر عموم الأنبياء بعد محمد ونوح، ثم ذكر موسى بعينه بعد ذكر النبيين عمومًا، ثم ذكر خصوص تكليمه، ثم أكده بالمصدر وكل من له أدنى ذوق في الألفاظ ودلالتها على معانيها يجزم بأن هذا السياق يقتضي تخصيص موسى بتكليم لم يحصل لغيره. وأنه ليس تكليمًا ما. فما ذكره أبو الحسن غير حسن بل باطل قطعًا والذي غره ما اختاره سيبويه من حذف صفة المصدر وإرادتها، وسيبويه لم يذكر هذا في كل مصدر كان هذا شأنه، وإنما ذكر أن هذا مما يسوغ في الجملة، فإذا كان في الكلام ما يدل على إرادة التأكيد دون الصفة لم يقل سيبويه ولا أحد أنه موصوف محذوف يدل على تقليله كما إذا قيل: صدقت الرسول تصديقًا وآمنت به إيمانًا. أو قيل: قاتل فلان مع رسول الله ﷺ قتالًا ونصره نصرًا وبين الرسول لأمته تبيينًا وأرشدهم إرشادًا وهداهم هدى فهل يقول سيبويه أو أحد أن هذا يجوز أن يكون موصوفًا. والمراد تصديقًا وإيمانًا ما وتبيينًا ما وهدى ما. فهكذا الآية والله الموفق للصواب.
قال السهيلي: وسألته عن العامل في المصدر إذا كان توكيدًا للفعل. والتوكيد لا يعمل فيه المؤكد إذ هو هو في المعنى فما العامل فيه؟
فسكت قليلًا، ثم قال ما سألني عنه أحد قبلك وأرى أن العامل فيه ما كان يعمل في الفعل قبله، لو كان اسمًا لأنه لو كان اسمًا لكان منصوبًا بفعلت المتضمنة فيه، ثم عرضت كلامه على نفسي وتأملت الكتاب. فإذا هو قد ذهل عما لوح إليه سيبويه في باب المصادر بل صرح، وذلك أنه جعل المصدر المؤكد منصوبًا بفعل هو التوكيد على الحقيقة واختزل ذلك الفعل وسد المصدر الذي هو معموله مسده. كما سدت إياك وزيدًا مسد العامل فيهما فصار التقدير ضربت ضربت ضربًا. فضربت الثانية هي التوكيد على الحقيقة وقد سد ضربًا مسدها وهو معمولها، وإنما يقدر عملها فيه على أنه مفعول مطلق لا توكيد. هذا معنى قول صاحب الكتاب مع زيادة شرح. ومن تأمله هناك وجده كذلك.
والذي أقول به الآن قول الشيخ أبي الحسن لأن الفعل المختزل معنى والمعانى لا يؤكد بها، إنما يؤكد بالألفاظ وقولك: ضربت فعل مشتق من المصدر فهو يدل عليه فكأنك قلت: فعلت الضرب. فضربت يتضمن المصدر ولذلك تضمره فتقول: من كذب فهو شر له وتقيده بالحال. نحو قمنا سريعًا فسريعًا حال من القيام. فكما جاز أن تقيده بالحال وأن تكنى عنه. جاز أيضا أن تؤكده بضربًا كأنك قلت: ضربًا ضربًا أو نصب ضربًا المتضمن ضربًا المصرح به وبه يعمل في الثاني يعني فعلت كما كان ذلك في المفعول المطلق. إذا قلت: ضربت ضربًا شديدًا أي فعلت ضربًا شديدًا وليس المؤكد كذلك، إنما ينتصب كما ينتصب زيد الثاني في قولك: ضربت زيدًا زيدًا مكررًا انتصب من حيث كان هو الأول لا أنك أضمرت له فعلًا، فتأمله. تم كلامه.
ثم قال:
فصل فيما يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكد
قد أشرنا إلى أن الفعل قسمان: خاص وعام، فالعام فعلت وعملت وفعلت أعم، لأن عملت عبارة عن حركات الجوارح الظاهرة مع دؤب. ولذلك جاء على وزن فعل كتعب ونصب، ومن ثم لم تجدها يخبر بها عن الله سبحانه إلا أن يراد بها سمع فيحمل على المجاز المحض ويلتمس له التأويل.
قلت: وقد ورد قوله تعالى: { أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًا }، [135] وقد تقدم له كلام أن اليد صفة أخص من القدرة والنعمة كما هو مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله ونصر ذلك المذهب وارتضاه، وعلى هذا فلا تأويل في الآية، بل هي على حقيقتها على قوله. وأما الدؤب والنصب وإثبات الجارحة فمن خصائص العبد والله تعالى منزه عن ذلك متعال عنه. وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لرب العالمين. بل الصفة المضافة إلى الله لا يلحقه فيها شيء من خصائصهم، فإثباتها له كذلك يحتاج معه إلى تأويل فإن الله ليس كمثله شيء. وقد تقدم أن خصائص المخلوقين غير داخلة في الاسم العام فضلًا عن دخولها في الاسم الخاص المضاف إلى الرب تعالى، وأنها لا يدل اللفظ عليها بوضعه حتى يكون نفيها عن الرب تعالى صرفًا للفظ عن حقيقته. ومن اغتفر دخولها في الاسم المضاف إلى الرب، ثم توسل بذلك إلى نفي الصفة عنه. فقد جمع بين التشبيه والتعطيل. وأما من لم يدخلها في مسمى اللفظ الخاص ولا أثبتها للموصوف. فقوله محض التنزيه وإثبات ما أثبت الله لنفسه. فتأمل هذه النكتة ولتكن منك على ذكر في باب الأسماء والصفات فإنها تزيل عنك الاضطراب والشبهة والله الموفق للصواب.
عاد كلامه، قال: إذا ثبت هذا ففعلت وما كان نحوها من الأحداث العامة الشائعة لا تؤكد بمصدر، لأنها في الأفعال بمنزلة شيء وجسم في الأسماء فلا يؤكد، لأنه لم يثبت له حقيقة معينة عند المخاطب، وإنما يؤكد ما ثبت حقيقة والمخاطب أحوج إلى ذكر المفعول المطلق الذي تقع الفائدة منه إلى توكيد فعلت فلو قلت له: فعلت فعلت وأكدته بغاية ما يمكن من التوكيد ما كان الكلام إلا غير مفيد، وكذلك لو قال: فعلت فعلًا على التوكيد، لأن المصدر الذي كنت تؤكد به، لو أكدت قياسه أن يكون مفتوح الفاء، لأنه ثلاثي والمصدر الثلاثي قياسه فتح فائه، كما أن فعله كذلك.
قلت: هذا ليس على اطلاقه. فإن فعلت إذا أريد بها الفعل العام لم تتحصل حقيقته عند المخاطب امتنع تأكيدها. بل مثل هذا لا يقع في التخاطب، وأما إذا أريد بها فعل خاص قد تحصلت حقيقته وتميزت عندهما، كما إذا قال له: أنت فعلت هذا وأشار إلى فعل معين. فإنه إذا أكد الفعل وقال: فعلت فعلت كان الكلام مفيدًا أبلغ فائدة. وهذا إنما جاء من حيث كانت فعلت مرادًا بها الحدث الخاص. وأكثر ما يجيء فعلت في الخطاب، كذلك فتأمله.
قال: إذا ثبت هذا فلا يقع بعد فعلت إلا مفعول مطلق إما من لفظها فيكون عامًا نحو فعلت فعلًا حسنًا. ومن ثم جاء مكسور الفاء، لأنه كالطحن والذبح ليس بمصدر اشتق منه الفعل، بل هو مشتق من فعلت. وإما أن يكون خاصًا نحو فعلت ضربًا. فضربًا أيضا مفعول مطلق من غير لفظ فعل، فصار فعلت فعلًا كطحنت طحنًا وفعلت ضربًا كطحنت دقيقًا.
فإن قيل: ألم يجيزوا في ضربت ضربًا وقتلت قتلًا أن يكون مفعولًا مطلقًا فلم لم يكن مكسور الأول إذا كان مفعولًا مطلقًا، ومفتوحًا إذا كان مصدرًا مؤكدًا؟
قيل: "حدِّث حديثين امرأةً"، ألم يقدم في أول الفائدة أنه لا يعمل في ضربًا إذا كان مفعولًا مطلقًا؟ إلا معنى فعلت لا لفظ ضربت، فلو عمل فيه لفظ ضربت لقلت، ضربًا بالكسر كطحن وهو محال، لأن الضرب لا يضرب. ولكنك إذا شققت له اسمًا من فعلت التي هي عاملة فيه على الحقيقة فقلت هو فعل وإن شققت له اسمًا من ضربت التي لا يعمل لفظها فيه لم يجز أن يجعلها كالطحن والذبح، لأن الاسم القابل لصورة الفعل. إنما يشتق لفظه من لفظ ما عمل فيه. فثبت من هذا كله إن فعلت وعملت استغنى بمفعولها المطلق عن مصدرها، لأنها لا تتعدى إلا إلى حدث وذلك الحدث يشتق له اسم من لفظها فيجتمع اللفظ والمعنى ويكون أقوى عند المخاطب من المصدر الذي يشتق منه الفعل. ولذلك لم يقولوا: صنعت صنعًا بفتح الصاد، ولا عملت عملًا بسكون الميم، ولا فعلت فعلًا، بفتح الفاء استغناء عن المصادر بالمفعولات المطلقة، لأن العمل مثل القصص والنغص والصنع مثل الدهن والخبز والفعل مثل الطحن وكلها بمعنى المفعول لا بمعنى المصدر الذي اشتق منه الفعل.
وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدى إلى الجواهر والأجسام إلا أن يخبر بها عن خالقها. وإنما تتعدى إلى الجواهر بعض الأفعال الخاصة نحو ضربت زيدًا فهو مضروب على الإطلاق وإن اشتق له من لفظ فعلت مفعول به أي فعل به الضرب، ولم يفعل هو جاز.
وأما حلمت في النوم حلمًا فهو بمنزلة فعلت وصنعت في اليقظة، لأن جميع أفعال النوم تشتمل عليها حلمت وكان جميع أفعال اليقظة يشتمل عليها فعلت، فمن ثم لم يقولوا حلمًا بوزن ضربًا، لأن حلمت مغنية عن المصدر كما كانت فعلت مغنية عنه. وإنما مطلوب المخاطب معرفة المحلوم والمفعول، فلذلك قالوا: حلمًا ولذلك جمعوه على أحلام وحلوم، لأن الأسماء هي التي تجمع وتثنى. وأما الفعل أو ما فائدته كفائدة الفعل من المصادر فلا يجمع ولا يثنى. وقولهم: إنما جمعت الحلوم والأشغال لاختلاف الأنواع. بل يقال لهم: (وهل) اختلفت الأنواع إلا من حيث كانت بمثابة الأسماء المفعولة؟ ألا ترى أن الشغل على وزن فعل كالدهن هو عبارة عما يشتغل المرء عنه. فهو اسم مشتق من الفعل وليس الفعل مشتقًا منه. إنما هو مشتق من الشغل والشغل هو المصدر كما أن الجعل كذلك. فعلى هذا ليس الأشغال والأحلام بجمع المصدر. وإنما هو جمع اسم والمصدر على الحقيقة لا يجمع، لأن المصادر كلها جنس واحد من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل، والحركة تماثل الحركة، ولا تخالفها بذاتها. ولولا هاء التأنيث في الحركة ما ساغ جمعها فلو نطقت العرب بمصدر حلمت الذي استغنى عنه بالحلم وبمصدر شكرت الذي استغني عنه بالشكر لما جاز جمعه، لأن اختلاف الأنواع ليس راجعًا إليه وإنما هو راجع إلى المفعول المطلق ألا ترى أن الشكر عبارة عما يكافأ به المنعم من ثناء أو فعل، وكذلك نقيضه وهو الكفر عبارة عما يقابل به المنعم من جحد وقبح فعل فهو مفعول مطلق لا مصدر اشتق منه الفعل إلا أن الكفر يتعدى بالباء لتضمنه معنى التكذيب، وشكرت يتعدى باللام التي هي لام الإضافة، لأن المشكور في الحقيقة هي النعمة وهي مضافة إلى المنعم، وكذلك المكفور في الحقيقة هي النعمة. لكن كفرها تكذيب وجحد، فلذلك قالوا: كفر بالله وكفر نعمته وشكر له وشكر نعمته. وإذا ثبت أن الشكر من قولك شكرت شكرًا مفعول مطلق وهو مختلف الأنواع، لأن مكافأة النعم تختلف جاز أن يجمع، كما جمع الحلم والشغل، فيحتمل قوله سبحانه حكاية عن المخلصين من عباده: { لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا }، [136] أن يكون جمعًا لشكر وليس كالقعود والجلوس، لأنه متعد. ومصدر المتعدي لا يجيء على الفعول.
قلت: الصحيح أنه مصدر جاء على الفعول، لأن مقابله وهو الكفر والجحد والنفار تجيء مصادرها على الفعول نحو كفور وجحود ونفور، ويبعد كل البعد أن يراد بالكفور جمع الكفر والكفر لا يعهد جمعه في القرآن قط ولا في الاستعمال. فلا يعرف في التخاطب أكفار وكفور، وإنما المعروف الكفر والكفران. والكفور مصادر ليس إلا فحسن مجيء الشكور على الفعول حمله على مقابله وهو كثير في اللغة، وقد تقدم الإشارة إليه وحتى لو كان الشكور سائغًا استعماله جمعًا واحتمل الجمع والمصدر لكان الأليق بمعنى الآية المصدر لا الجمع، لأن الله تعالى وصفهم بالإخلاص، وإنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه ولم يريدوا من المطعمين جزاءً ولا شكورًا، ولا يليق بهذا الموضع أن يقول: لا نريد منكم أنواعًا من الشكر وأصنافًا منه. بل الأليق بهم وبإخلاصهم أن يقولوا: لا نريد منكم شكرًا أصلًا فينفوا إرادة نفس هذه الماهية منهم وهو أبلغ في قصد الإخلاص من نفي الأنواع فتأمله، فإنه ظاهر فلا يليق بالآية إلا المصدر. وكذلك قوله تعالى: { لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا }، [137] إنما هو مصدر وليس بالمعهود البين جمع الشكر على الشكور واستعماله كذلك. كما لم يعهد ذلك في الكفور.
عاد كلامه، قال ويزيد هذا وضوحًا قولهم: أحببت حبًا. فالحب ليس بمصدر لأحببت. إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب. ولذلك جاء على وزنه مضموم الأول، ومن ثم جمع كما يجمع الشغل قال:
ثلاثة أحباب فحب علاقة ** وحب تملاق وحب هو القتل
فقد انكشف لك بقولهم أحببت حبًا ولم يقولوا: إحبابًا استغناء بالمفعول المطلق الذي هو أفيد عند المخاطب من الأحباب. أن حلمت حلمًا وشكرت شكرًا وكفر كفرًا وصنع صنعًا كلها واقعة على ما هو اسم للشيء المفعول وناصب له نصب المفعول المطلق. وهو في هذه الأفعال أجدر أن يكون كذلك، لأنها أعم من أحببت إذ الشكر واقع على أشياء مختلفة، وكذلك الكفر والشغل والحلم، وكلما كان الفعل أعم وأشيع لم يكن لذكر مصدره معنى وكان فعل ويفعل مغنيًا عنه. ولولا كشف الشاعر لاختلاف أنواع الحب ما كدنا نعرف ما فيه من العموم وإنه في معنى الشغل صار أحببت كشغلت وصار الحب كالشغل. ولو قال: أحبابًا لكان بمنزلة شغلت شغلًا بفتح الشين ألا ترى أنهم لا يجمعون من المصادر ما كان على وزن الأفعال. نحو الإكرام. وعلى وزن الإنفعال والافتعال والفعل ونحوها إلا أن يكون محدودًا كالتمرة من التمر.
وأما جمعه لاختلاف الأنواع فلا اختلاف للأنواع فيه، إنما اختلاف الأنواع فيما كان اسمًا مشتقًا من الفعل استغنى به عن المصدر لخصوصه وعموم المصدر. وذلك لا تجده في الثلاثي إلا على وزن فعل وفعل. ألا ترى أنهم لا يجمعون نحو الحذر والرمد والخدر والخفس والبرص والعمى وبابه.
قلت: فعل الحب فيه لغتان فعل وأفعل، وقد أنشدوا في الصحاح بيتين على اللغتين وهما:
أحب أبا مروان من أجل تمره ** وأعلم أن الحب بالمرء أرفق
ووالله لولا تمره ما حببته ** وكان عياض منه أدنى ومشرق
هكذا أنشده المبرد. والذي في الصحاح: * ولا كان أدنى من عبيد ومشرق * بالاقواء. [138] والبيتان لغيلان بن شجاع النهشلي وهو عربي فصيح. وإذا ثبت أنهما لغتان في أحببته حبًا فأنا له محب وهو محبوب على تداخل اللغتين فأتوا في المصدر بمصدر الثلاثي كالشكر والشغل، واستعملوا من الفعلين الرباعي في غالب كلامهم حتى كأنهم هجروا الثلاثي وأتوا بمصدره حتى كأنهم هجروا الرباعي، فلما جاؤوا إلى اسم الفاعل أتوا بالاسم من الرباعي حتى كأنهم لم ينطقوا بالثلاثي، فقالوا: محب ولم يقولوا: حاب أصلًا وجاؤوا إلى المفعول فأتوا به من الفعل الثلاثي في الأكثر فقالوا: محبوب، ولم يقولوا محب إلا نادرًا كما قال:
ولقد نزلت فلا تظني غيره ** مني بمنرلة المحب المكرم
هذا من أحببت كما أن المحبوب من حببت ثم استعملوا لفظ الحبيب في المحبوب أكثر من استعمالهم إياه في المحب مع أنه يطلق عليهما، فمن مجيئه بمعنى المفعول قول ابن الدمينة:
وإن الكثيب الفرد من جانب الحمى ** إلي وإن لم آته لحبيبُ
أي لمحبوب. ومن مجيئه للفاعل قول المجنون:
أتهجر ليلى للفراق حبيبَها ** وما كان نفسًا بالفراق تطيبُ
فهذا بمعنى محبها. وربما قالوا للحبيب: حِبّ مثل خدن. فخِدْن وخَدِين مثل حب وحبيب. وإذا ثبت هذا فقوله هذا رحمه الله: الحب ليس بمصدر لأحببت. إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب ليس الأمر كما قال: بل هي مصدر للثلاثي أجروه على الفعل الرباعي استغناء عن مصدره وهذا لكثرة ولوع أنفسهم بالحب وألسنتهم به، استعملوا منه أخف المصدرين استغناء به عن أثقلهما.
وأما مجيئه بالضم دون الفتح فكثير في ذلك وهو قوة هذا المعنى، وتمكنه من نفس المحب وقهره وإذلاله إياه. حتى إنه ليذل الشجاع الذي لا يذل لأحد فينقهر لمحبوبه ويستأسر له كما هو معروف في أشعارهم ونثرهم، وكما يدل عليه الوجود. فلما كان بهذه المثابة أعطوه أقوى الحركات وهي الضمة. فإن حركة المحب أقوى الحركات فأعطوا أقوى حركات المتحرك أقوى الحركات اللفظية ليتشاكل اللفظ والمعنى. فلهذا عدلوا عن قياس مصدره وهو الحب إلى نضمه.
وأيضا فإنهم كرهوا أن يجيئوا بمصدره على لفظ الحب الذي هو اسم جنس للمحبة ولم يكن بد من عدولهم إما إلى الضم أو إلى الكسر وكان الضم أولى لوجهين. أحدهما: قوته وقوة الحب. الثاني: أن في الضمة مع الجمع ما يوازي ما في معنى الحب من جمع الهمة والإرادة على المحبوب. فكأنهم دلوا السامع بلفظه وحركته وقوته على معناه.
وتأمل كيف أتوأ في هذا المسمى بحرفين أحدهما الحاء التي هي من أقصا الحلق مبدأ الصوت ومخرجها قريب من مخرج الهمزة من أصل المصدر الذي هو معدن الحب وقراره. ثم قرنوها بالباء التي هي من الشفتين وهي آخر مخارج الصوت ونهايته. فجمع الحرفان بداية الصرت ونهايته كما اشتمل معنى الحب على بداية الحركة ونهايتها. فإن بداية حركة المحب من جهة محبوبه ونهايتها إلى الوصول إليه، فاختاروا له حرفين هما بداية الصوت ونهايته، فتأمل هذه النكت البديعة تجدها ألطف من النسيم ولا تعلق إلا بذهن يناسبها لطافة ورقة.
فقل لكثيف الطبع ويحك ليس ذا ** بعشك فادرج سالمًا غير غانم
واشتقاقه في الأصل من الملازمة والثبات من قولهم: أحبَّ البعير فهو محب، إذا برك فلم يثر. قال:
حلت عليه بالقطيع ضربًا ** ضرب بعيرالسوء إذا حبا
فلما كان المحب ملازمًا لذكر محبوبه ثابت القلب على حبه مقيمًا عليه لا يروم عنه انتقالًا، ولا يبغي عنه زوالًا. وقد اتخذ له في سويداء قلبه وطنًا وجعله له سكنًا.
تزول الجبال الراسيات وقلبه ** على العهد لا يلوي ولا يتغير
فلذلك أعطوه هذا الاسم الدال على الثبات واللزوم، ولما جاؤوا إلى المحبوب أعطوه في غالب استعمالهم لفظ فعيل الدال على أن هذا الوصف وهو كون متعلق المحب أمر ثابت له لذاته، وإن لم يحب فهو حبيب سواء أحبه غيره أم لا. وهذا الوزن موضوع في الأصل لهذا المعنى الشريف وإن لم يشرفه غيره وهو من بناء الأوصاف الثابتة اللازمة كطويل وقصير وكريم وعظيم وحليم وجميل وبابه. وهذا بخلاف مفعول، فإن حقيقته لمن تعلق به الفعل ليس إلا مضروب لمن وقع عليه الضرب ومقتول ومأكول وبابه، فهجروا في أكثر كلامهم لفظ محبوب لما يؤذن من أنه الذي تعلق به الحب فقط، واختاروا له لفظ حبيب الدال على أنه حبيب في نفسه تعلق به الحب أم لا، ثم جاؤوا إلى من قام به الحب، فأعطوه لفظة محب دون حاب لوجهين:
أحدهما: أن الأصل هو الرباعي والنطق به أكثر فجاء على الأصل.
الثاني: أن حروفه أكثر من حروف حاب، والمحل محل تكثير لا محل تقليل.
فتأمل هذه المعاني التي لا تجدها في كتاب، وإنما هي روضة أنف منح العزيز الوهاب فهمها وله الحمد والمنة. وقد ذكرنا من هذا وأمثاله في كتاب التحفة المكية ما لو وجدناه لغيرنا لأعطيناه حقه من الاستحسان والمدح ولله الفضل والمنة.
وأما جمع الشاعر له على ثلاثة أحباب فلا يخرجه عن كونه مصدرًا لأنه أراد أن الحب ثلاثة أنواع وثلاثة ضروب وهذا تقسيم للمصدر نفسه وهو تقسيم صحيح فإن للحب بداية وتوسطًا ونهاية فذكر الشاعر الأقسام الثلاثة فحب البداية هو حب العلاقة ويسمى علاقة لتعلق القلب بالمحبوب قال الشاعر:
أعلاقة أم الوليد بعدما ** أفنانُ رأسِكِ كالثَّغام المُخلِس
والحب المتوسط، وهو حب التملق وهو التذلل والتواضع للمحبوب والانكسار له. وتتبع مواقع رضاه وإيقاعها على ألطف الوجوه فهذا هو التملق وهو إنما يكون بعد تعلق القلب به.
والحب الثالث الذي هو يباشر القلب ويصطلم العقل ويذهب اللب ويمنع القرار. وهذه المحبة تنقطع دونها العبارة وتمتنع إليها الإشارة. ولي فيها من أبيات:
وما هي إلا الموتُ أو هو دونها ** وفيها المنايا ينقلبن أمانيا
فقد بان لك أن الشاعر إنما أراد جمع الحب الذي هو المصدر باعتبار أنواعه وضروبه. ولنقطع الكلام في هذه المسألة فمن لم يشبع من هذه الكلمات ففي كتاب التحفة أضعاف ذلك والله الموفق.
عاد كلامه، قال: فإن قيل فقد قالوا: سقم وأسقام، والسقم مصدر سقم فهذا جمع لاختلاف الأنواع، لأنه اسم كما ذكرت.
قيل: هذه غفلة أليس قد قالوا: سقم بضم السين فهو عبارة عن الداء الذي يسقم الإنسان فصار كالدهن والشغل. وهو في ذاته مختلف الأنواع فجمع.
وأما المرض فقد يكون عبارة عن السقم والعلة فيجمع على أمراض، وقد يكون مصدرًا كقولك مرض فلا يجمع.
فإن قيل: تفريقك بين الأمرين دعوى فما دليلها؟
قلنا: قولك عرق يعرق عرقًا لا يخفى على أحد أنه مصدر عرق، والعرق الذي هو جسم سائل مائع سائل من الجسد لا يخفى على أحد أنه غير العرق الذي هو المصدر. وإن كان اللفظ واحدًا، فكذلك المرض يكون عبارة عن المصدر وعبارة عن السقم والعلة. فعلى هذا تقول: تصبب زيد عرقًا فيكون له إعرابان تمييز إذا أردت المائع ومفعول من أجله، أو مصدر مؤكد إذا أردت المصدر. وكذلك دميت أصبعي دمًا إذا أردت المصدر فهي مثل العمى، وإن أردت الشيء المائع. فهو دم مثل يد وقد يسمى المائع بالمصدر قال:
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومُنا ** ولكن على أعقابنا تقطر الدما
فهذا مقصور كالعصا. وعليه قول الآخر: * جرى الدميان بالخبر اليقين *
فصل: توكيد الفعل وتوكيد النكرة
ومن حيث امتنع أن يؤكد الفعل العام بالمصدر لشيوعه، كما يمتنع توكيد النكرة لشيوعها، وأنها لم تثبت لها عين لم يجز أن يخبر عنه، كما لا يخبر عن النكرة لا تقول من فعل: كان شرًا له بخلاف من كذب كان شرًا له، لأن كذب فعل خاص، فجاز الأخبار عما تضمنه من المصدر، ومن ثم لم يقولوا: فعلت سريعًا ولا عملت طويلًا. كما قالوا: سرت سريعًا وجلست طويلًا على الحال من المصدر، كما يكون الحال من الاسم الخاص، ولا يكون من النكرة الشائعة.
فإن قلت: اجعله نعتًا للمفعول المطلق كأنك قلت: فعلت فعلًا سريعًا وعملت عملًا كثيرًا.
قيل: لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت إلا على شروط مذكورة في موضعها فليس قولهم سرت سريعًا نعتًا لمصدر نكرة محذوفة، إنما هو حال من مصدر في حكم المعرفة بدلالة الفعل الخاص عليه. فقد استقام الميسم للناظر في فصول هذه المسألة واستتب القياس فيها من كل وجه.
فإن قيل: فما قولكم في علمت علمًا أليس هو مصدرًا لعلمت فلم جاء مكسور الأول كالطحن والذبح.
قيل: العلم يكون عبارة عن المعلوم كما تقول: قرأت العلم وعبارة عن المصدر نفسه الذي اشتق منه علمت. إلا أن ذلك المصدر مفعول لعلمت، لأنه معلوم بنفس العلم لأنك إذا علمت الشيء فقد علمته، وعلمت أنك علمته بعلم واحد فقد صار العلم معلومًا بنفسه، فلذلك جاء على وزن الطحن والذبح وليس له نظير في الكلام إلا قليل لا اعلم فعلًا يتناول المفعول ويتناول نفسه إلا العلم والكلام، لأنك تقول للمخاطب: تكلم، فيقول: قد تكلمت فيكون صادقًا وإن لم ينطق قبل ذلك ولهذا قال النبي ﷺ للأعرابي: لما قال له: يا ابن عبد المطلب قد أجبتك، وكان قد أجبتك جوابًا وخبرًا عن الجواب. فتناول القول نفسه، ولذلك تعبدنا في التلاوة أن نقول: قل هو الله أحد، لأن قل أمر يتناول ما بعده ويتناول نفسه، فمن ثم جاء مصدر القول على القيل، كما جاء مصدر علمت على العلم، وجاء أيضا على القال وهو على وزن القبض، لأن القول قد يكون مقولًا بنفسه، وجاء أيضا على الأصل مفتوح الأول، وأما العلم فلم يجىء إلا مكسورًا مصدرًا كان أو مفعولًا، لأنه لا يكون أبدًا إلا معلومًا بنفسه، والقول بخلاف ذلك قد يتناول نفسه في بعض الكلام وقد لا يتناول إلا المفعول وهو الأغلب.
وأما الفكر فليس باسم عند سيبويه. ولذلك منع من جمعه. فقال: لا يجمع الفكر على أفكار حمله على المصادر التي لا تجمع. وقد استهوى الخطباء والقصاص خلاف هذا وهو كالعلم لقربه منه في معناه ومشاركته له في محله، وأما الذكر فبمنزلة العلم لأنه نوع منه.
فصل: فيما يحدد من المصادر بالهاء
فيما يحدد من المصادر بالهاء وفيه بقايا من الفصل الأول.
قد تقدم أن الفعل لا يدل على مصدره إلا مطلقًا غير محدد ولا منعوت، وإنك إذا قلت ضربته ضربة. فإنما هو مفعول مطلق لا توكيد، لأن التوكيد لا يكون في معناه زيادة على المؤكد، ومن ثم لا تقول سير بزيد سريعة حسنة تريد سيرة، كذلك ولا قعدت طويلة لأن الفعل لا يدل بلفظه على المرة الواحدة، ومن ثم بطل ما أجازه النحاس وغيره من قوله: زيد ظننتها منطلق تريد الظنة، لأن الفعل لا يدل عليها.
وإذا ثبت هذا فالتحديد في المصادر ليس يطرد في جميعها. ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديد غالبًا، لأنه مضارع للأجناس الظاهرة التي يقع الفرق بين الواحد منه والجنس بهاء التأنيث نحو تمرة وتمر ونخلة ونخل، وكذلك تقول: ضربة وضرب.
وأما ما كان من الأفعال الباطنة نحو علم وحذر وفرق ووجل أو ما كان طبعًا نحو ظرف وشرف لا يقال في شيء من هذا فعلة لا يقال: فهم فهمة، ولا ظرف ظرفة. وكذلك ما كان من الأفعال عبارة عن الكثرة والقلة نحو طال وقصر وكبر وصغر وقل وكثر لا تقول فيه فعلة،
وأما قولهم الكبرة في الهرم. فعبارة عن الصفة وليست بواحدة من الكبر، وكذلك الكثرة ليست كالضربة من الضرب، لأنك لا تقول: كثر كثرا.
وأما حمدًا فما أحسبه يقال في تحديده حمدة، كما يقال مدحة، والفرق بينهما أن حمد يتضمن الثناء مع العلم بما يثنى به فإن تجرد عن العلم كان مدحًا ولم يكن حمدًا فكل حمد مدح دون العكس. ومن حيث كان يتضمن العلم بخصال المحمود جاء فعله على حمد بالكسر موازنًا لعلم ولم يجىء كذلك مدح، فصار المدح في الأفعال الظاهرة كالضرب ونحوه، ومن ثم لم تجد في الكتاب والسنة حمد ربنا فلانًا. ويقول: مدح الله فلانًا وأثنى على فلان ولا تقول: حمد إلا نفسه. ولذلك قال سبحانه: { الحمد لله } بلام الجنس المفيدة للاستغراق، فالحمد كله له إما ملكًا، وإما استحقاقًا، فحمده لنفسه استحقاق وحمد العباد له، وحمد بعضهم لبعض ملك له، فلو حمد هوغيره، لم يسع أن يقال في ذلك: الحمد ملك له، لأن الحمد كلامه، ولم يسغ أن يضاف إليه على جهة الاستحقاق وقد تعلق بغيره.
فإن قيل: أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما علم. فلم لا يجوز أن يسمى حمد؟
قيل: لا يسمى حمدًا على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن على الكمال، وذلك معدوم في غيره سبحانه، فإذا مدح فإنما يمدح بخصلة هي ناقصة في حق العبد وهو أعلم بنقصانها. وإذا حمد نفسه حمد بما علم من كمال صفاته.
قلت: ليس ما ذكره من الفرق بين الحمد والمدح باعتبار العلم وعدمه صحيحًا. فإن كل واحد منهما يتضمن العلم بما يحمد به غيره ويمدحه، فلا يكون مادحًا ولا حامدًا. من لم يعرف صفات المحمود والممدوح. فكيف يصح قوله إن تجرد عن العلم كان مادحًا. بل إن تجرد عن العلم كان كلامًا بغير علم. فإن طابق فصدق وإلا فكذب.
وقوله: ومن ثَم لم يجىء في الكتاب والسنة: حمد ربنا فلانًا، يقال: وأين جاء فيهما مدح الله فلانًا؟ وقد جاء في السنة ما هو أخص من الحمد، وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد كما في قول النبي ﷺ لأهل قباء: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ فإذا كان قد أثنى عليهم والثناء حمد متكرر فما يمنع حمده لمن شاء من عباده.
ثم الصحيح في تسمية النبي ﷺ محمدًا أنه الذي يحمده الله وملائكته وعباده المؤمنون. وأما من قال: الذي يحمده أهل السموات وأهل الأرض، فلا ينافي حمد الله تعالى، بل حمد أهل السموات والأرض له بعد حمد الله له؛ فلما حمده الله حمده أهل السموات والأرض.
وبالجملة لما كان الحمد ثناء خاصًا على المحمود لم يمتنع أن يحمد الله من يشاء من خلقه كما يثنى عليه. فالصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون أخبارًا مجردًا من حب وإرادة أو مقرونًا بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ولهذا كان خبرًا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد فالقائل إذا قال: الحمد الله، أو قال: ربنا لك الحمد. تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد.
ولما كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تتقوم حقيقته إلا به فسره من فسره بالرضى والمحبة. وهو تفسير له بجزء مدلوله. بل هو رضاء ومحبة مقارنة للثناء. ولهذا السر والله أعلم. جاء فعله على بناء الطبائع والغرائز فقيل: حمد، لتضمنه الحب الذي هو بالطبائع والسجايا أولى وأحق من فهم وحذر وسقم ونحوه بخلاف الأخبار المجرد عن ذلك وهو المدح. فإنه جاء على وزن فعل فقالوا: مدحه لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع، فتأمل هذه النكتة البديعة، وتأمل الإنشاء الثابت في قولك: ربنا لك الحمد، وقولك: الحمد الله كيف تجده تحت هذه الألفاظ، ولذلك لا يقال موضعها المدح لله، ولا ربنا لك المدح، وسره ما ذكرت لك من الأخبار بمحاسن المحمود اخبارًا مقترنًا بحبه وإرادته وإجلاله وتعظيمه.
فإن قلت: فهذا ينقض قولكم أنه لا يمتنع أن يحمد الله تعالى من شاء من خلقه. فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء، ولا يستحق التعظيم غيره، فكيف يعظم أحد من عباده؟
قلت: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله، وكذلك محبة الوالدين والعلماء وملوك العدل، وأما محبة الرب عبده. فإنها تستلزم إعزازه لعبده، وإكرامه إياه، والتنويه بذكره وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه، فهذا المعنى ثابت في محبته. وحمده لعبده سمي تعظيمًا وإجلالًا أو لم يسم، ألا ترى أن محبته سبحانه لرسله كيف اقتضت أن نوه بذكرهم في أهل السماء والأرض، ورفع ذكرهم على ذكر غيرهم، وغضب على من لم يحبهم ويوقرهم ويجلهم، وأحل به أنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، وجعل كرامته في الدنيا والآخرة لمحبيهم وأنصارهم وأتباعهم. أو لا ترى كيف أمر عباده وأولياءه بالصلاة التي هي تعظيم وثناء على خاتمهم، وأفضلهم صلوات الله عليه وسلامه. أفليس هذا تعظيمًا لهم وإعزازًا وإكرامًا وتكريمًا.
فإن قيل: فقد ظهر الفرق بين الحمد والمدح. واستبان صبح المعنى وأسفر وجهه. فما الفرق بينهما وبين الثناء والمجد؟
قيل: قد تعدينا طورنا فيما نحن بصدده. ولكن نذكر الفرق تكميلًا للفائدة فنذكر تقسيمًا جامعًا لهذه المعاني الأربعة أعني الحمد والمدح والثناء والمجد. فنقول:
الإخبار عن محاسن الغير له ثلاثة اعتبارات. اعتبار من حيث المخبر به. واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخبر. واعتبار من حيث حال المخبر، فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد والمجد. فإن المخبر به أما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال والسعة وتوابعها، أو من أوصاف الجمال والاحسان وتوابعها. فإن كان الأول فهو المجد، وإن كان الثاني فهو الحمد. وهذا، لأن لفظ م ج د في لغتهم يدور على معنى الاتساع والكثرة فمنه قولهم أمجد الدابة علفًا أي أوسعها علفًا، ومنه مجد الرجل فهو ماجد إذا كثر خيره وإحسانه إلى الناس. قال الشاعر:
أنت تكون ماجد نبيلُ ** إذا تهبُّ شَمأل بليلُ
ومنه قولهم: في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار، أي كثرت النار فيهما.
ومن حيث اعتبار الخبر نفسه ينشأ التقسيم إلى الثناء والحمد. فإن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو ص لا. فإن تكرر فهو الثناء وإن لم يتكرر فهو الحمد فإن الثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض ومنه ثنيت الثوب ومنه التثنية في الاسم فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة.
ومن جهة اعتبار حال المخبر ينشأ التقسيم إلى المدح والحمد، فإن المخبر عن محاسن الغير أما أن يقترن بإخباره حب له وإجلالًا أو لا. فإن اقترن به الحب فهو الحمد والإ فهو المدح، فحصل هذه الأقسام وميزها، ثم تأمل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه رسول الله ﷺ حين يقول العبد: { الحمد لله رب العالمين } فيقول الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، لأنه كرر حمده، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي فإنه وصفه بالملك والعظمة والجلال.
فاحمد الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عفوًا لم تسهر فيها عينك، ولم يسافر فيها فكرك عن وطنه ولم تتجرد في تحصيلها عن مألوفاتك. بل هي عرائس معان تجلى عليك وتزف إليك فلك لذة التمتع بها، ومهرها على غيرك، لك غنمها وعليه غرمها.
فصل: تثنية المصادر وجمعها
فلنرجع إلى كلامه، قال: وكل ما حدد من المصادر تجوز تثنيته وجمعه وما لم يحدد فعل الأصل الذي تقدم لا يثنى، ولا يجمع وقولهم: إلا أن تختلف أنواعه لا تختلف أنواعه، إلا إذا كان عبارة عن مفعول مطلق اشتق من لفظ الفعل لا عن مصدر اشتق الفعل منه، ولذلك تجده على وزن فعل بالكسر وعلى وزن فعل نحو عمل. والذي هو مصدر حقيقة ما تجده على وزن فعل نحو ضرب وقتل. وأما الشرب بالفتح والضم والكسر فالشرب بالفتح هو المصدر، والشرب بالضم عبارة عن المشروب، أو عن الحدث الذي هو مفعول مطلق في الأصل، وربما اتسع فيه فأجرى مجرى المصدر الذي اشتق الفعل منه كما قال تعالى: { فشاربون شرب الهيم }، [139] بالضم والفتح.
قلت: هذه كبوة من جواد ونبوة من صارم، فإن الشرب بالضم هو المصدر، وأما المشروب فهو الشرب بكسر الشين. قال تعالى في الناقة: { لها شرب ولكم شرب يوم معلوم }، [140] فهذا هو المشروب كما تقول: قسم من الماء وحظ ونصيب تشربه في يومها، ولكم حظ وقسم تستوفونه في يومكم وهذا هو القياس في الباب، كالذبح بمعنى المذبوح، والطحن للمطحون والحب للمحبوب والحمل للمحمول والقسم للمقسوم والعرب للزوجة التي قد عرس بها ونظائره كثيرة جدًا.
وأما الشرب بالفتح فقياسه أن يكون جمع شارب كصاحب وصحب وتاجر وتجر، وهو يستعمل كذلك وإطلاق لفظ الجمع عليه جريًا على عادتهم، والصواب أنه اسم جمع فإن فعلًا ليس من صيغ الجموع، واستعمل أيضا مصدرًا وقد قرئت الآية بالوجوه الثلاثة، فمن قرأ بالضم أو الفتح فهو مصدر، ومن قرأ بالكسر فهو بمعنى المشروب. وعلى الأول يقع التشبيه بين الفعلين وهو المقصود بالذكر شبه شربهم من الحميم بشرب الإبل العطاش التي قد أصابها الهيام وهو داء تشرب منه ولا تروى وهو جمع أهيم وأصله هيم بضم الهاء كأحمر وحمر، ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل الياء فقالوا: هيم. وأما قراءة الكسر فوجهها أنه شبه مشروبهم بمشروب الإبل الهيم في كثرته وعدم الري به والله أعلم.
عاد كلامه قال: فإن قيل: فإن الفهم والعقل والوهم والظن مصادر وليست مما ذكرت. وقد جمعت فقالوا: أفهام وأوهام وعقول.
قيل: هذه مصادر في أصل وضعها. ولكنها قد أجريت مجرى الأسماء حيث صارت عبارة عن صفة لازمة وعن حاسة ناطقة كالبصر. ألا ترى أنك إذا قلت: عقلت البعير عقلًا، لم يجز في هذا المصدر الجمع. فإذا أردت به المعنى الذي استعير له وهو عقل الإنسان جاز جمعه إذا صار للإنسان كأنه حاسة ناطقة كالبصر. ألا ترى أن البصر حيثما ورد في القرآن مجموع، والسمع غير مجموع في أجود الكلام لبقاء السمع على أصله من بناء المصادر الثلاثية ولكون البصر على وزن فعل كالأسماء، ولأنه يراد به الحاسة. وقد يجوز في السمع على ضعف أن تجمعه إذا أردت به الحاسة دون المصدر، كما تجمع الفهم على أفهام. ولكن لا يكون ذلك إلا بشرط. وهو أن تكون الأفهام والأسماع ونحوها مضافة إلى جمع نحو أفهام القوم وأسماع الزيدين ولو كان هذا الجمع. إنما هو لاختلاف أنواع المصدر لما جاز أن تقول: عرفت أفهام القوم في هذه المسألة وعرفت علومهم، لأن الصفة لا تختلف عند اتحاد متعلقها بل هي مماثلة. وإن اختلفت محالها فعلم زيد وعلم عمرو وإذا تعلقا بشيء واحد فهما مثلان وعلم زيد بشيء واحد، وعلمه بشيء آخر مختلفان لاختلاف المعلومين.
والمقصود أن الأفهام والعقول لا تجمع لاختلاف أنواعها، لأنها قد تجمع حيث لا تختلف. وهي عند اتفاق أفهام على مفهوم واحد وتجيء مفردة عند اختلافها نحو فهم زيد الحساب والنحو وغيرهما. لا يقال فيه: عرفت أفهام زيد بالعلوم، ولكن تقول: فهم زيد بالافراد مع اختلاف متعلقه. واختلاف متعلقه يوجب اختلافه.
وإذا ثبت هذا فلم يجمع الفهم على أفهام إلا من حيث كان بمنزلة حاسة ناطقة للإنسان. فإذا أضيف إلى أكثرين جمع، وإذا أضيف إلى واحد لم يجمع، لأنه كالحاسة الواحدة وإن كان في أصله مصدرًا فرب مصدر أجرى مجرى الأسماء كضيف وضيفان وعدل وعدول وصيد وصيود.
وأما رؤية العين فليست التاء فيها للتحذير بل هي لتأنيث الصفة كالقدرة والصفرة والحمرة وكان الأصل فيها رأيًا، ولكنهم إنما يستعملون هذا الأصل مضافًا إلى العين نحو قوله تعالى: { رأي العين } [141] فاذا لم تضف استعمل في الرأي المعقول، واستعملت الرؤية في المعنى الآخر للفرق.
وأما الظن فمصدر لا يثنى ولا يجمع إلا أن تريد به الأمور المظنونة نحو قوله تعالى: { وتظنون بالله الظنونا }، [142] أي يظنون أشياء كاذبة. والظنون على هذا مفعول مطلق. لا عبارة عن الظن الذي هو المصدر في الأصل. والله أعلم.
فائدة: لفظ سحر وتقسيمه
سحر على قسمين: أحدهما يراد به سحر يوم بعينه معرفة كان اليوم أو نكرة. وهو في هذا ظرف غير منون، بشرط أن يكون اليوم ظرفًا لا فاعلًا ولا مفعولًا. وفيه وجهان:
أحدهما: أن تعريفه لما فيه من معنى الإضافة فإنك تريد سحر ذلك اليوم، فحذف التنوين منه، كما حذف في أجمع وأكتع لما كان مضافًا في المعنى.
والوجه الثاني: وهو اختيار سيبويه أن تعريفه باللام المقدرة كأنك حين ذكرت يومًا قبله وجعلته ظرفًا، ثم ذكرت سحر فكأنك أردت السحر الذي من ذلك اليوم فاستغنيت عن الألف واللام بذكر اليوم. وهذا القول أصح للفرق الذي بين سحر وبين أجمع، فإن أجمع توكيد بمنزلة كله ونفسه فهو مضاف في المعنى إلى ضمير المؤكد، واستغنى عن إظهار الضمير بذكر المؤكد، لأن أجمع لا يكون إلا تابعًا له ولا يكون مخبرًا عنه بحال. وليس كذلك السحر، لأنه بمنزلة الفرس والجمل، فإن أضفته لم يكن بد من إظهار المضاف إليه. وإنما هو معرف باللام كما قال سيبويه وهذا كله لما كان اليوم ظرفًا لا مفعولًا. فلو قلت: كرهت يوم السبت سحر كان بدلًا، كما تقول: أكلت الشاة رأسها.
فإن قيل: فهلا قلتم أنه بدل إذا كان ما قبله ظرفًا أيضا، لأنه بعض اليوم فيكون بدل البعض من الكل كما كان ذلك إذا كان اليوم مفعولًا.
قيل: الفرق بينهما. أن البدل يعتمد عليه ويكون المبدل منه في حكم الطرح، ويكون الفعل مخصوصًا بالبدل بعد ما كان عمومًا في المبدل منه. فإذا قلت: أكلت السمكة رأسها. لم يتناول الأكل إلا رأسها وخرج سائرها من أن يكون مأكولًا، وليس كذلك خرجت يوم الجمعة سحر، لأن الظرف مقدر بفي وجعل سحر ظرفًا لا يخرج اليوم عن أن يكون ظرفًا بل يبقى على حاله، لأنه ليس من شرط الظرف أن يملأه ما يوضع فيه، فالكلام معتمد عليه كما كان قبل ذكر سحر نعم وما هو أوسع من اليوم في المعنى نحو الشهر والعام الذي فيه ذكر اليوم وماهو أوسع من العام، كالزمان كل واحد من هذه ظرف للفعل الذي وقع في سحر بالذكر، فذكر سحر لا يخرج شيء منها أن يكون ظرفًا للفعل فلذلك اعتمد الكلام على اليوم واستغني به عن تجديد آلة التعريف بخلاف كرهت يوم السبت سحرًا، أو السحر منه. لا بد من البدل فيه.
فقد بان الفرق وبانت علة ارتفاع التنوين، لأنه لا يجامع الألف واللام ولا معناها. وإن كان في حكم المضاف كما زعم بعضهم، فلذلك أيضا امتنع تنوينه.
وأما مانع تصرفه وتمكنه فإنك لما أردته ليوم هو ظرف فلو تمكن خرج عن أن يكون من ذلك اليوم، لأن الظرفية كانت رابطة بينهما ومشعرة بأن السحر من ذلك اليوم، فإذا قلت: سير يزيد يوم الجمعة سحر وجعلته مفعولًا على السعة لم يجز لعدم الرابط بينه وبين اليوم، فإن أردت هذا المعنى فقل: سير يزيد يوم الجمعة سحر، أو السحر منه حتى يرتبط به، لأنك لا تقدر الألف واللام من غير أن يلفظ بهما إلا إذا كان في الكلام ما يغني عنهما، وأما إذا كان اسمًا متمكنًا كسائر الأسماء فلا بد من تعريفه بما تعرف به الأسماء، أو تجعله نكرة فلا يكون من ذلك اليوم.
فإن قلت: فقد أجازوا سير يزيد يوم الجمعة سحر برفع اليوم ونصب سحر فلم لا يجوز أيضا يوم الجمعة سحر بنصب اليوم ورفع سحر.
قيل: لأن اليوم وإن اتسع فيه فهو ظرف في معناه وهو يشتمل على السحر ولا يشتمل السحر عليه. فلا يجوز إذًا أن يتعرف السحر تعريفًا معنويًا جتى يكون ظرفًا بمنزلة اليوم الذي هو منه ليكون تقديم اليوم مع كونه ظرفًا مغنيًا عن آلة التعريف.
فصل: ضحوة وعشية ومساء
وأما ضحوة وعشية ومساء ونحو ذلك، فإنها مفارقة لسحر من حيث كانت منونة، وإن أردتها ليوم بعينه وهي موافقة له في عدم التصرف والتمكن. والفرق بينهما أن هذه أسماء فيها معنى الوصف، لأنها مشتقة مما توصف به الأوقات التي هي ساعات اليوم، فالعشي من العشاء والضحوة من قولك فرس أضحى وليلة أضحيان يريد البياض والصباح من الصبح وهو لون بين لونين. فإذا قلت: خرجت اليوم عشاء وظلامًا وضحى وبصرًا حكاه سيبويه، فإنما تريد خرجت اليوم في ساعة وصفها كذا. وخرجت وقتًا مظلمًا أو مبصرًا ونحو ذلك. فقد بان لك أنها أوصاف لنكرات، وتلك النكرات هي أجزاء اليوم وساعاته. ألا ترى أنك إذا قلت: خرجت اليوم ساعة منه أو مسيت اليوم وقتًا منه لم يكن إلا منونًا إلا أن ساعة ووقتًا غير معين. وضحوة وعشية قد تخصصا بالصفة، ولكنه لم يتعرف وإن كان ليوم بعينه، لأنه غير معرف بالألف واللام كما كان سحر، لأن سحر اسم جامد يتعرف كالأسماء ويخبر عنه، وأما نعته فلا يكون كذلك لأن النعت لا يكون فاعلًا ولا مفعولًا. ولا يقام مقام المنعوت إلا على شروط مخصوصة.
فإن قلت: أليس هذه الأوقات معروفة عند المخاطب من حيث كانت ليوم بعينه فلم لا تكون معرفة كما كان سحر إذا كان ليوم بعينه؟
قيل: إن سحر لم يتعرف بشيء إلا بمعنى الألف واللام. لا من حيث كان ليوم بعينه فقد تعرف المخاطب الشيء بصفته كما تعرفه بآلة التعريف، فتقول: رأيت رجلًا من صفته كذا وكذا حتى يعرفه المخاطب فيسري إليه التعريف. وهو مع ذلك نكرة، وكذلك ضحوة وعشية، وإنما استغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدم ذكر اليوم الذي هو مشتمل على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني، كما استغني عن ذكر المنعوت إذا قلت: زيد قائم، ولا شك أن المعنى زيد رجل قائم ولكن ترك ذكر الرجل، لأنه زيد. وكذلك جاءني زيد صالحًا أي رجلًا صالحًا. ولكن زيد هو الرجل فأغناك عن ذكره، وكذلك ما نحن بسبيله من هذه الأسماء التي هي في نفسها أوصاف لأوقات أغنى ذكر اليوم الذي هي له عن ذكرها لاشتمالها عليه، ولم يكن ذلك في سحر، ومن ثم أيضا لم تتمكن فتقول: سير عليه يوم الجمعة ضحوة وعشية، لأن تمكنها يخرجها إلى حيز الأسماء ويبطل منها معنى الصفة. فلا ترتبط حينئذ باليوم الذي أردتها له، وينضاف إلى هذه العلة علة أخرى قد تقدمت في فصل سحر. وكذلك كل ما كان من الظروف نعتًا في الأصل نحو ذا حاج وكلت مرة وأقمت طويلًا وجلست قريبًا لا يتمكن ولا يخرج من الظرف.
ويلحق بهذا الفصل نهارًا إذا قلت: خرجت اليوم نهارًا، لأنه مشتق من أنهر الدم بما تشتت تريد الانتشار والسعة ومنه النهر من الماء، لأنه بالإضافة إلى موضع تفجره كالنهار بالإضافة إلى فجره، لأن النهر ما ينتشر ويتسع فما انفجر من الماء والنهر بمنزلة ما انتشر، واتسع من فجر الضياء واليوم أوسع من النهار في معناه. فصار قولك خرجت اليوم نهارًا كقولك خرجت اليوم ظهرًا أو عشيًا، معنى الاشتقاق فيها كلها بين فجرت مجرى الأوصاف للنكرات في تنوينها وعدم تمكنها.
قلت: ولما كان النهار أوسع من النهر خص بالألف المعطية اتساع النطق وانفتاح الفم دون النهر.
فصل: غدوة وبكرة
وأما غدوة وبكرة فهما اسمان علمان وعدم التنوين فيهما للتعريف والتأنيث، والذي أخرجهما عن باب ضحوة وعشية وإن كان فيهما معنى الغدو والبكور كما كان في أخواتهما معاني الفعل. إنهما قد بنيا بناء لا يكون عليه المصادر ولا النعوت وغيرها للعلمية. كما غير عمارة وعمر وأشباههما، وكما غير الدبران وفيه معنى الدبور إيذانًا بالعلمية وتحقيقًا لمعناها. ألا ترى أن ضحوة على وزن صعبة من النعوت وضربة من المصادر، والمصادر ينعت بها، وضحى على وزن هدى وعلى وزن حطم من النعت، وكذلك سائر تلك الأسماء وغدوة وبكرة بخلاف ذلك قد غيرنا عن لفظ الغدو والبكور تغييرًا بينًا، ففارقتا الفصل المتقدم.
فإن قيل: فلعل امتناع التنوين فيهما بمثابة امتناعه في سحر ليوم بعينه.
قيل: كلام العرب يدل على خلاف ذلك، لأنهم لا يكادون يقولون: خرجت اليوم في الغدوة وللغدوة خير من أول الليل. كما يقال: السحر خير من أول الليل. فالسحر كسائر الأجناس في تنكيره وتعريفه وغدوة وبكرة من اليوم بمنزلة رجب وصفر من العام، فقد تبين مخالفتهما لسحر وضحوة وأخواتهما، وإنهما بمنزلة أسماء الشهور الأعلام وأسماء الأيام نحو السبت والجمعة.
وإذا ثبت هذا فهما اسمان متمكنان يجوز إقامتهما مقام الفاعل. إذا قلت سير بزيد يوم الجمعة غدوة فلا يحتاج إلى إضافة، ولا إلى لام تعريف، وتقول: سير به يوم الجمعة غدوة على الظرف فيهما جميعًا، لأنها بعض اليوم كما تقول: سرت العام رجبًا كله. وتقول أيضا سير به يوم الجمعة غدوة برفعهما كأنهما بدل من اليوم، ولا تحتاج أيضا إلى الضمير كما تحتاج في بدل البعض من الكل، لأنها ظرف في المعنى. ولو قلت: كره يوم السبت غدوة على البدل لم يكن بد من إضافة غدوة إلى ضمير المبدل منه، لأن اليوم ليس بظرف فيكون كقولك: كرهت الخميس سحره إذا أردت البدل، لأن المكروه هو السحر دون سائر اليوم، وإنما يستغنى عن ضمير يعود على اليوم إذا تركته ظرفًا على حاله، لأن بعض اليوم إذا كان ظرفًا لفعل كان جميع ذلك اليوم ظرفًا لذلك الفعل.
واعلم أنه ما كان من الظروف له اسم علم. فإن الفعل إذا وقع فيه تناول جميعه وكان الظرف مفعولًا على سعة الكلام. فإذا قلت: سرت غدوة فالسير وقع في الوقت كله، وكذلك سرت السبت والجمعة وصفر والمحرم كله مفعول على سعة الكلام لا ظرف للفعل، لأن هذه الأسماء لا يطلبها الفعل، ولا هي في أصل موضوعها زمان. إنما هي عبارة عن معان أخر. فإن أردت أن تجعل شيئًا منها ظرفًا ذكرت لفظ الزمان وأضفته إليها كقولك سرت يوم السبت وشهر المحرم. فالسير واقع في الشهر ولا يتناول جميعه إلا بدليل والشهر ظرف، وكذلك اليوم.
قال سيبويه: ومما لا يكون الفعل إلا واقعًا به كله سرت المحرم وصفر، هذا معنى كلامه. وإذا ثبت هذا فرجب ورمضان أسماء أعلام إذا أردتها لعام بعينه، أو كان في كلامك ما يدل على عام تضيفها إليه، فإن لم يكن كذلك صار الاسم نكرة تقول: صمت رمضان ورمضانًا آخر، وصمت الجمعة وجمعة أخرى، إنما أردت جمعة أسبوعك ورمضان عامك. وإذا كان نكرة لم يكن إلا شهرًا واحدًا كما تكون النكرة من قولك ضربت رجلًا إنما تريد واحدًا، وإذا كان معرفة يكون ما يدل على التمادي وتوالي الأعوام. لم يكن حينئذ واحدًا كقولك المؤمن يصوم رمضان فهو معرفة، لأنك لا تريده لعام واحد بعينه إذ المعنى يصوم رمضان من كل عام على التمادي وذكر الإيمان قرينة تدل على أن المراد ولو لم يكن في الكلام ما يدل على هذا لم يكن محمله إلا على العام الذي أنت فيه.
وإذا ثبت هذا فانظر إلى قوله تعالى: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن }، [143] وفي الحديث: «من صام رمضان»، وإذا دخل رمضان بدون لفظ الشهر، ومحال أن يكون فعل ذلك إيجازًا واختصارًا، لأن القرآن أبلغ إيجازًا وأبين إعجازًا، ومحال أيضا أن يدع لفظ القرآن مع تحريه لألفاظه وما علم من عادته من الاقتداء به فيدع ذلك لغير حكمة بل فائدة جسيمة ومعان شريفة اقتضت الفرق بين الموضعين.
وقد ارتبك الناس في هذا الباب فكرهت طائفة أن تقول: صمت رمضان بل شهر رمضان، واستهوى ذلك الكتاب واعتل بعضهم في ذلك برواية منحولة إلى ابن عباس: رمضان اسم من أسماء الله. قالوا: ولذلك أضيف إليه الشهر وبعضهم يقول: إن رمضان من الرمضاء وهو الحر وتعلق الكراهية بذلك، وبعضهم يقول: إن هذا استحباب واقتداء بلفظ القرآن.
وقد اعتنى بهذه المسألة أبو عبد الرحمن النسائي لعلمه وحذقه فقال في السنن: باب جواز أن يقال دخل رمضان أو صمت رمضان، وكذلك فعل البخاري وأورد الحديث المتقدم من صام رمضان.
وإذا أردت معرفة الحكمة والتحقيق في هذه النكتة فقد تقدم أن الفعل إذا وقع على هذه الأسماء الأعلام فإنه يتناول جميعها ولا يكون ظرفًا مقدرًا بفي حتى يذكر لفظ الشهر، أو اليوم الذي أصله أن يكون ظرفًا. وأما الاسم العلم فلا أصل له في الظرفية.
وإذا ثبت هذا فقوله سبحانه: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } فيه فائدتان أو أكثر:
إحداهما أنه لو قال: رمضان الذي أنزل فيه القرآن لاقتضى اللفظ وقوع الإنزال على جميعه كما تقدم من قول سيبويه. وهذا خلاف المعنى. لأن الإنزال كان في ليلة واحدة منه في ساعة منها. فكيف يتناول جميع الشهر وكان ذكر الشهر الذي هو غير علم موافقًا للمعنى كما تقول: سرت في شهر كذا فلا يكون السير متناولًا لجميع الشهر.
والفائدة الأخرى أنه لو قال: رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكان حكم المدح والتعظيم مقصورًا على شهر بعينه. إذ قد تقدم أن هذا الاسم وما هو مثله إذا لم تقترن به قرينة تدل على توالي الأعوام التي هو فيها لم يكن محله إلا العام الذي أنت فيه أو العام المذكور قبله، فكان ذكر الشهر الذي هو الهلال في الحقيقة كما قال الشاعر: * والشهر مثل قلامة الظفر * يريد الهلال، مقتضيًا لتعليق الحكم الذي هو التعظيم بالهلال والشهر المسمى بهذا الاسم متى كان في أي عام كان. مع أن رمضان وما كان مثله لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن، لأنه لم يرد لعام بعينه. ألا ترى أن الآية في سورة البقرة وهي من آخر ما نزل. وقد كان القرآن أنزل قبل ذلك بسنين. ولو قلت: رمضان حج فيه زيد تريد فيما سلف لقيل لك أي رمضان كان ولزمك أن تقول: حج في رمضان من الرمضانات حتى تريد عامًا بعينه كما سبق.
وفائدة ثالثة في ذكر الشهر وهو التبيين في الأيام المعدودات، لأن الأيام تبين بالأيام وبالشهر ونحوه، ولا تبين بلفظ رمضان لأن لفظه مأخوذ من مادة أخرى. وهو أيضا علم فلا ينبغي أن يبين به الأيام المعدودات حتى يذكر الشهر الذي هو في معناها، ثم تضاف إليه.
وأما قوله ﷺ: «من صام رمضان»، ففي حذف الشهر فائدة أيضا، وهى تناول الصيام لجميع الشهر. فلو قال: من صام أو قام شهر رمضان لصار ظرفًا مقدرًا بفي، ولم يتناول القيام والصيام جميعه. فرمضان في الحديث مفعول على السعة نحو قوله: { قم الليل } لأنه لو كان ظرفًا لم يحتج إلى قوله: { إلا قليلًا }. [144]
فإن قيل: فينبغي أن يكون قوله من قام رمضان مقصورًا على العام الذي هو فيه لما تقدم من قولكم إنه إنما يكون معرفة علمًا. إذا أردته لعامك، أو لعام بعينه.
قيل: قوله: من صام رمضان على العموم خطاب لكل فرد ولأهل كل عام فصار بمنزلة قولك: من صام كل عام رمضان كما تقول: إن جئتني كل يوم سحر أعطيتك فقد مر قرينة تدل على التمادي وتنوب مناب ذكر كل عام. وقد اتضح الفرق بين الحديثين والآية فاذا فهمت فرق ما بينهما بعد تأمل هذه الفصول وتدبرها، ثم لم تعدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرها. فما قدرتها حق قدرها والله المستعان على واجب شكرها. هذا نص كلام السهيلي بحروفه. ثم قال:
فصل: عمل الفعل وشروطه
الفعل لا يعمل في الحقيقة إلا فيما يدل عليه لفظه، كالمصدر والفاعل والمفعول به، أو فيما كان صفة لواحد من هذه. نحو سرت سريعًا وجاء زيد ضاحكًا، لأن الحال هي صاحب الحال في المعنى، وكذلك النعت والتوكيد والبدل كل واحد من هذه هو الاسم الأول في المعنى فلم يعمل الفعل إلا فيما دل عليه لفظه، لأنك إذا قلت: ضرب اقتضى هذا اللفظ ضربًا وضاربًا ومضروبًا، وأقوى دلالته على المصدر، لأنه هو الفعل في المعنى ولا فائدة في ذكره مع الفعل إلا أن تريد التوكيد، أو تبيين النوع منه وإلا فلفظ الفعل مغن عنه، ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول به من وجهين:
أحدهما: أنه يدل على الفاعل بعمومه وخصوصه نحو فعل زيد وعمل عمرو. وأما الخصوص فنحو ضرب زيد عمرًا، ولا تقول: فعل زيد عمرًا إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه.
والوجه الآخر أن الفعل هو حركة الفاعل والحركة لا تقوم بنفسها. وإنما هي متصلة بمحلها، فوجب أن يكون الفعل متصلًا بفاعله لا بمفعوله، ومن ثم قالوا: ضرب زيد لعمرو وضرب زيد عمرًا فأضافوه إلى المفعول باللام تارة، وبغير لام أخرى. ولم يضيفوه إلى الفاعل باللام أصلًا، لأن اللام تؤذن بالانفصال، ولا يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظًا، كما لا ينفصل عنه معنى.
قلت: وفي صحة قوله ضرب زيد لعمرو نظر، والمعروف الإتيان بهذه اللام إذا ضَعُف الفعل بالتأخير، نحو قوله تعالى: { إن كنتم للرؤيا تعبرون }، [145] أو كان اسمًا نحو أنا ضارب لزيد، أو يعجبني ضربك لزيد، لضعف العامل في هذه المواضع دعم باللام. ولا يكادون يقولون: شربت للماء وأكلت للخبز.
قال: فإن قيل: فإن الفعل لا يدل على الفاعل معينًا، ولا على المفعول معينًا. وإنما يدل عليهما مطلقًا، لأنك إذا قلت: ضرب لم يدل على زيد بعينه. وإنما يدل على ضارب، وكذلك المضروب وكان ينبغي أن لا يعمل حتى تقول ضرب ضارب مضروبًا بهذا اللفظ، لأن لفظ زيد لا يدل عليه لفظ الفعل، ولا يقتضيه.
قيل: الأمر كما ذكرت، ولكن لا فائدة عند المخاطب في الضارب المطلق، ولا في المفعول المطلق، لأن لفظ الفعل قد تضمنهما. فوضع الاسم المعين مكان الاسم المطلق تبيبنًا له. فيعمل فيه الفعل، لأنه هو في المعنى وليس بغيره.
قلت: الواضع لم يضع هذه الألفاظ في أصل، الخطاب مقتضية فاعلًا مطلقًا ومفعولًا مطلقًا. وإنما جاء اقتضاء المطلق من العقل لا من الوضع. والواضع إنما وضعها مقتضيات لمعين من فاعل ومفعول طالبة له. فما لم يقترن بها المعين كان اقتضاؤها وطلبها بحاله، لأن الأخبار والطلب، إنما يقعان على المعين.
فإن قيل: فلو كانت قد وضعت مقتضية لمعين لم يصح إضافتها إلى غيره، فلما صح نسبتها وإضافتها إلى كل معين علم أنها وضعت مقتضية للمطلق.
قيل: الفرق بين المعين على سبيل البدل والمعين على سبيل التعيين بحيث لا يقوم غيره مقامه. والسؤال إنما يلزم أن لو قيل: إنها مقتضية للثاني. أما إذا كانت مقتضية لمعين من المعينات على سبيل البدل لم يلزم ذلك السؤال والله أعلم.
قال: وإذا ثبت ما قلناه فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه الفعل إلا بواسطة حرف نحو المفعول معه والظرف المكاني نحو قمت في الدار، لأنه لا يدل عليه بلفظه، وأما ظرف الزمان فكذلك أيضا، لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه ولا بنسبته، وإنما يدل بنسبته على اختلاف أنواع الحدث وبلفظه على الحدث نفسه. وهكذا قال سيبويه في أول الكتاب، وإن تسامح في موضع آخر.
وأما الزمان فهو حركة الفلك فلا ارتباط بينه وبين حركة الفاعل إلا من جهة الإتفاق والمصاحبة، إلا أنهم قالوا: فعلت اليوم، لأن اليوم ونحوه أسماء وضعت للزمان يؤرخ بها الفعل الواقع فيها. فإذا سمعها المخاطب علم المراد منها واكتفى بصيغتها عن الحرف الجار. فإن أضمرتها لم يكف لفظ الإضمار ولا أغنى عن الحرف، لأن لفظ الإضمار يصلح للزمان ولغيره فقلت: يوم الجمعة خرجت فيه. وقد تقول: خرجت في يوم الجمعة، لأنها وإن كانت أسماء موضوعة للتاريخ فقد يخبر عنها كما يخبر عن المكان. إلا أن الأخبار عن المكان المحدود أكثر وأقوى، لأن الأمكنة أشخاص كزيد وعمرو وظروف الزمان بخلاف ذلك، فمن ثم قالوا: سرت اليوم وسرت في اليوم ولم يقولوا: جلست الدار.
فصل: تعدي الفعل واشتقاقه
فإن كان الظرف مشتقًا من فعل تعدى إليه بنفسه، لأنه في معنى الصفة التي لا تتمكن ولا يخبر عنها، وذلك كقبل وبعد وقريبًا لمنك، لأن في قبل معنى المقابلة وهي من لفظ قبل وبعد من لفظ بعد وهذا المعنى هو من صفة المصدر، لأنك إذا قلت: جلست قبل جلوسي زيد فما في قبل من معنى المقابلة فهو في صفة جلوسك، ولم يمتنع الاخبار عن قبل وبعد من حيث كان غير محدود، لأن الزمان والدهر قد يخبر عنهما وهما غير محدودين. تقول: قمت في الدهر مرة، وإنما امتنع قمت في قبلك للعلة التي ذكرناها.
ومن هذا النحو ما تقدم في فصل غدوة وعشية من امتناع تلك الأسماء من التمكن لما فيها من معنى الوصف. نحو خرجت بصرًا وظلامًا وعشاء وضحى، وإن كنا قد قدمنا أن هذه المعاني أوصاف للأوقات فليس بمناقض لما قلناه آنفًا، لأن الأوقات قد توصف بهذه المعاني مجازًا، وأما في الحقيقة فالأوقات هي الفلك والحركة لا توصف بصفة معنوية، لأن العرض لا يكون حاملًا لوصف.
ومن هذا الفصل خرجت ذات يوم وذات مرة، لأن ذات في أصل وضعها وصف للخرجة ونحوها كأنك قلت: خرجت خرجة ذات يوم أي لم يكن إلا في يوم واحد فمن ثم لم يجز فيها إلا النصب ولم يجز دخول الجار عليها، وكذلك ذا صباح وذا مساء في غير لغة خثعم.
فإن قيل: فلم أعربها النحويون ظرفًا إذا كانت في الأصل مصدرًا؟
قيل لأنك إذا قلت: ذات يوم علم أنك تريد يومًا واحدًا. وقد اختزل المصدر ولم يبق إلا لفظ اليوم مع الذات، فمن ثم أعربوه ظرفًا. وسر المسألة في اللغة ما تقدم.
وأما مرة فإن أردت بها فعلة واحدة من مرور الزمان فهي ظرف زمان. وإن أردت بها فعلة واحدة من المصدر مثل قولك لقيته مرة أي لقيه فهي مصدر وعبرت عنها بالمرة، لأنك لما قطعت اللقاء ولم تصله بالدوام صار بمنزلة شيء مررت به ولم تقم عنده. فإذا جعلت المرة ظرفًا. فاللفظ حقيقة، لأنها من مرور الزمان، وإذا جعلتها مصدرًا. فاللفظ مجاز إلا أن تقول: مررت مرة فيكون حينئذ حقيقة.
فصل: جلست خلفك وأمامك
ومن هذا القبيل جلست خلفك وأمامك وفوق وتحت، (وإزاءَ وتِلقاء وحِذاء، وكذلك قربك وعندك، لأن) وعندك في معنى القرب لأنها من لفظ العَنَد. قال الراجز:
وكل شيء قد يحب ولدَه ** حتى الحبارى فتطير عَنَدَه
أي إلى جنبه. وهذه الألفاظ غير خاف أنها مأخوذة من لفظ الفعل؛ فخلف من خلفت، وقدام من تقدمت، وفوق من فقت، وأمام من أممت أي قصدت، وكذلك سائرها. إلا أنهم لم يستعملوا فعلًا من تحت. ولكنها مصدر في الأصل أُميت فعله.
وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت كقبل وبعد في الزمان (وكعشي) وقريب، وصار فيها كلها معنى الوصف. فلذلك عمل الفعل فيها بنفسه كما يعمل فيما هو وصف للمصدر، أو وصف للفاعل أو المفعول به، لأن الوصف هو الموصوف في المعنى فلا يعمل الفعل إلا في هذه الثلاثة أو ما هو في معناها، لأنها لا تدل بلفظها إلا عليها كما تقدم، فقد بان لك أنه لم يتمنع الإخبار عنها، ولا دخول الجار عليها من جهة الإبهام كما قا لوا: لأنه لا فرق بينهما وبين غير المبهم في انقطاع دلالة الفعل عنها. إذ لا يدل الفعل بلفظه على مبهمها، ولا على محدودها، ولا على حركة فلك. وإنما يدل بلفظه على مصدره وفاعله إذا كان الفاعل مطلقًا وعلى المفعول به كذلك.
فإن قيل: فأين لفظ الفعل في ميل وفرسخ وأي معنى للوصف فيه والفعل قد تعدى إليه بغير حرف وعمل فيه بلا واسطة؟
قيل: المراد بالميل والفرسخ تبيين مقدار المشي لا تبيين مقدار الأرض. فصار الميل عبارة عن عدة خطى كأنك قلت: سرت خطى عدتها كيت وكيت. فلم يتعد الفعل في الحقيقة إلا إلى المصدر المقدر بعدد معلوم كقولك: ضربت ألف ضربة، ومشيت ألف خطوة. ألا ترى أن الميل عبارة عن ثلاثة آلاف وخمسمائة خطوة، والفرسخ أضعاف ذلك ثلاث مرات. فلم ينكسر ما أصلناه من أن الفعل لا يتعدى إلا إلى ما ذكرنا. وإنما سموا هذا المقدار من الخطى والأذرع ميلًا، لأنهم كانوا ينصبون في رأس ثلث كل فرسخ كهيئة الميل الذي يكتحل به إلا أنه كبير، ثم يكتبون في رأسه عدد ما مشوه ومقدار ما تخطوه.
وذكر قاسم بن ثابت أن هشام بن عبد الملك مر في بعض أسفاره بميل فأمر أعرابيًا أن ينظر في الميل كم فيه مكتوبًا. وكان الأعرابي أميًا فنظر فيه، ثم رجع إليه فقال فيه محجن وحلقة وثلاثة كأطباء الكلبة وهامة كهامة القطا. فضحك هشام وقال: معناه خمسة أميال.
فقد وضح لك أن الأميال مقادير المشي وهو مصدر. فمن ثم عمل فيها الفعل، ومن ثم عمل في المكان نحو جلست مكان زيد، لأنه مفعل من الكون فهو في أصل وضعه مصدر عبر به عن الموضع. والموضع أيضا من لفظ الوضع فلا يعمل المفعل في شيء من هذا القبيل بغير حرف.
والذي قلناه في مكان أنه من الكون هو قول الخليل في كتاب العين. إلا أنهم شبهوا الميم بالحرف الأصلي للزومها فقالوا في الجمع، أمكنة حتى كأنه على وزن فعال، وقد فعلوا ذلك في ألفاظ كثيرة شبهوا الزائد بالأصلي نحو تمدرع وتمسكن.
وأما جلست يمينك وشمالك، فليس من هذا الفصل، ولكنه مما حذف منه الجار لعلم السامع أرادوا عن يمينك، وعن شمالك أي الناحيتين، ثم حذف الجار فتعدى الفعل فنصب فهو من باب أمرتك الخير، وإنما حذف الحرف لما تضمنه الفعل من معنى الناصب، لأنك إذا قلت: جلست عن يمينك، فمعنى الكلام قابلت يمينك وحاذيته ونحو ذلك.
فصل: تعدي الفعل إلى الحال بنفسه
ومن هذا الباب تعدي الفعل إلى الحال بنفسه. ونعني بالحال صفة الفاعل التي فيها ضميره، أو صفة المفعول، أو صفة المصدر الذي عمل فيها، لأن الصفة هي الموصوف من حيث كان فيها الضمير الذي هو الموصوف. وذلك نحو سرت سريعًا وجاء ضاحكًا وضربته قائمًا. فلم يعمل الفعل في هذا النحو من حيث كان حالًا، لأن الحال غير الاسم الذي نزل عليه الفعل، ألا ترى أنك إن صرحت بلفظ الحال لم يعمل فيها الفعل إلا بواسطة الحرف نحو جاء زيد في حال ضحك، ولا تقول: جاء زيد حال ضحك، لأن الحال غير زيد. ولذلك لا تقول: جاء زيد ضحكًا لأنه غيره وغير المجيء فلا يعمل جاء فيه إلا بواسطة. فإن قلت: ضاحكًا عمل فيه، لأن الضاحك هو زيد. وإذا قلت: جاء مشيًا عمل فيه أيضا. لا من حيث كان صفة لزيد، لأنه لا ضمير فيه يعود على زيد. ولكن من حيث كان صفة للمصدر الذي هو المجيء فعمل فيه جاء كما يعمل في المصدر.
وأما عمله في المفعول من أجله فإنه لم يعمل فيه بلفظ عندي. ولكنه دل على فعل باطن من أفعال النفس والقلب وإلا قلت آثار هذا الفعل الظاهر وصار ذلك الفعل الباطن عاملًا في المصدر الذي هو المفعول من أجله في الحقيقة والفعل الظاهر دال عليه. ولذلك لا يكون المفعول من أجله منصوبًا إلا بثلاثة شرائط: أن يكون مصدرًا، وأن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة، وأن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. نحو جاء زيد خوفًا مثلًا ورغبة، ولو قلت: جاء قراءة للعلم وقتلًا للكافر لم يجز، لأنها أفعال ظاهرة، فقد بان لك أن المجي إنما يظهر ما كان باطنًا خفيًا حتى كأنك قلت: جاء زيد مظهرًا بمجيئه الخوف، أو الرغبة أو الحرص أو أشباه ذلك، فهذه الأفعال الظاهرة تبدي تلك الأفعال الباطنة فهي مفعولات في المعنى والظاهرة دالة على ما تتضمنها. فإن جئت بمفعول من أجله من غير هذا القبيل الذي ذكرناه لم يصل الفعل إليه إلا بحرف نحو جئت لكذا، أو من أجل كذا. والله أعلم.
قلت: ما أدري أي ضرورة به إلى هذا التعسف والتكلف الظاهر الذي لا يصح لفظًا ولا معنى. وأما اللفظ فإنه لو كان معمولًا لعامل مقدر وهو قولك يظهر الخوف والمحبة ونحوه لتلفظوا به ولو مرة في كلامهم فإنه لا دليل عليه من سياق ولا قرينة، ولا هو مقتضى الكلام، فيصح إضماره فدعوى إضماره ممتنعة. وأما فساده من جهة المعنى فمن وجوه عديدة:
منها: أن المتكلم لا يخطر بباله هذا المعنى بحال فلا يخطر ببال القائل زرتك محجة لك زرتك مظهرًا لمحبتك، ولا بقوله: تركت هذا خوفًا من الله، تركته مظهرًا خوفي من الله. وهذا أظهر من أن يحتاج إلى تقديره.
الثاني: أنه إذا كان التقدير ما ذكر خرج الكلام عن حقيقته. ومقصوده إذ لا يبقى فيه دليل على أنه علة الفعل الباعثة عليه. فإنه إذا قال: خرجت مظهرًا ابتغاء مرضات الله مثلًا لم يدل ذلك على أن الباعث له على الخروج ابتغاء مرضات الله تعالى، لأن قوله مظهر كذا حال أي خرجت في هذه الحال، فأين مسألة الحال من مسألة المفعول لأجله.
الثالث: أن المفعول له هو علة الفعل وهي إما علة فاعلية، أو غائية. وكلاهما ينتصب على المفعولية تقول فعلت ذلك خوفًا وقعدت عن الحرب جبنًا، وأمسك عن الإنفاق شحًا. فهذه أسباب حاملة على الفعل والترك لا أنها هي الغايات المقصودة منه. وتقول: ضربته تأديبًا وزرته إكرامًا، وحبسته صيانة، فهذه غايات مطلوبة من الفعل، إذا ثبت هذا فالمعلل إذا ذكر الفعل طلب المخاطب منه الباعث عليه لما في النفوس من طلب الأسباب والغايات في الأفعال الاختيارية شاهدًا، أو غائبًا، فإذا ذكر الباعث أو الغاية وهو المراد من الفعل كان مخبرًا بأن هذا هو مقصوده وغايته، والباعث له على الفعل. فكان اقتضاء الفعل اللفظي كاقتضاء الفعل الذي هو حدث له فصح نصبه له كما كان واقعًا لأجله، وهذا بحمد الله واضح، فتأمله.
فصل: إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم
قال: إذا كانت الحال صفة لازمة للاسم كان حملها عليه على جهة النعت أولى بها. وإذا كانت مساوية للفعل غير لازمة للاسم إلا في وقت الإخبار عنه بالفعل. مع أن تكون حالًا، لأنها مشتقة من التحول فلا تكون إلا صفة يتحول عنها، ولذلك لا تكون إلا مشتقة من فعل، لأن الفعل حركة غير ثابتة، وقد تجيء غير مشتقة، لكن في معنى المشتق كقوله ﷺ: «وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا»، أي يتحول عن حاله ويعود منصورًا في صورة الرجل، فقوله رجلًا في قوة متصورًا بهذه الصورة. وأما قولهم: جاءني زيد رجلًا صالحًا. فالصفة وطأت الاسم للحال ولولا صالحًا ما كان رجل حالًا، وكذلك قوله تعالى: { لسانًا عربيًا }. [146]
قلت: وعلى هذا فيكون أقسام الحال أربعة: مقيدة ومقدرة ومؤكدة وموطئة.
فإن قيل: وما فائدة ذكر الاسم الجامد في الموطئة وهلا اكتفي بالمشتق فيها؟
قيل: في ذكر الاسم موصوفًا بالصفة في هذا الموطن دليل على لزوم هذه الحال لصاحبها، وإنها مستمرة له وليس كقولك: جاءني زيد صالحًا، لأن صالحًا ليس فيه غير لفظ الفعل. والفعل غير دائم، وفي قولك رجلًا صالحًا لفظ رجل وهو دائم. فلذلك ذكر.
فإن قيل: كيف يصح في لسانًا عربيًا أن يكون حالًا وليست وصفًا منتقلًا ولهذا لو قلت: جاءني زيد قرشيًا أو عربيًا لم يجز.
قيل: قوله: { لسانًا عربيًا } حال من الضمير في { مصدق } لا من { كتاب }، لأنه نكرة، والعامل في الحال ما في مصدق من معنى الفعل. فصار المعنى أنه مصدق لك في هذه الحال والاسم الذي هو صاحب الحال قديم، وقد كان غير موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى ومن خلا من الرسل. وإنما كان عربيًا حين أنزل على محمد ﷺ مصدقًا لما بين يديه من الكتاب. فقد أوضحت فيه معنى الحال وبرح الإشكال.
قلت: كلا بل زدت الإشكال إشكالًا. وليس معنى الآية ما ذهبت إليه، وإنما { لسانًا عربيًا } حال من كتاب، وصح انتصاب الحال عنه مع كونه نكرة لكونه قد وصف. والنكرة إذا وصفت انتصب عنها الحال لتخصصها بالصفة، كما يصح أن يبتدأ بها.
وأما قوله: إن المعنى مصدق لك، فلا ريب أنه مصدق له. ولكن المراد من الآية أنه مصدق لما تقدم من كتب الله تعالى كما قال: { وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب }، [147] وقال: { الم * الله لا إله إلا هو الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه }، [148] وقال: { وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه }. [149] أفلا ترى كيف اطرد في القرآن وصف الكتاب بأنه مصدق لما بين يديه. وقال: وباتفاق الناس: أن المراد مصدق لما تقدمه من الكتب. وبهذه الطريق يكون مصدقا للنبي ﷺ، ويكون أبلغ في الدليل على صدقه من أن يقال: هذا كتاب مصدق لك فإنه إذا كانت الكتب المتقدمة تصدقها وتشهد بصحة ما فيها مما أنزله الله من غير مواطأة ولا اقتباس منها، دل على أن الذي جاء به رسول الله ﷺ صادق كما أن الذي جاء بها كذلك، وأن مخرجهما من مشكاة واحدة.
ولهذا قال النجاشي حين قرىء عليه القرآن: إن هذا والذي جاء به موسى يخرج من مشكاة واحدة، يعني فإذا كان موسى صادقًا وكتابه حق فهذا كذلك، إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة واحدة ويكون أحدهما باطلًا محضًا والآخر حقًا محضًا. فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر. فالقرآن صدق الكتب المتقدمة وهي بشرت به وبمن جاء به فقام الدليل على صدقه من الوجهين معًا من جهة بشارة من تقدمه به، ومن جهة تصديقه ومطابقته له فتأمله.
ولهذا كثيرًا ما يتكرر هذا المعنى في القرآن، إذ في ضمنه الاحتجاج على الكتابيينَ بصحة نبوة محمد ﷺ بهذه الطريق. وهي حجة أيضا على غيرهم بطريق اللزوم، لأنه إذا جاء بمثل ما جاؤوا به من غير أن يتعلم منهم حرفًا واحدًا، دل على أنه من عند الله. وحتى لو أنكروا رسالة من تقدم لكان في مجيئه بمثل ما جاؤوا به إثبات لرسالته ورسالة من تقدمه ودليل على صحة الكتابينِ وصدق الرسولين، لأن الثاني قد جاء بأمر لا يمكن أن ينال بالتعليم أصلًا ولا البعض منه.، فجاء على يدي أمي لا يقرأ كتابًا ولا خطه بيمينه، ولا عاشر أحدًا من أهل الكتاب، بل نشأ بينكم وأنتم شاهدون حاله حضرًا وسفرًا وظعنًا وإقامة. فهذا من أكبر الأدلة على أن ما جاء به ليس من عند البشر ولا في قدرتهم، وهذا برهان بين أبين من برهان الشمس. وقد تضمن ما جاء به تصديق من تقدمه، وتضمن ما تقدمه البشارة به فتطابقت حجج الله وبيناته على صدق أنبيائه ورسله، وانقطعت المعذرة وثبتت الحجة. فلم يبق لكافر إلا العناد المحض أو الإعراض والصد.
وقوله: إن الاسم الذي هو صاحب الحال قديم وكان غير موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى وداود هذا بناء منه على الأصل الذي انفردت به الكلابية عن جميع طوائف أهل الأرض من أن معاني التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وسائر كتب الله معنى واحد. فالعين لا اختلاف فيها ولا تعدد. وإنما تتعدد وتتكرر العبارات الدالة على ذلك المعنى الواحد فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا وهو نفس التوراة. وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة وهو نفس القرآن. وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا وهو أيضا نفس القرآن ونفس التوراة، وكذلك سائر الكتب.
وهذا قول يقوم على بطلانه تسعون برهانًا لا تندفع ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة المصرية وكيف تكون معاني التوراة والإنجيل هي نفس معاني القرآن وأنت تجدها إذا عربت لا تدانيه ولا تقاربه فضلًا عن أن تكون هي إياه. وكيف يقال إن الله تعالى أنزل هذا القرآن على داود وسليمان وعيسى بعينه بغير هذه العبارات. أم كيف يقال إن معاني كتب الله كلها معنى واحد يختلف التعبير عنها دون المعنى المعبر عنه. وهل هذا إلا دعوى يشهد الحس ببطلانها؟ أم كيف يقال إن التوراة إذا عبر عنها بالعربية صارت قرآنًا مع تميز القرآن عن سائر الكلام بمعانيه وألفاظه تميزًا ظاهرًا لا يرتاب فيه أحد؟ وبالجملة فهذا الجواب منه بناء على ذلك الأصل.
والجواب الصحيح أن يقال الحال المؤكدة لا يشترط فيها الاشتقاق والانتقال، بل التنقل مما ينافي مقصودها فإنما أتى بها لتأكيد ما تقدمها وتقريره فلا معنى لوصف الاشتقاق والانتقال فيها أصلًا وتسميتها حالًا تعبير نحوي اصطلاحي وإلا فالعرب لم تقل: هذه حال حتى يقال: كيف سميتموها حالًا؟ وهي وصف لازم. وإنما النحاة سموها حالًا فيا لله العجب! من أن تكون تسميتهم الحادثة الاصطلاحية موجبة لاشتراط التنقل والاشتقاق فلو سماها مسم بغير هذا الاسم. وقال: هذه نصب على القطع من المعرفة إذا جاءت بعد معرفة أكان يلزمه هذا السؤال فقد بان لك ضعف ما اعتمده من الجواب وبالله التوفيق.
عاد كلامه، قال: وأما قوله تعالى: { وهو الحق مصدقًا }، [150] فقد حكموا أنها حال مؤكدة. ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها كمعنى الفعل، لأن التوكيد هو المؤكد في المعنى. وذلك نحو قم قائمًا وأنا زيد معروفًا هذه هي الحال المؤكدة في الحقيقة. وأما وهو الحق مصدقًا فليس بحال مؤكدة لأنه قال: { مصدقًا لما معهم } وتصديقه لما معهم ليس في معنى الحق إذ ليس من شرط الحق أن يكون مصدقًا لفلان ولا مكذبًا له بل الحق في نفسه حق وإن لم يكن مصدقًا لغيره. ولكن مصدقًا هنا حال من الاسم المجرور من قوله تعالى: { ويكفرون بما وراءه }، وقوله: { وهو الحق } جملة في معنى الحال أيضا. والمعنى كيف تكفرون بما وراءه وهو في هذه الحال أعني مصدقًا لما معكم كما تقول: لا تشتم زيدًا وهو أمير محسنًا إليك. فالجملة حال ومحسنًا حال بعددها. والحكمة في تقديم الجملة التي في موضع الحال على قولك محسنًا ومصدقًا إنك لو أخرتها لتوهم أنها في موضع الحال من الضمير الذي في محسن ومصدق. ألا ترى أنك لو قلت: أشتم زيدًا محسنًا إليك وهو أمير لذهب الوهم إلى أنك تريد محسنًا إليك في هذه الحال. فلما قدمتها اتضح المراد وارتفع اللبس.
ووجه آخر يطرد في هذه الآية وفي الآية التي في سورة فاطر: { والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقًا لما بين يديه } [151] وهو أن يكون مصدقًا ههنا حالًا يعمل فيها ما دلت عليه الإشارة المنبئة عنها الألف واللام، لأن الألف واللام قد تنبىء عما تنبىء عنه أسماء الإشارة. حكى سيبويه لمن الدار مفتوحًا بابها فقولك مفتوحًا بابها حال. لا يعمل فيها الاستقرار الذي يتعلق به لمن، لأن ذلك خلاف المعنى المقصود وتصحيح المعنى لمن هذه الدار مفتوحًا بابها فقد استغني بذكر الألف واللام، وعلم المخاطب أنه مشير وتنبه المخاطب بالإشارة إلى النظر وصار ذلك المعنى المنبه عليه عاملًا في الحال.
وكذلك قوله: { وهو الحق مصدقًا } كأنه يقول: ذلك هو الحق مصدقًا، لأن الحق قديم ومعروف بالعقول والكتب المتقدمة، فلما أشار نبهت الإشارة على العامل في الحال، كما إذا قلت: هذا زيد قائمًا، نبهت الإشارة المخاطب على النظر فكأنك قلت: انظر إلى زيد قائمًا، لأن الاسم الذي هو ذا هو العامل. ولكن مشعر ومنبه على المعنى العامل في الحال. وذلك المعنى هو انظر.
ومما أغنت فيه الألف واللام على الإشارة قولهم اليوم قمت، والساعة جئت، والليلة فعلت والآن قعدت. اكتفيت بالألف واللام عن أسماء الإشارة.
قلت: ليس المراد بقول النحاة حال مؤكدة ما يريدون بالتأكيد في باب التوابع. فالتأكيد المبوب له هناك أخص من التأكيد المراد من الحال المؤكدة. وإنما مرادهم بالحال المؤكدة المقررة لمضمون الجملة بذكر الوصف الذي لا يفارق العامل ولا ينفك عنه. وإن لم يكن معنى ذلك الوصف هو معنى الجملة بعينه وهذا كقولهم زيد أبوك عطوفًا. فإن كونه عطوفًا ليس معنى كونه أباه، ولكن ذكر أبوته تشعر بما يلازمها من العطف، وكذلك قوله: { هو الحق مصدقًا لما بين يديه } فإن ما بين يديه حق، والحق يلازمة تصديق بعضه بعضًا.
وقوله: ليس من شرط الحق أن يكون مصدقًا لفلان. يقال: ليس هذا بنظير لمسألتنا. بل الحق يلزمه لزومًا لا انفكاك عنه تصديق بعضه بعضًا. فتصديق ما بين يديه من الحق هو من جهة كونه حقًا. فهذا معنى قولهم: إنها حال مؤكدة فافهمه. والمعنى أنه لا يكون إلا على هذه الصفة وهي مقررة لمضمون الجملة. فإن كونه مصدقًا للحق المعلوم الثابت مقررًا ومؤكدًا ومبينًا لكونه حقًا في نفسه.
وأما قوله: إنها حال من المجرور في قوله: { ويكفرون بما وراءه }، والمعنى يكفرون به مصدقًا لما معهم. فهذا المعنى وإن كان صحيحًا، لكن ليس هو معنى الحال في القرآن حيث وقعت بهذا المعنى وهب أن هذا يمكن دعواه في هذا الموطن. فكيف يقول في قوله تعالى: { والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقًا لما بين يديه }، والكلام والنظم واحد. وأيضا فالمعنى مع جعل مصدقًا حال من قوله: { وهو الحق } أبلغ وأكمل منه إذا جعل حالًا من المجرور. فإنه إذا جعل حالًا من المجرور يكون الإنكار قد توجه عليهم في كفرهم به حال كونهم مصدقًا لما معهم، وحال كونه حقًا. فيكونان حالًا من المجرور أي يكفرون به في هذه الحال وهذه الحال. وإذا جعل حالًا من مضمون قوله: { وهو الحق } كان المعنى يكفرون به حال كونه حقًا مصدقًا لما معهم فكفروا به في أعظم أحواله المستلزمة للتصديق والإيمان به وهو اجتماع كونه حقًا في نفسه وتصديقه لما معهم. فالكفر به عند اجتماع الوصفين فيه يكون أغلظ وأقبح وهذا المعنى والمبالغة لا تجده فيما إذا قيل يكفرون به حال كونه حقًا وحال كونه مصدقًا لما معهم. فتأمله بديع جدًا فصح قول النحاة والمفسرين في الآية والله أعلم.
فائدة: قولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا
قولهم هذا بسرًا أطيب منه رطبًا فيه أسئلة عشرة:
أحدها: ما جهة انتصاب بسرًا ورطبًا أعلى الحال أم خبر كان؟
الثاني: إذا كانا حالين فما هو صاحبهما؟
الثالث: ما العامل في الحالين؟ هل هو أفعل التفضيل، أو اسم الإشارة أو غير ذلك؟
الرابع: إنكم إذا جعلتم العامل أفعل التفضيل لزم تقديم معمول أفعل التفضيل عليه والاتفاق واقع على امتناع زيد منك أحسن وإذا لم يتقدم منك لم يتقدم الحال؟
الخامس: متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين ومتى لا يجوز وما ضابط ذلك؟
السادس: هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين جميعًا أم لا؟
السابع: كيف تصورت الحال في غير المشتق؟
الثامن: إلى أي شيء وقعت الإشارة بقولهم هذا؟
التاسع: هلا قلتم إن بسرًا ورطبًا منصوبان علن خبر كان، وتخلصتم من هذا كله؟
العاشر: هل يشترط في هذه المسألة أن يكون الأسمان المنصوبان اسمين لشيء واحد باعتبار صفتين أو يجوز أن يقع بين شيئين مختلفين نحو هذا بسرًا أطيب منه عنبًا؟
فالجواب في هذه المسائل.
أما السؤال الأول: فجهة انتصابه على الحال في أصح القولين وهو اختيار سيبويه ومحققي أصحابه خلافًا لمن زعم أنه خبر كان، وسيأتي إبطاله في جواب السؤال التاسع وإنما جعله سيبويه حالًا، لأن المعنى عليه فإن المخبر إنما يفضله على نفسه باعتبار حالين من أحواله. ولولا ذلك لما صح تفضيل الشيء على نفسه. فالتفضيل إنما صح باعتبار الحالين فيه. فكان جهة انتصابهما على الحال لوجود شروط الحال وسيأتي الكلام على شرط الاشتقاق. فلما كان هذا الباب لا يذكر إلا لتفضيل شيء في زمان، أو على حال على نفسه في زمان، أو على حال أخرى وسائر وجوه النصب متعذرة فيه إلا الحال، أو كونه خبرًا لكان. وسيأتي بطلان الثاني فيتعين أن يكون حالًا. فإن قلت: فهلا جعلته تمييزًا. قلت. يأتي ذلك أنه ليس من قسمي التميير فإنه ليس من المقادير المنتصبة عن تمام الاسم، ولا من التمييز المنتصب عن تمام الجملة فلا يصح أن يكون تمييزًا.
فصل: صاحب الحال
وأما السؤال الثاني: وهو ما هو صاحب الحال ههنا فجوابه أنه الاسم المضمر في أطيب الذي هو راجع إلى المبتدأ من خبره. فبسرًا حال من ذلك الضمير، ورطبًا حال من المضمر المجرور بمن. وإن كان المجرور بمن هو المرفوع المستتر في أطيب من جهة المعنى. ولكنه نزل منزلة الأجنبي، ألا ترى أنك لو قلت: زيد قائمًا أخطب من عمرو قاعدًا. لكان قاعدًا حال من الاسم المخفوض بمن وهو عمرو، فكذلك رطبًا حال من الاسم المجرور بمن.
هذا قول جماعة من البصريين. وقال أبو علي الفارسي: صاحب الحالين المضمر المستكن في كان المقدرة التامة. وأصل المسألة هذا إذا كان أي وجد بسرًا أطيب منه. إذا كان أي وجد رطبًا فبسرًا ورطبًا حالان من المضمر المستكن في كان.
وهذان القولان مبنيان على المسألة الثالثة: وهو ما هو العامل في هذه الحال، وفيه أربعة أقوال:
أحدها: أنه ما في أطيب من معنى الفعل، لأنك تريد أن طيبه في حال البسرية يزيد على طيبه في حال الرطبية، فالطيب أمر واقع في هذه الحال.
القول الثاني: إن العامل فيها كان الثانية المقدرة وهذا اختيار أبي علي.
والقول الثالث: إن العامل فيها ما في اسم الإشارة من معنى الفعل أي أشير إليه بسرًا.
والقول الرابع: إنه ما في حرف التنبيه من معنى الفعل.
والمختار القول الأول وهو العامل فيها ما في أطيب من معنى الفعل. وإنما اخترناه لوجوه:
أحدها: أنهم متفقون على جواز زيد قائمًا أحسن منه راكبًا، وثمرة نخلتي بسرًا أطيب منه رطبًا. والمعنى في هذا كالمعنى في الأول سواء وهو تفضيل الشيء على نفسه باعتبار حالين: فانتفى اسم الإشارة وحرف التنبيه ودار الأمر بين القولين الباقيين: أن يكون العامل كان مقدرة أو أطيب. والقول بإضمار كان ضعيف فإنها لا تضمر إلا حيث كان في الكلام دليل عليها. نحو قولهم: إن خيرًا فخير وبابه، لأن الكلام هناك لا يتم إلا بإضمارها بخلاف هذا، وأيضا فإن كان الزمانية ليس المقصود منها الحدث. وإنما هي عبارة عن الزمان، والزمان لا يضمر، وإنما يضمر الحدث إذا كان في الكلام ما يدل عليه وليس في الكلام ما يدل على الزمان الذي يقيد به الحدث إلا أن يلفظ به. فإن لم يلفظ به لم يعقل.
فإن قلت: فمن ههنا قالوا: إن كان ههنا تامة غير ناقصة. بل قد خلعوا منها الدلالة على الزمان وجردوها لنفس الحدث.
قلت: هذا كلام من لم يحصل معنى كان التامة والناقصة كما ينبغي. فإن كان الناقصة والتامة يرجعان إلى أصل واحد، ولا يجوز إضمار واحد منهما وكشف ذلك يطول، لكن نشير إلى بعض وهو أن القائل إذا قال كان برد وكان مطر فهو بمنزلة وقع وحدث، وكذا غيرهما من الأفعال اللازمة، والزمان جزء مدلول الفعل فلا يجوز أن يخلعه ويجرد عنه. وإنما الذي خلع من كان التامة اقتضاؤها خبرًا يقارن زمانها وبقيت تقتضيه مرفوعًا يقارن زمانها، كما كان يقارنه الخبر، فلا فرق بينهما أصلًا فإن الزمان الذي كان الخبر يقترن به هو بعينه الزمان الذي اقترن به مرفوعًا وينزل مرفوعها في تمامها به منزلة خبرها إذا كانت ناقصة فتأمل هذا السر الذي أغفله كثير عن النحاة.
ويبطل هذا المذهب أيضا بشيء آخر وهو كثرة الإضمار. فإن القائل به يضمر ثلاثة أشياء إذا والفعل والضمير، وهذا تعد لطور الإضمار، وقول بلا دليل عليه.
الوجه الثاني من وجوه الترجيح: أن العامل في الحال لو كان معنى الإشارة إلى الحال لا إلى الجوهر وهذا باطل. فإنه إنما يشير إلى ذات الجوهر ولهذا يصح إشارته إليه. وإن لم يكن على تلك الحال. كما إذا أشار إلى تمر يابس. وقال: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا. فإنه يصح ولو كان العامل في الحال هو الإشارة لم تصح المسألة.
الوجه الثالث: أنه لو كان العامل معنى الإشارة لوجب أن يكون الخبر عن الذات مطلقًا، لأن تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان مبتدأ لا يوجب تقديم خبره إذا أخبرت عنه. ولهذا تقول: هذا ضاحكًا أبي. فالإخبار عنه بالأبوة غير مقيد بحال ضحكه. بل التقييد للإشارة فقط. والإخبار بالأبوة وقع مطلقًا عن الذات. فاعتصم بهذا الموضع فإنه ينفعك في كثير من المواضع. وإذا عرف هذا وجب أن يكون الخبر بأطيب وقع عن المشار إليه مطلقًا.
الوجه الرابع: إن العامل لو لم يكن هو أطيب لم تكن إلا طيبية مقيدة بالبسرية. بل تكون مطلقة. وإذا لم تكن مقيدة فسد المعنى، لأن الغرض تقييد الأطيبية بالبسرية مفضلة على الرطبية وهذا معنى العامل. وإذا ثبت أن الأطيبية مقيدة بالبسرية وجب أن يكون بسرًا معمولًا لأطيب.
فإن قلت: فلأجل هذا قدرنا الظرف المقيد حتى يستقيم المعنى، وقلنا: تقديره هذا إذا كان بسرًا أطيب منه إذا كان رطبًا أي هذا في وقت بسريته أطيب منه في وقت رطبيته.
قلت: هذا يحتاج إليه إذا لم يكن في اللفظ ما يغني عنه ويقوم مقامه. فأما إذا كان معنا ما يغني عنه فلا وجه لتكلف إضماره وتقديره.
فإن قلت: لو كان العامل هو أطيب لزم منه المحال، لأنه يستلزم تقييده بحالين مختلفين وهذا ممتنع.
قلت: الجواب عن هذا أن العامل في الحالين وصاحبهما متعدد ليس متحدًا. أما العامل في الحال الأولى فهو ما في أطيب من معنى الفعل، لأنك إذا قلت: هذا أطيب من هذا تريد أنه طاب وراد طيبه عليه، والطيب أمر ثابت له في حال البسرية قال سيبويه: هذا باب ما ينصب من الأسماء على أنها أحوال وقعت فيها الأمور.
وأما الحال الثانية وهي رطبًا، فالعامل فيها معنى الفعل الذي هو متعلق الجار في قولك منه. فإن منه متعلق بمعنى غير الطيب، لأن طاب يطيب لا يتعدى بمن. ولكن صيغة الفعل تقتضي التفضيل بين شيئين مشتركين في صفه واحدة إلا أن أحدهما متميز من الآخر منفصل منه بزيادة في تلك الصفة. فمعنى التميز والانفصال الذي تضمنه افعل هو الذي تعلق به حرف الجر، وهو الذي يعمل في الحال الثانية. كما عمل معنى الفعل الذي تعلق به حرف الجر من قولك زيد في الدار قائمًا في الحال التي هي قائمًا.
فإن قلت: فهلا أعملت فيهما جميعًا ما في أطيب.
قلت: لاستلزامه لمحال المذكور، لأن الفعل الواحد لا يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين. لا تقول: زيد قائم يوم الجمعة يوم الخميس، ولا جالس خلفك أمامك. فإذا قلت: زيد يوم الجمعة أطيب منه يوم الخميس جاز، لأن العامل في أحد اليومين غير العامل في اليوم الثاني، لأنك فضلت حين قلت: أطيب، أو أصح، أو أقوم صحة وقيامًا على صحة أخرى وقيام آخر. وفضلت حال من حال بمزية وزيادة، وكذلك حين قلت: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا. ولا يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا ظرفين إلا أن يتداخلا ويصح الجمع بينهما نحو قولك: زيد مسافر يوم الخميس ضحوة، لأن الضحوة داخلة في اليوم، وكذلك سرت راكبًا مسرعًا لدخول الإسراع في السير وتضمنه له ولو قلت: سرت مسرعًا مبطيًا لم يجز لاستحالة الجمع بينهما إلا على تقدير الواو أي مسرعًا تارة ومبطئًا أخرى، وكذلك بسرًا ورطبًا يستحيل أن يعمل فيهما عامل واحد، لأنهما غير متداخلين. هذا هو الجواب الصحيح عندي.
وأجاب طائفة بأن قالوا: أفعل التفضيل في قوة فعلين، لأن معناه حسن وزاد حسنه وطاب وزاد طيبه. وإذا كان في قوة فعلين فهو عامل في بسرًا باعتبار حسن وطاب، وفي رطبًا باعتبار زاد. حتى لو فككت ذلك لقلت هذا زاد بسرًا في الطيب على طيبه في حال كونه رطبًا. فاستقام المعنى المطلوب. وهذا جواب حسن والأول أمتن، فتأملهما.
فصل: تقديم معمول أفعل التفضيل عليه
وأما السؤال الرابع: وهو تقديم معمول أفعل التفضيل عليه. فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: لا نسلم امتناع تقديم معموله عليه. وقولكم: الإتفاق واقع على امتناع زيد منك أحسن غير صحيح لا اتفاق في ذلك، بل قد جوز بعض النحاة ذلك واستدل عليه بقول الشاعر: * كأنه جنى النحل أو ما زودت منه أطيب *
قال هؤلاء: وأفعل التفضيل لما كان في قوة فعلين جاز تقديم معموله عليه. قالوا وتقديمه أقوى من قولك أنا لك محب، وفيك راغب وعندك مقيم. ولاستقصاء الحجج في هذه المسألة موضع آخر.
الوجه الثاني: سلمنا امتناع تقديم معموله، ولا يقال زيد منك أحسن. فهذا الأمر يختص بقولهم منك لا يتعدى إلى الحال والظرف وذلك لأن منك في معنى المضاف إليه بدليل أن قولهم زيد أحسن منك بمنزلة زيد أحسن الناس في قيام أحدهما مقام آخر وأنهم لا يجمعون بينهما، فلما قام المضاف إليه مقامه لكونه المفضل عليه في المعنى كرهوا تقديمه على المضاف، لأنه خلاف لغتهم، فلا يلزم من امتناع تقديم معمول هو كالمضاف إليه امتناع تقديم معمول، ليس كهو. وهذا بين.
وجواب ثالث: وهو أنهم إذا فضلوا الشيء على نفسه باعتبار حالين. فلا بد من تقديم أحدهما على العامل وإن كان مما لا يسوغ تقديمه لو لم يكن كذلك فإذا فضلوا ذاتًا باعتبار حالين قدموا أحدهما على العامل، وأخروا الآخر عنه. فقالوا: زيد قائمًا أحسن منه قاعدًا، وكذلك في التشبيه أيضا، يقولون: زيد قائمًا كعمرو قاعدًا. وإذا جاز تقديم هذا المعمول على الكاف التي هي أبعد في العمل من باب أحسن. فتقديم معمول أحسن أجدر. والغرض هنا بهذا الكلام تفضيل هذه التمرة في حال كونها بسرًا عليها في حال كونها رطبًا.
فصل: عمل العامل الواحد في حالين
وأما السؤال الخامس: وهو متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين، فقد فرغنا من جوابه فيما تقدم. وأن ذلك يجوز إذا كانت إحدى الحالين متضمنة للأخرى نحو جاء زيد راكبًا مسرعًا، وكذلك يعمل في الظرفين إذا تضمن أحدهما الآخر. نحو سرت يوم الخميس بكرة.
فصل: التقديم والتأخير في الحالين
وأما السؤال السادس: وهو هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين أم لا؟ فالجواب عنه أن الحال الأولى يجوز فيها ذلك، لأن العامل فيها لفظي وهو ما في أطيب من معنى الفعل فلك أن تقول: هذا بسرًا أطيب منه رطبًا، وأن تقول: هذا أطيب بسرًا منه رطبًا وهو الأصل.
فإن قلت: إذا كان هذا هو الأصل فلم مثل سيبويه بها مقدمة وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها.
قلت: كأنه أراد تأكيد معنى الحال فيها، لأنه ترجم عن الحال فلو أخرها لأشبهت التمييز، لأنك إذا قلت: هذا الرجل أطيب بسرًا من فلان، فبسرًا لا محالة تمييز، وإذا قدمت بسرًا على أطيب، من كذا فبسرًا لا محالة حال ولا يصح أن يخبر بهذا الكلام عن رجل، ولا عن شيء سوى التمر وما هو في معناه. فإذا قلت: هذا بسرًا احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر في قرائن أحواله أن يكون بسرًا تمييزًا، وأن يكون حالًا وبينهما في المعنى فرق عظيم. فاقتضى تخصيص المعنى والحرص على البيان للمراد تقديم الحال الأولى على عاملها. ولو أخرت لجاز.
وأما الحال الثانية فلا سبيل إلى تقديمها على عاملها، لأنه معنوي والعامل المعنوي لا يتصور تقديم معموله عليه، لأن العامل اللفظي إذا تقدم على منصوبه الذي حقه التأخير. قلت: فيه مقدم في اللفظ مؤخر في المعنى، فقسمت العبارة بين اللفظ والمعنى فإن لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم يتصور تقديم المعمول عليه، لأنه لا بد من تأخير المعمول على عامله في المعنى. فلا يوجد تعد إلا وعامله متقدم عليه، لأنه منوي غير ملفوظ به فلا تذهب النية والوهم إلى غير موضعه بخلاف اللفظي. فإن محل اللفظ اللسان ومحل المعنى القلب. فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير موضعه لم يذهب القلب بالمعنى إلا إلى موضعه وهو التقديم.
فصل: تصور الحال في غير المشتق
وأما السؤال السابع: وهو كيف يتصور الحال في غير المشتق فاعلم أنه ليس لاشتراط الاشتقاق حجة ولا يقوم على هذا الشرط دليل. ولهذا كان الحذاق من النحاة على أنه لا يشترط بل كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالًا. فلا يشترط فيها إلا أن تكون دالة على معنى متحول. ولهذا سميت حالًا كما قال:
لو لم تحل ما سميت حالًا ** وكل ما حال فقد زالا
فإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفعل في صفة غير لازمة للفعل فلا تبالي. أكانت مشتقة أم غير مشتقة فقد جاء في الحديث يتمثل لي الملك رجلًا فوقع رجلًا هنا حالًا، لأن صورة الرجلية طارئة على الملك في حال التمثل وليست لازمة للملك إلا في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل فهي إذًا حال، لأنه قد تحول إليها ومثله: { يخرجكم طفلًا }، [152] ومثله: { هذه ناقة الله لكم آية }، [153] ومثله: { فتمثل لها بشرًا }. [154] ويقولون: مررت بهذا العود شجرًا، ثم مررت به رمادًا وهذا زيد أسدًا، وتأويل هذا كله بأنه معمول الحال والتقدير يشبه بعيد جدًا، وكذا تأويل ذلك كله بمشتق تعسف ظاهر والتحقيق ما تقدم وأنها كلها أحوال وإن كانت جامدة، لأنها صفات يتحول الفاعل إليها وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فعلية بل فيها نفسية ومعنوية وعدمية وهي صفة النفي، وإضافية وفعلية ولا يكون من جميعها حالًا إلا ما كان الفعل واقعا فيه وجاز خلوه عنها. فأما ما كان لازمًا للاسم مما لا يجوز خلوه عنه فلا يكون حالًا منتصبة بالفعل. نحو قولك: قرشي وعربي وحبشي وابن وبنت وأخ وأخت، فكل هذه لا يتصور وقوعها أحوالًا، لأنها لا تتحول.
فصل: مدلول الإشارة بقولك هذا
وأما السؤال الثامن: وهو إلى أي شيء وقعت الإشارة بقولك هذا؟
فالجواب أن متعلق الإشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه الأحوال وهو ما تخرجه النخل من أكمامها فيكون بلحًا، ثم يكون سيابًا ثم جدالًا، ثم بسرًا إلى أن يكون رطبًا. فمتعلق الإشارة المحل الحامل لهذه الأوصاف. فالإشارة إلى شيء ثالث غير البسر والرطب وهو حامل االبسرية والرطبية، وقد عرفت بهذا أنه لا ينبغي تخصيص الإشارة بقولهم إنها إلى البلح والطلع والجدال كل ذلك تمثيل، والتحقيق أن الإشارة إلى الحقيقة الحاملة لهذه الصفات والذي يدل على هذا أنك تقول: زيد قائمًا أخطب منه قاعدًا. وقال عبد الله بن سلام لعثمان: أنا خارجًا أنفع لك مني داخلًا، فلا إشارة ولا مشار هنا، وإنما هو إخبار عن الاسم الحامل للصفات التي منها القيام والقعود، ولا يصح أن يكون متعلق الإشارة صفة البسرية، ولا الجوهر بقيد تلك الصفة، لأنك لو أشرت إلى البسرية وكان الجوهر بقيدها لم يصح تقييده بحال الرطبية، فتأمله فلم تبق إلا أن تكون الإشارة إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه الأحوال. وقد تبين لك بطلان قول من زعم أن متعلق الإشارة في هذا هو العامل في بسر. فإن العامل فيها إما ما تضمنه أطيب من الفعل، وإما كان المقدرة وكلاهما لا يصح تعلق الإشارة به.
فصل: هل النصب على أنه خبر كان
وأما السؤال التاسع وهو قوله: هلا قلتم إنه منصوب على أنه خبر كان.
فجوابه إن كان لو أضمرت لأضمر ثلاثة أشياء. الظرف الذي هو إذا وفعل كان ومرفوعها، وهذا لا نظير له إلا حيث يدل عليه الدليل وقد تقدم ذلك، وقد منع سيبويه من إضمار كان فقال: لو قلت عبد الله المقتول تريد كان عبد الله المقتول لم يجز. وقد تقدم ما يدل على امتناع إضمار كان فلا نطول بإعادته وإذا لم يجز إضمار كان على انفرادها فكيف يجوز اضمار إذ وإذا معها وأنت لو قلت: آتيك جاء زيد تريد إذا جاء زيد كان خلفًا من الكلام بإجماع، وإذا كان كذلك كان الإضمار من هذا الموطن أبعد، لأنه لا يدري ههنا أئذ تريد أم إذا وفي قولك: سآتيك لا يحتمل إلى أحدهما بخلاف قولك زيد قائمًا أخطب منه قاعدًا، وإذا بعد كل البعد إضمار الظرف ههنا. فإضماره مع كان أبعد ومن قدره من النحاة، فإنما أشار إلى شرح المعنى بضرب من التقريب.
فإن قيل: الذي يدل على أنه لا بد من إضمار كان. أن هذا الكلام لا يذكر إلا لتفضيل شيء في زمان من أزمانه على نفسه في زمان آخر، ويجوز أن يكون الزمان المفضل فيه ماضيًا، وأن يكون مستقبلًا، ولا بد من إضمار ما يدل على المراد منهما فيضمر للماضي إذ وللمستقبل إذا. وإذ وإذا يطلبان الفعل وأعم الأفعال وأشملها فعل الكون الشامل لكل كائن ولهذا كثير ما يضمرونه، فلا بد من فعل يضاف إليه الظرف لاستحالة أن تقول: هذا إذ بسرًا أطيب منه إذ رطبًا فتعين إضمار كان لتصحيح الكلام.
قيل: هذا السؤال إنما يلزم إذ أضمرنا الظرف. وأما إذا لم نضمره لم نحتج إلى كان ويكون. وأما قولكم إنه يفضل الشيء على نفسه باعتبار زمانين وإذ وإذا للزمان. فجوابه أن في التصريح بالحالين المفضل أحدهما على الآخر غنية عن ذكر الزمان وتقدير إضماره. ألا ترى أنك إذا قلت: هذا في حال بسريته أطيب منه في حال رطبيته استقام الكلام ولا إذ هنا، ولا إذا لدلالة الحال على مقصود المتكلم من أن التفضيل باعتبار الوقتين، وكذلك تقول: هذا في حال شبوبيته أعقل منه في حال شيخوخته، ونظائر ذلك مما يصح فيه التفضيل باعتبار زمانين من غير ذكر ظرف، ولا تقديره فافهمه.
فصل: اتحاد المفضل والمفضل عليه
وأما السؤال العاشر: وهو أنه هل يشترط اتحاد المفضل والمفضل عليه بالحقيقة؟
فجوابها أن وضعها كذلك. ولا يجوز أن يقال: هذا بسرًا أطيب منه عنبًا، لأن وضع هذا الباب لتفضيل الشيء على نفسه باعتبارين وفي زمانين. قال الأخفش كل ما لا يتحول إلى شيء فهو رفع نحو هذا بسر أطيب منه عنب. فأطيب مبتدأ وعنب خبره. وفي هذا التركيب إشكال. وتوجيهه أن الكلام جملتان إحداهما قولك هذا بسر. والثانية قولك أطيب منه عنب، والمعنى العنب أطيب منه فأفدت خبرين. أحدهما أنه بسر. والثاني أن العنب أطيب منه. ولو قلت هذا البسر أطيب منه عنب لاتضحت المسألة وانكشف معناها والله أعلم.
فهذا ما في هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث علقتها صيدًا لسوانح الخاطر فيها خشية أن لا يعود فليسامح الناظر فيها فإنها علقت على حين بعدي من كتبي وعدم تمكني من مراجعتها وهكذا غالب هذا التعليق. إنما هو صيد خاطر والله والمستعان.
(مسألة سلام عليكم ورحمة الله)
سلام عليكم ورحمة الله
في هذا التسليم ثمانية وعشرون سؤالًا.
السؤال الأول: ما معنى السلام وحقيقته؟
السؤال الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟
السؤال الثالث: هل قول المسلم سلام عليكم خبر أو إنشاء وطلب؟
السؤال الرابع: ما معنى السلام المطلوب عند التحية وإذا كان دعاء وطلبًا فما الحكمة في طلبه عند التلاقي والمكاتبة دون غيره من المعاني؟
السؤال الخامس: إذا كان من السلامة فمعلوم أن الفعل منها لا يتعدى بعلى فلا يقال سلامة عليك وسلمت عليك بكسر اللام وإنما يقال سلام لك كما قال تعالى: { فسلام لك من أصحاب اليمين }. [155]
السؤال السادس: ما الحكمة في الابتداء بالنكرة في السلام مع كون الخبر جارًا ومجرورًا وقياس العربية تقديم الخبر في ذلك نحو في الدار رجل؟
السؤال السابع: لم اختص المسلم بهذا النظم والراد بتقديم الجار والمجرور على السلام وهلا كان رده بتقديم السلام مطلقًا كابتدائه؟
السؤال الثامن: ما الحكمة في كون سلام المبتدي بلفظ النكرة وسلام الراد عليه بلفظ المعرفة وكذلك ما الحكمة في ابتداء السلام قف المكاتبة بالنكرة وفي آخرها بالمعرفة فيقال أولا سلام عليكم، وفي انتهاء المكاتبة والسلام عليكم. وهل هذا التعريف لأجل العهد وتقدم السلام أم لحكمة سوى ذلك.
السؤال التاسع: ما الفائدة في دخول الواو العاطفة في السلام الآخر؟ فيقول أولا سلام عليكم، وفي الانتهاء والسلام عليكم، وعلى أي شيء هذا العطف؟
السؤال العاشر: ما السر في نصب السلام في تسليم الملائكة ورفعه في تسليم إبراهيم وهل هو كما تقول: النحاة أن سلام إبراهيم أكمل لتضمنه جملة إسمية دالة على الثبوت وتضمن سلام الملائكة صيغة جملة فعلية دالة على الحدوث أم لسر غير ذلك؟
السؤال الحادي عشر: ما السر في نصب السلام؟ من قوله تعالى: { وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا }، [156] ورفعه من قوله: { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم }، [157] أو ما الفرق بين الموضعين؟
السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله والسلام إنما هو طلب السلامة للمسلم عليه فكيف يتصور هذا المعنى في حق الله؟ وهذا من أهم الأسئلة وأحسنها.
السؤال الثالث عشر: إذا ظهرت حكمة سلامه تعالى عليهم فما الحكمة في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ فيقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكذلك سلامهم على أنفسهم وعلى عباد الله الصالحين.
السؤال الرابع عشر: ما السر في تسليم الله على يحيى بلفظ النكرة في قوله: وسلام عليه وتسليم المسيح نفسه بلفظ المعرفة بقوله: { والسلام علي }، وأي السلامين أتم وأعم.
السؤال الخامس عشر: ما الحكمة في تقييد هذين السلامين بهذه الأيام الثلاثة: { يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا }، [158] خاصة مع أن السلام مطلوب في جميع الأوقات فلو أتى به مطلقًا. أما كان أعم. فإن هذا التقييد خص السلام بهذه الأيام خاصة؟
السؤال السادس عشر: ما الحكمة في تسليم النبي ﷺ على من اتبع الهدى في كتاب هرقل بلفظ النكرة، وتسليم موسى على من اتبع الهدى بلفظ المعرفة ليطابق القرآن وما الفرق بينهما؟
السؤال السابع عشر: قوله تعالى: { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى }، [159] هل هذا سلام من الله فيكون الكلام قد تضمن جملتين طلبية وهي الأمر بقوله: قل الحمد لله، وخبرية وهي سلامه تعالى على عباده وعلى هذا، فيكون من باب عطف الخبر على الطلب أو هو أمر من الله بالسلام عليهم. وعلى هذا فيكون قد أمر بشيئين أحدهما قول الحمد لله، والثاني قول سلام على عباده الذين اصطفى ويكون كلاهما معمولًا لفعل القول وأي المعنيين أليق بالآية.
السؤال الثامن عشر: روى أبو داود في سننه من حديث أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال: «لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى»، قال الترمذي: حديث صحيح وقد صح عنه في السلام على الأموات فعلًا وأمرًا السلام عليكم دار قوم مؤمنين فما وجه هذا الحديث وكيف الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة؟
السؤال التاسع عشر: ما وجه دخول الواو في قول النبي ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم» وقد استشكل كثير من الناس أمر هذه الواو حتى أنكر بعضهم من الحذاق أن تكون ثابتة، قال: لأن الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الأول وتصديقه. كما إذا قلت زيد كاتب. فقال: المخاطب وفقيه فإنه يقتضي إثبات الأول وزيادة وصف فقيه. فكيف دخلت في هذا الموضع وما وجهها؟
السؤال العشرون: ما السر في اقتران الرحمة والبركة بالسلام دون غيرها من الصفات كالمغفرة والبر والإحسان ونحو هذا؟
السؤال الحادي والعشرون: لم كانت نهاية السلام عند قوله وبركاته ولم تشرع الزيادة عليها.
السؤال الثاني والعشرون: ما الحكمة في إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى وتجريد السلام عن هذه الإضافة ولم لا أضيفت كلها أو جردت كلها.
السؤال الثالث والعشرون: ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة.
السؤال الرابع والعشرون: ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي ﷺ بالمصدر دون الصلاة في قوله تعالى: { صلوا عليه وسلموا تسليمًا }، [160] ولم يقل صلوا صلاة.
السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقديم السلام عليه في الصلاة على الصلاة عليه، وهلا وقعت البداءة بالصلة عليه أولًا، ثم اتبعت بالسلام لتصح البداءة بما بدأ الله به من تقديم الصلاة على السلام؟
السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام عليه في الصلاة بصيغة خطاب المواجهة؟ وأما الصلاة عليه فجاءت بصيغة الغيبة لذكره باسم العلم.
السؤال السابع والعشرون: وهو ما جر إليه طرد الكلام ما الحكمة في كون الثناء على الله ورد بصيغة الغيبة في قولنا التحيات الله مع أنه سبحانه هو المناجي المخاطب الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا، وجاء السلام على النبي ﷺ بصيغة الخطاب. مع أن الحال كان يقتضي العكس فما الحكمة في ذلك؟
السؤال الثامن والعشرون: وهو خاتمة الأسئلة ما السر في كون السلام خاتمة الصلاة وهلا كان في ابتدائها. وإذا كان كذلك. فما السر في مجيئه معرفًا وهلا جاء منكرًا؟
أما السؤال الأول: وهو ما حقيقة هذه اللفظة. فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها فمن ذلك، قولك: سلمك الله وسلم فلان من الشر. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم اللهم سلم ومنه سلم الشيء لفلان. أي خلص له وحده. فخلص من ضرر الشركة فيه قال تعالى: { ضرب الله مثلًا رجلًا فيه شركاء متشاكسون ورجلًا سلمًا لرجل }. [161] أي خالصًا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب قال تعالى: { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها }، [162] لأن كلًا من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ولهذا يبني منه على المفاعلة. فيقال: المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الغل والدغل. وحقيقته الذي قد سلم الله وحده. فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات. بل هو المستقيم على صدق حبه، وحسن معاملته. فهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته، ومنه أخذ الإسلام فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله، والتخلص من شوائب الشرك فسلم لربه، وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون، ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم المخلص الخالص لربه والمشرك به.
ومنه السَّلَم للسَّلَف، وحقيقته العوض المسلم فيه، لأن من هو في ذمته قد ضمن سلامته لربه، ثم سمى العقد سلمًا وحقيقته ما ذكرناه.
فإن قيل: فهذا ينتقض بقولهم للديغ سليما.
قيل: ليس هذا بنقض له. بل طرد لما قلناه فإنهم سموه سليمًا باعتبار ما يهمه ويطلبه ويرجو أن يؤول إليه حاله من السلامة. فليس عنده أهم من السلامة ولا هو أشد طلبًا منه لغيرها. فسمي سليمًا لذلك. وهذا من جنس تسميتهم المهلكة مفازة، لأنه لا شيء أهم عند سالكها من فوزه منها أي نجاته. فسميت مفازة لأنه يطلب الفوز منها. وهذا أحسن من قولهم: إنما سميت مفازة وسمي اللديغ سليمًا تفاؤلًا، وإن كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذي ذكرناه وداخل فيه فهو أعم وأحسن.
فإن قيل: فكيف يمكنكم رد السلم إلى هذا الأصل.
قيل: ذلك ظاهر، لأن الصاعد إلى مكان مرتفع لما كان متعرضًا للهوي والسقوط طالبًا للسلامة راجيًا لها سميت الآلة التي يتوصل بها إلى غرضه سلمًا لتضمنها سلامته. إذ لو صعد بتكلف من غير سلم لكان عطبه متوقعًا. فصح أن السلم من هذا المعنى.
ومنه تسمية الجنة بدار السلام وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني: أنها إضافة إلى تحية أهلها فإن تحيتهم فيها سلام. الثالث: أنها إضافة إلى معنى السلامة، أي دار السلامة من كل آفة ونقص وشر والثلاثة متلازمة. وإن كان الثالث أظهرها فإنه لو كانت الإضافة إلى مالكها لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلام. وكان يقال دار الرحمن، أو دار الله، أو دار الملك. ونحو ذلك. فإذا عهدت إضافتها إليه، ثم جاء دار السلام حملت على المعهود، وأيضا فإن المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتها، أو إلى أهلها.
أما الأول فنحو دار القرار دار الخلد جنة المأوى جنات النعيم جنات الفردوس. وأما الثاني فنحو دار المتقين ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القرآن فالأولى حمل الإضافة على المعهود في القرآن.
وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين؛ أحدهما: أن التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة وما يضاف إلى الجنة لا يكون إلا مختصًا بها كالخلد والقرار والبقاء. الثاني: أن من أوصافها غير التحية ما هو أكمل منها مثل كونها دائمة وباقية، ودار الخلد والتحية فيها عارضة عند التلاقي والتزاور بخلاف السلامة من كل عيب ونقص وشر. فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام التي لا يتم النعيم فيها إلا به فإضافتها إليه أولى وهذا ظاهر.
فصل: إطلاق السلام على الله تعالى
وإذا عرف هذا فإطلاق السلام على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى من هذا كله وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به، لسلامته سبحانه من كل عيب ونقص من كل وجه. فهو السلام الحق بكل اعتبار والمخلوق سلام بالإضافة، فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة، بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار. فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه. وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه ونزهه به رسوله، فهو السلام من الصاحبة والولد والسلام من النظير والكفء والسمي والمماثل والسلام من الشريك. وكذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها، فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم، وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة وكلماته سلام من الكذب والظلم، بل تمت كلماته صدقا وعدلا وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غني عن كل ما سواه وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه وإلاهيته سلام من مشارك له فيها بل هو الله الذي لا إله إلا هو وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذلك أو مصانعة كما يكون من غيره بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه.
وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلما أو تشفيا أو غلظة أو قسوة، بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء مواضعها وهو مما يستحق عليه الحمد والثناء كما يستحقه علي إحسانه وثوابه ونعمه بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته، فوضعه العقوبة موضعها هو من عدله وحكمته وعزته، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته.
وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل.
وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى. ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق. بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز.
واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرض ولا غيره بوجه ما. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه وسلام مما يضاد غناه وكماله، وسلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصورا في شيء - تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه. وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل.
وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذلك كما يوالي المخلوق المخلوق بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر كما قال تعالى: { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل }. [163] فلم ينف أن يكون له ولي مطلقا بل نفي أن يكون له ولي من الذل.
وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه وسلام مما يتقوله المعطلون فيها وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل.
فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني والله المستعان المسئول أن يوفق للتعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط إنه قريب مجيب
فصل: هل السلام مصدر أو اسم مصدر
وأما السؤال الثاني، وهو هل السلام مصدر أو اسم؟
فالجواب أن السلام الذي هو التحية اسم مصدر من سلَّم، ومصدره الجاري عليه تسليم كعلَّم تعليما وفهم تفهيما وكلم تكليما. والسلام من سلم كالكلام من كلم.
فإن قيل: وما الفرق بين المصدر والاسم؟
قلنا: بينهما فرقان لفظي ومعنوي.
أما اللفظي فإن المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قياسه كالأفعال من أفعل والتفعيل من فعل والإنفعال من انفعل والتفعلل من تفعلل وبابه. وأما السلام والكلام فليسا بجاريين على فعليهما ولو جريا عليه لقيل تسليم وتكليم.
وأما الفرق المعنوي فهو أن المصدر دال على الحدث وفاعله. فإذا قلت تكليم وتسليم وتعليم ونحو ذلك دل على الحدث ومن قام به، فيدل التسليم على السلام والمسلم وكذلك التكليم والتعليم. وأما اسم المصدر فإنما يدل على الحدث وحده، فالسلام والكلام لا يدل لفظه على مسلِّم ولا مكلم، بخلاف التكليم والتسليم.
وسر هذا الفرق أن المصدر في قولك سلم تسليما وكلم تكليما بمنزلة تكرار الفعل فكأنك قلت سلم سلم وتكلم تكلم والفعل لا يخلو عن فاعله أبدا. وأما اسم المصدر فإنهم جردوه لمجرد الدلالة على الحدث. وهذه النكتة من أسرار العربية، فهذا السلام الذي هو التحية.
وأما السلام الذي هو اسم من أسماء الله ففيه قولان:
أحدهما: أنه كذلك اسم مصدر وإطلاقه عليه كإطلاق العدل عليه والمعنى أنه ذو السلام وذو العدل على حذف المضاف.
والثاني أن المصدر بمعنى الفاعل هنا أي السالم كما سميت ليلة القدر سلاما أي سالمة من كل شر بل هي خير لا شر فيها.
وأحسن من القولين وأقيس في العربية أن يكون نفس السلام من أسمائه تعالى كالعدل وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه غالبا عليه مكررا منه كقولهم رجل صوم وعدل وزور وبابه.
وأما السلام الذي هو بمعنى السلامة فهو مصدر نفسه وهو مثل الجلال والجلالة فإذا حذفت التاء كان المراد نفس المصدر وإذا أتيت بالثاء كان فيه إيذان بالتحديد بالمرة من المصدر كالحب والحبة فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث لم يكن فيه تاء التحديد. والسلامة والجلالة والملاحة والفصاحة كلها تدل على الخصلة الواحدة.
ألا ترى أن الملاحة خصلة من خصال الكمال والجلالة من خصال الجلال، ولهذا لم يقولوا كمالة كما قالوا مَلاحة وفصاحة، لأن الكمال اسم جامع لصفات الشرف والفضل فلو قالوا كمالة لنقضوا الغرض المقصود من اسم الكمال فتأمله.
وعلى هذا جاءت الحلاوة والأصالة والرزانة والرجاحة لأنها خصلة من مطلق الكمال والجمال محدودة فجاءوا فيها بالتاء الدالة على التحديد؛ وعكسه الحماقة والرقاعة والنذالة والسفاهة فإنها خصال محدودة من مطلق العيب والنقص فجاءوا في الجنس الذي يشمل الأنواع بغير تاء فجاءوا في أنواعه وأفراده بالتاء، وقد تقدم تقرير هذا المعنى وأيضا فلا حاجة إلى إعادته.
فتأمل الآن كيف جاء السلام مجردا عن التاء إيذانا بحصول المسمى التام إذ لا يحصل المقصود إلا به، فإنه لو سلم من آفة ووقع في آفة لم يكن قد حصل له السلام فوضح أن السلام لم يخرج عن المصدرية في جميع وجوهه.
فإن قيل: فما الحكمة في مجيئه اسم مصدر ولم يجيء على أصل المصدر؟
قيل: هذا السر بديع وهو أن المقصود حصول مسمى السلامة للمسلَّم عليه على الإطلاق من غير تقييد بفاعل، فلما كان المراد مطلق السلامة من غير تعرض لفاعل أتوا باسم المصدر الدال على مجرد الفعل ولم يأتوا بالمصدر الدال على الفعل والفاعل معًا، فتأمله.
فصل: هل السلام عليكم إنشاء أم خبر
وأما السؤال الثالث: وهو أن قول المسلم سلام عليكم هل هو إنشاء أم خبر؟
فجوابه: أن هذا ونحوه من ألفاظ الدعاء متضمن للإنشاء والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض جهة الإنشائية. وهذا موضع بديع يحتاج إلى كشف وإيضاح. فنقول: الكلام له نسبتان نسبة إلى المتكلم به نفسه، ونسبة إلى المتكلم فيه إما طلبًا، وإما خبرًا. وله نسبة ثالثة إلى المخاطب لا يتعلق بها هذا الغرض. وإنما يتعلق تحقيقه بالنسبتين الأوليين فباعتبار تينك النسبتين نشأ التقسيم إلى الخبر، والإنشاء ويعلم أين يجتمعان وأين يفترقان. فله بنسبته إلى قصد المتكلم وإرادته لثبوت مضمونه وصف الإنشاء، وله بنسبته إلى المتكلم فيه والإعلام بتحققه في الخارج وصف الأخبار، ثم تجتمع النسبتان في موضع وتفترقان في موضع. فكل موضع كان المعنى فيه حاصلًا بقصد المتكلم وإرادته فقط. فإنه لا يجامع فيه الخبر الإنشاء نحو قوله: بعتك كذا، ووهبتكه وأعتقت وطلقت. فإن هذه المعاني لم يثبت لها وجود خارجي إلا بإرادة المتكلم وقصده. فهي إنشاءات وخبريتها من جهة أخرى وهي تضمنها إخبار المتكلم عن ثبوت هذه النسبة في ذهنه. لكن ليست هذه هي الخبرية التي وضع لها لفظ الخبر وكل موضع كان المعنى حاصلًا فيه من غير جهة المتكلم. وليس للمتكلم إلا دعاؤه بحصوله ومحبته. فالخبر فيه لا يناقض الإنشاء وهذا نحو سلام عليكم. فإن السلامة المطلوبة لم تحصل بفعل المسلم، وليس للمسلم إلا الدعاء بها ومحبتها فإذا قال: سلام عليكم تضمن الإخبار بحصول السلامة والإنشاء للدعاء بها وإرادتها وتمنيها، وكذلك ويل له قال سيبويه: هو دعاء وخبر ولم يفهم كثير من الناس قول سيبويه على وجهه. بل حرفوه عما أراده به. وإنما أراد سيبويه هذا المعنى أنها تتضمن الإخبار بحصول الويل له مع الدعاء به، فتدبر هذه النكتة التي لا تجدها محررة في غير هذا الموضع هكذا. بل تجدهم يطلقون تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء من غير تحرير. وبيان لمواضع اجتماعهما وافتراقهما. وقد عرفت بهذا أن قولهم سلام عليكم وويل له وما أشبه هذا أبلغ من إخراج الكلام في صورة الطلب المجرد نحو اللهم سلمه.
فصل: معنى السلام المطلوب عند التحية
وأما السؤال الرابع: وهو ما معنى السلام المطلوب عند التحية ففيه قولان مشهوران:
أحدهما: أن المعنى اسم السلام عليكم والسلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام نزنت بركة اسمه عليكم، وحلت عليكم ونحو هذا واختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء لما يأتي في جواب السؤال الذي بعده، واحتج أصحاب هذا القول بحجج منها ما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على فلان فقال النبي ﷺ: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام». ولكن قولوا: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فنهاهم النبي ﷺ أن يقولوا: السلام على الله، لأن السلام على المسلم عليه دعاء له، وطلب أن يسلم والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له. فيستحيل أن يسلم عليه. بل هو المسلم على عباده كما سلم عليهم في كتابه. حيث يقول: { سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين }، [164] وقوله: { سلام على إبراهيم }، [165] { سلام على نوح }، [166] { سلام على إل ياسين }، [167] وقال في يحيى: { وسلام عليه } وقال لنوح: { اهبط بسلام منا وبركات عليك }، [168] ويسلم يوم القيامة على أهل الجنة كما قال تعالى: { لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون * سلام قولًا من رب رحيم }، [169] فقولًا منصوب على المصدر، وفعله ما تضمنه سلام من القول، لأن السلام قول.
وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة من، حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوقهم فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم». وقال: «يا أهل الجنة سلام عليكم»، ثم قرأ قوله: { سلام قولًا من رب رحيم }، [170] ثم يتوارى عنهم فتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم.
وفي سنن ابن ماجة مرفوعًا أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر، وقال تعالى: { تحيتهم يوم يلقونه سلام }، [171] فهذا تحيتهم يوم يلقونه تبارك وتعالى. ومحال أن تكون هذه تحية منهم له. فإنهم أعرف به من أن يسلموا عليه، وقد نهوا عن ذلك في الدنيا، وإنما هذا تحية منه لهم. والتحية هنا مضافة إلى المفعول فهي التحية التي يحيون بها لا التحية التي يحيونه هم بها. ولولا قوله تعالى في سورة يس: { قولًا من رب رحيم }، لاحتمل أن تكون التحية لهم من الملائكة كما قال تعالى: { والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم }. [172] ولكن هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازلهم من الجنة يدخلون مسلمين عليهم، وأما التحية المذكورة في قوله: { تحيتهم يوم يلقونه سلام }، فتلك تحية لهم وقت اللقاء كما يحيي الحبيب حبيبه، إذا لقيه. فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ؟
يكفي الذي غاب عنك غيبته ** فذاك ذنب عقابه فيه
والمقصود أن الله تعالى يطلب منه السلام. فلا يمتنع في حقه أن يسلم على عباده ولا يطلب له، فلذلك لا يسلم عليه. وقوله ﷺ: «إن الله هو السلام» صريح في كون السلام اسمًا من أسمائه.
قالوا: فإذا قال المسلم: سلام عليكم كان معناها اسم السلام عليكم. ومن حججهم ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رجلًا سلم على النبي ﷺ فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار، ثم تيمم ورد عليه وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر»، قالوا: ففي هذا الحديث بيان أن السلام ذكر الله. وإنما يكون ذكرًا إذا تضمن اسمًا من أسمائه.
ومن حججهم أيضا أن الكفار من أهل الكتاب لا يُبدأون بالسلام. فلا يقال لهم: سلام عليكم. ومعلوم أنه لايكره أن يقال لأحدهم: سلمك الله وما ذاك إلا أن السلام اسم من أسماء الله. فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة ذلك الاسم عليه. فهذه حجج كما ترى قوية ظاهرة.
القول الثاني: أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أن يذكر بلا ألف ولام. بل يقول المسلم سلام عليكم ولو كان اسمًا من أسماء الله لم يستعمل كذلك. بل كان يطلق عليه معرفًا كما يطلق عليه سائر أسمائه الحسنى فيقال: السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر فإن التنكير لايصرف اللفظ إلى معين فضلًا عن أن يصرفه إلى الله وحده، بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينًا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى.
ومن حججهم أيضا أن عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدل على أن المراد به المصدر ولهذا عطف عليه مصدرين مثله.
ومن حججهم أيضا أنه لو كان السلام هنا اسمًا من أسماء الله لم يستقم الكلام إلا بإضمار وتقدير يكون به مقيدًا، ويكون المعنى بركة اسم السلام عليكم. فإن الاسم نفسه ليس عليهم، ولو قلت: اسم الله عليك كان معناه بركة هذا الاسم ونحو ذلك من التقدير، ومعلوم أن هذا التقدير خلاف الأصل ولا دليل عليه.
ومن حججهم أيضا أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرًا ودعاء كما يأتي في جواب السؤال الذي بعد هذا. ولهذا كان السلام أمانًا لتضمنه معنى السلامة وأمن كل واحد من المسلم والراد عليه من صاحبه. قالوا: فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وحذفت تاؤه، لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه، والتاء تفيد التحديد كما تقدم.
وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال الحق في مجموع القولين فكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما وإنما نبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارًا وهي أن من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله. حتى كأن الداعي مستشفع إليه متوسل إليه به فإذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه بإسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، وكذلك قول النبي ﷺ لعائشة وقد سألته ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني» وكذلك قوله للصديق وقد سأله أن يعلمه دعاء يدعو به: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» وهذا كثيرًا جدًا فلا نطول بإيراد شواهده.
وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي يطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله كما في حديث ابن عمر. والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسمًا من أسماء الله، وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة.
وقريب من هذا ما روى عن بعض السلف. إنه قال في آمين: إنه اسم من أسماء الله تعالى. وأنكر كثير من الناس هذا القول. وقالوا: ليس في أسمائه آمين، ولم يفهموا معنى كلامه فإنه، إنما أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تبارك وتعالى، فإن معناها استجب وأعط ما سألناك فهي متضمنة لإسمه مع دلالتها على الطلب. وهذا التضمن في سلام عليكم أظهر، لأن السلام من أسمائه تعالى. فهذا كشف سر المسألة.
فصل: الحكمة في السلام عند اللقاء
إذا عرف هذا، فالحكمة في طلبه عند اللقاء دون غيره من الدعاء. إن عادة الناس الجارية بينهم أن يحيي بعضهم بعضًا عند لقائه، وكل طائفة لهم في تحيتهم ألفاظ وأمور اصطلحوا عليها. وكانت العرب تقول في تحيتهم بينهم في الجاهلية. أنعم صباحًا وأنعموا صباحًا. فيأتون بلفظة أنعموا من النعمة بفتح النون. وهي طيب العيش والحياة ويصلونها بقولهم صباحًا، لأن الصباح في أول النهار. فإذا حصلت فيه النعمة استصحب حكمها واستمرت اليوم كله فخصوها بأوله إيذانًا لتعجيلها وعدم تأخرها إلى أن يتعالى النهار، وكذلك يقولون: أنعموا مساء. فإن الزمان هو صباح ومساء. فالصباح في أول النهار إلى بعد انتصافه. والمساء من بعد انتصافه إلى الليل. ولهذا يقول الناس: صبحك الله بخير، ومساك الله بخير، فهذا معنى أنعم صباحًا ومساء، إلا أن فيه ذكر الله.
وكانت الفرس يقولون في تحيتهم: "هزار سال بيمائي" [173] أي تعيش ألف سنة. وكل أمة لهم تحية من هذا الجنس أو ما أشبهه، ولهم تحية يخصون بها ملوكهم من هيئات خاصة عند دخولهم عليهم، كالسجود ونحوه، وألفاظ خاصة تتميز بها تحية الملك من تحية السوقة وكل ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامها. ولهذا سميت تحية وهي تفعلة من الحياة كتكرمة من الكرامة. لكن أدغم المثلان فصار تحية فشرع الملك القدوس السلام تبارك وتعالى لأهل السلام تحية بينهم سلام عليكم وكانت أولى من جميع تحيات الأمم، التي منها ما هو محال وكذب نحو قولهم تعيش ألف سنة، وما هو قاصر المعنى، مثل أنعم صباحًا ومنها ما لا ينبغي إلا لله مثل السجود. فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها. فهي الأصل المقدم على كل شيء.
ومقصود العبد من الحياة إنما يحصل بشيئين؛ بسلامته من السر وحصول الخير كله، والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهي الأصل. ولهذا إنما يهتم الإنسان بل كل حيوان بسلامته أولًا، ثم غنيمته ثانيًا. على أن السلامة المطلقة تضمن حصول الخير. فإنه لو فاته حصل له الهلاك والعطب أو النقص والضعف. ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة فتضمنت السلامة نجاته من كل شر وفوزه بالخير. فانتظمت الأصلين الذين لا تتم الحياة إلا بهما مع كونها مشتقة من اسمه السلام ومتضمنة له وحذفت التاء منها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا السلامة الواحدة. ولما كانت الجنة دار السلامة من كل عيب وشر وآفة، بل قد سلمت من كل ما ينغص العيش، والحياة كانت تحية أهلها فيها سلام، والرب يحييهم فيها بالسلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذا سر التحية بالسلام عند اللقاء.
وأما عند المكاتبة فلما كان المراسلان كل منهما غائب عن الآخر ورسوله إليه كتابه يقوم مقام خطابه له، استعمل في مكاتبته له من السلام ما يستعمله معه لو خاطبه لقيام الكتاب مقام الخطاب.
فصل: تعدية السلام بعلى
وأما السؤال الخامس: وهو تعدية هذا المعنى بعلى.
فجواب بذكر مقدمة وهي ما معنى قوله سلمت. فإذا عرف معناها عرف أن حرف على أليق به. فاعلم أن لفظ سلمت عليه، وصليت عليه، ولعنت فلانًا موضوعها ألفاظ هي جمل طلبية وليس موضوعها معاني مفردة. فقولك: سلمت، موضوعه: قلت: السلام عليك. وموضوع صليت عليه قلت: اللهم صل عليه أو دعوت له. وموضوع لعنته قلت: اللهم العنه.
نظير هذا سبحت الله قلت: سبحان الله. ونظيره وإن كان مشتقًا من لفظ الجملة هلل إذا قال: لا إله إلا الله، وحمدل إذا قال: الحمد الله، وحوقل إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيعل إذا قال: حي على الصلاة وبسمل إذا قال بسم الله. قال:
وقد بسملت ليلى غداة لقيتها ** ألا حبذا ذاك الحبيب المبسمل
وإذا ثبت هذا فقولك: سلمت عليه أي ألقيت عليه هذا اللفظ وأوضعته عليه إيذانًا باشتمال معناه عليه كاشتمال لباسه عليه. وكان حرف على أليق الحروف به فتأمله.
وأما قوله تعالى: { وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين }، [174] فليس هذا سلام تحية ولو كان تحية لقال: فسلام عليه كما قال: { سلام على إبراهيم }، [175] { سلام على نوح }، [176] ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله. فذكر أنهم ثلاثة أقسام. مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم. ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة ووعد المقرب بالغنيمة والفوز. وإن كان كل منهما سالمًا غانمًا... وظالم بتكذيبه وضلاله. فأوعده بنزل من حميم وتصلية جحيم. فلما لما يكن المقام مقام تحية، وإنما هو مقام أخبار عن حاله ذكر ما يحصل له من السلامة.
فإن قيل: فهذا فرق صحيح. لكن ما معنى اللام في قوله لك، ومن هو المخاطب بهذا الخطاب، وما معنى حرف من في قوله من أصحاب اليمين؟ فهذه ثلاثة أسئلة في الآية.
قيل: قد وفينا بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في الآية، وبين سلام التحية وهو الذي كان المقصود. وهذه الأسئلة وإن كانت متعلقة بالآية فهي خارجة عن مقصودنا، ولكن نجيب عنها إكمالًا للفائدة بحول الله وقوته، وإن كنا لم نر أحدًا من المفسرين شفى في هذا الموضع الغليل، ولا كشف حقيقة المعنى واللفظ، بل منهم من يقول المعنى فمسلم لك إنك من أصحاب اليمين ومنهم من يقول غير ذلك مما هو حرم على معناها من غير ورود.
فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مضاف إلى صاحبه بلام الإضافة الدالة على حصوله له. ومن ذلك قوله تعالى: { أولئك لهم اللعنة }، [177] ولم يقل عليهم اللعنة إيذانًا بحصول معناها وثبوته لهم. وكذلك قوله: { ولكم الويل مما تصفون }. [178] ويقول في ضد هذا: لك الرحمة، ولك التحية، ولك السلام. ومنه هذه الآية: { فسلام لك }، أي ثبت لك السلام وحصل لك.
وعلى هذا فالخطاب لكل من هو من هذا الضرب فهو خطاب للجنس، أي فسلام لك يا من هو من أصحاب اليمين، كما تقول هنيئًا لك يا من هو منهم. ولهذا والله أعلم أتى بحرف من في قوله: { من أصحاب اليمين }. [179] والجار والمجرور في موضع حال أي سلام لك كائنًا من أصحاب اليمين، كما تقول: هنيئًا لك من أتباع رسول الله وحزبه، أي: كائنًا منهم، والجار والمجرور بعد المعرفة ينتصب على الحال كما تقول: أحببتك من أهل الدين والعلم، أي: كائنًا منهم. فهذا معنى هذا الآية، وهو وإن خلت عنه كتب أهل التفسير فقد حام عليه منهم من حام وما ورد ولا كشف المعنى ولا أوضحه. فراجع ما قالوه والله الموفق المان بفضله.
فصل: الابتداء بالنكرة في السلام
وأما السؤال السادس: وهو ما الحكمة في الابتداء بالنكرة ههنا مع أن الأصل تقديم الخبر عليها؟ هذا سؤال قد تضمن سؤالين؛ أحدهما: حكمة الابتداء بالنكرة في هذا الموضع. الثاني: أنه إذ قد ابتدىء بها فهلا قدم الخبر على المبتدأ، لأنه قياس الباب، نحو: في الدار رجل؟
والجواب عن السؤال الأول أن يقال: النحاة قالوا: إذا كان في النكرة معنى الدعاء مثل سلام لك وويل له جاز الابتداء بها، لأن الدعاء معنى من معاني الكلام. فقد تخصصت النكرة بنوع من التخصيص. فجاز الابتداء بها وهذا كلام لا حقيقة تحته. فإن الخبر أيضا نوع من أنواع الكلام ومع هذا فلا تكون جهة الخبر مسوغة للابتداء بالنكرة، فكيف تكون جهة الدعاء مسوغة للابتداء بها؟
وما الفرق بين كون الدعاء نوعًا والخبر نوعًا والطلب نوعًا، وهل يفيد ذلك تعيين مسمى النكرة حتى يصلح الإخبار عنها؟ فإن المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من تحصيلها عند المخاطب في ذهنه حتى يستفيد نسبة الإسناد الخبري إليها. ولا فرق في ذلك بين كون الكلام دعاء أو خبرًا. وقول من قال: إن الابتداء بالنكرة. إنما امتنع حيث لا يفيد نحو رجل في الدنيا ورجل مات ونحو ذلك. فإذا أفادت جاز الابتداء بها من غير تقييد بضابط ولا حصر بعد. وأحسن من تقييد ذلك يكون الكلام دعاء، أو في قوة كلام آخر وغير ذلك من الضوابط المذكورة. وهذه طريقة إمام النحو سيبويه. فإنه في كتابه لم يجعل للابتداء بها ضابطًا ولا حصره بعدد. بل جعل مناط الصحة الفائدة وهذا هو الحق الذي لا يثبت عند النظر سواه. وكل من تكلف ضابطًا فإنه ترد عليه ألفاظ خارجة عنه. فأما أن يتمحل لردها إلى ذلك الضابط. وإما أن يفردها بضوابط آخر حتى آل الأمر ببعض النحاة إلى أن جعل في الباب ثلاثين ضابطًا، وربما زاد غيره عليها، وكل هذا تكلف لا حاجة إليه. واسترحت من "شَرٌّ أَهَرَّ ذا نابٍ" [180] وبابه.
فإن قلت: فما عندك من الضابط إذا سلكت طريقتهم في ذلك؟
قلت: اسمع الآن قاعدة جامعة في هذا الباب لا يكاد يشذ عنها شيء منه. أصل المبتدأ أن يكون معرفة أو مخصوصًا بضرب من ضروب التخصيص بوجه تحصل الفائدة من الإخبارى عنه. فإن انتفت عنه وجوه التخصيص بأجمعها فلا يخبر عنه إلا أن يكون الخبر مجرورًا مفيدًا معرفة، مقدمًا عليه بهذه الشروط الأربعة، لأنه إذا تقدم وكان معرفة صار كان الحديث عنه وكأن المبتدأ المؤخر خبر عنه.
ومثال ذلك إذا قلت على زيد دين، فإنك تجد هذا الكلام في قوة قولك زيد مديان أو مدين. فمحط الفائدة هو الدين وهو المستفاد من الأخبار فلا تنحبس في قيود الأوضاع. وتقول على زيد، جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ فأنت تراه هو المخبر عنه في الحقيقة وليس المقصود الإخبار عن الدين بل عن زيد بأنه مديان، وإن كثف ذهنك عن هذا. فراجع شروط المبتدأ وشروط الخبر. وإن لم يكن الخبر مفيدًا لم تفد المسألة شيئًا. وكان لا فرق بين تقديم الخبر وتأخيره، كما إذا قلت في الدنيا: رجل كان في عدم الفائدة بمنزلة قولك رجل في الدنيا. فهنا لم تمتنع الفائدة بتقديم ولا تأخير. وإنما امتنعت من كون الخبر غير مفيد. ومثل هذا قولك في الدار امرأة فإنه كلام مفيد، لأنه بمنزلة قولك الدار فيها امرأة. فأخبرت عن الدار بحصول المرأة فيها في اللفظ والمعنى. فإنك لم ترد الإخبار عن المرأة بأنها في الدار، ولو أردت ذلك لحصلت حقيقة المخبر عنه أولًا، ثم أسندت إليه الخبر. وإنما مقصودك الإخبار عن الدار بأنها مشغولة بامرأة، وأنها اشثملت على امرأة فهذا القدر هو الذي حسن الإخبار عن النكرة ههنا فإنها ليست خبرًا في الحقيقة. وإنما هي في الحقيقة خبر عن المعرفة المتقدمة فهذا حقيقة الكلام، وأما تقديره الإعرابي النحوي فهو أن المجرور خبر مقدم، والنكرة مرفوعة بالابتداء.
فإن قلت: فمن أين امتنع تقديم هذا المبتدأ في اللفظ، فلا تقول: امرأة في الدار ودين على زيد؟
قلت: لأن النكرة تطلب الوصف طلبًا حثيثًا فيسبق الوهم إلى أن الجار والمجرور وصف لها لا خبر عنها إذ ليس من عادتها الإخبار عنها إلا بعد الوصف لها. فيبقى الذهن متطلعًا إلى ورود الخبر عليه وقد سبق إلى سمعه. ولكن لم يتيقن أنه الخبر بل يجوز أن يكون وصفًا فلا تحصل به الفائدة بل يبقى في ألم الانتظار للخبر والترقب له. فإذا قدمت الجار والمجرور عليها استحال أن يكون وصفًا لها، لأنه لا يتقدم موصوفه فذهب وهمه إلى أن الاسم المجرور المقدم هو الخبر والحديث عن النكرة وهو محط الفائدة.
إذا عرفت هذا. فمن التخصيصات المسوغة للابتداء بها، أن تكون موصوفة نحو: { ولعبد مؤمن خير من مشرك }، [181] أو عامة نحو "ما أحد خير من رسول الله"، وهل أحد عندك؟
ومن ذلك أن تقع في سياق التفضيل نحو قول عمر: تمرة خير من جرادة. فإن التفضيل نوع من التخصيص بالعموم. إذ ليس المراد واحدة غير معينة من هذا الجنس. بل المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة إيذانًا بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد فرد من أفراد الجنس، ومنه تأويل سيبويه في قوله تعالى: { طاعة وقول معروف }، [182] فإنه قدره طاعة أمثل وقول معروف أشبه وأجدر بكم وهذا أحسن من قول بعضهم: أن المسوغ للابتداء بها ههنا العطف عليها، لأن المعطوف عليها موصوف فيصح الابتداء به. وإنما كان قول سيبويه أحسن، لأن تقييد المعطوف بالصفة لا يقتضي تقييد المعطوف عليه بها. ولو قلت: طاعة أمثل، لساغ ذلك وإن لم يعطف عليها.
ومنه وقوع النكرة في سياق تفصيل بعد إجمال. كما إذا قلت: أقسم هذه الثياب بين هؤلاء فثوب لزيد وثوب لعمرو وثوب لبكر. فإن النكرة ههنا تخصصت وتعينت وزال إبهامها وشياعها في جنس الثياب. بل تخصصت بتلك الثياب المعية فكأنك قلت: ثوب منها لزيد وثوب منها لعمرو وهذا تقييد وتخصيص.
ومنه الابتداء بالنكرة إذا لم يكن الكلام خبرًا محضًا بل فيه معنى التزكية والمدح فمن ذلك قولهم أمت في الحجر لافيك، لأنهم لم يقولوا: أمت في الحجر وسكتوا حتى قرنوه بقولهم لا فيك. فصار معنى الكلام نسبة الأمت إلى الحجر أقرب من نسبته إليك، والأمت بالحجر أليق به منك، لأنهم أرادوا تزكية المخاطب ونفي العيب عنه ولم يريدوا الإخبار عن أمت بأنه في الحجر. بل هو في حكم النفي عن الحجر وعن المخاطب معًا إلا أن نفيه عن المخاطب أوكد، وإذا دخل الحديث معنى النفي فلا غروان يبتدأ بالنكرة لما فيه من العموم والفائدة.
ومن هذا قولهم: "شر أهر ذا ناب" وفيه تقديران. أحدهما أنه على الوصف أي شر عظيم، أو شر مخوف أهره. والثاني: أنه في معنى كلام آخر وهو ما أهر ذا ناب الأشر، أو إنما أهره شر، ولا ريب في صحة المسألة على وجه الفاعلية. فهكذا إذا كانت على وجه المبتدأ والخبر الذي في معناه.
ومنه قولهم "شرٌّ ما جاء به"، لأن معنى الكلام ما جاء به الأشر فأدت ما الزائدة هنا معنى شيئين النفي والإيجاب، كما أدته في قولك إنما جاء به شر وفي قوله تعالى: { فقليلًا ما يؤمنون } [183] أي ما يؤمنون إلا قليلًا وقليلًا ما يذكرون. وقوله: { فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم }، [184] أي ما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم ونحو فبما رحمة من الله لنت لهم أي ما لنت لهم إلا برحمة من الله، ولا تسمع قول من يقول من النحاة: إن ما زائدة في هذه المواضع فإنه صادر عن عدم تأمل.
فإن قيل: فمن أين لكم أفادة؟ ما هذه المعنيين المذكورين من النفي؟ والإيجاب: وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح لم تفد إلا معنى واحدًا وهو النفي. فإذا لم يكن النفي صريحًا فيها كيف تفيد معنيين؟
قيل: نحن لم ندع أنها أفادت النفي والإيجاب بمجردها. ولكن حصل ذلك منها ومن القرائن المحتفة بها في الكلام.
أما قولهم شر ما جاء به، فلما انتظمت مع الاسم النكرة، والنكرة لا يبتدأ بها فلما قصد إلى تقديمها علم أن فائدة الخبر مخصوصة بها، وأكد ذلك التخصيص بما، فانتفى الأمر عن غير الاسم المبتدأ، ولم يكن إلا له حتى صار المخاطب يفهم من هذا ما يفهم من قوله ما جاء به الأشر، واستغنوا هنا بما هذه عن ما النافية وبالابتداء بالنكرة عن إلا.
وأما قولك: إنما زيد قائم فقد انتظمت بأن وامتزجت معها وصارتا كلمة واحدة، وأن تعطي الإيجاب الذي تعطيه إلا وما تعطي النفي. ولذلك جاز إنما يقوم أنا، ولا تكون أنا فاعلة إلا إذا فصلت من الفعل بالأ تقول ما يقوم إلا أنا، ولا تقول: يقوم أنا. فإذا قلت: إنما قام أنا صرت كأنك لفظت بما مع إلا. قال:
أدافع عن أعراض قومي وإنما ** يدافع عن أعراضهم أنا أو مثلي
فإذا عرفت أن زيادتها مع أن واتصالها بها اقتضى هذا النفي والإيجاب. فانقل هذا المعنى إلى اتصالها بحرف الجر من قوله: { فبما رحمة من الله } [185] و { فبما نقضهم ميثاقهم }. [186] وتأمل كيف تجد الفرق بين هذا التركيب وبين أن يقال: فبرحمة من الله، وفبنقضهم ميثاقهم. وأنك تفهم من تركيب الآية ما لنت لهم إلا برحمة من الله، وما لعناهم إلا بنقضهم ميثاقهم، وكذلك قوله: { فقليلًا ما يؤمنون دلت على النفي بلفظها وعلى الإيجاب بتقديم ما حقه التأخير من المعمول وارتباط ما به مع تقديم. كما قرر في قولهم شر ما جاء به، وقد بسطنا هذا في كتاب الفتح المكي، وبينا هناك أنه ليس في القرآن حرف زائد وتكلمنا على كل ما ذكر في ذلك، وبينا أن كل لفظة لها فائدة متجددة زائدة على أصل التركيب. ولا ينكر جريان القلم إلى هذه الغاية وإن لم يكن من غرضنا فإنها أهم من بعض ما نحن فيه وبصدده.
فلنرجع إلى المقصود. فنقول: الذي صحح الابتداء بالنكرة في سلام عليكم. إن المسلم لما كان داعيًا وكان الاسم المبتدأ النكرة هو المطلوب بالدعاء صار هو المقصود المهتم به، وينزل منزلة قولك أسأل الله سلامًا عليكم، وأطلب من الله سلامًا عليك. فالسلام نفس مطلوبك ومقصودك. ألا ترى أنك لو قلت: أسأل الله عليك سلامًا لم يجز وهذا في قوته ومعناه. فتأمله فإنه بديع جدًا.
فإن قلت: فإذا كان في قوته فهلا كان منصوبًا مثل سقيًا ورعيًا، لأنه في معنى سقاك الله سقيًا ورعاك رعيًا؟
قلت: سيأتي جواب هذا في جواب السؤال العاشر في الفرق بين سلام إبراهيم، وسلام ضيفه إن شاء الله. وأيضا فالذي حسن الابتداء بالنكرة ههنا. إنها في حكم الموصوفة، لأن المسلم إذا قال: سلام عليكم فإنما مراده سلام مني عليك كما قال تعالى: { اهبط بسلام منا }، [187] ألا ترى أن مقصود المسلم إعلام من سلم عليه بأن التحية والسلام منه نفسه لما في ذلك من حصول مقصود السلام من التحيات والتواد والتعاطف فقد عرفت جواب السؤالين لما ابتدىء بالنكرة، ولم قدمت على الخبر بخلاف الباب في مثل ذلك والله أعلم.
فصل: تقديم السلام في جانب المسلم
وأما السؤال السابع وهو أنه لم كان في جانب المسلم تقديم السلام، وفي جانب الراد تقديم المسلم عليه.
فالجواب عنه: أن في ذلك فوائد عديدة.
أحدها: الفرق بين الرد والابتداء. فإنه لو قال له في الرد: السلام عليكم أو سلام عليكم لم يعرف أهذا رد لسلامه عليه أم ابتداء تحية منه؟ فإذا قال: عليك السلام. عرف أنه قد رد عليه تحيته ومطلوب المسلم من المسلم عليه أن يرد عليه سلامه. ليس مقصوده أن يبدأه بسلام كما ابتدأه به. ولهذا السر والله أعلم نهى النبي ﷺ المسلم عليه بقوله: عليك السلام عن ذلك فقال: «لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى»، وسيأتي الكلام على هذا الحديث ومعناه في موضعه. أفلا ترى كيف نهاه النبي ﷺ عن ابتداء السلام بصيغة الرد التي لا تكون إلا بعد تقديم سلام وليس في قوله: «فإنها تحية الموتى»، ما يدل على أن المشروع في تحايا الموتى، كذلك كما سنذكره، وإذا كانوا قد اعتمدوا الفرق بين سلام المبتدىء وسلام الراد، خصوا المبتدأ بتقديم السلام، لأنه هو المقصود، وخصوا الراد بتقديم الجار والمجرور.
الفائدة الثانية: وهي أن سلام الراد يجري مجرى الجواب. ولهذا يكتفي فيه بالكلمة المفردة الدالة على أختها. فلو قال: وعليك، لكان متضمنًا للرد كما هو المشروع في الرد على أهل الكتاب مع أنا مأمورون أن نرد على من حيانا بتحية مثل تحيته. وهذا من باب العدل الواجب لكل أحد فدل على أن قول الراد، وعليك مماثل لقول المسلم سلام عليك. لكن اعتمد في حق المسلم إعادة اللفظ الأول بعينه تحقيقًا للماثلة، ودفعًا لتوهم المسلم عدم رده عليه لاحتمال أن يريد عليك شيء آخر.
وأما أهل الكتاب فلما كانوا يحرفون السلام ولا يعدلون فيه، وربما سلموا سلامًا صحيحًا غير محرف ويشتبه الأمر في ذلك على الراد ندب إلى اللفظ المفرد المتضمن لرده عليهم نظير ما قالوه. ولم تشرع له الجملة التامة، لأنها إما أن تتضمن من التحريف مثل ما قالوا، ولا يليق بالمسلم تحريف السلام الذي هو تحية أهل الإسلام. ولا سيما وهو ذكر الله كما تقدم لأجل تحريف الكافر له، وإما أن يرد سلامًا صحيحًا غير محرف مع كون المسلم محرفًا للسلام فلا يستحق الرد الصحيح. فكان العدول إلى المفرد وهو عليك هو مقتضى العدل والحكمة مع سلامته من تحريف ذكر الله. فتأمل هذه الفائدة البديعة. والمقصود أن الجواب يكفي فيه قولك وعليك وإنما كمل تكميلًا للعدل وقطعًا للتوهم.
الفائدة الثالثة: وهي أقوى مما تقدم أن المسلم لما تضمن سلامة الدعاء للمسلم عليه بوقوع السلامة عليه، وحلولها عليه. وكان الرد متضمنًا لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل ما دعا به. فإنه إذا قال: وعليك السلام كان معناه وعليك من ذلك مثل ما طلبت لي. كما إذا قال: غفر الله لك. فإنك تقول له: ولك يغفر ويكون هذا أحسن من قولك وغفر لك. وكذا إذا قال: رحمة الله عليك، تقول: وعليك وإذا قال: عفا الله عنك. تقول: وعنك، وكذلك نظائره لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعو له للداعي في ذلك الدعاء لا إلى إنشاء دعاء مثل ما دعا به فكأنه قال: ولك أيضا، وعنك أيضا. أي وأنت مشارك لي في ذلك مماثل لي فيه لا أنفرد به عنك، ولا اختص به دونك، ولا ريب أن هذا المعنى يستدعي تقديم المشارك المساوي فتأمله.
فصل: ابتداء السلام بالنكرة والجواب بالمعرفة
وأما السؤال الثامن: وهو ما الحكمة في ابتداء السلام بلفظ النكرة وجوابه بلفظ المعرفة، فيقول: سلام عليكم فيقول الراد: وعليك السلام؟
فهذا سؤال يتضمن لمسألتين. إحداهما هذه. والثانية اختصاص النكرة بابتداء المكاتبة والمعرفة بآخرها، والجواب عنها بذكر أصل نمهده ترجع إليه مواقع التعريف والتنكير في السلام. وهو أن السلام دعاء وطلب وهم في ألفاظ الدعاء والطلب. إنما يأتون بالنكرة إما مرفوعة على الابتداء، أو منصوبة على المصدر، فمن الأول ويل له. ومن الثاني خيبة له وجدعًا وعقرًا وتربًا وجندلًا هذا في الدعاء عليه. وفي الدعاء له سقيًا ورعيًا وكرامة ومسرة فجاء سلام عليكم بلفظ النكرة، كما جاء سائر ألفاظ الدعاء. وسر ذلك أن هذه الألفاظ جرت مجرى النطق بالفعل. ألا ترى أن سقيًا ورعيًا وخيبة جرى مجرى سقاك الله ورعاك وخيبه، وكذلك سلام عليك جار مجرى سلمك الله والفعل نكرة فأحبوا أن يجعلوا اللفظ الذي هو جار مجراه كالبدل منه نكرة مثله.
وأما تعريف السلام في جانب الراد فنذكر أيضا أصلًا يعرف به سره وحكمته، وهو أن الألف واللام إذا دخلت على اسم السلام تضمنت أربعة فوائد.
أحدها: الإشعار بذكر الله تعالى، لأن السلام المعرف من أسمائه كما تقدم تقريره.
الفائدة الثانية: إشعارها بطلب معنى السلامة منه للمسلم عليه، لأنك متى ذكرت اسمًا من أسمائه فقد تعرضت به، وتوسلت به إلى تحصيل المعنى الذي اشتق منه ذلك الاسم.
الفائدة الثالثة: إن الألف واللام يلحقها معنى العموم في مصحوبها والشمول فيه في بعض المواضع.
الفائدة الرابعة: أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين، كما تقول: ناولني الكتاب واسقني الماء وأعطني الثوب لما هو حاضر بين يديك. فإنك تستغني بها عن قولك هذا فهي مؤدية معنى الإشارة.
وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع فقول الراد وعليك السلام بالتعريف متضمن للدلالة على أن مقصوده من الرد مثل ما ابتدىء به وهو هو بعينه فكأنه قال: ذلك السلام الذي طلبته لي مردود عليك وواقع عليك فلو أتى بالرد منكرًا لم يكن فيه إشعار بذلك، لأن المعرف وأن تعدد ذكره واتحد لفظه فهو شيء واحد بخلاف المنكر. ومن فهم هذا فهم معنى قول النبي ﷺ: «لن يغلب عسر يسرين». فإنه أشار إلى قوله تعالى: { فإن مع العسر يسرًا * إن مع العسر يسرًا }، [188] فاليسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة، فهو يسران. فالعسر محفوف بيسربن يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين.
وفائدة ثانية وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة. مقام فضل. ومقام عدل. ومقام ظلم، فالفضل أن يرد عليه أحسن من تحيته، والعدل أن ترد عليه نظيرها، والظلم أن تبخسه حقه وتنقصه منها. فاختير للراد أكمل اللفظين وهو المعرف بالأداة التي تكون للاستغراق والعموم كثيرًا ليتمكن من الإتيان بمقام الفضل.
وفائدة ثالثة وهي أنه قد تقدم أن المناسب في حقه تقديم المسلم عليه على السلام فلو نكره وقال عليك سلام لصار بمنزلة قولك عليك دين وفي الدار رجل فخرجه فخرج الخبر المحض. وإذا صار خبرًا بطل معنى التحية، لأن معناها الدعاء والطلب. فليس بمسلم من قال: عليك سلام. إنما المسلم من قال: سلام عليك. فعرف سلام الراد باللام إشعارًا بالدعاء للمخاطب. وإنه راد عليه التحية طالب له السلامة من اسم السلام. والله أعلم.
فصل: السلام في المكاتبة
وأما السؤال التاسع: وهو ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة، واختتامها بالمعرفة، فابتداؤها بالنكرة كما تقدم في ابتداء السلام النطقي بها سواء. فإن المكاتبة قائمة مقام النطق.
وأما تعريفه في آخر المكاتبة ففيه ثلاث فوائد.
أحدها: أن السلام الأول قد وقع الأنس بينهما به وهو مؤذن بسلامه عليه خصوصًا فكأنه قال: سلام مني عليك كما تقدم. وهذا أيضا من فوائد تنكر السلام الابتدائي للإيذان بأنه سلام مخصوص من المسلم. فلما استقر ذلك. وعلم في صدر الكتاب كان الأحسن أن يسلم عليه سلامًا هو أعم من الأول لئلا يبقى تكرارًا محضًا. بل يأتي بلفظ يجمع سلامه وسلام غيره. فيكون قد جمع له بين السلامتين الخاص منه، والعام منه ومن غيره. ولهذه الفائدة استحسنوا أن يكون قول الكاتب: وفلان يقرئك السلام، وفلان في آخر المكاتبة بعد والسلام عليك لهذا الغرض.
الفائدة الثانية: أنه قد تقدم أن السلام المعرف اسم من أسماء الله، وقد افتتح الكاتب رسالته بذكر الله فناسب أن يختمها باسم من أسمائه وهو السلام ليكون اسمه تعالى في أول الكتاب وآخره. وهذه فائدة بديعة.
الفائدة الثالثة: بديعة جدًا وهي جواب السؤال التاسع بعد هذا، وهي أن دخول الواو العاطفة في قول الكاتب: والسلام عليكم ورحمة الله فيها وجهان:
أحدهما: قول ابن قتيبة إنها عطف على السلام المبدوء به فكأنه قال: والسلام المتقدم عليكم.
والقول الثاني: إنها لعطف فصول الكتاب بعضه على بعض. فهي عطف لجملة السلام على ما قبلها من الجمل، كما تدخل الواو في تضاعيف الفصول وهذا أحسن من قول ابن قتيبة لوجوه؛ منها أن الكلام بين السلامين قد طال فعطف آخره بعد طوله على أوله قبيح غير مفهوم من السياق. الثاني: إنه إذا حمله على ذلك كان السلام الثاني هو الأول بعينه. فلم يفد فائدة متجددة. وفي ذلك شح بسلام متجدد وإخلال بمقاصد المتكاتبين من تعداد الجمل والفضول واقتضاء كل جملة لفائدة غير الفائدة المتقدمة. حتى أن قارىء الكتاب كلما قرأ جملة منه لفائدة غير الفائدة المتقدمة تطلعت نوازع قلبه إلى استفادة ما بعدها. فإذا كررت له فائدة واحدة مرتين سئمتها نفسه فكان اللائق بهذا المقصود أن يجدد له سلامًا غير الأول يسره به كما سره بالأول وهو السلام العام الشامل.
ولما فرغ الكاتب من فصول كتابه، وختمها أتى بالواو العاطفة مع السلام المعرف فقال: والسلام عليكم. أي وبعد هذا كله السلام عليكم. وقد تقدم أن السلام إذا انبنى على اسم مجرور قبله وكان سلام رد لا ابتداء فإنه يكون معرفًا نحو وعليك السلام، ولما كان سلام المكاتب ههنا ليس بسلام رد قدم السلام على المجرور فقال: والسلام عليكم وأتى باللام لتفيد تجديد سلام آخر والله أعلم.
وهذه فصاحة غريبة وحكمة سلفية موروثة عن سلف الأمة وعن الصحابة في مكاتباتهم. وهكذا كانوا يكتبون إلى نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد فرغنا من جواب السؤال التاسع المتعلق بواو العطف.
فصل: نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة
وأما السؤال العاشر: وهو السر في نصب سلام ضيف إبراهيم الملائكة ورفع سلامه.
فالجواب: أنك قد عرفت قول النحاة فيه. أن سلام الملائكة تضمن جملة فعلية، لأن نصب السلام يدل على سلمنا عليك سلامًا، وسلام إبراهيم تضمن جمل إسمية، لأن رفعه يدل على أن المعنى سلام عليكم. والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقرر والفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فكان سلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه وكان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه ﷺ وهو مقام الفضل إذ حياهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما قالوه.
وعندي فيه جواب أحسن من هذا، وهو أنه لم يقصد حكاية سلام الملائكة. فنصب قوله سلامًا انتصاب مفعول القول المفرد كأنه قيل: قالوا قولًا سلامًا، وقالوا سدادًا وصوابًا ونحو ذلك. فإن القول إنما تحكي به الجمل. وأما المفرد فلا يكون محكيًا به. بل منصوب به انتصاب المفعول به ومن هذا قوله تعالى: { وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا }، [189] ليس المراد أنهم قالوا هذا اللفظ المفرد المنصوب، وإنما معناه قالوا: قولًا سلامًا مثل سدادًا وصوابًا، وسمي القول سلامًا، لأنه يؤدي معنى السلام ويتضمنه من رفع الوحشة وحصول الاستئناس.
وحكي عن إبراهيم لفظ سلامه فأتى به على لفظه مرفوعًا بالابتداء محكيًا بالقول. ولولا قصد الحكاية لقال سلامًا بالنصب، لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلى الحكاية ليس إلا. فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سلام إبراهيم، ورفعه ونصب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدًا. وهو أن قوله: سلام عليكم من دين الإسلام المتلقي عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء وأنه من ملة إبراهيم التي أمر الله بها وباتباعها. فحكى لنا قوله ليحصل الاقتداء به والاتباع له، ولم يحك قول أضيافه، وإنما أخبر به على الجملة دون التفصيل. والله أعلم فزن هذا الجواب والذي قبله بميزان غير جائر يظهر لك أقواهما وبالله التوفيق.
فصل: نصب السلام ورفعه
وأما السؤال الحادي عشر: وهو نصب السلام من قوله تعالى: { وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا } ورفعه في قوله حكاية عن مؤمني أهل الكتاب { سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين }.
فالجواب عنه أن الله سبحانه مدح عباده الذين ذكرهم في هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم فقال: { وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا }، [190] فسلامًا هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسه. أي قالوا: قولًا سلامًا أي سدادًا وصوابًا وسليمًا من الفحش والخنا ليس مثل قول الجاهلين الذين يخاطبونهم بالجهل، فلو رفع السلام هنا لم يكن فيه المدح المذكور. بل كان يتضمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون سلموا عليهم، وليس هذا معنى الآية ولا مدح فيه، وإنما المدح في الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون الجهل بجهل مثله بل يقابلونه بالقول السلام فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن التي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم وتفسير السلف. وألفاظهم صريحة بهذا المعنى.
وتأمل كيف جمعت الآية وصفهم في حركتي الأرجل والألسن بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرها، فقال: الذين يمشون على الأرض هونًا أي بسكينة ووقار. والهون بفتح الهاء من الشيء الهين وهو مصدر هان هونًا. أي سهل. ومنه قولهم: يمشي على هينته ولا أحسبها إلا مولدة. ومع هذا فهي قياس اللفظة فإنها على بناء الحالة والهيئة فهي فعلة من الهون وأصلها هونة فقلبت واوها ياء لانكسار ما قبلها، فاللفظة صحيحة المادة والتصريف.
وأما الهون بالضم فهو الهوان فأعطوا حركة الضم القوية للمعنى الشديد وهو الهوان، وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنى السهل وهو الهون. فوصف مشيهم بأنه مشي حلم ووقار وسكينة لامشي جهل وعنف وتبختر. ووصف نطقهم بأن سلام فهو نطق حلم وسكينة ووقار لا نطق جهل وفحش وخناء وغلظة. فلهذا جمع بين المشي والنطق في الآية. فلا يليق بهذا المعنى الشريف العظيم الخطير أن يكون المراد منه سلام عليكم. فتأمله.
وأما قوله تعالى: { وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين }، [191] فإنها وصف لطائفة من مؤمني أهل الكتاب قدموا على رسول الله ﷺ مكة فآمنوا به فعيرهم المشركون. وقالوا: قبحتم من وفد بعثكم قومكم لتعلموا خبر الرجل ففارقتم دينكم وتبعتموه ورغبتم عن دين قومكم. فأخبر عنهم بأنهم خاطبوهم خطاب متاركة وإعراض وهجر جميل. فقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. سلام عليكم. لا نبتغي الجاهلين. وكان رفع السلام متعينًا، لأنه حكاية ما قد وقع ونصب السلام في آية الفرقان متعينًا، لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل. والأولى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهل. فتأمل هذه الأسرار التي أدناها يساوي رحلة، والله المحمود وحده على ما منَّ به وأنعم.
وهي المواهب من رب العباد فما ** يقال لولا ولا هلّا ولا فَلِما
فصل: تسليم الله أنبيائه ورسله
وأما السؤال الثاني عشر: وهو ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله، والسلام هو طلب ودعاء فكيف يتصور من الله؟
فهذا سؤال له شأن ينبغي الاعتناء به، ولا يهمل أمره وقل من يدرك سره إلا من رزقه الله فهمًا خاصًا وعناية، وليس هذا من شأن أبناء الزمان الذين غاية فاضلهم نقلًا أن يحكي قيلًا وقالًا. وغاية فاضلهم بحثًا أن يبدي احتمالًا، ويبرز أشكالًا، وأما تحقيق العلم كما ينبغي.
فللحروب أناس قائمون بها ** وللدواوين كتاب وحساب
وقد كان الأولى بنا الإمساك وكف عنان القلم. وأن نجري معهم في ميدانهم ونخاطبهم بما يألفونه. وأن لا نجلو عرائس المعاني على ضرير، ولا نزف خودها إلى عنين. ولكن هذه سلعة وبضاعة لها طلاب وعروس لها خطاب فستصير إلى أهلها، وتهدى إلى بعلها ولا تستطل الخطابة، فإنها نفثة مصدور.
فلنرجع إلى المقصود فنقول: لا ريب أن الطلب يتضمن أمورًا ثلاثة طالبًا ومطلوبًا ومطلوبًا منه، ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان الثلاثة وتغاير هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئًا من غيره. كما هو الطلب المعروف مثل من يأمر غيره وينهاه ويستفهمه. وأما إذا كان طالبًا من نفسه فهنا يكون الطالب هو المطلوب منه، ولم يكن هنا إلا ركنان طالب ومطلوب والمطلوب منه هو الطالب نفسه.
فإن قيل: كيف يعقل اتحاد الطالب والمطلوب منه وهما حقيقتان متغايرتان. فكما لا يتحد المطلوب والمطلوب منه ولا المطلوب والطالب. فكذلك لا يتحد الطالب والمطلوب منه، فكيف يعقل طلب الإنسان من نفسه؟
قيل: هذا هو الذي أوجب غموض المسألة وأشكالها، ولا بد من كشفه وبيانه، فنقول: الطلب من باب الإرادات والمريد كما يريد من غيره أن يفعل شيئًا، فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله والطلب النفسي وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها، والإرادة كالجنس له، فكما يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه، فكذلك يطلب من نفسه، وللفرق بين الطلب والإرادة وما قيل في ذلك مكان غير هذا. والمقصودان طلب الحي من نفسه أمر معقول يعلمه كل أحد من نفسه. وأيضا فمن المعلوم أن الإنسان يكون آمرًا لنفسه ناهيًا لنفسه قال تعالى: { إن النفس لأمارة بالسوء }، [192] وقال: { وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى }. [193] وقال الشاعر:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله ** عار عليك إذا فعلت عظيم
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها ** فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
وهذا أكثر من إيراد شواهده. فإذا كان معقولًا أن الإنسان يأمر نفسه وينهاها. والأمر والنهي طلب مع أن فوقه آمرًا وناهيًا، فكيف يستحيل ممن لا آمر فوقه ولا ناه أن يطلب من نفسه فعل ما يحبه وترك ما يبغضه.
وإذا عرف هذا عرف سر سلامه تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، وأنه طلب من نفسه لهم السلامة، فإن لم يتسع لهذا ذهنك فسأزيدك إيضاحًا وبيانًا وهو أنه قد أخبر سبحانه في كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا إيجاب منه على نفسه فهو الموجب وهو متعلق الإيجاب الذي أوجبه، فأوجب بنفسه على نفسه. وقد أكد النبي ﷺ هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاح ويكشف حقيقته بقوله في الحديث الصحيح: «لما قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي»، وفي لفظ: «سبقت غضبي». فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة وصفة اليد ومحل الكتابة. وأنه كتاب وذكر مستقر الكتاب، وأنه عنده فوق العرش. فهذا إيجاب مؤكد بأنواع من التأكيد وهو إيجاب منه على نفسه. ومنه قوله تعالى: { وكان حقًا علينا نصر المؤمنين } [194] فهذا حق أحقه على نفسه فهو طلب وإيجاب على نفسه بلفظ الحق ولفظ على.
ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لمعاذ: «أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت الله ورسوله أعلم، قال: «حقهم عليه أن لا يعذبهم بالنار»، ومنه قوله ﷺ في غير حديث: «من فعل كذا وكذا كان حقًا على الله أن يفعل به كذا وكذا»، في الوعد والوعيد، فهذا الحق هو الذي أحقه على نفسه. ومنه الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي ﷺ في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك. فهذا حق للسائلين عليه هو أحقه على نفسه لا أنهم هم أوجبوه ولا أحقوه. بل أحق على نفسه أن يجب من سأله كما أحق على نفسه في حديث معاذ أن لا يعذب من عبده. فحق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، والحقان هو الذي أحقهما وأوجبهما لا السائلون ولا العابدون، فإنه سبحانه:
ما للعباد عليه حق واجب ** كلا ولا سعى لديه ضائع
إن عذبوا فبعد له أو نعموا ** فبفضله وهو الكريم الواسع
ومنه قوله تعالى: وعدًا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن فهذا الوعد هو الحق الذي أحقه على نفسه وأوجبه. ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه ليفعلنه نحو: { فوربك لنسألنهم أجمعين }، [195] وقوله: { فوربك لنحشرنهم والشياطين }، [196] وقوله: { لنهلكن الظالمين }، [197] وقوله: { فالحق والحق أقول * لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين }، [198] وقوله: { فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار }، [199] وقوله: { فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين }، [200] إلى أمثال ذلك مما أخبر أنه يفعله أخبارًا مؤكدًا بالقسم. والقسم في مثل هذا يقتضي الحض والمنع بخلاف القسم على ما فعله تعالى مثل قوله: { يس * والقرآن الحكيم * إنك لمن المرسلين }، [201] والقسم على ثبوت ما ينكره المكذبون، فإنه توكيد للخبر وهو من باب القسم المتضمن للتصديق. ولهذا تقول الفقهاء اليمين ما اقتضى حقًا، أو منعًا، أو تصديقًا، أو تكذيبًا. فالقسم الذي يقتضي الحض والمنع هو من باب الطلب، لأن الحض والمنع طلب ومن هذا ما أخبر به أنه لا بد أن يفعله لسبق كلماته به كقوله: { ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون }، [202] وقوله: { وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين }، [203] وقوله: { ولولا كلمة سبقت من ربك }، [204] فهذا إخبار عما يفعله ويتركه أنه لسبق كلمته به فلا يتغير.
ومن هذا تحريمه سبحانه ما حرمه على نفسه كقوله فيما يرويه عنه رسوله: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا». فهذا التحريم نظير ذلك الإيجاب ولا يلتفت إلى ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلة، فإن الناظر في سياق هذه المواضع. ومقصودها به يجزم ببعد المراد منها كقول بعضهم: إن معنى الإيجاب والكتابة في ذلك كله هو إخباره به، ومعنى كتب ربكم على نفسه الرحمة أخبر بها عن نفسه وقوله: حرمت الظلم على نفسي أي أخبرت أنه لا يكون ونحو ذلك مما يتيقن المرء أنه ليس هو المراد بالتحريم، بل الإخبار ههنا هو الإخبار بتحريمه وإيجابه على نفسه. فمتعلق الخبر هو التحريم والإيجاب، ولا يجوز إلغاء متعلق الخبر فإنه يتضمن إبطال الخبر ولهذا إذا قال القائل: أوجبت على نفسي صومًا فإن متعلقه وجوب الصوم على نفسه، فإذا قيل: إن معناه أخبرت بأني أصوم كان ذلك إلغاء وإبطالًا لمقصود الخبر فتأمله.
وإذا كان معقولًا من الإنسان أنه يوجب على نفسه ويحرم ويأمرها وينهاها مع كونه تحت أمر غيره ونهيه، فالآمر الذي ليس فوقه آمر ولا ناه كيف يمتنع في حقه أن يحرم على نفسه ويكتب على نفسه وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه ومحبته له ورضاه به، وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرمه وكراهته له وإرادة أن لا يفعله. فإن محبته للفعل تقتضي وقوعه منه وكراهته، لأن يفعله تمنع وقوعه منه وهذا غير ما يحبه سبحانه من أفعال عباده ويكرهه. فإن محبة ذلك منهم لا تستلزم وقوعه، وكراهته منهم لا تمنع وقوعه. ففرق بين فعله هو سبحانه وبين فعل عباده الذي يقع مع كراهته وبغضه له ويتخلف مع محبته له ورضاه به بخلاف فعله هو سبحانه، فهذا نوع وذاك نوع، فتدبر هذا الموضع الذي هو منزلة أقدام الأولين والآخرين إلا من عصم الله وهداه إلى صراط مستقيم. وتأمل أين تكون محبته وكراهته موجبة لوجود الفعل، ومانعة من وقوعه وأين تكون المحبة منه والكراهة لا توجب وجود الفعل، ولا تمنع وقوعه.
ونكتة المسألة هو الفرق بين ما يريد أن يفعله هو سبحانه وما لا يريد أن يفعله، وبين ما يحبه من عبده أن يفعله العبد، أو لا يفعله ومن حقق هذا المقام زالت عنه شبهات ارتبكت فيها طوائف من النظار والمتكلمين والله الهادي إلى سواء السبيل.
واعلم أن الناس في هذا المقام ثلاث طوائف.
فطائفة منعت أن يجب عليه شيء، أو يحرم عليه شيء بإيجابه وتحريمه. وهم كثير من مثبتي القدر الذين ردوا أقوال القدرية النفاة وقابلوهم أعظم مقابلة، نفوا لأجلها الحكم والأسباب والتعليل وأن يكون العبد فاعلًا أو مختارًا.
الطائفة الثانية بإزاء هؤلاء، أوجبوا على الرب وحرموا أشياء بعقولهم جعلوها شريعة له يجب عليه مراعاتها من غير أن يوجبها هو على نفسه ولا حرمها، وأوجبوا عليه من جنس ما يجب على العباد، وحرموا عليه من جنس ما يحرم عليهم، ولذلك كانوا مشبهة في الأفعال والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين تعطيل صفاته وجحد نعوت كماله والتشبيه له بخلقه فيما أوجبوه عليه، وحرموه فشبهوا في أفعاله وعطلوا في صفات كماله فجحدوا بعض ما وصف به نفسه من صفات الكمال، وسموه توحيدًا وشبهوه بخلقه فيما يحسن منهم ويقبح من الأفعال، وسموا ذلك عدلًا، وقالوا: نحن هل العدل والتوحيد فعدلهم إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شتى من الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالها وتوحيدهم إلحادهم في أسمائه الحسنى، وتحريف معانيها عما هي عليه. فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلًا وعدلهم شركًا وهذا مقرر في موضعه.
والمقصود أن هذه الطائفة مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، وهدى الله الأمة الوسط لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فلم يقيسوه بخلقه، ولم يشبهوه بهم في شيء من صفاته ولا أفعاله، ولم ينفوا ما أثبته لنفسه من ذلك، ولم يوجبوا عليه شيئًا، ولم يحرموا عليه شيئًا، بل أخبروا عنه بما أخبر عن نفسه وشهدت قلوبهم ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم والغايات المحمودة التي يستحق عليها كمال الحمد والثناء، فإن العباد لا يحصون ثناء عليه أبدا بل هو كما أثنى على نفسه. وهذا بين بحمد الله عند أهل العلم والإيمان مستقر في فطرهم ثابت في قلوبهم يشهدون انحراف المنحرفين في الطرفين وهم لا إلى هؤلاء، ولا إلى هؤلاء. بل هم إلى الله ورسوله متحيزون، وإلى محض سنته منتسبون يدينون دين الحق أنى توجهت ركائبه، ويستقرون معه حيث استقرت مضاربه لا تستفزهم بداوات آراء المختلفين، ولا تزلزلهم شبهات المبطلين. فهم الحكام على أرباب المقالات والمميزون لما فيها من الحق والشبهات، يردون على كل باطله ويوافقونه فيما معه في الحق، فهم في الحق سلمه وفي الباطل حربه. لا يميلون مع طائفة على طائفة، ولا يجحدون حقها لما قالته من باطل سواه. بل هم ممتثلون قول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون }. [205]
فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائه أن لا يعدلوا عليهم مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله، فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطىء على أن لا يعدلوا عليهم. بل يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله، وما جاء به منه علمًا وعملًا. ودعوة إلى الله على بصيرة، وصبرًا من قومهم على الأذى في الله، وإقامة لحجة الله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل لا كمن نصب معالمه صادرة عن آراء الرجال، فدعا إليها وعاقب عليها وعادى من خالفها بالعصبية وحمية لجاهلية، والله المستعان وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا به. وليكن هذا تمام الكلام في هذا السؤال. فقد تعدينا به طوره وإن لم نقدره قدره.
فصل: التسليم بلفظ النكرة أو المعرفة
وأما السؤال الثالث عشر: وهو ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ النكرة وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة. وكذلك تسليمهم على نفوسهم وعلى عباده الصالحين؟
فقد تقدم بيان الحكمة في كون السلام ابتداء بلفظ النكرة، ونزيد هنا فائدة أخرى وهي أنه قد تقدم أن في دخول اللام في السلام أربعة فوائد وهذا المقام مستغن عنها، لأن المتكلم بالسلام هو الله تعالى. فلم يقصد تبركًا بذكر الاسم كما يقصده العبد فإن التبرك استدعاء البركه واستجلابها. والعبد هو الذي يقصد ذلك، ولا قصد أيضا تعرضًا وطلبًا على ما يقصده العبد، ولا قصد العموم. وهو أيضا غير لائق هنا، لأن سلامًا منه سبحانه كاف من كل سلام، ومغن عن كل تحية ومقرب من كل أمنية. فأدنى سلام منه ولا أدنى هناك يستغرق الوصف ويتم النعمة ويدفع البؤس ويطيبب الحياة ويقطع مواد العطب والهلاك، فلم يكن لذكر الألف واللام هناك معنى. وتأمل قوله تعالى: { وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر }، [206] كيف جاء بالرضوان مبتدأ منكرًا مخبرًا عنه بأنه أكبر من كل وعدوا به. فأيسر شيء من رضوانه أكبر الجنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته، ولهذا لما يتجلى لأوليائه في جنات عدن ويمنيهم أي شيء يريدون. فيقولون: ربنا وأي شيء نريد أفضل مما أعطيتنا. فيقول تبارك وتعالى: إن لكم عندي أفضل من ذلك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدًا.
وقد بان بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده وبين سلام العباد عليهم. فإن سلام العباد لما كان متضمنًا لفوائد الألف واللام التي تقدمت من قصد التبرك باسمه السلام والإشارة إلى طلب السلام له وسؤالها من الله باسم السلام، وقصد عموم السلام كان الأحسن في حق المسلم على الرسول. أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإن كان قد ورد سلام عليك، فالمعرفة أكثر وأصح وأتم معنى. فلا ينبغي العدول عنه ويشح في هذا المقام بالألف واللام والله أعلم.
فصل: التسليم على يحيى والمسيح
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الرابع عشر: وهو ما الحكمة في تسليم الله تعالى على يحيى بلفظ النكرة، وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة لا ما يقوله من لا تحصيل له إن سلام يحيى جرى مجرى ابتداء السلام في الرسالة والمكاتبة فنكر، وسلام المسيح جرى مجرى السلام في آخر المكاتبة فعرف. فإن السورة كالقصة الواحدة. ولا يخفى فساد هذا الفرق فإنهما سلامان متغايران من مسلمين. أحدهما سلام الله تعالى على عباده. والثاني سلام العبد على نفسه. فكيف يبنى أحدهما على الآخر؟ وكذلك قول من قال: إن الثاني عرف لتقدم ذكره في اللفظ فكانت الألف واللام فيه للعهد وهذا أقرب من الأول لإمكان أن يكون المسيح أشار إلى السلام الذي سلمه الله على يحيى، فأراد أن لي من السلام في مثل هذه المواطن الثلاثة مثل ما حصل له. والله أعلم.
فصل: تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح
وأما السؤال الخامس عشر: وهو ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلاثة؟
فسره والله أعلم أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب ومواطن الوحشة. وكلما كان الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامة، وتعلقت بها الهمة، فذكرت هذه المواطن الثلاثة، لأن السلامة فيها آكد وطلبها أهم والنفس عليها أحرص، لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها موطن النفس على صحبتها وسكناها إلى دار هو فيها معرض للآفات والمحن والبلاء. فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار انتصب لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأفكارها كما أفصح الشاعر بهذا المعنى حيث يقول:
تأمل بكاء الطفل عند خروجه ** إلى هذه الدنيا إذا هو يولد
تجد تحته سرًا عجيبًا كأنه ** بكل الذي يلقاه منها مهدد
وإلا فما يبكيه منها وإنها ** لأوسع مما كان فيه وأرغد
ولهذا من حين خرج ابتدرته طعنه الشيطان في خاصرته فبكى لذلك، ولما حصل له من الوحشة بفراق وطنه الأول، وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون، وأما ما أخبر به الرسول، فليس في صناعتهم ما يدل عليه، كما ليس فيها ما ينفيه. فكان طلب السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور.
الموطن الثاني: خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت، ونسبة الدنيا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريبًا وتمثيلًا وإلا فالأمر أعظم من ذلك، وأكبر، وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور.
الموطن الثالث: موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياء ولا نسبة لما قبله من الدار إليه وطلب السلامة فيه آكد من جميع ما قبله. فإن عطبه لا يستدرك وعثرته لا تقال، وسقمه لا يداوى. وفقره لا يسد. فتأمل كيف خص هذه المواطن بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيها وأعرف قدر القرآن وما تضمنه من الأسرار وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارها، وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس وذهاب الوحشة، ثم نزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم الابتلاء، وعند معاينته هول المطلع. إذا قدم على الله وحيدًا مجردًا عن كل مؤنس إلا ما قدمه من صالح عمل وعند موافاته القيامة مع الجمع إلا أعظم ليصير إلى إحدى الدارين التي خلق لها، واستعمل بعمل أهلها، فأي موطن أحق بطلب السلامه من هذه المواطن. فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه.
فصل: تسليم نبينا وتسليم موسى
وأما السؤال السادس عشر: وهو ما الحكمة في تسليم النبي ﷺ على من اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة وتسليم موسى عليهم بلفظ المعرفة؟
فالجواب عنه أن تسليم النبي ﷺ تسليم ابتدائي. ولهذا صدر به الكتاب حيث قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى ففي تنكيره ما في تنكير سلام من الحكمة، وقد تقدم بيانها. وأما قول موسى: السلام على من اتبع الهدى، فليس بسلام تحية فإنه لم يبتدىء به فرعون بل هو خبر محض. فإن من اتبع الهدى له السلام المطلق دون من خالفه فإنه قال له: { فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى * إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى }. [207]
أفلا ترى أن هذا ليس بتحية في ابتداء الكلام ولا خاتمته. وإنما وقع متوسطًا بين الكلامين إخبار محضًا عن وقوع السلامة، وحلولها على من اتبع الهدى. ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جبلت النفوس على حبه. وإيثاره من السلامة. وإنه إن اتبع الهدى الذي جاءه به، فهو من أهل السلام والله أعلم.
وتأمل حسن سياق هذه الجمل، وترتيب هذا الخطاب، ولطف هذا القول اللين الذي سلب القلوب حسنه وحلاوته مع جلالته وعظمته. كيف ابتدأ الخطاب بقول: أنا رسولا ربك وفي ضمن ذلك إنا لم نأتك لننازعك ملكك ولا لنشركك فيه. بل نحن عبدان مأموران مرسلان من ربك إليك. وفي إضافة اسم الرب إليه هنا دون إضافته إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبوله. كما يقول الرسول للرجل من عند مولاه: أنا رسول مولاك إليك واستاذك وإن كان أستاذهما معا، ولكن ينبهه بإضافته إليه على السمع والطاعة له، ثم إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل ويخلي بينهم وبينهما، ولا يعذبهم ومن طلب من غيره ترك العدوان والظلم، وتعذيب من لا يستحق العذاب فلم يطلب منه شططًا ولم يرهقه من أمره عسرًا. بل طلب منه غاية النصف.
ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات أحدها قوله تعالى: { قد جئناك بآية من ربك }، [208] فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى التقول والافتراء بما جئناك به من البرهان والدلالة الواضحة. فقد قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرسل إليه حالتان إما أن يسمع ويطيع فيكون من أهل الهدى والسلام على من اتبع الهدى، وإما أن يكذب ويتولي، فالعذاب على من كذب وتولى فجمعت الآية طلب الإنصاف وإقامة الحجة، وبيان ما يستحقه السامع المطيع. وما يستحقه المكذب المتولي بألطف خطاب وأليق قول وأبلغ ترغيب وترهيب.
فصل: قل الحمد لله وسلام على عباده
وأما السؤال السابع عشر: وهو أن قوله: { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى } هل السلام من الله فيكون المأمور به الحمد والوقف التام عليه، أو هو داخل في القول والأمر بهما جميعًا؟
فالجواب عنه أن الكلام يحتمل الامرين ويشهد لكل منهما هذا ضرب من الترجيح فيرجح كونه داخلًا في جملة القول بأمور:
منها اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل. وهذا يقتضي أن يكون فعل القول واقعًا على كل واحد منهما هذا هو الأصل ما لم يمنع منه مانع، ولهذا إذا قلت: الحمد الله وسبحان الله، فإن التسبيح هنا داخل في المقول.
ومنها أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبر على خبر وهو الأصل. ولو كان منقطفًا عنه كان عطفًا على جملة الطلب، وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب.
ومنها أن قوله: { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى }، [209] ظاهر في أن المسلم هو القائل الحمد لله ولهذا أتى بالضمير بلفظ الغيبة، ولم يقل سلام على عبادي.
ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور. أحدها: مطابقته لنظائره في القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفى كقوله: { سلام على نوح في العالمين }، [210] { سلام على إبراهيم }، [211] { سلام على موسى وهارون }، [212] { سلام على إل ياسين }. [213]
ومنها أن عباده الذين اصطفى هم المرسلون والله سبحانه يقرن بين تسبيحه لنفسه. وسلامه عليهم، وبين حمده لنفسه، وسلامه عليهم. أما الأول فقال تعالى: { سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين }، [214] وقد ذكر تنزيهه لنفسه عما لا يليق بجلاله، ثم سلامه على رسله.
وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار القرآن يتضمن الرد على كل مبطل ومبتدع فإنه نزه نفسه تنزيهًا مطلقًا، كما نزه نفسه عما يقول خلقه فيه، ثم سلم المرسلين. وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقول المكذبون لهم المخالفون لهم. وإذا سلموا من كل ما رماهم به أعداؤهم لزم سلامة كل ما جاؤوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاؤوا به التوحيد ومعرفة الله ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال والفساد فهو الحق المحض. وما خالفه هو الباطل والكذب المحال. وهذا المعنى بعينه في قوله: { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى } فإنه يتضمن حمده بما من نعوت الكمال وأوصاف الجلال والأفعال الحميدة، والأسماء الحسنى، وسلامة رسله من كل عيب ونقص وكذب. وذلك يتضمن سلامة ما جاؤوا به كل باطل. فتأمل هذا السر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيحه. فهذا يشهد لكون السلام هنا من الله تعالى. كما هو في آخر الصافات.
وأما عطف الخبر على الطلب فما أكثره فمنه قوله تعالى: { قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان }، [215] وقوله: { وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين }، [216] وقوله: { ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين }، [217] ونظائره كثيرة جدًا.
وفصل الخطاب في ذلك أن يقال الآية تتضمن الأمرين جميعًا وتنتظمهما انتظامًا واحدًا. فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامه وليس فيه إلا البلاغ. والكلام كلام الرب تبارك وتعالى فهو الذي حمد نفسه وسلم على عباده. وأمر رسوله بتبليغ ذلك، فإذا قال الرسول: الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حمد الله وسلم على عباده بما حمد به نفسه، وسلم به هو على عباده. فهو سلام من الله ابتداء ومن المبلغ بلاغًا، ومن العباد اقتداء وطاعة. فنحن نقول كما أمرنا ربنا تعالى: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ونظير هذا قوله تعالى: { قل هو الله أحد }، فهو توحيد منه لنفسه وأمر للمخاطب بتوحيده. فإذا قال العبد: قل هو الله أحد كان قد وحد الله بما وحد به نفسه وأتى بلفظة قل تحقيقًا لهذا المعنى. وأنه مبلغ محض قائل لما أمر بقوله والله أعلم.
وهذا بخلاف قوله: { قل أعوذ برب الناس } فإن هذا أمر محض ط بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله أعوذ برب الناس، فإن الله لا يستعيذ من أحد، وذلك عليه محال بخلاف قوله: { قل هو الله أحد } فإنه خبر عن توحيده وهو سبحانه يخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحد، فتأمل هذه النكتة البديعة والله المستعان.
فصل: عليك السلام تحية الموتى
وأما السؤال الثامن عشر: وهو نهي النبي ﷺ من قال له عليك السلام عن ذلك وقال: لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، فما أكثر من ذهب عن الصواب في معناه وخفي عليه مقصوده وسره. فتعسف ضروبًا من التأويلات المستنكرة الباردة ورد بعضهم الحديث وقال: وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال في تحية الموتى: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»، قالوا: وهذا أصح من حديث النهي. وقد تضمن تقديم ذكر لفظ السلام فوجب المصير إليه، وتوهمت طائفة. أن السنة في سلام الموتى أن يقال: عليكم السلام. فرقًا بين السلام على الأحياء والأموات.
وهؤلاء كلهم إنما أتوا ما أتوه من عدم فهمهم لمقصود الحديث. فإن قوله ﷺ: «عليك السلام تحية الموت»، ليس تشريعًا منه وإخبارًا عن أمر شرعي، وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة الشعراء والناس. فإنهم كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء كما قال قائلهم:
عليك سلام الله قيس بن عاصم ** ورحمته ما شاء أن يترحما
وقول الذي رثى عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
عليك سلام من أمير وباركت ** يدُ الله في ذاك الأديم الممزق
وهذا أكثر في أشعارهم من أن نذكره ههنا. والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه فضلًا عن كونه سنة، بل نهيه عنه مع إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته، وأن السنة في السلام تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه في السلام على الأحياء وعلى الأموات. فكما لا يقال في السلام على الأحياء عليكم السلام، فكذلك لا يقال في سلام الأموات كما دلت السنة الصحيحة على الأمرين، وكأن الذي تخيله القوم من الفرق. أن المسلم على غيره لما كان يتوقع الجواب. وأن يقال له: وعليك السلام بدأوا باسم السلام على المدعو له توقعًا لقوله وعليك السلام. وأما الميت فما لم يتوقعوا منه ذلك قدموا المدعو له على الدعاء، فقالوا عليك السلام.
وهذا الفرق لو صح كان دليلًا على التسوية بين الأحياء والأموات في السلام. فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع الجواب أيضا. قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام»، وبالجملة فهذا الخيال قد أبطلته السنة الصحيحة.
وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها وهي أن السلام شرع على الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلم عليهم، لأنه دعاء بخير، والأحسن في دعاء الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعو له كقوله تعالى: { رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت }، [218] وقوله: { سلام على إبراهيم }، [219] { سلام على نوح }، [220] { سلام على إل ياسين }، [221] { سلام عليكم بما صبرتم }. [222]
وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه على المدعو به غالبًا كقوله تعالى لإبليس: { وإن عليك لعنتي }، [223] وقوله: { وإن عليك اللعنة }، [224] وقوله: { عليهم دائرة السوء }، [225] وقوله: { وعليهم غضب }.
وسر ذلك والله أعلم أن في الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذي تشتهيه النفوس، وتطلبه ويلذ للسمع لفظه فيبدأ السمع بذكر الاسم المحبوب المطلوب، ويبدأ القلب بتصوره فيفتح له القلب والسمع. فيبقى السامع كالمنتظر لمن يحصل هذا وعلى من يحل، فيأتي باسمه فيقول: عليك أو لك. فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحل الذي هو المقصود بالسلام.
وأما في الدعاء عليه ففي تقديم المدعو عليه إيذان باختصاصه بذلك الدعاء وأنه عليه وحده كأنه قيل له: هذا عليك وحدك لا يشركك فيه السامعون بخلاف الدعاء بالخير. فإن المطلوب عمومه وكل ما عم به الداعي كان أفضل.
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فضل عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء في الأرض. وذكر في ذلك حديثا مرفوعا عن علي أن النبي ﷺ مر به وهو يدعو فقال: "يا علي فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض". [226]
وفيه فائدة ثانية أيضا، وهي أنه في الدعاء عليه. إذا قال له: عليك انفتح سمعه وتشوف قلبه إلى أي شيء يكون عليه. فإذا ذكر له اسم المدعو به صادف قلبه فارغًا متشوفًا لمعرفته. فكان أبلغ في نكايته. ومن فهم هذا فهم السر في حذف الواو في قوله تعالى: { وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها }، [227] ففاجأهم وبغتهم عذابها وما أعد الله فيها فهم بمنزلة من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من أنواع الشر إلا أنه متوقع منه شرًا عظيمًا ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه. وهذا كما تجد في الدنيا من يساق إلى السجن فإنه يساق إليه وبابه مغلق. حتى إذا جاءه فتح الباب في وجهه. ففاجأته روعته وألمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه.
وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا مساقين إلى دار الكرامة وكان من تمام إكرام المدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجيء فيلقاه مفتوحًا، فلا يلحق ألم الانتظار فقال في أهل الجنة: { حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها }، [228] وحذف الجواب تفخيمًا لأمره وتعظيمًا لشأنه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو، ومن دعوى كونها واو الثمانية. لأن أبواب الجنة ثمانية. فإن هذا لو صح فإنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة في اللفظ واحدًا بعد واحد فينتهون إلى السبعة، ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو وهنا لا ذكر للفظ الثمانية في الآية، ولا عدها فتأمله. على أن في كون الواو تجيء للثمانية كلام آخر قد ذكرناه في الفتح المكي وبينا المواضع التي ادعى فيها. أن الواو للثمانية وأين يمكن دعوى ذلك وأين يستحيل؟
فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن سيد الخلائق ﷺ يأتي باب الجنة فيلقاه مغلقًا حتى يستفتحه.
قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق أن الجنة تكون مغلقة. فلا تفتح لأهلها إلا على يديه فلو جاءها وصادفها مفتوحة فدخلها هو وأهلها لم يعلم الداخلون أن فتحها كان على يديه وأنه هو الذي استفتحها لهم. ألا ترى أن الخلق إذا راموا دخول باب مدينة، أو حصن وعجزوا، ولم يمكنهم فتحه حتى جاء رجل ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه كان في ذلك من ظهور سيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم فوجدوه مفتوحًا.
وقد خرجنا عن المقصود وما أبعدنا، ولا تستطل هذه النكت، فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق والله المان بفضله وكرمه.
فصل: إذا سلم أهل الكتاب فقولوا وعليكم
وأما السؤال التاسع عشر: وهو دخول الواو في قوله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم»، فقد استشكلها كثير من الناس كما ذكر في السؤال. وقالوا: الصواب حذفها. وأن يقال: عليكم. قال الخطابي: يرويه عامة المحدثين بالواو وابن عيينة: يرويه بحذفها وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوا بعينه مردودًا عليهم وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه، لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين.
قلت: معنى ما أشار إليه الخطابي: إن الواو في مثل هذا تقتضي تقرير الجملة وزيادة الثانية عليها، كما إذا قلت: زيد كاتب. فقال المخاطب وشاعر: فإنه يقتضي إثبات الكتابة له وزيادة وصف الشعر، وكذلك إذا قلت لرجل: فلان محب لك، فقال: ومحسن إلي.
ومن هنا استنبط السهيلي في الروض أن عدة أصحاب الكهف سبعة. قال: لأن الله تعالى عطف عليهم الكلب بحرف الواو فقال: وثامنهم كلبهم، ولم يذكر الواو فيما قبل ذلك من كلامهم. والواو تقتضي تقرير الجملة الأولى. وما استنبطه حسن غير أنه إنما يفيد إذا كان المعطوف بالواو ليس داخلًا في جملة قولهم. بل يكون قد حكى سبحانه أنهم قالوا: سبعة، ثم أخبر تعالى أن ثامنهم الكلب فحينئذ يكون ذلك تقريرًا لما قالوه وإخبارًا يكون الكلب ثامنًا، وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة قولهم، وأنهم قالوا: هذا وهذا لم يظهر ما قاله، ولا تقتضي الواو في ذلك تقريرًا ولا تصديقًا فتأمله.
وأما قوله: المتحدثون يروونه بالواو. فهذا الحديث رواه عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ قال: «إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم فقولوا وعليكم». قال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار وقال فيه: وعليكم. انتهى كلامه.
وأخرجه الترمذي والنسائي كذلك. ورواه مسلم وفي بعض طرقه فقل عليك. ولم يذكر الواو.
وحديث مالك الذي ذكره أبو داود وأخرجه البخاري في صحيحه، وحديث سفيان الثوري متفق عليه كلها بالواو.
وأما ما أشار إليه الخطابي من حديث ابن عيينة فرواه النسائي في سننه بإسقاط الواو.
وإذا عرف هذا فإدخال الواو في الحديث لا تقتضي محذورًا البتة، وذلك لأن التحية التي يحيون بها المسلمين غايتها الإخبار بوقوع الموت عليهم وطلبه، لأن السام معناه الموت، فإذا حيوا به المسلم فرده عليهم كان من باب القصاص والعدل وكان مضمون رده أنا لسنا نموت دونكم. بل وأنتم أيضا تموتون فما تمنيتموه لنا حالٌّ بكم واقع عليكم.
وأحسن من هذا أن يقال: ليس في دخول الواو تقرير لمضمون تحيتهم، بل فيه ردها وتقريرها لهم أي ونحن أيضا. ندعو عليكم بما دعوتم به علينا. فإن دعاءهم قد وقع. فإذا رد عليهم المجيب بقوله: وعليكم. كان في إدخال الواو سر لطيف وهو الدلالة على أن هذا الذي طلبتموه لنا، ودعوتم به هو بعينه مردود عليكم لا تحية غيره، فإدخال الواو مفيد لهذه الفائدة الجليلة.
وتأمل هذا في مقابلة الدعاء بالخير. إذا قال: غفر الله لك، فقال له: ولكن المعنى أن هذه الدعوة بعينها مني لك. ولو قلت: غفر الله لك، فقال: لك لم يكن فيه إشعار بأن الدعاء الثاني هو الأول بعينه فتأمله فإنه بديع جدًا. وعلى هذا فيكون الصواب إثبات الواو كما هو ثابت في الصحيح والسنن. فهذا ما ظهر لي في هذه اللفظة فمن وجد شيئًا فليلحقه بالهامش، فيشكر الله له وعباده سعيه. فإن المقصود الوصول إلى الصواب، فإذا ظهر وضع ما عداه تحت الأرجل. وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة بما أمكننا في كتاب تهذيب السنن.
فصل: اقتران الرحمة والبركة بالسلام
وأما السؤال العشرون: وهو ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام؟
فالجواب عنه أن يقال: لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء. أحدها: سلامته من الشر ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. والثاني: حصول الخير له. والثالث: دوامه وثباته له؛ فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعه بالحياة شرعت التحية متضمنة للثلاثة، فقوله: سلام عليكم يتضمن السلامة من الشر وقوله: ورحمة الله يتضمن حصول الخير. وقوله: وبركاته يتضمن دوامه وثباته كما هو موضوع لفظ البركة وهو كثرة الخير واستمراره. ومن هنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور الرحيم في عامة القرآن. ولما كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحد. بل هي متضمنة لكل مطالبه وكل المطالب دونها ووسائل إليها، وأسباب لتحصيلها جاء لفظ التحية دالًا عليها بالمطابقة تارة وهو كمالها، وتارة دالًا عليها بالتضمن، وتارة دالًا عليها باللزوم فدلالة اللفظ عليها مطابقة إذا ذكرت بلفظها، ودلالته بالتضمن إذا ذكر السلام والرحمة فإنهما يتضمنان الثالث، ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على السلام وحده، فإنه يستلزم حصول الخير وثباته إذ لوعدم لم تحصل السلامة المطلقة. فالسلامة مستلزمة لحصول الرحمة كما تقدم تقريره.
وقد عرف بهذا فضل هذه التحية وكمالها على سائر تحيات الأمم ولهذا اختارها الله لعباده وجعلها تحيتهم بينهم في الدنيا وفي دار السلام. وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكماله. فإذا كان هذا في فرع من فروع الإسلام وهو التحية التي يعرفها الخاص والعام. فما ظنك بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبهجته التي شهدت بها العقول والفطر. حتى أنها من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على نبوة محمد ﷺ وكمال دينه وفضله وشرفه على جميع الأدايان، وأن معجزته في نفس دعوته فلو اقتصر عليها كانت آية وبرهانًا على صدقه. وأنه لا يحتاج معها إلى خارق، ولا آية منفصلة. بل دينه وشريعته ودعوته وسيرته من أعظم معجزاته عند الخاصة من أمته حتى أن إيمانهم به، إنما هو مستند إلى ذلك. والآيات في حقهم مقويات بمنزلة تظاهر الأدلة. ومن فهم هذا انفتح له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان، بل باب من أبواب الجنة العاجلة يرقص القلب فيها طربًا ويتمنى أنه له بالدنيا وما فيها.
وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيساعد على تعليق كتاب يتضمن ذكر بعض محاسن الشريعة وما فيها من الحكم البالغة والأسرار الباهرة التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته، وبره بعباده ولطفه بهم، وما اشتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد إليها، وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها. وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا برحمة، ولم يحسن إليهم إحسانًا أعظم من إحسانه إليهم، بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة، ولهذا لم يذكر في القرآن لفظة المن عليهم إلا في سياق ذكرها كقوله: { لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين }، [229] وقوله: { يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين } [230] فهي محض الإحسان إليهم والرأفة بهم، وهدايتهم إلى ما به صلاحهم في الدنيا والآخرة. لا أنها محض التكليف والامتحان الخالي عن العواقب الحميدة التي لا سبيل إليها إلا بهذه الوسيلة فهي لغاياتها المجربة المطلوبة بمنزلة الأكل للشبع والشرب للري والجماع لطلب الولد. وغير ذلك من الأسباب التي ربطت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعزة. فلذلك نصب هذا الصراط المستقيم وسيلة وطريقًا إلى الفوز الأكبر والسعادة، ولا سبيل إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق، كما لا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالعبور على الصراط. فالشريعة هي حياة القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والمشقة الحاصلة فيها. والتكليف وقع بالقصد الثاني كوقوعه في الأسباب المفضية إلى الغايات المطلوبة لا أنه مقصود لذاته فضلًا عن أن يكون هو المقصود لا سواه. فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من الفكر في مصادرها ومواردها يفتح لك بابًا واسعًا من العلم والإيمان. فتكون من الراسخين في العلم لا من الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
وكما أنها آية شاهدة له على ما وصف به نفسه من صفات الكمال. فهي آية شاهدة لرسوله بأنه رسوله حقًا، وأنه أعرف الخلق وأكملهم وأفضلهم وأقواهم إلى الله وسيلة، وأنه لم يؤت عبد مثل ما أوتي فوالهفاه على مساعد على سلوك هذه الطريق، واستفتاح هذا الباب والإفضاء إلى ما وراءه ولو بشطر كلمة، بل والهفاه على من لا يتصدى لقطع الطريق والصد عن هذا المطلب العظيم ويدع المطي وحاديها، ويعطي القوس باريها، ولكن إذا عظم المطلوب قل المساعد وكثر المعارض والمعاند وإذا كان الاعتماد على مجرد مواهب الله وفضله يغنيه ما يتحمله المتحمل من أجله. فلا يثنك شنآن من صد عن السبيل وصدف. ولا تنقطع مع من عجز عن مواصلة السرى ووقف، فإنما هي مهجة واحدة فانظر فيما تجعل تلفها وعلى من تحتسب خلفها.
أنت القتيل بكل من أحببته ** فانظر لنفسك في الهوى من تصطفي
وانفق أنفاسك فيما شئت فإن تلك النفقة مردودة بعينها عليك وصائرة لا سواها إليك وبين العبد وبين السعادة والفلاح صبر ساعة لله وتحمل ملامة في سبيل الله.
وما هي إلا ساعة ثم تنقضي ** ويذهب هذا كله ويزول
وقد أطلنا ولكن ما أمللنا. فإن قلبًا فيه أدنى حياة يهتز إذا ذكر الله ورسوله ويود أن لو كان المتكلم كله ألسنة تالية والسامع كله آذانًا واعية، ومن لم يجد قلبه ثَم، فليشتغل بما يناسبه، فكل ميسر لما خلق له وكل يعمل على شاكلته.
وكل امرىء يهفو إلى من يحبه ** وكل امرىء يصبو إلى ما يناسبه
فصل: لماذا نهاية السلام عند قوله وبركاته
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الحادي والعشرون، وأن كمال التحية عند ذكر البركات إذ قد استوعبت هذه الألفاظ الثلاث جميع المطالب من دفع الشر، وحصول الخير وثباته وكثرته ودوامه؛ فلا معنى للزيادة عليها ولهذا جاء في الأثر المعروف انتهى السلام إلى وبركاته.
فصل: إضافة الرحمة لله وتجريد السلام عن الإضافة
وأما السؤال الثاني والعشرون: وهو ما الحكمة في إضافة الرحمة والبركة إلى الله تعالى وتجريد السلام عن الإضافة؟
فجوابه أن السلام لما كان اسمًا من أسماء الله تعالى استغنى بذكره مطلقًا عن الإضافة إلى المسمى، وأما الرحمة والبركة فلو لم يضافا إلى الله لم يعلم رحمة من، ولا بركة من تطلب، فلو قيل: عليكم ورحمة وبركة لم يكن في هذا اللفظ إشعار بالراحم المبارك الذي تطلب الرحمة والبركة منه. فقيل: رحمة الله وبركاته، وجواب ثان: أن السلام يراد به قول المسلم سلام عليكم. وهذا في الحقيقة مضاف إليه ويراد به حقيقة السلامة المطلوبة من السلام سبحانه وتعالى. وهذا يضاف إلى الله فيضاف هذا المصدر إلى الطالب الذاكر تارة، وإلى المطلوب منه تارة، فأطلق ولم يضف، وأما الرحمة والبركة فلا يضافان إلا إلى الله وحده. ولهذا لا يقال: رحمتي وبركتي عليكم، ويقال: سلام مني عليكم وسلام من فلان على فلان.
وسر ذلك أن لفظ السلام اسم للجملة القولية، بخلاف الرحمة والبركة، فإنهما اسمان لمعناهما دون لفظهما. فتأمله فإنه بديع.
وجواب ثالث: وهو أن الرحمة والبركة أتم من مجرد السلامة. فإن السلامة تبعيد عن الشر. وأما الرحمةوالبركة فتحصيل للخير وإدامة له وتثبيت وتنمية، وهذا أكمل فإنه هو المقصود لذاته والأول وسيلة إليه، ولهذا كان ما يحصل لأهل الجنة من النعيم أكمل من مجرد سلامتهم من النار، فأضيف إلى الرب تبارك وتعالى أكمل المعنيين وأتمهما لفظًا، وأطلق الآخر وفهمت إضافة إليه من العطف وقرينة الحال، فجاء اللفظ على أتم نظام وأحسن سياق.
فصل: الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة
وأما السؤال الثالث والعشرون: وهو ما الحكمة في إفراد السلام والرحمة وجمع البركة؟
فجوابه: إن السلام إما مصدر محض فهو شيء واحد فلا معنى لجمعه. وإما اسم من أسماء الله. فيستحيل أيضا جمعه. فعلى التقديرين لا سبيل إلى جمعه.
وأما الرحمة فمصدر أيضا بمعنى العطف والحنان فلا تجمع أيضا والتاء فيها بمنزلتها في الخلة والمحبة، والرقة ليست للتحديد بمنزلتها في ضربة وتمرة. فكما لا يقال: رقات ولا خلات ولا رأفات، لا يقال: رحمات، وهنا دخول الجمع يشعر بالتحديد والتقييد بعدد وإفراده يشعر بالمسمى مطلقًا من غير تحديد، فالإفراد هنا أكمل وأكثر معنى من الجمع، وهذا بديع جدًا أن يكون مدلول المفرد أكثر من مدلول الجمع، ولهذا كان قوله تعالى: { قل فلله الحجة البالغة }، [231] أعم وأتم معنى من أن يقال: فلله الحجج البوالغ وكان قوله: { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها }. [232] أتم معنى من أن يقال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. وقوله: { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة }، [233] أتم معنى من أن يقال حسنات. وكذا قوله: { يستبشرون بنعمة من الله وفضل } [234] ونظائره كثيرة جدًا، وسنذكر سر هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما البركة فإنها لما كان مسماها كثرة الخير واستمراره شيئًا بعد شيء كلما انقضى منه فرد خلفه فرد آخر، فهو خير مستمر بتعاقب الأفراد على الدوام شيئًا بعد شيء كان لفظ الجمع أولى بها لدلالته على المعنى المقصود بها، ولهذا جاءت في القرآن، كذلك في قوله تعالى: { رحمة الله وبركاته عليكم }، [235] أهل البيت فأفرد الرحمة وجمع البركة. وكذلك في السلام في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
فصل: الرحمة المضافة إلى الله
واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله تعالى نوعان:
أحدهما مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله.
والثاني: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها.
فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: «احتجت الجنة والنار»، فذكر الحديث وفيه: «فقال للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى وسماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة وخص بها أهل الرحمة وإنما يدخلها الرحماء ومنه قوله ﷺ: «خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض»، ومنه قوله تعالى: { ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة }، [236] ومنه تسميته تعالى للمطر رحمة بقوله: { وهو الذي أرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته }، [237] وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثًا وهو قول الداعي. اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، وذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد له عن بعض السلف وحكى فيه الكراهة. قال: لإن مستقر رحمته ذاته وهذا بناء على أن الرحمة صفة، وليس مراد الداعي ذلك، بل مراده الرحمة المخلوقة التي هي الجنة.
ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جدًا وهو أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليها، ولهذا لا يحسن أن يقال اجمعنا في مستقر جنتك، فإن الجنة نفسها هي دار القرار وهي المستقر نفسه. كما قال: حسنت مستقرًا ومقامًا، فكيف يضاف المستقر إليها والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه الشيء، ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة، فتأمله ولهذا قال: مستقر رحمته ذاته، والصواب أن هذا لا يمتنع وحتى لو قال صريحًا: اجمعنا في مستقر جنتك لم يمتنع. وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة، أو عذابًا. فإن أضيف إلى أحد أنواعه أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره، كأنه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لا في المستقر الآخر، ونظير هذا أن يقول: اجلس في مستقر المسجد. أي المستقر الذي هو المسجد، والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرهة وأيضا فإن الجنة وإن سميت رحمة لم يمتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رحمة، ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الجنة، فالداعي أن يطلب أن يجمعه الله ومن يحب في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنة وهذا ظاهر جدًا، فلا يمتنع الدعاء بوجه والله أعلم.
وهذا بخلاف قول الداعي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فإن الرحمة هنا صفته تبارك وتعالى وهي متعلق الاستغاثة. فإنه لا يستغاث بمخلوق ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمنه من التوحيد والاستغاثة برحمة أرحم الراحمين متوسلًا إليه بإسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما مرجع معانيها جميعها، وهو اسم الحي القيوم، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة، وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال.
وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته وعزته. فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من الوجوه وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغنى التام والقدرة التامة، فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاته فما أولى الاستغاثة بهذين الاسمين أن يكونا في مظنة تفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، وإنالة الطلبات.
والمقصود إن الرحمة المستغاث بها هي صفة الرب تعالى لا شيء من مخلوقاته، كما أن المستعيذ بعزته في قوله: أعوذ بعزتك، مستعيذ بعزته التي هي صفته لا بعزته التي خلقها يعز بها عباده المؤمنين. وهذا كله يقرر قول أهل السنة إن قول النبي ﷺ: «أعوذ بكلمات الله التامات» يدل على أن كلماته تبارك وتعالى غير مخلوقة، فإنه لا يستعاذ بمخلوق، وأما قوله تعالى حكاية عن ملائكته: { ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمًا } [238] فهذه رحمة الصفة التي وسعت كل شيء كما قال تعالى: { ورحمتي وسعت كل شيء }، [239] وسعتها عموم تعلقها بكل شيء. كما أن سعة علمه تعالى عموم تعلقه بكل معلوم.
فصل: البركة المضافة لله
وأما البركة. فكذلك نوعان أيضا:
أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة، وبأداة على تارة، وبأداة في تارة. والمفعول منها مبارك وهو ما جعل. كذلك فكان مباركًا بجعله تعالى.
والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح: { وجعلني مباركا أين ما كنت }، [240] فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك.
وأما صيغة تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله: { تبارك الله رب العالمين }، [241] { تبارك الذي بيده الملك }، [242] { فتبارك الله أحسن الخالقين }، [243] { وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون }، [244] { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده }، [245] { تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرًا من ذلك }، [246] { تبارك الذي جعل في السماء بروجًا }. [247]
أفلا تراها كيف أطردت في القرآن جارية عليه غير مختصة به لا تطلق على غيره. وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوهما. فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك وتعاظم. وقال آخر معناه أن تجيء البركات من قبله. فالبركة كلها منه. وقال غيره: كثر خيره وإحسانه إلى خلقه. وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقيل تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله، ومن هنا قيل معناه تعالى وتعاظم وقيل: تبارك تقدس والقدس الطهارة، وقيل: تبارك أي باسمه يبارك في كل شيء. وقيل: تبارك ارتفع والمبارك المرتفع ذكره البغوي. وقيل: تبارك أي البركة تكتسب وتنال بذكره. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. وقيل: معناه ثبت ودام بما لم يزل ولا يزال، ذكره البغوي أيضا.
وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفًا وفعلًا منه تبارك وتعالى، وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل، فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم.
ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيمًا، وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه، وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس. فكذلك تبارك، لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره، وأين أحدهما من الآخر لفظًا ومعنى، هذا لازم وهذا متعد، فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في غيره، لم يصب معناها وإن كان هذا من لوازم كونه متباركًا فتبارك من باب مجد والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل وبارك من باب أعطى وأنعم ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس. فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين. فقال: مجيء البركة كلها من عنده، أو البركة كلها من قبله. وهذا فرع على تبارك في نفسه.
وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك، ولهذا كان كتابه مباركًا ورسوله مباركًا وبيته مباركًا، والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة. فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك وأرض الشام وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة، وتدبر قول النبي ﷺ في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام»، فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء أعني ثناء التنزيه والتسبيح، وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معنى. فأخبر أنه السلام ومنه السلام، فالسلام له وصفًا وملكًا، وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام. وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسماءه كلها سلام، وكذا الحمد كله له وصفًا وملكًا فهو المحمود في ذاته وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودًا، فيهبه حمدًا من عنده، وكذلك العزة كلها له وصفًا وملكًا وهو العزيز الذي لا شيء أعز منه ومن عز من عباده فبإعزازه له. وكذلك الرحمة كلها له وصفًا وملكًا. وكذلك البركة فهو المتبارك في ذاته الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك مباركًا. { فتبارك الله رب العالمين }، [248] { وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون }. [249]
وهذا بساط؛ وإنما غاية معارف العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه. وأما ما وراء ذلك فكما قال: أعلم الخلق بالله، وأقربهم إلى الله وأعظمهم عنده جاهًا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال في حديث الشفاعة الطويل فأخرساجدًا لربي فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن وفي دعاء الهم والغم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك فدل على أن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل. وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك فلا نغلو فيه، ولا نجفو عنه وبالله التوفيق.
فصل: تأكيد السلام على النبي دون الصلاة عليه
وأما السؤال الرابع والعشرون: وهو ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام على النبي ﷺ بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله: { صلوا عليه وسلموا تسليما }؟
فجوابه أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام. وإن اختلفت جهة التأكيد فإنه سبحانه أخبر في أول الآية بصلاته عليه وصلاة ملائكته عليه مؤكدًا لهذا الاخبار بحرف أن مخبرًا عن الملائكة بصيغة الجمع المضاف إليه وهذا يفيد العموم والاستغراق. فإذا استشعرت النفوس أن شأنه ﷺ عند الله، وعند ملائكته هذا الشأن بادرت إلى الصلاة عليه، وإن لم تؤمر بها، بل يكفي تنبيهها والإشارة إليها بأدنى إشارة، وإذا أمرت بها لم تحتج إلى تأكيد الأمر بل إذاجاء مطلق الآمر بادرت وسارعت إلى موافقة الله وملائكته في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلم يحتج إلى تأكيد الفعل بالمصدر. ولما خلا السلام عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر المجرد دون الخبر، حسن تأكيده بالمصدر ليدل على تحقيق المعنى وتثبيته، ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره كما حصل التكرير في الصلاة خبرًا أو طلبًا، فكذلك حصل التكرير في السلامة فعلًا ومصدرًا. فتأمله فإنه بديع جدًا والله أعلم.
وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم العجيبة في كتاب تعظيم شأن الصلاة، والسلام على خير الأنام وأتينا فيه من الفوائد بما يساوي أدناها رحلة مما لا يوجد في غيره. ولله الحمد فلنقتصر على هذه النكتة الواحدة.
فصل: تقديم السلام على النبي في الصلاة قبل الصلاة عليه
وأما السؤال الخامس والعشرون: وهو ما الحكمة في تقديم السلام على النبي ﷺ في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ وهلا وقعت البداءة بما بدأ الله به في الآية؟
فهذا سؤال أيضا له شأن لا ينبغي الإضراب عنه صفحًا وتمشية. والنبي ﷺ كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله والبداءة بما بدأ به. فلهذا بدا بالصفا في السعي. وقال: نبدأ بما بدا الله به. وبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس في الوضوء. ولم يخل بذلك مرة واحدة. بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا لم يقدم منه مؤخرًا ولم يخل منه مقدمًا قط. ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف ذلك لا بإسناد صحيح، ولا حسن ولا ضعيف. ومع هذا فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام، وتأخير الصلاة. وذلك لسر من أسرار الصلاة نشير إليه بحسب الحال إشارة. وهو أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب، فلكل عضو منها نصيب من العبودية. فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة عبودية لله وذلًا له وخضوعًا، فلما أكمل المصلي هذه العبودية وانتهت حركاته ختمت بالجلوس بين يدي الرب تعالى جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته عز وجل. كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده، وكان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعًا وتذللًا. فإذن للعبد في هذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم بما يليق بهم، وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه. فجمع العبد في قوله التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء على الله، وأخبر أن ذلك له وصفًا وملكًا، وكذلك الصلوات كلها لله فهو الذي يصلي له وحده لا لغيره، وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال كلها له فكلماته طيبات وأفعاله كذلك وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب والكلم الطيب إليه يصعد. فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه له ملكًا ووصفًا، ومنه مجيئها وابتداؤها. وإليه مصعدها ومنتهاها والصلاة مشتملة على عمل صالح وكلم طيب، والكلم الطيب إليه يصعد، والعمل الصالح يرفعه. فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إلى الله تعالى. فلما أتى بهذا الثناء على الرب تعالى التفت إلى شأن الرسول الذي حصل هذا الخير على يديه. فسلم عليه أتم سلام معرف باللام التي للاستغراق مقرونًا بالرحمة والبركة. هذا هو أصح شيء في السلام عليه فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام.
ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين وبدأ بنفسه، لأنها أهم، والإنسان يبدأ بنفسه، ثم بمن يعول، ثم ختم هذا المقام يعقد الإسلام وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول الأمر وآخره. وعندها كل الثناء والتشهد.
ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب، فالتشهد يجمع نوعي الدعاء. دعاء الثناء والخير، ودعاء الطلب والمسألة والأول أشرف النوعين، لأنه حق الرب ووصفه، والثاني حظ العبد ومصلحته وفي الأثر: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»، لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها شرع فيها النوعين. وقدم الأول منهما لفضله، ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو دعاء الطلب والمسألة.. فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه له وهو طلب الصلاة من الله على رسوله ﷺ وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته، كما ذكرنا في كتاب تعظيم شأن الصلاة على النبي ﷺ، وفيه أيضا أن الداعي جعله مقدمة بين يدي حاجته وطلبه لنفسه، وقد أشار النبي ﷺ إلى هذا المعنى في قوله، ثم لينتخب من الدعاء أعجبه إليه، وكذلك في حديث فضالة بن عبيد إذا دعا أحدكم. فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصل على النبي ﷺ، ثم ليدع فتأمل، كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقًا لهذا منتظمًا له أحسن النظام، فحديث فضالة هذا هو الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه، وأتم برسالته علينا نعمته، وجعله رحمة للعالمين وحسرة على الكافرين.
فصل: السلام بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة
وأما السؤال السادس والعشرون: وهو ما الحكمة في كون السلام وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة؟
فجوابه يظهر مما تقدم، فإن الصلاة عليه طلب وسؤال من الله أن يصلي عليه فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة إذ لا يقال: اللهم صل عليك. وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلًا له منزلة المواجه لحكمة بديعة جدًا وهي أنه ﷺ لما كان أحب إلى المؤمن من نفسه التي بين جنبيه وأولى به منها وأقرب وكانت حقيقته الذهنية ومثاله العلمي موجودًا في قلبه بحيث لا يغيب عنه إلا شخصه كما قال القائل:
مثالك في عيني وذكرك في فمي ** ومثواك في قلبي فأين تغيب
ومن كان بهذه الحال فهو الحاضر حقًا وغيره. وإن كان حاضرًا للعيان فهو غائب عن الجنان. فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور بالسلام عليه أولى من سلام الغيبة تزيلًا له منزلة المواجه المعاين لقربه من القلب، وحلوله في جميع أجزائه بحيث لا يبقى في القلب جزء إلا ومحبته وذكره فيه كما قيل: لو شق عن قلبي يرى وسطه ذكرك.
والتوحيد في سطر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا تستنكر استيلاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه، حتى كأنه يراه، ولهذا تجدهم في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور، والمشاهدة مع غاية البعد العياني لكمال القرب الروحي، فلم يمنعهم بعد الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتها ومن كثفت طباعه فهو عن هذا كله بمعزل. وإنه ليبلغ الحب ببعض أهله أن يرى محبوبه في القرب إليه بمنزلة روحه التي لا شيء أدنى إليه منها كما قيل:
يا مقيمًا مدى الزمان بقلبي ** وبعيدًا عن ناظري وعِياني
أنت روحي إن كنت لست أراها ** فهي أدنى إلي من كل داني
وقال آخر:
يا ثاويًا بين الجوانح والحشا ** مني وإن بعدت علي دياره
وإنه ليلطف شأن المحبة حتى يرى أنه أدنى إليه وأقرب من روحه. ولي من أبيات تلم بذلك:
وأدنى إلى الصب من نفسه ** وإن كان عن عينه نائيا
ومن كان مع حبه هكذا ** فأنى يكون له ساليا
ثم يلطف شأنها ويقهر سلطانها حتى يغيب المحب بمحبوبه عن نفسه، فلا يشعر إلا بمحبوبه ولا يشعر بنفسه، ومن هنا نشأت الشطحات الصوفية التي مصدرها عن قوة الوارد وضعف التمييز. فحكم صاحبها فيها الحال على العلم وجعل الحكم له وعزل علمه من البين وحكم المحفوظون فيها حاكم العلم على سلطان الحال. وعلموا أن كل حال لا يكون العلم حاكمًا عليه، فإنه لا ينبغي أن يغتر به، ولا يسكن إليه إلا كما يساكن المغلوب المقهور لما يرد عليه مما يعجز عن دفعه. وهذه حال الكمل من القوم الذين جمعوا بين نور العلم، وأحوال المعاملة. فلم تطفىء عواصف أحوالهم نور علمهم، ولم يقصر بهم علمهم عن الترقي إلى ما وراءه من مقامات الإيمان والإحسان، فهؤلاء حكام على الطائفتين ومن عداهم فمحجوب يعلم لا نفوذ له فيه، أو مغرور بحال لا علم له بصحيحه من فاسده والله المسؤول من فضله إنه قريب مجيب.
فالكامل من يحكّم العلم على الحال فيتصرف في حاله بعلمه، ويجعل العلم بمنزلة النور الذي يميز به الصحيح من الفاسد لا من يقدح في العلم بالحال، ويجعل الحال معيارًا عليه وميزانًا، فما وافق حاله من العلم قبله وما خالفه رده ونفاه، فهذا أضل الضلال في هذا الباب، بل الواجب تحكيم العلم والرجوع إلى حكمه، وبهذا أوصى العارفون من شيوخ الطريق كلهم وحرضوا على العلم أعظم تحريض لعلمهم بما في الحال المجرد عنه من الغوائل والمهالك والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
فصل: الثناء على الله في التشهد
وأما السؤال السابع والعشرون: وهو ما الحكمة في ورود الثناء على الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه سبحانه هو المخاطب الذي يناجيه العبد والسلام على النبي ﷺ بلفظ الخطاب مع كونه غائبًا؟
فجوابه أن الثناء على الله عامة ما يجيء مضافًا إلى أسمائه الحسنى الظاهرة دون الضمير إلا أن يتقدم ذكر الاسم الظاهر فيجيء بعده المضمر. وهذا نحو قول المصلي: { الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * إياك نعبد }، وقوله في الركوع: سبحان ربي العظيم وفي السجود: سبحان ربي الأعلى وفي هذا من السر أن تعليق الثناء بأسمائه الحسنى هو لما تضمنت معانيها من صفات الكمال ونعوت الجلال. فأتى بالاسم الظاهر الدل على المعنى الذي يثنى به ولأجله عليه تعالى ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك. ولهذا إذا كان ولابد من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرونًا بميم الجمع الدالة على جمع الأسماء والصفات نحو قوله في رفع رأسه من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد وربما اقتصر على ذكر الرب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى. فتأمله فإنه لطيف المنزع جدًا.
وتأمل كيف صدر الدعاء المتضمن للثناء والطلب بلفظة اللهم. كما في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك الحديث. وجاء الدعاء المجرد مصدرًا بلفظ الرب نحو قول المؤمنين: { ربنا اغفر لنا ذنوبنًا }، [250] وقول آدم: { ربنا ظلمنا أنفسنا }، [251] وقول موسى: { رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي }، [252] وقول نوح: { رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم }، [253] وكان النبي ﷺ يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي».
وسر ذلك أن الله تعالى يسأل بربوبيته المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره ويثنى عليه بالاهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتدبر طريقة القرآن تجدها كما ذكرت لك.
فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة وهو في القرآن حيث وقع لا يكاد، يجيء إلا مصدرًا باسم الرب.
وأما الثناء فحيث وقع فمصدر بالأسماء الحسنى وأعظم ما يصدر به اسم الله جل جلاله نحو: { الحمد لله } حيث جاء ونحو: { فسبحان الله } وجاء: { سبحان ربك رب العزة }، ونحوه: { سبح لله ما في السموات وما في الأرض } [254] حيث وقعت ونحو: { تبارك الله رب العالمين }، [255] { تبارك الله أحسن الخالقين }، [256] { تبارك الذي نزل الفرقان على عبده }، [257] ونظائره.
وجاء في دعاء المسيح: { اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء }، [258] فذكر الأمرين ولم يجىء في القرآن سواه ولا رأيت أحدًا تعرض لهذا ولا نبه عليه. وتحته سر عجيب دال على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له. فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه له: { هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء }، [259] فخوفهم بالله وأعلمهم أن هذا مما لا يليق أن يسأل عنه. وأن الإيمان يرده. فلما ألحوا في الطلب وخاف المسيح أن يداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألوا بدأ في السؤال باسم ( اللهم ) الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته ففي ضمن ذلك تصوره بصورة المثنى الحامد الذاكر لأسماء ربه المثى عليه بها. وأن المقصود من هذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة. إنما هو أن يثنى على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهد قدرته وربوبيته، ويكون برهانًا على صدق رسوله. فيحصل بذلك من زيادة الإيمان والثناء على الله أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر فيه فأتى بالاسمين: اسم الله الذي يثنى عليه به. واسم الرب الذي يدعي ويسأل به لما كان المقام مقام الأمرين. فتأمل هذا السر العجيب، ولا ينب عنه فهمك فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه وله الحمد.
وأما السلام على النبي ﷺ بلفظ الخطاب فقد ذكرنا سره في الوجه الذي قبل هذا فالعهد به قريب.
فصل: السلام في آخر الصلاة وتعريفه
وأما السؤال الثامن والعشرون: فقد تضمن سؤالين. أحدهما ما السر في كون السلام في آخر الصلاة، والثاني لم كان معرفًا؟
والجواب: أما اختتام الصلاة به فإنه قد جعل الله لكل عبادة تحليلًا منها. فالتحليل من الحج بالرمي وما بعده، وكذلك التحلل من الصوم بالفطر بعد الغروب، فجعل السلام تحليلًا من الصلاة كما قال النبي ﷺ: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، تحريمها هنا هو بابها الذي يدخل منه إليها وتحليلها بابها الذي يخرج به منها. فجعل التكبير باب الدخول، والتسليم باب الخروج لحكمة بديعة بالغة يفهمها من عقل عن الله وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم، وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره وبدائعه، وتغرب عن عالم العادة والألف، فلم يقنع بمجرد الأشباح حتى يعلم ما يقوم بها من الأرواح. فإن الله لم يشرع شيئًا سدى، ولا خلوًا من حكمة بالغة. بل في طوايا ما شرعه وأمر به من الحكم والأسرار التي تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه، فيسجد القلب خضوعًا وإذعانًا.
فنقول وبالله التوفيق: لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل، وقطع جميل العلائق وتطهر، وأخذ زينته وتهيأ للدخول على الله ومناجاته. شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على الملوك، فيدخل بالتعظيم والإجلال. فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى وهو قول الله أكبر. فإن في اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب المحذوف المجرور بمن ما لا يوجد في غيره، ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه، ولا يؤدي معناه، ولا تنعقد الصلاة إلا به كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث. فجعل هذا اللفظ واستشعار معناه. والمقصود به باب الصلاة الذي يدخل العبد على ربه منه. فإنه إذا استشعر بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيي منه أن يشغل قلبه في الصلاة بغيره. فلا يكون موفيًا لمعنى الله أكبر، ولا مؤديا لحق هذا اللفظ، ولا أتى الببت من بابه، بل الباب عنه مسدود. وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه.
وما أحسن ما قال أبو الفرج بن الجوزي في بعض وعظه: حضور القلب أول منزل من منازل الصلاة فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى، فإذا رحلت عنها أنخت بباب المناجاة فكان أول قرى الضيف اليقظة، وكشف الحجاب لعين القلب، فكيف يطمع في دخول مكة من لا خرج إلى البادية، وقد تبعث قلبك في كل واد، فربما تفجأك الصلاة وليس قلبك عندك، فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه، فتدخل في الصلاة بغير قلب.
والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبر. وقد امتلأ قلبه بغير الله فهو قبلة قلبه في الصلاة، ولعله لا يحضر بين يدي ربه في شيء منها. فلو قضي حق الله أكبر وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات. فهذا الباب الذي يدخل منه المصلي وهو التحريم.
وأما الباب الذي يخرج منه فهو باب السلام المتضمن أحد الأسماء الحسنى، فيكون مفتتحًا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ومختتمًا لها باسمه فيكون ذاكرًا لاسم ربه أول الصلاة وآخرها. فأولها باسمه، وآخرها باسمه. فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمه مع ما في اسم السلام من الخاصية، والحكمة المناسبة لانصراف المصلي من بين يدي الله، فإن المصلي ما دام في صلاته بين يدي ربه فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره. بل هو في حمى من جميع الآفات والشرور. فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن، وتعرضت له من كل جانب وجاءه الشيطان بمصائده وجنده، فهو متعرض لأنواع البلايا والمحن. فإذا انصرف من بين يدي الله مصحوبًا بالسلام لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى. وكان من تمام النعمة عليه أن يكون انصرافه من بين يدي ربه بسلام يستصحبه ويدوم له ويبقى معه.
فتدبر هذا السر الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافيًا، فكيف وفيه من الأسرار والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان، والحمد في ذلك لله وحده. فكما أن المنعم به هو الله وحده. فالمحمود عليه هو الله وحده. وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني وهو مجيء السلام هنا معرفًا ليكون دالًا على اسمه السلام.
وليكن هذا آخر الكلام في مسألة سلام عليكم. فلولا قصد الاختصار لجاءت مجلدًا ضخمًا. هذا ولم نتعرض فيها إلى المسائل المسطورة في الكتب من فروع السلام ومسائله. فإنها مملوءة منها فمن أرادها، فليأخذها من هناك والحمد لله رب العالمين.
(تفسير المعوذتين)
روى مسلم في صحيحه من حديث قيس بن أبى حازم عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله ﷺ: «ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس». وفي لفظ آخر من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة: أن رسول الله ﷺ قال له: «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون»، قلت: بلى، قال: «قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس». وفي الترمذي: حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة قال: هذا حديحث غريب. وفي الترمذي والنسائي وسنن أبي داود عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة نطلب النبي ﷺ ليصلي لنا فأدركناه. فقال: قل، فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئًا، ثم قال: قل، قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا من حديث الجريري عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما. قال: وفي الباب عن أنس، وهذا حديث غريب. وفي الصحيحين عن عائشة: إن النبي ﷺ كان إذا آوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والعوذتين جميعًا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قلت: هكذا رواه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة ذكره البخاري. ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها أن النبي ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. وكذلك قال معمر عن الزهري عن عروة عنها: إن النبي ﷺ كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ذكره البخاري أيضا. وهذا هو الصواب أن عائشة كانت تفعل ذلك والنبي ﷺ لم يأمرها ولم يمنعها من ذلك. وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا. ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها على رقيته أن يكون مسترقيًا. فليس أحدهما بمعنى الآخر، ولعل الذي كان بأمرها به إنما هو المسح على نفسه بيده فيكون هو الراقي لنفسه، ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه ويكون هذا غير قراءتها هي عليه ومسحها على يديه، فكانت تفعل هذا وهذا، والذي أمرها به إنما هو تنقل يده لا رقيته. والله أعلم.
والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة، بل الضرورة إليهما وأنه لا يستغني عنهما أحد قط. وأن لهما تأثيرًا خاصًا في دفع السحر والعين وسائر الشرور. وإن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجتهه إلى النفس والطعام والشراب واللباس.
فنقول والله المستعان: قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهي أصول الاستعاذة: أحدها نفس الاستعاذة، والثانية المستعاذ به، والثالثة المستعاذ منه. فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين. فلنعقد لهما ثلاثة فصول الفصل الأول في الاستعاذة، والثاني في المستعاذ به، والثالث في المستعاذ منه.
الفصل الأول: الاستعاذة وبيان معناها
اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة. وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذًا. كما يسمى ملجأ ووزرًا.
وفي الحديث أن ابنة الجون لما أدخلت على النبي ﷺ فوضع يده عليها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: «لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك». فمعنى أعوذ التجىء وأعتصم وأتحرز. وفي أصله قولان: أحدهما أنه مأخوذ من الستر. والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. فأما من قال إنه من الستر، قال: العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها عُوَّذًا، بضم العين وتشديد الواو وفتحها، فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها سموه عوذا. فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه، واستجن به منه، ومن قال: هو لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوذ، لأنه اعتصم به واستمسك به. فكذلك العائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه.
والقولان حق، والاستعاذة تنتظمهما معًا. فإن المستعيذ مستتر بمعاذه متمسك به معتصم به. قد استمسك قلبه به ولزمه. كما يلزم الوالد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفًا وقصده به فهرب منه فعرض له أبوه في طريق هربه. فإنه يلقي نفسه عليه، ويستمسك به أعظم استمساك. فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه.
وبعد، فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم وإلا فما يقوم بالقلب حيئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب الافتقار إليه. والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة.
ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته، فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك، ولا تدرك إلا بالانصاف بذلك لا بمجرد الصفة والخبر، كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلًا، فلو قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبهها به لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه، فإذا وصفتها لمن خلقت فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق.
وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكين العين وضم الواو، ثم أعل بنقل حركة الواو إلى العين، وتسكين الواو، فقالوا: أعوذ على أصل هذا الباب، ثم طردوا إعلاله فقالوا في اسم الفاعل عائذ وأصله عاوذ فوقعت الواو بعد ألف فاعل فقلبوها همزة، كما قالوا: قائم وخائف، وقالوا في المصدر: عياذًا بالله. وأصله عواذًا كلواذ، فقلبوا الواو ياء لكسرة ما قبلها، ولم تحصنها حركتها لأنها قد ضعفت بإعلالها في الفعل. وقالوا: مستعيذ، وأصله مستعوذ كمستخرج فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلها، قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب.
فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل. كقوله: فاستعذ بالله ولم تدخل في الماضي والمضارع، بل الأكثر أن يقال: أعوذ بالله وعذت بالله دون أستعيذ واستعذت.
قلت: السين والتاء دالة على الطلب. فقوله: استعيذ بالله أي أطلب العياذ به. كما إذا قلت: أستخير الله أي أطلب خيرته وأستغفره، أي أطلب مغفرته وأستقيله، أي أطلب إقالته. فدخلت في الفعل إيدانًا لطلب هذا المعنى من المعاذ. فإذا قال المأمور: أعوذ بالله. فقد امتثل ما طلب منه، لأنه طلب من الالتجاء والاعتصام وفرق بين نفس الالتجاء الاعتصام وبين طلب ذلك، فلما كان المستعيذ هاربًا ملتجئًا معتصمًا بالله أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك، فتأمله.
وهذا بخلاف ما إذا قيل: استغفر الله، فقال: استغفرِ الله، فإنه طلب منه أن يطلب المغفرة من الله، فإذا قال: أستغفر الله كان ممتثلًا، لأن المعنى أطلب من الله أن يغفر لي. وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين فيقول: أستعيذ بالله، أي أطلب منه أن يعيذني، ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء الهرب إليه. فالأول مخبر عن حاله وعياذه بربه، وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه. والثاني: طالب سائل من ربه أن يعيذه كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني، فحال الأول أكمل.
ولهذا جاء عن النبي ﷺ في امتثال هذا الأمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - وأعوذ بكلمات الله التامات - وأعوذ بعزة الله وقدرته. دون أستعيذ، بل الذي علمه الله إياه أن يقول: { أعوذ برب الفلق }، { قل أعوذ برب الناس }، دون أستعيذ، فتأمل هذه الحكمة البديعة.
فإن قلت: فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به. فقال: { قل أعوذ برب الفلق }، { قل أعوذ برب الناس }، ومعلوم أنه إذا قيل: قل الحمد الله وقل سبحان الله، فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله وسبحان الله، ولا يقول: قل سبحان الله.
قلت: هذا هو السؤال الذي أورده أبي بن كعب على النبي ﷺ بعينه وأجابه عنه رسول الله ﷺ فقال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة ثنا سفيان بن عاصم وعبدة عن زر قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله ﷺ فقال: قيل لي، فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله ﷺ. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان ثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش، وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا، فقال: إني سألت رسول الله ﷺ فقال: قيل لي، فقلت: قل، فنحن نقول كما قال رسول الله.
قلت: مفعول القول محذوف وتقديره قيل لي قل، أو قيل لي هذا اللفظ، فقلت كما قيل لي.
وتحت هذا من السر أن النبي ﷺ ليس له في القرآن إلا بلاغه، لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه، بل هو المبلغ له عن الله. وقد قال الله له: { قل أعوذ برب الفلق }، فكان يقتضي البلاغ التام أن يقول: { قل أعوذ برب الفلق }، كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي ﷺ إليه بقوله: «قيل لي فقلت». أي: فلست مبتدئًا، بل أنا مبلغ أقول كما يقال لي، وأبلغ كلام ربي كما أنزله إلي. فصلوات الله وسلامه عليه. لقد بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، وقال كما قيل له، فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول: هذا القرآن العربي، وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به. ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا القول وأنه ﷺ بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه حتى أنه لما قيل له "قل" قال هو: قل، لأنه مبلغ محض. وما على الرسول إلا البلاغ.
الفصل الثاني: المستعاذ به هو الله
في المستعاذ به، وهو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس، الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه. بل هو الذي يعيذ المستعيذين، ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وقد أخبر تعالى في كتابه عن من استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانًا ورهقًا. فقال حكاية عن مؤمني الجن: { وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا }، [260] جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح. أي فزاد الإنسَّ الجنُّ باستعاذتهم بسادتهم رهقًا، أي طغيانًا وإثمًا وشرًا. يقولون: سدنا الإنس والجن. والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم، فزادوهم بهذه الاستعاذة غشيانًا لما كان محظورًا من الكبر والتعاظم، فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن.
واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة بأن النبي ﷺ استعاذ بقوله: «أعوذ بكلمات الله التامات»، وهو ﷺ لا يستعيذ بمخلوق أبدًا. ونظير ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك». فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته، وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته»، وقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». وما استعاذ به النبي ﷺ غير مخلوق فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو صفة من صفاته. وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس، ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. وقد قررنا في مواضع متعددة. أن الله سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه، وقد قال النبي ﷺ في هاتين السورتين: إنه «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما». فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيًا للمطلوب وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه، وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث وهو الشيء المستعاذ منه. فتتبين المناسبة المذكورة فنقول.
الفصل الثالث: الشرور المستعاذ منها
في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين.
الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالًا بصاحبه. وإما شر واقع به من غيره، وذلك الغير إما مكلف، أو غير مكلف، والمكلف إما نظيره وهو الإنسان، أو ليس نظيره وهو الجني وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمى وغيرها.
فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة. بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما.
فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة. أحدها: شر المخلوقات التي لها شر عمومًا. الثاني: شر الغاسق إذا وقب. الثالث: شر النفاثات في العقد، الرابع: شر الحاسد إذا حسد. فنتكلم على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد والتحرز منها قبل وقوعها وبماذا تدفع بعد وقوعها؟
وقبل الكلام في ذلك. لا بد من بيان الشر ما هو وما حقيقته. فنقول:
الشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه، وليس له مسمى سوى ذلك، فالشرور هي الآلام وأسبابها. فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور. وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة. لكنها شرور، لأنها أسباب الالام ومفضية إليها كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها. فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة، وعلى الذبح والإحراق بالنار والخنق بالحبل وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها، ولا بد ما لم يمنع السببية مانع، أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده، كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان وعظمة الحسنات الماحية وكثرتها فيزيد في كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب فيدفع الأقوى للأضعف. وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة كأسباب الصحة والمرض، وأسباب الضعف والقوة.
والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذة ما هي شر. وإن نالت بها النفس مسرة عاجلة وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي. لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذ لآكله، وطاب له مساغه، وبعد قليل يفعل به ما يفعل. فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده.
وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته. فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه، ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه: { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال }. [261]
ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم. وجد سبب ذلك جميعه، إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله، وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره. وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب كما قيل:
إذا كنت في نعمة فارعها ** فإن المعاصي تزيل النعمْ
فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره، ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه. فإنها نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له.
والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا بد. وأما كون مسبباتها شرورًا فلأنها آلام نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم الغموم والأحزان والحسرات. ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب. ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمرًا كان مفعولا. فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العاجل والآجل من الله. وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم والإشراف والإطلاع على عالم البقاء. فحينئذ يقول: { يا ليتني قدمت لحياتي }، [262] { يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله }. [263]
ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات النبي ﷺ جميعها مدارها على هذين الأصلين فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم، وإما سبب يفضي إليه. فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع وأمر بالاستعاذة منهن وهي عذاب القبر وعذاب النار. فهذان أعظم المؤلمات. وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. وهذان سبب العذاب المؤلم. فالفتنة سبب العذاب. وذكر الفتنة خصوصًا وعمومًا. وذكر نوعي الفتنة، لأنها إما في الحياة، وإما بعد الموت، ففتنة الحياة قد يتراخى عنها العذاب مدة، وأما فتنة الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابها. وهذا من آكد أدعية الصلاة حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدع به في التشهد الأخير، وأوجبه ابن حزم في كل تشهد، فإن لم يأت به في بطلت صلاته.
ومن ذلك قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال» فاستعاذ من ثمانية أشياء كل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان وهما من آلام الروح ومعذباتها. والفرق بينهما أن الهم توقع الشر في المستقبل والحزن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح. فإن تعلق بالماضي سمي حزنًا، وإن تعلق بالمستقبل سمي همًا.
والعجز والكسل قرينان وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب، فالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عده إرادته. فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل.
والجبن والبخل قرينان، لأنهما عدم النفع بالمال والبدن وهما من أسباب الألم، لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة، والبخل يحول بينه دونها أيضا، فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام.
وضلع الدين وقهر الرجال قرينان وهما مؤلمان للنفس معذبان لها. أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين. والثاني: قهر بباطل وهو غلبة الرجال، وأيضا فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب وغلبة الرجال قهر بغير اختياره.
ومن ذلك تعوذه ﷺ: «من المأثم والمغرم» فإنهما يسببان الألم العاجل. ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» فالسخط سبب الألم والعقوبة هي الألم، فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها.
فصل: الشر المستعاذ منه نوعان
والشر المستعاذ منه نوعان: أحدهما موجود يطلب رفعه، والثاني معدوم يطلب بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. كما أن الخير المطلق نوعان: أحدهما موجود فيطلب دوامه وثباته وأن لا يسلبه، والثاني معدوم فيطلب وجوده وحصوله.
فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين وعليها مدار طلباتهم. وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم: { ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا }، [264] فهذا الطلب لدفع الشر الموجود. فإذ الذنوب والسيئات شر كما تقدم بيانه.
ثم قال: { وتوفنا مع الأبرار }، فهذا طلب لدوام الخير الموجود وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليه. فهذان قسمان.
ثم قال: { ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك }، فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه. ثم قال: { ولا تخزنا يوم القيامة }، فهذا طلب أن لا يوقع بهم الشر المعدوم وهو خزي يوم القيامة.
فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام مرتبة أحسن ترتيب قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا، وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت، ثم اتبعا بالنوعين اللذين في الآخرة. وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وأن لا يخزيهم يوم القيامة.
فإذا عرف هذا فقوله ﷺ في في تشهد الخطبة: «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»، يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوة فيسأل دفعه وأن لا يوجد.
وأما قوله: «من سيئات أعمالنا» ففيه قولان.
أحدهما: أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت، فيكون الحديث قد تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجد ومن الشر الموجود. فطلب دفع الأول ورفع الثاني.
والقول الثاني: إن سيئات الأعمال هي التي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء صاحبها وعلى هذا يكون من استعاذه الدفع أيضا دفع المسبب. والأول دفع السبب فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه وعلى الأول يكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه. فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منها. وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبب إلى سببه والمعلول إلى علته كأنه قال من عقوبة عملي. والقولان محتملان. فتأمل أيهما أليق بالحديث وأولى به. فإن مع كل واحد منهما نوعًا من الترجيح.
فيترجح الأول بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس، فشر النفس يولد الأعمال السيئة فاستعاذ من صفة النفس ومن الأعمال التي تحدث عن تلك الصفة وهذان جماع الشر وأسباب كل ألم، فمتى عوفي منهما عوفي من الشر بحذافيره.
ويترجح الثاني بأن سيئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء العامل وأسبابها شر النفس، فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها. والقولان في الحقيقة متلازمان والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر.
فصل: الشر ومصدره ومنتهاه
ولما كان الشر له سبب هو مصدره وله مورد ومنتهى. وكان السبب إما من ذات العبد، وإما من خارج ومورده ومنتهاه إما نفسه، وإما غيره؛ كان هنا أربعة أمور: شر مصدره من نفسه ويعود على نفسه تارة وعلى غيره أخرى، وشر مصدره من غيره وهو السبب فيه ويعود على نفسه تارة وعلى غيره أخرى - جمع النبي ﷺ هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه الصديق أن يقوله إذا أصبح، وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم». فذكر مصدري الشر وهما النفس والشيطان، وذكر مورديه ونهايتيه وهما عوده على النفس أو على أخيه المسلم، فجمع الحديث مصادر الشر وموارده في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه وأبينه.
فصل: الشرور المستعاذ منها في المعوذتين
فإذا عرف هذا فلنتكلم على الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين.
الشر الأول العام في قوله: { من شر ما خلق }، وما ههنا موصولة ليس إلا. والشر مسند في الآية إلى المخلوق المفعول لا إلى خلق الرب تعالى الذي هو فعله وتكوينه. فإنه لا شر فيه بوجه ما. فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته، ولا في أفعاله. كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى. فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما.
وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلًا، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى. ولعاد إليه منه حكم تعالى وتقدس عن ذلك وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، وإنما يكون شرًا بالنسبة إليهم، فالشر وقع في تعلقه بهم وقيامه بهم لا في فعله القائم به تعالى، ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير والشر.
ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال:
أحدهما: أن ما هو شر أو متضمن للشر. فإنه لا يكون إلا مفعولًا منفصلًا لا يكون وصفًا له، ولا فعلًا من أفعاله.
الثاني: أن كونه شرًا هو أمر نسبي إضافي فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان هو من أحدهما خير وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقًا وتكوينًا ومشيئة لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها، وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منها، وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادىء معرفتها فضلًا عن حقيقتها فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه هو الغني الحميد، وفاعل الشر لا يفعله لحاجته المنافية لغناه، أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده. فيستحيل صدور الشر من الغنى الحميد فعلًا، وإن كان هو الخالق للخير والشر، فقد عرفت أن كونه شرًا هو أمر إضافي وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه.
فلا تغفل عن هذا الموضع فإنه يفتح لك بابًا عظيمًا من معرفة الرب ومحبته، ويزيل عنك شبهاث حارت فيها عقول أكثر الفضلاء. وقد بسطت هذا في كتاب التحفة المكية، وكتاب الفتح القدسي، وغيرهما.
وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة.
أحدها: أن السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، وخير محض بالنسبة إلى عموم الناس لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي القطع أمرًا وحكمًا لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عمومًا بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك، وأمره به مشكورعليه يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة.
وكذلك الحكم بقتل من يصول عليهم في دمائهم وحرماتهم وجلد من يصول عليهم في أعراضهم. فإذا كان هذا عقوبة من يصول عليهم في دنياهم، فكيف عقوبة من يصول على أديانهم ويحول بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به رسله، وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به.
أفليس في عقوبة هذا الصائل خير محض، وحكمة وعدل وإحسان إلى العبيد وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي، فالشر ما قام به من تلك العقوبة، وأما ما نسب إلى الرب منها من المشيئة والإرادة والفعل فهو عين الخير والحكمة، فلا يغلظ حجابك عن فهم هذا النبأ العظيم، والسر الذي يطلعك على مسألة القدر ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى خلقه. وإنه سبحانه. كما إنه البر الرحيم الودود المحسن، فهو الحكيم الملك العدل. فلا تناقض حكمته رحمته. بل يضع رحمته وبره وإحسانه موضعه، ويضع عقوبته وعدله وانتقامه وبأسه موضعه وكلاهما مقتضى عزته وحكمته وهو العزيز الحكيم. فلا يليق بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب، ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته، ولا يلتفت إلى قول من غلظ حجابه عن الله أن الأمرين بالنسبة إليه على حد سواء، ولا فرق أصلًا، وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا حكمة.
وتأمل القرآن من أوله إلى آخره. كيف تجده كفيلًا بالرد على هذه المقالة، وإنكارها أشد الإنكار وتنزيه نفسه عنها كقوله تعالى: { أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون }، [265] وقوله: { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون }، [266] وقوله: { أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار }، [267] فأنكر سبحانه على من ظن هذا الظن ونزه نفسه عنه. فدل على أنه مستقر في الفطر والعقول السليمة. إن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعزته وإلاهيته لا إله إلا هو تعالى عما يقول الجاهلون علوًا كبيرًا.
وقد فطر الله عقول عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام في موضع الرحمة والإحسان، ومكافأة الصنع الجميل بمثله وزيادة. فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنكرته فطرهم وعقولهم أشد الاستنكار، واستهجنته أعظم الاستهجان، وكذلك وضع الإحسان والرحمة والإكرام في موضع العقوبة والانتقام. كما إذا جاء إلى من يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيء من أموالهم وحريمهم ودمائهم. فأكرمه غاية الإكرام ورفعه وكرمه. فإن الفطر والعقول تأبى استحسان هذا وتشهد على سفه من فعله.
هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. فما للعقول والفطر لا تشهد حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أولى المحال بها وأحقها بالعقوبة. وأنها لو أوليت النعم لم تحسن بها، ولم تلق، ولظهرت مناقضة الحكمة، كما قال الشاعر:
نعمة الله لا تعاب ولكن ** ربما استقبحت على أقوام
فهكذا نعم الله لا تليق ولا تحسن، ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله الساعين في خلاف مرضاته الذين يرضون إذا غضب، ويغضبون إذا رضي، ويعطلون ما حكم به، ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره فهم مضادون في كل ما يريد. يحبون ما يبغضه ويدعون إليه، ويبغضون ما يحبه، وينفرون عنه ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله. كما قال تعالى: { وكان الكافر على ربه ظهيرًا }، [268] وقال: { وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو }. [269]
فتأمل ما تحت هذا الخطاب الذي يسلب الأرواح حلاوة وعقابًا وجلالة وتهديدًا. كيف صدره بإخبارنا أنه أمر إبليس بالسجود لأبينا فأبى ذلك فطرده ولعنه وعاداه من أجل إبائه عن السجود لأبينا، ثم أنتم توالونه من دوني. وقد لعنته وطردته إذ لم يسجد لأبيكم، وجعلته عدوًا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني. فليس هذا من أعظم الغبن وأشد الحسرة عليكم ويوم القيامة يقول تعالى: أليس عدلًا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولى في دار الدنيا. فليعلمن أولياء الشيطان كيف حالهم يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا مع أحد فيتجلى لهم ويقول: ألا تذهبون حيث ذهب الناس. فيقولون: فارقنا الناس أحوج ما كنا إليهم. وإنما ننتظر ربنا الذي كنا نتولاه ونعبده. فيقول: هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم إنه لا مثل له فيتجلى لهم، ويكشف عن ساق فيخرون له سجدًا.
فيا قرة عيون أوليائه بتلك الموالاة، ويا فرحهم إذا ذهب الناس مع أوليائهم، وبقوا مع مولاهم الحق. فسيعلم المشركون به الصادون عن سبيله أنهم ما كانوا أولياءه؛ إن أولياءه إلا المتقون { ولكن أكثرهم لا يعلمون }.
ولا تستطل هذا البسط، فما أحوج القلوب إلى معرفته وتعقله ونزولها منها منازلها في الدنيا، لتنزل في جوار ربها في الآخرة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
فصل: حديث لبيك وسعديك
إذا عرف هذا عرف معنى قوله ﷺ في الحديث الصحيح: «لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك». وإن معناه أجل وأعظم من قول من قال: والشر لا يتقرب به إليك. وقول من قال: والشر لا يصعد إليك. وإن هذا الذي قالوه وإن تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه. فلا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر بخلاف لفظ المعصوم الصادق المصدق. فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بوجه ما لا في صفاته، ولا في أفعاله ولا في أسمائه وأن دخل في مخلوقاته كقوله: { قل أعوذ برب الفلق * من شر ما خلق }.
وتأمل طريقة القرآن في إضافة الشر تارة إلى سببه ومن قام به كقوله: { والكافرون هم الظالمون }، [270] وقوله: { والله لا يهدي القوم الفاسقين }، [271] وقوله: { فبظلم من الذين هادوا } وقوله: { ذلك جزيناهم ببغيهم }، [272] وقوله: { وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين }، [273] وهو في القرآن أكثر من أن يذكر ههنا عشر معشاره. وإنما المقصود التمثيل.
وتارة بحذف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: { وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا }، [274] فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد.
ونظيره في الفاتحة: { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين }، فذكر النعمة مضافة إليه سبحانه والضلال منسوبًا إلى من قام به والغضب محذوفًا فاعله. ومثله قول الخضر في السفينة: { فأردت أن أعيبها }، [275] وفي الغلامين: { فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك }. [276]
ومثله قوله: { ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان }، [277] فنسب هذا التزيين المحبوب إليه، وقال: { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين }، [278] فحذف الفاعل المزين.
ومثله قول الخليل ﷺ: { الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين * وإذا مرضت فهو يشفين * والذي يميتني ثم يحيين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين }، [279] فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال. ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة.
وهذا كثير في القرآن ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب الفوائد المكية، وبينا هناك السر في مجيء الذين آتيناهم الكتاب، والذين أوتوا الكتاب والفرق بين الموضعين. وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعًا في سياق المدح. وحيث حذفه كان من أوتيه واقعًا في سياق الذم، أو منقسمًا. وذلك من أسرار القرآن الكريم.
ومثله: { ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا }، [280] وقال: { وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب }، [281] وقوله: { فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى }، [282] وبالجملة فالذي يضاف إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل والشر ليس إليه.
فصل: من شر ما خلق
وقد دخل في قوله تعالى: { من شر ما خلق }، الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيًا كان أو جنيًا أو هامة أو دابة أو ريحًا أو صاعقة أي نوع كان من أنواع البلاء.
فإن قلت: فهل في ما ههنا عموم؟
قلت: فيها عموم تقييدي وصفي، لا عموم إطلاقي. والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر. فعمومها من هذا الوجه. وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر، وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض والخير كله حصل على أيديهم فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر، وكل شر في الدنيا والآخرة وشر شياطين الإنس والجن، وشر السباع والهوام وشر النار والهواء وغير ذلك.
وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من نزل منزلًا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منه»، رواه مسلم.
وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا سافر فأقبل الليل قال: «يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد».
وفي الحديث الآخر: «أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما نزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقًا يطرق بخير يا رحمن». [283]
فصل: شر غاسق إذا وقب
الشر الثاني: { شر غاسق إذا وقب }، فهذا خاص بعد عام، وقد قال المفسرين: إنه الليل. قال ابن عباس: الليل إذا أقبل بظلمته من الشرق، ودخل في كل شيء وأظلم والغسق الظلمة يقال: غسق الليل وأغسق إذا أظلم ومنه قوله تعالى: { أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل }. [284]
وكذلك قال الحسن ومجاهد: الغاسق: إذا وقب الليل إذا أقبل ودخل والوقوب الدخول. وهو دخول الليل بغروب الشمس. وقال مقاتل: يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار، وفي تسمية الليل غاسقًا قول آخر إنه من البرد والليل أبرد من النهار والغسق البرد. وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى: { هذا فليذوقوه حميم وغساق }، [285] وقوله: { لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا * إلا حميما وغساقا }، [286] قال: هو الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرها، وكذلك قال مجاهد ومقاتل: هو الذي انتهى برده.
ولا تنافي بين القولين. فإن الليل بارد مظلم فمن ذكر برده فقط، أو ظلمته فقط. اقتصر على أحد وصفيه. والظلمة في الآية أنسب لمكان الاستعاذة، فإن الشر الذي يناسب الظلمة أولى بالاستعاذة من البرد الذي في الليل ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح والنور من شر الغاسق الذي هو الظلمة فناسب الوصف المستعاذ به للمعنى المطلوب بالاستعاذة. كما سنزيده تقريرًا عن قريب إن شاء الله.
فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الترمذي من حديث ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة قالت: أخذ النبي ﷺ بيدي فنظر إلى القمر. فقال: «يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهذا أولى من كل تفسير فيتعين المصير إليه.
قيل: هذا التفسير حق ولا يناقض التفسير الأول. بل يوافقه ويشهد بصحته، فإن الله تعالى قال: { وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة }، [287] فالقمر هو آية الليل وسلطانه فهو أيضا غاسق إذا وقب. كما أن الليل غاسق إذا وقب والنبي ﷺ أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب وهذا خبر صدق وهو أصدق الخبر ولم ينف عن الليل اسم الغاسق إذا وقب، وتخصيص النبي ﷺ له بالذكر لا ينفي شمول الاسم لغيره.
ونظير هذا قوله في المسجد الذي أسس على التقوى وقد سئل عنه فقال: «هو مسجدي»، هذا ومعلوم أن هذا لا ينفي كون مسجد قبا مؤسسًا على التقوى، (بل ثبت أن مسجده أحق بالدخول في هذا الاسم، وأنه أحق بأن يكون مؤسسا على التقوى) من ذاك.
ونظيره أيضا قوله في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت. ولكن هؤلاء أحق من دخل في لفظ أهل بيته.
ونظير هذا قوله ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان التمرة والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئًا ولا يفطن له فيتصدق عليه وهذا لا ينفي اسم المسكنة عن الطواف. بل ينفي اختصاص الاسم به وتناول المسكين لغير السانل أولى من تناوله له.
ونظير هذا قوله: ليس الشديد بالصرعة. ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب فإن لا يقتضي نفي الاسم عن الذي يصرع الرجال. ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يملك نفسه عند الغضب أولى. ونظيره الغسق والوقوب وأمثال ذلك. فكذلك قوله في القمر: هذا هو الغاسق إذا وقب لا ينفي أن يكون الليل غاسقًا بل كلاهما غاسق (والنبي ﷺ أشار إلى آية الليل وسلطانه والمفسرون ذكروا الليل نفسه، والله أعلم).
فإن قيل: فما تقولون في القول الذى ذهب إليه بعضهم أن المراد به القمر إذا خسف واسود، وقوله: وقب أي دخل في الخسوف أو غاب خاسفًا؟
قيل: هذا القول ضعيف ولا نعلم به سلفًا، والنبي ﷺ لما أشار إلى القمر وقال: «هذا الغاسق إذا وقب» لم يكن خاسفًا إذ ذاك، وإنما كان وهو مستنير ولو كان خاسفًا لذكرته عائشة. وإنما قالت: نظر إلى القمر وقال هذا هو الغاسق. ولو كان خاسفًا لم يصح أن يحذف ذلك الوصف منه. فإن ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار صفة لا يجوز أن يطلق عليه بدونها لما فيه من التلبيس.
وأيضا فإن اللغة لا تساعد على هذا فلا نعلم أحدًا. قال الفاسق في حال خسوفه. وأيضا فإن الوقوب لا يقول أحد من أهل اللغة أنه الخسوف. وإنما هو الدخول من قولهم وقبت العين إذا غارت وركية وقبار غار ماؤها فدخل في أعماق التراب.
ومنه الوقب للثقب الذي يدخل فيه المحور. وتقول العرب: وقب يقب وقوبًا إذا دخل.
فإن قيل: فلما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن الغاسق هو الثريا إذا سقطت. فإن الأسقام تكثر عند سقوطها وغروبها وترتفع عند طلوعها.
قيل: إن أراد صاحب هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا غرب فباطل. وإن أراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ما فهذا يحتمل أن يدل اللفظ عليه بفحواه ومقصوده وتنبيهه، وأما أن يختص اللفظ به فباطل.
فصل: سبب الاستعاذة من شر الليل
والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل وشر القمر إذا وقب هو أن الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة وفيه تنتشر الشياطين. وفي الصحيح أن النبي أخبر أن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين ولهذا قال: فاكفتوا صبيانكم واحبسوا مواشيكم حتى تذهب فحمة العشاء. وفي حديث آخر: فإن الله يبث من خلقه ما يشاء. والليل هو محل الظلام وفيه تتسلط شياطين الإنس والجن ما لا تتسلط بالنهار؛ فإن النهار نور والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع المظلمة وعلى أهل الظلمة
وروي أن سائلا سأل مسيلمة كيف يأتيك الذي يأتيك فقال في ظلماء حندس، وسأل النبي كيف يأتيك؟ فقال: في مثل ضوء النهار. فاستدل بهذا على نبوته وأن الذي يأتيه ملك من عند الله وأن الذي يأتي مسيلمة شيطان. ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار، فالسحر الليلي عندهم هو السحر القوي التأثير. ولهذا كانت القلوب المظلمة هي محال الشياطين وبيوتهم ومأواهم، والشياطين تجول فيها وتتحكم كما يتحكم ساكن البيت فيه. وكلما كان القلب أظلم كان للشيطان أطوع وهو فيه أثبت وأمكن.
فصل: سر الاستعاذة برب الفلق
من ههنا تعلم السر في الاستعاذة برب الفلق في هذا الموضع، فإن الفلق الصبح الذي هو مبدأ ظهور النور وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل. فيأوي كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب. أو كن أو غار، وتأوي الهوام إلى أحجرتها والشياطين التي انتشرت بالليل إلى أمكنتها ومحالها. فأمر الله عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلها ويقهر عسكرها وجيشها. ولهذا ذكر سبحانه في كل كتاب أنه يخرج عباده من الظلمات إلى النور ويدع الكفار في ظلمات كفرهم. قال تعالى: { الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات }، [288] وقال تعالى: { أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها }، [289] وقال في اعمار الكفار: { أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور }. [290]
وقد قال قبل ذلك في صفات أهل الإيمان ونورهم: { الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء }. [291]
فالإيمان كله نور ومآله إلى نور ومستقره في القلب المضيء المستنير والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة والكفر الشرك كله ظلمة ومآله إلى الظلمات ومستقره في القلوب المظلمة والمقترن بها الأرواح المظلمة.
فتأمل الاستعاذة برب الفلق من شر الظلمة، ومن شر ما يحدث فيها ونزل هذا المعنى على الواقع يشهد بأن القرآن بل هاتان السورتان من أعظم أعلام النبوة وبراهين صدق رسالة محمد ﷺ ومضادة لما جاء به الشياطين من كل وجه. وإن ما جاء به ما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فما فعلوه ولا يليق بهم، ولا يتأتى منهم، ولا يقدرون عليه.
وفي هذا أبين جواب وأشفاه لما يورده أعداء الرسول عليه من الأسئلة الباطلة التي قصر المتكلمون غاية التقصير في دفعها، وما شفوا في جوابها. وإنما الله سبحانه هو الذي شفى وكفى في جوابها فلم يحوجنا إلى متكلم، ولا إلى أصولي، ولا أنظار. فله الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه.
فصل: تفسير الفلق
واعلم أن الخلق كله فلق وذلك أن فلقًا فعل بمعنى مفعول كقبض وسلب وقنص بمعنى مقبوض ومسلوب ومقنوص. والله عز وجل فالق الأصباح، وفالق الحب والنوى، وفالق الأرض عن النبات، والجبال عن العيون، والسحاب عن المطر، والأرحام عن الأجنة، والظلام عن الأصباح، ويسمى الصبح المتصدع عن الظلمة فلقًا وفرقًا. يقال: هو أبيض من فرق الصبح وفلقه.
وكما أن في خلقه فلقًا وفرقًا. فكذلك أمره كله فرقان يفرق بين الحق والباطل. فيفرق ظلام الباطل بالحق كما يفرق ظلام الليل بالإصباح، ولهذا سمى كتابه الفرقان ونصره فرقانًا لتضمنه الفرق بين أوليائه وأعدائه. ومنه فلقه البحر لموسى وسماه فلقًا وفرقا.
فظهرت حكمة الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضع، وظهر بهذا إعجاز القرآن وعظمته وجلالته وأن العباد لا يقدرون قدره، وأنه تنزيل من حكيم حميد.
فصل: شر النفاثات في العقد
الشر الثالث شر النفاثات في العقد. وهذا الشر هو شر السحر، فإن النفاثات في العقد هن السواحر اللاتي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل وهو مرتبة بينهما، والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيقع فيه السحر بإذن الله الكوني القدري، لا الأمر الشرعي.
فإن قيل فالسحر يكون من الذكور والإناث فلم خص الإستعاذة من الإناث دون الذكور؟
قيل في جوابه: إن هذا خرج على السبب الواقع وهو أن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي ﷺ. هذا جواب أبي عبيدة وغيره. وليس هذا بسديد فإن الذي سحر النبي ﷺ هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح.
والجواب المحقق إن النفاثات هنا هن الأرواح والأنفس النفاثات، لا النساء النفاثات، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه إنما يظهر منها. فلهذا ذكرت النفاثات هنا بلفظ التأنيث دون التذكير والله أعلم.
ففي الصحيح عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ طُبَّ حتى إنه ليخيل إليه أنه صنع شيئا وما صنعه، وأنها دعا ربه، ثم قال: أشعرتِ أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال له: فبماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في ذروان، بئر في بني زريق، قالت عائشة رضي الله عنها: فأتاها رسول الله ﷺ ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين. قال: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته، قال: أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا، فأمر بها فدفنت. قال البخاري: وقال الليث وسفيان بن عيينة عن هشام في مشط ومشاقة، ويقال إن المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط والمشاقة من مشاقة الكتان.
قلت: هكذا في هذه الرواية إنه لم يخرجه اكتفاء بمعافاة الله له وشفائه إياه. وقد روى البخاري من حديث سفيان بن عيينة قال: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشام عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، فقال: يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق حليف ليهود وكان منافقا، قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة، قال: وأين؟ قال: في جف طلع ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان، قال: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رءوس الشياطين، قال: فاستخرج، قالت: فقلت: أفلا؟ أي تنشَّرت، فقال: أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
ففي هذا الحديث أنه استخرجه، وترجم البخاري عليه باب هل يستخرج السحر.
وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب ويؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه.
فهذان الحديثان قد يظن في الظاهر تعارضهما فإن حديث عيسى عن هشام عن أبيه الأول فيه أنه لم يستخرجه وحديث ابن جريج عن هشام فيه أنه استخرجه، ولا تنافي بينهما فإنه استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه ثم دفنه بعد أن شفي.
وقول عائشة رضي الله عنها "هلا استخرجته" أي هلا أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوه، فأخبرها بالمانع له من ذلك وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك فيقع الإنكار ويغضب للساحر قومه فيحدث الشر؛ وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر بها فدفنت ولم يستخرجها للناس. فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة، والذي يدل عليه أنه إنما جاء إلى البئر ليستخرجها منه ولم يجيء إليه لينظر إليها ثم ينصرف، إذ لا غرض له في ذلك والله أعلم.
وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته وقد اعتاض على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على هشام وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء قال لأن النبي لا يجوز أن يسحر فإنه يكون تصديقا لقول الكفار: { إن تتبعون إلا رجلا مسحورا }، [292] قالوا وهذا كما قال فرعون لموسى: { إني لأظنك يا موسى مسحورا }. [293] وقال قوم صالح له: { إنما أنت من المسحرين } [294] وقال قوم شعيب له: إنما أنت من المسحرين. قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين.
وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشاما من أوثق الناس وأعلمهم ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن؟ وقد رواه غير هشام عن عائشة رضي الله عنها.
وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء؛ وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله ﷺ وأيامه من المتكلمين.
قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد ابن الأرقم قال سحر النبيَّ ﷺ رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال: فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لذلك عقدا، فأرسل رسول الله عليا فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة فقام رسول الله كأنما أنُشِط من عقال، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه قط.
وقال ابن عباس وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله ﷺ فدنت إليه اليهود فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي وعدة أسنان من مُشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود فنزلت هاتان السورتان فيه.
قال البغوي: وقيل كانت مغروزة بالإبرة، فأنزل الله تعالى هاتين السورتين وهما أحد عشرة آية: سورة الفلق خمس آيات وسورة الناس ست آيات، فكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، فقام النبي كأنما أُنشط من عقال.
قال: وروي أنه لبث فيه ستة أشهر واشتد عليه ثلاثة أيام فنزلت المعوذتان.
قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما، فإن المرض يجوز على الأنبياء وكذلك الإغماء. فقد أغمي عليه في مرضه ووقع حين انفكت قدمه وجُحِش شِقُّه. وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيل كرامته. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس. فليس ببدع أن يبتلى النبي ﷺ من بعض أعدائه بنوع من السحر كما ابتلي بالذي رماه فشجه وابتلي بالذي ألقى على ظهره السَّلى وهو ساجد، وغير ذلك. فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله.
قالوا: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي فقال: يا محمدُ اشتكيتَ؟ فقال: نعم، فقال: باسم الله أَرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفسٍ أو عينِ حاسدٍ اللهُ يشفيك، بسم الله أَرقيك. فعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته ﷺ، وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره.
قالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها لا حجة لكم فيها. أما قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقول قوم صالح له: إنما أنت من المسحرين، فقيل المراد به من له سحر وهي الرئة، أي أنه بشر مثلهم يأكل ويشرب ليس بملك، ليس المراد به السحر. وهذا جواب غير مرض وهو في غاية البعد، فإن الكفار لك يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور ولا يعرف هذا في لغة من اللغات، وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر فقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، أنؤمن لبشر مثلنا، أبعث الله بشرا رسولا. وأما المسحور فلم يريدوا به ذا السحر وهي الرئة، وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع؟ ثم كيف يقول فرعون لموسى إني لأظنك يا موسى مسحورا أفتراه ما علم أنه له سَحرا وأنه بشر. ثم كيف يجيبه موسى بقوله وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولو أراد بالمسحور أنه بشر لصدقه موسى وقال نعم أنا بشر أرسلني الله إليك كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم: إن أنتم إلا بشرا مثلنا، فقالوا: إن نحن إلا بشرا مثلكم، ولم ينكروا ذلك. فهذا الجواب في غاية الضعف.
وأجابت طائفة منهم ابن جرير وغيره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إياه غيره، فالمسحور عنده بمعنى ساحر أي عالم بالسحر. وهذا جيد إن ساعدت عليه اللغة وهو أن من علم السحر يقال له مسحور، ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال، ولا في اللغة وإنما المسحور من سحره غيره كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. وأما من علِم السحر فإنه يقال له ساحر بمعنى أنه عالم بالسحر وإن لم يسحر غيره، كما قال قوم فرعون لموسى: { إن هذا لساحر عليم }. [295] ففرعون قذفه بكونه مسحورا، وقومه قذفوه بكونه ساحرا.
فالصواب هو الجواب الثالث وهو جواب صاحب الكشاف وغيره: أن المسحور على بابه، وهو من سُحِر حتى جُن فقالوا مسحور مثل مجنون، زائل العقل لا يعقل ما يقول، فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول فهو كالمجنون. ولهذا قالوا فيه: { معلم مجنون }. فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه. وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم وهو أنهم قد سُحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين. ولهذا قال تعالى: { انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا } [296]: مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى والمجنون مرة والمسحور أخرى، فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه، فإن أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة، فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلا ولا يقدر على سلوكها. فهذا حال أعداء رسول الله ﷺ معه حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها وهو أبعد خلق الله منها، وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان.
وأما قولكم: إن الأنبياء ينافي حماية الله لهم (أن يسحروا؛ فجوابه أن ما يصيبهم من أذى أعدائهم لهم وأذاهم إياهم لا ينافي حماية الله وصيانته لهم)، فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم، ولتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم، فيعجل تطهير الأرض منهم. فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم، وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة، لا إله غيره ولا رب سواه.
فصل: تأثيرات السحر
وقد دل قوله: { ومن شر النفاثات في العقد }، وحديث عائشة المذكور على تأثير السحر وإن له حقيقة. وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا: إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد. قالوا: وإنما ذلك تخييل لأعين الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك. وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء.
والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقلًا وحلًا وعقدًا وحبًا وبغضًا ونزيفًا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس وكثير منهم قد علمه ذوقًا بما أصيب به منه.
وقوله تعالى: { ومن شر النفاثات في العقد }، دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه. ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرًا كما يقوله هؤلاء لم يكر للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه.
وأيضا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به مع أن هذا تغير في إحساسهم. فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم. وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن. فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركًا والمتصل منفصلًا والميت حيًا، فما المحيل لأن يغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضًا والبغيض محبوبًا، وغير ذلك من التأثيرات.
وقد قال تعالى عن سحرة فرعون: { سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم }، [297] فبين سبحانه أن أعينهم سحرت، وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي وهو الحبال والعصي مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها وهذا كما إذا جر من لا يراه حصيرًا أو بساطًا، فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له مع أنه هو الذي يجره. فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين فقلبتها كتقلب الحية، فظن الرائي أنها تقلبت بأنفسها والشياطين هم الذين يقلبونها. وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأى الحبال والعصي تتحرك وهي ساكنة في أنفسها. ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا، فتارة يتصرف في نفس الرأي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به، وتارة يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها.
وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل الزيبق وغيره، حتى سعت، فهذا باطل من وجوه كثيرة. فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالًا بل حركة حقيقية، ولم يكن ذلك سحرًا لأعين الناس، ولا يسمى ذلك سحرًا بل صناعة من الصناعات المشتركة. وقد قال تعالى: { فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى }، [298] ولو كانت تحركت بنوع حيلة كما يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء، ومثل هذا لا يخفى. وأيضا لو كان ذلك بحيلة كما قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الزئبق وبيان ذلك المحال، ولم يحتج إلى إلقاء العصي لابتلاعها. وأيضا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج فيها إلى الاستعانة بالسحرة، بل يكفي فيها حذاق الصناع ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء. وأيضا فإنه لا يقال في ذلك إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها. وبالجملة فبطلان هذا أظهر من أن يتكلف رده فلنرجع إلى المقصود.
فصل: شر الحاسد إذا حسد
الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد، وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود. فنفس حسده شر يتصل بالمحسود من نفسه وعينه، وإن لم يؤذه بيده ولا لسانه، فإن الله تعالى قال: { ومن شر حاسد إذا حسد }، فحقق الشر منه عند صدور الحسد.
والقرآن ليس فيه لفظة مهملة. ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدًا إلا إذا قام به الحسد كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك. ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد وهو غافل عن المحسود لاه عنه. فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليه ووجهت إليه سهام الحسد من قبله، فيتأذى المحسود بمجرد ذلك؛ فإن لم يستعذ بالله ويتحصن به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات والتوجه إلى الله والاقبال عليه بحيث يدفع عنه من شره بمقدار توجهه وإقباله على الله، وإلا ناله شر الحاسد ولا بد. فقوله تعالى: { إذا حسد } بيان، لأن شره إنما يتحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل.
وقد تقدم في حديث أبي سعيد الصحيح رقية جبريل النبي ﷺ وفيها: بسم الله أَرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. فهذا فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد. ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها إذ لو نظر إليه نظر لاه ساه عنه كما ينظر إلى الأرض والجبل وغيره لم يؤثر فيه شيئًا، وإنما إذا نظر إليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة واتسمت واحتدت، فصارت نفسًا غضبية خبيثة حاسدة أثرت بها تلك النظرة فأثرت في المحسود تأثيرًا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد، فربما أعطبه وأهلكه بمنزلة من فوّق سهمًا نحو رجل عريان فأصاب منه مقتلًا وربما صرعه وأمرضه. والتجارب عند الخاصة والعامة بهذا أكثر من أن تذكر.
وهذه العين إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة وهي في ذلك بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا عضت واحتدت فإنها تتكيف بكيفية الغضب والخبث فتحدت فيها تلك الكيفية السم فتؤثر في الملسوع، وربما قويت تلك الكيفية واشتدت في نوع منها حتى تؤثر بمجرد نظرة فتطمس البصر وتسقط الحبل، كما ذكره النبي ﷺ في الأبتر وذي الطفيتين منها وقال: «اقتلوهما فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل». فإذا كان هذا في الحيات، فما الظن في النفوس الشريرة الغضبية الحاسدة إذا تكيفت بكيفيتها الغضبية واتسمت وتوجهت إلى المحسود بكيفيتها. فلله كم من قتيل وكم من سليب وكم من معافى عاد مضنى على فراشه يقول طبيبه لا أعلم داءه ما هو فصدق، ليس هذا الداء من علم الطبائع، هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها.
وهذا علم لا يعرفه إلا خواص الناس، والمحجوبون منكرون له، ولا يعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إلا من له نصيب من ذوقه. وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى، وهل الانفعال والتأثر وحدوث ما يحدث عنها من الأفعال العجيبة والآثار الغريبة إلا من الأرواح، والأجسام آلتها بمنزلة آلة الصانع. فالصنعة في الحقيقة له، والآلات وسائط في وصول أثره إلى الصنع.
ومن له أدنى فطنة، وتأمل أحوال العالم ولطفت روحه وشاهدت أحوال الأرواح وتأثيراتها وتحريكها الأجسام وانفعالها عنها، كل ذلك بتقدير العزيز العليم خالق الأسباب والمسببات، رأى عجائب في الكون وآيات دالة على وحدانية الله وعظمته وربوبيته. وإن ثم عالمًا آخر تجري عليه أحكام أخر تشهد آثارها وأسبابها غيب عن الأبصار. فتبارك الله رب العالمين وأحسن الخالقين الذي اتقن ما صنع، وأحسن كل شيء خلقه. ولا نسبة لعالم الأجسام إلى عالم الأرواح، بل هو أعظم وأوسع وعجائبه أبهر وآياته أعجب.
وتأمل هذا الهيكل الإنساني إذا فارقته الروح كيف يصير بمنزلة الخشبة أو القطعة من اللحم، فأين ذهبت تلك العلوم والمعارف والعقل وتلك الصنائع الغريبة وتلك الأفعال العجيبة وتلك الأفكار والتدبيرات، كيف ذهبت كلها مع الروح وبقي الهيكل سواء هو والتراب، وهل يخاطبك من الإنسان أو يراك أو يحبك أو يواليك أو يعاديك ويخف عليك ويثقل ويؤنسك ويوحشك إلا ذلك الأمر الذي وراء الهيكل المشاهد بالبصر. فرُب رجل عظيم الهيولا كبير الجثة خفيف على قلبك حلو عندك، وآخر لطيف الخلقة صغير الجثة أثقل على قلبك من جبل؛ وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخفتها وحلاوتها، وكثافة هذا وغلظ روحه ومرارتها. وبالجملة فالعلق والوصل التي بين الأشخاص والمنافرات والبعد إنما هي للأرواح أصلًا والأشباح تبعًا.
فصل: العائن والحاسد
والعائن والحاسد يشتركان في شيء ويفترقان في شيء. فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه. فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضا. ويفترقان في أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد، أو حيوان، أو زرع أو مال، وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. وربما أصابت عينه نفسه، فإن رؤيته للشيء رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين.
وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله تعالى: { وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر }، [299] إنه الإصابة بالعين فأرادوا أن يصيبوا بها رسول الله ﷺ فنظر إليه قوم من العائنين. وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حجته. وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فيعينها، ثم يقول لخادمه: خذ المكتل والدرهم وأتنا بشيء من لحمها، فما تبرح حتى تقع فتنحر.
وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين، أو ثلاثة لا يأكل، ثم يرفع جانب خبائه، فتمر به الإبل فيقول: لم أر كاليوم إبلًا ولا غنمًا أحسن من هذه؛ فما تذهب إلا قليلًا حتى يسقط منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ﷺ بالعين ويفعل به كفعله في غيره، فعصم الله رسوله وحفظه وأنزل عليه: { وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم }، [300] هذا قول طائفة.
وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتيبة: ليس المراد أنهم يصيبونك بالعين كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك.
قال الزجاج: يعني من شدة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. وهذا مستعمل في الكلام يقول القائل نظر إلي نظرًا كاد يصرعني منها. قال: ويدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة فيحدون إليه النظر بالبغضاء.
قلت: النظر الذي يؤثر في المنظور قد يكون سببه شدة العداوة والحسد. فيؤثر نظره فيه كما تؤثر نفسه بالحسد، ويقوى تأثير النفس عند المقابلة، فإن العدو إذا غاب عن عدوه قد يشغل نفسه عنه، فإذا عاينه قبلًا اجتمعت الهمة عليه وتوجهت النفس بكليتها إليه. فيتأثر بنظره حتى إن من الناس من يسقط ومنهم من يحم ومنهم من يحمل إلى بيته، وقد شاهد الناس من ذلك كثيرًا. وقد يكون سببه الإعجاب، وهو الذي يسمونه بإصابة العين، وهو أن الناظر يرى الشيء رؤية إعجاب به أو استعظام فتتكيف روحه بكيفية خاصة تؤثر في المعين. وهذا هو الذي يعرفه الناس من رؤية المعين، فإنهم يستحسنون الشيء ويعجبون منه فيصاب بذلك.
قال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن همام بن منبه [301] قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «العين حق»، ونهى عن الوشم. [302] وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة عن عامر عن عبيد بن رفاعة أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين». [303]
فالكفار كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد العداوة فهو نظر يكاد يزلقه لولا حفظ الله وعصمته. فهذا أشد من نظر العائن، بل هو جنس من نظر العائن، فمن قال إنه من الإصابة بالعين أراد هذا المعنى ومن قال ليس به أراد أن نظرهم لم يكن نظر استحسان وإعجاب، فالقولان حق.
وقد روى الترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ كان يتعوذ من عين الإنسان. فلولا أن العين شر لم يتعوذ منها.
وفي الترمذي من حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير حدثني حابس بن حبة التميمي حدثني أبي أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لا شيء في الهام، والعين حق». [304]
وفيه أيضا من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ يقول: «لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا». قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وهذا حديث صحيح.
والمقصود أن العائن حاسد خاص وهو أضر من الحاسد. ولهذا والله أعلم إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه أعم، فكل عائن حاسد ولا بد. وليس كل حاسد عائنًا. فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين، وهذا من شمول القرآن وإعجازه وبلاغته.
وأصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمنى زوالها، فالحاسد عدو النعم، وهذا الشر هو من نفسه وطبعها، ليس هو شيئًا اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها، بخلاف السحر فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرى واستعانة بالأرواح الشيطانية. فلهذا والله أعلم قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر لأن الاستعاذة من شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن. فالحسد من شياطين الإنس والجن والسحر من النوعين. وبقي قسم ينفرد به شياطين الجن وهو الوسوسة في القلب فذكره في السورة الأخرى، كما سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالحاسد والساحر يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل منه، بل هو أذى من أمر خارج عنه. ففرق بينهما في الذكر في سورة الفلق. والوسواس إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له وقبوله منه، ولهذا يعاقب العبد على الشر الذي يؤذيه به الشيطان من الوساوس التي تقترن بها الأفعال والعزم الجازم، لأن ذلك بسعيه وإرادته، بخلاف شر الحاسد والساحر، فإنه لا يعاقب عليه إذ لا يضاف إلى كسبه ولا إرادته. فلهذا أفرد شر الشيطان في سورة، وقرن بين شر الساحر والحاسد في سورة، وكثيرًا ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبة.
ولهذا اليهود أسحر الناس وأحسدهم، فإنهم لشدة خبثهم فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم. وقد وصفهم الله في كتابه بهذا وهذا فقال: { واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون }. [305]
وللكلام على أسرار هذه الآية وأحكامها وما تضمنته من القواعد والرد على من أنكر السحر وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين المعجزات الذي أنكره من أنكر السحر خشية الالتباس، وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما موضع غير هذا؛ إذ المقصود الكلام على أسرار هاتين السورتين وشدة حاجة الخلق إليهما، وأنه لا يقوم غيرهما مقامهما.
وأما وصفهم بالحسد فكثير في القرآن كقوله تعالى: { أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله }، [306] وفي قوله: { ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق }. [307]
والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما، ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا استدعاء منه للشيطان، لأن الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه، لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم، كما أن إبليس حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسدًا. فالحاسد من جند إبليس، وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه، وربما يعبده من دون الله حتى يقضي له حاجته وربما يسجد له. وفي كتب السحر والسر المكتوم من هذا عجائب. ولهذا كلما كان الساحر أكفر وأخبث وأشد معاداة لله ولرسوله ولعباده المؤمنين كان سحره أقوى وأنفذ. ولهذا سحر عباد الأصنام أقوى من سحر أهل الكتاب، وسحر اليهود أقوى من سحر المنتسبين إلى الإسلام، وهم الذين سحروا رسول الله ﷺ. وفي الموطأ عن كعب قال: كلمات أحفظهن من التوراة لولاها لجعلتني يهود حمارًا، أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ.
والمقصود أن الساحر والحاسد كل منهما قصده الشر، لكن الحاسد بطبعه ونفسه وبغضه للمحسود والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ويأمره بموجبه والساحر بعلمه وكسبه وشركه واستعانته بالشياطين.
فصل: الحاسد من الجن والإنس
وقوله: { ومن شر حاسد إذا حسد }، يعم الحاسد من الجن والإنس، فإن الشيطان وحزبه يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله كما حسد إبليس أبانا آدم وهو عدو لذريته كما قال تعالى: { إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا }، [308] ولكن الوسواس أخص بشياطين الجن والحسد أخص بشياطين الإنس، والوسواس يعمهما كما سيأتي بيانهما. والحسد يعمهما أيضا. فكلا الشيطانين حاسد موسوس. فالاستعاذة من شر الحاسد تتناولهما جميعًا. فقد اشتملت السورة على الاستعاذة من كل شر في العالم. وتضمنت شرورًا أربعة يستعاذ منها: شرًا عامًا وهو شر ما خلق، وشر الغاسق إذا وقب، فهذا نوعان، ثم ذكر شر الساحر والحاسد، وهي نوعان أيضا لأنهما من شر النفس الشريرة، وأحدهما يستعين بالشيطان ويعبده وهو الساحر، وقلما يتأتى السحر بدون نوع عبادة للشيطان وتقرب إليه إما بذبح باسمه أو بذبح يُقصد به هو، فيكون ذبحًا لغير الله، وبغير ذلك من أنواع الشرك والفسوق. والساحر وإن لم يسم هذا عبادة للشيطان فهو عبادة له وإن سماه بما سماه به. فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه لا لاسمه ولفظه. فمن سجد لمخلوق وقال ليس هذا بسجود له، هذا خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة كما أقبلها بالنعم أو هذا إكرام، لم يخرج بهذه الألفاظ عن كونه سجودًا لغير الله، فليسمه بما شاء. وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب، فقد عبده وإن لم يسم ذلك عبادة بل يسميه استخدامًا ما. وصدق، هو استخدام من الشيطان له، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليس خدمة عبادة. فإن الشيطان لا يخضع له ويعبده كما يفعل هو به. والمقصود أن هذا عبادة منه للشيطان، وإنما سماه استخدامًا. قال تعالى: { ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين }. [309] وقال تعالى: { ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون }. [310] فهؤلاء وأشباههم عباد الجن والشياطين وهم أولياؤهم في الدنيا والآخرة، ولبئس المولى ولبئس العشير. فهذا أحد النوعين. والنوع الثاني: من يعينه الشيطان وإن لم يستعن به وهو الحاسد، لأنه نائبه وخليفته، لأن كليهما عدو نعم الله ومنغصها على عباده.
فصل: تقييد الحاسد بقوله إذا حسد
وتأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: { إذا حسد } لأن الرجل قد يكون عنده حسد. ولكن يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما لا بقلبه، ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئًا من ذلك، ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله.
وقيل للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك إخوة يوسف. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر لها بل يعصيها طاعة لله وخوفًا وحياء منه وإجلالًا له أن يكره نعمه على عباده، فيرى ذلك مخافة لله وبغضًا لما يحب الله ومحبة لما يبغضه، فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير له بخلاف ما إذا حقق ذلك وحسد ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح؛ فهذا الحسد المذموم وهذا كله حسد تمني الزوال.
وللحسد ثلاث مراتب أحدها هذه. الثانية تمني استصحاب عدم النعمة فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب فهذا حسد على شيء مقدر، والأول حسد على شيء محقق وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدو عباده وممقوت عند الله تعالى وعند الناس ولا يسود أبدًا ولا يرأس. فإن الناس لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم، فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم أبدًا إلا قهرًا يعدونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها، فهم يبغضونه وهو يبغضهم. والحسد الثالث حسد الغبطة وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه. فهذا لا بأس به، ولا يعاب صاحبه. بل هذا قريب من المنافسة. وقد قال تعالى: { وفي ذلك فليتنافس المتنافسون }، [311] وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس». فهذا حسد غبطة الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه وحب خصال الخير والتشبه بأهلها، والدخول في جملتهم وأن يكون من سباقهم وعليتهم ومصليهم، لا من فساكلهم، فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغبطه. وتمنى دوام نعمة الله عليه. فهذا لا يدخل في الآية بوجه ما. فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود فإنها تتضمن التوكل على الله، والإلتجاء إليه، والاستعاذة به من شر حاسد النعمة فهو مستعيذ بولي النعم وموليها كأنه يقول: يا من أولاني نعمته وأسداها إلي أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبها مني ويزيلها عني وهو حسب من توكل عليه، وكافي من لجأ إليه وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه فلا تستبطىء نصره ورزقه وعافيته. فإن الله بالغ أمر، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ومن لم يخفه أخافه من كل شيء وما خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله قال تعالى: { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون }، [312] وقال: { إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين }، [313] أي يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم. فلا تخافوهم وأفردوني بالمخافة أكفكم إياهم.
فصل: دفع شر الحاسد عن المحسود
ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب:
أحدها: التعوذ بالله من شره والتحصن به، واللجأ إليه، وهو المقصود بهذه السورة والله تعالى سميع لاستعاذته عليم بما يستعيذ منه، والسمع هنا المراد به سمع الإجابة لا السمع العام فهو مثل قوله: سمع الله لمن حمده. وقول الخليل ﷺ: { إن ربي لسميع الدعاء }، ومرة يقرنه بالعلم ومرة بالبصر لاقتضاء حال المستعيذ ذلك، فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله يراه، ويعلم كيده وشره. فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته أي مجيب علم بكيد عدوه يراه ويبصره لينبسط أمل المستعيذ ويقبل بقلبه على الدعاء، وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف وحم السجدة. وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون بالأبصار بلفظ السميع البصير في سورة حم المؤمن فقال: { إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير }، [314] لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر. وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها، وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية والله أعلم.
السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولم يكله إلى غيره. قال تعالى: { وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا }، وقال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس: «احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك»، فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه. ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف ولمن يحذر.
السبب الثالث: الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلًا فما نصره على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله، ولا يستطل تأخيره وبغيه. فإنه كلما بغى عليه كان بغيه جندًا وقوة للمبغي عليه المحسود يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعر فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله، وقد قال تعالى: { ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله }، [315] فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولًا. فكيف بمن لم يستوفه شيئًا من حقه. بل بغى عليه وهو صابر، وما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. وقد سبقت سنة الله أنه لو بغى جبل على جبل جعل الباغي منهما دكًا.
السبب الرابع: التوكل على الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدًا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه، قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال: { ومن يتوكل على الله فهو حسبه }، [316] ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر. كما قال في الأعمال. بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجًا من ذلك وكفاه ونصره. وقد ذكرناه حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه في كتاب الفتح القدسي. وذكرنا هناك فساد من جعله من المقامات المعلولة وإنه من مقامات العوام، وأبطلنا قوله من وجوه كثيرة، وبينا أنه من أجل مقامات العارفين وأنه كلما علا مقام العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشد وأنه على قدر إيمان العبد يكون توكله. وإنما المقصود هنا ذكر الأسباب التي يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر والباغي.
السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه، ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره. فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه، فإذا لم يتعرض له ولا تماسك هو وإياه. بل انعزل عنه لم يقدر عليه. فإذا تماسكا وتعلق كل منهما بصاحبه حصل الشر وهكذا الأرواح سواء. فإذا علق روحها وشبثها به، وروح الحاسد الباغي متعلقة به يقظة ومنامًا لا يفتر عنه وهو يتمنى أن يتماسك الروحان ويتشبثا فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرى عدم القرار ودام الشر حتى يهلك أحدهما، فإذا جبذ روحه عنه وصانها عن الفكر فيه والتعلق به وأن لا يخطره بباله، فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر والاشتغال بما هو أنفع له وأولى به بقى الحاسد الباغي يأكل بعضه بعضًا. فإن الحسد كالنار، فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها بعضًا. وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية، وبين الكيس الفطن، وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه، وتعلق روحه به، ولا يرى شيئًا ألم لروحه من ذلك، ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة اللينة التي رضيت بوكالة الله لها، وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي لنفسها فوثقت بالله، وسكنت إليه، واطمأنت به وعلمت أن ضمانه حق ووعده صدق وإنه لا أوفى بعهده من الله، ولا أصدق منه قيلًا فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وأدوم وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسها، أو نصر مخلوق مثلها لها، ولا يقوى على هذا إلا:
بالسبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه، وأمانيها تدب فيها دبيب تلك الخواطر شيئًا فشيئًا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب، والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه وذكره. كما يذكر المحب التام المحب لمحبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأت جوانحه من حبه فلا يستطيع قلبه انصرافا عن ذكره ولا روحه انصرافا عن محبته، فإذا صار كذلك. فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت إنكاره وقلبه معمورًا بالفكر في حاسده، والباغي عليه والطريق إلى الانتقام منه. والتدبير عليه هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه محبة الله وإجلاله وطلب مرضاته. بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه إياك وحمى الملك اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيها ونزل بها مالك، ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك، وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور. قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال: { فبعزتك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك منهم المخلصين }، [317] قال تعالى: { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان }، [318] وقال: { إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون }، [319] وقال في حق الصديق يوسف ﷺ: { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين }، [320] فما أعظم سعادة من دخل هذاالحصن وصار داخل اليزك. لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به، ولا ضيعة على من آوى إليه، ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منه { ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم }. [321]
السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه، فإن الله تعالى يقول: { وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم }، [322] وقال لخير الخلق وهم أصحاب نبيه دونه ﷺ: { أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم }، [323] فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه، أو لا يعلمه وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منها وما ينساه مما علمه وعمله أضعاف ما يذكره. وفي الدعاء المشهور: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلمه فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب. ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه. فقال له: قف حتى أدخل البيت، ثم أخرج إليك فدخل فسجد لله وتضرع إليه، وتاب وأناب إلى ربه، ثم خرج إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. وسنذكر إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها. فإذا عوفي من الذنوب عوفي من موجباتها. فليس للعبد إذا بغى عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة النصوح، وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منها فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه. ولا بد فما أسعده من عبد وما أبركها من نازلة نزلت به وما أحسن أثرها عليه. ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع فما كل أحد يوفق لهذا لا معرفة ولا إرادة له ولا قدرة عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه. فإن لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسد ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديمًا وحديثًا لكفى به فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدق. وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملًا فيه باللطف والمعونة والتأييد. وكانت له فيه العاقبة الحميدة. فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية وحصن حصين وبالجملة، فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببًا لزوالها. ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن فإنه لا يفتر ولا يني ولا يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود. فحينئذ يبرد أنينه وتنطفي ناره لا أطفأها الله فما حرس العبد نعمة الله عليه بمثل شكرها ولا عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله وهو كفران النعمة وهو باب إلى كفران المنعم. فالمحسن المتصدق يستخدم جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه. فمن لم يكن له جند ولا عسكر ولا عدو، فإنه يوشك أن يظفر به عدوه. وإن تأخرت مدة الظفر والله المستعان.
السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها، ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو طفي نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. فكلما ازداد أذى وشرًا وبغيًا وحسدًا ازددت إليه إحسانًا، وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلًا عن أن تتعاطاه فاسمع الآن قوله عز وجل: { ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم }، [324] { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم }، [325] وقال: { أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون }. [326]
وتأمل حال النبي ﷺ الذي حكى عنه نبينا ﷺ أنه ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم العظيمة إليه. أحدها عفوه عنهم. والثاني استغفاره لهم. والثالث اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. الرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه، فقال: «اغفر لقومي»، كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به: هذا ولدي، هذا غلامي، هذا صاحبي، فهبه لي.
واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعمها به. اعلم أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعفو عنها ويغفرها لك ويهبها لك. ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله، فإذا كنت ترجو هذا من ربك أن يقابل به اساءتك. فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه وتقابل به اساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة. فإن الجزاء من جنس العمل فكما تعمل مع الناس في اساءتهم في حقك بفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقًا. فانتقم بعد ذلك أو اعف وأحسن أو اترك فكما تدين تدان. وكما تفعل مع عباده يفعل معك. فمن تصور هذا المعنى وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من أساء إليه. هذا مع ما يحصل له بذل من نصر الله ومعيته الخاصة كما قال النبي ﷺ للذي شكى إليه قرابته وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه فقال: «لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك». هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم معه على خصمه فإنه كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسيء وذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرًا لا يعرفهم ولا يعرفونه، ولا يريدون منه إقطاعًا ولا خبزًا. هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، وإما أن يفتتكبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه فإنه يذيقه بإحسانه أضاف ما ينال منه بانتقامه. ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة والله هو الموفق المعين بيده الخير كله لا إله غيره. وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه.
وفي الجملة ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مائة منفعة للعبد عاجلة وآجلة سنذكرها في موضع آخر إن شاء الله تعالى.
السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه. فهو الذي يحسن عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه قال تعالى: { وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو }، [327] { وإن يردك بخير فلا راد لفضله }. [328] وقال النبي ﷺ لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك». فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه. وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله. بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلًا واشتغالًا به عن غيره. فيرى أن أعماله فكره في أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده. وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل. والله يتولى حفظه والدفع عنه. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا فإن كان مؤمنًا فالله يدافع عنه ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع، وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة كما قال بعض السلف: من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة، ومن أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة.
فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين قال بعض السلف: من خاف الله خافه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء.
فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقباله عليه وثقته به. وأن لا يخاف معه غيره، بل يكون خوفه منه وحده ولا يرجو سواه. بل يرجوه وحده فلا يعلق قلبه بغيره، ولا يستغيث بسواه، ولا يرجو إلا إياه، ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه، وكل إليه وخذل من جهته فمن خاف شيئًا غير الله سلط عليه، ومن رجا شيئًا سوى الله خذل من جهته وحرم خيره. هذه سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلًا.
فصل: تأثير نفوس الحاسدين وأعينهم والأرواح الشيطانية
فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة المهمة التي لا غنى للعبد عنها في دينه ودنياه ودلت على أن نفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير وعلى أن الأرواح الشيطانية لها تأثير بواسطة السحر، والنفث في العقد. وقد افترق العالم في هذا المقام أربع فرق:
ففرقة أنكرت تأثير هذا وهذا. وهم فرقتان: فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة والجن وأنكرت تأثيرهما البتة، وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. وفرقة أنكرت وجودهما بالكلية، وقالت: لا وجود لنفس الآدمي سوى هذا الهيكل المحسوس وصفاته وأعراضه فقط. ولا وجود للجن والشياطين سوى أعراض قائمة به. وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام. وهو قول شذوذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة.
الفرقة الثانية أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن، وأقرت بوجود الجن والشياطين. وهذا قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم.
الفرقة الثالثة بالعكس أقرت بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن وأنكرت وجود الجن والشياطين، وزعمت أنها غير خارجة عن قوى النفس وصفاتها. وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم، وهؤلاء يقولون إنما يوجد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة. فهي من تأثيرات النفس ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصل وابن سينا وأتباعه على هذا القول. حتى إنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب. ويقولون: إنما هي من تأثيرات النفس في هيولي العالم وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل ليسوا من أتباع الرسل جملة.
الفرقة الرابعة وهم أتباع الرسل. وأهل الحق أقروا بوجود النفس الناطقة المفارقة للبدن، وأقروا بوجود الجن والشياطين وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من صفاتهما وشرهما، واستعاذوا بالله منه وعلموا أنه لا يعيذهم منه ولا يجبرهم إلا الله. فهؤلاء أهل الحق ومن عداهم مفرط في الباطل أو معه باطل وحق. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
فهذا ما يسر الله من الكلام على سورة الفلق.
(سورة الناس)
وأما سورة الناس: فقد تضمنمت أيضا استعاذة ومستعاذًا به ومستعاذًا منه.
فالاستعاذة تقدمت. وأما المستعاذ به فهو الله، "رب الناس، ملك الناس، إله الناس" فذكر ربوبيته للناس وملكه إياهم وإلاهيته لهم. ولا بد من مناسبة في ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان كما تقدم. فنذكر أولا معنى هذه الإضافات الثلاث، ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة.
الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه، ودفع الشر عنهم وحفظهم مما يفسدهم، هذا معنى ربوبيته لهم وذلك يتضمن قدرته التامة ورحمته الواسعة وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة دعواتهم وكشف كرباتهم.
الإضافة الثانية: إضافة الملك فهو ملكهم المتصرف فيهم وهم عبيده ومماليكه. وهو المتصرف لهم المدبر لهم كما يشاء النافذ القدرة فيهم الذي له السلطان التام عليهم فهو ملكهم الحق الذي إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب. وهو مستغاثهم ومعاذهم وملجأهم فلا صلاح لهم، ولا قيام إلا به وبتدبيره. فليس لهم ملك غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدو، ويستصرخون به إذا نزل العدو بساحتهم.
الإضافة الثالثة: إضافة الإلهية فهو إلههم الحق ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه، ولا معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيته ولا في ملكه أحد. فكذلك هو وحده إلههم ومعبودهم فلا ينبغي أن يجعلوا معه شريكًا في إلهيته كما لا شريك معه في ربوبيته وملكه.
وهذه طريقة القرآن يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة، وإذا كان وحده هو ربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد سواه، ولا ملجأ لنا منه إلا إليه، ولا معبود لنا غيره. فلا ينبغي أن يدبر ولا يخاف ولا يرجى ولا يحب سواه، ولا يذل لغيره، ولا يخضع لسواه، ولا يتوكل إلا عليه، لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك وهو ربك فلا رب سواه، أو تكون مملوكه وعبده الحق فهو ملك الناس حقًا وكلهم عبيده ومماليكه أو يكون معبودك وإلهك الذي لا تستغني عنه طرفة عين. بل حاجتك إليه أعظم من حاجتك إلى حياتك وروحك. وهو الإله الحق إله الناس الذي لا إله لهم سواه فمن كان ربهم وملكهم وإلههم، فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره، ولا يستنصروا بسواه، ولا يلجأوا إلى غير حماه فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم ووليهم ومتولي أمورهم جميعًا بربوبيته وملكه وإلاهيته لهم، فكيف لا يلتجىء العبد عند النوازل ونزول عدوه به إلى ربه ومالكه وإلهه. فظهرت مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى الأعداء، وأعظمهم عداوة، وأشدهم ضررًا وأبلغهم كيدًا.
ثم إنه سبحانه كرر الاسم الظاهر ولم يوقع المضمر موقعه فيقول رب الناس وملكهم وإلههم تحقيقًا لهذا المعنى وتقوية له. فأعاد ذكرهم عند كل اسم من أسمائه، ولم يعطف بالواو لما فيها من الإيذان بالمغايرة.
والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصفات حتى كأنها صفة واحدة وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب وأخر الإلهية لخصوصها، لأنه سبحانه إنما هو إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلهًا. فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه وإن كان في الحقيقة لا إله له سواه، ولكن ترك إلهه الحق واتخذ إلهًا غيره، ووسط صفة الملك بين الربوبية والإلًهية، لأن الملك هو المتصرف بقوله وأمره فهو المطاع إذا أمر وملكه لهم تابع لخلقه فملكه من كمال ربوبيته، وكونه إلههم الحق من كمال ملكه فربوبيته تستلزم ملكه وتقتضي وملكه يستلزم إلهيته ويقتضيها. فهو الرب الحق الملك الحق الإله الحق خلقهم بربوبيته وقهرهم بملكه واستعبدهم بإلآهيته، فتأمل هذه الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق رب الناس ملك الناس إله الناس. وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه الحسنى.
أما تضمنها لمعاني أسمائه الحسنى، فإن الرب هو القادر الخالق البارىء المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء، ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء، ويشقي ويعز من يشاء، ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى.
وأما الملك فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى، كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي المتعالي مالك الملك المقسط الجامع إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك.
وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى. ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم، وإن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلي، فقد تضمنت هذه الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى. فكان المستعيذ بها جديرًا بأن يعاذ ويحفظ ويمنع من الوسواس الخناس، ولا يسلط عليه.
وأسرار كلام الله أجل وأعظم من أن تدركها عقول البشر. وإنما غاية أولى العلم الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه وأن باديه إلى الخافي يسير.
فصل: الاستعاذة من الشر
وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها، وهو الشر الداخل في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة. فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له بالسحر والحسد وهو شر من خارج، وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه وهو شر من داخل.
فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه الكف عنه، لأنه ليس من كسبه. والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي. فهذا شر المعائب والأول شر المصائب، والشر كله يرجع إلى العيوب والمصائب ولا ثالث لهما. فسورة الفلق تتضمن الاستعاذة من شر المصيبات، وسورة الناس تتضمن الاستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة.
فصل: الوسواس
إذا عرف هذا. فالوسواس فعلال من وسوس. وأصل الوسوسة الحركة، أو الصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه، فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى إليه، وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد ومن هذا وسوسة الحلى وهو حركته الخفية في الأذن والظاهر والله أعلم أنها سميت وسوسة لقربها وشدة مجاورتها لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الإذن. فقيل: وسوسة الحلى، لأنه صوت مجاور للأذن كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس له.
ولما كانت الوسوسة كلامًا يكرره الموسوس ويؤكده عند من يلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها. فقالوا: وسوس وسوسة، فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه، ونظير هذا ما تقدم من متابعتهم حركة اللفظ بإزاء متابعة حركة معناه كالدوران والغليان والنزوان وبابه.
ونظير ذلك زلزل ودكدك وقلقل وكبكب الشيء، لأن الزلزلة حركة متكررة، وكذلك الدكدكة والقلقلة، وكذلك كبكب الشيء إذا كبه في مكان بعيد فهو يكب فيه كبًا بعد كب كقوله تعالى: { فكبكبوا فيها هم والغاوون }، [329] ومثله رضرضه إذا كرر رضه مرة بعد مرة ومثله ذر ذره إذا ذره شيئًا بعد شيء ومثله صرصر الباب إذا تكرر صريره. ومثله مطمط الكلام إذا مططه شيئًا بعد شيء، ومثله كفكف الشيء إذا كرر كفه وهو كثير.
وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلاثي المضاعف لم يصب، لأن الثلاثي لا يدل على تكرار بخلاف الرباعي المكرر. فإذا قلت ذو الشيء وصر الباب وكف الثوب ورض الحب لم يدل على تكرار الفعل بخلاف ذرذر وصرصر ورضرض ونحوه، فتأمله فإنه مطابق للقاعدة العربية في الحذو بالألفاظ حذو المعاني. وقد تقدم التنبيه على ذلك فلا وجه لإعادته.
وكذلك قولهم عَجَّ العِجلُ، إذا صوت، فإن تابع صوته قالوا: عجعج. وكذلك ثج الماء إذا صب، فإن تكرر ذلك قيل ثجثج. والمقصود أن الموسوس لما كان يكرر وسوسته ويتابعها قيل وسوس.
فصل: هل الوسواس وصف أو مصدر
إذا عرف هذا فاختلف النحاة في لفظ الوسواس هل هو وصف، أو مصدر. على قولين، ونحن نذكر حجة كل قول، ثم نبين الصحيح من القولين بعون الله وفضله.
فأما من ذهب إلى أنه مصدر فاحتج بأن الفعل منه فعلل، والوصف من فعلل إنما هو مفعلل كمد حرج ومسرهف ومبيطر ومسيطر، وكذلك هو من فعل بوزن مفعل كمقطع ومخرج وبابه، فلو كان الوسواس صفة لقيل موسوس، ألا ترى أن اسم الفاعل من زلزل مزلزل لا زلزال، وكذلك من دكدك مدكوك وهو مطرد. فدل على أن الوسواس مصدر وصف به على وجه المبالغة، أو يكون على حذف مضاف تقديره ذو الوسواس. قالوا: والدليل عليه أيضا قول الشاعر: * تسمع للحلي بها وسواسًا * فهذا مصدر بمعنى الوسوسة سواء.
قال أصحاب القول الآخر: الدليل على أنه وصفًا أن فعلل ضربان أحدهما صحيح لا تكرار فيه كدحرج وسرهف وبيطر وقياس مصدر هذا الفعللة كالدحرجة والسرهفة والبيطرة. والفعلان بكسر الفاء كالسرهاف والدحراج والوصف منهه مفعلل كمدحرج ومبيطر.
والثاني فعلل الثنائي المكرر كزلزل ودكدك ووسوس وهذا فرع على فعلل المجرد عن التكرار، لأن الأصل السلامة من التكرار ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفه فمصدره يأتي على الفعللة كالوسوسة والزلزلة والفعلال كالزلزال، وأقيس المصدرين وأولاهما بنوعي فعلل الفعلال لأمرين:
أحدهما أن فعلل مشاكل لا فعل في عدد الحروف، وفتح الأول والثالث والرابع وسكون الثاني. فجعل أفعال مصدر أفعل وفعلال مصدر فعلل ليتشاكل المصدران كما يتشاكل الفعلان. فكان الفعلال أولى بهذا الوزن من الفعللة.
الثاني أن أصل المصدر أن يخالف وزنه وزن فعله، ومخالفة فعلال لفعلل أشد من مخالفة فعللة له فكان فعلال أحق بالمصدرية من فعللة، أو تساويًا في الإطراد مع أن فعللة أرجح في الاستعمال، وأكثر هذا هو الأصل.
وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاء، فقالوا: وسوس الشيطان وسواسًا ووعوع الكلب وعواعًا إذا عوى وعظعظ السهم عظعاظًا. والجاري على القياس فعلال بكسر الفاء أو فعللة وهذا المفتوح نادر، لأن الرباعي الصحيح أصل للمتكرر، ولم يأت مصدر الصحيح مع كونه أصلًا إلا علىفعللة وفعلال بالكسر فلم يحسن بالرباعي المكرر لفرعيته أن يكون مصدره إلا كذلك، لأن الفرع لا يخالف أصله بل يحتذى فيه حذوه. وهذا يقتضي أن لا يكون مصدره على فعلال بالفتح فإن شذ حفظ ولم يزد عليه.
قالوا: وأيضا فإن فعلالًا المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة مصوغة من فعلل المكرر ليكون فيه نظير فعال من الثلاثي، لأنهما متشاركان وزنًا فاقتضى ذلك أن لا يكون لفعلال من المصدرية نصيب كما لم يكن لفعال فيها نصيب. فلذلك استندروا وقوع وسواس ووعواع وعظعاظ مصادر، وإنما حقها أن تكون صفات دالة على المبالغة في مصادر هـذه الأفعال.
قالوا: وإذا ثبت هذا فحق ما وقع منها محتملًا للمصدرية والوصفية أن يحمل على الوصفية حملًا على الأكثر الغالب وتجنبًا للشاذ. فمن زعم أن الوسواس مصدر مضاف إليه ذو تقديرًا. فقوله خارج عن القياس والاستعمال الغالب ويدل على فساد ما ذهب إليه أمران:
أحدهما أن كل مصدر أضيف إليه ذو تقديرًا. فتجرده للمصدرية أكثر من الوصف به كرضى وصوم وفطر وفعلال المفتوح لم يثبت تجرده للمصدرية إلا في ثلاثة ألفاظ فقط وسواس ووعواع وعظعاظ على أن منع المصدرية في هذا ممكن، لأن غاية ما يمكن أن يستدل به على المصدرية قولهم وسوس إليه الشيطان وسواسًا وهذا لا يتعين للمصدرية لاحتمال أن يراد به الوصفية، وينتصب وسواسًا على الحال ويكون حالًا مؤكدة. فإن الحال قد يؤكد بها عاملها الموافق لها لفظًا ومعنى كقوله تعالى: { وأرسلناك للناس رسولًا }، [330] وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره نعم، إنما تتعين مصدرية الوسواس ذا سمع، أعوذ بالله من وسواس الشيطان، ونحو ذلك مما يكون الوسواس فيه إلى مضافًا إلى فاعله كما سمع ذلك في الوسوسة، ولكن أين لكم ذلك. فهاتوا شاهده. فبذلك يتعين أن يكون الوسواس مصدرًا لا بانتصابه بعد الفعل.
الوجه الثاني من دليل فساد من زعم أن وسواسًا مصدر مضاف إليه ذو تقديرًا أن المصدر المضاد إليه ذو تقديرًا لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. بل يلزم طريقة واحدة ليعلم أصالته في المصدرية وإنه عارض الوصفية. فيقال: امرأة صوم وامرأتان صوم ونساء صوم، لأن المعنى ذات صوم وذاتا صوم وذوات صوم وفعلال الموصوف به ليس كذلك. بل يثنى ويجمع ويؤنث فتقول: رجل ثرثار وامرأة ثرثارة ورجال ثرثارون. وفي الحديث: «أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون» وقالوا: ريح رفرافة أي تحرك الأشجار. وريح سفسافة أي تنخل التراب. ودرع فضفاضة أي متسعة. والفعل من ذلك كله فعلل، والمصدر فعللة وفعلال بالكسر، ولم ينقل في شيء من ذلك فعلال بالفتح، وكذلك قالوا تمتام وفأفاء ولضلاض أي ماهر في الدلالة، وفجفاج كثير الكلام وهرهار أي ضحاك وكهكاه ووطواط أي ضعيف وحشحاش وعسعاس أي خفيف وهو كثير ومصدره كله الفعللة والوصف فعلال بالفتح ومثله هفهاف أي خميص ومثله دحداح أي قصير ومثله بجباج أي جسيم وتختاخ أي ألكن وشمشام أي سريع وشيء خشخاش أي مصوت وقعقاع مثله وأسد قضقاض أي كاسر وحية تضناض تحرك لسانها، فقد رأيت فعلال في هذا كله وصفًا لا مصدرًا. فما بال الوسواس أخرج عن نظائره وقياس بابه، فثبت أن وسواسًا وصف لا مصدر كثرثار وتمتام ودحداح وبابه.
ويدل عليه وجه آخر وهو أنه وصفه بما يستحيل أن يكون مصدرًا، بل هو متعين الوصفية وهو الخناس. فالوسواس الخناس وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان وحسن حذف الموصوف ههنا غلبه الوصف حتى صار كالعلم عليه. والموصوف إنما يقبح حذفه إذا كان الوصف مشتركًا يقع اللبس كالطويل والقبيح والحسن ونحوه. فيتعين ذكر الموصوف ليعلم أن الصفة له لا لغيره. فأما إذا غلب الوصف واختص ولم يعرض فيه اشتراك فإنه يجري مجرى الاسم ويحسن حذف الموصوف كالمسلم والكافر والبر والفاجر والقاضي والداني والشاهد والوالي ونحو ذلك. فحذف الموصوف هنا أحسن من ذكره. وهذا التفصيل أولى من إطلاق من منع حذف الموصوف ولم يفصل.
ومما يدل على أن الوسواس وصف لا مصدر أن الوصفية أغلب على فعلال من المصدرية كما تقدم، فلو أريد المصدر لأتي بـ"ذو" المضافة إليه ليزول اللبس وتتعين المصدرية. فإن اللفظ إذا احتمل الأمرين على السواء، فلا بد من قرينة تدل على تعيين أحدهما، فكيف والوصفية أغلب عليه من المصدرية؟
وهذا بخلاف صوم وفطر وبابهما، فإنها مصادر لا تلتبس بالأوصاف. فإذا جرت أوصافًا، علم أنها على حذف مضاف أو تنزيلًا للمصدر منزلة الوصف مبالغة على الطريقتين في ذلك. فتعين أن الوسواس هو الشيطان نفسه وأنه ذات لا مصدر والله أعلم.
فصل: الخناس وبيان اشتقاقه
وأما الخناس فهو فعال من خنس يخنس إذا توارى واختفى. ومنه قول أبي هريرة: لقيني النبي ﷺ في بعض طرق المدينة وأنا جنب فانخنست منه. وحقيقة اللفظ اختفاء بعد ظهور فليست لمجرد الاختفاء ولهذا وصفت بها الكواكب في قوله تعالى: { فلا أقسم بالخنس }، [331] قال قتادة: هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار فتختفي ولا ترى. وكذلك قال علي رضي الله عنه: هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى. وقالت طائفة: الخنس هي الراجعة التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق وهي السبعة السيارة. قالوا: وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء. والخناس هو مأخوذ من هذين المعنيين فهو من الاختفاء والرجوع والتأخر. فإن العبد إذا غفل عن ذكر الله جثم على قلبه الشيطان وانبسط عليه وبذر فيه أنواع الوساوس التي هي أصل الذنوب كلها، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به انخنس وانقبض كما ينخنس الشيء ليتوارى، وذلك الانخناس والانقباض هو أيضا تجمع ورجوع وتأخر عن القلب إلى خارج فهو تأخر ورجوع معه اختفاء.
وخنس وانخنس يدل على الأمرين معًا. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان. فإذا ذكر العبد ربه خنس.
ويقال رأسه كرأس الحية وهو واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه فإذا ذكر الله خنس، وإذا لم يذكره عاد ووضع رأسه يوسوس إليه ويمنيه.
وجيء من هذا الفعل بوزن فعال الذي للمبالغة دون الخانس والمنخنس إيذانًا بشدة هروبه ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر الله. وأن ذلك دأبه وديدنه لا أنه يعرض له ذلك عند ذكر الله أحيانًا. بل إذا ذكر الله هرب وانخنس وتأخر. فإن ذكر الله هو مقمعته التي يقمع بها كما يقمع المفسد والشرير بالمقامع التي تردعه من سياط وحديد وعصي ونحوها.
فذكر الله يقمع الشيطان ويؤلمه ويؤذيه كالسياط والمقامع التي تؤذي من يضرب بها. ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلًا ضئيلًا مضنى مما يعذبه المؤمن ويقمعه به من ذكر الله وطاعته.
وفي أثر عن بعض السلف أن المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي الرجل بعيره في السفر، لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط الذكر والتوجه والاستغفار والطاعة فشيطانه معه في عذاب شديد ليس بمنزلة شيطان الفاجر الذي هو معه في راحة ودعة ولهذا يكون قويًا عاتيًا شديدًا.
فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده واستغفاره وطاعته عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار، فلا بد لكل أحد أن يعذب شيطانه أو يعذبه شيطانه.
وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكررًا لتكريره الوسوسة الواحدة مرارًا حتى يعزم عليها العبد وجاء بناء الخناس على وزن الفعال الذي يتكرر منه نوع الفعل، لأنه كلما ذكر الله انخنس، ثم إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة فجاء بناء اللفظين مطابقًا لمعنييهما.
فصل: الصفة الثالثة للوسواس
وقوله: { الذي يوسوس في صدور الناس }، صفة ثالثة للشيطان. فذكر وسوسته أولًا، ثم ذكر محلها ثانيًا وأنها في صدور الناس. وقد جعل الله للشيطان دخولًا في جوف العبد ونفوذًا إلى قلبه وصدره فهو يجري منه مجرى الدم. وقد وكل بالعبد فلا يفارقه إلى الممات.
وفي الصحيحين من حديث الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله ﷺ معتكفًا فأتيته أزوره ليلًا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلِبني - وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد - فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا فقال النبي ﷺ: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، فقال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءًا - أو قال - شيئًا».
وفي الصحيح أيضا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول ﷺ: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضيت أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضى أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتى لا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، فإذا لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا سجد سجدتي السهو».
ومن وسوسته ما ثبت وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته».
وفي الصحيح أن أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة».
ومن وسوسته أيضا أن يشغل القلب بحديثه حتى ينسيه ما يريد أن يفعله ولهذا يضاف النسيان إليه إضافته إلى سببه، قال تعالى حكاية عن صاحب موسى إنه قال: { إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره }. [332]
وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولم يقل من شر وسوسته لتعم الاستعاذة شره جميعه. فإن قوله: { من شر الوسواس }، يعم كل شره ووصفه بأعظم صفاته وأشدها شرًا وأقواها تأثيرًا وأعمها فسادًا وهي الوسوسة التي هي مبادي الإرادة، فإن القلب يكون فارغًا من الشر والمعصية. فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه. فيصير شهوة ويزينها له ويحسنها ويخيلها له في خيال تميل نفسه إليه، فيصير إرادة، ثم لا يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسي علمه بضررها ويطوي عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعته فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه بها فقط وينسى ما وراء ذلك فتصير الإرادة عزيمة جازمة فيشتد الحرص عليها من القلب. فيبعث الجنود في الطلب فيبعث الشيطان معهم مددًا لهم وعونًا. فإن فتروا حركهم وإن ونوا أزعجهم كما قال تعالى: { ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزًا }، [333] أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًا كلما فتروا أو ونوا أزعجتهم الشياطين وأزتهم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد تقوده إلى الذنب وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة قد رضي لنفسه بالقيادة لفجرة بني آدم وهو الذي استكبر وأبى أن يسجد لأبيهم فلا بتلك النخوة والكبر ولا يرضاه أن يصير قواد الكل من عصى الله كما قال بعضهم:
عجبت من إبليس في تيهه ** وقبح ما أظهر من نخوته
تاه على آدم في سجدة ** وصار قوادًا لذريته
فأصل كل معصية وبلاء، إنما هو الوسوسة. فلهذا وصفه بها لتكون الاستعاذة من شرها أهم من كل مستعاذ منه وإلا فشره بغير الوسوسة حاصل أيضا.
فمن شره إنه لص سارق لأموال الناس فكل طعام أو شراب لم يذكر اسم الله عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف، وكذلك يبيت في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم، ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم. فيدخل سارقًا ويخرج مغيرًا ويدل على عوراتهم فيأمر العبد بالمعصية، ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومنامًا أنه فعل كذا وكذا.
ومن هذا أن العبد يفعل الذنب لا يطلع عليه أحد من الناس فيصبح والناس يتحدثون به وما ذاك إلا أن الشيطان زينه له وألقاه في قلبه، ثم وسوس إلى الناس بما فعل، وألقاه إليهم فأوقعه في الذنب، ثم فضحه به. فالرب تعالى يستره والشيطان يجهد في كشف ستره وفضيحته فيغتر العبد ويقول: هذا ذنب لم يره إلا الله ولم يشعر بأن عدوه ساع في إذاعته وفضيحته. وقلّ من يتفطن من الناس لهذه الدقيقة.
ومن شره أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدًا تمنعه من اليقظة كما في صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان».
ومن شره أنه يبول في أذن العبد حتى ينام إلى الصباح كما ثبت عن النبي ﷺ أنه ذكر عنده رجل نام ليله حتى فأصبح قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه». رواه البخاري.
ومن شره أنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلها فما من طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه يمنعه بجهده أن يسلكه فإن خالفه وسلكه ثبطه فيه وعوقه وشوش عليه بالمعارضات والقواطع، فإن عمله وفرغ منه قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته.
ويكفي من شره أنه أقسم بالله ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم، وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة، ثم لم يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين، ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض وقصد أن تكون الدعوة له. وأن يعبد من دون، الله فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلامه من الأرض.
ويكتفي من شره أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق في النار فرد الله كيده عليه، وجعل النار على خليله بردًا وسلامًا، وتصدى للمسيح ﷺ حتى أراد اليهود قتله وصلبه فرد الله كيده، وصان المسيح ورفعه إليه، وتصدى لزكريا ويحيى حتى قتلا. واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض ودعوى أنه ربهم الأعلى وتصدى للنبي ﷺ وظاهر الكفار على قتله بجهده والله تعالى يكتبه ويرده خاسئًا، وتفلت على النبي ﷺ بشهاب من نار يريد أن يرميه به وهو في الصلاة. فجعل النبي ﷺ يقول: «ألعنك بلعنة الله». وأعان اليهود على سحرهم للنبي ﷺ.
فإذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته ولا يمكن حصر أجناس شره فضلًا عن آحادها. إذ كل شر في العالم فهو السبب فيه. ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر:
الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه وهو أول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى يناله منه. فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه.
فإن يأس منه من ذلك وكان ممن سبقت له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد وهي ذنب لا يتاب منه وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعا إلى خلاف ما جاؤوا به وهي باب الكفر والشرك فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيضا نائبه وداعيًا من دعاته.
فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان الجد ممن سبق له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر وهي الكبائر على اختلاف أنواعها فهو أشد حرصًا على أن يوقعه فيها. ولا سيما إن كان عالمًا متبوعًا فهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه، ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس، ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينًا وتقربًا بزعمه إلى الله تعالى وهو نائب إبليس، ولا يشعر فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها. فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم. ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به وذنوب هذا. ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء فإنها ظلم منه لنفسه إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته، وبدل سيئاته حسنات، وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعورتهم وقصد لفضيحتهم. والله سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس.
فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة وهي الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاجها كما قال النبي ﷺ إياكم ومحقرات الذنوب فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض. وذكر حديثًا معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتى أوقدوا نارًا عظيمة فطبخوا واشتووا، ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالًا منه.
فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة وهي إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها.
فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظًا لوقته شحيحًا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب. نقله إلى المرتبة السادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل. فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له. إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. قل من يتنبه لهذا من الناس فإنه إذا رأى فيه داعيًا قويًا ومحركًا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان، فإن الشيطان لا يأمر بخير، ويرى أن هذا خير فيقول: هذا الداعي من الله، وهو معذور؛ ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير، إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت بها خيرًا أعظم من تلك السبعين بابًا وأجل وأفضل.
وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول ﷺ وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم، ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول ﷺ ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض. وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم والله يمن بفضله على من يشاء من عباده.
فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه، وقصد إخماله واطفاءه ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره وليمنع الناس من الانتفاع به فيبقى سعيه في تسليط المبطللين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر ولا يني. فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب، ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها أسر أو أصيب. فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله.
فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه وعظيم منفعته واجعله ميزانك تزن به الناس، وتزن به الأعمال فإنه يطلعك على حقائق الوجود ومراتب الخلق والله المستعان وعليه التكلان ولو لم يكن في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعًا لمن تدبره ووعاه.
فصل: الصدور والقلوب
وتأمل السر في قوله تعالى: { يوسوس في صدور الناس }، ولم يقل في قلوبهم والصدر هو ساحة القلب وبيته. فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع في الصدر، ثم تلج في القلب فهو بمنزلة الدهليز له، ومن القلب تخرج الأوامر والإرادات إلى الصدر، ثم تتفرق على الجنود.
ومن فهم هذا فهم قوله تعالى: { وليبتلي الله ما في صدوركم و ليمحص ما في قلوبكم } [334] فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقى ما يريد إلقاءه إلى القلب فهو موسوس في الصدر ووسوسته واصلة إلى القلب، ولهذا قال تعالى: { فوسوس لهما الشيطان }، [335] ولم يقل فيه. لأن المعنى. أنه ألقى إليه ذلك وأوصله فيه فدخل في قلبه.
فصل: الجار والمجرور من الجنة والناس
وقوله تعالى: { من الجنة والناس }، اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور بم يتعلق.
فقال الفراء وجماعة هو بيان للناس الموسوس في صدورهم والمعنى يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس أي الموسوس في صدورهم قسمان: إنس وجن.
فالوسواس يوسوس للجني كما يوسوس للانسي. وعلى هذا القول فيكون من الجنة والناس نصب على الحال، لأنه مجرور بعد معرفة على قول البصريين، وعلى قول الكوفيين نصب بالخروج من المعرفة هذه عبارتهم ومعناها أنه، لما لم يصلح أن يكون نعتًا للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه نصبًا. والبصريون يقدرونه حالًا أي كائنين من الجنة والناس، وهذا القول ضعيف جدًا لوجوه:
أحدها: أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدور الجن ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي، ويجري منه مجراه من الإنسي. فأي دليل يدل على هذا حتى يصح حمل الآية عليه.
الثاني: أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا فإنه قال الذي يوسوس في صدور الناس. فكيف يبين الناس بالناس؟ فإن معنى الكلام على قوله يوسوس في صدور الناس الذين هم، أو كائنين من الجنة والناس. أفيجوز أن يقال في صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم؟ وهذا ما لا يجوز، ولا هو استعمال فصيح.
الثالث: أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين جنة وناس وهذا غير صحيح فإن الشيء لايكون قسيم نفسه. الرابع: أن الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه لا أصلًا ولا اشتقاقًا ولا استعمالًا ولفظهما يابى ذلك، فإن الجن إنما سمو جنًا من الاجتنان وهو الاستتهار، فهم مستترون عن أعين البشر فسموا جنًا لذلك من قولهم جنه الليل، وأجنه إذا ستره وأجن الميت إذا ستره في الأرض قال:
ولا تبك ميتًا بعد ميت أجنه ** عليٌّ وعباسٌ وآلُ أبي بكرِ
يريد النبي ﷺ.
ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه قال تعالى: { وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم }، [336] ومنه المجن لاستتار المحارب به من سلاح خصمه، ومنه الجنة لاستتار داخلها بالأشجار ومنه الجنة بالضم لما يقي الإنسان من السهام والسلاح، ومنه المجنون لاستتار عقله.
وأما الناس فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى وبينهما اشتقاق أوسط وهو عقد تقاليب الكلمة على معنى واحد والإنس والإنسان مشتق من الإيناس وهو الرؤية والإحساس ومنه قوله: { آنس من جانب الطور نارًا }، [337] أي رآها ومنه: { فإن آنستم منهم رشدًا }، [338] أي أحسستموه ورأيتموه. فالإنسان سمي إنسانًا، لأنه يونس أي يرى بالعين.
والناس فيه قولان:
أحدهما أنه مقلوب من أنس وهو بعيد والأصل عدم القلب.
والثاني وهو الصحيح أنه من النوس وهو الحركة المتتابعة، فسمي الناس ناسًا للحركة الظاهرة والباطنة كما سمي الرجل حارث وهمام وهما أصدق الأسماء كما قال النبي ﷺ، لأن كل أحد له هم وإرادة وهي مبدأ وحرث وعمل هو منتهى فكل أحد حارث وهمام. والحرث والهم حركتا الظاهر والباطن وهو حقيقة النوس وأصل ناس نوس تحركت الواو وقبلها فتحة فصارت ألفًا هذان هما القولان المشهوران في اشتقاق الناس.
وأما قول بعضهم أنه من النسيان وسمي الإنسان إنسانًا لنسيانه، وكذلك الناس سموا ناسًا لنسيانهم، فليس هذا القول بشيء وأين النسيان الذي مادته ن س ي إلى الناس، الذي مادته ن و س، وكذلك أين هو من الإنس الذي مادته ا ن س. وأما إنسان فهو فعلان من أ ن س والألف والنون في آخره زائدتان لا يجوز فيه غير هذا البتة، إذ ليس في كلامهم أنسن حتى لا يكون إنسانًا إفعالًا منه. ولا يجوز أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين إذ ليس في كلامهم انفعل. فيتعين أنه فعلان من الإنس، ولو كان مشتقًا من نسي لكان نسيانًا لا إنسانًا.
فإن قلت فهلا جعلته إفعلالًا وأصله إنسيان كليلة إصحيان، ثم حذفت الياء تخفيفًا فصار إنسانًا.
قلت: يأبى ذلك عدم إفعلال في كلامهم وحذف الياء بغير سبب ودعوى ما لا نظير له، وذلك كله فاسد على أن الناس قد قيل إن أصله الأناس فحذفت الهمزة فقيل الناس. واستدل بقول الشاعر:
إن المنايا يطلعـ ** ـن على الأناس الغافلينا
ولا ريب أن أناسا فعال، ولا يجوز فيه غير ذلك البتة. فإن كان أصل ناس أناسًا فهو أقوى الأدلة على أنه من أنس ويكون الناس كالإنسان سواء في الاشتقاق ويكون وزن ناس على هذا القول عال لأن المحذوف فاؤه وعلى القول الأول يكون وزنه فعل لأنه من النوس. وعلى القول الضعيف يكون وزنه فلع، لأنه من نسي فقلبت لامه إلى موضع العين فصار ناسًا ووزنه فلعًا.
والمقصود أن الناس اسم لبني آدم فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح أن يكون من الجنة والناس بيانًا لقوله: { في صدور الناس }، وهذا واضح لإخفاء فيه.
فإن قيل: لا محذور في ذلك، فقد أطلق على الجن اسم الرجال كما في قوله تعالى: { وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن }، فإذا أطلق عليهم اسم الرجال لم يمتنع أن يطلق عليهم اسم الناس.
قلت: هذا هو الذي غر من قال: إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآية. وجواب ذلك أن اسم الرجال. إنما وقع عليهم وقوعًا مقيدًا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس، ولا يلزم من هذا أن يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقًا. وأنت إذا قلت: إنسان من حجارة أو رجل من خشب ونحو ذلك، لم يلزم من ذلك وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب. وأيضا فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس وذلك، لأن الناس والجنة متقابلان، وكذلك الإنس والجن. فالله سبحانه يقابل بين اللفظين كقوله: { يا معشر الجن والإنس }، [339] وهو كثير في القرآن. وكذلك قوله: { من الجنة والناس }، يقتضي أنهما متقابلان فلا يدخل أحدهما في الآخر بخلاف الرجال والجن فإنهما لم يستعملا متقابلين فلا يقال الجن والرجال، كما يقال الجن والإنس. وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس، لأنه قابل بين الجنة والناس فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخرة. فالصواب القول الثاني وهو أن قوله: { من الجنة والناس } بيان للذي يوسوس وأنهم نوعان: إنس وجن، فالجني يوسوس في صدور الإنس، والإنسي أيضا يوسوس إلى الأنسي.
فالموسوس نوعان: إنس وجن. فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب وهذا مشترك بين الجن والإنس وإن كان إلقاء الإنسي ووسوسته، إنما هي بواسطة الأذن والجني لا يحتاج إلى تلك الواسطة، لأنه يدخل في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم.
على أن الجني قد يتمثل له ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي كما في البخاري. عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة من عند أنفسهم». فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن.
ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني قال تعالى: { وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا }، [340] فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطله ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله فشياطين الإنس والجن يشتركان في الوحي الشيطاني، ويشتركان في الوسوسة. وعلى هذا فتزول تلك الإشكالات والتعسفات التى ارتكبها أصحاب القول الأول.
وتدل الآية على الاستعاذة من شر نوعي الشياطين شياطين الإنس والجن. وعلى القول الأول إنما تكون الاستعاذة من شر شياطين الجن فقط. فتأمله فإنه بديع جدًا.
فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين وله الحمد والمنة. وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمط فما ذلك على الله بعزيز. والحمد لله رب العالمين ونختم الكلام على السورتين بذكر:
قاعدة نافعة: اعتصام العبد من الشيطان
فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه.
وذلك عشرة أسباب:
أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطان. قال تعالى: { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم }، [341] وفي موضع آخر: { إنه سميع عليم }، [342] وقد تقدم أن السمع المراد به ههنا. سمع الإجابة لا مجرد السمع العام.
وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة. هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصها. وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حم لاقتضاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه. فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه. وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، كما قال الله تعالى.
والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا. بل يريه أن هذا ذل وعجز، ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه، وأن لا يسيء إليه ولا يحسن فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله وما عنده على حظه العاجل، فكان المقام مقام تأكيد وتحريض فقال فيه: { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم }. [343]
وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان. بل بالإعراض. وهذا سهل على النفوس غير مستعصي عليها. فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان فقال: { وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم }، [344] وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين، وبين قوله في حم المؤمن: { فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير }.
وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسًا مع النبي ﷺ ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد».
الحرز الثاني: قراءة هاتين السورتين فإن لهما تاثيرًا عجيبًا في الاستعاذة بالله من شره ودفعه والتحصن منه. ولهذا قال النبي ﷺ: «ما تعوذ المتعوذون بمثلهما». وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم، وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. وتقدم قوله ﷺ: «إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثًا حين يمسي وثلاثًا حين يصبح كفته من كل شيء».
الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان فأتى آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ. فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي ﷺ: «صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان».
وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله وتأييده.
الحرز الرابع: قراءة سورة البقرة. ففي الصحيح من حديث سهل عن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا وأن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان».
الحرز الخامس: خاتمة سورة البقرة فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان».
الحرز السادس: أولى سورة حم المؤمن إلى قوله: { إليه المصير } [345] مع آية الكرسي، ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة، عن زرارة بن مصعب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ حم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح»، وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه. فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي، وهو محتمل على غرابته.
الحرز السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة، ففي الصحيحين من حديث سمى مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك»، فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه.
الحرز الثامن: وهو من أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل. ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن النبي ﷺ قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطىء بها»، فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تامرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدِ إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمرَكم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمرَكم أن تذكروا الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعًا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي ﷺ: «وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع». ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من حثاء جهنم». فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام قال: «وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله». قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح، وقال البخاري: الحارث الأشعري له صحبة، وله غير هذا الحديث. [346]
فقد أخبر النبي ﷺ في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل أعوذ برب الناس، فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي وساوس الشر كله فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل.
الحرز التاسع: الوضوء والصلاة وهذا من أعظم ما يتحرز به منه. ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة. فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رايتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض، وفي أثر آخر إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء»، فأما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة. فإنها نار والوضوء يطفئها. والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه.
الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة. فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان، ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به. والفكرة في الظفر به. فمبدأ الفتنة من فضول النظر كما في المسند عن النبي ﷺ أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه، أو كما قال ﷺ. فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر:
كل الحوادث مبداها من النظر ** ومعظم النار من مستصغر الشرر
كم نظرة فتكت في قلبها صاحبها ** فتك السهام بلا قوس ولا وتر
وقال الآخر:
وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا ** لقلبك يومًا أتعبتك المناظر
رأيت الذي لا كله أنت قادر ** عليه ولا عن بعضه أنت صابر
وقال المتنبي:
وأنا الذي جلب المنية طرفه ** فمن المطالب والقتيل القاتل
ولي في أبيات:
يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدًا ** أنت القتيل بما ترمي فلا تصب
وباعث الطرف يرتاد الشفاء له ** توقه إنه يرتد بالعطب
ترجو الشفاء بأحداق بها مرض ** فهل سمعت ببرء جاء من عطب
ومفنيًا نفسه في أثر أقبحهم ** وصفًا للطخ جمال فيه مستلب
وواهبًا عمره في مثل ذا سفها ** لو كنت تعرف قدر العمر لم تهب
وبائعًا طيب عيش ماله خطر ** بطيف عيش من الآلام منتهب
غبنت والله غبت فاحشًا فلو اسـ ** ترجعت ذا العقد لم تغبن ولم تخب
وواردًا صفو عيش كله كدر ** أمامك الورد صفوًا ليس بالكذب
وحاطب الليل في الظلماء منتصبًا ** لكل داهية تدن من العطب
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب ** وضاع وقتك بين اللهو واللعب
وشمس عمرك قد حان الغروب لها ** والفيء في الأفق الشرقي لم يغب
وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت ** عن أفقه ظلمات الليل والسحب
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ** ورسل ربك قد وافتك في الطلب
ما في الديار وقد سارت ركائب من ** تهواه للصب من سكنى ولا أرب
فافرش الخد ذياك التراب وقل ** ما قاله صاحب الأشواق في الحقب
ما ربع مية محفوفًا يطوف به ** غيلان أشهى له من ربعك الخرب
ولا الخدود وإن أدمين من ضرج ** أشهى إلى ناظري من خدك الترب
منازلًا كان يهواها ويألفها ** أيام كان منال الوصل عن كثب
فكلما جليت تلك الربوع له ** يهوي إليها هوى الماء في صبب
أحيى له الشوق تذكار العهود بها ** فلو دعا القلب للسلوان لم يجب
هذا وكم منزل في الأرض يألفه ** وما له في سواها الدهر من رغب
ما في الخيام أخو وجد يريحك أن ** بثثته بعض شأن الحب فاغترب
وأسر في غمرات الليل مهتديًا ** بنفحة الطيب لا بالنار والحطب
وعاد كل أخي جبن ومعجزة ** وحارب النفس لا تلقيك في الحرب
وخذ لنفسك نورًا تستضيء به ** يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب
فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه ** إلا بنور ينجي العبد في الكرب
والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء.
وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشر كلها مداخل للشيطان. فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها وكم من حرب جرتها كلمة واحدة. وقد قال النبي ﷺ لمعاذ: «وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم». وفي الترمذي أن رجلًا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة طوبى له، فقال النبي ﷺ: «فما يدريك، فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه».
وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشيطان فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسئمان بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلىء لم يبق فيه إرادة للطعام، وأما العين واللسان فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات. وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان.
وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر. فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرًا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام وكم من طاعة حال دونها. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرًا عظيمًا. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا جاء في بعض الآثار ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم، وقال النبي ﷺ: «ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطن». ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، واذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد. فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات. وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت.
وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات. وهي في القلوب لا تزول بفضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر.
أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه في اليوم والليلة. فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر وهم العلماء بالله، وأمره ومكايد عدوه، وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب من مخالطتهم الربح كله.
القسم الثاني: من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحًا فلا حاجة لك في خلطته وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش، وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للإدواء ونحوها، فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من:
القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا. ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف.
ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربًا عليك فإذا فارقك سكن الألم.
ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها. بل إن تكلم فكلامه كالعصى تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به. فهو يحدث من فيه كلما تحدث، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا يطاق حملها، ولا جرها على الأرض.
ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر.
ورأيت يومًا عند شيخنا قدس الله روحه رجلًا من هذا الضرب والشيخ يحمله، وقد ضعفت القوى عن حمله، فالتفت إلي وقال مجالسة الثقيل: حمى الربع، ثم قال، لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة، أو كما قال. وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة.
ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجًا ومخرجًا.
القسم الرابع: من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم. فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس، لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله ﷺ الداعون إلى خلافها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا. فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرًا والمنكر معروفًا، إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله ﷺ قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتّنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا: أنت من أهل البدع المضلين. وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينه وبين جيفة الدنيا قالوا: أنت من الملبّسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم، وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم فإنه عينُ كمالِكَ، كما قال:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص ** فهي الشهادة لي بأني فاضل
وقال آخر:
وقد زادني حبًا لنفسي أنني ** بغيض إلى كل امرىء غير طائل
فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم. وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة، واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشيطان. فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على نفسه أبواب جهنم، وفتح عليها أبواب الرحمة وانغمر ظاهره وباطنه. ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء فعند الممات يحمد القوم التقي، وفي الصباح يحمد القوم السري والله الموفق لا رب غيره، ولا إله سواه.
هامش
أحمد والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
بدائع الفوائد
المجلد الأول | المجلد الثاني | المجلد الثالث | المجلد الرابع
تصنيف:
بدائع الفوائد
=========
[التكاثر: 5]
[الواقعة: 95]
[طه: 39]
في النتائج: ولم يعذروا.
صحيح مسلم
[ص: 45]
[ص: 75]
[طه: 39]
[القمر: 14]
[هود: 37]
[طه: 41]
[طه: 39]
[القيامة: 18]
[يوسف: 3]
[آل عمران: 28، 30]
[الزمر: 56]
[العلق: 15 - 16]
[النحل: 73]
[الأحقاف: 30]
[الشورى: 52]
[الأنعام: 87]
[التوبة: 92]
[الفتح: 2]
[الشورى: 52]
[الأنعام: 87]
[الأنعام: 161]
[الشورى: 52]
[التوبة: 33]
[الحديد: 25]
[آل عمران: 1 - 4]
[الأنفال: 41]
[الأنبياء: 84]
[الصافات: 117]
[الصافات: 118]
[الأحقاف: 30]
[الأحقاف: 9]
[الاحقاف: 30]
[البقرة: 274]
[الزمر: 33]
[الأحقاف: 13]
[الأحقاف: 78، 79، 80]
[الجن: 10]
[الكهف: 82]
[البقرة: 187]
[البقرة: 275]
[المائدة: 3]
[الأنعام: 151]
[النساء: 23]
[النساء: 24]
[المائدة: 3]
[البقرة: 152]
[الفتح: 2]
[الشورى: 52]
[الأنعام: 161]
[الأعراف: 43]
[الإسراء: 9]
[الإنسان: 6]
[الحج: 25]
[النساء: 69]
[البقرة: 15]
[إبراهيم: 34]
[البقرة: 122]
[النحل: 81 - 83]
[البقرة: 122]
[آل عمران: 197]
[البقرة: 217]
[العلق: 16]
[البقرة: 90]
[النحل: 88]
[الملك: 3 - 4]
[البقرة: 9]
[المائدة: 60]
[المائدة: 78 - 80]
[المائدة: 77]
[المائدة: 72]
[المؤمنون: 1 - 3]
[الأعلى: 1 - 3]
[طه: 5]
[المؤمنون: 115]
[الأنعام: 38]
[الأنعام: 37]
[فصلت: 17]
[الشورى: 52]
[النحل: 93]
[النحل: 37]
[القصص: 56]
[الشورى: 52]
[يونس: 9]
[الأعراف: 43]
[الصافات: 23]
[البقرة: 201]
[البروج: 5]
[آل عمران: 97]
[البقرة: 183]
[المائدة: 3]
[الأنعام: 151]
[آل عمران: 96 - 97]
[الحج: 26]
[البقرة: 217]
أهل السنن
[الأعراف: 70]
[البقرة: 222]
[الأنعام: 128]
[التغابن: 10]
[البقرة: 184]
[الحج: 37]
[البقرة: 93]
[الأعراف: 155]
[نوح: 4، الأحقاف: 31]
[البقرة: 58]
[آل عمران: 147]
[الصف: 12]
[البقرة: 271]
[نوح: 17]
[الأعراف: 75]
[البقرة: 61]
[البقرة: 146]
[التوبة: 101]
[الأنفال: 60]
[المطففين: 3]
[المطففين: 2]
[البقرة: 286]
[المجادلة: 1]
[آل عمران: 181]
[البقرة: 104]
[المائدة: 41، 42]
[التوبة: 47]
[الأحقاف: 12]
[النساء: 164]
[الأعراف: 144]
[القصص: 7]
[المائدة: 111]
[الأعراف: 143]
[مريم: 52]
[يس: 71]
[الإنسان: 9]
[الفرقان: 62]
تغير حركة الرَّوِي
[الواقعة: 55]
[الشعراء: 155]
[آل عمران: 13]
[الأحزاب: 10]
[البقرة: 185]
[المزمل: 2]
[يوسف: 43]
[الأحقاف: 46]
[المائدة: 48]
[آل عمران: 3]
[الأنعام: 92]
[البقرة: 91]
[فاطر: 31]
[غافر: 67]
[هود: 64، الأعراف: 73]
[مريم: 17]
[الواقعة: 91]
[الفرقان: 63]
[القصص: 55]
[مريم: 33]
[النمل: 59]
[الأحزاب: 56]
[الزمر: 29]
[الأنفال: 61]
[الإسراء: 111]
[الصافات: 180 - 181]
[الصافات: 109]
[الصافات: 79]
[الصافات: 130]
[هود: 48]
[يس: 57 - 58]
[يس: 58]
[الأحزاب: 44]
[الرعد: 23]
تحرفت في الأصول
[الواقعة: 90 - 91]
[الصافات: 109]
[الصافات: 79]
[الرعد: 25]
[الأنبياء: 18]
[الواقعة: 91]
من أمثال العرب
[البقرة: 221]
[محمد: 21]
[البقرة: 88]
[المائدة: 13]
[آل عمران: 159]
[المائدة: 13]
[هود: 48]
[الشرح: 5 - 6]
[الفرقان: 63]
[الفرقان: 63]
[القصص: 55]
[يوسف: 53]
[النازعات: 40]
[الروم: 47]
[الحجر: 92]
[مريم: 68]
[إبراهيم: 13]
[ص: 84 - 85]
[آل عمران: 195]
[الأعراف: 6]
[يس: 1]
[الصافات: 171 - 173]
[هود: 191]
[طه: 129، فصلت: 45، الشورى: 14]
[المائدة: 8]
[التوبة: 72]
[طه: 47 - 48]
[طه: 47]
[النمل: 59]
[الصافات: 79]
[الصافات: 109]
[الصافات: 120]
[الصافات: 130]
[الصافات: 180 - 181]
[الأنبياء: 112]
[المؤمنون: 118]
[الأعراف: 89]
[هود: 73]
[الصافات: 109]
[الصافات: 79]
[الصافات: 130]
[الرعد: 24]
[ص: 78]
[الحجر: 35]
[التوبة: 98]
أبو داود في المراسيل والبيهقي في الكبرى من مرسل عمرو بن شعيب.
[الزمر: 71]
[الزمر: 73]
[آل عمران: 164]
[الحجرات: 17]
[الأنعام: 149]
[إبراهيم: 34]
[البقرة: 201]
[آل عمران: 171]
[هود: 73]
[هود: 9]
[الفرقان: 48]
[غافر: 7]
[الأعراف: 156]
[مريم: 31]
[الأعراف: 54]
[الملك: 1]
[المؤمنون: 14]
[الزخرف: 85]
[الفرقان: 1]
[الفرقان: 10]
[الفرقان: 61]
[الأعراف: 54]
[الزخرف: 85]
[آل عمران: 147]
[الأعراف: 23]
[القصص: 16]
[هود: 47]
[الحشر: 1، الصف: 1]
[الأعراف: 54]
[المؤمنون: 14]
[الفرقان: 1]
[المائدة: 114]
[المائدة: 112]
[الجن: 6]
[الرعد: 11]
[الفجر: 24]
[الزمر: 56]
[آل عمران: 193]
[القلم: 36]
[الجاثية: 21]
[ص: 28]
[الفرقان: 55]
[الكهف: 50]
[البقرة: 254]
[النساء: 160]
[الأنعام: 146]
[الزخرف: 76]
[الجن: 10]
[الكهف: 79]
[الكهف: 82]
[الحجرات: 7]
[آل عمران: 14]
[الشعراء: 78 - 82]
[فاطر: 32]
[الشورى: 14]
[الأعراف: 169]
أحمد وأبو يعلى
[الإسراء: 78]
[ص: 57]
[النبأ: 24 - 25]
[الإسراء: 12]
[البقرة: 257]
[الأنعام: 122]
[النور: 40]
[النور: 35]
[الإسراء: 47]
[الإسراء: 101]
[الشعراء: 153]
[الشعراء: 34]
[الإسراء: 48]
[الأعراف: 116]
[طه: 66]
[القلم: 51]
[القلم: 51]
تحرف في بعض النسخ إلى "هشام بن قتيبة".
مصنف عبد الرزاق وصحيفة همام.
أحمد والترمذي وابن ماجه.
أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
[البقرة: 102]
[النساء: 54]
[البقرة: 109]
[فاطر: 6]
[يس: 60]
[سبأ: 40، 41]
[المطففين: 26]
[النحل: 98 - 100]
[آل عمران: 175]
[غافر: 56]
[الحج: 60]
[الطلاق: 3]
[ص: 82]
[الحجر: 42]
[النحل: 99]
[يوسف: 24]
[الجمعة: 4]
[الشورى: 30]
[آل عمران: 165]
[فصلت: 35]
[الأعراف: 200]
[القصص: 54]
[الأنعام: 17]
[يونس: 107]
[الشعراء: 94]
[النساء: 79]
[التكوير: 15]
[الكهف: 63]
[مريم: 83]
[آل عمران: 154]
[الأعراف: 20]
[النجم: 31]
[القصص: 29]
[النساء: 6]
[الأنعام: 130]
[الأنعام: 112]
[فصلت: 36]
[الأعراف: 200]
[فصلت: 36]
[الأعراف: 200]
[غافر: 3]
======
